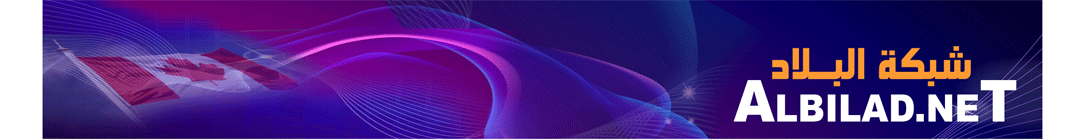
*صبحي *صبحي حديدي كاتب وناقد سوري مقيم في فرنسا حديدي كاتب وناقد سوري مقيم في فرنسا
كيسنجر في سنّ الـ100:
مجرم حرب يستشرف سلام القرون
صبحي حديدي
في 27 أيار (مايو) الجاري سوف يبلغ هنري كيسنجر سنّ الـ100 سنة، حفلت
بما قد لا يكون رجل دولة أمريكي قد شهده أو شارك في صنعه أو اقترفه من
سياسات وتحوّلات وجرائم حرب؛ على حدّ غير سواء، كما يشير السجلّ
التاريخي، إذْ تطغى السيئات الكثيرة على المحاسن القليلة، ولا تُقارَن
عواقب الخيارات الإجرامية النكراء بأيّ من نوادر المبادرات السلمية
الحميدة. وقد شاءت أسبوعية الـ»إيكونوميست» البريطانية، الناطقة الأمثل
بلسان الرأسمالية المعاصرة واقتصاد السوق، أن تحتفي على طريقتها
بالدنوّ من الـ100 سنة لمستشار الأمن القومي/ وزير الخارجية الأمريكي
الأسبق؛ الأشهر، أغلب الظنّ، على امتداد النصف الثاني من القرن
العشرين، وربما سائر عقوده.
ذلك لأنه «ما من أحد على قيد الحياة امتلك خبرة أكثر في الشؤون
الدولية، أوّلاً كعالِم في دبلوماسية القرن الـ19، ثمّ بعدئذ كمستشار
للأمن القومي وزير خارجية، وكمستشار ومبعوث إلى الملوك والرؤساء ورؤساء
الحكومات» يقول تحرير المجلة في التمهيد للحوار الاستثنائي الذي أجرته
مع كيسنجر؛ الآن تحديداً إذْ يتخوّف من مواجهة وشيكة بين الولايات
المتحدة والصين، هو الذي يُنسب إليه (بهتاناً، في قسط غير قليل) فضل
إطلاق ما بات يُعرف باسم «دبلوماسية كرة الطاولة» بين واشنطن وبكين،
وفتح العلاقات بين البلدين خلال زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق ريشارد
نيكسون صحبة كيسنجر إلى الصين، في حزيران (يونيو) 1971.
خلاصة أقواله، خلال 8 ساعات من الحوار مع تحرير الـ»إيكونوميست» أنّ
اشتداد التنافس على علوّ المكانة التكنولوجية والاقتصادية بين الصين
وأمريكا يثير المخاوف، حتى في وقت يشهد «تخبّط روسيا داخل المدار
الصيني» والحرب التي تخيّم على الخاصرة الشرقية لأوروبا، والذكاء
الاصطناعي يشحن التنافس الصيني ـ الأمريكي أكثر فأكثر. يذهب كيسنجر
أبعد، إلى نطاق عالمي يشهد تحوّلاً متسارعاً ومتعدد الأشكال في موازين
القوّة والأساس التكنولوجي للحرب، بحيث أنّ دولاً عديدة تفتقر إلى أيّ
«مبدأ مستقرّ» يمكّنها من إرساء الاستقرار، وبالتالي تلجأ إلى استخدام
الإجبار والعنف. «نحن في الوضع الكلاسيكي لما قبل الحرب العالمية
الأولى» يتابع بنبرة أستاذ التاريخ الدبلوماسي، «حيث لا يملك كلا
الطرفين هامشاً كافياً للتنازل السياسي، وحيث يمكن لأيّ اضطراب في
التوازن أن يقود إلى عواقب كارثية».
كلام ينذر بالويل والثبور، غنيّ عن القول، ما خلا أنه ليس جديداً في
مستوى النبوءات على الأقلّ؛ إذْ لم تنقضِ، بعدُ، سنة على أقوال مماثلة
صدرت عن كيسنجر، في حوار دراماتيكي بدوره مع صحيفة «وول ستريت جورنال»
الأمريكية هذه المرّة، غير المفترقة كثيراً عن خطوط تحرير
الـ»إيكونوميست» في نهاية المطاف. الولايات المتحدة «على حافة حرب مع
روسيا والصين حول مسائل أنشأناها نحن جزئياً، خالية من أيّ مفهوم
لكيفية الإنهاء أو ما يُفترض أن تسفر عنه» استخلص كيسنجر؛ وبصدد قدرة
واشنطن على «التثليث» مع الصين وروسيا، رأى التالي: «يصعب أن تقول الآن
أننا سوف نقسم صفوفهم ونقلبها إلى مواجهة فيما بينهم، وكل ما تستطيع
القيام به هو وقف تسريع التوترات واستنباط خيارات، ضمن هدف ما واضح
ومحدد».
يُنسب إلى كيسنجر فضل إطلاق ما بات يُعرف باسم «دبلوماسية كرة الطاولة» بين واشنطن وبكين، وفتح العلاقات بين البلدين خلال زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق ريشارد نيكسون صحبة كيسنجر إلى الصين
طريف، إلى هذا، أنّ كيسنجر يرى «المنظومة الصينية» أقرب إلى الكونفوشية
منها إلى الماركسية، الأمر الذي يدفع القادة الصينيين إلى بلوغ القوّة
القصوى التي في وسع بلدهم امتلاكها، وأن يُعترف بهم كقضاة أصحاب قرار
أعلى في مصالحهم. وإذْ ينفي عن زعماء الصين أية رغبة في الهيمنة
العالمية، فإنّ كيسنجر يُبعدهم عن أية مقارنة (لا أحد عتب عليه في
عقدها، أصلاً!) مع أدولف هتلر: في ألمانيا النازية كانت الحرب حتمية
لأنّ هتلر احتاج إليها، لكنّ الصين مختلفة كما يستنتج الرجل الذي التقى
بالعديد من القادة الصينيين، وعلى رأسهم ماو تسي تونغ نفسه. ومع ذلك،
لا يجزم كيسنجر حول نزوع الصين إلى فرض ثقافتها على العالم، مفضّلاً
إحالة السؤال إلى علاج قوامه «مزيج الدبلوماسية والقوّة».
ما هو بعيد عن الطرافة، بل أكثر تمثيلاً لنقائضها، أنّ تحرير
الـ»إيكونوميست» يلحّ على الخبير المئوي أن يستشرف سلام القرون وصراعات
الأمم ومنافسات القوى الكبرى، وفي الآن ذاته يتفادى طرح أيّ سؤال عن
مآلات/ عواقب أفعال كيسنجر في عشرات الميادين والساحات والحروب؛ كان
فيها مجرم حرب بامتياز، ومهندس انقلابات على أنظمة ديمقراطية أو توشك
على الانتقال إلى أنظمة حكم منتخَبة، وناصحاً باحتضان الطغاة ومساندة
الطغيان، ومستشاراً (شخصياً أو عبر شركاته ووكلائه) لأنظمة الفساد
والاستبداد في طول العالم وعرضه، ومحرّضاً على استخدام القوّة المفرطة
خارج أية شرعة قانونية أو إنسانية…
الأمثلة الكلاسيكية في بعض هذا «الاختصاص» لائحة طويلة عابرة للقارّات
والجغرافيات والثقافات، لعلّ أبرزها النصائح والمشورات والتوصيات
التالية:
ـ نصح دولة الاحتلال الإسرائيلي بسحق الانتفاضة «على نحو وحشيّ وشامل
وخاطف» وهذه كلمات كيسنجر الحرفية التي سرّبها عامداً جوليوس بيرمان
الرئيس الأسبق للمنظمات اليهودية الأمريكية، وتسربت معها نصيحة أخرى
مفادها ضرورة إبعاد الصحافة الغربية والمراسلين الأجانب عن مناطق
المواجهة مع الفلسطينيين، «مهما بلغت محاذير ذلك الإجراء»؛
ـ توبيخ فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، لأنّ ما
تعاقدوا عليه مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في أوسلو ثمّ في البيت
الأبيض، ليس سوى «إوالية»
Mechanism
متحرّكة ستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى دولة فلسطينية (هذه التي يرفضها
كيفما جاءت وأينما قامت، ويستوي لديه أن تتخلق من محض «إوالية» أو
تنقلب الى أقلّ من بلدية)؛
ـ الموقف «التشريحي» المأثور من الاحتلال العراقي للكويت، ودعوة بوش
الأب إلى تنفيذ ضربات «جراحية» تصيب العمق الحضاري والاجتماعي
والاقتصادي للعراق (البلد والشعب، قبل النظام وآلته العسكرية
والسياسية)؛
ـ الدعوة العلنية، المأثورة تماماً بدورها، إلى «نزع أسنان العراق دون
تدمير قدرته على مقاومة أي غزو خارجي من جانب جيرانه المتلهفين على
ذلك» في مقالة مدوّية بعنوان «جدول أعمال ما بعد الحرب» نشرها كيسنجر
مطلع 1991؛
ـ السخرية من بعض الفتية الهواة في البيت الأبيض ممّن يخلطون «البزنس»
بالأخلاق، والتجارة بحقوق الإنسان (في مثال الصين)؛ ولا يميّزون في
حروب التبادل التجارية بين العصبوية الأورو ـ أمريكية وشرعة التقاسم
الكوني لسوق شاسعة بقدر ماهي ضيقة…
هذه لائحة ذات نفع كبير في قراءة الخلفيات الفكرية والجيو ـ سياسية
والأخلاقية لما يقوله كيسنجر اليوم عن أيّ ملفّ دولي، شرقاً وغرباً؛
ومثلها في النفع الأعمّ أية إطلالة راهنة على تلك «الوصفة» الفريدة
لعلاج الكون كما فصّلها في كتابه الضخم «دبلوماسية» 1994. تلك، على
الأرجح، تظلّ عصارة فكر «الحكيم الستراتيجي» الذي لا يغيب ظلّه عن
ردهات البيت الأبيض أو البنتاغون أو تلة الكابيتول: مقيم ما أقامت
البراغماتية والتعاقد السرّي (المفضوح للغاية، مع ذلك) بين توازنات
القوّة وانعدام الحدّ الأدنى من الأخلاق، بين العنف والرطانة
الليبرالية، وبين الدم والبترول.
ولعلّ الأبلغ تعبيراً عن شخصية كيسنجر ومزاجه هذا المبدأ الذي جاءت به
تلك الوصفة: لا مناص من ترجيح التحالفات القائمة على المصلحة المشتركة،
وغضّ النظر عن التحالفات التي تحوّل مقولات «السلام» و«الحرّية» إلى
شعارات مطاطة وجوفاء. والأرجح أنّ تحرير الـ»إيكونوميست» غضّ الطرف،
اليوم، عن حصيلة كبرى جلية: هذه الـ 100 سنة لم تبدّل رؤى أستاذ
التاريخ، الأسوأ تمثّلاً لدروس التاريخ.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
ديون رئيسي في دمشق:
فاقد الشيء كيف يعطيه؟
صبحي حديدي
الأرجح أنّ رأس النظام السوري بشار الأسد اشتاق إلى تلك المناسبات
السالفة التي أتاحت له أن يتفلسف على هواه، في السياسة والعلاقات
الدولية والاقتصاد والثقافة؛ فانتهز فرصة كلمة الترحيب بالرئيس
الإيراني إبراهيم رئيسي، زائر دمشق هذه الأيام، فخاض في بعض هواياته
الكلامية الأثيرة. ولقد بدأ بإطراء مواقف نظامه ونظام الملالي في
إيران، معاً، التي حالت دون أن يكونا «كقطعة خشب ملقاة في البحر تأخذها
الأمواج حيث تشاء»؛ ثمّ سارع إلى ذمّ «تقديم المزيد من التنازلات تحت
عنوان الانحناء للعاصفة» بوصفه «السبب في تعزيز السياسات الاستعمارية
عبر العالم».
وهذا الذي يتشدق حول أخشاب تتقاذفها البحار أو انحناء أمام العواصف، هو
نفسه الذي يغتصب رئاسة بلد واقع تحت خمسة احتلالات إسرائيلية وروسية
وإيرانية وتركية وأمريكية، فضلاً عن كتائب «حزب الله» اللبناني وعشرات
الميليشيات المذهبية المأمورة من «الحرس الثوري» الإيراني و«الحشد
الشعبي» العراقي، إضافة إلى جهاديين إسلاميين من كلّ حدب وصوب. ولا
يجلس على يساره، خلال إلقاء موعظته الخرقاء، سوى مغتصب للرئاسة في
إيران، أتى إلى المنصب من حقول إعدام الآلاف من طلبة المدارس والشبان
والناشطين الإيرانيين، خلال حقبة 1988 الدامية الوحشية، الذين لم يكن
لهم من ذنب سوى المطالبة بإصلاحات بالغة البساطة.
وإذا كانت وسائل الإعلام، على اختلاف انحيازاتها، قد التقطت سمة أولى
طبعت الزيارة، هي كونها الأولى لرئيس إيراني إلى دمشق منذ 13 سنة؛ فإنّ
سمة أخرى كانت وتظلّ جديرة بالاستذكار، هي أنّ الأسد سبق أن زار طهران
مرّتين، على نحو معلن، في شباط (فبراير) 2019 وكان حسن روحاني رئيساً
لإيران، وفي أيار (مايو) 2022 وكان رئيسي قد تولّى الرئاسة؛ كما
استقبله، خلال الزيارتَين، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. هذا
تفصيل أوّل قد يخصّ مؤشر التبعية وأيّ الطرفين يحرص على إرضاء الآخر،
بافتراض أنّ نظام آل الأسد «طرف» بأيّ معنى للتناظر مع نظام الملالي؛
لكنّ الشطر الثاني منه، الذي يتصل بزيارة رئيسي إلى دمشق، يكتسب أهمية
خاصة من زاوية أولى محددة، لعلها الوحيدة التي تستحق معنى الجديد في
ميزان التبعية.
وهذا الشطر هو أنّ رئيسي في مجيئه إلى دمشق، وليس الأسد في هرولته إلى
طهران على دفعتين، إنما أتى وجدول أعماله شبه الوحيد هو تحصيل
الإيرادات عن سنوات طويلة من الإنفاق المادي على النظام، نفطاً وسلاحاً
وعملة صعبة وصيرفة. اللافتة المعلنة، كما نطق بها رئيسي نفسه، هي
الحضور الإيراني في صفقات إعادة الإعمار التي قد تكون على وشك الإبرام،
على ضوء مقايضات محتملة مع أنظمة مثل الإمارات والسعودية. وأمّا تجسيد
ذلك على الأرض فلم يكن خافياً بدوره، ليس على صعيد ما سُمّيت «مذكرة
تفاهم لخطة التعاون الشامل الستراتيجي طويل الأمد» فقط، بل كذلك حول
سلسلة اتفاقيات في ميادين الطاقة والزراعة والنقل والاتصالات والثقافة
(والمقصود هنا: تسهيلات الحجّ الإيراني إلى الأماكن الشيعية المقدسة في
سوريا)…
رئيسي يأتي، اليوم، حاملاً لائحة ديون إلى أجير مفلس وتابع مرتهن؛ ولن يعود، أغلب الظنّ، بما هو أثقل من خفّيْ حنين!
حساب الإيرادات والأرصدة وسداد بعضها ليس، مع ذلك، باليُسر الذي قد
يبدو عليه للوهلة الأولى، اتكاء على عوامل عديدة يصحّ الترجيح في أنّ
القرار حول الكثير منها ليس في عهدة النظام أصلاً، سوى تلك التي لا
يملك بصددها أيّ تخويل. العامل الأوّل، ولعله الحاسم أكثر من سواه، هو
ذاك الذي تقول به القاعدة العتيقة الصارمة، في أنّ فاقد الشيء لا
يعطيه، وليس في وسعه أن يعطيه أصلاً مهما ادعى وتشدّق. فالمليارات
الموعودة في مظاريف إعادة الإعمار رهن قرارات مراكز دولية مثل مؤتمرات
الدول المانحة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي
والأمم المتحدة، وهذه ليست حتى الساعة على وشك الترخيص بدولار واحد
يذهب إلى المصرف المركزي السوري شكلاً؛ ولكنه ينتهي سريعاً إلى خزائن
آل الأسد وآل الأخرس، ثمّ الشركاء وصغار الكسبة هنا وهناك في منظومة
الفساد المافيوزية.
العامل الثاني هو أنّ أيّ اتفاق بين النظامَين، الملالي في طهران وآل
الأسد في دمشق، ليس مضمون الإذن أو القبول أو الترخيص من القوى الأخرى
التي تحتل مناطق في سوريا، وتمتلك بالتالي أوراق ضغوط ومساومات
واستحقاقات؛ على غرار الوجود الروسي مثلاً، حيث يصعب تخيّل موسكو راضية
عن تسليم استثمارات ميناء اللاذقية إلى طهران الراغبة في تحويله إلى
منفذ بحري إيراني أوّل على المتوسط، كما يتردد. الحال ذاته يمكن أن
تنطبق على استثمارات روسية عديدة في سوريا، أبرزها الفوسفات (ثلاثة
مليارات طن من الاحتياطي) الذي تسيطر القوات الروسية على مواقعه، ويسيل
لعاب طهران على اقتسام موارده مع موسكو. ثمة درجات أخرى من التنافس حول
تطوير مطار دمشق واستثماره، أو إنشاء مطار جديد بطاقة استيعاب أعلى،
ومثله مطار حلب والقامشلي وميناء طرطوس؛ وفي أواسط آذار (مارس) الماضي
كان الأسد نفسه قد أعلن من موسكو عن أكثر من 40 مشروع استثمار روسي في
سوريا.
عامل ثالث يتصل من جانبه بقاعدة قديمة بدورها تخصّ انقلاب السحر على
الساحر، إذْ أنّ نظام آل الأسد الذي أقام الحكم والتحكم والتسلط على
شبكات الولاء والنهب والتكسّب، لن يفلح بسهولة في تذليل مصاعب (وربما
استحالة) عقد شراكات بالتراضي بين كبار أمراء الحرب ضمن العائلتَين
الأسدية والمخلوفية، وكبار قادة ميليشيات النظام الطائفية، وكبار
المستثمرين والفاسدين من ضباط الأجهزة الأمنية والجيش، من جهة؛ وأيّ،
وكلّ، استثمار إيراني يمكن أن يقتسم الكعكة مع هؤلاء، في مناطق الساحل
السوري بصفة خاصة، من جهة ثانية. هذه مسألة حياة أو موت على الطرفين،
رأس النظام وآل بيته الداخلي واستثماراته، ورؤوس النظام الأدنى مرتبة
ولكن ليس الأقلّ استثماراً أو استماتة في الحفاظ على النظام. ولقد مضى
زمن كان فيه «حزب الله» يلعب في مناطق الساحل السوري دور المبشّر
الطائفي الروحي والميسّر المادي التجنيدي بالنيابة عن ملالي طهران،
لكنّ قسطاً غير قليل من تلك الأدوار تذهب اليوم إلى «بو علي بوتين»
وضباط الجيش الروسي في قاعدة حميميم.
يبقى عامل رابع يخصّ ما تبقى من قوام دولة في سوريا، على أصعدة البنى
التحتية والمؤسسات والمنشآت وكلّ ما يتكفل عادة باحتضان استثمارات لها
طابع تحصيل الإيرادات؛ وهذا اعتبار لا يقتصر على مستقبل أموال نظام
الملالي في سوريا، بل يشمل أيضاً ما سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى انتزاعه من بشار الأسد خلال زيارة مفاجئة إلى دمشق، مطلع 2020، عاد
بعدها خالي الوفاض. لقد تكفلت حروب النظام ضدّ سوريا، الدولة والشعب
والمؤسسات والتاريخ، بتحويل البلد إلى حال متفاقمة من العطالة والفشل
والشلل، فضلاً عن العوز والندرة والتجويع والغلاء الفاحش وهبوط العملة
الوطنية إلى أسفل سافلين. وغير مستبعد، إلى هذا، أن يطوّب الأسد آلاف
الهكتارات من أراضي سوريا لصالح سلطات الملالي أو شركات استقبال الحجيج
الإيراني أو حتى تشييد الحسينيات، وأن تتعالى أكثر فأكثر الهتافات
الطائفية «يا علي! يا علي!» التي استقبلت الرئيس الإيراني على دروب
مطار دمشق.
وهذا لن يبدّل حقيقة أنّ رئيسي يأتي، اليوم، حاملاً لائحة ديون إلى
أجير مفلس وتابع مرتهن؛ ولن يعود، أغلب الظنّ، بما هو أثقل من خفّيْ
حنين!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
نتنياهو وآل الأسد:
طراز الانفتاح الآخر
صبحي حديدي
في غمرة الهرولة إلى الانفتاح على النظام السوري، والأحرى الحديث
بالطبع عن إعادة إدخاله إلى حظيرة نظام عربي متوحّد متماثل من حيث
الاستبداد والفساد والتبعية والفشل، تُنسى جهة مشاركة في السيرورة،
سبّاقة إليها كما يتوجب القول، وصاحبة الكثير من المصالح السياسية
والأمنية والعسكرية؛ على خلاف غالبية المهرولين العرب، حيث أهداف
الهرولة قصيرة النظر أو محدودة أو آنية أو وصولية تتوسل اتقاء الشرّ
وليس حتى دفعه.
تلك الجهة الثالثة هي دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تُنسى عموماً (عن
سابق قصد وتصميم، مضمونه الأوّل هو التجاهل لأغراض التجهيل)؛ رغم أنّ
المعطيات الشكلية يمكن أن تفضي إلى عكس هذا الافتراض، لأنّ الطيران
الحربي الإسرائيلي لم يتوقف عن قصف الأهداف في عمق الأراضي السورية،
وصواريخ الاحتلال تنهمر على الجولان ودمشق كما على مصياف وحلب
والبوكمال، جنوب سوريا وغربها وشمالها وشرقها.
ما خلا أنّ هذه المعطيات، ذاتها، تشير إلى أنّ الغالبية الساحقة من
«بنك الأهداف» الإسرائيلي تتركز على مواقع إيرانية يديرها «الحرس
الثوري» الإيراني، أو ميليشيات تتبع لطهران ابتداء من «حزب الله» وحتى
أصغر عصائب عراقية أو آسيوية متشيّعة المذهب؛ ويندر، في المقابل، أن
تستهدف الاعتداءات الإسرائيلية ما تبقى من ألوية جيش النظام، أو حتى
كتائب الفرقة الرابعة المرتبطة أكثر بالتواجد الإيراني في سوريا.
صحيح أنّ حكومة بنيامين نتنياهو أكثر انشغالاً بالشأن الإسرائيلي
الداخلي ومعضلات شروخ المجتمع الإسرائيلي بين مؤيد للائتلاف الحكومي
الأكثر يمينية وتطرفاً وفاشية في تاريخ الكيان من جهة، ومناهض لها
يتباكى على أطلال «الديمقراطية» الإسرائيلية وأنظمتها القضائية وموقع
المحكمة العليا من جهة ثانية. كما أنّ نتنياهو منشغل بآفاق التطبيع مع
الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، واحتمالات المستقبل مع ولي العهد
السعودي؛ وبالتالي ليس الانخراط في أي طراز من الانفتاح العلني نحو
نظام آل الأسد على جداول أعماله، الحافلة المزدحمة.
ولا يصحّ أن يُغفل، هنا، مغزى التصريحات التي نسبتها صحيفة «نيويورك
تايمز» الأمريكية إلى رامي مخلوف، ابن خال الرئاسة الذي كان حتى عهد
قريب صيرفي آل الأسد/ مخلوف، وتمساح الاستثمار والأعمال الأشرس في
سوريا؛ بصدد العلاقة الوثيقة بين استقرار النظام السوري، واستقرار دولة
الاحتلال، حيث قال بالحرف: إذا لم يتوفّر استقرار هنا، فلا سبيل إلى
استقرار هناك. كان ذلك بعد أشهر قليلة أعقبت انطلاق الانتفاضة الشعبية
السورية، ولم يطل الوقت حتى تناغمت مع هذه الأقوال تسريبات على ألسنة
جنرالات إسرائيليين في المؤسستين العسكرية والأمنية، تحثّ على الامتناع
عن أيّ إسهام في تقويض نظام آل الأسد.
وكان منطق المطالبة الإسرائيلية بالمدّ في عمر النظام يستند على ثلاثة
مسوّغات، بين أخرى أقلّ إلحاحاً؛ أوّلها أنّ نظام «الحركة التصحيحية»
حافظ على حدود الاحتلال الإسرائيلي للجولان، لا كما فعل أيّ نظام سوري
سابق، منذ تأسيس الكيان الصهيوني. الثاني يساجل بأنّ أيّ نظام مقبل في
سوريا لن يكون أفضل حالاً لدولة الاحتلال؛ بل الأرجح أنه سوف يكون أسوأ
لأمنها القريب والبعيد، بالنظر إلى الروابط العميقة التي شدّت، وستظلّ
تشدّ، الشعب السوري إلى القضية الفلسطينية. وأمّا المسوّغ الثالث فإنه
انطلق من معادلة ذرائعية لوجستية: ما دام جيش النظام استخدم ضدّ
المعارضة صنوف الأسلحة جميعها، من الدبابة والمدفعية الثقيلة إلى
السلاح الصاروخي والجوّي، بما في ذلك البراميل المتفجرة، والقنابل
العنقودية، والألغام البحرية…؛ وما دامت المعارضة ليست مكتوفة الأيدي،
فهي تدمّر الدبابة وتُسقط الطائرة وتقتل، مثلما يُقتل منها…؛ فإنّ دولة
الاحتلال رابحة في كلّ الأحوال.
طراز انفتاح آخر، إذن، لم يعكر صفوه أيّ تشدّق أمريكي معترض (علانية
فقط) على هرولة بعض الأنظمة العربية إلى أخيهم ساكن الحظيرة السابق،
الذي تجري إعادته إلى حيث انتمى وينتمي.
الغزو الأمريكي للعراق:
لائحة المطامع ودروس الإخفاق
صبحي حديدي
صدرت في هذه السنة، 2023، مؤلفات كثيرة تتناول الذكرى الـ20 للاجتياح
الأمريكي في العراق، 20/3/2003؛ وما أعقبه من إسقاط نظام صدّام حسين،
وسلسلة الإخفاقات السياسية التي ستقود الولايات المتحدة من عثرة إلى
أخرى، وصولاً إلى مواجهات عسكرية شرسة مع فصائل جهادية تتبع «القاعدة»
أو تنفرد عنها، كان سقوط مدينة الموصل في قبضة تنظيم «داعش» بمثابة
ذروة قصوى فارقة توّجت سيرورة الغزو. غالبية تلك الأعمال، خاصة ما صدر
منها باللغة الإنكليزية في بريطانيا والولايات المتحدة، خلصت إلى تسجيل
أنساق شتى لفشل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، وحكومة رئيس
الوزراء البريطاني توني بلير؛ في ضمان حدود دنيا من كسب السلام، بعد
حسم الحرب.
وتتوقف هذه السطور عند واحد من أفضل المؤلفات في هذا الصدد، كتاب أستاذ
التاريخ في جامعة فرجينيا ملفن بول ليفلر، الذي صدر مؤخراً ضمن منشورات
جامعة أكسفورد بعنوان «مجابهة صدّام حسين: جورج و. بوش وغزو العراق».
اعتبار أوّل حكم هذا الاختيار هو أنّ حجم أبحاث الكتاب، من وثائق
وإفادات ومعلومات، ليس هائلة ومتنوعة وشاملة، فحسب؛ بل هي فريدة لجهة
الموازنة بين المعطيات الأمريكية ونظائرها العراقية. الاعتبار الثاني
هو أنّ ليفلر يتمتع برصانة تأريخية مشهود لها، في حقل دراسي مزروع
بكثير من الألغام والعوائق، فضلاً عن المحظورات والمنازعات.
ويبدأ ليفلر من تبيان الفوارق بين برهة الهجمات الإرهابية يوم
11/9/2001، حين حظيت أمريكا بتعاطف عالمي سهّل على إدارة بوش الذهاب
مباشرة نحو الغزو؛ وبين عقد واحد فقط، أعقب اجتياح العراق وشهد الكثير
من المتغيرات: أمريكا متورطة في العراق، مكانتها العالمية آخذة في
التراجع، وهيمنتها الاقتصادية تواصل الانحسار، ومعنويات الشعب الأمريكي
تواصل الهبوط في غمرة انقسامات سياسية وحزبية وعنصرية؛ وعلى صعيد
الخارج تتزايد مشاعر العداء لأمريكا، وتصعد في المقابل قوى جبارة مثل
الصين، ويسجّل الانسحاب المخزي من أفغانستان نكسة متعددة المستويات،
ويطرح الغزو الروسي في أوكرانيا مزيداً من التحديات، ويبحث بعض أبرز
حلفاء أمريكا التقليديين (على شاكلة السعودية والإمارات) عن أصدقاء
بدلاء…
ومنذ السطور الأولى يعلن ليفلر أنّ الهدف من كتابه هو «تفحّص ما جعل
الولايات المتحدة تقرّر غزو العراق، ولماذا انحرفت الحرب سريعاً، وآلت
إلى مأساة للعراقيين وللأمريكيين». وأيضاً، يتابع ليفلر: «أحاول تصحيح
مفاهيم مغلوطة واسعة الاعتناق، كما أثبّت أيضاً بعض الحكمة المترسخة.
أضع الرئيس بوش في قلب سيرورة صناعة السياسة حيث يقتضي موقعه. أشدّد
على مخاوفه، وحرصه على أمن الوطن الداخلي. أناقش خططه الحربية
وستراتيجية دبلوماسيته القسرية. وأشدّد على التمييز بين دوافعه
وأهدافه، وأشرح كيف أنّ حرباً من أجل الأمن انقلبت إلى تمرين في بناء
الأمّة والترويج للديمقراطية من دون تحضير ملائم».
كسب السلام، السلام بمعناه الأعرض المركّب الذي يتجاوز وقف إطلاق النار وانتهاء الأعمال العسكرية، والذي لا يعني ما هو أقلّ من استثمار نتائج الحرب لصالح القوّة الظافرة، في المستويات الجيو ـ سياسية والاقتصادية في البدء؛ ثمّ في المستويات الأخرى
وللمرء أن يتفق مع العديد من خلاصات ليفلر، خاصة تلك التي تعيد قراءة
المشهد في ضوء الانتكاسات الفعلية المتعاقبة وليس الآمال الأولى
الكاذبة؛ وللمرء أن يختلف معه أيضاً، في طائفة غير قليلة من تأويلاته
لأسباب الاجتياح الأكثر خفاء، والأبعد خدمة لأغراض جيو -سياسية تتجاوز
مآلات 11/9 وحوافزها. وبين الاتفاق والاختلاف ثمة هوامش، عديدة بدورها،
تنفع حقوق كتابة التاريخ وإنصاف سلسلة الجوانب المأساوية التي كان
الشعب العراقي أوّل دافعي أثمانها الباهظة، وما يزال يسدّد المزيد منها
حتى الساعة. وثمة، استطراداً، ملفات لا تنحصر داخل العراق وحده، ولا
حتى ضمن الخطوط الأعرض لخيارات السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة؛
لأنها ببساطة تكشف قسطاً غير قليل من نهج الولايات المتحدة في إدارة
العلاقات الدولية، من موقعها كقوّة كونية سياسية وعسكرية واقتصادية
وتكنولوجية عظمى، بمعزل هذه المرّة عن هوية سيّد البيت الأبيض وما إذا
كان جمهورياً أم ديمقراطياً، بوش الأب أم الابن، بيل كلنتون أم باراك
أوباما.
وبين أبرز عناصر الملفّ السياسي خلف قرار الغزو استقرّ ما حلم به
رجالات بوش الابن (وخاصة أصحاب «مشروع قرن أمريكي جديد» أمثال بول
ولفوفيتز وريشارد بيرل) حول تحويل العراق إلى «دولة ـ أمثولة» حاملة
للقِيَم الأمريكية (في طبعتها الرجعية أو النيو ـ محافظة تحديداً) إلى
أربع رياح الشرق الأوسط. والحال أنّ أسابيع قليلة فقط أعقبت الاجتياح
كانت كافية لدفع هذا الهوس إلى الكواليس بعض الشيء، ليس لأنّ أصحابه
فقدوا الإيمان به (عن حسن نيّة أو سوء طوية)؛ بل لأنّ الأولوية القصوى
في أشغال الإدارة كانت ممنوحة لاعتبارات التمهيد العسكري على الأرض،
وإنقاذ ماء وجه الحليف الأبرز، رئيس الوزراء البريطاني بلير.
وفي ستراتيجية السيطرة على النفط العراقي، الاحتياطيّ الأوّل في العالم
كما كانت التقديرات تشير عشية الغزو، لم تكتفِ الولايات المتحدة بهدف
تأمين حاجاتها إلى الطاقة فحسب؛ بل أرادت أيضاً إكمال طوق السيطرة غير
المباشرة على نفط السعودية والكويت، والإمساك تالياً بورقة ضغط
اقتصادية ـ سياسية كونية حاسمة أطلق عليها جوستن بودر تسمية «الفيتو
النفطي». وفي الترجمة العملية لأبجدية تلك السيطرة، كان يتوجب أن يصبح
في وسع الولايات المتحدة الضغط على اقتصاديات منافسة (مثل الاتحاد
الأوروبي واليابان) أو أخرى مرشحة للمنافسة مستقبلاً (الصين وروسيا
والهند).
كذلك لم يكن قرار الغزو خالياً من هاجس ما أمكن تسميته «الاستيطان
العسكري» بمعنى حاجة الولايات المتحدة إلى التواجد العسكري، الدائم
والكثيف والمستقرّ، في منطقة الشرق الأوسط عموماً، والخليج خصوصاً. لكن
خبراء التخطيط في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ثمّ في وزارة الدفاع،
كانوا على يقين بأنّ استمرار التواجد العسكري المكثف في السعودية
والكويت يتحوّل تدريجياً إلى عبء سياسي؛ إذْ بات بمثابة حاضنة خصبة
لتفريخ مشاعر العداء للولايات المتحدة، واستيلاد المزيد من نماذج أسامة
بن لادن، وتعريض أمن النظامين الحاكمين لمخاطر مباشرة. وهكذا فإنّ قرار
غزو العراق واحتلاله كان يعني، أيضاً، الاستيطان فيه عسكرياً إلى أمد
طويل، وتخفيف العبء عن دول الخليج، وحراسة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن
بُعد، وإحكام القبضة على المنطقة بأسرها عملياً.
ويبقى أنّ الدرس الختامي، الأشبه بتأمّل واقعي لمجمل سردية الاجتياح
وليس لأية حكمة مستقبلية، هو التالي في يقين ليفلر: «قد يكون من باب
العزاء التفكير في أنّ الأمر كان سينتهي على ما يرام لو توفّر لنا
صانعو سياسة أكثر نزاهة. أمّا الحقيقة فهي أنه من الصعب حيازة معلومات
دقيقة وتقييمها موضوعياً. من الصعب قياس التهديد. من الصعب موازنة
الوسيلة مع الغاية. من الصعب ترويض الميول والتعصبات. من الصعب وَزْن
ردود أفعال أناس لا يعرف عنهم المرء إلا القليل. من الصعب التحكّم
بمخاوفنا، وضبط سلطتنا، ولجم غطرستنا».
وقد تصحّ لائحة الصعوبات هذه، في كثير أو قليل، غير أنها لا تجبّ،
وهيهات أن تُبطل، حقيقة كبرى تكررت على مدار الحروب جمعاء، وحروب
الولايات المتحدة خصوصاً وتحديداً: أنّ كسب الحرب لا يعني البتة كسب
السلام، السلام بمعناه الأعرض المركّب الذي يتجاوز وقف إطلاق النار
وانتهاء الأعمال العسكرية، والذي لا يعني ما هو أقلّ من استثمار نتائج
الحرب لصالح القوّة الظافرة، في المستويات الجيو ـ سياسية والاقتصادية
في البدء؛ ثمّ في المستويات الأخرى التالية، المباشرة وغير المباشرة.
وحال الولايات المتحدة في عراق هذه الأيام ليس في حاجة إلى تمحيص، في
ضوء تلك الحقيقة الكبرى.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
العلاقات السعودية ـ الإيرانية:
أبعد من عصا الصين السحرية
صبحي حديدي
أيّ عصا سحرية تمتلك الصين الرسمية حتى تمكنت، وتتمكن تباعاً، من كسر
جليد لاح أنه سميك قديم متقرّن في العلاقات بين السعودية وإيران؛ فما
كاد كثيرون يفلحون في التقاط أنفاسهم بعد مفاجأة اختراق صيني أوّل
(مبادرة الرئيس الصيني، مطلع آذار/ مارس الماضي، شي جين بينغ للجمع بين
الرياض وطهران) حتى جاء التطور المباغت الثاني في لقاء وزيرَي خارجية
البلدين في بكين دائماً وإعلانهما الاتفاق على استئناف العلاقات
الدبلوماسية وفتح السفارتين؟ وهل توفير عصا، من نوع خارق وقادر على
اجتراح العجائب، ضروري هنا لتأويل المنقلبات التي يمكن أن تطرأ على
سياسات دولية أو إقليمية تتصف، من حيث المظهر الخارجي والمعطيات
الظاهرة على الأقلّ، بالتعقيد والتشابك وصعوبة الحلحلة؟
العصا استعارة بالطبع، أو هي في تبسيط أوضح مجاز عن أدوات متعددة
الوظائف، جيو ـ سياسة واقتصادية ودبلوماسية، قد تتوفر لدى جهة وازنة في
وسعها التوسط بين قضيتَين أو أزمتَين أو عاصمتين، لصالح الأطراف
الثلاثة في أوّل الجهد وآخره؛ مقترنة، غالباً، بتراكم سلسلة من العوامل
المساعدة على تليين هنا أو تنازل هناك، مثلما هي مشروطة بضرورة انحسار
قطب رابع كان في الماضي القريب يمتلك عناصر الضغط والتعكير أو حتى
تعطيل جهود المصالحة. في صياغة أوضح:
ـ مع وصول العلاقات السعودية ـ الإيرانية إلى ما يشبه درجة الصفر في
التحكّم والتحكّم المضاد (اليمن مثلاً بالنسبة إلى الرياض، وملفّ
العقوبات الاقتصادية الخانقة ومأزق الاتفاق حول البرنامج النووي
بالنسبة إلى طهران)؛
ـ ومع بحث الرياض عن نظائر بديلة (روسية وصينية، أساساً) يمكن أن تحدّ
في قليل أو كثير من قيود التبعية السعودية المتأصلة للولايات المتحدة،
مقابل دأب طهران على مقارعة الخصم الأمريكي بما ملكت من وسائل وطرائق
وساحات؛
ـ فإنّ من المنطقي أن تتقدّم بكين إلى المشهد، وأن تكون مصالحها مع
الرياض وطهران، العالقة في الآن ذاته مع واشنطن، هي الحافز والميزان
والمحك، خاصة وأنها القوّة الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمارية
الصاعدة، من جانب أوّل؛ وأنها ليست روسيا، المتورطة في أكثر من جبهة
عسكرية خارجية، والأعلى كموناً بما لا يُقاس بصدد استثارة حساسية
واشنطن وإغضاب البيت الأبيض والكونغرس معاً، من جانب ثانٍ.
هذه الخلاصة تظلّ حصيلة معطيات حاضرة ومرئية، تحظى أيضاً بمقادير غير
قليلة من المنطق السليم الذي يغطي القسط الأعظم من جوانبها؛ الأمر الذي
لا ينفي، للوجاهة المنطقية إياها، وعورة الدروب التي يتوجب أن تقتفيها
المصالحة، بصرف النظر عن فاعلية الوسيط الصيني أو ما يحمله من أوراق
تبدو كفيلة بتعبيد المسير. ثمة، في بُعد أوّل، ما يكتنف الركائز
الوجودية ذاتها للبلدَين، في محيط إقليمي مشتعل أو لم يتوقف عن
الاحتقان بصدد الاستقطاب العتيق إياه، السنّي الذي تقوده السعودية،
والشيعي الذي تتولاه طهران فعلياً وتنغمس فيه منذ انتصار الثورة
الإسلامية وعودة الإمام الخميني، سنة 1979.
من المنطقي أن تتقدّم بكين إلى المشهد، وأن تكون مصالحها مع الرياض وطهران، العالقة في الآن ذاته مع واشنطن، هي الحافز والميزان والمحك، خاصة وأنها القوّة الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمارية الصاعدة، من جانب أوّل؛ وأنها ليست روسيا، المتورطة في أكثر من جبهة عسكرية خارجية
المسائل هنا ليست فقهية، إلا في حدود سطحية أقرب إلى تمويه الجوهر،
لأنّ طبيعتها الوجودية تقتضي من طهران تسعير ما تسمّيه «ثورة
المستضعَفين» وتصديرها في أنساق ميليشيات صغرى كثيرة متناثرة وأخرى
كبرى متمركزة على شاكلة «حزب الله» في لبنان و«الحشد الشعبي» في العراق
و«أنصار الله» في اليمن.
ما تقتضيه من الرياض، في المقابل، ينبسط في التاريخ الحديث والمعاصر
على فصول عديدة، تضمنت معظمها قطع العلاقات مع طهران على غرار أحداث
مكة 1987، كما ذهبت في مناسبات أخرى شأو إعدام الشيخ السعودي الشيعي
نمر باقر النمر، وتأخذ صباح مساء شتى أشكال القلق السعودي الأمني من
التحريض الإيراني للمواطنين السعوديين الشيعة في المنطقة الشرقية وفي
محافظتَي القطيف والأحساء أو في مختلف أراضي المملكة.
العصا السحرية الصينية تذهب، بالتعريف الذي لا يتعارض مع أصول أخلاقيات
الاتجار الصيني المعاصر وخاصة التكنولوجي والمعلوماتي منه، إلى ما يشبه
إدارة الموقع والمتجر والمختبر؛ أي إلى المراهنة على علاقات بنيوية
وبينية بين مؤسسات الدولة في البلدين، التي تؤاخي بين استيراد كميات
هائلة وقصوى من النفط السعودي والإيراني، وبين تصدير تطبيق «تيك توك»
على سبيل المثال الراهن الأبرز. والأمر هنا لا يدخل في عداد قوانين
العولمة، ذات السطوة والعشوائية في آن معاً، وحدها، وعلى أهميتها؛ بل
يشتغل على تطورات آنية لم تكن في المشهد قبل سنوات قليلة فقط، مثل
التوتر السعود ـ الأمريكي بصدد قرارات منظمة «أوبك» أو اعتماد الولايات
المتحدة نهجاً في تفضيل النفط الصخري على نحو يُسقط الكثير من هيمنة
النفط السعودي (إدارة الطاقة الأمريكية توقعت أن يرتفع إنتاج الزيت
النفطي إلى أكثر من 9 ملايين برميل يومياً) أو… تيه إدارة جو بايدن بين
الوعد بتحديد دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبين الانتهاء إلى
حال معكوسة يكيل فيها بن سلمان طعنات دبلوماسية ونفطية نجلاء إلى الشيخ
الأمريكي الرئيس.
ثمة الكثير الذي يتوجب أن يُحتسب أبعد من قدرات العصا السحرية الصينية،
وفي الطليعة ما يُنتظر من مفاعيل سلبية داخلية إزاء طيّ عدد من الملفات
الحساسة، في السعودية كما في إيران، وعلى مستويات الشوارع الشعبية أو
تلك الدينية، العفوية منها أو المنظمة؛ فكيف والتعقيدات الأشدّ سخونة
ليست في داخل البلدين بقدر ما هي خارجهما في الإقليم الواسع الشاسع،
العراق وسوريا ولبنان مثل اليمن والبحرين والكويت؟ البعض يساجل بأنّ
زخم المبادرة الصينية راجع إلى استجابة بن سلمان وحماسه لوضع المزيد من
عناصر التكييف السعودي الداخلي على أسرّة العلاج بالصدمة، فضلاً عن
شهية شخصية لتصفية حسابات قديمة مع بايدن على صلة بمقتل الصحافي
السعودي جمال خاشقجي. فإذا جاز هذا السجال، فإنّ المشهد الداخلي
الإيراني، الموازي في أكثر من اعتبار، ليس بعدُ جاهزاً لطرائق علاج
مماثلة مع الدولة ذاتها التي أمطر الحوثيون منشآتها النفطية ومطاراتها
بوابل من صواريخ «الحرس الثوري» الإسلامي.
ليس مجرداً من مغزى بالغ الخصوصية، وهو بدوره أبعد من اشتغال العصا
السحرية الصينية على التوسط بين الرياض وطهران، أن زيارة الرئيس الصيني
إلى السعودية أواخر العام المنصرم وُضعت (من جانب الصين أوّلاً، في
الواقع) ضمن إطار إقليمي، أو عربي محدد بالاسم على الأقلّ. فقد تقصد
الناطق باسم الخارجية الصينية التشديد على هذا البُعد حين اعتبر
الزيارة «حجر أساس صانع لحقبة في تاريخ العلاقات الصينية ـ العربية»
و«شراكة ستراتيجية وشاملة». ليس مستغرباً، بالتالي، أن تكون أعين الصين
متوجهة إلى مشهد أوسع نطاقاً وأدسم مكاسباً، يشجع على الأمل في اغتنامه
ما يعتمل في المنطقة من اختلاط أوراق واحتشاد تدخلات وصراع مصالح
وتوافقات وصفقات… في آن معاً.
وإذا كان صحيحاً أنّ الصين، في انفتاحها المتسارع على الشرق الأوسط
عموماً ومنطقة الخليج خصوصاً، قد قفزت إلى فراغ خلّفته السياسة
الأمريكية خلال سنوات الرئيس الأسبق دونالد ترامب وخَلَفه بايدن على
نحو متكامل؛ فالصحيح المقابل هو أنّ تاريخ التبعية السعودية للولايات
المتحدة، الطويل والمركّب والعضوي تقريباً، لا يسمح بقفزة إلى الفراغ
ذاته. ليس بين ليلة وضحاها بادئ ذي بدء، وليس قبل أن يسود الوئام
والسلام في ربوع، وعلى خرائب وأطلال، حروب الوكالة بين الرياض وطهران.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
صيد السَحَرة:
من المعجم العربي إلى ترامب
صبحي حديدي
يشير التقرير الأحدث، الذي أصدرته
«رابطة المكتبة الأمريكية» قبل أيام، إلى تزايد هائل في أعداد الشكاوى
المطالبة بسحب هذا الكتاب أو ذاك من مكتبات المدارس، على اختلاف
صفوفها، والمكتبات العامة، وكذلك دور العجزة والمشافي والسجون؛ ضمن
ظاهرة ليست البتة طارئة، بل مألوفة تماماً وترصدها الرابطة منذ تأسيسها
رسمياً قبل 20 سنة. الفارق أنّ الأرقام هذه المرّة صاعقة: من 1858 شكوى
(وهي أعداد عناوين، بالطبع) في سنة 2021، إلى 2571 في سنة 2022؛
ومحتويات الكتب الرجيمة لا تدور فقط حول الحريات الجسدية أو إدانة
التمييز العنصري أو قضايا الدين والسياسة كما للمرء أن يتخيل، بل تشمل
أيضاً روايات ومجموعات شعرية ومعاجم.
هنا، على سبيل الأمثلة الأولى، نماذج من لائحة أعمال مُنعت قراءتها في
سجون ولاية كارولاينا الشمالية، بقرار إداري من «إدارة الأمن العام»:
«معجم عربي ــ إنكليزي»، «أسس تقنيات الكتابة»، «موسوعة الكلاب»،
«موسوعة كرة السلة»، «قاموس ألماني موسّع»، «أطلس العالم الجديد»،
«النحت بالطين»، «موسوعة أدب الخيال العلمي»، «موسوعة السينما»، «قاموس
وبستر الشامل»… فإذا كان المعجم الأوّل مشبوهاً لأنه يحتوي مفردات
عربية، فما المشكلة مع قاموس وبستر الإنكليزي، أو… موسوعة الكلاب؟
هنا أمثلة أخرى من الكتب، مع سرد المسوّغات التي دفعت إلى سحبها: مارك
توين، «مغامرات هكلبري فين»، 1884، لأنه اعتُبر «نفاية لا تلائم إلا
الأحياء الفقيرة»؛ مالكولم إكس وأليكس هيلي، «السيرة الذاتية لـ
مالكولم إكس»، 1965، وقد نُظر إليه كـ»دليل يعلّم ارتكاب الجريمة»،
ومعاداة البيض؛ توني مويسون، «محبوبة»، 1987، لأنّ الرواية تكرّس العنف
وتحرّض السود على البيض؛ دي براون، «ادفنوا قلبي عند الركبة الجريحة»،
1903، لأنه يثير إشكاليات تاريخ الهنود الحمر، ويعيد سرد تاريخ توسّع
الولايات المتحدة في الغرب من وجهة نظر الأقوام الأصلية؛ جاك لندن،
«نداء البرّية»، 1903، لأنه يقيم الوجود على أساس من العلاقة بين إنسان
وكلب (وهذا، للمناسبة، تفسير اعتمدته النازية أيضاً فأحرقت الرواية)…
حملات المطالبة بسحب هذه الكتب، وسواها كثير متنوع، تقودها جمعيات
محافظة مثل «أمهات من أجل الحرية» أو «اتحاد أولياء يوتا»، حيث تنصبّ
الجهود على استصدار تشريعات بتضييق اقتناء الكتب ومحاسبة أمناء
المكتبات أمام القضاء، أو الضغط المباشر على إدارات المدارس والمشافي
والسجون عن طريق التظاهر والاعتصام والإعلانات المدفوعة في الصحف.
لافت، على نحو خاصّ، أنّ غالبية هذه الجمعيات محافظة بالمعنى الأشدّ
تزمتاً في الثقافة السياسية والاجتماعية والأخلاقية الأمريكية، لكنها
أيضاً تنتمي إلى المجموعات المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد
ترامب، المؤمنة بأنّ الانتخابات الرئاسية الأخيرة سُرقت منه، والمتحمسة
لترشحه وعودته مجدداً إلى البيت الأبيض.
طريف إلى هذا أنّ ترامب هو اليوم رافع راية «صيد السَحَرة»، واستهدافه
من جانب الديمقراطيين واليسار في القضاء الأمريكي على خلفية شراء سكوت
الممثلة الإباحية التي جمعته بها علاقة حميمة قبل أن يقتحم ميدان
السياسة ويتصدّر مرشحي الحزب الجمهوري لانتخابات 2016. وأمّا وجه
الطرافة فهو أنّ التعبير إنما يحيل إلى الكاتب المسرحي الأمريكي الكبير
آرثر ميللر (1915-2005)، الذي كان ضحية الرقابة على مسرحيته الشهيرة
«المحنة»، والتي تدور حول المحاكمات الشهيرة لساحرات بلدة سالم
الأمريكية، أواخر القرن السابع عشر. إلا أنّ خلفية النصّ كانت تشير إلى
أمريكا القرن العشرين، وصيد السحرة الذي مارسته «لجنة النشاطات
المعادية لأمريكا»، التي دشّنت فجر الـ»مكارثية» بوصفها أسوأ استبداد
ثقافي وفكري عرفته الولايات المتحدة على امتداد تاريخها. ففي عام 1947
أُضيف ميللر إلى لائحة تضمّ 320 من العاملين في مختلف أعمال المسرح
والسينما والغناء والأوبرا وسواها من الفنون، مُنعوا من العمل بقرار من
اللجنة تلك.
وإلى جانب ميللر توفّرت أسماء عدد كبير من خيرة كتّاب وفنّاني الولايات
المتحدة آنذاك: ريشارد رايت، جوزيف لوزي، بول روبسون، داشيل هاميت،
كليفورد أوديتس، لويس أنترمير، وسواهم. وذنب هؤلاء كان مزدوجاً: أنهم
ينتمون بهذا الشكل أو ذاك إلى تيّارات اليسار، ويُشتبه تالياً
بانتمائهم إلى الحزب الشيوعي؛ وأنهم رفضوا ممارسة الدسيسة على زملائهم،
والإدلاء بمعلومات عنهم إلى اللجنة. وفي كتاب السيرة الذاتية الذي
أصدره سنة 1987 بعنوان «على مرّ الأيام: حياة»، يروي ميللر تفاصيل
مثيرة عن تلك الحقبة، لعلّ أشدّها تأثيراً في النفس ليس صموده هو
شخصياً أمام اللجنة، بل انهيار صديقه المخرج المسرحي والسينمائي الشهير
إيليا كازان.
وقد يعجب امرؤ من أنّ أمريكا هذه، ذاتها التي لا تمارس أيّ طراز ملموس
من الرقابة على اقتناء الأسلحة النارية، أو إنتاج مختلف بضائع البورنو
المقروءة والمرئية والمصنّعة والترويج لها، تتحفز جمعيات نافذة فيها
ضدّ معجم عربي ــ إنكليزي أو آخر إنكليزي – إنكليزي داخل سجن، أو تتجند
لسحب روايات إرنست همنغواي، «لمَنْ يقرع الجرس»؛ أو مرغريت ميتشل، «ذهب
مع الريح»؛ أو جون شتاينبك، «أعناب الغضب»؛ أو ف. سكوت فتزجيرالد،
«غاتسبي العظيم»…
والأرجح أنّ العجب لن يطول، إذا كان المطالِب بمنع هذه الأعمال، هو
نفسه المؤمن بأنّ ترامب ضحية صيد السَحَرة؛ سواء بسواء!
مقالات سابقة
صيد السَحَرة:
من المعجم العربي إلى ترامب
صبحي حديدي
يشير التقرير الأحدث، الذي أصدرته «رابطة المكتبة الأمريكية» قبل أيام،
إلى تزايد هائل في أعداد الشكاوى المطالبة بسحب هذا الكتاب أو ذاك من
مكتبات المدارس، على اختلاف صفوفها، والمكتبات العامة، وكذلك دور
العجزة والمشافي والسجون؛ ضمن ظاهرة ليست البتة طارئة، بل مألوفة
تماماً وترصدها الرابطة منذ تأسيسها رسمياً قبل 20 سنة. الفارق أنّ
الأرقام هذه المرّة صاعقة: من 1858 شكوى (وهي أعداد عناوين، بالطبع) في
سنة 2021، إلى 2571 في سنة 2022؛ ومحتويات الكتب الرجيمة لا تدور فقط
حول الحريات الجسدية أو إدانة التمييز العنصري أو قضايا الدين والسياسة
كما للمرء أن يتخيل، بل تشمل أيضاً روايات ومجموعات شعرية ومعاجم.
هنا، على سبيل الأمثلة الأولى، نماذج من لائحة أعمال مُنعت قراءتها في
سجون ولاية كارولاينا الشمالية، بقرار إداري من «إدارة الأمن العام»:
«معجم عربي ــ إنكليزي»، «أسس تقنيات الكتابة»، «موسوعة الكلاب»،
«موسوعة كرة السلة»، «قاموس ألماني موسّع»، «أطلس العالم الجديد»،
«النحت بالطين»، «موسوعة أدب الخيال العلمي»، «موسوعة السينما»، «قاموس
وبستر الشامل»… فإذا كان المعجم الأوّل مشبوهاً لأنه يحتوي مفردات
عربية، فما المشكلة مع قاموس وبستر الإنكليزي، أو… موسوعة الكلاب؟
هنا أمثلة أخرى من الكتب، مع سرد المسوّغات التي دفعت إلى سحبها: مارك
توين، «مغامرات هكلبري فين»، 1884، لأنه اعتُبر «نفاية لا تلائم إلا
الأحياء الفقيرة»؛ مالكولم إكس وأليكس هيلي، «السيرة الذاتية لـ
مالكولم إكس»، 1965، وقد نُظر إليه كـ»دليل يعلّم ارتكاب الجريمة»،
ومعاداة البيض؛ توني مويسون، «محبوبة»، 1987، لأنّ الرواية تكرّس العنف
وتحرّض السود على البيض؛ دي براون، «ادفنوا قلبي عند الركبة الجريحة»،
1903، لأنه يثير إشكاليات تاريخ الهنود الحمر، ويعيد سرد تاريخ توسّع
الولايات المتحدة في الغرب من وجهة نظر الأقوام الأصلية؛ جاك لندن،
«نداء البرّية»، 1903، لأنه يقيم الوجود على أساس من العلاقة بين إنسان
وكلب (وهذا، للمناسبة، تفسير اعتمدته النازية أيضاً فأحرقت الرواية)…
حملات المطالبة بسحب هذه الكتب، وسواها كثير متنوع، تقودها جمعيات
محافظة مثل «أمهات من أجل الحرية» أو «اتحاد أولياء يوتا»، حيث تنصبّ
الجهود على استصدار تشريعات بتضييق اقتناء الكتب ومحاسبة أمناء
المكتبات أمام القضاء، أو الضغط المباشر على إدارات المدارس والمشافي
والسجون عن طريق التظاهر والاعتصام والإعلانات المدفوعة في الصحف.
لافت، على نحو خاصّ، أنّ غالبية هذه الجمعيات محافظة بالمعنى الأشدّ
تزمتاً في الثقافة السياسية والاجتماعية والأخلاقية الأمريكية، لكنها
أيضاً تنتمي إلى المجموعات المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد
ترامب، المؤمنة بأنّ الانتخابات الرئاسية الأخيرة سُرقت منه، والمتحمسة
لترشحه وعودته مجدداً إلى البيت الأبيض.
طريف إلى هذا أنّ ترامب هو اليوم رافع راية «صيد السَحَرة»، واستهدافه
من جانب الديمقراطيين واليسار في القضاء الأمريكي على خلفية شراء سكوت
الممثلة الإباحية التي جمعته بها علاقة حميمة قبل أن يقتحم ميدان
السياسة ويتصدّر مرشحي الحزب الجمهوري لانتخابات 2016. وأمّا وجه
الطرافة فهو أنّ التعبير إنما يحيل إلى الكاتب المسرحي الأمريكي الكبير
آرثر ميللر (1915-2005)، الذي كان ضحية الرقابة على مسرحيته الشهيرة
«المحنة»، والتي تدور حول المحاكمات الشهيرة لساحرات بلدة سالم
الأمريكية، أواخر القرن السابع عشر. إلا أنّ خلفية النصّ كانت تشير إلى
أمريكا القرن العشرين، وصيد السحرة الذي مارسته «لجنة النشاطات
المعادية لأمريكا»، التي دشّنت فجر الـ»مكارثية» بوصفها أسوأ استبداد
ثقافي وفكري عرفته الولايات المتحدة على امتداد تاريخها. ففي عام 1947
أُضيف ميللر إلى لائحة تضمّ 320 من العاملين في مختلف أعمال المسرح
والسينما والغناء والأوبرا وسواها من الفنون، مُنعوا من العمل بقرار من
اللجنة تلك.
وإلى جانب ميللر توفّرت أسماء عدد كبير من خيرة كتّاب وفنّاني الولايات
المتحدة آنذاك: ريشارد رايت، جوزيف لوزي، بول روبسون، داشيل هاميت،
كليفورد أوديتس، لويس أنترمير، وسواهم. وذنب هؤلاء كان مزدوجاً: أنهم
ينتمون بهذا الشكل أو ذاك إلى تيّارات اليسار، ويُشتبه تالياً
بانتمائهم إلى الحزب الشيوعي؛ وأنهم رفضوا ممارسة الدسيسة على زملائهم،
والإدلاء بمعلومات عنهم إلى اللجنة. وفي كتاب السيرة الذاتية الذي
أصدره سنة 1987 بعنوان «على مرّ الأيام: حياة»، يروي ميللر تفاصيل
مثيرة عن تلك الحقبة، لعلّ أشدّها تأثيراً في النفس ليس صموده هو
شخصياً أمام اللجنة، بل انهيار صديقه المخرج المسرحي والسينمائي الشهير
إيليا كازان.
وقد يعجب امرؤ من أنّ أمريكا هذه، ذاتها التي لا تمارس أيّ طراز ملموس
من الرقابة على اقتناء الأسلحة النارية، أو إنتاج مختلف بضائع البورنو
المقروءة والمرئية والمصنّعة والترويج لها، تتحفز جمعيات نافذة فيها
ضدّ معجم عربي ــ إنكليزي أو آخر إنكليزي – إنكليزي داخل سجن، أو تتجند
لسحب روايات إرنست همنغواي، «لمَنْ يقرع الجرس»؛ أو مرغريت ميتشل، «ذهب
مع الريح»؛ أو جون شتاينبك، «أعناب الغضب»؛ أو ف. سكوت فتزجيرالد،
«غاتسبي العظيم»…
والأرجح أنّ العجب لن يطول، إذا كان المطالِب بمنع هذه الأعمال، هو
نفسه المؤمن بأنّ ترامب ضحية صيد السَحَرة؛ سواء بسواء!
ديمقراطية الامتناع/ احتلال الشارع:
مأزق فرنسا المعاصرة
صبحي حديدي
هنالك الكثير الجوانب المطلبية، المشروعة بقدر ما هي إشكالية في قليل
أو كثير، تكتنف حركات الاحتجاج المتواصلة منذ أسابيع ضدّ تشريعات إصلاح
أنظمة التقاعد في فرنسا، والتي باتت تُختصر في معادلة تمرير القانون
الناظم لتلك الإصلاحات أو سحبه على نحو جذري غير جزئي أو تلطيفي. كذلك
بات جلياً أنّ جولات الحراك المتعاقبة تحولت إلى صراع تناطحي بين
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومة إليزابيث بورن من جهة أولى،
ونقابات العمال والمستخدمين على اختلاف توجهاتها الإيديولوجية والطبقية
من جهة ثانية؛ ضمن منطق أقرب إلى حرب مفتوحة مطوّلة، لن تتكفل معركة
واحدة بحسمها، حتى إذا بقيت قواعد الاشتباك في جبهاتها مستقرة ومتفقاً
عليه.
ثمة، في المقابل، أسئلة تتجاوز الجوانب المطلبية إلى أخرى ذات طابع
مختلف أكثر تعقيداً، وأقلّ جلاء أمام الجمهور العريض من حيث الاشتغال
والأثر على الأقلّ، يمكن أن تبدأ من العمارة السوسيولوجية للحركات
الاحتجاجية، وقد يصحّ ألا تنتهي عند الثقافة السياسية المعيارية في
فرنسا الراهنة، فضلاً عن الجوهري بين هذه الأسئلة أو تلك: أين
الديمقراطية الفرنسية، كنظام وبنية ومؤسسات، من هذا الحراك الاجتماعي
والسياسي والنقابي والحقوقي والدستوري؟ وإذا كان ماكرون قد نصّ في
برنامجه الانتخابي على إقرار هذه الإصلاحات، وقد انتُخب بالفعل
استناداً إليها، فكيف يُلام إذا اختار الوفاء بوعوده وذهب إلى التنفيذ؟
وأيضاً، كيف يُقرأ تصريحه الاستفزازي بأنّ «الحشد لا يملك شرعية في وجه
الشعب الذي عبّر عن نفسه من خلال ممثّليه المنتخبين».
ولعلّ السؤال الأكثر اشتمالاً على المعضلة، أو تشكيل المأزق في واقع
الأمر، تختصره هذه المعادلة البسيطة، هائلة الدلالات في المقابل: 6 من
أصل كلّ 10 فرنسيين صاروا من فئة الممتنعين عن التصويت في غالبية
الانتخابات البلدية والمناطقية والتشريعية والرئاسية، فبأيّ معنى يمكن
الحديث عن تمثيل شعبي في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) لا يتجاوز
ثلث سكان فرنسا؟ واستطراداً، أيّ فارق في أن يصوّت مجلس الشيوخ (غير
المنتخَب) على مشاريع إصلاح التقاعد، وتلجأ الحكومة إلى المادة 3ـ49 من
الدستور لتمرير المشاريع إياها رغماً عن المجلس المنتخَب، ومن دون
تصويته؟
السؤال التالي، المتفرّع منطقياً وسياقياً عن الأسئلة أعلاه، يخصّ
شخصية الرئيس الفرنسي ماكرون، صانع تشريعات التقاعد وموضوع سخط الشارع
الغاضب؛ الذي لم يكن، مع ذلك، إلا خيار شرائح واسعة من الساخطين اليوم
حين توجهوا إلى صناديق الاقتراع لانتخابه رئيساً، مرّتين، لقطع الطريق
على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين. هذه المفارقة، وهي واحدة ضمن
سلسلة متماثلة تارة أو متناقضة تارة أخرى، كانت تتوّج بصمة ماكرون
الأهمّ في الحياة السياسية الفرنسية المعاصرة خصوصاً، وتقاليد قرابة
نصف قرن من الجمهورية الخامسة عموماً: أنّه نجح في تحييد اليسار
(التقليدي على الأقلّ، وفي طليعته الحزب الاشتراكي والخضر) أسوة
باليمين (التقليدي بدوره، إرث شارل دوغول ثمّ فيليب سيغان/ جاك شيراك،
ونيكولا ساركوزي)؛ ولكنه اقتفى، جوهرياً، مسارات يمين ليبرالي سياسي
واقتصادي واجتماعي، أتقن لعبة تمويه التوحّش الرأسمالي في فلسفات
أخلاقية وإصلاحية غائمة.
6 من أصل كلّ 10 فرنسيين صاروا من فئة الممتنعين عن التصويت في غالبية الانتخابات البلدية والمناطقية والتشريعية والرئاسية، فبأيّ معنى يمكن الحديث عن تمثيل شعبي في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) لا يتجاوز ثلث سكان فرنسا؟
وقد يجهل الكثيرون أنّ أحد أبرز مشاهير الفلسفة في عالمنا المعاصر،
يورغن هابرماس، الألماني مع ذلك، كان أيضاً أحد أبكر المرحبين بانتخاب
ماكرون للدورة الرئاسية الأولى سنة 2017؛ حيث سار بعض التهليل هكذا:
«يندر أنّ صعوداً غير متوقَّع مثل هذه الشخصية الفاتنة، الاستثنائية في
كلّ حال، شهد بهذه الدرجة على حالات التاريخ الطارئة. ماكرون يمتلك
ثلاث خصال خارجة عن الإطار المعتاد: شجاعته في صياغة السياسة، ثمّ وعيه
الدقيق بالحاجة إلى إصلاح المشروع الأوروبي الذي تولّته النُخب حتى
الساعة وينقله ماكرون اليوم إلى المواطنين اتكاءً على الشرعية
الديمقراطية الذاتية للمواطنين، وأخيراً حقيقة أنه يؤمن بثقل الكلمات،
قوّة الإفصاح عن التأمل، وتدبُّر الإقناع».
إطناب من عيار ثقيل، غنيّ عن القول، سوف يتصادى مع تيار آخر فرنسي هذه
المرّة، «اكتشف» أنّ ماكرون تلميذ نجيب لفيلسوف الإنسانيات الفرنسي بول
ريكور (1913-2005)؛ صاحب أعمال تأسيسية مثل ثلاثية «فلسفة الإرادة»
و«التاريخ والحقيقة» و«الذات بوصفها آخر». ولم نعدم كاتباً فرنسياً،
فرنسوا دوس، أصدر في مطلع رئاسة ماكرون الأولى كتاباً بعنوان «الفيلسوف
والرئيس: ريكور وماكرون»؛ ساجل فيه بأنّ برامج الأخير تتناغم مع فلسفة
الأوّل في جوانب أخلاقية عديدة، وتأويل أشغال التاريخ، واستكمال واجبات
الذاكرة، والالتزام بطراز من العلمانية مفتوح على حسن النوايا
والاستضافة وتفعيل النظام الديمقراطي، وسوى ذلك. ليس مدهشاً أنّ المؤلف
ذاته عاد وأصدر كتاباً ثانياً عنوانه «ماكرون أو الأوهام الضائعة ـ
دموع بول ريكور» يستخلص فيه (ولكن دون أن يتراجع عن خلاصات كتابه
الأوّل!) أنّ الفيلسوف يدمع حزناً على ما آل إليه الرئيس.
وبين مفاعيل هذَين الاستقطابين، خلف حراك الشارع الشعبي اليوم ضدّ
تشريعات التقاعد، يتعاظم مأزق ديمقراطية قوامها حشود تمتنع عن التصويت
بمعدّل 6 من كلّ عشرة مواطنين، مقابل سلطة تنفيذية يترأسها ليبرالي
عتيد أحال اليسار واليمين إلى الصفوف الخلفية. ثمة استقطاب ثالث يخصّ
الحاضر الفرنسي تحديداً، ضمن منظور الخروج إلى الشارع كوسيلة كبرى
للاحتجاج والسعي إلى التغيير، وفي إطار نقاش كهذا يصعب على المرء إغفال
ظاهرة السترات الصفراء التي عمّت فرنسا قبل خمس سنوات، من زوايا عديدة
لعل الأكثر التصاقاً منها بسياقات الراهن هي حكاية التأويل: أهي حركة
أنذرت بولادة «ائتلاف الريف والمدينة» أو «صحوة الطبقة العاملة» أو
«انتفاضة الطبقة الوسطى»؛ أم هي، على الضفة الموازية، كسر لمعادلة
ماكرون في تحييد اليمين واليسار، أو مطالبة بطيّ صفحة الجمهورية
الخامسة، أو تسجيل عودة الإيديولوجيا؟ الأوضح مع ذلك، والأشدّ واقعية
وصواباً، كان الإقرار بأنّ الحركة وليدة حزمة الضرائب ذاتها التي وعد
بها المرشح الرئاسي ماكرون في برنامجه الانتخابي؛ بل كانت أقرب إلى
«بصمة» شخصية» تحدّد مسارات رئاسته.
وكان فيلسوف آخر غير هابرماس، هو عالم الاجتماع والمفكر الفرنسي بيير
بورديو (1930 ـ 2002) أحد آخر الكبار المحترمين الذين كرّسوا الكثير من
الجهد المعمّق المنتظم والمنهجي لدراسة ظواهر السياسة اليومية في فرنسا
المعاصرة. ولقد ظلّ بورديو شديد القلق إزاء شبكة العلاقات المعقدة بين
رأس المال المعاصر والخطاب السياسي الشعبوي، أو حتى الشعبوي، وكان بالغ
الحصانة ضدّ إغواء الألعاب النظرية ما بعد الحداثية التي تطمس التاريخ
كشرط أوّل لافتتاح اللعب. ولم يكن غريباً بالتالي أن بورديو، صحبة نفر
قليل من ممثلي هذه الأقلية، شارك في اجتماع شهير مع القيادات النقابية
الفرنسية لاتخاذ قرار الإضراب الشامل الواسع الذي شلّ مختلف قطاعات
الحياة اليومية الفرنسية أواخر العام 1995. ولم يكن غريباً، أيضاً، أنه
آنذاك وضع إصبعه على الغور العميق للجرح الحقيقي، أي اغتراب المجتمع
الفرنسي بين خيارين أحلاهما مرّ، بل شديد المرارة: الليبرالية الهوجاء
التي تخبط في الإصلاح خبط عشواء، والبربرية الوقحة لنفر من التكنوقراط
يرون أنهم يعرفون الدرب إلى سعادة الأمّة أكثر من الأمّة نفسها.
وتلك وجهة أخرى لتشخيص الداء الراهن لديمقراطية فرنسية ترسل إلى الشارع
ملايين الرافضين، ولكنها لا تلاقي صندوق الاقتراع إلا بنسبة الثلث التي
تسفر عن صعود أمثال ماكرون، وسنّ التشريعات طبقاً للمادة 3ـ49. وللحشود
أن تعترض، ما شاء لها السخط…
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
شهر رمضان: من مآزق
العيش إلى بورصة التأجيج
صبحي حديدي
في لبنان، حيث مآزق العيش اليومي وأزمات الوجود البسيط المستعصية، من
ندرة حليب الأطفال إلى التلاعب بأدوية الضرورات الماسة، فانقطاع الماء
والكهرباء والوقود؛ لا يُستثنى شهر رمضان من انتهاك سلطات النهب
والفساد والتسلط والمحاصصة الطائفية، فيتحوّل الشهر الفضيل إلى مادة
إلهاء عن الجوهري، وإشعال لمعارك طائفية ومذهبية.
وهكذا اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه البري، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال
نجيب ميقاتي، وتوافقا على تأخير العمل بالتوقيت الصيفي المعتاد، على
سبيل التخفيف من أعباء الصائمين كما قيل؛ الأمر الذي سارع بعض أقطاب
نهب البلد وإقعاده وتخريبه وتجويعه وتفليسه، ولكن من الجانب الأخر
للتقاسم الطائفي، إلى رفع العقيرة احتجاجاً على تدبير «مسلم» يُلحق
الضرر بمصالح مواطن «مسيحي»!.
وإلى جانب أقصى الحماقة، عن سابق قصد وتصميم، في قرار لا يمتّ بصلة إلى
شروق الشمس ومغيبها (وهو معيار توقيتات الإمساك والإفطار)، فإنّ
التسجيل المسرّب للقاء «رأس» السلطة التشريعية بنظيره في السلطة
التنفيذية لا يبدو صنيعة الصدفة أو إهمال هذا الهاتف المحمول المسجِّل
أو ذاك؛ بقدر ما يثبت السيناريو بأسره، من التسريب إلى الاستنكار، أنّ
«بنك» استغفال العقول لدى أمثال برّي وميقاتي، ثمّ جبران باسيل على
الضفة الموازية، لا حدود له من جهة أولى، كما أنه في الآن ذاته مصاب
بإفلاس فاضح في الطرائق والتقنيات.
طراز آخر من بورصة استغلال شهر الصيام للإيحاء بما قد يبدو في الظاهر
نزاعاً مذهبياً بين السنّة والشيعة، ولكنه في العمق أو تحت قشرة السطح
مباشرة ليس أكثر من وجهة أخرى مماثلة لإجراء برّي/ ميقاتي؛ هو حكاية
الإعلان عن عرض مسلسل «معاوية»، ثمّ تراجع الشركة المنتجة عن بثّه بسبب
الجدل حول ما قد يثيره من «نعرات طائفية». وإذْ تبارى ساسة ورجال دين،
أو ذلك الطراز المشترك في صفوفهم كما يعكسه الزعيم العراقي الشيعي
مقتدى الصدر مثلاً، في إطلاق التصريحات المحذّرة من عواقب عرض المسلسل؛
بادرت قناة «الشعائر» العراقية ذات التوجّه الشيعي إلى اتخاذ ردّ عملي
صدامي، فأعلنت إنتاج شريط سينمائي يمتدح شخصية أبي لؤلؤة المجوسي، قاتل
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.
وحتى الساعة، أو إلى أن يثبت العكس عند إشعار آخر، انتهج الفريقان جانب
التهدئة (ما دام المرء في قلب خطابات الحرب والاقتتال!)، وكأنّ عشرات
المؤلفات، أو المئات منها، لم تفصّل القول في شخصيتَي معاوية أو أبي
لؤلؤة، ثمّ الإمام عليّ ومعركة صفين في الخلفية الأعرض والأهمّ
والأخطر، أو موقعة الجمل قبلها؛ سواء لجهة التشديد على الرواية
السنّية، أو نقضها في قليل أو كثير لصالح إعلاء الرواية الشيعية.
طراز ثالث من استغلال شهر رمضان تولاه رئيس النظام المصري عبد الفتاح
السيسي، الذي تناسى أزمات معيش المصريين وحال العملة الوطنية واستجداء
صندوق النقد الدولي والتسوّل لدى هذه وتلك من دول الخليج الداعمة
لنظامه؛ واختار أن يفتتح مسجداً في أرجاء ما يسمّيه «العاصمة الإدارية
الجديدة»، بكلفة تجاوزت 800 مليون جنيه، رغم أنّ المنطقة ذاتها تضمّ
مسجداً ثانياً يُعدّ أحد أكبر مساجد العالم. ولم يكن خافياً عن
المصريين مغزى الترويج السياسي خلف اختيار شهر الصيام لافتتاح المسجد
الثاني، ثمّ دلالة أن تتولى البناء شركة مقاولة تشرف عليها الهيئة
الهندسية للقوات المسلحة.
وكان البعض يبدي الأسف لأنّ شهر العبادة والتضامن والتسامي الروحي
والجسدي انقلب إلى موسم للإفراط في الأطعمة والإدمان على المسلسلات؛
وجاءت اليوم أحقاب من انتهاك الشهر الفضيل، على أصعدة شتى من الاستغلال
والإلهاء والإفساد. وليست هذه التحولات غريبة عن أساليب اشتغال
الغالبية الساحقة من الأنظمة العربية، حيث تستعين طرائقُ الاستبداد
والفساد بكلّ ما يمكن أن يخدّر العقل ويستلب الروح.
مصرف «سيليكون فالي»
والتاريخ الذي لا ينتهي
صبحي حديدي
مَن اعتقد أنّ انهيار مصرف «سيليكون فالي» واقعة منطوية على المفاجأة
الأدهى في العصر الراهن من أنظمة الصيرفة الرأسمالية، فقد جانب الصواب
في الاعتقاد؛ على غرار ذاك الذي يظنّ أنها معزولة أو منفصلة عن سياقات
أعرض، أو حتى عابرة سوف يفلح الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أو أجهزة
إدارة جو بايدن المالية ومؤسسات وول ستريت، في تطويق تبعاتها. هما في
ذات الظنّ الخاطئ الذي يدفع أنصار الرأسمالية المعاصرة إلى التأكيد/
الطمأنة بأنّ فصول مسرح الإفلاس هذا («سيلفرغيت» و«سغنيشر» بعد
«سيليكون فالي») مقتصرة على الأسواق الأمريكية وبورصاتها.
في المثال، الذي يصحّ أن يتوارد سريعاً إلى الذهن، ذلك المشهد الذي
تابعته اليابان ذات يوم غير بعيد؛ حين أطلّ المدير التنفيذي لشركة
«يامايشي» للسندات والأسهم والمضاربات على شاشات التلفزة، فانخرط في
بكاء متقطع مرير، وانحنى على النحو الشعائري الياباني وهو يعلن الإفلاس
الوشيك للشركة. واكتملت الدراما القصوى حين توقفت الكومبيوترات، وتجمدت
المعاملات المالية، وأُطفئت الأضواء في ناطحة السحاب حيث مقرّ الشركة.
نهاية حزينة لا ريب، وكان المشهد، المسرحي بامتياز، جديراً بأكثر
تراجيديات وليام شكسبير توتراً ومأساة؛ مع فارق حاسم هو أنّ المشهد كان
واقعياً 100٪.
تلك كانت الشركة التي تحتلّ المرتبة الرابعة في لائحة كبريات بيوتات
السندات المالية الخاصة في اليابان، وعراقتها تعود إلى عام 1897، ولها
فروع في 31 عاصمة رأسمالية، بكادر من المستخدمين يتجاوز السبعة آلاف
موظف. ذلك كله لم يحصّنها ضدّ سلسلة من الفضائح المالية، وسلسلة ثانية
من تقلبات أسعار الأسهم، وسلسلة ثالثة من صعوبات تأمين التمويل، الأمر
الذي أفضى إلى خسارة صافية مقدارها 52 مليار دولار أمريكي، وإلى إعلان
الإفلاس والإغلاق.
أوّل الدروس وراء ذلك الانهيار الدراماتيكي للشركة اليابانية هو أنّ
العمالقة قد يجدون أنفسهم بغتة في عراء مطلق، بلا سند أو كفيل أو ضامن،
قاب قوس واحد من الهاوية. البنوك المركزية في أوروبا وضعت يدها على
قلبها، وأبدت مشاعر «التعاطف» ثم التزمت الصمت. الشركاء الأمريكيون
ضنّوا حتى بمشاعر التعاطف. وبنك «فوجي» الذي رعى مصالح الشركة المفلسة
منذ عقود وربح على ظهرها ومعها مئات الملايين، نفض يده في نهاية الأمر
وأعلن مسؤولوه أنهم لا يستطيعون القيام بأيّ شيء لإنقاذ الموقف.
ثاني الدروس أنّ التشدّق الليبرالي حول ضرورة توطيد الاستقلالية
المطلقة للمؤسسة الخاصة مقابل الدولة والإدارة المركزية، تلقى لطمة
قاسية، لأنّ الجهة الوحيدة التي كانت قادرة على انتشال «يامايشي» من
الهاوية هي وزارة المالية اليابانية؛ تماماً كما اتضح أنها الحال اليوم
مع مصرف «سيليكون فالي» وقريناته المنهارات. وهنا أيضاً، في المثالين
الياباني والأمريكي، اتضحت محدودية هذا الدور لأنّ الخزينة العامة ليست
مضخة مليارات لا تنضب؛ بدليل عجز الحكومة اليابانية عن إنقاذ بنك
«تاكوشوكو» وشركة سندات «سانيو» من إفلاس مماثل وقع خلال الفترة ذاتها؛
وتنصّل المصرف المركزي الأمريكي، اليوم، من مهمة إنقاذ المصارف المفلسة
لقاء ضرورات رفع أسعار الفوائد ومجابهة التضخم.
ظنّ خاطئ يمكن أن يدفع أنصار الرأسمالية المعاصرة إلى التأكيد/ الطمأنة بأنّ فصول مسرح الإفلاس هذا («سيلفرغيت» و«سغنيشر» بعد «سيليكون فالي») مقتصرة على الأسواق الأمريكية وبورصاتها
وأما ثالث الدروس فهو مفارقة مزدوجة وخارج حدود اليابان، إذْ كانت
فانكوفر الكندية تشهد انعقاد مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول آسيا
والباسيفيكي (أبيك)؛ وفي الآن ذاته، أصدر صندوق النقد الدولي وثيقة
جديدة حول برنامج التعديل الهيكلي، أي «وصفة» الإصلاحات الإلزامية التي
يفرضها الصندوق على الدول النامية كشرط مسبق للإقراض والإعانة، والتي
تحثّ على منح المزيد من الاستقلال للشركات الخاصة، والمزيد من إقصاء
الدولة بعيداً عن الحياة الاقتصادية!
العالم تابع ردود أفعال غريغ بيكر، المدير التنفيذي لشركة «سيليكون
فالي» الأمّ، فلم يتضح أنه ذرف دمعة واحدة على انهيار مصرفه، بل فعل ما
لم يكن سيخطر على بال المدير الياباني لشركة «يامايشي»: لقد استبق
الانهيار، منذ 27 شباط (فبراير) الماضي، فباع من أسهمه الشخصية ما درّ
عليه 3,6 مليون دولار أمريكي من الأرباح الصافية. وقبل سنوات، حين أوصى
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفع قيود التدقيق على المصارف،
أنفق بيكر ما يعادل نصف مليون دولار لشراء الذمم في الكونغرس وتسهيل
تمرير التشريعات التي تجعل المصارف حرّة طليقة. وإذا كان المعمار
الأخلاقي في قلب الثقافة الرأسمالية اليابانية قد أتاح انهمار دموع
المدير التنفيذي لشركة «يامايشي» فإنّ المعمار الأخلاقي النظير في
الثقافة الرأسمالية الأمريكية لم يُعفِ غريغ من تلك الانحناءة
الشكسبيرية فحسب، بل أعطاه الحقّ في أن يدير ظهره ويغادر المسرح وكأنّ
شيئاً لم يكن… ولعلّ براءة الأطفال داعبت عينيه أيضاً!
وكان فريدريك إنجلز، شريك كارل ماركس في رصد ملامح الشبح الشيوعي الذي
أخذ يحوم في سماء أوروبا وأرضها منذ أواسط القرن التاسع عشر، قد أطلق
عبارة نبوئية مدهشة وثمينة في آخر أيام حياته: «ثمة غرابة خاصة في
أطوار البرجوازية، تميّزها عن جميع الطبقات الحاكمة السابقة، هي أنها
تبلغ منعطفاً حاسماً في صعودها وتطوّرها تصبح فيه كلّ زيادة في وسائل
جبروتها، أيّ كلّ زيادة في رأسمالها أساساً، بمثابة عنصر جديد إضافي
يساهم في جعلها أشد عجزاً عن الحكم بالمعنى السياسي». وبصرف النظر عن
درجة الصلاحية العامة في تشخيص صدر قبل قرن ونيف (توفي الرجل عام 1895)
فإنّ المجموعات الحاكمة في المجتمعات الرأسمالية الغربية المعاصرة تبدي
الكثير من هذا الميل؛ فكيف الحال في مجتمعات الاهتداء الهستيري العجول
إلى فضائل الرأسمالية العتيقة وآلامها وآمالها.
وكان الأمريكي فرنسيس فوكوياما قد أعلن نهاية التاريخ وانتصار
الليبرالية السياسية والاقتصادية في معركة ختامية لن تقوم بعدها قائمة
لأية إيديولوجية منافسة. بعد خمس سنوات أصدر كتابه الثاني الذي يبشّر
بنهاية الاقتصاد الوطني وولادة التعميم العالمي لاقتصاد كوني واحد
عماده «الثقة» تدور من حوله أفلاك اقتصادية أصغر أو هي ليست بالاقتصاد
إلا لعدم توفّر مصطلح بديل يصف طبيعتها. ولكنّ فوكوياما، في الكتاب
الأوّل كما في الثاني، كان قد أساء قراءة هوية «الرجل الأخير» أو
الرأسمالي خاتم البشر، الذي سيرث الأرض بعد طيّ صفحة الحرب الباردة.
الأشباح التي أخذت تجوس من جديد ليست بالتأكيد في عداد ذلك الرجل، فكيف
إذا تسارعت الانهيارات في قلب الولايات المتحدة، وتعاقب انهيار المصارف
التي تستقبل ودائع «الرجل الأخير» إياه!
انقضت، اليوم، 34 سنة على مقالة فوكوياما التي ساجلت بأنّ التاريخ لعبة
كراسٍ موسيقية بين الإيديولوجيات (عصر الأنوار، الرأسمالية،
الليبرالية، الشيوعية، الإسلام، القِيَم الآسيوية، ما بعد الحداثة…)؛
وقد انتهى التاريخ وانتهت اللعبة، لأنّ الموسيقى توقفت تماماً (سقوط
جدار برلين، وانتهاء الحرب الباردة) أو لأنّ الموسيقى الوحيدة التي
تُعزف الآن هي تلك الخاصة بالرأسمالية والليبرالية واقتصاد السوق. ليس
في استعارة لعبة الكراسي الموسيقية أيّ إجحاف بحقّ أطروحة فوكوياما، بل
لعلها أفضل تلخيص للتمثيلات الكاريكاتورية التي وضعها الرجل لعلاقة
البشر بالتواريخ، ولتأثير البنية الفوقية (الإيديولوجيا والنظام
الفكري) على البنية التحتية (الاقتصاد والنظام الاجتماعي) وعلى «ولادة
إنسان لا حاجة له بالتاريخ لأنه ببساطة خاتم البشر»!
أم لعله في حاجة ماسّة إلى ودائعه المضيّعة في خزائن نهاية التاريخ،
خاصة إذا افتقر إلى ما يملكه غريغ بيكر من «بصيرة» تجعله يتنقل بين
الكراسي الموسيقية فلا يسحب ودائعه في التوقيت القاتل فحسب؛ بل يتكسب
من سحبها، أيضاً وأيضاً!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
من عبيد جيفرسون إلى قصاص ترامب:
أسفار أمريكا المحافظة
صبحي حديدي
يزعم أقطاب التيارات المحافظة، في السياسة والاقتصاد كما في الاجتماع
والثقافة، أن «مؤتمر العمل السياسي للمحافظين» أو الـ
CPAC
في مختصراته الإنكليزية، هو ذروة ملتقيات المحافظين على نطاق العالم،
ليس لأنه يُعقد في الولايات المتحدة، إحدى أعرق قلاع الفكر المحافظ،
وعمره تجاوز الخمسين سنة، فحسب؛ بل كذلك، أو أساساً، لأنه المحفل الذي
يخرّج رؤساء الولايات المتحدة الأشدّ تمسكاً بمبادئ الفلسفة المحافظة
والأحرص على تحويلها إلى عقائد، على طراز ما خلّف توماس جيفرسون
ورونالد ريغان ودونالد ترامب. وعلى امتداد الشطر المحافظ من التاريخ
الأمريكي، توفّر رجل مثل جيفرسون ترأس في الفترة بين 1801 إلى 1809،
وكان أحد ملاّك العبيد ومبرّري الاستعباد؛ وأمّا أشهرهم، أبرهام لنكولن
(لنكن) فهو محرّر العبيد الذي كان، مع ذلك، صاحب التصريح الشهير
العاصف: «إذا كنتُ لا أريد لامرأة سوداء أن تكون عبدة، فهل هذا يعني
أنني أريدها زوجة».
ورغم أنّ المؤتمر الأخير للـ
CPAC،
الذي عُقد قبل أيام في إحدى ضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن لم يسجّل
إقبالاً ملحوظاً بالمقارنة مع دورات سابقة، فإنّ ظلّ الرئيس الأمريكي
السابق ترامب كان هو الأطول، تماماً كما كان لسانه خلال خطبة حفلت
بالهجاء على اليسار والوسط واليمين؛ وبالتالي لم يخرج المؤتمر عن سنن
سابقة ترسخت في أوساط المحافظين منذ صعود نجم ترامب قبل ثماني سنوات،
داخل صفوف الحزب الجمهوري خصوصاً وجماعات المحافظين عموماً. وخلال
التصويت المعتاد على مرشح المحافظين الأفضل لرئاسة الولايات المتحدة،
وهو إجراء طقسي لكنه لا يخلو من دلالات بعيدة الأثر، حلّ ترامب في
المرتبة الأولى بمعدّل 62٪، بينما جاء حاكم فلوريدا رون ديسانتيس
(منافس ترامب المرجح) في المرتبة الثانية بنسبة 20٪ رغم غيابه عن
المؤتمر؛ أسوة بشخصيات كبرى في الحزب الجمهوري أمثال نائب الرئيس
السابق مايك بنس، وزعيم الأقلية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل،
ورئيس لجنة الحزب الجمهوري الوطنية رونان ماكدانيل.
فإذا تمسك محافظو العالم بما اعتادوا عليه من فخار بمؤتمرهم هذا، فلعلّ
من حسن السلوك أن يراجعوا خطبة ترامب خلال دورة واشنطن الأخيرة؛ خاصة
شتائمه ضدّ حزبه، الحزب الجمهوري ذاته، هذا الذي «يديره وحوش ومحافظون
جدد ومدافعون عن العولمة وأنصار متعصبون إلى حدود مفتوحة وأغبياء».
وعليهم، كذلك، أن يتنبهوا إلى ما قالته نيكي هيلي، مندوبة واشنطن
الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة ترامب والمرأة المخلصة
المقرّبة منه؛ من أنّ «قضيتنا على حقّ ولكننا فشلنا في كسب ثقة غالبية
الأمريكيين» وغمزها من قناة رئيسها السابق نفسه بالقول: «إذا تعبتم من
الخسران، ضعوا ثقتكم في جيل جديد». ومن مصلحة المتفاخرين أنفسهم أن
يصغوا إلى خطبة مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق في إدارة ترامب وظلّ
سيّده التابع، حين يغمز بدوره هكذا: «لا يمكن أن نتبع الزعماء المشاهير
بما يشيعونه من سياسات هوية، وما يحملون من أنا ذاتية هشّة ترفض
الإقرار بالواقع الفعلي».
هذه الأمّة الأمريكية تحمل التوراة بيد والدستور بيد أخرى، وحين تطبّق حرفياً موادّ القانون الذي وضعه البشر (الدستور) فإنها إنما تفعل ذلك ضمن حال من الخضوع المذهل للنصّ الذي وضعه الربّ (التوراة) وللتأويل الميتافيزيقي لمعظم الظواهر الدنيوية
إحدى الخلاصات الضمنية في خُطَب ترامب وهيلي وبومبيو، وغالبية الخطباء
في مؤتمر واشنطن، يمكن بالفعل أن تقود المرء إلى ترجيح الأفول المضطرّد
لذلك التيار الذي حمل اسم «المحافظين الجدد» في الولايات المتحدة خلال
عهد جورج بوش الابن؛ والذي بنى، أصلاً، على أصحاب «مشروع قرن أمريكي
جديد» من أمثال بول ولفوفيتز وريشارد بيرل خصوصاً. والتيارات المحافظة
الراهنة في الولايات المتحدة هي، استطراداً، أشبه بأنفار نافخة لأبواق
تفخيم ترامب إلى درجة عبادة الفرد أحياناً، وإلى رفع الشعار الأخرق حول
جعل أمريكا عظيمة مجدداً، وكأنها كانت كذلك في أيّ يوم من تاريخها غير
المديد في كلّ حال. ذاك، في المقابل، مسار لا يطمس حقيقة تيارات أخرى
محافظة، أو «جديدة» هنا وهناك في أوروبا؛ على شاكلة رهط «الفلاسفة
الجدد» ألان فنكلكراوت وأندريه غلوكسمان وبرنار ـ هنري ليفي في فرنسا.
والحال أنّ هبوط أسهم «المحافظين الجدد» الذين باتوا قدماء متقادمين في
الواقع؛ يتوازى مع علوّ مكانة المحافظين نافخي الأبواق من خلف ترامب،
في جلسات الـ
CPAC
خصوصاً؛ والوقوف على أسباب كلا الظاهرتين ليس بالأمر العجيب، مثله مثل
صعود نظريات التفوّق الأبيض والعقائد المسيحية الأصولية. جملة من
الأسئلة تظلّ، مع ذلك، ملحّة وجديرة بالنقاش: كيف يمكن لهذه الأمّة
الأمريكية، أو لغالبية غير ضئيلة فيها، أن تكون قوّة كونية عظمى أولى،
ديمقراطية دستورية وعصرية مصنّعة ومتقدّمة، وفي الآن ذاته محافظة
قَدَرية سلفية متديّنة؟ واستطراداً، أهو تراث جيفرسون وترامب وريغان
الذي يسود اليوم، ويوحي بالسيادة في المستقبل أيضاً؛ بما ينطوي عليه،
أيضاً، من صياغات لنكولن التي تريد تحرير امرأة سوداء وتأبى عليها أن
تكون زوجة لرجل أبيض؟
وهذه السطور خفّفت، في كثير أو قليل، من الاعتماد على علوم النفس أو
الاجتماع أو السياسة والاقتصاد والتاريخ بحثاً عن مسوّغات هذا الانشطار
بين أقصيَي الحداثة والسلفية في الذهنية المحافظة الأمريكية، على وجه
الخصوص. ولعلّ بعض أفضل البدائل، في ناظر هذه السطور دائماً، هو اللجوء
إلى أنثروبولوجي أمريكي بارز وبارع وغير تقليدي، هو فنسنت كرابانزانو؛
وتحديداً إلى كتابه الممتاز «خدمة الكلمة: النزعة الحرفية في أمريكا،
من منبر الوعظ إلى منصّة القضاء». ومقام كرابانزانو الرفيع في ميدان
الدراسات الأنثروبولوجية يجعل المرء يقرأ، بثقة راسخة، خلاصاته عن
طرائق ومؤسسات وعواقب التأويل الديني لموادّ الدستور الأمريكي. هذا رجل
سبق له أن أثار ضجّة في صفّ الأنثروبولوجيا البنيوية حين أصدر
«الحمادشة: دراسة في طبّ النفس الإثني في المغرب» 1973. وضجّة أخري في
مناهج التحليل الأنثروبولوجي لنظام الفصل العنصري، الأبارتيد، في كتابه
«انتظار: البيض في جنوب أفريقيا» 1985. وضجّة ثالثة في صفّ
الأنثروبولوجيا الثقافية، من خلال كتابه الاختراقي «معضلة هرميس ورغبة
هاملت: حول إبستمولوجيا التأويل» 1993.
المقولة الأساسية في «خدمة الكلمة» تسير هكذا: هذه الأمّة تحمل التوراة
بيد والدستور بيد أخرى، وحين تطبّق حرفياً موادّ القانون الذي وضعه
البشر (الدستور) فإنها إنما تفعل ذلك ضمن حال من الخضوع المذهل للنصّ
الذي وضعه الربّ (التوراة) من جهة أولى، وللتأويل الميتافيزيقي لمعظم
الظواهر الدنيوية، من جهة ثانية. وهكذا فإنّ منبر الوعظ يمكن أن يغادر
الكنيسة كي يستقرّ على منصّة القاضي في المحكمة، وليس غريباً أن يقول
أحد قضاة المحكمة العليا (أي تلك التي لا يعلو على رأيها رأي قانوني أو
تشريعي) إنّ موادّ الدستور الأمريكي هي «إلهام من الربّ». لكنّ
الأنثروبولوجيا الميدانية ليست وحدها محطّ اهتمام كرابانزانو في تنقيبه
عن الجذور الدينية الأصولية لظواهر ومظاهر نزعة التأويل الحرفي، لأنه
أيضاً يلجأ إلى التحليل اللغوي والنصّي الثاقب لعدد من الأعمال التي
تفسّر الدنيا بالدين، وتحيل موادّ الدستور الأمريكي إلى إصحاحات وأعداد
خارجة مباشرة من أسفار الكتاب المقدّس. وحين نتذكّر الأولويات الكبرى
عند أنصار ترامب، فإن هتك كرابانزانو لأستار تلك الميول الكامنة يتجاوز
النشاط الأنثربولوجي أو العلمي المحض، ليصبح استكشافات ثقافية وأخلاقية
وسياسية بالغة الحساسية.
ولم يكن عجيباً أن تطغى النبرة التبشيرية والوعظية على هذه الجملة من
خطاب ترامب أمام مؤتمر الـ
CPAC:
«في 2016 قلت: أنا صوتكم، واليوم أضيف أنا محاربكم. أنا عدلكم. وللذين
تعرضوا للظلم والخيانة: أنا قصاصكم».
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
تفجير أنبوب «نورد ستريم»:
لماذا لا يُسجن سيمور هيرش؟
صبحي حديدي
ليس جديداً أن يفجّر الصحافي الأمريكي الشهير سيمور هيرش قنبلة حقائق
مذهلة، معاكسة للتيار السائد في وسائل الإعلام الأمريكية، كاشفة عن
الوجوه الأقبح في سلوك الإدارات الأمريكية المتعاقبة؛ وسائرة،
استطراداً، على نقيض ما هو شائع أو مُشاع في يقين الرأي العام القياسي.
ولعلّ الرجل اليوم هو صحافي الاستقصاء الأعلى كعباً في الولايات
المتحدة، لأنه ضمن حصيلة عمله أبرع (في يقين هذه السطور) من أمثال بوب
وودورد وكارل برنستين، اللذين كشفا فضيحة ووترغيت الشهيرة؛ وكذلك لأنّ
أمثال البولندي ريجارد كابوشينسكي والإيطالية أوريانا فالاشي رحلوا عن
عالمنا. سجلّه الحافل يبدأ من إماطة اللثام عن مذبحة «ماي لي» التي
ارتُكبت في فييتنام بأمر من الضابط الأمريكي وليام كالي (قرابة 347
قتيلاً من المدنيين الفييتناميين)؛ ويمرّ بحقائق مجزرة الرميلة، التي
ارتكبها الجنرال الأمريكي باري ماكيفري غرب البصرة في 2/3/1991 بحقّ
«هؤلاء العراقيين الأوغاد» المنهارين المهزومين المنسحبين المتراجعين
على الأوتوستراد 8؛ ولا ينتهي عند تفاصيل الهمجية الأمريكية في سجن أبو
غريب العراقي، ثم فضح «مذكرات التعذيب» الإدارية التي كتبها أكاديميون
على سبيل تزويد الإدارة بالمسوّغات القانونية للالتفاف على اتفاقية
جنيف حول تحريم التعذيب.
كل هذا لا يعني أنّ هيرش لم ينزلق إلى هذا القدر أو ذاك من التضخيم أو
الافتعال أو حتى الاختلاق، إنْ لم يكن على سبيل خدمة آرائه السياسية
المخالفة هنا أو هناك، فعلى الأقل عملاً بمبدأ «خالِفْ تُعرف» العتيق
الذي يحثّ على تدعيم المكانة والموقع، عن طريق الظهور والتظاهر؛ ولعلّ
تحقيق هيرش، سنة 2013، بصدد استبعاد مسؤولية النظام السوري عن المجزرة
الكيميائية ضد الغوطة الشرقية، واتهام المعارضة المسلحة بتنفيذها، هو
المثال الأبرز على هذا النزوع. وفي كتابه «مذكرات محقق» الذي صدر سنة
2018 وأبان الكثير من نوازعه الذاتية في هذا أو ذاك من تحقيقاته
الاختراقية الشهيرة، يشدد هيرش مراراً على تعاون بشار الأسد مع
الاستخبارات الأمريكية من زوايا تنتهي إلى إطراء رأس النظام (وملامة
إدارة جورج بوش الابن، لأنها كافأت خدمات الأسد بإضافتها إلى «محور
الشر» الشهير)؛ كما يمتدح «تحرّق» الأسد إلى الاجتماع مع الرئيس
الأمريكي باراك أوباما، بما ينطوي عليه اللقاء من «تغيير» في علاقات
النظام السوري مع إيران و«حزب الله» وحركة «حماس». لم يكن غريباً،
قياساً على خلفيات مزاج هيرش بصدد النظام السوري، أن ينزّه جيش الأسد
عن ضربة الغوطة الكيميائية، وألا يحمل تحقيقه ذاك ما اعتاد هيرش على
حشده من وقائع وتفاصيل ومعطيات وملابسات.
ولعل تحقيقه الأخير، الذي يرقى كالعادة إلى صيغة القنبلة المدوية،
يندرج في منزلة وسيطة بين التفضيح والاختلاق؛ ليس لأن حساسيته عالية،
وقد تقود إلى مواجهة عسكرية شعواء لا تُحمد عقباها بين واشنطن وموسكو،
فحسب؛ بل كذلك لأنّ هيرش هذه المرة لا يسوق الكثير، أو حتى الحد الأدنى
الذي يكفي، من الوقائع والتفاصيل والمعطيات والملابسات التي تدعم
فرضياته، وتُنهضها على أرضيات صلبة. التهمة خطيرة، مفادها أنّ الولايات
المتحدة بالتعاون مع البحرية النرويجية هي التي خرّبت خط الغاز «نورد
ستريم» في حزيران (يونيو) السنة المنصرمة. وضمن مادة مفصلة امتدت على
أكثر من 5200 كلمة، نشرها على موقعه الشخصي (ربما لاعتذار منبره
المعتاد، مجلة «نيويوركر» عن نشر التحقيق) روى هيرش أنّ زمرة من غوّاصي
البحرية الأمريكية، وتحت غطاء مناورات الحلف الأطلسي، زرعوا متفجرات
على الخط في عمق مياه البلطيق، تولت وحدات نرويجية خاصة تفجيرها بعد
ثلاثة أشهر؛ وتوجه هيرش بأصابع الاتهام إلى ثلاثة مسؤولين في الإدارة:
مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن،
ومساعدته فكتوريا نولاند.
سؤال «لماذا يبقى هيرش مطلق السراح؟» نافل قضائياً، لأنه بالغ الحرج سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً؛ لكنه قائم، مشروع أو حتى ملحّ، إذا شاء المرء أن يضع مصداقية هيرش على محكّ ملموس، قاطع الأدلة وبيّن الوقائع
وبمعزل عن فيديو، مثير حقاً ولافت ودامغ في قليل أو كثير، يعود إلى
مطلع شباط (فبراير) 2022 ويسجّل على الهواء مباشرة تصريحاً للرئيس
الأمريكي جو بايدن، أثناء مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف
شولتز، يقول فيه بالحرف إنّ إدارته قادرة على إغلاق أو إيقاف خط «نورد
ستريم» إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا؛ ليس ثمة الكثير الذي يُعتدّ به
في تقرير هيرش، وتلك خلاصة وقائعية لا تقود هذه السطور إلى نفي أو
تأكيد سردية هيرش حول المسؤولية الأمريكية عن التفجير. الاقتصاد من
جانبه، وحرص واشنطن على خنق الموارد الروسية من الغاز المصدّر إلى
ألمانيا، مقابل ترويج الغاز الأمريكي في حال تعطيل «نورد ستريم» كلياً
أو حتى جزئياً؛ يمكن، بسهولة مبررة، أن تُساق لصالح تأكيد تقرير هيرش،
فالمليارات من الأرباح هنا تتضافر ببساطة مع المغانم الجيو ـ سياسية
غير الضئيلة. يُضاف إلى هذا ما ينقله هيرش، عن «مصدر مباشر وثيق
الاطلاع» على الملف، من أنّ خطة التفجير اختُزلت من مستوى العملية
السرية التي تستوجب إطلاع الكونغرس، إلى أخرى صُنّفت تحت بند السرّية
الاستخباراتية القصوى الخاصة بالقوات المسلحة.
الإدارة تجاهلت التقرير بالطبع، أو علّقت عليه في مستويات دنيا لم
تتجاوز المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، التي اعتبرته «من نسج
الخيال»؛ أو ناطق باسم وكالة المخابرات المركزية، رأى أنّ التقرير
«كاذب على نحو مطلق». وزارة الخارجية النروجية، من جانبها، لم تتردد في
وصم التقرير بـ«المزاعم الكاذبة» خاصة وأنّ هيرش يعيد التعاون
الاستخباراتي بين النرويج والولايات المتحدة إلى عقود حرب فييتنام حين
تولت أوسلو تزويد المخابرات الأمريكية بقوارب استُخدمت في عمليات سرية
ضدّ جيش فييتنام الشمالية؛ وهي القوارب التي حوّلها البنتاغون إلى
ذريعة للقصف المكثف والتدخل العسكري المباشر. غير أنّ التجاهل، أو
استخدام اللغة الخشبية المعتادة في التكذيب، لا يطمس تفصيلاً حاسماً
يكتنف نشر تقرير هيرش؛ يرتدي هذه المرّة طابعاً قضائياً صرفاً، قياساً
على سوابق قانونية تخصّ متهماً مثل جوليان أسانج، المدان والمحكوم
بـ175 سنة سجناً لمخالفات أقل مما ارتكبه هيرش مراراً، أو في تقريره
الأخير حول تخريب أنبوب «نورد ستريم» على وجه التحديد.
«لماذا يبقى هيرش مطلق السراح، إذن؟» هكذا يتساءل مراقبون كثر إذْ
يرصدون حقيقة كبرى ساطعة تقول إنّ هيرش يتفوق على أسانج في انتهاك
معلومات عالية السرّية، وأنه مطالَب بكشف مصادره الإخبارية التي يتوجب
أن تُحاسب قانونياً أيضاً على غرار شيلسي ماننغ التي مرّرت الأسرار إلى
أسانج وكان جزاؤها الإدانة والسجن 35 سنة. الإجابة بسيطة، كما يقترحها
الكاتب الأمريكي ستيف براون مثلاً: لأنّ إحالة هيرش إلى القضاء تعني،
أول ما تعنيه، أنه أماط اللثام عن الحقيقة؛ الأمر الذي لن يضع سوليفان
وبلينكن ونولاند وحدهم في قفص الاتهام، بل سيجر رئيسهم بايدن نفسه لأنه
بالتعريف كبيرهم الذي يعلم بالسحر أو يعلّمه. الحرج أكبر، على أصعدة
دبلوماسية وشعبية، لدى الحليفة ألمانيا بادئ ذي بدء، لأنّ تعطيل أنبوب
الغاز يُلحق الكثير من الأذى بالصناعات الألمانية؛ وهذه عاقبة وخيمة لن
تقتصر على ألمانيا، بل ستعبر الحدود إلى حليفات مثل فرنسا وبلجيكا
وإيطاليا والنمسا والدول الإسكندنافية، على مستوى الشعوب ذاتها قبل
الحكومات التي لا يُستبعد تورّطها في المخطط.
بهذا المعنى فإنّ السؤال، «لماذا يبقى هيرش مطلق السراح؟» نافل قضائياً
لأنه بالغ الحرج سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً؛ لكنه قائم، مشروع أو
حتى ملحّ، إذا شاء المرء أن يضع مصداقية هيرش على محك ملموس، قاطع
الأدلة وبيّن الوقائع.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
مرضى الحنين
إلى النيو – عثمانية
صبحي حديدي
ليس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولا «حزب العدالة والتنمية»
وكوادره وقياداته، هم وحدهم دعاة استعادة الإمبراطورية العثمانية كما
يسود اعتقاد شائع؛ تبسيطي من حيث المبدأ، ولكنه أيضاً يختزل ظاهرة
اجتماعية وثقافية وشعورية تتجاوز بكثير عناصر الحميّة الدينية أو
نوستالجيا الخلافة أو تغذية الفخار القومي. ولعلّ أفضل العلائم على
تلمّس الجوهر الفعلي لهذه الظاهرة، في تجليات مختلفة وأشدّ عمقاً
وإدهاشاً أحياناً، إنما تحيل إلى المخيّلة عبر أنماطها المختلفة، وخاصة
بالطبع في ميادين الآداب والفنون من جانب أوّل؛ ثمّ لدى شرائح علمانية
أو ليبرالية على وجه التحديد، داخل صفوف الأدباء والفنانين.
هذا هو موضوع كتاب «المتخيَّلات النيو – عثمانية في تركيا المعاصرة»،
الذي أشرفت على تحريره كاتارينا رودفير وبيتيك أونور، وصدر مؤخراً
بالإنكليزية عن منشورات بالغريف/ ماكميلان في لندن؛ وضمّ 11 مساهمة
تستكشف عشرات المظاهر ذات الصلة بحضور العثمانية الجديدة، في العمارة
والفضاء العام ووسائل الإعلام والطقوس والأعياد والمناسبات والسياسة
والذاكرة والمتاحف والنُصُب وأسماء الشوارع والساحات، فضلاً عن الشعر
والرواية والمسرح والتشكيل والسينما والموسيقى… وكلّ هذا بعيداً،
كثيراً أحياناً، عن السياسة المباشرة والصراعات الحزبية والانتماءات
العقائدية، الأمر الذي لا يثير الدهشة في مستوى أوّل، فحسب؛ بل يحثّ
على التأمل الثقافي للظاهرة وعلى الذهاب أبعد من المعطيات الجلية إلى
العمق المبطّن أو الخفي من تفاعلاتها وتأثيراتها. وإذا صحّ أنّ
«العدالة والتنمية»، والتيارات السياسية والفكرية المحافظة التركية
إجمالاً، تأتي في طليعة أنصار الظاهرة النيو – عثمانية، فإنّ خلاصة
كهذه لا تطمس إلا النزر اليسير من حقيقة الوجود الطاغي للظاهرة، في
الميادين المشار إليها آنفاً؛ كافة، في الواقع.
على سبيل المثال، ليس جديداً (إلا عند المتشبثين باختزال الظاهرة
وتبسيط مفاعيلها المتعددة) أنّ روائياً علمانياً وليبرالياً مثل أورهان
باموق (نوبل الآداب، 2006) هو في طليعة المصابين بـ»حنين النيو –
عثمانية»، رغم مواقفه المناهضة بقوّة لسياسات أردوغان وحزبه، وجسارته
في تظهير التاريخ الدامي للإمبراطورية العثمانية والممارسات
الأتاتوركية والمذابح بحقّ الأرمن واضطهاد الكرد. ويندر أن تخلو
رواياته من ذلك التغنّي، الغنائي أحياناً وعلى خلاف نبرته الأسلوبية
العامة، من تلك المشهدية التعددية التي رسخها العثمانيون على أصعدة
إثنية ودينية ولغوية وثقافية، في اللباس والمطبخ كما في الموسيقى
والعمارة. وسواء ذهب إلى أحياء إسطنبول الأقدم، أو توغل في نفوس متصوفة
على تخوم المدينة الزاخرة، أو استبصر كتاباً أسود في أغوار قلعة بيضاء؛
فإنّ القواسم المشتركة عند باموق ترتدّ، دائماً، إلى التاريخ العثماني،
أو الانفلات عنه، أو حضوره في تركيا الراهنة/ الشرق أوسطية، أو
تمثيلاته في الثورة الثقافية الأتاتوركية.
وفي علم الاجتماع البسيط، فإنّ شيوع هذا المرض على نطاق اسع عابر للحساسيات والعقائد، متغاير في الزمان والمكان، موحِّد في كثير أو قليل بين أمثال باموق وشفق وبديع الزمان… يستوجب الكثير من الرصانة والتعمق والتأمل، واستبعاد الاختزال والقراءة الأحادية
وهل يُدهش المرء، في مثال ثانٍ، أن تكون ابنة بلده الروائية إليف شفق
مصابة بمرض الحنين إياه؟ من الأيسر الذهاب في المثال الأول إلى روايتها
«تلميذ المعماري»، 2015، التي تُبحر في قرن كامل من التاريخ العثماني،
يبدأ من سنة 1540 وتتناوب على سردياته المتشابكة أجيال بعد أجيال من
الأتراك، وهذه المفردة الأخيرة ذات دلالة خاصة وكبيرة في الرواية. ولا
عجب في أنّ معظم النقّاد الأتراك لا يرون ضلالة، أو زيغاً أو سوأة، في
هذا التوجّه الذي دأبت عليه شفق؛ بينما يذهب عدد غير قليل من الباحثين
والنقاد الأوروبيين، من أهل الاختصاص في التاريخ العثماني تحديداً، إلى
درجة اتهام الروائية التركية بـ»إشاعة يوتوبيا عثمانية»… ليس أقلّ!
آخرون من هؤلاء قرأوا رواية «لقيطة إسطنبول»، 2006، بوصفها بحث شفق عن
«فضاء نقيّ وآمن» للمجتمعات التي تدين بالولاء للروحية العثمانية؛ رغم
أنّ زليخة بطلة الرواية شخصية متمردة ورافضة للتقاليد المحافظة، على
خلاف أختها بانو المحجّبة والمتدينة.
وإلى جانب باموق وشفق، هنالك روايات أحمد رفيق ألتيناي (1880-1937)،
التي لم تهبط شعبيتها قطّ لدى شرائح متنوعة من القراء الأتراك المصابين
بالمرض إياه؛ رغم أنّ المجتمع التركي تجاوز الكثير من المواضعات
والأعراف التي تشدد تلك الروايات على تبجيها وامتداحها، كما تحثّ على
إحيائها. هنالك، أيضاً، الشاعر واسع الشعبية يحيى كمال بياث
(1884-1958)، وزميله أحمد حمدي تانبينار (1901-1962)؛ وكلاهما لم يكتفِ
بالحنين إلى الأحقاب العثمانية، بل غمز من قناة الأتاتوركية
والجمهوريين والجمهورية. هذا إذا وضع المرء الأدباء والكتّاب جانباً،
واستسأنس بمجموعة خاصة من دعاة العثمانية الجديدة، تألفت عموماً من
متصوفة أقاموا صلات وثيقة مع طرائق صوفية مشرقية نافذة مثل النقشبندية
والرفاعية، ثمّ حركة تجديد التصوّف التي قادها بديع الزمان سعيد نورسي
الكردي (1877-1960).
وفي علم الاجتماع البسيط، فإنّ شيوع هذا «المرض»، إذْ تستوجب الأمانة
العلمية حصر المفردة ضمن أهلّة، على نطاق اسع عابر للحساسيات والعقائد،
متغاير في الزمان والمكان، موحِّد في كثير أو قليل بين أمثال باموق
وشفق وبديع الزمان… يستوجب الكثير من الرصانة والتعمق والتأمل،
واستبعاد الاختزال والقراءة الأحادية. هذا، الشطر الأوّل من المعادلة
الآنفة، هو ما يجهد المشاركون في كتاب «المتخيَّلات النيو – عثمانية في
تركيا المعاصرة» لتبيانه ورصده وتحليله؛ بما ينتهي إلى خلاصات لامعة،
علمية وملموسة ومهتدية بنُظُم تحليل متقدمة، تتكفل بإحالة الشطر الثاني
من المعادلة إلى سلال مهملات التسطيح.
)عدم الانحياز(:
انعدام الصلة بين التسمية والمسمى
صبحي حديدي
قد لا يُلام امرؤ يفرك عينيه تعجباً، أو على سبيل التيقّن، حين يقرأ
خبراً عن اجتماعات تخصّ حركة عدم الانحياز؛ تُعقد على مستوى الوفود في
باريس، حيث مقرّ منظمة اليونسكو؛ أو على مستوى القمّة في أذربيجان أو
أوغندا، وقبلها في فنزويلا وإيران ومصر وكوبا وماليزيا وجنوب أفريقيا.
عدم انحياز في هذه الأزمنة؟ للمرء إياه أن يتساءل، الآن حين يمرّ عام
على الاجتياح الروسي في أوكرانيا، وتمرّ ساعات على الاحتشاد الأمريكي
والأطلسي هنا وهناك، ويعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقيع موسكو
على اتفاقية «ستارت الجديدة»…؟
وبين خداع العالم أو مخادعة الذات أو مزج أكذوبة مفضوحة الأركان بدعابة
ثقيلة الدم، ثمة طراز مضحك/ مبكٍ من التشبث بفكرة شبعت انحساراً
واحتضاراً، وموتاً بطيئاً في جوانب عديدة؛ لكنّ المتشبثين ليسوا البتة
على استعداد لتشييع ما تبقى منها إلى مقابر التاريخ، اتكاءً على مبدأ
عتيق يقول إنّ إكرام الميت دفنه. القمم ذاتها لم تعد تُعقد سنوياً، بل
على سبيل المناسبات المواتية، كما في قمة أذربيجان الـ18، أواخر
أكتوبر/تشرين الأول 2019، التي خرجت بتوصيات تخاطب مواضعات عالم مضى
وانقضى. وحين خاطب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وفود 20 بلداً
وممثلي نحو 160 منظمة وكياناً، لم تنحصر المفارقة في أنّ بلده منحاز
إلى روسيا من الرأس حتى أخمص القدمين، فحسب؛ بل كذلك في مشاركة كوريا
الشمالية، إلى جانب أفغانستان وإيران والبوسنة والهرسك و… سويسرا!
وكي يستقرّ المرء على بلد عربي، كان مفاجئاً أن تستذكر الجزائر وجود
حركة عدم الانحياز، في سنة 2014، فتقيم لها أشغال ندوة وزارية حضرها 60
وزير خارجية، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية؛ بعد أن كانت
الجزائر، ذاتها، قد احتضنت قمة الحركة الرابعة، سنة 1973. يومها قال
البيان الرسمي إنّ تلك الأشغال هدفت إلى «العمل سوياً من أجل الوصول
إلى أرضية تفاهم شاملة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها
مسائل التنمية التي تشكل هاجسا لجميع دول العالم النامي، وقضايا الأمن
والإرهاب العابر للأوطان». القمة الـ15، في شرم الشيخ 2009، شددت على
أنّ الانعقاد في مصر تحديداً يكتسب أهميته «ليس فقط من حجم المشاركة
الكبير، ومستوى التمثيل المتميز فيها، أو من طبيعة الظروف الدولية
الاستثنائية، والتطورات الراهنة التي يشهدها العالم، وفى مقدمتها
الأزمة المالية العالمية» و«إنما أيضاً من مكان انعقادها بما لمصر من
دور محوري في مسيرة حركة عدم الانحياز».
انطوى تاريخ الحركة على تجاور عجيب بين زعماء أنظمة دكتاتورية استبدادية (من الأندونيسي سوهارتو، إلى السوري حافظ الأسد، مروراً بأمثال عيدي أمين وجعفر النميري…) مع زعماء من طراز نلسون مانديلا وياسر عرفات
وأن تكون الحركة أقرب إلى جثة هامدة أمر لا يبدّل حقيقة أنها تعدّ في
عضويتها 120 دولة، و17 دولة مراقبة، و11 منظمة عالمية، بما يجعلها
التكتل الدولي الأكبر بعد منظمة الأمم المتحدة؛ كما لا يلطّف حقيقة
موازية تشير إلى أنّ الجوهر لم يعد يخصّ هذه التفاصيل، بل صار يدور حول
مصير الحركة ذاتها، وما إذا كان الاسم لايزال ينطبق على المسمّى
أساساً، أو يعبّر عن واقع حال فعلي. ففي سنة 1961 كان الزعيم الهندي
جواهر لال نهرو قد نحت هذه العبارة العجيبة، «عدم الانحياز» وأراد منها
ثلاثة أغراض: التحرّر من ربقة الاستعمار، بمختلف أشكاله القديمة
والحديثة؛ وتخفيف حدّة التوتر الدولي بين القطبين ــ المعسكرين،
الرأسمالي والاشتراكي؛ وتحقيق التنمية الاقتصادية لبلدان العالم
الثالث، بوصفها البلدان التي تمثّل الكتلة الطبيعية لمفهوم عدم
الانحياز.
وكان لافتاً أن تتحوّل هذه المبادئ إلى «فلسفة» في العلاقات الدولية،
هيمنت على مؤتمر باندونغ (أندونيسيا، 1955) للدول الآسيوية والأفريقية،
ولم يعتمدها بعض أبرز زعماء هذه الدول (نهرو، جمال عبد الناصر، كوامي
نكروما) فحسب؛ بل انضمّ إليهم اليوغسلافي جوزف بروز تيتو، زعيم دولة
كان يصعب اعتبارها غير منحازة، أياً كانت مشكلاتها العقائدية أو
السياسية مع المعسكر الاشتراكي. ليس هذا فقط، بل انطوى تاريخ الحركة
اللاحق على تجاور عجيب بين زعماء أنظمة دكتاتورية استبدادية (من
الأندونيسي سوهارتو، إلى السوري حافظ الأسد، مروراً بأمثال عيدي أمين
وجعفر النميري…) مع زعماء من طراز نلسون مانديلا وياسر عرفات.
غير أنّ «الفلسفة» حملت الكثير من مبررات وجودها، في سياقات اشتداد
الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو، وانقلاب مفهوم الاستقطاب إلى ما يشبه
الخيار القسري، في الاقتصاد والأمن أسوة بالسياسة والاجتماع. ثمّ
استقرت، وإنْ في المستوى اللفظي وحده طيلة عقود، على سلسلة من
«المطالب» العامة التي يظلّ الاتكاء عليها تذكرة نافعة، محدودة الجدوى.
بينها احترام حقوق الإنسان، وإقرار المساواة بين الأعراق والأمم،
واحترام حقّ الأمم في الدفاع عن النفس عند تعرّضها للعدوان، والامتناع
عن التهديد بالعدوان واستخدام القوّة، وحلّ النزاعات الدولية بطرق
سلمية… وفي ضوء الانتهاك المتعاقب لهذه المبادئ، كلّها، كلّ يوم
تقريباً، بات واضحاً أنّ مفهوم «عدم الانحياز» اغترب عن محتواه
الدلالي، وصارت مؤتمرات الحركة محض لقاءات فاقدة للمعنى؛ خاصة حين
يتواصل فيها التجاور بين دولة مثل إيران، تنحاز عسكرياً لصالح نظام
وراثي استبدادي في سوريا؛ أو أخرى مثل بورما (ميانمار) أو كوريا
الشمالية، حيث لا تنحاز الأنظمة إلا ضدّ الشعوب؛ وثالثة مثل أفغانستان،
كانت لا تزال تحت احتلال أمريكي وأطلسي، وتُصنّف غير منحازة!
ومن نافل القول إنّ أيّ اجتماع للحركة، حتى على مستوى وزراء الخارجية،
لن يخرج عن واقعة شاذة ضمن مشهد عالمي يهيمن عليه طراز واحد من
الانحياز، بمعنى المصطلح القديم بين واشنطن وموسكو، وفي مستويات
القطبية الأحادية أو القليل من الاستقطابات الفرعية؛ وهذه، كما لا
يخفى، ذروة الشكلانية الجوفاء في إدارة مؤسسات دولية انقلبت إلى ما
يشبه الميراث التاريخي الصرف، ولم تلفظ أنفاسها بعد لأسباب تتصل
جوهرياً بالنفاق السياسي والديكور التجميلي. وذات يوم، سنة 1998، شاءت
المفارقة، القاسية تماماً ولكن التعليمية المفيدة بالقدر ذاته، أن
تنعقد قمّتان في فترة زمنية واحدة: القمّة الأمريكية ــ الروسية،
والقمّة الـ 12 لدول عدم الانحياز؛ فكان الفارق صارخاً بالطبع، ولم تكن
اعتبارات الجغرافيا والمسافات الشاسعة هي وحدها التي فصلت بين موسكو
ودوربان في جنوب أفريقيا. كان ثمة اعتبارات أخرى جوهرية تخصّ الموقع
والدور والوظيفة الذي تشغله القمّتان في نظام العلاقات الدولية، وكان
ثمة الكثير الذي يدور حول التاريخ والاقتصاد والسياسة والثقافة
والديموغرافيا، أو كلّ ما يُبقي الشمال شمالاً والجنوب جنوباً، باختصار
كلاسيكي.
وذاك الذي، في السطور الأولى أعلاه، فرك عينيه تعجباً يحقّ له أن يضيف
سلسلة أسئلة ذات وجاهة: عدم انحياز، بين مَنْ ومَنْ؟ لصالح مَنْ بالضبط
(إذْ ينبغي أن يكون هنالك ذلك الفريق الثالث الذي يصبّ موقف عدم
الانحياز لصالحه) وأين؟ خطوة آمنة أولى هي حصر المصطلح بين مزدوجات،
بحيث تكون له مساحة دلالية مفتوحة بعض الشيء، سواء لجهة التأويل أو
لجهة الالتباس: إنه مصطلح، مثله مثل سواه من مصطلحات فقدت الكثير من
مخزونها الدلالي هذه الأيام، من دون أن تنقرض أو تُسحب تماماً من
التداول. خطوة تالية هي وضع الفكرة بأسرها جانباً، ليس لأنها باتت
نافلة مُماتة فقط، بل أساساً لأن كتلة الدول الأعضاء منحازة شاءت أم
أبَت، ومنحازة بحكم ما يُناط بها من وظائف ضمن التقاسم الدقيق للأدوار
الإجمالية في نظام العلاقات الدولية.
تسمياته الأخرى متوفرة بالطبع، على غرار «حوار الشمال والجنوب» من باب
الكياسة، و«حوار الأغنياء والفقراء» من باب تسمية الأشياء بمسمّياتها
الفعلية.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
)ساعة القيامة( بين الكارثة
النووية وغنائيات البنتاغون
صبحي حديدي
«ساعة القيامة» في تعريفها الموسوعي المبسط والشائع دولياً، هي أداة
توقيت رمزية ترصد دنوّ الكوارث الكبرى التي من صنع أيدي البشر، على
غرار اندلاع حرب نووية لا تُبقي ولا تذر مثلاً؛ وهي، منذ أن ابتدعها في
سنة 1947 أعضاء «نشرة العلماء النوويين» جهاز مجازي يحدد عدد الدقائق
أو الثواني التي تفصل البشرية عن منتصف ليل الكارثة/ القيامة، وذلك في
كانون الثاني (يناير) من كلّ عام. وكما هو معروف، كانت الساعة تلك قد
تعدلت 17 مرّة ضمن معدلات زمنية أقلّ أو أكثر، كانت القيمة الأبعد فيها
17 دقيقة سنة 1991، والأدنى (التي أُعلن عنها يوم 24 كانون الثاني/
يناير هذه السنة) كانت 90 ثانية قبل منتصف الليل.
الحكاية ليست لعبة، بالطبع، والمؤكد أنها ليست وسيلة ترهيب وردع على
المستوى الشعوري في أقلّ تقدير؛ وزائر موقع «نشرة العلماء النوويين»
على الإنترنت سوف يجد الكثير من المعطيات الجادّة، الملموسة الموثقة
أوّلاً، والخطيرة المفزعة استطراداً. والسادة العلماء يسوقون عدداً من
العوامل الكونية التي دفعتهم إلى تقصير أجل «القيامة النووية» إلى 90
ثانية فقط، على رأسها الحرب في أوكرانيا واحتمالات تصعيد المواجهة
العسكرية الروسية ـ الأمريكية، أو الروسية ـ الأطلسية، وكذلك التهديدات
المتزايدة الناجمة عن أزمة المناخ، والانكسار التدريجي للنُظم العالمية
التي تحتاج إليها الإنسانية من أجل ضبط انفجارات التطور التكنولوجي
والأخطار البيولوجية على شاكلة كوفيد ـ 19. راشيل برونسون، الرئيسة
والمديرة التنفيذية للمعهد الذي يصدر النشرة، لا تتردد في التصريح
هكذا: «نحن نعيش في زمن من الخطر غير المسبوق، وتوقيت ساعة القيامة
يعكس الواقع الفعلي. 90 ثانية نحو منتصف ليل القيامة هو الأقصر الذي
بلغته الساعة، وهذا قرار لا يحمله علماؤنا على محمل الخفّة».
ربما على محمل الجدّ الأقصى، بالفعل، غير أنّ المرء لن يجد عناء في
تلمّس «خفّة» من طراز مختلف لا يعتمد ساعة منبّه من أيّ نوع، بل لعله
لا يكترث كثيراً بالرمز أو المجاز في تحذير المعمورة من الانزلاق
المضطرد نحو الكارثة؛ وهذا إذا اختار المرء وضع نبوءات «نشرة العلماء
النوويين» جانباً، وذهب إلى أرلنغتون، ولاية فرجينيا، حيث مقرّ
البنتاغون، وزيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية على
الإنترنت، وتصفّح بعض تفاصيل التقرير المسمّى «ستراتيجة الدفاع الوطني»
لأيّ سنة يشاء، ولكن 2008 على وجه الخصوص. ولسوف يقرأ، في المستهلّ،
مقدّمة جيو – سياسية تتغنّى بـ 230 سنة قضتها القوّات العسكرية
الأمريكية وهي تلعب دور الحصن المنيع المدافع عن الحرّية والفرصة
والرخاء داخلياً، ودور المساند الأقوى للراغبين في حياة أفضل على نطاق
العالم بأسره؛ حين كانت أمريكا هي «النبراس المضيء في الأماكن
المظلمة». كذلك سوف يجد فصولاً لاحقة، تتحدّث عن البيئة الستراتيجية،
والإطار الستراتيجي، والأغراض الستراتيجية، وإمكانات الوزارة ووسائلها،
وإدارة الأخطار…
زائر موقع «نشرة العلماء النوويين» على الإنترنت سوف يجد الكثير من المعطيات الجادّة، الملموسة الموثقة أوّلاً، والخطيرة المفزعة استطراداً. والسادة العلماء يسوقون عدداً من العوامل الكونية التي دفعتهم إلى تقصير أجل «القيامة النووية» إلى 90 ثانية فقط
والحال أنّ قارئ التقرير يمكن أن يخرج بانطباع يفيد بأنّ العالم في
عقيدة البنتاغون لم يتغيّر كثيراً منذ سقوط جدار برلين وانهيار نظام
القطبين وأفول الحرب الباردة، حتى لتبدو الصورة وكأنّ الإنسانية لم
تغادر العام 1988 إلا زمنياً فقط، وليس جيو ـ سياسياً أو جيو ـ
عسكرياً. عالم واحد ثابت، وإلى الجحيم بأيّ وجميع المتغيرات والهزّات
والانقلابات، دولية كانت أم إقليمية، داخلية أمريكية أم خارجية كونية،
إيديولوجية أم سياسية أم ثقافية… وبالمعنى العسكري، وهو ميدان
البنتاغون وعلّة وجوده، العالم كما هو في اعتبارات شتى مركزية، لأنه
ببساطة (أي: بتبسيط عن سابق قصد وتصميم) صورة طبق الأصل عن الحال ذاتها
التي اقتضت، قبل أعوام وعقود، إعداد سيناريوهات تعبوية وقتالية
ولوجستية لمواجهة… حلف وارسو!
مثير، أيضاً، مقدار التشابه بين التقارير السنوية وتلك التي اعتادت
الوزارة رفعها إلى الكونغرس كلّ أربع سنوات، وتأخذ صفة البرنامج
العقائدي والعسكري والتكنولوجي والإداري والمالي طيلة السنوات الأربع
اللاحقة. ومن المعروف أنّ عقود الحرب الباردة جعلت تحرير مثل هذه
التقارير مسألة روتينية للغاية، لأنّ العقيدة لم تكن تتغير في قليل أو
كثير ما دام الخصم على حاله، وما من حكمة تبرر تجميد هذا الخطّ أو ذاك
في الصناعات العسكرية، بل الحكمة كلّ الحكمة في تطوير أجيال الأسلحة
وفق مبدأ هنري كيسنجر الشهير: لا تتوقفوا عن تطوير الأسلحة، وسيضطرّ
الشيوعيون إلى اللحاق بنا، حتى يأتي يوم تفتح فيه السيدة الروسية
الثلاجة فلا تجد سوى الجليد والرفوف الخاوية. سيدة تلك الأيام،
السوفييتية كما يصحّ التذكير، ليست هي ذاتها سيدة روسيا فلاديمير بوتين
غنيّ عن القول؛ وهي، أيضاً، ليست ابنة عمّ السيدة الأوكرانية أو
الجورجية أو مواطنة روسيا البيضاء وجزيرة القرم…
على مستوى العقيدة العسكرية كانت الرؤية الدفاعية، وتحديداً في عهد
رونالد ريغان وطور «حرب النجوم» قد نهضت على مفهومين ستراتيجيين:
– أشكال التعامل مع النزاع الخفيف
Low Intensity Conflict
أو
LIC،
والذي لقي اهتماماً محدوداً في السبعينيات إثر هزيمة فييتنام، لكنه
اكتسب حيوية خاصة في مطلع الثمانينيات مع إحياء اهتمام البيت الأبيض
بالعالم الثالث. ريغان، من جانبه، ارتقى بالمفهوم ليعطيه أولوية عسكرية
في ولايته الثانية، حين انتقل اهتمام الإدارة من سباق التسلح النووي
إلى التسابق على اجتذاب أنظمة الجنوب، خصوصاً تلك التي كانت موالية
للاتحاد السوفييتي.
– أشكال التعامل مع النزاع المتوسط
Mid-Intensity Conflict
أو
MIC،
وهو القتال الذي تخوضه القوات الأمريكية ضدّ قوى كبرى في العالم
الثالث. وإذا كان الـ
LIC
مخصصاً لمواجهة ضروب حرب العصابات والجيوش الصغيرة المحدودة (كما في
مثال باناما) فإن الـ
MIC
مخصص لحرب واسعة النطاق تشترك فيها قوّات وصنوف وأنظمة قتالية عالية
المستوى والتدريب والتسليح (كما في مثال العراق، ذات حقبة سابقة).
في القسم التمهيدي الذي يحمل عنوان «البيئة الأمنية العالمية» ظلت
تقارير البنتاغون تقول: «مع اقتراب القرن الحادي والعشرين تواجه
الولايات المتحدة مناخاً أمنياً ديناميكياً وغير مضمون، حافلاً بالفرص
مثل التحديات. ففي الجانب الإيجابي نحن في طور الفرصة الستراتيجية. لقد
تراجع خطر الحرب الكونية، وقيمنا في الديمقراطية التمثيلية واقتصاد
السوق يتمّ اعتناقها في العديد من أطراف العالم، الأمر الذي يخلق فرصاً
جديدة من أجل السلام والرخاء وتوطيد التعاون بين الشعوب. ودينامية
الاقتصاد العالمي تتسبب في تبدّل التجارة، والثقافة، والتفاعلات
المتبادلة على نطاق عالمي. وإنّ تحالفاتنا، مع الناتو واليابان وكوريا،
تتأقلم بنجاح مع التحديات الراهنة، وتؤمّن الأساس لبناء عالم مستقر
ورغيد (…) ومع ذلك فإنّ العالم يظلّ مكاناً بالغ الخطورة وغير مضمون،
ومن المرجح أن تواجه الولايات المتحدة عدداً من التحديات الهامة لأمنها
ومصالحها».
هذه، غنيّ عن القول، غنائيات مستعادة متكررة متماثلة لم يتوقف
البنتاغون عن إعادة استنساخها، سواء كان قيصر روسيا المعاصر جالساً على
مبعدة بوصة واحدة من أزرار إطلاق القنبلة النووية؛ أو كان يلقي خطاباً
في مؤتمر ميونيخ للأمن سنة 2007، ينطوي على هجاء مقذع لأحادية القطب
الأمريكية؛ أو في صيغة وسيطة قبلها، سنة 1994، حين انضمت موسكو إلى
برنامج «الشراكة من أجل السلام» ووقعت سلسلة اتفاقيات مه الحلف
الأطلسي. الأكيد، إلى هذا وذاك، أنّ ثواني ساعة القيامة التي تقف اليوم
عند 90 ثانية من منتصف ليل الكارثة، ليست البتة شريكة في توافق من أيّ
طراز مع غنائيات البنتاغون.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
حصة سوريا من الزلازل:
تجارة الإشفاق وذرائع الأجندات
صبحي حديدي
قبل أن يتكفل الزلزال الأخير بالقضاء على 3162 سورياً وإصابة 5685 حتى
ساعة تحرير هذه السطور، في مختلف المناطق المنكوبة من سوريا؛ كانت
أرقام أخرى تنطق عن الشقاء السوري غير الناجم عن الكوارث الطبيعية، تحت
نير 53 سنة من نظام الاستبداد والفساد الذي أقامه آل الأسد، بينها 12
سنة من إشراف الوريث بشار الأسد على قمع الانتفاضة الشعبية عن طريق
إزهاق أرواح مئات الآلاف، وتشريد الملايين، واعتماد خيارات الأرض
المحروقة والتدمير الشامل والتطهير المناطقي، وتسليم البلاد إلى خمسة
احتلالات، فضلاً عن عشرات الميليشيات المذهبية ومفارز المرتزقة.
إحصائيات الأمم المتحدة كانت تقول إنّ 70٪ من سكان سوريا هم في حاجة
فعلية إلى العون بمختلف أشكاله، غذائياً وصحياً وإنسانياً؛ و«برنامج
الغذاء العالمي» يكمل مشهد البؤس بالتحذير من أنّ الجوع بلغ معدلات
قصوى لا أمثلة عليها في تاريخ سوريا، مع 2.9 مليون نسمة يقتربون من
حافة المجاعة، و12 مليون لا يعرفون متى سيحصل أيّ منهم على وجبة طعام
مقبلة. مكاتب أخرى أممية تشير إلى أنّ 90٪ من سكان سوريا الـ18 مليون
نسمة يعيشون في حال من الفقر، ومعاناة الأوبئة والأمراض المتفشية ونقص
الأدوية؛ وأمّا العملة الوطنية، التي كانت قبل 2011 سنة الانتفاضة
تُصرف بـ50 ليرة أمام الدولار الأمريكي، فإنها قبيل الزلزال الأخير
تُصرف بأكثر من 7.000…
الزلازل لم تفرّق، بالطبع، بين مناطق تحت سيطرة «المعارضة» أياً كانت
إفادة هذه المفردة بين ميليشيات جهادية وحكومات إنقاذ كرتونية
وائتلافات ومجالس وهيئات ومؤسسات صادقة النوايا أو كاذبة فاسدة ناهبة؛
ومناطق تابعة للنظام، أو تديرها بالشراكة معه جيوش محتلة، وميليشيات
محلية أو خارجية تابعة، وعصابات نهب وتهريب وقرصنة وكبتاغون. واكتوى
بلهيب الزلازل مواطنون من جنديريس وحارم والقامشلي، مع أبناء بلدهم في
شمال حلب وجبلة وريف حماة، وحُرموا استطراداً من موجات الإشفاق
العالمية التي تعالت واصطخبت؛ تارة لأنّ النظام مصرّ على تمرير
المعونات عبر طرقاته ومعابره السيادية (أي تلك الكفيلة بإتاحة النهب
المباشر وتحويل المساعدات إلى خزائن مافيات النظام) وتارة أخرى لأنّ
السلطات التركية منشغلة بحصتها من الكارثة ولشعبها ومناطقها أولوية غير
قابلة للتجزئة. الإنسانية من جانبها، وهي هنا ذلك الخليط العجيب من
«العالم الحرّ» و«المجتمع الدولي» وعشرات المنظمات غير الحكومية، تعلن
النوايا الأحسن وتعرب عن الاستعداد التامّ لتقديم العون، مكتوفة الأيدي
أو تكاد إزاء وضع «قانوني» عالق في معبر مفتوح مثل باب الهوى، أو في
معابر أخرى يُنتظر أن تفتح أبوابها معجزةٌ ما!
وفي المقابل لا يعدم الضحايا السوريون، أينما وقعت مآسيهم في كلّ شبر
من سوريا الواحدة، جبهات نفاق وسوء استغلال وتشويه لا تضاعف الآلام
والعذابات فحسب، بل تضيف الإهانة المباشرة على الجراح النازفة؛ كما حين
تصحو من سبات عميق تلك الحملة الكاذبة الزائفة التي تطالب بـ«رفع
الحصار عن سوريا» بينما المقصود الوحيد هو فكّ الخناق عن مافيات النظام
وعصابات الكبتاغون. وسواء اتفق المرء مع العقوبات الاقتصادية الدولية
عموماً والأمريكية منها خصوصاً، أو كان مناهضاً لها (كما هي حال هذه
السطور) بسبب أنها لا تؤذي الأنظمة بمقدار إيذاء الشعوب والشرائح
الأكثر فقراً ومعاناة؛ فإنّ جملة الحقائق الصلبة التي تتصل بالعقوبات
الراهنة المفروضة على النظام السوري تؤكد أنها لا تحول، البتة، دون
إيصال المساعدات الإنسانية، والغذائية والطبية منها على وجه الخصوص.
التعاطف العالمي مع المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا ظاهر بالطبع، والكثير منه صادق ربما؛ ما يخفى، في المقابل، هو ذلك النهج الذي يُخضع الاتجار بالشفقة إلى اعتبارات خدمة الأجندات المبطنة، على اختلاف ذرائعها وأغراضها
والضحايا أنفسهم لن يعدموا جوقة عداء صاخبة، لا تتورع عن اللجوء إلى
أقصى مستويات البذاءة، في تأثيم متطوّعي «الخوذ البيضاء» الذين ينشغل
نحو 3000 منهم في أعمال الإغاثة والإنقاذ وانتشال الأحياء والجثث من
تحت الأنقاض؛ وقد أنجزوا في السنوات العشر الأخيرة، ويواصلون اليوم
إنجاز، الكثير من المهامّ الصعبة أو شبه المستحيلة في مناطق الشمال
الشرقي من سوريا، تحت قصف مدفعية النظام وراجماته وحواماته وبراميله
المتفجرة، وبمشاركة مباشرة من القاذفات الروسية. فإمّا أن يتهمهم
«علماني» مزيف منافق بتمرير أجندات «إسلاموية» وفي هذا وقاحة صارخة لا
حدود للسخافة فيها؛ أو أن يعيّرهم «ممانع» لا يقلّ زيفاً ونفاقاً،
بأنهم ليسوا سوى استطالة للاستخبارات التركية.
وإذْ يصغي المرء إلى نيد برايس، الناطق باسم الخارجية الأمريكية، وهو
يشدد بإباء على أنّ الإدارة في ملفّ المعونات لن تتعامل مع النظام
السوري الذي ارتكب الفظائع بحقّ الشعب السوري؛ فإنّ المرء ذاته لن يسمع
من برايس مفردة واحدة تفيد بأنّ قسطاً من المعدات والمساعدات والأموال
سوف يصل إلى أيّ من أولئك الـ3000 الذين يصارعون الزلازل ويسابقون
الزمن في المناطق المنكوبة. وبالطبع، يندر لدى لائمي «الخوذ البيضاء»
التوقف عند حقيقة أولى كبرى تقول إنهم، حتى إشعار آخر، وحدهم في ميادين
الإغاثة تلك؛ وحقيقة أخرى تفيد بأنّ نحو 252 من متطوّعيهم استُشهدوا
حتى الساعة، فوق الأنقاض أو تحتها.
وكما يحدث في كلّ مأساة من طراز مماثل لما شهدته مناطق تركية وسورية
مؤخراً، يصحّ للمرء أن يتذكر تلك الإحصائية الطريفة السوداء التي
اقترحها أحد الأذكياء، الكاتب البريطاني جورج مونبيوت، ذات كارثة غير
بعيدة: ساعة وقوع زلزال تسونامي في المحيط الهندي سنة 2004، كان
الاحتلال الأمريكي للعراق قد دخل في يومه الـ 656، وكانت واشنطن قد
أنفقت حتى ذاك التاريخ قرابة 148 مليار دولار في تغطية نفقاته؛ وهذا
عنى أنّ المبلغ الذي تبرّعت به واشنطن لإغاثة منكوبي جنوب شرق آسيا كان
يعادل يوماً ونصف يوم فقط من مصروفات أمريكا! فوق هذا، جدير بالاستذكار
مؤشر آخر كان يقول إنّ أرقام المساعدات الخارجية الأمريكية لا تُقارن
البتة بما تنفقه واشنطن لخلق المزيد من، أو إدامة وتوسيع نطاق، عذابات
الشعوب: إنها تقدّم سنوياً قرابة 16 مليار دولار (بينها ثلاثة مليارات
لدولة الاحتلال الإسرائيلي وحدها!) تعادل تُسع إنفاق واشنطن في هذه
السُبُل.
وذات يوم أيضاً، على سيرة التسابق المحموم لإغاثة مرابع تسونامي، كان
لا بدّ لجهة ما أن تغرّد خارج سرب تماثل وتشابه وتوحّد حتى تسبّب في
تشويش الآدمي طيّب القلب حسن النيّة، أو لعلّ الأحرى القول إنّ نغمة
نشازاً مدروسة وهادفة كانت جديرة بأن تردّ الأمور إلى بعض نصابها.
وهكذا صدر عن منظمة «أطباء بلا حدود» الفرنسية الدولية إعلان إلى الرأي
العام يخرج عن الإجماع حقاً، لأنه قال ما معناه: لكم جزيل الشكر! لقد
وصلتنا منكم تبرّعات سخيّة تكفي بل تزيد عن حاجة برنامجنا المخصص
لإغاثة منكوبي تسونامي، وبذلك نرجوكم التوقف عن التبرّع لهذا البرنامج،
وتحويل سخائكم إلى برامج مناطق أخرى من العالم ليست نكباتها الإنسانية
أقلّ مأساوية وحاجة! كان الإعلان مفاجئاً بالطبع، وبعض الرأي السطحي
بصدده سار هكذا: هل يعقل أن تطالب منظمة إنسانية بالتوقف عن التبرّع؟
والحال أنّ ذلك الطلب لم يكن يعقل إلا من منظمة نزيهة وعادلة في نظرتها
إلى الكوارث الإنسانية، تقول ببساطة إنها تريد من الجمهور أن يواصل
التبرّع، ولكن ليس إلى نكبة تلقّت أكثر ممّا تحتاج، بل إلى برامج إغاثة
أخرى في حاجة ماسّة إلى التمويل.
والتعاطف العالمي مع المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا ظاهر بالطبع،
والكثير منه صادق ربما؛ ما يخفى، في المقابل، هو ذلك النهج الذي يُخضع
الاتجار بالشفقة إلى اعتبارات خدمة الأجندات المبطنة، على اختلاف
ذرائعها وأغراضها.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
غروسمان
ورواية ستالينغراد الكبرى
صبحي حديدي
الآن وقد مرّت الذكرى الـ80 للانتصار السوفييتي في معركة ستالينغراد
(1,5 إلى 2 مليون قتيل، وأكثر معارك الحروب دموية على امتداد التاريخ)؛
للمرء أن يقلّب الرأي في نوعية القراءات الواجبة، على سبيل استذكار
واقعة لم تكن عادية، ولم تخلّف في التاريخ الإنساني الحديث خدوشاً
عابرة أو قابلة للنسيان. العودة إلى كتابات تمزج التاريخ العسكري
بالذاكرة البشرية، على سبيل استقراء «النصّ الدفين» لأبناء المدينة، ما
دُوّن قليله أو اندثر كثيره، خلال زهاء ستة أشهر من الحصار والقتال
والقصف والأهوال؛ اقتداء بمصائر تلك النصوص التي اقترنت بحصار طروادة
مثلاً، وقصائد شعرائها التي كُتبت وضاعت وظلّ محمود درويش ممسوساً
بفكرة العثور عليها وقراءتها. في خيار آخر، يمكن للمرء أن يعود إلى
مشاهدة بعض أفضل نماذج أفلام الحرب السوفييتية، فلاديمير بيتروف مثلاً،
أو يوري أوزيروف، أو حتى شريط ألكساندر إيفانوف الذي يتلمّس عواطف عشاق
المدينة من نساء ورجال. خيار ثالث، ليس أقلّ إمتاعاً ومؤانسة وتكريماً
أيضاً، قد يتمثل في استقراء عشرات، وربما مئات، اللوحات التشكيلية
والصور الفوتوغرافية والمنحوتات والتماثيل والجداريات، التي خلّدت
المعركة ورصدت مصائر البشر والحجر.
أو، كما اختارت هذه السطور، العودة إلى الكاتب والصحافي والروائي
السوفييتي فاسيلي سيمينوفتش غروسمان (1905-1964)، الذي كتب المدوّنات
الأفضل عن حصار موسكو وكرسك وبرلين، فضلاً عن تقاريره التي غطّت حصار
ستالينغراد وانتصارها؛ ثمّ درّة أعماله، الرواية الضخمة التي حملت
عنوان «الحياة والمصير» وامتدّت على ثلاثة أجزاء (بلغت 1550 صفحة في
الترجمة العربية التي أنجزها ثائر زين الدين وفريد الشحف، وصدرت سنة
2021 عن دار سؤال في بيروت). ومن الجدير بالإشارة، هنا، أنّ قيادة
الحزب الشيوعي السوفييتي وعلى رأسها نيكيتا خروتشوف ذاته، ومن خلفه
المخابرات السوفييتية وأجهزة اتحاد الكتّاب ورهط الدوغما العقائدية
والجمود الفكري والأدبي، لم يطربها عمل غروسمان وأخضعته مراراً للرقابة
والمنع والتنكيل. ومن مفارقات التاريخ، الساخرة والمريرة في آن، أنّ
غروسمان أوكراني المحتد؛ والأرجح أنّ مواطنيه يعيدون قراءته اليوم على
أضواء الشموع، تحت الحصار، وكأنّ ستالينغراد التي أبدع في تصويرها قفزت
مشاهدها من سنة 1952 إلى سنة 2023!
في العودة إلى الذكرى الـ80 لانتصار ستالينغراد على هتلر وموسوليني والرايخ الثالث والنازية والفاشية، معاً، قد تكون أردأ الخيارات تلك التي تستقرّ على قراءة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يستذكر الواقعة عن طريق قرع طبول الحرب الباردة والنووية
هنا فقرة من ختام الرواية، في ترجمة زين الدين والشحف: «ولكن في برد
الغابة، كان يحسّ بالربيع متوتراً، أكثر منه في السهل المضاء بالشمس.
كان في صمت هذه الغابة حزن أكبر من صمت الخريف. سُمعت في بكمها الأخرس
صرخة نواح على الموتى وفرحة الحياة الغاضبة. لا يزال ثمة برد وظلام،
لكن قريباً جداً ستُفتح الأبواب على مصراعيها، وسيعود البيت المهجور
إلى الحياة، ويمتلئ بضحك الأطفال وبكائهم، وستُسمع خطوات الإناث
اللطيفة المستعجلة، وسيتجول في البيت صاحبه الواثق. وقفا وهما يحملان
محافظ الخبز، وصمتا». وفي هذه اللغة، وتلك المناخات الطبيعية
والشعورية، كانت أساليب تشيخوف وغوغول وليرمنتوف تتقاطع وتتصارع، في
خلاصات أقرب إلى مزيج تصنعه مطحنة، منه إلى عصارة يقذفها أتون. وكان
لقب «تولستوي السوفييتي» يعتمل في النفوس، ولكن ندر أنه تردد على
الألسن بالنظر إلى البغضاء الصريحة التي أعلنها أندريه جدانوف (مفوّض
ستالين في الرقابة على الآداب والفنون) ضدّ غروسمان وأقرانه.
لقد ابتدأ جدانوف من الأشهر، الشاعرة الكبيرة أنا أخماتوفا، فاعتبرها
مجرد «فضلات من الثقافة الأرستقراطية القديمة»، وعمل على طردها من
اتحاد الكتّاب، ولم يتورّع عن توصيفها بـ» نصف عاهرة، نصف راهبة، أو
بالأحرى عاهرة/ راهبة»؛ وكان القصد هو التلويح بالهراوة الغليظة في
وجوه الآخرين، إذْ كان الإجهاز على أخماتوفا بمثابة محرقة تنتظر سواها.
ولم يكن غريباً أنّ ميخائيل سوسلوف شخصياً، وكان في سنة 1947 رئيس
«دائرة التحريض والبروباغندا» في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
السوفييتي، راجع بنفسه مخطوط عمل غروسمان المعنون «الكتاب الأسود»،
ووجّه بعدم صلاحيته للنشر. لا غرابة، كذلك، في أنّ صداقة حميمة نشأت
بين غروسمان ومواطنه الأوكراني الكاتب والصحافي فكتور نكراسوف الذي، في
المقابل، كان مرضياً عنه نسبياً ولكنه عجز عن تخليص صديقه من أغلال
الرقابة الجدانوفية. وفي أزمنتنا الراهنة، التي شهدت وتشهد أفواج
اللاجئين والمهجّرين ويقظة العصبيات والعنصريات، لا يَعجب قارئ غروسمان
حين تدور الفقرات الأولى من روايته الضخمة في معسكرات لجوء.
وفي العودة إلى الذكرى الـ80 لانتصار ستالينغراد على هتلر وموسوليني
والرايخ الثالث والنازية والفاشية، معاً، قد تكون أردأ الخيارات تلك
التي تستقرّ على قراءة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يستذكر
الواقعة عن طريق قرع طبول الحرب الباردة أو النووية، والتذكير بأنّ
دبابات ليوبارد الألمانية التي ستصل إلى أوكرانيا هي ذاتها التي اجتاحت
ستالينغراد. لافت، إلى هذا، أنّ بوتين كان قبل سنتين فقط قد تعمّد
إغفال اسم ستالين خلال الاحتفالات بالذكرى ذاتها، وأمّا اليوم فإنه لا
يبجّله كقائد حرب فقط، بل كزعيم شارك في بناء الإمبراطورية الروسية،
ودبلوماسي فاوض خصومه وحلفائه في طهران ويالطا، وقبلهما في التفاهمات
مع النازية. غير خارج عن هذه السياقات أنه هذه المرّة يحشد العواطف
القوموية الشعبوية، على مبعدة أمتار من تمثال جديد يردّ ستالين إلى
ساحات فولغوغراد؛ التي كانت تسمى ستالينغراد، والأرجح أنها هكذا ستبقى
في ملازمة اسمها الوضاء.
من باريس إلى لندن:
فقاعات الرأسمالية التي تتفجر
صبحي حديدي
ملايين في ساحات باريس، ومئات الآلاف في شوارع لندن، هذه الأيام؛
وقبلها، خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، في عواصم ألمانيا وإسبانيا
والبرتغال وإيطاليا والنمسا وكبرى المدن والمراكز الصناعية فيها، وفي
سواها؛ والمحتوى المشترك في خلفيات الاحتجاج، الموحّد أيضاً على نحو أو
آخر، هو غلاء المعيشة مقابل تدني الأجور، والسياسات الاقتصادية التي
تكرّس التضخم والبطالة وانحطاط الخدمات العامة. أما المحتوى المباشر،
المعلَن الراهن في فرنسا على الأقلّ، فهو تمويل صناديق التقاعد تحت
حزمة أسئلة مثل هذه: كيف نسدّ عجزاً سنوياً بقيمة 33 مليار يورو؟ وإذا
استبعدنا فرض ضرائب جديدة لتغذية الصناديق، فهل نرفع سنّ التقاعد إلى
64 (حيث يرتفع إلى 65 في معظم الأنظمة الرأسمالية الأوروبية)؟ أم نكسر
بعض محظورات تقاليد التأمين الاجتماعي الفرنسية العريقة، فنلجأ أكثر
فأكثر إلى القطاع الخاصّ بأنظمته الاستثمارية الاستغلالية؟ وإذا كان
غالبية رؤساء فرنسا خلال الجمهورية الخامسة (1958 -) قد حاولوا إصلاح
ملفّ التقاعد، فتملصوا أو تراجعوا؛ فهل يفعلها الرئيس الحالي إيمانويل
ماكرون بوصفه ربيب ليبرالية صيرفية تلعب على حبال اليمين واليسار
والوسط، ولم يعد لديه ما يخسره أصلاً لأنه حاز ولاية ثانية ذات طابع
تاريخي واختراقي في جوانب عديدة، ولا يجوز له الترشيح للمرّة الثالثة؟
صحيح أنّ الإضراب أحد الأسلحة الماضية التي يمكن للتنظيمات النقابية أن
تشهرها في وجه السلطات الرأسمالية الحاكمة، في الديمقراطيات الأوروبية
بصفة خاصة، وقد كانت سابقة الإضراب الفرنسي الشهير سنة 1995 قد أجبرت
الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس وزرائه آلان جوبيه على التراجع عن
مشاريع وتعديلات وقوانين مماثلة؛ إلا أنّ الصحيح، في المقابل، هو أنه
سلاح مؤقت محفوف بالمخاطر، وهو أيضاً ذو حدّين في أفضل تطبيقاته
الحديثة والمعاصرة. على سبيل المثال، إذا كانت ثماني منظمات نقابية
فرنسية قد توافقت على مواجهة تعديلات سنّ التقاعد، التي ينوي ماكرون
تمريرها في الجمعية الوطنية وسنّها كقانون، ونجحت في إخراج 1,27 مليون
متظاهر في شوارع فرنسا؛ فهل هي على الاتفاق ذاته، بصدد المضيّ أبعد،
وأطول، في أشكال الضغط على الحكومة؟ كلا، بالطبع، لأسباب ليست بعيدة
كثيراً عن واحدة من معضلات النظم الديمقراطية الأوروبية؛ لأنّ
«الكونفدرالية العامة للشغل» الأعرق التي يعود تأسيسها إلى سنة 1895
والأشدّ توجهاً نحو اليسار والفعل الراديكالي، تقترح التصعيد في منشآت
تشلّ قطاعات المصافي والطاقة والمواصلات؛ بينما تساجل «الكونفدرالية
الفرنسية الديمقراطية للشغل» الثانية من حيث أعداد المنتسبين والأكثر
اعتدالاً وميلاً إلى المقاربة الإدارية، بأنّ الإضراب في تلك القطاعات
سوف يعطّل إيقاع الحياة اليومية لملايين الفرنسيين ويُفقد حركة الإضراب
بعض التأييد الشعبي، وربما الكثير منه.
من جانبها، لن تقف إدارة ماكرون مكتوفة الأيدي إزاء استمرار أعمال
الاحتجاج والإضرابات، وثمة مستويات تكتيكية عديدة يمكن أن تلجأ إليها؛
من داخل، وفي صميم، القوانين ذاتها التي تحكم الحريات الدستورية
للنقابات وهوامش تحرّك السلطات. هنالك خيار أوّل يتمثل في تقديم
تنازلات هنا أو هناك، سواء لشرائح عمل معيّنة ودون سواها، أو لقطاعات
سوسيولوجية وديمغرافية تخصّ النساء مثلاً؛ وهنالك خيار تحويل هذه
التعديلات إلى منصات اختلاف وشقاق داخل كُتل الجمعية الوطنية، بين
برلماني يساري متشدد وآخر معتدل، وبين يميني جمهوري وآخر عنصري،
بالإضافة إلى شقّ صفوف النقابات استطراداً.
وتلك فقاعات لا تتفجر مجموعة منها حتى تُخلي الساحات والشوارع لفقاعات أخرى، وهكذا؛ على منوال يعيد التذكير بنبوءة كارل ماركس حول رأسمالية لا تكفّ عن مراكمة التفاوت بين رأس المال والعمل، فلا تتوقف تالياً عن… إنتاج حفّار قبرها.
وأمّا في خيار ثالث يوفّره دستور الجمهورية الخامسة ذاته، ففي وسع
الحكومة أن تلجأ إلى المادة 49,3 التي تتيح تمرير بعض التشريعات من دون
المرور بالتصويت المعتاد، أو إلى المادّة الأخرى 47.1 (التي لا عجب في
أنّ لقبها هو «المقصلة»!) نادرة الاستخدام، تختصر مناقشة التشريعات إلى
20 يوماً فقط. وليس خافياً أنّ الرساميل والشركات الصناعية الكبرى
وأرباب القطاع الخاص وأصحاب مليارات الاستثمار الراهن أو المحتمل في
قطاع التأمين والتقاعد، هم أشرس مساندي خطط ماكرون وحكومته، ونفوذهم في
قلب الجمعية الوطنية يتعدى الصداقة مع هذا النائب أو تلك الكتلة
البرلمانية.
ولأنّ مشكلات/ أزمات/ استعصاءات، مثل هذه التي تشهدها ساحات الرأسمالية
الأوروبية المعاصرة، تتكدس تباعاً وتتفاقم باضطراد، وعلى مبدأ متصاعد؛
فإنها أقرب إلى فقاعات تواصل الانتفاخ حتى تبلغ درجة الانفجار، وتسجيل
معدّلات أعلى فأعلى من السخط والاحتجاج، ثمّ الفاقة والإدقاع المريع
مقابل التخمة والإثراء الفاحش. وإذْ كان شاهد من أهلها قد شهد ذات يوم،
بلسان الملياردير الأمريكي وارن بافيت، الذي اعتبر أنّ هذا الطراز من
الانفجارات تليق به تسمية «أسلحة التدمير المالي الشامل»؛ فإنّ شهوداً
آخرين تعاقبوا على توصيف الحال من قلب شبكات التسليم بأقداره الكاسحة
المدمّرة، والعجز بالتالي عن اقتراح الحلول العلاجية، فكيف أصلاً
بتطبيقها على الأرض إذا اعتُمدت حكومياً أصلاً. بعض البريطانيين، الذين
صوّتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51,9٪، حصون اليوم
خسائرهم ابتداء من الجيوب والمحافظ، مروراً بالحسابات المصرفية وفواتير
الطاقة والرهن العقاري ونفقات البقالية، وليس انتهاء بالتأمين الصحي؛
في مناخ (حسب المصرف المركزي البريطاني) من ركود متسارع ضاغط، بات يدفع
غلاة من دعاة «بريكست» السابقين إلى الاستنجاد بما يسمونه «النموذج
السويسري» في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي: رضوخ من دون انخراط، وتبعية
من دون انضمام !
أكبر الأوهام، وأعلاها زيفاً وخداعاً وباطلاً هو التذرّع بالاجتياح
الروسي في أوكرانيا، وانفلات أسعار الطاقة والأغذية، لأنه إذا كانت
الحرب على جبهات الاقتصاد مستعرة حقاً، ضارية إلى أقصى السلوك الهمجي،
فإنها تدور فعلياً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جانب
أوّل، وبين روسيا والصين على الجانب المقابل. ودلائلها الأوضح، لأنه
يصعب تمويهها، بادية في مؤشرات التضخم المذهلة وتخبّط البنوك المركزية
لدى الأقطاب الرأسمالية الكبرى في اللجوء إلى علاج التدمير الذاتي عن
طريق رفع معدلات الفوائد. وليس من دون دلالة منطقية صاعقة، لأنها أقرب
إلى خلاصات رياضية خارجة مباشرة من مخابر الاقتصاد، أنّ عجز حكومة ريشي
سوناك عن تعديل الأجور في بريطانيا مرتبط أيضاً بالعلاقة الطردية مع
انفلات التضخم إلى مستويات قياسية؛ في غمرة انزلاق ارتدادي هستيري نحو
حلول مارغريت ثاتشر وأزمنة أخرى غابرة من المال وراس المال واقتصاد
السوق.
على المنوال ذاته، افتُضحت واحدة تلو الأخرى أكاذيب التمويه حول أزمات
الرأسمالية المعاصرة خلال الـ 20 سنة الأخيرة فقط: تلك المعروفة باسم
dot.com crisis
في ربيع 2000، حين تفجرت فقاعة مؤشر ناسداك بنسبة 400٪ دفعة واحدة؛
وأزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة، ثمّ العالم طولاً
وعرضاً، سنة 2008؛ وأخيراً، وليس آخراً أغلب الظنّ، أزمة كوفيد ـ 19.
ومن المسلّم به أن إمبراطورية الولايات المتحدة، على أصعدة الهيمنة
الاقتصادية والعسكرية والمالية والتكنولوجية المختلفة، أخذت تواجه
منافسة مضطردة من الصين، وقليلاً بعض الشيء من كتلة الاتحاد الأوروبي،
الأمر الذي يحيل الصراعات إلى ملفات أخرى غير التنافس الجيو ـ سياسي
والصناعي؛ أي إلى ملفات الداخل، حيث مشكلات رأس المال تتقاطع أكثر
فأكثر مع المعضلات الاجتماعية ومشكلات التعاقد بين الحاكم والمحكوم،
والحقوق المدنية، وظواهر التطرف والتشنج القومي والانعزالية والعنصرية…
وتلك، وسواها كثير، فقاعات لا تتفجر مجموعة منها حتى تُخلي الساحات
والشوارع لفقاعات أخرى، وهكذا؛ على منوال يعيد التذكير بنبوءة كارل
ماركس حول رأسمالية لا تكفّ عن مراكمة التفاوت بين رأس المال والعمل،
فلا تتوقف تالياً عن… إنتاج حفّار قبرها.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
فردمان ومراثي دولة الاحتلال:
نفخ في قِرَب مثقوبة
صبحي حديدي
توماس فردمان، الصحافي الأمريكي وكاتب العمود البارز في صحيفة «نيويورك
تايمز» اعتاد النفخ في أبواق شتى تعزف ترانيم المديح لدولة الاحتلال
الإسرائيلي، كما تمزج الإطراء بما يشبه مناشدة «الواحة الديمقراطية
الوحيدة» في الشرق الأوسط أن تلازم موقعها الأثير هذا، كلما لاحت بارقة
انحراف عنه أو حتى تأخّر في تولّي مسؤولياته. لم يكن الوحيد، بالطبع،
وثمة العشرات من نافخي الأبواق إياها بصرف النظر عن تنويعات في
«النغمة» تارة، أو في سياقات الدفاع الأعمى والتنزيه الأقصى تارة أخرى؛
ليس من دون التفنّن في التلفيق والاختلاق والخداع، لدى قارئ أو مستقبِل
لا تنقصه عشوائية عمياء بدورها، في احتضان أيّ إطناب لتلك «الواحة»
الصهيونية.
لكنّ فردمان، في عدد من تعليقاته الأخيرة التي أعقبت فوز بنيامين
نتنياهو وتشكيل الحكومة الأكثر يمينية وتطرفاً وعنصرية وتشدداً دينياً
في تاريخ الكيان، بدا أشبه لنافخ في قربة مثقوبة اسمها «الليبرالية
الإسرائيلية» التي توشك على الاضمحلال؛ حتى أنه لم يتورّع عن مناشدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتدخل لإيقاف «تحوّل تاريخي» تشهده دولة
الاحتلال: «من ديمقراطية تامّة إلى شيء أقلّ، ومن قوّة توازن في
المنطقة إلى قوّة مزعزعة له. وقد تكون الوحيد القادر على منع رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالفه المتطرف من تحويل إسرائيل إلى معقل
غلوّ غير ليبرالي». وهذه فقرة واحدة من مشروع «مذكّرة» افتراضية كان
فردمان سيرفعها إلى بايدن لو قُيّض له هذا، وسيقول أيضاً إنّ دولة
الاحتلال التي عرفها بايدن «تضمحلّ» وتنبثق بدلاً عنها أخرى «جديدة»
حيث العديد من الوزراء في حكومتها «معادون للقِيَم الأمريكية، وجميعهم
تقريباً معادون للحزب الديمقراطي».
مضحكة، في المقابل، تلك الذريعة البائسة التي حرص فردمان على استرجاعها
(أنّ نسبة محدودة من الإسرائيليين هي التي منحت نتنياهو وتحالفه
تفوّقهم العددي في الكنيست) وكأنه تناسى أنّ قواعد هذه «الواحة
الديمقراطية» لا تعترف بنسبة ضئيلة أو كاسحة؛ ما دام الرقم السحري لـ
62 مقعداً مؤيداً للحكومة قد تحققت في الكنيست، وما دام الناخب
الإسرائيلي، وليس الأرواح غير الليبرالية، هي التي صنعت هامش الفارق.
ليس أقلّ إضحاكاً حرص فردمان، في مقالة/ مذكّرة المناشدة إياها، على
تذكير بايدن بأنّ نتنياهو «تآمر» مع الجمهوريين لـ«هندسة» خطبته أمام
الكونغرس في سنة 2015، على النقيض من إرادة الرئيس الأمريكي الأسبق
باراك أوباما ونائبه بايدن؛ وأنّ رجال نتنياهو يحبون رؤية جمهوري في
البيت الأبيض، ويفضّلون دعم المسيحيين الإنجيليين على اليهود
الليبراليين.
أيّ قربة مثقوبة هذه التي يخال فردمان أنّ نفخه فيها كفيل بدفع الرئيس
الأمريكي إلى «إنقاذ» دولة الاحتلال، بل الأحرى التساؤل المشروع هكذا:
هل يضحك على القارئ أم على نفسه، حين يفترض أنّ بايدن (أو أيّ رئيس
أمريكي في الواقع، منذ تأسيس الكيان الصهيوني إلى اليوم وحتى إشعار
آخر) يمكن بالفعل أن يتدخل لـ«منع» حكومة، منتخَبة وفق قواعد «الواحة»
إياها، من تنفيذ التعهدات التي على أساسها أتى بها الناخب الإسرائيلي
إلى سدّة الحكم؟ للمرء، هنا، أن ينصح فردمان بالعودة إلى معلّق آخر،
إسرائيلي هذه المرّة، سبق أن ناشد رئيساً أمريكياً إنقاذَ دولة
الاحتلال؛ مع فارق جدير بالاستذكار. ففي تعليق على واحدة من زيارات
نتنياهو إلى واشنطن، كتب جدعون ليفي متمنياً على أوباما الاقتداء
بالرئيس الأمريكي الأسبق ريشارد نكسون في إنقاذ إسرائيل، مع تمييز
حاسم: الاخير أنقذها من الجيوش العربية سنة 1973، والأوّل ينبغي أن
ينقذها من… نفسها!
كأنّ فردمان تناسى أنّ قواعد هذه «الواحة الديمقراطية» لا تعترف بنسبة ضئيلة أو كاسحة؛ ما دام الرقم السحري لـ 62 مقعداً مؤيداً للحكومة قد تحققت في الكنيست، وما دام الناخب الإسرائيلي، وليس الأرواح غير الليبرالية، هي التي صنعت هامش الفارق
فإذا أبى فردمان الاستئناس برأي ليفي، ربما لأنّ الأخير يساري مناصر
للحقوق الفلسطينية، ففي وسعه الذهاب إلى مواطنه الأمريكي دانييل بايبس؛
الليكودي الذي لم يوفّر جهداً في تأثيم أوباما أثناء أطوار الترشيح
والحملات الانتخابية، وفي رؤية العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية من
زاوية خاصة تماماً هي مآثر الصهيونية المسيحية، ذاتها التي يبغض فردمان
ما يجمعها من علاقات حبّ مع متشددي نتنياهو. ولقد اعتبر بايبس أنّ هذا
الطراز من الصهيونية هو «أفضل أسلحة» دولة الاحتلال، بالنظر إلى أهمية
نهج اليمين الأمريكي المسيحي المتعاطف، وكيف يتبنى مواقف متشددة تبدو
خيارات ساسة إسرائيليين «حمائمية» تماماً إلى جانبها. تفسيره البسيط،
أو التبسيطي تماماً في الواقع، يقول إنّ هذا النسق السياسي ـ الفلسفي،
الذي عبّر ويعبّر عنه أمثال غاري باور وجيري فالويل وريشارد لاند، يعود
بجذوره إلى العصر الفكتوري في بريطانيا؛ وتحديداً إلى عام 1840 حين
أوصى وزير الخارجية اللورد بالمرستون بأن تبذل السلطات العثمانية كلّ
جهد ممكن من أجل تشجيع وتسهيل عودة يهود أوروبا إلى فلسطين؛ هذا فضلاً
عن أنّ اللورد شافتزبري (شقيق زوجة بالمرستون وزعيم حزب الإنجيليين) هو
الذي كان، في العام 1853، قد نحت العبارة الشهيرة البذيئة في وصف
فلسطين: «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض».
يتناسى فردمان، إذْ لا يعقل أنه نسي، ما انطوت عليه زيارة نتنياهو إلى
واشنطن سنة 2015 من وقائع أخرى ليست أقلّ دراماتيكية من خطبة الأخير
أمام الكونغرس؛ بينها، على سبيل المثال، عدم اكتراث ران باراتز،
المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بأيّ لباقة بروتوكولية أو
تهذيب دبلوماسي حين وصف موقف أوباما من الاتفاق النووي مع إيران بأنه
«الوجه الحديث للعداء للسامية في الغرب والبلدان الليبرالية». أمّا جون
كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة يومذاك، فقد خصّه باراتز بهذه
الأمنية: أن يفلح في رؤية العالم بعقلية فتى عمره أكثر من 12 سنة!
الأهمّ، بالطبع، كانت ملفات تتجاوز بكثير أقوال باراتز، مثل تدعيم
«القبّة الفولاذية» التي تستقبل وتدمّر الصواريخ قصيرة المدى؛ و«مقلاع
داود» للصواريخ متوسطة وبعيدة المدى؛ وأنظمة «سهم» المضادة للصواريخ
بدورها؛ ومقاتلات
F-35A
التي تُمنح، للمرّة الأولى، إلى أيّ حليف؛ ومقاتلات
V-22،
التي تحلّق كطائرة وتهبط كحوّامة، والقادرة على بلوغ إيران؛ فضلاً،
بالطبع، عن اتفاقية مساعدة سنوية بقيمة 30 مليار دولار كانت تنتهي في
سنة 2017 وتوجّب تجديدها… إلى أجل غير مسمى!
فهل تجاسر فردمان يومئذ على التفكير في أنّ ملفات مثل توسيع الاستيطان
الإسرائيلي، أو الإمعان في تهويد القدس، أو مصادرة الأراضي، أو عربدة
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في المناطق ذاتها التي تخضع للتنسيق
الأمني مع السلطة الفلسطينية، أو وضع معظم بنود اتفاقيات أوسلو في سلّة
المهملات الإسرائيلية… يتوجب أن تُبحث خلال زيارة نتنياهو تلك؟ وهل
كانت «الليبرالية الإسرائيلية» في أحسن حال حينذاك، فما استدعت من
فردمان تسطير مقالة/ مذكّرة إلى أوباما، أو إلى نائبه بايدن؛ تناشد
الإدارة إنقاذ دولة الاحتلال؟ الثابت، الذي يتجاهله فردمان عامداً، هو
أنّ سلسلة التطوّرات السياسية الإسرائيلية الداخلية التي أعقبت توقيع
اتفاقيات أوسلو (اغتيال رابين، وانتخاب نتنياهو في غمرة تحقير شمعون
بيريس، وانتخاب إيهود باراك ضمن تحقير نتنياهو، وانتخاب شارون على
قاعدة تحقير باراك، ثمّ انتخاب نتنياهو وتحقير «كاديما» وباراك معاً…)؛
لم تكن إلا سبيل الإسرائيليين في التأكيد على أنّ نسبة ساحقة منهم لم
تخرج من الشرنقة العتيقة مرّة واحدة، ولا يبدو أنها بصدد ذلك في أيّ
يوم قريب.
عُزفت أبواق مديح «الواحة الديمقراطية» في دولة الاحتلال، أم نُفخ في
قِرَب مثقوبة ترثي «ليبرالية» موشكة على اضمحلال؛ سواء بسواء، في هذه
أو تلك!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
ليبيا: أية معجزة
تعرّف جنس الملائكة؟
صبحي حديدي
ثمة الكثير من الفوارق التي تضع الأمريكي وليام جوزيف بيرنز مدير وكالة
المخابرات المركزية الأمريكية على ضفة معاكسة، إنْ لم تكن مناقضة، مع
السنغالي عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في
ليبيا منذ أيلول (سبتمبر) 2022؛ والقواسم المشتركة بينهما، إنْ وُجدت،
فهي لا تتجاوز المسؤوليات الدبلوماسية التي تولاها الرجلان، مع حفظ
البون الشاسع الذي يفصل مهامّ أحدهما عن الآخر. صحيح أن بيرنز لم يترشح
لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة، كما فعل باتيلي على دفعتين في بلده
السنغال؛ غير أنّ موقع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وسفير
أمريكا لدى الاتحاد الروسي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية (بعض
مناصب بيرنز)، يصعب أن تُقارن بأمين ثالث لرئاسة حزب «العصبة
الديمقراطية، أو أمينه العام، أو المرتبة السادسة بمعدّل 2,21% في
الانتخابات الرئاسية السنغالية (أبرز محطات سيرة باتيلي).
فما الذي يمكن أن يحدث إذا عكفا، كلّ من موقعه واتكاءً على أولويات
وظيفته وخدمة مصالح الجهة التي تنتدبه، على إيجاد الحلول لسلسلة لا حصر
لها من تعقيدات المشهد الليبي الراهن؛ حيث السياسة تختلط بالنفط، وعبد
الحميد دبيبة رئيس حكومة طرابلس في مقابل فتحي باشاغا رئيس حكومة طبرق
الموازية، وبرلمان عقيلة صالح إزاء مجلس دولة خالد المشري، ومجلس رئاسة
محمد المنفي أمام جيش المارشال الانقلابي خليفة حفتر…؟ أم أنّ الأحرى
هو التساؤل هكذا: ما الذي سيجترحه باتيلي من معجزات عجز عن اجتراحها
ستة مبعوثين سابقين أصلاء أو وكلاء أمثال عبد الإله الخطيب، إيان
مارتن، طارق متري، برناردينو ليون، مارتن كوبلر، غسان سلامة، يان
كوبيتش، وستيفاني وليامز؟
لن يحدث الكثير أغلب الظنّ، من جانب باتيلي على الأقل، في جبهات صراعية
مثل تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 كانون الأول (ديسمبر) إلى
أجل غير معلوم، والتفاهم على قواعد دستورية للترشيح، وتحويل مباحثات
دبيبة وصالح والمشري والمنفي وحفتر من التفاوض حول جنس الملائكة إلى
أيّ من النقاط الملموسة التي تنفع أبناء ليبيا على الأرض، والحيلولة
دون مزيد من انقلاب ثنائية دبيبة/ باشاغا إلى مواجهات عسكرية دامية،
و«هندسة» صيغة ما إعجازية للتوفيق بين اشتباك التدخلات الخارجية في
الشؤون الليبية…
بيرنز، من جانبه، سجّل نقلة مشهودة في تعاطي إدارة الرئيس الأمريكي جو
بايدن مع المعضلات الليبية، فلم تعكس زيارته إلى البلد مستوى هو الأرفع
منذ تنصيب سيّد جديد في البيت الأبيض فحسب، بل كانت أيضاً بوّابة عبور
الجهاز الاستخباري الأمريكي الأعلى إلى دهاليز ليبيا. وحرص بيرنز على
الاجتماع مع الفرقاء أتاح له إطراء الدبيبة (لأسباب متعددة، لا يغيب
عنها ترحيل المواطن الليبي المتهم بالمسؤولية عن تفجير طائرة لوكربي
لمحاكمته في الولايات المتحدة)، والضغط على حفتر لتقليم (بعض، وليس
كامل!) أظافر ميليشيات فاغنر الروسية؛ وتنبيه الجميع إلى واجباتهم تجاه
حماية النفط.
ولأنّ ما بين بيرنز وباتيلي من فروقات ليس مرشحاً لأيّ طراز وشيك من
الالتئام أو التلاؤم، بالنظر أوّلاً إلى موقع واشنطن في مجلس الأمن حيث
يرتفع سلاح الفيتو فوق الرؤوس، فإنّ زيارة الأوّل العابرة وإقامة
الثاني المديدة (حتى يُعزل أو يستقيل من تلقاء نفسه) ليست أقلّ من حركة
على رقعة الشطرنج الليبي، السياسي والعسكري والنفطي والقبائلي
والميليشياتي، وبالتالي ليست أكثر كما يُرجّح. فكيف وأحجار الشطرنج
الأخرى تشارك في تحريكها أيادٍ من مصر والإمارات والسعودية وروسيا
وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا؛ ومجموعات مسلحة أو إرهابية
تمرّ من «تنظيم الدولة» المنتعش والمزدهر والمنتشر في الجنوب، ولا
تنتهي عند مرتزقة «فاغنر» الروسية ورفاقهم في الارتزاق من المجموعات
التشادية والسودانية.
فأيّة معجزة يمكن أن تعين السنغالي على الأمريكي، في أتون هذه المعمعة
حول تعريف جنس الملائكة!
تركيا الـ«صفر مشاكل»:
هل يحوم شبح داود أوغلو؟
صبحي حديدي
لم يعد ثمة الكثير من الارتياب في أنّ تركيا تواصل حصد مكاسب
دبلوماسية، لكنها في جوهرها مغانم اقتصادية واعتبارات جيو ـ سياسية لا
تخفى، من وراء الحفاظ على ميزان اتصال توافقي دقيق بين روسيا
وأوكرانيا؛ أفسحت المجال، الآن، لمستوى من التعاطي مع ملفات الحرب
الدائرة يبلغ درجة الوساطة بين موسكو وكييف، يتجاوز نجاحات صادرات
الحبوب وتبادل الأسرى إلى ما ترتيبات تفاوضية عنوانها (بالغ الطموح
والتمنّي) التوصل إلى اتفاق سلام.
في ملفات أخرى تبدو المصالحة التركية ـ الإسرائيلية، التي تُوّجت
بتبادل السفراء بعد زيارات رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتزوغ إلى أنقرة،
ووزير الخارجية التركي إلى تل أبيب، بمثابة نقلة نوعية تستكمل سيرورات
انفتاح متبادل بين تركيا وكلّ من مصر والإمارات والسعودية؛ بعد سنوات
من الخصام والقطيعة. الأعلى دراماتيكية في هذا الحراك التركي، وإنْ كان
أقلّ قيمة وأدنى مرتبة من حيث التجسيد على الأرض وفي النطاقات
الميدانية، هو استجابة أنقرة لوساطة روسية استهدفت إعادة الدفء إلى
العلاقات بين تركيا والنظام السوري؛ وقُيّض للعالم أن يستمع إلى تصريح
من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصياً، يقول فيه إنه «ليس هناك خلاف
أو استياء أبدي في السياسة»، و«يمكننا إعادة النظر مجدداً في علاقاتنا
مع الدول التي لدينا معها مشاكل. ويمكننا القيام بذلك بعد انتخابات
حزيران (يونيو)، ونكمل طريقنا وفقا لذلك».
صحيح، بالطبع، ما يسوقه غالبية مراقبي المشهد التركي من أنّ معظم هذه
الملفات، وخاصة ما يتصل باستئناف التعاطي مع النظام السوري، ذات صلة
بالانتخابات الرئاسية التركية المقبلة؛ حيث يسعى أردوغان إلى تخفيف
سلسلة من الأوجاع الداخلية الناجمة، اقتصادياً في المقام الأوّل، عن
نزوعات إدارته إلى التسخين مع الجوار والخارج عموماً؛ والسعي، في الآن
ذاته، إلى تجيير المعالجات للمشاكل المختلفة لصالح ترقية صورته في ناظر
الرأي العام التركي، أبعد من جمهوره وأنصار حزب «العدالة والتنمية»، أو
الشرائح الشعبوية التي تتلمس في شخصه ملامح سلطانية عثمانية. غير أنّ
هذا العنصر، أي انتخابات حزيران (يونيو) المقبلة، لا تطمس الأبعاد
الأخرى خلف مبادرات الانفتاح التركي، وعلى رأسها طبائع أردوغان في
التقلّب والتنقّل والتحوّل، وفي قياس الماضي والمستقبل طبقاً لمعطيات
الراهن.
وبين أن يُحكم على منهج كهذا من منطلق توصيف انتهازي، مفتقر إلى
المبدئية، ذرائعي بالمعنى الهابط للمصطلح؛ أو، على النقيض، من منطلق
التثمين العقلاني، والتبصّر، والذرائعية بالمعنى الصوابيّ للمصطلح؛ ثمة
مفارقة جلية، دراماتيكية بدورها كما يصحّ القول، تتمثل في أن تركيا
أردوغان إنما ترتدّ بذلك إلى تركيا أحمد داود أوغلو، الذي سبق له أن
تولى مناصب رفيعة مثل وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء ورئاسة «العدالة
والتنمية»؛ الذي لا يتردد كثيرون في اعتباره «كيسنجر تركيا»، واعتاد
خصومه في صفوف الأتراك القوميين في الارتياب بأنه يمثّل سياسة «نيو –
عثمانية». وأمّا مظهر الافتراق، في هذه العودة (المقنّعة حتى الساعة)
إلى أفكار الرجل وتطبيقاته الدبلوماسية، فإنها تبدأ أولاً من حقيقة
إقصائه خارج دائرة المقرّبين من أردوغان، وإبعاده عن قيادة الدولة
والحزب، ومبادرته إلى تأسيس حزبه الخاصّ الذي يحمل اسم «المستقبل»، و…
المشاركة في ائتلاف الأحزاب المناهضة لأردوغان، والمطالبة بدستور جديد
ونظام برلماني على أنقاض الرئاسي الحالي.
يبقى أنّ شبحاً يحوم حاملاً معه أطياف مبدأ مركزي في تبريد النزاعات إلى درجة الصفر، أمر مختلف عن الشبح ذاته وقد انقلب إلى خصم سياسي، حليف لتكتل أحزاب لا تروم هدفاً آخر أهمّ من الإطاحة برئاسة أردوغان، وإعادة النظام الرئاسي الحالي إلى سابق عهده البرلماني
وليس من المبالغة الافتراض بأنّ داود أوغلو هو اليوم أقرب إلى شبح يجوس
الحياة الحزبية والسياسية الداخلية في تركيا، وهو لا يستقرّ في نواة
عميقة من هواجس أردوغان شخصياً فحسب؛ بل يدفع الرئيس التركي إلى مزيد
من خطوات الخيار الشهير «صفر مشاكل»، أو النظرية الأمّ الكبرى التي
صنعت بصمة داود أوغلو في تاريخ تركيا المعاصرة.
وهذا الرجل من مواليد 1959، وقد وفد إلى السياسة من البوّابة
الأكاديمية إذْ كان أستاذاً للعلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية
العالمية في ماليزيا، وفي جامعتَيْ مرمرة وبيكنت في تركيا، واعتمد
مقاربة بسيطة في إدارة السياسة الخارجية التركية، قائمة على مبدئين ليس
أكثر. ولقد سبق له أن ناقش الخطوط العريضة للمبدأين في كتابه الشهير
«العمق الستراتيجي: موقع تركيا الدولي»، الذي صار قراءة إلزامية لكلّ
دبلوماسي على صلة بالشأن التركي، رغم أنّ الكتاب لم يكن متوفراً في أيّ
من اللغات الإنكليزية أو الفرنسية أو الألمانية. مؤلفاته الأخرى متوفرة
في لغات أوروبية، ولعلّ على رأسها كتابه «الهزّة المنتظمة والنضال من
أجل نظام دولي»، 2020؛ و«منظورات بديلة: تأثير رؤية العالم الإسلامية
والغربية على النظرية السياسية»، 1994.
المبدأ الأول، إذن، هو أنّ على تركيا إقامة روابط وثيقة ليس مع أوروبا
والولايات المتحدة فقط، رغم أهمية هذه العلاقات، بل يتوجب تطوير علاقات
متعددة المحاور مع القوقاز، والبلقان، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط،
وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والبحر الأسود، وكامل حوض المتوسط. ذلك لأنّ
تركيا ليست مجرّد قوّة إقليمية، في نظر داود أوغلو، بل هي قوّة دولية
ويتوجب عليها أن تتصرّف على هذا الأساس؛ فتعمل على خلق منطقة تأثير
تركية ستراتيجية، سياسية واقتصادية وثقافية. ولم يكن غريباً أنّ وزيرة
الخارجية الأمريكية الأسبق هيلاري كلنتون ثمّنت عالياً هذه المرونة
التركية في التعامل مع محاور مسلمة ومسيحية ويهودية، في العالم العربي
والإسلامي، وفي أوروبا وإسرائيل؛ فأطلقت على تركيا لقب «القوّة الكونية
الصاعدة».
المبدأ الثاني هو اعتماد سياسة «الدرجة صفر في النزاع» مع الجوار، من
منطلق أنه أياً كانت الخلافات بين الدول المتجاورة، فإنّ العلاقات يمكن
تحسينها عن طريق تقوية الصلات الاقتصادية. وفي الماضي كانت تركيا تحاول
ضمان أمنها القومي عن طريق استخدام «القوّة الخشنة»، «لكننا نعرف اليوم
أنّ الدول التي تمارس النفوذ العابر لحدودها، عن طريق استخدام ‘القوة
الناعمة’ هي التي تفلح حقاً في حماية نفسها»، كما ساجل داود أوغلو في
كتاباته العديدة. وهو، على أساس من هذا المبدأ، كان واثقاً من أنّ
الحاجة متبادلة تماماً بين أوروبا وتركيا: «بقدر ما صارت أوروبا محرّك
سيرورة التغيير في تركيا، بقدر ما ستصير تركيا محرّك تحويل للمنطقة
بأسرها».
والحال أنّ تلك المقاربات أعطت نتائج دراماتيكة في علاقات تركيا مع
جميع جيرانها تقريباً، وعلى حدودها الأوروبية والآسيوية، وخارج تلك
الحدود أيضاً، كما في الدور الذي سعت إلى لعبه في لبنان حين شاركت في
قوّات الأمم المتحدة التي نُشرت هناك بعد العدوان الإسرائيلي صيف 2006؛
وفي احتضان المفاوضات السورية – الإسرائيلية غير المباشرة، وإقامة
علاقة ثلاثية مع إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية وحركة «حماس»، ثمّ
القيام بجهود ميدانية مكوكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أثناء
العدوان الإسرائيلي على غزّة، واكتساب شعبية واسعة في الشارع العربي
بسبب انسحاب أردوغان من سجال مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس في
ملتقى دافوس. هذا بالإضافة إلى دور تركيا المتزايد في أفغانستان
والباكستان والهند.
يبقى أنّ شبحاً يحوم حاملاً معه أطياف مبدأ مركزي في تبريد النزاعات
إلى درجة الصفر، أمر مختلف عن الشبح ذاته وقد انقلب إلى خصم سياسي،
حليف لتكتل أحزاب لا تروم هدفاً آخر أهمّ من الإطاحة برئاسة أردوغان،
وإعادة النظام الرئاسي الحالي إلى سابق عهده البرلماني؛ فكيف وأنّ داود
أوغلو لا يبدأ المعادلة من ركائز علمانية أو أتاتوركية أو قومية، بل من
حجر أساس عالي الجاذبية، هو… رؤية العالم إسلامياً!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
اتفاق السودان الإطاري
ومحنة الاطمئنان إلى العسكر
صبحي حديدي
منذ انقلابهم في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، رفض عسكر السودان تعيين
رئيس وزراء للسودان، يخلف عبد الله حمدوك في منصب يتوجب أن يتولاه
مدنيّ طبقاً لتوافقات اقتسام السلطة مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»
ومجموعات مدنية أخرى، أعقبت انتفاضة شعبية أطاحت بدكتاتورية عمر حسن
البشير من دون استبدالها بمنظومة حكم ديمقراطية في الحدود الدنيا
المقبولة. لكنّ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وشريكه الأوّل محمد
حمدان دقلو ورهط الجنرالات الشركاء في الانقلاب لم يجدوا مشكلة، بل
انتظروا غنائم ومكاسب، في السماح لآخر رئيس وزراء في عهد البشير، محمد
طاهر إيلا، بالعودة إلى السودان بعد ثلاث سنوات من الفرار إلى مصر؛ ضمن
صفقة عقدها البرهان مع الريس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء
مباشر في القاهرة أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي.
مصلحة النظام المصري لم تقتصر على إحياء وجود «المؤتمر الوطني»، حزب
البشير المنحلّ، وإعادة زرع رموزه في السودان عموماً وفي شرق السودان
خصوصاً، وتحويل مكوّن البجا إلى معادلة تعكير ضاغطة على مسار التحولات
الديمقراطية في البلد؛ بل ثمة حاجة لدى السيسي إلى المناورة عبر شخص
إيلا لمساندة «جبهة تيغراي» وتغذية النزاع مع أثيوبيا، ضمن المناورات
الوحيدة التي يملكها السيسي للضغط في ملفّ سدّ النهضة. وعند عقد صفقة
إعادة إيلا الذي سبق أن رفض نظام السيسي تسليمه إلى السودان، كان
البرهان قد تجاهل تماماً حقيقة أنّ رجل البشير السابق مطلوب للقضاء
وثمة مذكرات جلب بحقّه وفي وسع أيّ شرطي سوداني أن يعتقله؛ وفضّل تغليب
مصالح العسكر في محاولات إغراء أنصار النظام السابق وأعضاء «المؤتمر
الوطني» وبعض الشرائح الإسلامية بالانخراط إلى جانب الجيش في المناورة
مع المدنيين.
من الإنصاف، وكذلك الصواب العقلي، تعليق قسط غير قليل من تقييم الاتفاق
الإطاري على مراحل لاحقة من مآلات التفاوض الراهنة، ريثما تتضح على نحو
أفضل حصيلة الأرباح والخسائر على الطرفين المتفاوضين؛ وفي انتظار أن
تستقرّ أكثر موازين القوى المنخرطة في الاتفاق، مقابل تلك التي تعارضه
اليوم أو سوف تواصل رفضها له إذا بلغ مرحلة التوقيع النهائي ورأى
النور. غير أنّ الإنصاف، إياه، يقتضي التوقف (الدقيق والحصيف، أو حتى
اليقظ والناقد) عند المسائل الخمس الكبرى التي تشكّل عقبات كأداء على
طريق الاتفاق: صياغات العدالة عموماً والانتقالية منها تحديداً، وكيفية
فرض الإصلاحات البنيوية على مؤسسات الجيش والأمن، وإعادة وضع اتفاق
السلام على محك المراجعة البناءة، وبلورة آليات ملموسة لتفكيك النظام
السابق، وإيجاد حلول آنية ودائمة لمشكلات شرق السودان.
ثمة، إلى هذا، معضلة كمونية إذا جاز التعبير، لأنّ افتراض منطق تفاوضي
بين العسكر والمدنيين يفترض أيضاً طرازاً ما، أياً كانت حدوده، من
التكافؤ المتبادل بينهما؛ ويتحكم، استطراداً، بما يمكن أن يتوصلا إليه،
على قاعدة الحقّ أو الباطل، الربح هنا والخسارة هناك، المصداقية
والالتزام مقابل النقض والانقلاب؛ وهذه بعض مظاهر محنة معقدة في
الاطمئنان إلى العسكر… وإذا كانت صفقات مثل تلميع إيلا غير طارئة ولا
غريبة عن الجنرالات في أية سلطة انقلابية عموماً، ولكن في أنظمة
الانقلابات العسكرية العربية والأفريقية بصفة خاصة؛ فإنها، في الآن
ذاته، يتوجب أن تنفع مجموعة المجلس المركزي في «قوى إعلان الحرية
والتغيير»، والأطراف المدنية الموافقة على الاتفاق الإطاري مع العسكر،
في تبصّر المخاطر المحتملة والكامنة طيّ أية مقايضة مع الجيش، ذاته
الذي قاد انقلاباً قائماً وعواقبه الوخيمة تُقعد البلد اقتصادياً
واجتماعياً وسياسياً.
فالمنطق يصادق على، وتجارب الماضي القريب والبعيد أثبتت وتواصل إثبات،
جشع الجنرالات إلى السلطة، والتسلط والهيمنة؛ وإذا لم تسعفهم المناورات
والمساومات والصفقات، فإنّ خيار انقلاب جديد يظلّ قائماً وميسّراً
ومغرياً… حتى إشعار آخر لا تلوح له نهاية.
تنويعات الديمقراطية:
ما تبقى من «سنة العجائب» 1989
صبحي حديدي
الـ«V-Dem»،
أو «تنويعات الديمقراطية» في تسمية أخرى، معهد يزعم أنه مستقلّ وإنْ
كان لا يخفي مصادر تمويل متعددة من منظمات حكومية والبنك الدولي
ومؤسسات أبحاث مختلفة؛ أسسه في سنة 2014 الأكاديمي السويدي ستافان
لندبرغ، ومقرّه في جامعة غوتنبرغ، السويد؛ وهو يصدر تقارير سنوية حول
أحوال الديمقراطيات في العالم بأسره، ويعتمد في أشغاله على أبحاث
ميدانية ومكتبية يتولاها نحو 3700 باحثة وباحث في أصقاع مختلفة، وتغطي
202 من بلدان المعمورة، وتشمل دراساتها نماذج ديمقراطية وأنساق حكم
وسلطة شهدها التاريخ بين سنة 1789 وحتى اليوم، كما هي حال التقرير
الأخير لسنة 2022.
وقد تكتنف عمل المعهد مظانّ كثيرة، متغايرة ومتنوّعة ومتقاطعة، إلا أنّ
التقارير السنوية ليست بالغة الفائدة لجهة ما توفّره من أرقام ومؤشرات،
فحسب؛ بل يبقى المعهد، حتى إشعار آخر وظهور نموذج أفضل، فريداً في
اعتبارات شتى تبيح درجة غير ضئيلة من الاطمئنان إلى معطياته. وهكذا،
طبقاً للتقرير الأحدث، تتصدّر لائحة النماذج 10 حكومات (من أصل 179
دولة)، هي السويد والدانمرك والنروج وكوستا ريكا ونيوزلندا وإستونيا
وسويسرا وفنلندا وألمانيا وإرلندا؛ وأما في المراتب الدنيا فالدول
العشر هي طاجكستان والسعودية والصين وتركمانستان وسوريا وبيلاروسيا
واليمن وأفغانستان وكوريا الشمالية. جديرة بالملاحظة، أيضاً، أنّ ما
يُصطلح على تسميتها «ديمقراطيات مستقرة»، غربية غالباً، تأتي في مراتب
حمّالة دلائل عديدة: فرنسا، في المرتبة 16؛ بريطانيا، 19؛ إيطاليا، 20؛
كندا، 24؛ آيسلندا، 25؛ النمسا، 26؛ الولايات المتحدة، 29؛ اليونان،
36؛ دولة الاحتلال الإسرائيلي، 41؛ ورومانيا، 44…
المؤشرات الأخرى تقول إنّ سنة الأساس 2021 سجّلت رقماً قياسياً لعدد
الأمم التي خضعت لأنظمة أوتوقراطية (والمصطلح هنا يُعتمد على سبيل
التضاد مع الديمقراطية)، بالمقارنة مع 50 سنة خلت: 33 بلداً، تأوي 36٪
من سكان الأرض، نحو 2.8 مليار نسمة؛ والمؤشر الأبرز، في ظنّ هذه
السطور، قد يكون حصّة الاتحاد الأوروبي من موجة الأوتوقراطية هذه، إذْ
انحدرت إليها نسبة 20٪ من الدول الأعضاء. ولم يسجّل العالم هذا العدد
القليل من عمليات الدمقرطة منذ العام 1978، فبلغ العدد في سنة الأساس
15 بلداً، تأوي 3٪ فقط من سكان الأرض. وتزايد قمع المجتمع المدني في 22
بلداً، وفَرْض الرقابة على وسائل الإعلام في 21 بلداً، وتوسّعت نزوعات
العداء للتعددية الحزبية في 6 من البلدان الأكثر ميلاً إلى
الأوتوقراطية (البرازيل، هنغاريا، الهند، بولندا، صربيا، وتركيا).
يتوقف التقرير أيضاً عند ظاهرة يطلق عليها تسمية «وباء الانقلابات»،
إذْ شهدت سنة الأساس إجراءات انقلابية لتوطيد الأوتوقراطية في 40
بلداً، وخمسة انقلابات تحمل الصفة الصريحة في ارتفاع حادّ لهذا القرن
بالقياس إلى معدّل 1.2 في القرن الماضي، أسفرت عن تأسيس أوتوقراطيات
جديدة منغلقة في تشاد وغينيا ومالي ميانمار؛ وهذا «الوباء» انطوى أيضاً
على أشكال مختلفة من تسميم الوعي، وتنظيم حملات تضليل الرأي العام
المحلي والعالمي لصالح تجميل الانقلابات. ومستوى الديمقراطية الذي تمتع
به المواطن الكوني، كما يصفه التقرير، خلال سنة الأساس هبط إلى مستويات
1989، وبالتالي فإنّ الـ30 سنة الأخيرة من مظاهر التقدّم الديمقراطي
تتآكل اليوم؛ فينخفض عدد «الديمقراطيات الليبرالية» إلى 34 في سنة
الأساس 2021، وهذا معدّل لم يسبق له مثيل منذ 26 سنة.
تحظى تقارير المعهد بقيمة تفاضلية وعملية عالية، لجهة المؤشرات والمعطيات وما هو ميداني منها بصفة خاصة؛ ولكنها في الآن ذاته لا تمنح رخصة تفويضية لتخليص الديمقراطية الليبرالية من آثام إغلاق الواقع حول ذهن واحد أحادي… لاديمقراطي، في الجوهر والمآل
ويعترف المعهد، ويبني تقاريره على أساس، أنّ مفهوم الديمقراطية تطوّر
كثيراً منذ ولادة المصطلح لدى الإغريق، وأنه يستخلص تقديراته اتكاءً
على ما يقارب 450 من الجوانب المختلفة التي تكتنف المفهوم وتنويعاته؛
لكنه، من دون تجاهل الأشكال الأخرى للتمثيل والانتخاب، يأنس إلى ما
يسمّيه «مؤشر الديمقراطية الليبرالية»، الذي يجمع بين المؤسسات
الانتخابية الأمّ، مع الجوانب الليبرالية الأخرى التي تضمّ الضوابط
التنفيذية الناجمة عن التشريع والمحاكم العليا، إلى جانب سيادة القانون
والحقوق الفردية. في ضوء ذلك، يصنّف المعهد أنظمة العالم في أربعة
أنماط متمايزة: نمطان من الديمقراطية (الانتخابية والليبرالية)، ونمطان
من الأوتوقراطية (الانتخابية والمغلقة). وكي يُعتبر ديمقراطياً في
الحدود الدنيا، ضمن نمط الديمقراطية الانتخابية، فعلى البلد أن يلبّي
مستويات عليا كافية من انتخابات حرّة ونزيهة واقتراع عامّ، وحرّية
تعبير واجتماع؛ وبالتالي فإنّ تنظيم انتخابات لا يكفي في ذاته لحيازة
الصفة الديمقراطية. ففي الأنظمة الأوتوقراطية الانتخابية، تتوفر مؤسسات
مختصة بمحاكاة انتخابات لا ترقى إلى العتبة الدنيا للديمقراطية، بمعنى
المصداقية والكيفية.
والحال أنّ في رأس المظانّ التي يمكن أن تجابه هذه المنظومة، وربما بعض
الركائز الكبرى في منهجية المعهد، ما يقوله عدد غير قليل من كبار
المفكّرين الغربيين الذين عكفوا على قراءة، أو بالأحرى إعادة قراءة،
دروس عام أساس آخر؛ هو 1989، أو «سنة العجائب» كما شاء البعض توصيفها،
لأنها شهدت سقوط جدار برلين وثورة تشيكوسلوفاكيا وإسقاط نظام شاوشيسكو
في رومانيا، والتمهيد لانحلال الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي
بأسره. بين هؤلاء المفكرين يبرز البريطاني جون غراي، صاحب سلسلة مؤلفات
إشكالية وسجالية مثل «الفجر الزائف: ضلال رأسمالية العولمة»، و«يقظة
الأنوار: السياسة والثقافة عند خاتمة العصر الحديث»، و«هرطقات: ضدّ
التقدّم وأوهام أخرى»، و«روح مسرح الدمى: تحقيق موجز حول الحرّية
الإنسانية»، فضلاً عن كتابه الأشهر ربما: «كلاب من قشّ: أفكار حول بني
البشر وحيوانات أخرى».
وفي مقالة لامعة بعنوان «إغلاق الذهن الليبرالي»، ذات صلة بمظان» معهد
الـ»V-Dem»،
يبدأ غراي من استعراض مشهد كوني عناصره أوروبا وحروب التبادل ودونالد
ترامب وفلاديمير بوتين وأمواج اللجوء والصين وحصار حلب السورية…؛ لكي
يبلغ خلاصة أولى تقول: «النظام الليبرالي الذي لاح أنه ينتشر عالمياً
بعد نهاية الحرب الباردة، يتلاشى من الذاكرة». ورغم اتضاح هذا التلاشي،
يوماً بعد آخر، فإنّ الليبراليين يجدون صعوبة في مواصلة العيش من دون
«الإيمان بأنهم في الصفّ الذي يحلو لهم اعتباره الصواب في التاريخ»؛
وبالتالي فإنّ إحدى كبريات مشكلاتهم أنهم لا يستطيعون تخيّل المستقبل
إلا إذا كان استمراراً للماضي القريب! وحين يختلف الليبراليون حول
كيفية توزيع الثروة والفرص في السوق الحرّة، فالمدهش في المقابل أنّ
أياً منهم لا يُسائل نمط السوق المعولَمة التي تطورت خلال العقود
الثلاثة الأخيرة.
وبعد الاستفاضة في مناقشة أزمة الليبرالية المعاصرة كما كانت يومذاك
تتجلى في بريطانيا، عبر محورَيْ أزمة حزب العمال والتصويت على الخروج
من الاتحاد الأوروبي؛ يردّ غراي السجال إلى جذور الفكر الليبرالي
الحديث، في أنه نتاج متأخر من التوحيدية اليهودية والمسيحية: «من
تقاليد هذَيْن الدينَيْن، وليس من أيّ شيء في الفلسفة الإغريقية، نبعت
القِيَم الليبرالية حول التسامح والحرية. وإذا ساد اليقين بأنها قيم
كونية، فذلك بسبب الاعتقاد بأنها فرائض إلهية. ومعظم الليبراليين
علمانيون في النظرة العامة، لكنهم يواصلون الإيمان بأنّ قيمهم إنسانية
وكونية». المعضلة، بعد هذا التوصيف، أنّ الذهن الليبرالي الحاضر عاجز
عن الاشتغال إلا إذا أغلق الواقع، أو عرضه كبضاعة أحادية، في المتجر
الليبرالي الوحيد!
وبهذا المعنى، في صيغة مظانّ طاعنة، تحظى تقارير المعهد بقيمة تفاضلية
وعملية عالية، لجهة المؤشرات والمعطيات وما هو ميداني منها بصفة خاصة؛
ولكنها في الآن ذاته لا تمنح رخصة تفويضية لتخليص الديمقراطية
الليبرالية من آثام إغلاق الواقع حول ذهن واحد أحادي… لاديمقراطي، في
الجوهر والمآل.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
البكاء على أطلال )برافدا(
صبحي حديدي
زائر موقع النسخة الإنكليزية من صحيفة «برافدا» الروسية سوف يجد الموضوعات التالية على صفحة الاستهلال: «أوكرانيا حائرة بسبب قرار بوتين وقف إطلاق النار في عيد الميلاد»، و»زيلنسكي يذهب إلى واشنطن من أجل الجنسية الأمريكية، وحسابات المصارف، والأملاك في فلوريدا»، و»المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو مسألة أسابيع»، و»رجب أردوغان يريد من روسيا أن تجعل أوروبا معتمدة على تركيا»، و»عقيد أمريكي متقاعد: روسيا أقوى من بلدان الناتو مجتمعة»، و»تركيا أردوغان لن تربح الحرب في سوريا، وأمريكا ستفشل أيضاً»… فإذا ذهب المرء إلى صفحات الرأي، فسيجد الموضوعات التالية: «إعادة تعريف أوكرانيا: المعنى الحقيقي لمبدأ السلاح من أجل السلام»، و»حكم الغباء: شكل من الديمقراطية الغربية الحديثة»، و»أعمال الشغب الإيرانية: الذهاب وراء حجاب الدعاية الغربية»، و»كان الغرب يحاول التهام سوريا، لكنه كسر أسنانه»…
هذه، كما يقتضي إيضاح ضروري لا يحتمل التأجيل، ليست «برافدا» الأخرى
الناطقة بالروسية، والتي يمتلكها الحزب الشيوعي في الاتحاد الروسي،
ولكن كلا الأختَين سبّاقة إلى سوية مماثلة من حيث نهج التحرير وخطوط
الولاء لسياسات الكرملين؛ على صعيد مختلف المغامرات العسكرية الخارجية،
في جورجيا والقرم وسوريا وليبيا، قبل اجتياح أوكرانيا. والتاريخ الموجز
للصحيفة الأمّ يشير إلى أنها كانت ناطقة باسم الحزب الشيوعي السوفييتي،
وتوزّع ملايين النسخ يومياً؛ وعند انحلال الاتحاد السوفييتي، باعها
الرئيس الروسي الأسبق يلتسين بوريس يلتسين إلى مجموعة استثمارية
يونانية، وهذه أصدرت الطبعة الدولية اعتباراً من عام 1996. في السنة
ذاتها، بسبب إصرار الحزب الشيوعي الروسي على إصدار «برافدا» من جانبه،
انتهى القضاء الروسي إلى منح الترخيص للجهتَين باستخدام الاسم ذاته.
هل هذه هي «برافدا»، أو ما تبقى من تراثها أياً كانت معادلات التوازن
بين الباقي والمندثر؟ كلا، بالطبع، إذْ من العبث أن يبحث المرء في
النسختين، الروسية والدولية، عن رسوبات تتواصل من أيام زمان، ليس لأنّ
العالم تبدّل في روسيا، وحيثما توزّع هذه الـ «برافدا» الجديدة، فحسب؛
بل لأنّ المعارك المالية والقانونية الشرسة التي توجّب أن تُخاض من أجل
بقاء الصحيفة واستمرار الاسم ذاته اقتضت مثل هذه الخيارات في التحرير،
وفي الخبر والرأي والتغطية. ومن الإنصاف القول إنّ قلّة قليلة فقط من
الروس، أهل الحنين إلى الماضي والبكاء على الأطلال، هم وحدهم الذين
يعيبون على هذه الـ»برافدا» أنها، أو أختها التي تحمل الاسم ذاته، لم
تعد تمثّل تلك الصفحات الماضية من تاريخ الصحيفة.
المرء، من جانب آخر، لا ينصف هؤلاء أنفسهم إذا لم يتفهم الأسباب
العميقة، الوجدانية والتاريخية والعقائدية، التي تدفعهم إلى مقدار هائل
من مشاعر النوستالجيا كلما قلّبوا صفحات الجريدة الراهنة، فلم يجدوا
فيها ما هو أشدّ جاذبية للقرّاء من طرائف العقيد الأمريكي المتقاعد أو
حكاية أسنان الغرب التي تكسرت خلال محاولة التهام سوريا. ذلك لأنّ
«برافدا» التاريخية، تلك التي انطلقت سنة 1912 قبل أن تصبح في سنة 1918
ناطقة باسم حزب البلاشفة والثورة الروسية، لم تكن محض مطبوعة سياسية؛
بل كانت أشبه بسجلّ وأرشيف وخزّان ذاكرة، سيّما عند أولئك الذين ما
تزال حميّة الماضي تغلي في عروقهم.
ولعلّ الصحيفة عرفت من المصائر المتقلبة مقداراً يكاد يفوق ما عرفه
الحزب الشيوعي السوفييتي ذاته، وحين أخذت أرقام توزيعها تتجاوز 11
مليون نسخة يومياً، كانت مصداقية الصحيفة تهبط إلى الحضيض في يقين
الرأي العام، وكانت تحكمها علاقة تناسب معاكسة: كلما طبعت المزيد من
النسخ، ازدادت الهوة بينها وبين الشارع. والمرء هنا يتذكر أنّ الإعلام
الرسمي السوفييتي توزّع على صحيفتين أساسيتين: «البرافدا» (أي:
الحقيقة) و»الإزفستيا» (أي: الخبر)؛ ولكنّ النكتة الشعبية، الذكية
والصائبة تماماً، تولّت تثمين المطبوعتين هكذا: في «برافدا» لا يوجد
«إزفستيا»، وفي «إزفستيا» لا توجد «برافدا». والترجمة: جريدة الحقيقة
لا تنطوي على الخبر، وجريدة الخبر لا حقيقة فيها!
يبقى أنّ حكاية «برافدا» الراهنة تتجاوز البكاء على أطلال «برافدا»
الأولى الأصلية، أو الأحرى أن تدور دروسها حول علاقة الصحافة ذات النسخ
المليونية بالشارع المستقبِل الذي لا يُعدّ بالملايين أيضاً فقط، بل
تظلّ صناعة الرأي في صفوفه مسألة بالغة التعقيد، سياساً واجتماعياً
وإعلامياً وثقافياً. ولم يكن غريباً، في ضوء مقاربة كهذه، أن يُصدر
الصحافي الأمريكي الانشقاقي جيمس أوكيف، في سنة 2018، كتاباً مدويّ
التأثير بعنوان «برافدا أمريكية: معركتي من أجل الحقيقة في عصر الأخبار
الزائفة»؛ فضح على امتداد فصوله عشرات النماذج لإعلام أمريكي مليونيّ
الجمهور وكونيّ الانتشار، مرئيّ ومقروء وإلكتروني، يكذب ويلفّق ويختلق
طبقاً لطرائق تجعل سُنن «برافدا» و»إرفستيا» العتيقة أشبه بألاعيب
أطفال.
وكما يبدو لافتاً أنّ موضوعات موقع «برافدا» الدولية تستخفّ تماماً
بعقول زائر الموقع، الروسي والدولي في واقع الأمر، فإنّ موضوعات وسائل
إعلام أمريكية عملاقة لا تتورّع عن ممارسة الاستخفاف ذاته، أو أشدّ منه
وأكثر مكراً وحذقاً؛ وفي الحالتَين، وسواهما كثير في طول العالم وعرضه
أياً كانت طبائع الأنظمة الحاكمة، ينقلب البكاء على الأطلال إلى سيرورة
إدراك لاستغفال الذات، وبعض الإمعان فيها… مع ذلك!
أمريكا الحزب الجمهوري:
استعصاء (أسلحة الإيهام الشامل)
صبحي حديدي
حتى ساعة كتابة هذه السطور، كان النائب الجمهوري كيفن مكارثي قد فشل في
حيازة الـ218 صوتاً التي تكفل له رئاسة مجلس النواب الأمريكي، وذلك بعد
ستّ جولات متعاقبة من تصويت أظهر تمترس 20 من زملائه النوّاب
الجمهوريين؛ «العصاة» كما باتت تسميتهم الشائعة في الإعلام الأمريكي،
الصقور بالأحرى ممّن يريدون رئيساً أكثر تشدداً في مواجهة الحزب
الديمقراطي والرئيس جو بايدن، وليس البتة أكثر صوناً للقِيَم المحافظة
التي يتوافق عليها الحزب الجمهوري وأنصاره. وحتى تتعالى سحابة دخان
أبيض من مداخن الكابيتول دلالة على انتخاب مكارثي او سواه (مجازاً
بالطبع، ومع الاعتذار من تقاليد الفاتيكان)؛ ثمة مقادير أخرى من مظاهر
انحدار هذا الحزب، خاصة وأنّ مهندس الانحطاط الحالي الأبرز، الرئيس
الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم يهضم هو نفسه هذا الفشل في انتخاب
رئيس للمجلس، في استعادة لسابقة لم تتكرر منذ 100 سنة.
بين مظاهر الانحطاط الأخرى حكاية النائب الجمهوري جورج سانتوس، الذي
فاز خلال انتخابات الكونغرس التكميلية الأخيرة عن لوغ آيلاند، والذي
حشد في سيرته الرسمية سلسلة من الأكاذيب المريعة: عن أماكن عمل في
مؤسسات مرموقة، لم يسبق له أن اشتغل فيها؛ عن كليات زعم الدراسة فيها،
منتحلاً المعلومة؛ وعن والدته، التي تفاخر بأنها قُتلت في مكتبها في
البرج الجنوبي يوم 11/9، واتضح أنها توفيت بمرض السرطان على فراشها…
صحيح أنّ نوّاباً آخرين عن الحزب الجمهوري كذبوا في سيرهم الرسمية، على
شاكلة هيرشل ووكر المرشح (الفاشل) لمجلس الشيوخ عن جورجيا، الذي اتضح
أنه متهم بالعنف المنزلي، وإجبار عشيقاته على الإجهاض، وتلفيق عناوين
منزلية غير صحيحة، والتخلي عن أطفال غير شرعيين، وتزييف شهادات
أكاديمية لم يحصل عليها. لكنّ مصيبة سانتوس، التي ذهب فيها أبعد من
جميع أسلافه الكاذبين، أنه زعم محتداً يهودياً من أمّه؛ واضطرّ فيما
بعد (حين فضحت صحيفة «نيويورك تايمز» سلسلة الأكاذيب) إلى الإقرار بأنه
كان ويظلّ كاثوليكياً.
خيط طريف في حكاية سانتوس أنّ القضاء الأمريكي وقف حائراً بضعة أيام
بعد افتضاح التفاصيل، قبل أن يضطر الادعاء في مقاطعة ناسو إلى التصريح
بأنّ من حقّ ناخبي سانتوس أن يكون لديهم في الكونغرس «ممثّل شريف وخاضع
للمحاسبة»، ولا أحد «فوق القانون، وإذا ارتُكبت جناية في هذه المقاطعة
فلسوف نحقق فيها». ومع ذلك فإنّ التصريح شيء، وإخضاع نائب منتخب
للمحاسبة القضائية شيء آخر مختلف، إنْ لم يكن بسبب تعقيدات قانونية
أقرب إلى متاهة كافكاوية في هذا المضمار، فعلى الأقلّ لأنّ الجمهوريين
في الكونغرس غارقون في هرج ومرج بصدد انتخاب رئيس لأغلبيتهم، أوّلاً؛
ثمّ ثانياً لأنّ سانتوس يدين في انتخابه بالكثير إلى مساندة مكارثي،
إياه، الذي يتمرد عليه 20 من غلاة الجمهوريين. وأمّا في الخلفية
الأبعد، والأعمق أيضاً، فإنّ قسطاً غير ضئيل من مظاهر الانحطاط سالفة
الذكر لا تقتصر على الحزب الجمهوري، بل تشمل نظيره وخصمه الحزب
الديمقراطي؛ وفي مسلسل أكاذيب السِيَر ليس المرء مضطراً للذهاب خارج
البيت الأبيض الراهن، إذْ أنّ جو بايدن نفسه يتصدر لوائح التزييف
والكذب.
وقد لا تكون مصادفة، أو هي واقعة خالية من دلالات تزامنية شتى عميقة
الغور، أنّ فشل الجولة السادسة لانتخاب مكارثي رئيساً جمهورياً لمجلس
النواب يأتي على أعتاب الذكرى الثانية لاقتحام مبنى الكابيتول، يوم 6
كانون الثاني (يناير) 2021؛ حين لاح أنّ الترامبية إنما تبلغ ذروة
الهستيريا الجَمْعية، البيضاء، الانعزالية، العنصرية، المتشددة دينياً
والمغالية في الولاء ليمين محافظ متعصب؛ وأنّ الأمريكي السبعيني الذي
اهتاج وانتشى وهو يدوس رموز ديمقراطية آبائه وأجداده، كان يكمل سعار
الأمريكي العشريني أو الثلاثيني الذي لم يعد يحفظ من «الحلم الأمريكي»
إلا أقنعة الكواسر. ذلك لأنّ 12 من النوّاب الـ20 «العصاة» اليوم،
كانوا ساعة اقتحام الكابيتول من المصفّقين ضمناً لأنهم أصلاً رفضوا
نتيجة الانتخابات الرئاسية واعتبروا أنّ ترامب وليس بايدن هو الفائز،
وهو رئيسهم الشرعي؛ و19 منهم أعضاء في «تجمّع الحرّية»، الذي أسسه عدد
من نوّاب الحزب الجمهوري سنة 2015 ويُعدّ الأشدّ يمينية وتشدداً في
تاريخ محلس النوّاب.
فهل يصحّ القول، بصدد حاضر الحزب الجمهوري قياساً على ماضيه القريب: ما
أبعد اليوم عن البارحة؟ ليس تماماً، أو بالأحرى ليس ضمن أيّ معدّلات
مقارنة تضع على المحكّ معايير السلوك السياسي والاجتماعي والاقتصادي
والإيديولوجي؛ ليس لأيّ اعتبار آخر يسبق الحقائق الأبعد والأعمق في
طبائع المنظومة الحزبية الأمريكية، عند الجمهوريين مثل الديمقراطيين،
وبدرجات عالية من التبادل والتكافل. ففي مثل هذه الأيام، ولكن قبل 27
سنة، وقع اختيار أسبوعية «تايم» الأمريكية على البروفيسور نيوتن ليروي
ماكفرسن (غنغرش) ليكون رجل العام؛ لأنه يومها كان أبرز وجوه الحزب
الجمهوري، رئيساً للكونغرس، وصانع ضجيج منتظم يكفي لإبقائه في سدّة
الحدث اليومي وعلى خشبة المسرح الأكثر اجتذاباً للأنظار. إلى هذا وذاك،
كان غنغرش أحد أبطال «العقد مع أمريكا»، أو ذلك البيان الانتخابي الذي
تبارى على توقيعه مرشحو الحزب الجمهوري في انتخابات تلك السنة، كمَنْ
يتناوب على شعائر الإخصاب وإحياء الأرض الموات. وإلى جانب السياسة
والكونغرس، كان غنغرش أستاذ التاريخ الحديث، والروائي المولع بقصص
الخيال العلمي ـ التاريخي، وأطول المحافظين الجدد لساناً في كلّ ما
يتصل بالأخلاق والقيم والأعراف.
وأمّا العنصر الأهمّ وراء صعود نجمه فقد كان احتفاؤه المفرط، إلى درجة
الهوس، بثوابت القيم الأمريكية، والموقع الاستثنائي لتلك القيم في
السلّم الأخلاقي للإنسانية؛ بحيث أنه أعطى التكنولوجيا المعاصرة فرصة
إشاعة وترسيخ وإحياء القيم القديمة، قبل تجديدها كرموز سارية المفعول
في الوجدان والانضباط العام. والتاريخ، في ذلك كله، ملزَم بتعليمنا
الدروس ذاتها التي تعلّمها بنيامين فرانكلين وألكسيس دو توكفيل، كما
ساجل مراراً؛ والجمهوريون مطالبون بتكرار صرخة باتريك هنري (المحامي
والمزارع والحاكم الأمريكي ابن القرن الثامن عشر): «أعطني الحرّية، أو
فاعطني المنيّة»! وعنده أنّ خمسة أسباب تستوجب دراسة التاريخ الأمريكي:
التاريخ ذاكرة جمعية، والتاريخ الأمريكي هو تاريخ الحضارة الأمريكية في
الآن ذاته، وذلك كله ينطوي على امتياز استثنائي تنفرد به أمريكا عن
التاريخ الإنساني العام، والتاريخ مصدر يعلّمنا بقدر ما يسمح لنا
باستخدامه، والتجربة التاريخية تساعدنا في استخراج طرائق جديدة لحل
المشكلات الراهنة.
غير أنّ غنغرش وقّع كتاباً بعنوان «إعادة اكتشاف الله في أمريكا»،
وانقلب ذاتياً إلى سوط مسلط على رؤوس «خونة» ترامب في صفوف الجمهوريين؛
ولهذا فللمرء حقّ مشروع في تلمّس ظلّه خلف «عصاة» هذه الأيام، ومقدار
الارتباط بين صعود ترامب، وانحطاط الحزب، وشيوع الأكاذيب وانتشارها
كالنار في الهشيم. والغالبية من رفاقه، منظّري عقائد الحزب الجمهوري
الحديث بصفة خاصة، الذين اختار لهم المؤرخ الأمريكي روبرت درابر صفة
باعة «أسلحة الإيهام الشامل»، انقلبوا ذاتياً بدورهم إلى سماسرة تبعثرت
وظائفهم بين خدمة ترامب والخنوع لاشتراطاته من جهة؛ واضطراب عاصف يضرب
جهاز الحزب ونوّابه وأنصاره، في قلب الكونغرس، من جهة ثانية. هي حال
استعصاء بالطبع، لكنّ ما يستعصي في بواطنها ليس أعراض اعتلال عضوي
يتفشى في الحزب الجمهوري وحده، بل هي سيرورات تتكاثر وتتنامى وتتفاقم
في الحزب الديمقراطي أيضاً، أقلّ ربما ولكن على قدم المساواة في ظواهر
عديدة.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
حصاد سوريا 2022:
مشاقّ وارتهان وعربدة إسرائيلية
صبحي حديدي
أكثر من واجب واحد، أخلاقي أولاً لكنه أيضاً يخصّ السياسة والاجتماع
الإنساني، يقتضي بدء حصاد سوريا للعام 2022 من تقارير منظمة «الدفاع
المدني السوري»، أو «الخوذ البيضاء» في التسمية الأخرى: استشهاد 165
شخصاً، بينهم 55 طفلاً و14 امرأة، جراء أكثر من 800 هجوم على شمال غربي
سوريا، شنته قوات النظام السوري والقاذفات الروسية ومفارز «الحرس
الثوري» الإيراني و»حزب الله» والميليشيات العراقية والمذهبية الأخرى
الموالية لطهران. وتنوعت الضربات بين 63 غارة جوية جميعها روسية، وأكثر
من 550 هجوماً بالقذائف المدفعية، و54 هجوماً صاروخياً بينها 3 هجمات
بصواريخ أرض ـ أرض محملةً بقنابل عنقودية، إضافة إلى 28 هجوماً
بالصواريخ الموجهة؛ وحسب المنظمة، فقد تركزت الهجمات بشكل خاصّ على
المراكز الحيوية والمنشآت المدنية ومقومات الأمن الغذائي. ارتُكبت، إلى
هذا، 9 مجازر في أنحاء مختلفة من سوريا، راح ضحيتها 73 شخصاً بينهم 29
طفلاً و8 نساء، وأُصيب 174 آخرون؛ وهنا أيضاً تقصد النظام وحلفاؤه
استهداف الأسواق الشعبية والمخابز والمباني العامة وبعض المشافي
والمستوصفات، ومخيمات اللجوء.
الأشدّ قبحاً وبشاعة وانحطاطاً في الغالبية العظمى من هذه الهجمات
أنها، على صعيد النظام، تسعى إلى شحن ما تبقى من قوّات تابعة لجيشه
ببعض أسباب الوجود كوحدات عسكرية، فضلاً عن شحن النفوس التائهة المريضة
بمزيد من الأحقاد الانتقامية والمناطقية التي لا يغيب عنها عنصر الشحن
الطائفي. على الصعيد الروسي، ثمة استمرار لنهج وضع الأسلحة الروسية
الفتاكة في حال من التجريب الميداني المفتوح، خاصة تلك الأصناف التي
تستحدثها مصانع الجيش الروسي ولا تجد الساحات الملائمة لاختبارها، سواء
في ميادين التدريب الروسية أو في جبهات أوكرانيا المختلفة. ولم يكن
استثناء أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب جنوده، خلال اجتماع مع
القيادات العسكرية الروسية، بأن يطبقوا في أوكرانيا ما تعلموه في
سوريا. إيران والميليشيات تستأنف الخيارات ذاتها التي اعتمدتها منذ
دخولها طرفاً مباشراً في القتال إلى جانب النظام السوري، وإلى جانب
التوسع وإنشاء القواعد العسكرية الميدانية، لا يوفّر أتباع طهران جهداً
في تفكيك ما تبقى من تماسك مجتمعي في قرى سوريا وأريافها بصفة خاصة،
والسعي إلى التبشير والتشييع والتطويع.
طراز آخر من الهجمات وعمليات القصف تعرضت وتتعرّض له مناطق مختلفة في
سوريا، تمثله هذه المرّة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أهداف
إيرانية مباشرة أو تابعة لميليشيات موالية لطهران؛ وبات من المعتاد أن
تُنفّذ ضمن سياقَين من الصمت المشترك، سواء من جانب الرادارات الروسية،
حتى حين تقترب الضربات من الساحل السوري والقواعد الروسية في مطار
حميميم وميناء طرطوس؛ أو من جانب الصواريخ والمسيرات الإيرانية،
المنتشرة داخل سوريا أو في عهدة «حزب الله». في أواخر كانون الثاني
(يناير) أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، وفي
مطلع شباط (فبراير) أغار على مواقع في محيط دمشق وضرب بصواريخ أرض –
أرض أهدافاً في الجزء السوري من الجولان المحتل، وبعد أيام قليلة خلال
الشهر ذاته قصفت دولة الاحتلال نقاطاً في تخوم مدينة القنيطرة، وفي
مطلع آذار (مارس) استهدفت محيط مدينة دمشق مجدداً، وفي 14 و27 نيسان
(أبريل) تكررت الضربات قرب العاصمة وفي عمق الجولان.
بين رحيل قَتَلة أمثال علي حيدر وذو الهمة شاليش، ومهازل عودة مجرم الحرب الأشنع رفعت الأسد إلى «حضن الوطن»، ومساخر فيديوهات تمساح الفساد رامي مخلوف؛ حملت سنة 2022 الكثير من العلامات الفارقة على اختتام آل الأسد 52 سنة من الاستبداد والفساد والإجرام والتبعية.
وفي أواسط أيار (مايو) وأواخره كان القصف نصيب القنيطرة ومحيط مصياف في
محافظة حماه، وفي 10 حزيران (يونيو) خرج مطار دمشق عن الخدمة نتيجة
القصف الإسرائيلي للمهابط والصالة الثانية، وفي أواسط آب (أغسطس)
وأواخره استهدفت الصواريخ الإسرائيلية ريف دمشق ونقاطاً في ريف
محافظتَيْ حماه طرطوس، وفي مطلع أيلول (سبتمبر) وأواسطه التحق مطار حلب
بمطار دمشق فخرج من الخدمة بعد القصف الإسرائيلي لمهابطه، وفي أواخر
تشرين الأول (أكتوبر) قُتل 21 عنصراً من الفرقة الرابعة في قصف استهدف
حافلة في منطقة الصبورة قرب دمشق، وبتاريخ 25 من الشهر ذاته نقلت صحيفة
«جيروزاليم بوست» عن مصادر عسكرية إسرائيلية أنّ دولة الاحتلال دمرت
90% من البنية العسكرية الإيرانية في سوريا. وهذه ليست حصيلة إحصائية
تامة، بل هي غيض من فيض ما وقع على الأراضي السورية من اعتداءات
إسرائيلية، لعلّ أكثر ما يلفت الانتباه فيها أنها غالباً لم تستهدف جيش
النظام مباشرة، أو الوحدات العسكرية المقرّبة من روسيا على شاكلة كتائب
سهيل الحسن (النمر) مثلاً، بل اقتصرت على أهداف تابعة لإيران
وميليشياتها.
من جانب آخر، اجتماعي – اقتصادي هذه المرّة، إذا كان ارتهان النظام إلى
إيران وروسيا قد أعاد بعض المناطق إلى سيطرته، حتى بالمعنى الإسمي؛
فإنّ ذلك الارتهان عجز، ويواصل العجز، عن انتشال النظام من مشكلات
اقتصادية بنيوية، ومن مشاقّ هائلة غير مسبوقة يعاني منها المواطن
السوري على صعيد غلاء الأسعار، وندرة الموادّ الأساسية أو رفع الدعم
عنها، وانحطاط الخدمات العامة على أصعدة الصحة والماء والكهرباء… ولعلّ
المؤشر الأوضح جاء في ختام السنة 2022 حين هبط سعر صرف العملة الوطنية
إلى 7000 مقابل الدولار الواحد، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ
الانهيارات المتعاقبة التي شهدتها الليرة السورية في أسواق العملات.
مؤشر آخر هو أنّ معدلات توفير الكهرباء بلغت في بعض المناطق درجة ربع
ساعة يتيمة مقابل 10 ساعات انقطاع، هذا عدا حقائق انعدام أصناف الوقود
اللازمة لتشغيل المولدات؛ وباعتراف رئيس وزراء النظام، فإنّ سوريا
بحاجة إلى 200 ألف برميل من النفط يومياً، بينما إنتاجها لا يتجاوز 20
ألف برميل. وكان النظام يعتمد على توريدات نفطية تؤمنها صهاريج «الحشد
الشعبي» تهريباً من العراق، لكنّ عجز النظام عن سداد قيمة المهربات
بالعملة الصعبة جعل الميليشيات الحليفة تتوقف عن التوريد، وكانت حال
مشابهة قد اكتنفت صادرات إيران من مشتقات النفط إلى النظام.
وفي غمرة مشاقّ طاحنة تخنق حياة السوريين اليومية، وإمعان النظام أكثر
فأكثر في الارتهان إلى رعاته الإيرانيين والروس، وعربدة الطيران الحربي
الإسرائيلي في أجواء سوريا طولاً وعرضاً؛ أفلح رأس النظام بشار الأسد
في «إنجاز» خطوتَين خارج عنق الزجاجة، تولت أجهزته الإعلامية التهليل
لها، متعامية تماماً عما اكتنف الخطوتين من ملابسات فاضحة تضيف الإهانة
إلى جراح السوريين. ففي مطلع أيار (مايو) قام الأسد بزيارة خاطفة إلى
طهران التقى خلالها المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي،
وكانت الثانية بعد زيارة أولى في خريف 2019 (أسفرت، يومذاك، عن استقالة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بسبب عدم علمه بالزيارة)؛ من
دون الإعلان مسبقاً، ومن دون رفع علم النظام لدى استقبال الأسد، وغمز
خامنئي من قناة «بعض قادة الدول المجاورة لإيران وسوريا» الذين «يجلسون
مع قادة إسرائيل». وليس أدلّ على هزال هذه الزيارة من حقيقة أنّ خامنئي
كان يقصد دولة الإمارات التي طبّعت مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن تلك
التي كانت «إنجاز» الأسد الثاني؛ لأنّ محمد بن زايد استقبل الأخير في
أبو ظبي، لأغراض شتى قد يكون تعكير ارتهان الأسد لإيران في طليعتها!
وبين رحيل قَتَلة أمثال علي حيدر (قائد الوحدات الخاصة الأسبق)، وذو
الهمة شاليش (المرافق الشخصي للأسدَين الأب والابن وأحد ضباع الفساد)،
ومهازل عودة مجرم الحرب الأشنع رفعت الأسد إلى «حضن الوطن»، ومساخر
فيديوهات تمساح الفساد رامي مخلوف؛ حملت سنة 2022 الكثير من العلامات
الفارقة على اختتام آل الأسد 52 سنة من الاستبداد والفساد والإجرام
والتبعية.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
الجولان وآل الأسد:
موئل المقاومة ومآل الاستبداد
صبحي حديدي
سجلت سنة 2022 الذكرى الـ40 للحدث الوطني والسياسي الفارق الأكثر مغزى
في التاريخ الحديث للجولان السوري، خلال العقود التي أعقبت وقوعه تحت
الاحتلال الإسرائيلي، سواء في سنة 1967 أو 1973؛ أي الإضراب الواسع
الكبير الذي تداعى إليه المواطنون السوريون في الغالبية الساحقة من
بلدات وقرى هضبة الجولان، والذي انطلق يوم 14/2/1982، وتواصل حتى 19/7
من ذلك العام، ويُعتبر الأطول ليس في حوليات الهضبة وحدها بل على
امتداد تاريخ سوريا الحديث. وفي جوانب عديدة، حمالة دلالات استثنائية،
كان الإضراب بمثابة حركة الاحتجاج الأوسع نطاقاً، والأرقى تنظيماً،
والأرفع التزاماً، ضد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المؤرخ في
14/12/1981 القاضي بضم الجولان، والذي صادق عليه الكنيست لاحقاً.
وإذا كانت عشرات التفاصيل التي اقترنت بمسارات ذلك الإضراب مدعاة
اعتزاز أهل الجولان، وحرصهم على استذكارها وتناقلها وتعميمها على
الأجيال الشابة؛ فإن الفخار المشروع ظل يقترن بغصة كبرى، مفهومة
تماماً، أو لعلها أحياناً تذهب إلى ما هو أبعد من مشاعر السخط والغضب،
إزاء التخاذل الذي طبع ردود أفعال النظام السوري تجاه خطوة رأى حافظ
الأسد أنها ترقى إلى مستوى إعلان الحرب، فلم يكتفِ بإبقاء خطوط الجبهة
كافة في الحال المعتادة من صمت القبور، بل أشغل أجهزة النظام الأمنية
ومعظم وحداته العسكرية الخاصة الموالية في تنفيذ المجازر الداخلية، ضد
مدن وبلدات وقرى سوريا طولاً وعرضاً!
وليس من الإنصاف، كلما ذُكرت هذه المفارقة بين إضراب السوريين في
الجولان المحتل وخضوع سوريين آخرين في الداخل لوحشية النظام، ألا تُساق
الوقائع أو تلك الأشد دموية في عدادها: حين بدأ إضراب الجولان المحتل،
كانت 12 يوماً قد انقضت على شروع النظام السوري في تنفيذ مجزرة حماة
(30 إلى 40 ألف قتيل)؛ وقبل، ثم بعد، قرار الاحتلال الإسرائيلي بضم
الجولان كان النظام قد ارتكب سلسلة مجازر أخرى (جبل الزاوية،
13ـ15/5/1980: 14 ضحية؛ سرمدا، 25/7/1980: 11 ضحية؛ سوق الأحد، حلب،
13/7/1980: 43 ضحية؛ ساحة العباسيين، دمشق، 18/8/1980: 60 ضحية؛ حي
المشارقة، حلب، 11/8/1980، صبيحة عيد الفطر: 100 ضحية…). وإلى جانب هذه
المجازر التي شهدتها التجمعات السكانية المختلفة، كانت السجون السورية
تشهد تصفيات جماعية مباشرة (مجزرة سجن تدمر، 27/6/1980: 500 ضحية على
الأقل)، أو مئات الوفيات جراء التعذيب. وأما ذروة التضاد المرير، في
ناظر أهل الجولان وأهل سوريا على حد سواء، فقد تجسدت في مقادير
اللاتناسب بين ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال مساعي كسر
الإضراب، وسلوك أجهزة النظام السوري في حصار المدن وقصفها وارتكاب
الفظائع هنا وهناك.
ثمة تلك الغصة القديمة عند السوريين في الداخل، إذ لا يملكون سوى التضامن مع أشقائهم في الجولان، فضلاً عن المقارنة بين استبداد فاشية محلية سورية، وأخرى محتلة إسرائيلية؛ وعند الجولانيين، إذْ يواصلون الانتماء إلى وطن ينزف على يد الطغاة، ولكنه موئل أول، ومآل أخير
ولقد توفر إجماع لدى مراقبي تلك الحقبة، سانده المنطق السليم البسيط،
بأن مناحيم بيغن، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك؛ وأرييل شارون، وزير
الدفاع الصقر؛ ويوسف بورغ، وزير الداخلية الممثل للأحزاب الدينية
المتشددة؛ وجدوا أن الفرصة سانحة لضم الهضبة المحتلة، في هذا التوقيت
تحديداً. ولم يكن السبب أنهم استغلوا انشغال جيش النظام بمعاركه ضد
الشعب السوري، إذ كانت الحكومة الإسرائيلية واثقة تماماً أن الأسد الأب
لن يحرك ساكناً في كل حال؛ بل لأن ضم الجولان آنذاك كان سيمر من دون
حرج دبلوماسي دولي ملموس، ومن دون تعاطف صريح مع نظام يرتكب المجازر
بحق أبناء سوريا وينشغل بالحفاظ على سلطة الاستبداد والفساد أكثر بكثير
من أي اكتراث بخسران أرض محتلة هو عاجز أصلاً عن تحريرها، لا بالحرب
ولا بالسلام. ونعرف اليوم، من المعطيات التي رُفعت عنها درجات مختلفة
من السرية، أن المشاحنة بين «الليكود» و«حزب العمل» لم تتركز على ضم
الجولان، فكلاهما اتفق على الخطوة، وإنما على توقيت مع المجازر داخل
سوريا رأى فيه «العمل» ضربة بارعة من جانب بيغن وبورغ!
قبل قرار الضم كانت دولة الاحتلال قد عدلت قانون الجنسية الإسرائيلية،
وجرى تخويل وزير الداخلية بمنح الجنسية تحت شروط متنوعة طُبق بعضها على
أهل الجولان بموجب توصيف غامض فضفاض يشير إلى اعتبار الجنسية «مصلحة
خاصة للدولة»؛ الأمر الذي اقترن، سريعاً، بإجراءات إسرائيلية تضغط على
سكان الجولان لقبول الجنسية، مع إشاعة أن 400 شخص قبلوا بها (اتضح أن
300 من هؤلاء يحملون الجنسية الإسرائيلية أصلاً لأنهم من دروز مناطق
1948 وهاجروا إلى الجولان لأسباب عائلية أو معيشية). الخطوة الجولانية
الرديفة، الوطنية بامتياز وبصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حول
أدوار رجال الدين في تنظيمها أو في تسخيرها أو تجييرها، كانت تحويل
«الخلوة» الدينية الشهيرة، خاصة حين تنعقد في مجدل شمس، إلى ما يشبه
مجلساً وطنياً للتداول حول شؤون الجولان المحتل واتخاذ القرارات
والتوصيات بشأن حاضره ومستقبله.
ولعل واحدة من أنصع وثائق تلك الممارسة كانت «الوثيقة الوطنية»، أواخر
آذار (مارس) 1981، التي نصت في البند 6 على أن «الأشخاص الرافضين
للاحتلال من خلال مواقفهم الملموسة والذين هم من كل قطاعاتنا
الاجتماعية، هم الجديرون والمؤهلون للإفصاح عما يختلج في ضمائر ونفوس
أبناء مجتمعهم»؛ وفي البند 7: «كل مواطن من هضبة الجولان السورية
المحتلة تسول له نفسه استبدال جنسيته بالجنسية الإسرائيلية، يسيء إلى
كرامتنا العامة وإلى شرفنا الوطني وإلى انتمائنا القومي وديننا
وتقاليدنا ويعتبر خائناً لبلادنا»؛ كما ذهب البند 8 إلى إجراءات ردع
قصوى: «قرارنا لا رجعة فيه، وهو كل من يتجنس بالجنسية الإسرائيلية، أو
يخرج عن مضمون هذه الوثيقة، يكون منبوذاً ومطروداً من ديننا، ومن
نسيجنا الاجتماعي، ويُحرم التعامل معه، أو مشاركته أفراحه وأتراحه، أو
التزاوج معه، إلى أن يقر بذنبه ويرجع عن خطئه، ويطلب السماح من مجتمعه
ويستعيد اعتباره وجنسيته الحقيقية».
ولم تكن مصادفة عمياء أن الذكرى الثلاثين لإضراب الجولان المحتل ترافقت
مع قصف وحشي تعرضت له أحياء حمص، فاستُخدمت ضد أبنائها أسلحة مدمرة
تحاكي، أو تفوق أحياناً، تلك التي استخدمها الإسرائيليون ضد رام الله
وغزة وقانا وبيروت… حتى إذا كان بلد المنشأ مختلفاً، بين أمريكا
وروسيا. قرائن المنطق خلف المصادفتَين كانت تشير إلى أن ذلك النظام
الذي دك مدينة حماة سنة 1982، عام الإضراب الجولاني المجيد؛ هو ذاته
النظام الذي دك حمص، في الذكرى الثلاثين للإضراب؛ بل لعله أشد همجية
أيضاً: بين الأسد الأب، الذي كان يقاتل لاجتثاث مجموعات مسلحة محدودة
العدد والعدة، بغية تأديب المجتمع بأسره؛ والأسد الوريث، الذي يقاتل
الغالبية الساحقة من الشعب الأعزل، بما ملك نظامه من آلة بطش أمنية
وعسكرية ومالية، وبما يستعين من قاذفات روسية ومقاتلي «الحرس الثوري»
الإيراني وميليشيات «حزب الله» والمفارز الأخرى المذهبية.
وبين 40 سنة على الإضراب الجولاني الكبير المشرف، وإصرار الغالبية
العظمى من أبنائه على المقاومة ورفض الضم والتشبث بالهوية الوطنية؛ و52
سنة على نظام الاستبداد والفساد والتوريث الذي أقامه آل الأسد، وينتهي
اليوم إلى تدمير سوريا شعباً وعمراناً وتسليمها إلى خمسة احتلالات
وتشريد الملايين من أبنائها في أربع رياح الأرض؛ ثمة تلك الغصة القديمة
المتأصلة: عند السوريين، في الداخل، إذ لا يملكون سوى التضامن مع
أشقائهم في الجولان، فضلاً عن المقارنة بين استبداد فاشية محلية سورية،
وأخرى محتلة إسرائيلية؛ وعند الجولانيين، إذ يواصلون الانتماء إلى وطن
ينزف على يد الطغاة، ولكنه موئل أول، ومآل أخير.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(بزنس) كرة القدم:
الشركة الرأسمالية أشطر وأغنى
صبحي حديدي
المؤلف الأول، لوك أرونديل، باحث في «المركز الوطني للبحث العلمي»
CNRS،
أحد أرفع مراكز الأبحاث الفرنسية؛ وزميله المؤلف الثاني، ريشار دوتوا،
باحث في «الكونسرفاتوار الوطني للفنون والمهن»
CNAM،
في عداد المؤسسات الأهمّ التابعة لوزارة التعليم العالي؛ وكلا المؤلفين
مختص بالاقتصاد والمال والأعمال، يديران مختبر أبحاث متعدد النُظُم
ومركزاً ثانياً لدراسات العمل والتوظيف؛ ولا علاقة فنية أو نقدية
تجمعهما بكرة القدم. لكنهما أصدرا سنة 2020 كتاباً بالفرنسية عنوانه
«على غرار الصبيان: اقتصاد كرة القدم النسائية»؛ وكتاباً ثانياً صدر
مؤخراً بالفرنسية أيضاً، يطوّر مساهمة سابقة تعود إلى عام 2018 بعنوان
«أموال كرة القدم»، في جزء أول تناول أوروبا.
وهذا عمل يتصف بأهمية خاصة لأسباب عديدة، لعل أبرزها في يقين هذه
السطور أن مقاربة أرونديل ودوتوا لا تسير على منوال السائد المتفق عليه
عموماً، حول كرة القدم بوصفها ميدان «بزنس» من العيار الثقيل؛ بل تساجل
بأن تقاليد الشركات الرأسمالية المعاصرة لا تترك لهذه الرياضة هوامش
منافسات ربحية عالية كما قد يذهب الظن، وذلك رغم عشرات المليارات التي
تجنيها المباريات والمسابقات ودورات المونديال، أو التي تُصرف على شراء
اللاعبين خلال مواسم الانتقالات بين الأندية. الكتاب لا ينزّه الرساميل
والشركات ومؤسسات المال الكبرى عن الاستثمار، الكثيف والثقيل، في
ميادين كرة القدم المختلفة؛ لكنه يسعى إلى وضع هذه الأنشطة في سياقات
مقارِنة تتيح تلمّس مؤشرات ملموسة أكثر تبياناً لطبائع «البزنس»
الفعلية في عوالم الأطوار الراهنة من هيمنة رأس المال واقتصاد السوق
وقوانين العرض والطلب والمنافسة.
على سبيل المثال، من واقع كرة القدم الاحترافية الفرنسية: في سنة 2018
ـ 2019 بلغ حجم معاملاتها المالية أكثر قليلاً من مليارَي يورو (2.117
مليار، لـ40 نادياً)، بينها 1.9 مليار لأندية الدرجة الأولى التي تعدّ
20 نادياً؛ وفي المقابل، كانت أكبر الشركات الفرنسية قيمة في البورصة،
تأمين
AXA،
قد حققت خلال السنة ذاتها أكثر من 50 ضعفاً بالمقارنة مع اتحاد الكرة
الفرنسي؛ وأمّا شركة
Uber Eats،
منصة توزيع الأطعمة الجاهزة التي تُشرك اسمها في رعاية البطولة
الفرنسية، فقد سجلت أرباحاً بقيمة 1.4 مليار يورو خلال سنة 2019. وعلى
مستوى أوروبي، خلال سنة القياس ذاتها، كانت الحسابات المجتمعة للبطولات
الخمس الأكبر في حدود 17 مليار يورو، أي أقل من حجم الأرباح التي
كدستها شركة اليانصيب الفرنسية.
من جانب آخر، إذا كانت أندية كرة القدم بمثابة «أقزام» اقتصادية
بالمقارنة مع الشركات الرأسمالية الكبرى، فإنها «عمالقة» على المستويات
الإعلامية وفي وسائل الميديا المختلفة، حسب تعبير أرونديل ودوتوا.
الأندية الثلاثة الأكثر «شعبية»، والمزدوجات من المؤلفين، أي ريال
مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، هي أيضاً الأندية الأغنى حسب تصنيف
«رابطة أموال كرة القدم»؛ وها هي أرقام التعاملات المالية: ريال مدريد،
757 مليون يورو؛ برشلونة، 852 يورو؛ مانشستر يونايتد، 627 مليون يورو؛
وهذه الأندية الكبيرة العريقة، ذات الجاذبية العالمية الواسعة، لا
تنافس اقتصادياً شركة أثاث وتجهيزات منزلية مثل «كونفوراما»، الراعي
السابق لأندية الدرجة الأولى الفرنسية، التي حققت معدلات أرباح أعلى من
الأندية الثلاثة مجتمعة.
النادي يمكن أن يمتلك رصيداً جماهيرياً، وسجلاً حافلاً بالانتصارات، واحتشاد المشاهدين في المدرجات، والثبات على مستوى راسخ في المنافسة؛ لكن هذا كله، وسواه أيضاً، لا يوحد بالضرورة ثنائية الفوز على أرضية الملعب والأرباح في شباك التذاكر
وفي عودة إلى الفرضية المركزية لنظرية الشركة الرأسمالية (النيو ـ
كلاسيكية، ولكن الحديثة والمعاصرة أيضاً)، يذكّر المؤلفان بأنها كانت
وتبقى تضخيم الأرباح قدر الإمكان؛ الأمر الذي يقودهما إلى الاستنتاج
بأن كرة القدم ليست من ذلك الطراز، الذي يوفر عناصر الزيادة في
المبيعات أو التوسع أو الوثوق بالمنتج، وما إلى ذلك. النادي يمكن أن
يمتلك رصيداً جماهيرياً، وسجلاً حافلاً بالانتصارات، واحتشاد المشاهدين
في المدرجات، والثبات على مستوى راسخ في المنافسة؛ لكنّ هذا كله، وسواه
أيضاً، لا يوحّد بالضرورة ثنائية الفوز على أرضية الملعب والأرباح في
شباك التذاكر. وهذه حال يناقشها المؤلفان بتفصيل أوسع، وأمثلة كثيرة
مدهشة في دلالاتها، على مدار ملفات ثلاثة: أولئك الذين يملكون، أو
«المليارديرات في لباس الشورت»؛ وأولئك الذين يموّلون، أو الأثرياء
والمشاهير؛ وأولئك الذين يلعبون، أو جماعة «إبذلْ أكثر لتربح أكثر».
حول الملف الأول، وعلى سبيل المثال من فرنسا أيضاً، كانت الأندية خلال
ثلاثينيات القرن المنصرم ملكية للشركات الصناعية بصفة رئيسية، أمثال
«بيجو»، التي امتلكت نادي سوشو؛ وشركة المناجم، صاحبة نادي لانس؛ وشركة
كازينو، مالكة سانت إتيان. وأما في حقبة 1980 ـ 1990 فإن شركات انتاج
المرئي/ السمعي هي التي استثمرت في كرة القدم الفرنسية:
Canal+
في باريس سان جيرمان، وM6
في بوردو. وأما اليوم، في فرنسا كما في أوروبا، فإن غالبية الأندية
باتت ملكية أشخاص أفراد، مادياً أو اعتبارياً، وطبقاً لاتحاد الكرة
الأوروبي فإن نسبة 50٪ من أندية النخبة تخضع لهذه الحال. وعند النظر في
الترسيم السوسيولوجي لمالكي أندية الدرجة الأولى، يتضح أن السيرورة
الأعم تعتمد على توظيف رأس المال، وليس تشغيل «شركة» بالمفهوم
الاقتصادي سالف الذكر؛ مع إشارة هامة إلى أن بعض مالكي الأندية يديرون،
بالفعل، شركات رأسمالية مزدهرة في قطاعات صناعية وتجارية أخرى.
وفي ملفّيْ التمويل واللعب، لا تختلف الخلاصات جوهرياً لجهة تأكيد ما
يفترضه أرونديل ودوتوا حول «بزنس» الشركة الرأسمالية المعاصرة الأشطر
من أي استثمار في ميادين كرة القدم، وهما يقتبسان عبارة اللاعب
الهولندي الشهير يوهان كرويف («لماذا لا نستطيع هزيمة فريق أغنى؟ لم
أشهد حقيبة مليئة بالأوراق النقدية تسجّل هدفاً»)، ليطرحا التساؤل
المزدوج التالي: أليس المال، على العكس، شرطاً ضرورياً أو حتى كافياً،
للفوز؟ أم أن الانتصارات هي التي تسمح بكسب المداخيل؟ وإلى جانب
الأموال الناجمة عن مناقلات اللاعبين، تنحصر مداخيل الأندية في أربعة
مصادر: حقوق نقل المباريات، بيع التذاكر، تسويق البضائع، والرعاية
المشتركة. وإذا كانت هذه قد خضعت، وتخضع منطقياً، لقانون المد والجزر
والصعود والهبوط، فإن جوهر اشتغالها يظل مختلفاً عن نظائره في الشركات
المعاصرة، خاصة في هذا الطور من عَوْلَمة رأس المال.
وفي قسم رابع ختامي من الكتاب، يُكرّس للجمهور والأنصار ومتابعي كرة
القدم عموماً، يسوق المؤلفان عبارة من الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو
(الذي كان ذات يوم حارس مرمى لفريق «راسينغ الجامعي» في الجزائر، أثناء
الاحتلال الفرنسي): «سوى ملعب كرة قدم، ليس من مكان آخر في العالم يكون
المرء فيه أكثر سعادة»؛ الأمر الذي لا يعني أن كتّاباً سواه لم يكونوا
أكثر تشكيكاً في اللعبة، على غرار الأرجنتيني خورخيه لويس بورخيس الذي
اعتبر أن «كرة القدم شعبية لأن الغباء شعبي»، معتبراً أن «22 فتى في
بناطيل قصيرة يركضون خلف كرة واحدة، بينما يكفيهم أن يشتروا 22 كرة».
والحال أن «الصراع» من أجل الفوز في الملعب غير بعيد عن تشكيل مناسبة
استثنائية تتيح للأمّة أن توظف طاقات أبنائها في قتال «نظيف» مع أمم
أخرى قد تكون أكثر جبروتاً في جميع الاعتبارات، لكنها تخضع بالتساوي
لقانون كوني واحد يضع المغرب على قدم المساواة مع فرنسا؛ كما يحيل ملعب
كرة القدم إلى ما يشبه البرلمان الأمثل لاتحاد شعوب العالم، حيث تتساوى
الشعوب في الخضوع لقوانين احتساب الهدف والخطأ وضربة الجزاء.
وبالطبع، حال كرة القدم أخطر كثيراً من اختزال كامو وبورخيس؛ وإنْ كانت
أموالها، التي تُقدّر بعشرات المليارات، أقل قدرة على صناعة الـ»بزنس»
من الشركات الرأسمالية المعاصرة، وأدنى شطارة» استطراداً.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
الاتفاق الإطاري في السودان:
المجرَّب والمخرَّب
صبحي حديدي
في وسع مراقب محايد أن يتلمس، وربما بسهولة نسبية، حفنة من المعطيات
التي تكتنف توقيع الاتفاق الإطاري بين جنرالات الجيش السوداني من جانب
أوّل، و«قوى إعلان الحرية والتغيير» – مجموعة المجلس المركزي والفئات
السياسية والنقابات المتحالفة معها من جانب ثان. وفي وسع المراقب ذاته،
إزاء وضع تلك المعطيات ضمن حال جدلية من تَطابق المصالح أو تناقضها، أن
يستخرج ميزاناً مبسطاً يتجاوز الخطاب واللغة الوردية والآمال وإعلانات
النوايا الحسنة؛ إلى الحقائق الصلبة ذات الرسوخ والصلاحية، وبالتالي
إلى حصيلة المكاسب والخسائر للفريقين.
مراقب آخر، من طراز غير محايد مثلاً، سوف يتوقف أوّلاً وبصفة خاصة عند
سؤال كبير مركزي: هل يمكن الوثوق بهؤلاء الجنرالات، أمثال رئيس مجلس
السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو على وجه التحديد،
في أنهم لن يسارعوا مجدداً إلى تنفيذ انقلاب جديد، يتابع انقلاب 25
تشرين الأول (أكتوبر) 2021، أو يستكمل أغراضه المتمحورة أساساً حول
إحكام قبضة الجيش على الدولة والمجتمع؟ وهل من التعقّل السياسي تجريب
المجرَّب، في مضمار شهوة العسكر إلى السلطة والتسلط، من دون الحكم على
المجرِّب بأنّ عقله مخرَّب، كما تقول الحكمة العتيقة الصائبة؟
وهذا المراقب سوف يرحّل أسئلة كهذه إلى منطقة ثالثة، لا تخلو من تحكيم
عقلي ذرائعي يشمل الفريقَين الموقعين على الاتفاق الإطاري، من زاوية
بسيطة أو حتى تبسيطية تتساءل عن حوافز العسكر في الذهاب إلى التوقيع
أصلاً: هل لأنّ الانقلاب فشل، حتى الساعة، في إنجاز أغراضه المرجوة
ودخل في حال من الركود أو الجمود أو العطالة، الأمر الذي يستدعي
تنازلاً هنا أو انحناءة هناك؟ أم، استطراداً، لأنّ الانقلاب أوقع قوى
إقليمية ودولية، صديقة للعسكر عملياً، في حرج بيّن استوجب وقف الدعم
المالي وتخفيف المساندة السياسية، والمطالبة بعودة الحكم المدني وإنْ
على مستوى اللفظ والبيان فقط؟ وهل، ثالثاً، أخفق العسكر في جرّ أمثال
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى
يقين بأنّ فضائل الانقلاب ما تزال سارية المفعول، ويمكن منحها فرصة
إضافية؟
وأمّا مراقب من طراز ثالث، يميل أكثر إلى «لجان المقاومة» والحراك
الشعبي وتظاهرات الاحتجاج الرافضة للاتفاق الإطاري، فإنّ ذخيرته من
أسباب التشكيك والطعن والاعتراض وافرة ومتعددة، بل سوف تكون آخذة في
التزايد كلما انقضى يوم شاهد على تخلّف الجنرالات عن الوفاء بما وقّعوا
عليه. القضايا الخلافية، وهي التي علّقها الاتفاق الإطاري إلى أجل غير
مسمى، ليست قليلة العدد ولا ضئيلة الأهمية، فضلاً عن احتوائها على
الكثير من عناصر تفجير الاتفاق:
ــ متى، ومَن يضمن، دمج «قوات الدعم السريع» في الجيش السوداني، ولماذا
يُقدم البرهان على خطوة كهذه كفيلة على المدى البعيد بإضعاف حليفه
ونائبه دقلو؟
ــ متى، ومَن يضمن، تحريك ملفات العدالة الانتقالية، بما يؤكد محاسبة
المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضدّ أبناء السودان؛ فما بالك بعدم عودة
رموز نظام عمر حسن البشير إلى المشهد، أو إلى سدّة السلطة؟
ــ متى، ومَن يضمن، حُسْن تنفيذ اتفاق سلام جوبا، ومشكلات شرق البلاد،
وأنشطة الحركات المسلحة، واستتباب الأمن في غرب السودان؟
ليس العسكر في عداد الضامنين، منطقياً، لأنّ قبضة الجنرالات على السلطة
والتسلط تتغذى على مشكلات كهذه، والإبقاء عليها معلّقة وعالقة يزوّد
الجيش بذرائع إضافية تسوق مخاوف انزلاق البلد إلى «الفوضى» و«الحرب
الأهلية» و«التفكك». وليست الأطراف المدنية المتوافقة اليوم مع
الجنرالات قادرة اصلاً على فعل الضمان، ومثلها اللجان والقوى المعترضة
على الاتفاق.
وأما مفتاح فكّ الاستعصاء فإنه يبدأ أوّلاً من كلمة حقّ نطق بها
البرهان (وأراد بها باطلاً، كما اتضح): «العسكر للثكنات والأحزاب
للانتخابات»؛ أو الحكم المدني الديمقراطي، باختصار وافٍ وكافٍ.
فضيحة بريطانية تسبق العراقية:
اقتصاد المواطن المكبّل
صبحي حديدي
إذا ظنّ امرؤ أنّ فضيحة القرن المالية، في ميادين الفساد والاختلاس
والسرقة وسواها، عراقية المنشأ (نهب نحو 3.7 ترليون دينار عراقي، ما
يعادل 2.5 مليار دولار، من أموال مصلحة الضرائب)؛ فإنّ فضيحة كبرى
منافسة، بريطانية قلباً وقالباً هذه المرّة، تحيل زميلتها العراقية إلى
مراتب أدنى: إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية خسرت 75٪ من الـ12 مليار
جنيه إسترليني (أي ما يعادل 4 مليار إسترليني) من تجهيزات دائرة
«معدّات الحماية الفردية»، أو الـ
PPE،
التي تمّ شراؤها خلال العام الأوّل من جائحة كوفيد ـ 19 ولم تعد صالحة،
وتوجّب إحراقها على سبيل الاستفادة منها في… قطاع الطاقة!
عضوة البرلمان البريطاني ورئيسة لجنة الحسابات العامة، السيدة ميغ
هيليير، قالت في تقريرها إنّ « حكاية مشتريات الـ
PPE
قد تكون الواقعة الأشدّ خزياً في ردّ الحكومة على الجائحة. ففي بدء
الجائحة تُرك العاملون في الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية وحيدين
يجازفون بحياتهم ومصائر أسرهم نظراً لنقص المعدات الأساسية. وفي محاولة
يائسة بذّرت الحكومة مبالغ هائلة، فصرفت على نحو متضخم بذيء إلى وسطاء
في تسرّع فوضوي، تركنا أمام عقود حكومية ضخمة تحقق فيها اليوم الوكالة
الجنائية الوطنية على أساس اتهامات بممارسة عبودية حديثة في سلسلة
تأمين المواد». ولا يُستخدم تعبير العبودية جزافاً هنا، لأنّ التقرير
البرلماني الذي رفعته هيليير يحتوي على تفاصيل مذهلة لجهة المدفوعات
غير المرخّص بها، وطبيعة الشبكات المستفيدة، ومدى الصلة (أو بالأحرى:
انعدامها) مع القطاع الصحي.
الإشكالية هنا أعمق، وأبعد أثراً ومغزى، من فرضية تبسيطية يمكن أن
يسوقها منافح مدافع عن النظام الحكومي أو الديمقراطية البريطانية
عموماً، وتتخذ من أخطاء البيروقراطية الإدارية ذريعة لتفسير الوقائع؛
الأمر الذي يسهّل القفز عن حقائق/ قواعد الإنفاق الحكومي في ظلّ النظام
الرأسمالي المعاصر، في أوروبا والولايات المتحدة وسائر منظومات
الاقتصاد الحرّ. ثمة تضادّ صارخ بين سياسات الصرف العامة، الحكومية،
ذات الصلة بقطاعات الدولة وشركائها عموماً، من جهة؛ وفُرَص المواطن/
دافع الضرائب، مموّل تلك السياسات، في مراقبة، أو حتى معرفة، أوجه
الإنفاق، الفعلية أو المستورة، من جهة ثانية. والمنطق يقول، من جهة
ثالثة، إنّ الفارق معدوم أو يكاد بين حكومة محافظين يقودها بوريس
جونسون، أو حكومة عمّال برئاسة كير ستارمر؛ بالنظر إلى أنّ ركائز
الجوهر، من حيث سلطة المنظومة قبل أنساق الجهاز البيروقراطي في الواقع،
متماثلة وشبه ثابتة.
ذلك، بالطبع، لا يعني البتة أنّ معدلات الفساد مرتفعة في بريطانيا، إذْ
أنّ تقرير منظمة «الشفافية الدولية» للعام 2021 يضعها في المرتبة 11 من
أصل 180 دولة، ويمنحها علامة متقدمة نسبياً تبلغ 78/ 100؛ ولا يعني،
استطراداً، أنّ فضيحة الـ 4 مليار إسترليني قابلة للمقارنة، بمعنى
طرائق الفساد والإفساد والنهب، مع الـ3,7 ترليون دينار عراقي. لكنه
يعني، على النحو الأوثق القابل للمقارنة، السهولة العالية أو القصوى
التي تتمتع بها أجهزة الصرف والإنفاق الحكومية، في ظلّ منظومة اقتصاد
رأسمالي حرّ بريطانياً، مقابل منظومة فساد غير ديمقراطية أو حزبية أو
ميليشياتية في نموذج العراق. وضمن مقاربة مقارنة كهذه، قد يصحّ
الافتراض بأنّ الطامة أكبر في لندن منها في بغداد، ليس لأنّ أعذار
النهب أو التبذير مختلفة بين البلدين، فحسب؛ بل كذلك، وأساساً ربما،
لأنّ أواليات الرقابة العامة أعلى كفاءة في بريطانيا قياساً على
العراق.
ولأنه ظاهرة شبيهة برقصة التانغو، لا تتمّ من دون وجود طرفين اثنين: الذي يستلم المال القذر، والذي يسلّمه؛ فإنّ مراقصة الأغنياء للفقراء في ملفات الفساد تنقلب إلى تانغو منفرد: العمالقة الأغنياء يرقصون، والصغار الفقراء يُهمشون
ومن عجائب هذا الملفّ، والدلائل على العلاقة الشائكة بين منظومات
الاقتصاد الحرّ والفساد، أنّ الحكومة البريطانية ذاتها كانت قد
استضافت، سنة 2016، قمة عالمية لمكافحة الفساد؛ تطلعت إلى الأمنيات
المتكررة، ورفعت الشعارات المألوفة العتيقة، ودعت إلى صياغة موقف عالمي
يعالج الظاهرة، ويقترح اتخاذ سلّة إجراءات رادعة ليس بصدد الأنظمة
الفاسدة، المشبوهة الدائمة، فقط؛ بل كذلك سرّية أعمال الشركات، وشفافية
الحكومات، وتطبيق قوانين دولية في محاسبة الفساد والفاسدين. دافيد
كاميرون، وكان رئيس وزراء بريطانيا يومذاك، مهّد للقمة بهذا التصريح:
«شرّ الفساد يبلغ كلّ زاوية من هذا العالم. وهو يكمن في قلب ما نواجهه
من المشكلات الأكثر إلحاحاً، من التشوش الاقتصادي، إلى الفقر المستوطن،
إلى تهديد دائم الحضور يخصّ التشدد والتطرف». وإذْ تمنى كاميرون أن
يلاقي وليد القمة تلك ـ «أوّل» إعلان عالمي ضدّ الفساد ـ نجاحاً
وفاعلية في المستقبل؛ فإنه أنذر، ضمناً، بالانتكاسات المعتادة:
الانتصار في المعركة «لا يتمّ بين ليلة وضحاها، ويتطلب وقتاً وشجاعة
وعزماً».
وإلى جانب حفنة ضئيلة من رؤساء الدول، مثل النيجيري محمد بخاري،
والأفغاني أشرف غني؛ واثنين من رؤساء الوزارة، في نيوزيلندا وسنغافورة؛
بدا ملحوظاً تماماً، وفاقعاً صارخاً، أنّ الدول الكبرى المصنّعة لم
تشارك إلا على مستوى وزراء الخارجية (أمريكا وألمانيا، مثلاً)، أو
شاركت بتمثيل متدنِ عن سابق قصد (روسيا أرسلت أحد نوّاب وزير
الخارجية)؛ وشاركت كريستين لاغارد، عن صندوق النقد الدولي؛ وجيم يونغ
كيم، عن البنك الدولي؛ وخوسيه أوغاز، عن منظمة «الشفافية الدولية». أما
الطريف، وسط هذا الحشد، فقد كانت مشاركة فرنسيس فوكوياما، دون سواه، في
ورقة لا تبشّر بنهاية التاريخ مجدداً، بل تشخّص الفساد: «السمة التي
تعرّف القرن الحادي والعشرين، تماماً كما كان القرن العشرون قد اتصف
بصراعات إيديولوجية واسعة النطاق بين الديمقراطية والفاشية والشيوعية»!
والحال أنّ سعادة كاميرون باعتماد «أوّل» إعلان عالمي حول مكافحة
الفساد لم تكن في محلّها، لأنّ اتفاقيات دولية سابقة، واحدة بارزة على
الأقلّ، رأت النور في صيغة «ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»
UNCAC،
وقعت عليه 140 دولة عند اعتماده سنة 2003، وهي اليوم تعدّ 178 دولة.
غنيّ عن القول إنّ معظم الدول الموقعة على ذلك الميثاق لا تغرق في
الفساد، فحسب؛ بل تمارس الإفساد أيضاً: في تقارير «الشفافية الدولية»
يسير ترتيب الدول الأكثر إفساداً، أي الأكثر سخاء في منح الرشاوي للدول
أو الجهات المتعاقدة، كما يلي: روسيا، الصين، تايوان، كوريا الجنوبية،
إيطاليا. وهذه اللائحة تضمّ مجموعة الدول الآسيوية الأساسية (هونغ
كونغ، ماليزيا، اليابان)، ثمّ معظم الديمقراطيات الغربية (الولايات
المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا…). لافت، إلى هذا، أنّ حقول منح
الرشوة تتركّز في قطاعات الزراعة، والصناعة الخفيفة، والإنشاءات
المدنية، والطبّ والصيدلة!
وإلى جانب علاقة الجهاز المبذّر مقابل المواطن المكبّل، ثمة مبدأ مركزي
حاسم، بات ناظماُ الآن، يقول إن الفساد تعَوْلَم بدوره، ولكنّ عواقبه
تصبح وخيمة أكثر أو أقلّ قياساً على ثقافة سياسية دون غيرها، أو على
نظام اقتصادي دون آخر، أو على الدكتاتوريات دون الديمقراطيات. وما دامت
الوقائع تشير إلى أنّ الكلّ سواسية، تقريباً، في فضائح النهب أو سوء
الإنفاق، فإن الطرائق الناجعة (أو التي يمكن أن تكون ناجعة في أي يوم)
ينبغي أن تأخذ بالحسبان حقيقة وجود الفاسد كتفاً إلى كتف مع المفسِد،
وحقيقة وجودهما داخل هياكل الدولة وخارجها أيضاً.
ولأنه ظاهرة شبيهة برقصة التانغو، لا تتمّ من دون وجود طرفين اثنين:
الذي يستلم المال القذر، والذي يسلّمه؛ فإنّ مراقصة الأغنياء للفقراء
في ملفات الفساد تنقلب إلى تانغو منفرد: العمالقة الأغنياء يرقصون،
والصغار الفقراء يُهمشون. وفي نموذج الفضيحة البريطانية، التي أرسلت
أختها العراقية إلى صفّ ثانٍ، فإنّ دافع الضرائب الضحية يمكن أن يقاصص
المسؤولين عن فضيحة ما في أيّ صندوق اقتراع وشيك؛ ريثما يُكشف النقاب
عن واقعة فاضحة أخرى… تجبّ ما قبلها!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
أمريكا وأوروبا: معارك
أقطاب الرأسمالية المعاصرة
صبحي حديدي
إذا كان التوتر بين فرنسا والولايات المتحدة حول صفقة الغواصات مع
أستراليا قد انخفضت حدّته منذ أيلول (سبتمبر) 2021، وأسلمت باريس أمرها
إلى واحد من أعتى وأعتق القوانين الرأسمالية التي تخصّ صراع الأسواق
وتسليع المصالح الاستثمارية؛ فإنّ التوتر الجديد يدور حول ما بات يُعرف
باسم «تشريع خفض التضخم»،
IRA،
الذي الذي أقرّه الكونغرس ووقّع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في
أواسط آب (أغسطس) الماضي ليصبح قانوناً. الاتحاد الأوروبي بأسره، وليس
فرنسا وحدها، هي هذه المرّة المتضررة من التشريع الجديد، وبالتالي فإنّ
الشطر الأوروبي من الرأسمالية المعاصرة يدخل في حال خلافية مع الشطر
الأمريكي. وليس من المرجح أن ينجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
خلال زيارته الراهنة إلى الولايات المتحدة، في إقناع نظيره الأمريكي
بأنّ مصالح الشطرَين تقتضي حلّ النزاعات بدل تأجيجها.
مضمون التوتر الجديد لا يخرج كثيراً عن التنظير العتيق القائل بأنّ
الرأسمالية هي التي تخلق أوّل حفّاري قبورها، إذْ أنّ تشريع الـ
IRA
يخدم مصالح التضخم في الولايات المتحدة، ولكنه يؤذي المصالح ذاتهأ أو
ما يماثلها في أوروبا: إنه سوف يوفّر 738 مليار دولار أمريكي في مجال
الإنفاق على الطاقة والتبدّل المناخي، و238 مليار دولار في ميدان خفض
التضخم، ومن المقرر له أن يخفّض في سنة 2030 انبعاثات غازات الدفيئة
بمعدّل 40٪ قياساً على مستويات 2005، ويقدّم دعماً بقيمة 7500 دولار
لمشتري السيارات الإلكترونية. أين المشكلة، إذن؟ إنها تبدأ من حقيقة
أنّ التشريع يشجّع الاستثمارات في صناعة السيارات الأمريكية، ويقلصها
في أوروبا على مستوى صناعات السيارات والبطاريات والطاقة المتجددة، إلى
درجة أنّ المفوض الأوروبي لشؤون السوق هدّد واشنطن باللجوء إلى منظمة
التجارة العالمية، ورئيسة الوزراء الفرنسية أعلنت أن بلادها لن تقف
مكتوفة الأيدي وأكمل وزير الاقتصاد في حكومتها فاشتكى من أنّ قيمة
الدعم الذي يقترحه تشريع الـ
IRA
أكبر 14 مرّة من القيمة القصوى التي تسمح بها المفوضية الأوروبية.
لا جديد، بالطبع، في اندلاع خلافات مثل هذه يمكن أن تنقلب إلى معارك
مفتوحة بين قطبَيْ الرأسمالية، وثمة ابعاد أخرى داخل القطب الواحد ذاته
على غرار معركة قانونية ذات مغزى عميق، اندلعت ضدّ «قصة نجاح» رأسمالية
فريدة، بل لعلّها أكثر كونية وانضواء في حاضنة العولمة؛ أي قضية وزارة
العدل الأمريكية (ومن ورائها أكثر من 20 ولاية، وعشرات شركات
الكومبيوتر الصغيرة والكبيرة)، ضدّ الملياردير الأمريكي بيل غيتس وشركة
«ميكروسوفت» العملاقة. وفي الجوهر العميق من تلك المواجهة الضارية كان
المبدأ الرأسمالي العريق «دعه يمرّ، دعه يعمل» يتعرّض للمساءلة
والمراجعة، ليس في ميدان التنظير الفلسفي او الاقتصادي كما جرت العادة؛
وإنما في خضم السوق، وفي ظلّ قوانين العرض والطلب دون سواها. ثمة، غنيّ
عن القول، الكثير من المغزى في أن تهبّ الرأسمالية ضدّ واحد من خيرة
أبنائها البرَرة، وضدّ واحدة من كبريات معجزاتها، كي نقتبس أسبوعية
الـ»إيكونوميست» العليمة بأسرار الآلة الرأسمالية.
ليس من المرجح أن ينجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الراهنة إلى الولايات المتحدة، في إقناع نظيره الأمريكي بأنّ مصالح شطرَي الرأسمالية تقتضي حلّ النزاعات بدل تأجيجيها
ومعارك رأس المال المعاصر ضدّ المؤسسة أو قوى الإنتاج أو علاقات
الإنتاج لم تعد تجري في معمعان الصراعات الطبقية الكلاسيكية، كما كانت
عليه الحال في الماضي، بل هي اليوم تُخاض في قاعات البورصة، أو
المحاكم، أو البرلمانات، أو اجتماعات مجالس إدارة الشركات العملاقة أو
الجمعيات العمومية لأصحاب الأسهم. في قاعات كهذه يتقرر مصير العقد
الاجتماعي، ليس على ضوء التعاقد بين المنتج والمستهلك أو العمل وقيمة
العمل، بل على أساس قاعدة ذهبية واحدة، ليست جديدة تماماً في الواقع:
التخفيف ما أمكن من النفقات، بقصد تحقيق أقصى زيادات ممكنة في الأرباح،
وتحسين حظوظ المؤسسة في المنافسة والاحتكار والتواجد الكوني القوي
المُعَوْلَم.
ليست أقلّ وضوحاً حقيقة أنّ الولايات المتحدة، في أعقاب أزمة 2007 ـ
2008 المالية التي شهدت ما يشبه الانهيار التامّ للنظام المالي الكوني،
أخذت تتراجع بانتظام عن سياسات الحماية المتغطرسة التي سعت إلى فرضها
على قمّة مجموعة العشرين في واشنطن، تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، ثمّ
قمّة لندن، في نيسان (أبريل) الماضي. الأسباب عديدة، على رأسها تناقض
المصالح بين النخب الحاكمة في الولايات المتحدة وأوروبا، وتعزُّز مواقع
الدول ذات الاقتصادات الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية، والصين بصفة
خاصة. وإذا غاب الدليل على هذا الوضوح، فليس على المرء إلا أن يقلّب
صفحات «وول ستريت جورنال»، فيقرأ الدروس السلوكية التي توجهت بها
الصحيفة إلى تيموثي غايثنر وزير الخزانة الأمريكي آنذاك: 1) لسنا في
عقود الهيمنة، وتأزم الاقتصادات الآسيوية، حين كانت الخزانة الأمريكية
تسيّر اقتصاد الكون من خلال صندوق النقد الدولي؛ و2) لا مناص،
استطراداً، من مراعاة مصالح اقتصادات الصين والهند والبرازيل، على حساب
الحلفاء في أوروبا؛ ومن الضروري منح هذه الدول قوّة تصويتية أعلى في
اجتماعات صندوق النقد الدولي، على حساب حلفاء مثل فرنسا وألمانيا، وهذه
المرّة عن سابق قصد، وبما يخدم مصالح الولايات المتحدة…
وإذ يجتمع ماكرون مع بايدن تحت راية إدارة أزمات قطبَيْ الرأسمالية،
فإنّ مداولاتهما لا تدير سوى بعض أزمات العمالقة أنفسهم، بين بعضهم
البعض؛ أو تشرع الابواب أمام اندلاع المزيد من الأزمات، على هذه الجبهة
او تلك، أو على كلّ الجبهات دفعة واحدة، بحيث يبدو العالم في حال دائمة
من تأزّم الوقائع واستعصاء الحلول. لقد سبق لقمم مماثلة، أو أوسع
نطاقاً وأكبر عدداً، أن وضعت على جداول أعمالها تنظيم إخضاع الأطراف
لسياسات التعديل الهيكلي التي تخدم المركز، في عام 1976؛ وتنظيم إعادة
بناء الدولار النفطي لصالح منطق المضاربة المالية، في عام 1980؛ وتشجيع
الهبوط في أسعار المادة الخام؛ وتنظيم إعادة جدولة الديون، في عام
1982؛ وتنظيم إدخال روسيا ودول أوروبا الشرقية في برامج التعديل
الهيكلي من طرف واحد في عام 1992؛ والتوفيق بين خفض التضخم في أمريكا
وزيادة معدلاته في أوروبا…
ومن جانب آخر يخصّ العملات الوطنية والبورصات، فإنّ مؤشرات إطلاق
اليورو في أسواق البورصة، أي منذ عام 1998 وقبل اعتماده عملة موحّدة،
لا تدلّ على أنّه ربح بعض الرهان مع الدولار الأمريكي. المنطق
الاقتصادي الصارم يبرهن على العكس: أنّ الدولار، عملة المركز الرأسمالي
الأوّل، ربح الرهان ضدّ المراكز الرأسمالية الأخرى؛ كلّ الرهان أو
معظمه، حتى إشعار آخر لا يبدو قريباً البتة. لقد بدأ اليورو بسعر صرف
1.17 دولار أمريكي، ثمّ مرّ بمرحلة لم تكن قيمته تتجاوز 80 سنتاً، ثمّ
راوح طويلاً وهو يسعى إلى تجاوز عتبة الـ 90 سنتاً، قبل أن يقفز فوق
الدولار في معدّلات متصاعدة لا تستقيم مع منطق البورصة السليم.، ويبلغ
اليوم سوية التذبذب عند رقم 0.96 أمام الدولار!
ولا يخفى على أحد أنّ إطلاق اليورو تزامن مع هيمنة أمريكية شاملة، أو
تكاد، على مقدّرات الكون: بالمعنى السياسي المحض، ثمّ بمعنى السياسة
بوصفها اقتصاداً مكثفاً. ذلك لأنّ طبائع حروب التبادل تجعل اليورو
غائباً سياسياً عن مناطق ساخنة مثل الشرق الأوسط وأفغانستان وشبه
القارّة الهندية والصين والبرازيل، فكيف تكون الحال في مناطق مثل
الاتحاد الأوروبي واليابان؛ حيث الغياب السياسي له أثمان اقتصادية دون
ريب، طال أجلها أم قصر، وحيث يعود ماكرون خائب الرجاء في مسعى تجميد
الـ
IRA،
أو حتى تليين عريكته.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
الحلف الأطلسي المعاصر:
توسّع «وجودي» يجبّ شرّ القتال
صبحي حديدي
ليس حرجاً ذلك السلوك الذي اتسمت
به ردود أفعال الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام لحلف شمال
الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، حول هوية الصاروخ الذي سقط في الأراضي
البولندية؛ وحرْص الرجلَين على نفي مسؤولية موسكو عن إطلاقه، والاكتفاء
بسردية بسيطة وتبسيطية تقول إنه صاروخ دفاع جوي أوكراني جنح عن مساره
في مواجهة الهجمات الروسية. الأصل هو كفاية شرّ الصدام مع موسكو، من
جانب التورّط الأطلسي على وجه التحديد، إذْ سواء صحّت السردية أم
اختُلقت فلا أحد على جانبَي المحيط والبحر الأسود وبحر البلطيق يجهل
مخاطر شرارة مثل هذه، تمثّل تصعيداً كفيلاً بإشعال مواجهة مثل تلك.
الأطرف في السياق أنّ اتصالات البيت الأبيض والناتو مع الحكومة
البولندية لم تستهدف المواساة أو شدّ الأزر والتضامن، بقدر ما مارست
سلسلة ضغوط كي لا يطلب الرئيس البولندي أندريه دودا تفعيل المادة
الرابعة من ميثاق الحلف، والتي تُلزم الحلفاء بالتشاور إذا شعرت دولة
عضو بأن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها معرضة
للتهديد.
مبدأ الصدام، أو كفاية شرّه سواء بسواء، يعيد المرء إلى حقيقة أنّ
الناتو ليس الحلف العسكري الوحيد في عالمنا المعاصر، فحسب؛ وليس
التذكرة الوحيدة، تقريباً، بأنّ البشرية عاشت الحرب الباردة طيلة حقبة
كاملة متكاملة، فحسب أيضاً؛ بل هو كذلك حلف مصالح متقاطعة متلاقية أو
متعاكسة، قابلة غالباً للأخذ والعطاء طبقاً لمبادئ المساومة والتسوية
والمحاصصة. ذلك لا يعني أنّ الناتو ليس محاصصة جغرافية ـ حضارية ـ
ثقافية، طبقاً لما كانت الإنسانية قد فهمته من كلام الرئيس التشيكي
الأسبق فاكلاف هافيل، قبل عقدين من الزمان حين احتضنت بلاده قمّة للحلف
لا تشبه سواها من القمم، لأنها ببساطة اعتُبرت «قمّة التحوّل». يومها
قال هافيل، في نبرة تحذير لا تخفي، إنّ «على الحلف ألا يتوسّع خارج
مضمار محدّد للغاية من الحضارات التي عُرفت عموماً باسم الحضارات
الأورو ـ أطلسية أو الأورو ـ أمريكية، أو الغرب ببساطة». هل كانت تركيا
هي المقصودة بذلك التعريف المضماري الذي لا يفلح تماماً في تنقية كلّ
الروائح العنصرية؟ أم كانت الدول التي ما تزال تعيش فيها جاليات مسلمة؟
وما الدافع إلى إطلاق ذلك التحذير والقمّة تناقش توسيع الحلف شرق
أوروبا وجنوبها، وضمّ سبع دول جديدة إلى النادي؟ وأيّ من هذه الدول
(التي تسلمّت وثائق عضويتها في الحلف يومذاك: إستونيا وبلغاريا
وسلوفينيا وسلوفاكيا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا)، لم تكن تنطبق عليها
معايير المضمار الحضاري الأورو ـ أطلسي؟
أياً كانت الأسئلة «الوجودية» فإنّ الأمر سيّان من حيث خلود جوهر الحلف، عسكرياً وسياسياً، ما دامت الولايات المتحدة هي الدولة الأهمّ في ضمان بقائه على قيد الحياة، وفي تعزيز شوكته التكنولوجية بصفة خاصة، دفاعاً وهجوماً على حدّ سواء
البعض يساجل، كما تفعل هذه السطور،
بأنّ أسئلة كهذه تظلّ نافلة كائناً من كان طارحها، ما دامت بنية الحلف
عسكرية ـ سياسية، وما دامت الولايات المتحدة في طليعة قيادته وتوجيهه
على أصعدة شتى لا تغيب عنها اعتبارات مصالح أمريكا الجيو ـ سياسة في
المقام الأوّل. صحيح أنّ الفرنسيين والألمان لا يكفّون عن مضايقة
البنتاغون، واليمين في إسبانيا خسر معركة الحلف المقدّس مع واشنطن،
وتراث الحلف في ليبيا والعراق وسوريا ليس البتة حصاداً يُعتدّ به… في
المقابل يعرف جميع أعضاء الحلف أنّ هزّة 11/9 منحت الولايات المتحدة
أكثر من ترخيص عسكري واحد؛ كما جنّبت واشنطن حرج التشاور مع الحليفات
الأطلسيات كلما رنّ ناقوس في كنيسة. وإذا كان لقاء براغ قد استحقّ
بالفعل تسمية «قمّة التحوّل»، فليس ذلك لأسباب عسكرية أوّلاً، وإنما
بسبب اختراق الناتو جميع مواقع حلف وارسو السابقة، وبلوغه ظهر روسيا
وبطنها وخاصرتها، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً!
صحيح، كذلك، أنّ التوازن داخل الحلف ليس مختلاً لصالح الولايات المتحدة
فقط، بل هو يفتقر بالفعل إلى جملة العناصر التي تتيح استخدام مفردة
«التوازن» وفق أيّ معني ملموس. مراسل صحيفة الـ «إندبندنت» البريطانية
اختار وجهة طريفة للتعبير عن هذا الاختلال، فسجّل حقيقة أنّ الوفد
الأمريكي إلى قمّة التحوّل تلك شغل سبع طبقات من فندق الهلتون الذي
احتضن الوفود، مقابل طبقة واحدة للوفد الهولندي مثلاً! وأمّا في
مصطلحات أخرى أكثر دلالة، فإنّ الولايات المتحدة تنفق، وحدها، مليار
دولار أمريكي يومياً على شؤون الدفاع، في حين أنّ مجموع الدول
الأوروبية الـ 15 الأعضاء في الحلف تنفق قرابة 500 مليون دولار. وكان
العالم بحاجة إلى انعدام الكياسة لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد
ترامب، كي يقرأ تغريدات مثل هذه: «من دون نجاح، حاول الرؤساء طوال
سنوات دفع ألمانيا وسواها من أمم الأطلسي الغنية إلى سداد المزيد لقاء
حمايتها من روسيا. إنهم يدفعون قسطاً ضئيلاً من نفقتهم. الولايات
المتحدة تدفع عشرات المليارات من الدولارات أكثر مما يتوجب لإعانة
أوروبا، وتخسر كثيراً في التجارة». أو هذه: «وفوق كل شيء، بدأت ألمانيا
تدفع لروسيا، البلد الذي تطلب الحماية منه، مليارات الدولارات لقاء
احتياجاتها من الطاقة عبر أنبوب آت من روسيا. هذا غير مقبول! جميع أمم
الناتو يجب أن تنفذ الالتزام بـ2٪، وهذا يجب أن يرتفع إلى 4٪».
والحال أنّ الأطلسي بدأ ذراعاً عسكرية أمريكية في الواقع العملي، حيث
الوحدات الأوروبية المنضوية في عداده ليست أكثر من استكمال للزخرف
الخارجي؛ وهكذا يظلّ الحلف اليوم، حتى بعد أن تضخم في العدد، وفي
العتاد، وفي مساحة الانتشار. لقد توسّع من 12 دولة مؤسسة، إلى 15 في
خمسينيات القرن الماضي، حتى بلغ اليوم 32 دولة، باحتساب السويد
وفنلندا؛ بينها ثلاث جمهوريات سوفييتية سابقة (إستونيا، لاتفيا،
ليتوانيا)، وسبع دول أعضاء سابقة في حلف وارسو المنقرض (بلغاريا،
رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ألبانيا، كرواتيا، بولندا)، وثمة في سجلّ
الطامحين إلى العضوية خليط متنافر يضمّ البوسنة والهرسك وجورجيا و…
أوكرانيا!
أمّا في مستوى التبشير الإيديولوجي، والعقيدة العسكرية، والغطاء
التعبوي، فإنّ مسوّغات وجود الحلف يمكن أن تبدأ من الجزم بأنه «الحلف
الأكبر والأكثر نجاحاً في التاريخ»، حسب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق
والجنرال المتقاعد كولن باول؛ ولن تنتهي عند يقين الرئيس الفرنسي
الأسبق نيكولا ساركوزي (الذي ارتدّ عن الفلسفة الديغولية، وأعاد فرنسا
إلى قيادة الحلف العسكرية) بأنّ الناتو هو الضامن الوحيد للأمن
الأوروبي، الذي يأتي ولا يأتي منذ عقود؛ فضلاً عن يقين دولة مثل
تشيكيا، بأنّ الفارق بين ركونها إلى الدفاع الأوروبي، مقابل الدفاع
الأمريكي، كالفارق بين الأرض والسماء!
وأياً كانت الأسئلة «الوجودية» هذه، أو سواها، فإنّ الأمر سيّان من حيث
خلود جوهر الحلف، عسكرياً وسياسياً؛ ما دامت الولايات المتحدة هي
الدولة الأهمّ في ضمان بقائه على قيد الحياة، وفي تعزيز شوكته
التكنولوجية بصفة خاصة، دفاعاً وهجوماً على حدّ سواء. صحيح أنّ
الفرنسيين والألمان حاولوا مضايقة واشنطن قبيل غزو العراق، سنة 2003؛
وأفغانستان، في عهد أوباما، انقلبت من جبهة ثانوية إلى أخرى مركزية…
ولكن من الصحيح أيضاً أنّه غير مسموح لأوروبا الغربية (الرأسمالية،
الحرّة، المعافاة نسبياً بسبب من جميل الولايات المتحدة في حماية
العالم الحر والرأسمالية…)، أن تزدهر أكثر من ازدهار الولايات المتحدة
نفسها، وأن توحّد صفوفها بالانتقاص من مبدأ الهيمنة الأمريكية على
النظام الدولي. لهذا فإنّ الولايات المتحدة تصبّ ما تشاء من زيوت على
حروب هنا وهناك، ولا تجد حرجاً حين تتفادى شرّ القتال، ولا فوارق كبيرة
هنا بين ترامب أو بايدن لجهة الافتقار إلى الدبلوماسية أو الإفراط في
تسخيرها.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
أمريكا المسيحية/الصهيونية:
أبعد من التوراة وفقه الانحياز
صبحي حديدي
منظمة «مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل»،
CUFI،
هي أكبر المنظمات الأمريكية الموالية لدولة الاحتلال الإسرائيلي من حيث
العدد (قرابة 10 ملايين منتسب حسب أحدث احصائياتها)، وحجم التبرعات
المرسلة إلى مختلف المؤسسات الإسرائيلية الحكومية والمستقلة (الأرقام
بمئات الملايين من الدولارات)، والانفراد عن غالبية مجموعات الضغط
اليهودية والصهيونية الأمريكية في إعلان التأييد الصريح للاستيطان
وتوسيع المستوطنات. ولأنها لا تفوّت فرصة من دون الإعراب عن التأييد
المطلق لدولة الاحتلال، على نحو أعمى وعشوائي وغير مشروط، فقد أصدرت
مؤخراً بياناً يستنكر القرار الذي أعلنه مكتب التحقيقات الفدرالي
الأمريكي بصدد إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين
أبو عاقلة، حاملة الجنسية الأمريكية.
لا جديد في محتوى البيان ونبرته العامة ومفرداته، وبعضها يسير هكذا على
سبيل المثال الأول: «صادم بقدر ما هو مريع أنّ وزارة العدل سمحت لبعض
أعضاء الكونغرس المعادين لإسرائيل بالضغط على فرع من السلطة التنفيذية
يُفترض أنه مستقلّ لإقرار هذا التحقيق. إسرائيل ديمقراطية وهي حليف
أمريكي، والإسرائيليون قد حققوا في هذه الحادثة بطريقة تليق
بالتوصيفين». وأيضاً، في مثال ثانٍ: «بدل أن يواجه الخصوم ويقف مع
حلفائنا، فإنّ الرئيس بايدن يقوم بالعكس تماماً. بدل أن يسمح لوزارة
عدله أن يستأسد عليها أعضاء في حزبه راديكاليون معادون لإسرائيل، على
الرئيس بايدن أن يركز على وضع حدّ لبرنامج السلطة الفلسطينية في تمويل
القتل، وعلى مساندة الدولة اليهودية لمواجهة الإرهاب الفلسطيني».
ولا جديد، كذلك، على صعيد مسارعة المنظمة إلى اعتناق الرواية
الإسرائيلية المبكرة حول مقتل أبو عاقلة، في أنها قُتلت برصاص مسلحين
فلسطينيين وليس بأيّ رصاص إسرائيلي؛ ثمّ استمرار المنظمة في تبنّي تلك
الرواية حتى بعد اضطرار سلطات الاحتلال إلى سحبها من التداول، أو حتى
بعد الحقائق الدامغة التي وفرتها تحقيقات أمريكية مستقلة أجرتها محطة
CNN
أو صحيفة «نيويورك تايمز»؛ وكلاهما لا يُعرف عنه العداء لدولة
الاحتلال، بل العكس هو الثابت الشائع. وهذه سطور لا تتوخى إبداء أيّ
عجب إزاء سلوك «مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل»، لأنّ أيّ موقف مختلف
ليس في الأصل منتظَراً منها في مقام أوّل؛ ولأنّ مواقف المنظمة منذ
الركائز الأولى لتأسيسها مطلع ثمانينيات القرن المنصرم لا يستقيم أن
تكون عجيبة، في مقام ثانٍ.
ما تتوخاه هذه السطور، في المقابل، هو التذكير مجدداً بالأبعاد
السياسية والدينية (المسيحية، الإنجيلية، البروتستانتية…) والثقافية
التي شكلت وتواصيل تشكيل مثاقيل كبرى تُحمل عليها شعبية المنظمة
ونفوذها؛ وتلك، استطراداً، هي الدلالات الأهمّ التي يتوجب أن تُستعاد
في كلّ حديث معمق عن الـ
CUFI،
أبعد من مجرّد تسجيل انحيازها إلى دولة الاحتلال، وأخطر ربما، وعلى
نطاق أوسع يعبر المحيط الأطلسي إلى حيث تصنع أية إدارة أمريكية فارقاً
نوعياً كونياً. ويكفي، ابتداء، التذكير بأنّ هذه المنظمة كانت إحدى
أبرز الركائز (شعبياً وشعبوياً ومالياً، إنجيلياً ثمّ توراتياً…) وراء
تصعيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتثبيت أركانه في قلب
الحزب الجمهوري، وصولاً إلى انتخابه واستيلاد المزيد فالمزيد من أركان
الترامبية كما تعرفها أمريكا اليوم، ويتابعها العالم بأسره معها.
بين العقيدة المذهبية الجَمْعية وعقائد تفوّق العرق الأبيض وفقه الهستيريا بصدد ارتباط عودة يسوع وخلاص «المجيء الثاني» بانتصار دولة إسرائيل… تتكاثر الوقائع والمناسبات والمظاهر التي بموجبها تتجذر أفكار مسيحية صهيونية لا تنأى إلا قليلاً عن العنصرية الصريحة والفاشية المقنّعة
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والاعتراف بالسيادة
الإسرائيلية على المستوطنات ومرتفعات الجولان السوري المحتل، والضغط
على الأنظمة الخليجية التابعة لإبرام ما باتت تُعرف باسم «اتفاقيات
أبراهام»… ليست سوى غيض ظاهر، من فيض في مساندة دولة الاحتلال وفير
وغامر، بعضه لم يتكشف تماماً كما تبشرنا مذكرات جاريد كوشنر صهر ترامب
وأحد كبار مهندسي التطبيع. بذلك فإنّ الترامبية، من زاوية تاريخ نشوئها
الحديث نسبياً وليس لجهة شعبيتها وتأصّلها الحثيث، ليست وحدها المسؤولة
عن انتشار تيارات المسيحية/ الصهيونية؛ وهنا الجذور الأجدر بالمتابعة
لظواهر تنغل وتتغلغل في الكتلة الصلبة من العقائد والنظريات والأعراف،
فضلاً عن الفِرَق والأقليات الدينية والمذهبية المسيحية. وبهذا فإنّ
المرء قد لا يكون بحاجة إلى بيانات الـCUFI
كي يتلمّس التوغّل الباطني الجارف للسرديات الدينية، في تأويلاتها
التوراتية خاصة، التي تسمح لهذا التبشير الإنجيلي بالتماهي الأقصى مع
سردية مركزية أولى ناظمة ارتكز عليها أحد أبرز الإنشاءات الرمزية لنشوء
الولايات المتحدة الأمريكية، في أنها «صهيون الجديدة»، أو «كنعان
الثانية».
تلك كانت صيغة ميتافيزيقية ـ أدبية، لا تخلو مع ذلك من روح تبشيرية
إمبريالية، تكمل النظرية الشعبية الأعمّ التي سادت منذ القرن الثامن
عشر في مختلف المنظمات المسيحية ـ الأصولية الأمريكية، والبروتستانتية
الإنجيلية بصفة خاصة. وفي اختصارها، غير المخلّ في الواقع، تقول هذه
النظرة بعودة يسوع إلى عالمنا، لتخليصه من الشرور، حين تكتمل جملة
شروط: قيام دولة إسرائيل، أوّلاً؛ ونجاحها في احتلال كامل أرض التوراة،
أي معظم المشرق، ثانياً؛ وإعادة بناء الهيكل الثالث في موقع، وعلى
أنقاض، قبّة الصخرة والمسجد الأقصى، ثالثاً؛ ورابعاً وأخيراً، اصطفاف
الكفرة أجمعين ضدّ إسرائيل، في موقعة ختامية سوف يشهدها وادي
أرماغيدون، حيث سيكون أمام اليهود واحد من خيارين: إمّا الاحتراق
والفناء، أو الاهتداء إلى المسيحية، الأمر الذي سيمهّد لعودة المسيح
المخلّص!
هنا، للمفارقة، صفة تناقضية لا ترضي غالبية اليهود من حيث أنها في
نهاية المطاف تُلزمهم بالاهتداء إلى المسيحية كشرط للخلاص، وهذا ما
يدفع عدداً من الحاخامات إلى رفض «الهدايا المسمومة» التي تقدمها منظمة
الـ
CUFI،
أو حتى استعداء الجموع عليها لأنها في الحصيلة لا تخدم الديانة
اليهودية إلا على أساس تقويضها وعن طريق ترسيخ الديانة المسيحية.
غالبية غير ضئيلة من اليهود، في أمريكا وداخل دولة الاحتلال، لهم رأي
آخر يتجاوز هذا التناقض، التأويلي في منتهاه والفقهي في الحساب الأخير؛
فيفضّلون ترجيح المكاسب الجمّة التي تجلبها منظمة الـCUFI
على أصعدة سياسية ومالية واجتماعية، والمثال القياسي هنا هو القمّة
التي عقدتها المنظمة في واشنطن، تموز (يوليو) 2019، وحضرها كلّ من رئيس
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي مايك
بنس.
وكان «معهد المشروع الأمريكي» قد نشر إحصائية تؤكد أنّ غالبية
الإنجيليين البروتستانت صوّتوا لصالح ترامب في سنة 2020، بمعدّلات
تجاوزت 81٪ في صفوف الناخبين البيض؛ على خلفية جديرة بالانتباه تشير
إلى أنّ هؤلاء هم المجموعة الدينية الأكبر في الولايات المتحدة، وأنّ
26٪ من الناخبين في صفوفهم يعلنون انتماءهم إلى المسيحيين الإنجيليين.
وبين العقيدة المذهبية الجَمْعية وعقائد تفوّق العرق الأبيض وفقه
الهستيريا بصدد ارتباط عودة يسوع وخلاص «المجيء الثاني» بانتصار دولة
إسرائيل… تتكاثر الوقائع والمناسبات والمظاهر التي بموجبها تتجذر أفكار
مسيحية صهيونية لا تنأى إلا قليلاً عن العنصرية الصريحة والفاشية
المقنّعة.
غير بعيدة في الزمن تلك الواقعة التي شهدت اضطرار الكنيسة
البروتستانتية الأمريكية إلى سحب كرّاس كانت قد وضعته على موقعها
الرسمي، لأنّ بضع منظمات يهودية أمريكية اعتبرته معادياً للعقيدة
الصهيونية، ولدولة الاحتلال استطراداً، رغم أنه لا ينطوي على أيّ عداء
للديانة اليهودية ذاتها. وكان الكرّاس بعنوان «صهيونية غير مستقرّة:
دليل دراسة للرعايا»، وقد تمّ إعداده لأغراض تعليمية تسهّل عمل أعضاء
هذه الكنيسة العاملين في الشرق الأوسط عموماً، والأراضي الفلسطينية
بصفة خاصة. وشخص الشهيدة أبو عاقلة، حين يقترن بمكتب التحقيقات
الفدرالي، كفيل بإثارة غضبة أشدّ وأعنف وأشرس من جانب الـCUFI،
وفاءً لموقعها الأثير كمخفر أمامي، سياسي ومالي وعقائدي وإعلامي، يحرس
تبييض الصفحة الصهيونية وتغذية فقه الانحياز الأعمى، سواء بسواء.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
الانتخابات النصفية:
غريزة القطيع وكواسر الذئاب
صبحي حديدي
في سنة 2016، قبل أسابيع قليلة من انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات
المتحدة، نشر الفتى جيمس دافيد فانس (مواليد 1984) كتاباً بعنوان
«مرثية ريفيّ» يجمع بين المذكرات والسيرة الذاتية، ويشدد على مشاقّ
الحياة في منطقة مدلتون، أوهايو، وفي بقاع الأبالاتشي الجبلية. الكتاب
أصبح في عداد الأكثر مبيعاً خلال أيام قلائل، ولم تمضِ أسابيع حتى
تجاوزت المبيعات ملايين النسخ، فكان طبيعياً أن تسارع نتفلكس إلى
اعتماد الرواية في فيلم أخرجه رون هاوارد وقامت غلين كلوز بدور البطولة
فيه. اليسار الأمريكي، خاصة ذاك التائه الباحث يائساً عن تمثيلات
مجتمعية في الأصقاع الريفية النائية، تلقف الكتاب وصاحبه فهلل له ورحّب
به؛ متشجعاً، كذلك، بمواقف فانس المناهضة للحزب الجمهوري ولمرشحه
الرئاسي دونالد ترامب.
ولسوف تحتاج أمريكا إلى ستّ سنوات فقط كي ينقلب ذلك الشقيّ الجبلي
الكئيب إلى ذئب ضارٍ متوحش، بكلّ ما تعنيه شراسة النوع وخصائصه في
الواقع كما في المجاز، إذْ أصبح أحد كواسر ترامب في المنطقة، واعتمده
الأخير على لائحة مرشحيه في الانتخابات النصفية الأخيرة، وفاز بالفعل
بمقعد في مجلس الشيوخ. وحين اختاره واحتضنه، سياسياً ومالياً، لم يكن
ترامب يجهل تفوهات فانس القديمة ضده، وبعضها كان مقذعاً تماماً؛ لكنّ
الرئيس السابق حرص على «تأديب» الفتى/ السناتور اليوم في الكونغرس،
فأعلن أنّ الأخير جاء إليه و»لحس الحذاء» على سبيل الزلفى وإعلان
الولاء، فسامحه الأب/ الأخ الأكبر للحزب الجمهوري، وأدرجه على لائحة
عشرات المرشحين الذين ساندهم.
والحال أنّ تحولات فانس ليست نموذجاً عجيباً أو طارئاً في الحياة
السياسية الأمريكية، وربما على صعيد أعرض نطاقاً يشمل التقلبات
الإيديولوجية من أقصى إلى أقصى نقيض؛ إلا أنّ المغزى الأهمّ فيها هو
روحية الانقياد شبه الأعمى التي باتت تتصف بها جماهير ترامب، ليس في
صفوف الحزب الجمهوري وحده، بل كذلك في عمق الاجتماع الأمريكي إجمالاً.
غريزة القطيع، التي يصحّ الاستئناس بها هنا في فهم عقلية الاتّباع لدى
الأتباع، لم تترك للناخب الذي صوّت لصالح فانس أيّ هامش مراجعة، سواء
حول ماضي شتائمه المقذعة ضدّ ترامب، أو حاضر لعق الحذاء مقابل اعتماد
الترشيح، أو مستقبل ما سيفعله للمناطق ذاتها التي شهدت شظف عيشه وشقاء
عائلته.
الماضي القريب، ضمن سجلّ الانتخابات النصفية إياها، كان في سنة 2018 قد
سجّل انتصار الحزب الديمقراطي وحيازة 41 مقعداً في مجلس النواب، وتلك
حقبة لم تكن بعدُ على أعتاب تسمين الكواسر من ذئاب وضباع في مزرعة
ترامب، على غرار الفتى فانس؛ إذْ توجّب تفعيل اختمار من طراز آخر، كان
استثماره لا يبدأ من التشكيك في صحة الانتخابات الرئاسية، ولا ينتهي
عند اقتحام مبنى الكابيتول. لكنّ صنفاً آخر من الوحوش الكاسرة ظلّ
يترعرع في كنف ترامب والترامبية، وكان مسعاه المركزي هو حشر التوراة في
صناديق الانتخابات النصفية، على مثال جون كيلباتريك، راعي كنيسة في
ولاية ألاباما، الذي قارن بين ما يواجهه ترامب من «أعمال السحر»
الخبيثة، وما سبق أن واجهه النبي إيليا مع إيزابيل الزانية الساحرة (في
سفر الملوك 2، 9:22). وبتفويض من هتاف المؤمنين في الكنيسة، تابع
كيلباتريك خيط الهلوسة والاستيهام هكذا: «لستُ سياسياً، ولكني لا أرى
كيف يستطيع الرئيس ترامب تحمّل هذا كله. إنه أقوى من أيّ رجل عرفته في
حياتي. ولكن اسمعوا ما قاله لي الروح القدس الليلة الماضية، وطالبني أن
أخبركم به. قال: أبلغ الكنيسة أن ترامب كان طيلة الوقت يجابه آخاب. لكن
إيزابيل تتآمر الآن كي تنبعث من الظلمات. هذا ما أبلغني به الروح
القدس».
وبين الراعي المديني كيلباتريك والريفي الجبلي فانس لا تغيب أمريكا
الأعمق، بل تواصل الحضور والتضخم في اجتماع غريزة القطيع وكواسر
الذئاب.
من يتذكر شولاميت ألوني؟
صبحي حديدي
عودة بنيامين نتنياهو، أقوى من ذي قبل أيضاً، ليست مفاجأة في ذاتها إلا عند عقولٍ وفئاتٍ وأجهزة تفكير لا تقوم بصدد دولة الاحتلال الإسرائيلي بما هو أبعد من تقليب الكليشيهات القديمة المستعادة؛ حول «الديمقراطية الأوحد في الشرق الأوسط»، أو «لو لم توجد، لتوجّب أن نخلقها»، أو «دولة شعب بلا أرض، في أرض بلا شعب»؛ أو، لمَن شاء التوسّع والوقوف على رأي إسرائيلي، الأساطير العشر التي ناقشها إيلان بابيه في كتاب يحمل العنوان ذاته، صدر سنة 2017.
ليست مفاجأة، على قدم المساواة، انتظار توزير فاشي عنصري استيطاني مثل إيتمار بن غفير، بدأ حياته السياسية بسرقة سيارة رئيس حكومة الاحتلال إسحق رابين، سنة 1995، معقباً بأنّ الوصول إلى السيارة يعني أيضاً إمكانية الوصول إلى جسد صاحبها ذات يوم، وهذا ما حصل بالطبع وإنْ برصاصات إيغال عمير. وشرطة الاحتلال التي أخرجته بالقوّة من مبنى الكنيست، سوف تحرس قريباً عودته إلى وزارة ما، حيث لن تتغير كثيراً أعمال الشغب والعنصرية والسباب المقذعة التي يكيلها للعرب، إلى جانب انحيازاته لمنظمات إرهابية من كلّ حدب إسرائيلي وصوب.
طريف، حتى من باب الشماتة الهادفة (كما هي حال هذه السطور) أن يتوقف
المرء عند معطى واحد محدد في نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة؛ أي عجز
حزب «ميرتس»، واجهة ما كان يُسمى «اليسار» بين الأحزاب الإسرائيلية، عن
بلوغ نسبة الـ 3.25٪ المؤهلة للدخول إلى الكنيست، للمرّة الأولى منذ
تأسيسه عام 1992؛ وتلك، عند زهافا غال – أون، زعيمة الحزب، «لحظة صعبة
للغاية بالنسبة لي، ولأصدقائي (…) وهي كارثة على ميرتس، كارثة للبلاد،
ونعم، كارثة شخصية بالنسبة لي».
والحديث عن هذا «اليسار» الإسرائيلي الآخذ في الانقراض يقود إلى شخصية شولاميت ألوني (1928 – 2014)، «أمّ حركة ميرتس» كما كانت تُلقّب، في إشارة إلى موقعها السابق المتقدّم ضمن المجموعة التي تأسست سنة 1992 كتحالف بين «راتس» و«مابام» و«شينوي»، وحصلت على 12 مقعداً في انتخابات الكنيست لذلك العام. ألوني هي الوحيدة التي تجاسرت على استعادة اقتباس شهير يُنسب إلى إيغال آلون (1918 ـ 1980)، ويفيد المعنى التالي، ليس حرفياً بالطبع: لوحات الفنان الروسي ـ الفرنسي اليهودي مارك شاغال، وحدها تقريباً، تتيح للبشر أن يسبحوا في فضاء ميتافيزيقي ملوّن، بعيداً عن الأرض بمعانيها المجازية والفلسفية، وبعيداً كذلك عن الأرض بمعانيها الفيزيائية الدنيوية، حيث الحياة والمجتمع والسياسة.
ومن منبر الكنيست، ذات يوم مضى وانقضى وانطوى، استعادت ألوني مخلوقات
شاغال كي تذكّر ساسة دولة الاحتلال بأنّ أيّ مفاوضات مع الفلسطينيين
ينبغي أن تضع جانباً، ونهائياً، مناخات شاغال التي تلغي أرض البشر؛
لأنّ المعطى الفلسطيني لا يحتمل إسقاط الأرض من لوحة الأرض الفلسطينية
المحتلة، ولا من أية لوحة فلسطينية أخرى حيث يعيش البشر ضمن قوانين
الجاذبية… جاذبية التاريخ والهوية والحقوق والسياسة!.
وعلى نحو أو آخر، لا تقول انتخابات الكنيست الأخيرة إنّ زمن «ميرتس»
تحجبه اليوم أزمنة بن غفير وبتسلئيل سموطريتش ووَرَثة الكاهانية في
أسوأ أنماطها العنصرية والفاشية. نادرون، إذن، أولئك الذين سوف يتذكرون
ألوني (ذلك «اليسار» الشاحب الوسطي المتقلب التائه…!)؛ والأرجح أنّ
استعارة شاغال لن تُستعاد إلا من باب الحنين إلى شطر من شخصية آلون
يلائم واقع الحال الراهنة في دولة الاحتلال: أنه كان أحد أبرز رجال
عصابات الـ«هاغاناه»، وأحد مؤسسي الـ«بالماخ» ذراعها العسكري
الإرهابيّ، وقائد الجبهة الجنوبية خلال حرب 1948؛ وأخيراً، وليس آخراً:
صاحب خطة السلام الشهيرة التي تحمل اسمه، وتقضي بضمّ الضفة الغربية، أو
«يهودا والسامرة» في تعبيره، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن من
دون السماح للجيش الأردني بالانتشار فيها.
«كاهانا حيّ»، خلاصة القول؛ بل هو يتمطى ويعوي ويتمدد!
(يا رب ترجع أيامكم):
مصر ومختبر آل مبارك
صبحي حديدي
في مناسبتَين معلنتَين على الأقل، زيارة قبر والده والمشاركة في تشييع
محامي الأسرة فريد الديب، خلال الشهر المنصرم تشرين الأول (أكتوبر)،
سمع جمال حسني مبارك هذه الهتافات، وسواها: «ما يتعوضتش»، «الدولار كان
بكام، والنهار ده بكام»، «ربنا ينتقم منهم»، «ويمكرون ويمكر الله،
والله خير الماكرين»، «هو جمال إن شاء الله بإذن الله»، «حبيب الشعب
كله، وأبوه»، «يا رب ترجع أيامكم»… ليس عسيرا، بالطبع، أن يجري استئجار
أنفار هنا وهناك، وظيفتها إطلاق هذه الهتافات وإشاعة أجواء احتفاء بنجل
الرئيس المصري الذي أطاحت به انتفاضة شعب مصر في كانون الثاني (يناير)
2011، وكانت مشاريع توريثه وفساده ومفاسده مع شقيقه علاء أحد أبرز
أسباب الانتفاضة.
لا يصح أن يكون عسيرا، في المقابل، ألا تُستخلص عبرة جوهرية من وراء ما
سمعه ويسمعه مبارك الابن اليوم من عبارات التهليل والترئيس، مفادها
إعلاء راية الاعتراض على نظام عبد الفتاح السيسي أكثر بكثير من الحنين
إلى نظام مبارك، من جهة أولى؛ وأن الأمر بأسره يبدو أقرب، من جهة
ثانية، إلى مختبر تجريبي يتلمس تحالفات موشكة، أو في طريق الصياغة
الابتدائية؛ بصدد سيناريوهات استبدال مكونات سلطة السيسي الراهنة، في
الجيش ومؤسساته الاقتصادية وشركاته الاستثمارية، وفي أجهزة المخابرات
واستطالاتها الداخلية والخارجية.
والأرجح أن أول الخيوط خلف تلك السيناريوهات ليست ما يُشاع عن عتبات
تعاون، أو حتى تنسيق فعلي وميداني، بين جماعة الإخوان المصرية وآل
مبارك والشركاء وأصحاب المصلحة في استعادة نظام مبارك؛ أو بين مجموعة
مبارك الابن وأمثال سامي عنان، وهذا الضابط الكبير أو ذاك. مرجح، هنا
أيضا، أن الخيط الأهم جاء عبر وساطة دولة الإمارات، والشيخ محمد بن
زايد شخصيا، لدى السيسي كي يسمح لكل من جمال وعلاء بالسفر إلى أبو ظبي
وتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد. ذلك لأن الواجب لم يقتصر
على التعزية وحدها، بل على تهنئة بن زايد بتوليه رئاسة الإمارات، في
غمرة جفاء إماراتي ـ سعودي غير معلَن تجاه السيسي، ألمح إليه الأخير في
خطبة ألقاها خلال مؤتمر الاقتصاد الأخير.
سلسلة الانتصارات القضائية، التي أحرزتها أسرة مبارك منذ شباط (فبراير)
الماضي، على أصعدة مصرية أو سويسرية أو اتحادية أوروبية، قد لا تكون
جزءا من عمليات إعادة التأهيل داخل المختبر إياه؛ ولكن يصعب ألا تكون
عنصرا بالغ التأثير، بل حاسم الفعل أيضا، من زاوية أنها أفرجت قانونيا
عن مليارات كانت مجمدة أو خارجة عن معادلات صياغة النفوذ وبناء شبكات
الولاء ورفع الصوت الصارخ بـ«يا رب ترجع أيامكم». صحيح، ومؤكد بدرجة
إطلاق عالية، أن مليارات آل مبارك التي نُهبت وكُدست على مدى عقود لن
تعود إلى خزائن مصر الدولة ومصر التنمية ومصر الجنيه الهابط أسفل
سافلين، وليس إلى سواد شعب مصر الجائعة الفقيرة العطشى المريضة
المقهورة؛ فالسارق لن يعيد المسروقات، بقدر ما سيصرف بعضها على ضمان
تمكينه من مسروقات أخرى. ليس أقل صحة، في المقابل، أنها مليارات صانعة
للسلطة ومولدة للنفوذ، تشتري الرضا الخارجي عزيز المنال، مثلما تُكسب
صاحبها منعة ومناعة.
ولأن المؤسسة العسكرية هي التي تحكم مصر منذ سنة 1952، عبر محمد نجيب وعبد الناصر والسادات ومبارك ومحمد حسين طنطاوي والسيسي؛ فإن المختبر قد يلجأ إلى مشير ما، قابع في الظل، حتى على سبيل تلبية الشكل من دون المساس بالمحتوى الفعلي
وذات يوم أطلقت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية «نكتة سوداء»، إذا صح
التعبير، حين تساءلت في عنوان واحد من مقالاتها الرئيسية: «هل يوجد
غورباتشوف على ضفاف النيل؟»؛ وكان كاتب المقالة جاكسون ديل يعلق على
زيارة مبارك الابن إلى واشنطن، ويحاول أن يضع سياقا سياسيا أمريكيا
ومصريا للأسباب التي جعلت نجل الرئيس المصري يُستقبل بصفة رسمية في
البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون. بالطبع، كان السياق المصري
هو التقارير والمؤشرات والوقائع التي تتحدث عن خلافة الابن لأبيه، وكان
السياق الأمريكي هو أن الإدارة قابلة بهذا التوريث مادام الفتى لا يشبه
أبيه في الولاء للولايات المتحدة، فحسب؛ بل يسابقه ويسبقه ويتفوق عليه!
يومذاك كان نظام مبارك الأب قد أعاد تفعيل مركز جديد للسلطة، عُهد إليه
هذه المرة بتمهيد الطريق أمام التغيير القادم في قمة الهرم، وإعطاء
إشارات كافية حول الخلافة؛ وكان ذلك المخلوق هو «الحزب الوطني
الديموقراطي»، القديم والحاكم نظريا منذ عهد الرئيس الراحل أنور
السادات، ويفترض في ذاته احتواء «الأغلبية» الشعبية المصرية. وتلك
محاولة انطوت على مخاطرة الإيحاء بأن المركز التقليدي للدولة، أي
الرئاسة، قد ضعف أو هرم ويحتاج إلى تجديد، والإيحاء بأن الأوان قد آن
لتبديل الشيوخ بالشباب، ولإطلاق سيرورة توريث مبارك الابن. ومن جانب
آخر كان الحزب قد جازف بالخوض في مجالات حساسة مثل البحث عن الهوية
السياسية وأساليب الحكم وحقوق الانسان ومعضلات المجتمع، واعتماد شعار
فضفاض ومثير للإحراج في آن معا هو «الفكر الجديد وحقوق المواطن».
وخلال مؤتمر مشهود للحزب، وبعد ثلاثة أيام من المناقشات التي غاب عنها
تماما، حضر مبارك الأب وألقى كلمة برهنت أن أبرز أهداف المؤتمر هو
تكريس الدور المحوري لولده جمال، وذلك حين تبنى الأب كل الأفكار
والاقتراحات التي سبق للابن أن عرضها في الجلسة الافتتاحية تحت عنوان
«الإصلاح السياسي وحقوق المواطن». أعلن مبارك الأب إلغاء الأحكام
العسكرية الصادرة على عشرات الآلاف من المواطنين الذين تعدوا على
الأراضي الزراعية وحولوها الى مناطق سكنية، ودعا أحزاب المعارضة الى
حوار وطني والى تفعيل دورها في المجتمع المصري، وعقد مؤتمراتها وتنظيم
حملاتها، وفتح الباب أمام تعديل قانون الجنسية الذي يمس الآلاف من
أبناء المصريين والمصريات المتزوجين من أجانب…
منطقي بذلك، ومنتظَر أغلب الظن، أن يبدأ مختبر إعادة تأهيل مبارك الابن
من هذه المناخات، التي ستنوب عن الحزب في الترويج لها أطرافٌ متنوعة
شتى؛ لها أن تبدأ من الجماهير الهاتفة بـ«يا رب ترجع أيامكم»، و«هو
جمال إن شاء الله»؛ وأن تمر بهذا الضابط الساخط في الجيش/ المؤسسة
الاستثمارية أو ذاك في الجهاز الأمني، ورجل أعمال يمثل تماسيح النهب
تارة أو آخر يقود قطعان ذئاب الفساد تارة أخرى؛ ولا تنتهي في أبو ظبي
والرياض وتل أبيب، فضلا عن واشنطن داخل أروقة البيت الأبيض والكونغرس
والبنتاغون. مبكر، مع ذلك، وربما بسبب من ذلك تحديدا، أن يعطي المختبر
ذاته نتائج ملموسة أو واضحة بما يكفي؛ حتى إذا كانت مؤشرات من قلب
السلطة تفيد بأن هواجس ما يُختبر لتوه تقلق النظام.
للمرء أن يبدأ من محاولات السيسي رشوة الشارع أو امتصاص النقمة، من
خلال رفع الحد الأدنى للأجور (حتى بمعدل 300 جنيه!)، والدعم المالي عبر
بطاقات التموين، ومنح علاوة استثنائية (بالمبلغ الأيقوني الهزيل ذاته:
300 جنيه!). وللمرء أن ينتقل إلى عصبية النظام في التعامل مع الدعوات
إلى المشاركة الجماهيرية الأوسع في حملة «11/11» يوم 11 تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل)، التي تكتسب المغزى من تزامنها مع احتضان مصر قمة
المناخ «كوب 27» في السادس من الشهر الجاري؛ والتي سيسعى إلى هندستها
مجددا المقاول والممثل المصري محمد علي، صاحب فيديوهات التفضيح الشهيرة
خريف 2019.
ولأن المؤسسة العسكرية هي التي تحكم مصر منذ سنة 1952، عبر محمد نجيب
وعبد الناصر والسادات ومبارك ومحمد حسين طنطاوي والسيسي؛ فإن المختبر
قد يلجأ إلى مشير ما، قابع في الظل، من باب الوفاء لإرث العسكر، حتى
على سبيل تلبية الشكل من دون المساس بالمحتوى الفعلي.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
البرهان ومكوّناته المدنية:
مَن يشتري الوقت؟
صبحي حديدي
ليست قلّة إنصاف أن تُعقد مقارنة بين ماضي السودان القريب كما حكمه عمر
البشير قبيل إسقاطه، وبين راهن السودان كما يُحكِم جنرالات الجيش
السوداني قبضاتهم العسكرية والأمنية على مقدراته؛ بزعامة قائد الجيش
الانقلابي عبد الفتاح البرهان وشريكه في الهيمنة محمد حمدان دقلو قائد
«قوات الدعم السريع»؛ ومن خلفهما حفنة صغيرة من الضباط الأدنى رتبة
وسطوة، ولكن ليس البتة أقلّ تعطشاً إلى النفوذ والبطش.
وكي يبدو اليوم أشبه بالبارحة، ليس من الضروري أن يتشابه انقلاب
البرهان يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، مع انقلاب البشير أو أيّ
انقلاب آخر سبقه، فضلاً عن أيّ انقلاب يُحتمل أن يعقبه إذا بلغت
تناقضات قوى الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ومفارز دقلو نقطة قصوى
يطفح عندها الكيل ويتحتّم الانفجار. والتظاهرات التي تعمّ السودان لا
تسجّل مرور سنة أولى على انقلاب البرهان فقط، بل تعيد التشديد على تلك
المحطات الانقلابية التي أطلقت عهود الاستبداد في البلد.
بعد سنتين فقط من استقلال السودان عن التاج البريطاني، عام 1956، قاد
الفريق إبراهيم عبود الانقلاب العسكري الأوّل، في تشرين الثاني
(نوفمبر) 1958؛ أعقبه العقيد جعفر النميري بانقلاب عسكري ثانٍ، في سنة
1969، اقترن أيضاً بالإجهاز على انتفاضة 1964 التي أنهت دكتاتورية
عبود؛ وأمّا المشير محمد سوار الذهب فقد كان استثناء قاعدة العسكر،
فعهد بالحكم إلى جهة مدنية بعد الإطاحة بنظام النميري. لكنّ تباشير
النفط في البلد أسالت لعاب القوى العظمى، وأعادت تأجيج شهية
الانقلابات، ووضعت البشير في سدّة الحكم سنة 1989.
وليس ما يُشاع اليوم عن اقتراب العسكر من صيغة اتفاق دستوري مع المكوّن
المدني سوى إشارة أخرى على طرازَين من التفاعلات التناحرية داخل سلطة
الانقلاب: بين الجيش والأجهزة الأمنية وقوات دقلو، من جهة أولى؛ وعند
هؤلاء جميعاً إذْ تدنيهم أحوال البلد الاقتصادية والمعيشية من حافة
مواجهات التصفية والتصفية المضادة أو التفاهمات الأقرب إلى صفقات
تواطؤية، من جهة ثانية. وإذا ظلت تفاصيل الاتفاق المزعوم بين العسكر
والمدنيين طيّ الكتمان، أو التكتم المتبادل بالأحرى، فإنّ عناصرها
الكبرى الجوهرية لن تأتي بجديد دراماتيكي في أحجام التنازلات بين
الطرفين؛ خاصة تلك الضمانات التي يشترطها الجنرالات، حول: 1) إعفائهم
من المساءلة القضائية عن مخالفات الماضي، في أيام البشير كما في أيام
البرهان؛ و2) تمكينهم من قبضة عسكرية وأمنية مستقلة، لا تقصيهم عن آلة
القرار وصناعته؛ و3) إبقاء التشكيلات العسكرية الخاصة، و»قوات الدعم
السريع» تحديداً، بمنأى عن الدمج في بنية الجيش أو الخضوع لأي شكل آخر
ينتهي إلى التفكيك…
وحين وافق جنرالات السودان على تسليم رئاسة الحكومة إلى عبد الله
حمدوك، والإيهام بأن السلطة باتت مدنية، كانت الضغوطات الخارجية
الدولية والأفريقية ومؤسسات مثل صندوق النقد الدولي هي محرّك القرار؛
الأمر الذي أحسن العسكر المناورة فيه وشراء الوقت ريثما تُستكمل
ترتيبات البيت العسكري والأمني الداخلي، وينفض البرهان وشركاؤه يدهم من
ترئيس حمدوك. اليوم تُستعاد مناخات مماثلة، فنقرأ تغريدة من وزير
الخارجية الأمريكي يقول فيها إن الوقت قد حان «لإنهاء الحكم العسكري»؛
وتحث 13 دولة، صحبة الاتحاد الأوروبي والآلية الثلاثية، على تشكيل
حكومة انتقالية يقودها مدنيون. ولا عجب، استطراداً، أن يسرّب الجنرالات
فتات معلومات عن قرب التوصل إلى اتفاق مع المكوّن المدني.
وهذا، على وجه التحديد، هو الشرك الذي يتوجب على القوى المدنية أن
تتفادى الوقوع فيه، لجهة تكرار الأخطاء ذاتها من جانب المدنيين، أو
إعادة إنتاج الخيارات القاصرة التي أفقدت الشارع الشعبي زخماً ثميناً
وأثخنته بالجراح والانكسارات والتضحيات؛ كما أكسبت العسكر أكثر من جولة
واحدة، ولا فرق أنّ إخراجها كان انقلابياً، أو أنّ سيناريوهاتها تعيد
ترسيم التناظرات بين البشير والبرهان.
عودة برلسكوني:
أيّ أثمان سوف تدفع إيطاليا؟
صبحي حديدي
ليس في الإمكان أفضل مما كان، يجوز القول تعليقاً على موقف الاتحاد
الأوروبي من زجاجات الفودكا التي أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى صديقه سلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق على ثلاث
دفعات، بمناسبة عيد ميلاد الأخير: إنها (الزجاجات الـ20، في التأويل
الأخبث المشروع) تخرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو! وأمّا
صيغة «لا تعليق» فإنها الخيار الذي احتكم إليه مسؤولو الاتحاد، رداً
على التسريبات الصوتية الأخرى التي نقلت مواقف برلسكوني الحقيقية من
الاجتياح الروسي لأوكرانيا: أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي هو
الذي بدأ الحرب، واستفزّ بوتين؛ وأنّ الأخير هبّ دفاعاً عن الروس في
دونباس، لكن العملية المحدودة التي كانت أهدافها احتلال أوكرانيا
وإسقاط زيلنسكي أصبحت الآن حرب الـ200 سنة…
في التسريبات الأخرى ثمة ما هو طريف (أنّ برلسكوني هو أحد خمسة أصدقاء
مقربين من بوتين، على نطاق العالم)؛ وما هو جامع بين البلاهة والطراز
المَرَضي من الغطرسة (أنه ليس في الغرب قادة بالمعنى الحقيقي وأنه، أي
برلسكوني، القائد الحقيقي الوحيد)، وهذا الشطر الذي يخصّ الغرب
(بالمعاني الجغرافية والحضارية والجيو – سياسية والأطلسية تحديداً)
يكتسب دلالة بالغة الخصوصية بالقياس إلى مواقف برلسكوني المأثورة تجاه
«العوالم» الأخرى خارج نطاق الغرب، خاصة تلك التي لا تعتمد القِيَم
اليهودية – المسيحية عموماً، وتلك الإسلامية بصفة خاصة. إنه القائل،
بالفم الملآن ومن موقع رئاسة الحكومة وليس من مقاعد المعارضة أو خلال
تسريبات صوتية: «حضارتنا متفوّقة على حضارتهم (المسلمين أساساً، وشعوب
الأرض الأخرى غير الأوروبية قاطبة وضمناً)، ولهذا ينبغي على الغرب،
واستناداً إلى تفوّق قِيَمه، أن يُغَرْبن
Occidentalize
ويغزو
Conquer
شعوباً جديدة». وكي يضرب أمثلة من العالم المحسوس، وليس العالم
الافتراضي وحده، استذكر أنّ «الغرب فعلها مع العالم الشيوعي ومع جزء من
العالم الإسلامي، ولكن للأسف مع جزء من العالم الإسلامي يعود إلى 1400
سنة إلى الوراء».
جسيمة سوف تكون الأثمان التي ستدفعها إيطاليا جراء عودة برلسكوني، من هذه البوّابة اليمينية المتطرفة تحديداً؛ وعلى أصعدة شتى سوف تتجاوز السياسة والاقتصاد والرياضة والإعلام، إلى الحريات العامة والمدنية وحقوق الرأي والتعبير.
هذه، في قراءة أخرى لا يصحّ إغفالها، استعادة جديدة للمهمّة العتيقة
التي ظنّ الغرب ــ و»الرجل الأبيض» في عبارة أوضح ــ أنها ملقاة علي
عاتقه: «المهمة التمدينية»
Mission Civilisatrice
التي تحدّث عنها الشاعر البريطاني الكولونيالي روديارد كبلنغ: «فاحملْ
عبء الرجل الأبيض/ واصنعْ لحروب الهمج السلام». الفارق أنّ برلسكوني
نطق بما كان، ويظلّ اليوم أيضاً، يعتمل في صدور رهط واسع من الساسة
وصانعي القرار وخبراء الستراتيجيات والمعلّقين في الولايات المتحدة
والغرب إجمالاً، إذا وضعنا جانباً مشاعر الشرائح الأعرض في ما تطلق
عليه العلوم الاجتماعية توصيفات مثل «الدهماء» أو «الشارع» أو «السواد
الأعظم». فارق برلسكوني أنه تجاسر على النطق في أزمنة جعلت الآخرين
يجنحون إلى الكتمان أو اللغة الدبلوماسية أو الألعاب اللفظية، كأن
يردّد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن تعبير «الحملة الصليبية»
ثم يتراجع عنه تدريجياً حرصاً على مشاعر المسلمين؛ أو أن يختار البيت
الأبيض للعمليات العسكرية/ المجازر المقبلة في العراق تسمية «عدالة
لانهائية»، ثمّ يستبدلها سريعاً بتسمية أخرى لا تخلط بين عدالة الأرض
وعدالة السماء… كرمى لمشاعر المسلمين هنا أيضاً!
والموقف الإيطالي الرسمي في الاصطفاف التامّ خلف الغزو الأمريكي –
البريطاني للعراق، كما رسمه برلسكوني وأشرف على تنفيذه، كان في الواقع
أقرب إلى سياسة قوامها التبعية (الغربية ذاتها، التي يسخر منها
برلسكوني اليوم) وعقلية اقتناص الأرباح السريعة البادية للعيان؛ تماماً
كما هي حال أيّ رجل أعمال مبتذل. أركان الموقف ذاك نهضت، أيضاً، على
الغطرسة والعنصرية والتحقير الثقافي والحضاري للآخر، العربي والمسلم
بصفة عامة. وحين أفادت الأخبار بمقتل 18 إيطالياً في الناصرية، لم يجد
برلسكوني ضرورة لمواساة شريحة واسعة من الإيطاليين رافضي التدخل في تلك
الحرب القذرة، بل صرّح بأنّ «أيّ ترهيب لن يثنينا عن التصميم على
المساعدة في بعث هذا البلد [العراق]، وبناء حكومة ذاتية، وتحقيق الأمن
والحرّية»! وتلك كانت بلاغة فخمة/ جوفاء تصدر عن أحد أسوأ نماذج انحطاط
الديمقراطيات الغربية، حيث يُتاح لرجل الأعمال وأغنى أغنياء إيطاليا أن
يشتري السياسة بالمليارات، وأن يمارسها على وتيرة عقد الصفقات التجارية
أو شراء الأندية الرياضية وأقنية التلفزة أو تمويه فضائح الفساد
والمباذل الجنسية…
صحيح أنّ برلسكوني يعود اليوم إلى الواجهة من بوّابات تحالف حزبه
«فورزا إيطاليا» مع حزب جورجيا ميلوني «إخوة إيطاليا» وحزب ماتيو
سالفيني «الرابطة»، وأنّ اليمين المتطرف هو الذي يعود فعلياً إلى سدّة
السياسة الإيطالية؛ مؤكداً صعوداً ملحوظاً، متعاقباً ومتماثلاً وإنْ
تمايز نسبياً، لليمين إياه في هنغاريا والسويد وفرنسا، وقبلها في
النمسا وإيطاليا ذاتها. ليس أقلّ صحّة، في المقابل، أنّ وجود برلسكوني
في الحياة السياسية الإيطالية يختلف عن صعود ميلوني وحزبها (الذي نال
4% فقط في الانتخابات العامة الماضية سنة 2018)؛ وهو فارق يخصّ الظاهرة
المتأصلة لدى الأوّل، مقابل «الطفرة» التي يمكن أن تنتهي إلى الطارئ
والمؤقت لدى الثانية.
ليست نقلة عابرة، لا قيمة لها ولا دلالة بعيدة الغور، أن يستسهل
برلسكوني هجاء «الغرب»، هو الذي اعتمده مفهوماً حضارياً مسيحياً
أوّلاً، ثمّ مصدر القِيَم ضمن التراث اليهودي – المسيحي تالياً، وليس
بالمعنى العقائدي العريض، المكرور أو المستنسَخ أو الديماغوجي/
الشعبوي، فحسب؛ بل، أساساً، بمعنى تسخير هذا كله، وسواه، لتغذية جوع
جموع حاشدة عنصرية المزاج وانعزالية الهوس تلتفّ حول «الثقافة» اليومية
التي يوفّرها برلسكوني، عبر أمواله وأنديته الرياضية وأقنيته، أسوة
بخطاباته الشعبوية. ولم يكن غريباً أنه سارع إلى التراجع عن الجزء
الساخر من الغرب في التسريبات الصوتية، وأوكل إلى أنتونيو تاجاني منسّق
«فورزا إيطاليا» أمر التشديد على «انحياز الحزب التامّ لصالح حلف
الناتو والعلاقات الأطلسية والعلاقات مع أوروبا، والوقوف ضدّ الغزو
الروسي غير المقبول لأوكرانيا».
وعودة برلسكوني اليوم تعيد التذكير بأنه، حين كان رئيس الوزراء وزعيم
حزب «شعب الحرّية» قائد الائتلاف الحاكم في إيطاليا؛ كان، في الآن
ذاته، مالك ثلاث أقنية أرضية من أصل سبع، مكّنته من بسط نفوذ واسع على
الحياة الإعلامية، سواء في القطاع الخاص أم في القطاع الحكومي. وتلك
حقبة شهدت قرار وزير الثقافة الإيطالي ساندرو باندي مقاطعة مهرجان كان
السينمائي الفرنسي الشهير، احتجاجاً على عرض الشريط الإيطالي «دراكيلا،
حيث ترتجف إيطاليا». ولقد اعتبر الوزير أنّ الشريط، الذي يمزج الوثيقة
بالخيال، ينطوي على «إهانة للحقيقة وللشعب الإيطالي بأسره»، ولهذا فإنّ
وزارته لن تشارك في المهرجان، وهو شخصياً يرفض تلبية الدعوة لحضور حفل
الافتتاح. أمّا الفيلم المعنيّ فقد استحقّ سخط الوزير لأنّ مخرجته
سابينا غوزاني في طليعة أشدّ منتقدي برلسكوني، وأبرعهم في استخدام
الفنّ السابع لكشف مباذله وفضائحه.
والأصل أنّ الديمقراطيات الغربية التي تسجّل صعود يمين ميلوني
وبرلسكوني وأمثالهما ليست البتة معافاة، حتى إذا كانت أمراضها عابرة أو
قابلة للعلاج أو حتى تحت السيطرة. الأصل، كذلك، أنّ الشارع الشعبوي
الذي يقف خلف ظواهر الصعود هذه يؤمن أنها ضامنة القِيَم والدين
والهوية، ولا يبصر ما يكمن عميقاً في جذور تكوينها من عطالة إزاء
معالجة العمل والتعليم والصحة والخدمات والاجتماع والحياة اليومية.
جسيمة، أغلب الظنّ، سوف تكون الأثمان التي ستدفعها إيطاليا جراء عودة
برلسكوني، من هذه البوّابة اليمينية المتطرفة تحديداً؛ وعلى أصعدة شتى
سوف تتجاوز السياسة والاقتصاد والرياضة والإعلام، إلى الحريات العامة
والمدنية وحقوق الرأي والتعبير.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
صعود الفاشية الأمريكية:
إعادة تجهيز الجاهز
صبحي حديدي
لا يفتقر المرء إلى مؤلفات جادّة المنهج ورصينة الطرح في معالجة صعود
الفاشية المتنامي في الولايات المتحدة، والأنساق المختلفة التي تتخذها
هذه الظاهرة في قلب المجتمع بصفة عامة، ولكن أيضاً في المستويات
القيادية العليا للحزب الجمهوري؛ وانتقال مفاعيل التفكير الفاشي إلى
مؤسسات مثل الكونغرس والمحاكم الفدرالية والإعلام والصحافة والجامعات
ومراكز الأبحاث. ولم تكن تلك المؤلفات تنتظر تنبيه الرئيس الأمريكي جو
بايدن شخصياً، في الخطبة التي ألقاها أمام قاعة الاستقلال في فيلادلفيا
مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، وباتت الآن شهيرة ومعيارية، حتى يتعاقب
صدورها؛ وتقرع عدداً من أخطر أجراس الإنذار حول الأخطار الكبرى خلف
تصاعد التيارات الفاشية على امتداد الولايات المتحدة.
وفي الخطبة تلك وضع بايدن سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب في سلّة
واحدة مع جماعات الـ
MAGA
(اختصار الشعار الشهير «فلنجعلْ أمريكا عظيمة مجدداً»)، من حيث تهديد
«ركائز جمهوريتنا ذاتها»، وإشاعة الفاشية، وتأجيج لهيب العنف السياسي،
وهذه كلها تهدد «حقوقنا الشخصية، ومسار العدل، وحكم القانون، وروح
بلادنا»… قلّة قليلة من أبناء أمريكا كانوا على جهل بأنّ العبارة لم
يخترعها ترامب أو جماعة الـ
MAGA،
بل سبق أن استخدمها رئيس أسبق أيقوني في الحزب الجمهوري، هو رونالد
ريغان؛ ورئيس أسبق، مشهود أيضاً في الحزب الديمقراطي، هو بيل كلنتون؛
ويندر أن تتجرد العبارة من طاقة التحشيد والتجنيد والتحريض على مستوى
الشارع الأمريكي، لدى شرائح الذكور والبيض والرجعيين والعنصريين على
وجه الخصوص.
صحيح أنّ ترامب وأنصاره أحيوا الشعار واستثمروه على نحو كان الأكثر
توظيفاً في السياسة والاجتماع والوعي الجَمْعي، والأشدّ خطورة من حيث
التوظيف والتأطير؛ إلا أنّ الجذور، كما البذور والتربة، كانت قد تهيأت
منذ عقود سبقت تأصيل ترامب والترامبية.
هذه بعض فصول كتاب برترام م. غروس «الفاشية الودودة: وجه السلطة الجديد
في أمريكا»، 2016؛ أو كتاب جيسون ستانلي «كيف تشتغل الفاشية: سياسة نحن
وهم»، 2018؛ أو أنتوني ديماجيو «الفاشية الصاعدة في أمريكا: يمكن أن
تحدث هنا»، 2021؛ أو، أخيراً وليس آخراً، كتاب غلين بيك وجستن هاسكنغ
«إعادة التجهيز العظمى: جو بايدن وصعود الفاشية في القرن 21»، الذي لا
يوفّر سيد البيت الأبيض الراهن من الانخراط في سردية إعادة الإرساء
القديمة التي اقترنت بغالبية السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية
الأمريكية، وكانت وتظلّ على الدوام بمثابة التربة الخصبة لاستنبات
الفاشية. وفي معظم هذه المؤلفات، وسواها أخرى عديدة، لا يقول المؤلفون
إنّ أمريكا تسير نحو الفاشية على غرار هنغاريا فكتور أوربان أو إيطاليا
المقبلة في طبعة جورجيا ميلوني، بل على شاكلة ما سارت إليه عمليات
اقتحام مبنى الكابيتول، وما صارت تتخذه جرائم القتل الجماعي من أبعاد
سياسية أو حتى انتخابية؛ وكذلك، على نحو أشدّ تسييساً، شيوع فلسفة
«الاستبدال الكبير» التي عبرت المحيط من داخل الفكر العنصري الشعبوي
الفرنسي لتحتلّ في أمريكا مكانة تهديمية تنخر أولاً بنيان الدستور
الأمريكي ذاته وركائز الحقوق المدنية.
لا تسير أمريكا نحو الفاشية على غرار هنغاريا فكتور أوربان أو إيطاليا المقبلة في طبعة جورجيا ميلوني، بل على شاكلة ما سارت إليه عمليات اقتحام مبنى الكابيتول، وما صارت تتخذه جرائم القتل الجماعي من أبعاد سياسية أو حتى انتخابية
والحال أنّ سيرورات «إعادة التجهيز» ليست في نهاية المطاف سوى إعادة
تصنيع سلسلة من المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لاح
أنها جُهّزت منذ السنوات الأولى في افتتاح ما سُمّى بـ«القرن
الأمريكي»؛ طبقاً لتوصيف هنري ر. لوس مطلع أربعينيات القرن الماضي،
الذي طالب الولايات المتحدة بالخروج من العزلة أولاً، وباعتماد مبدأ
التدخل المباشر في شؤون العالم قاطبة وأداء دور القوة العظمى
الديمقراطية. ولسوف تمرّ عقود قليلة قبل أن يسارع اثنان من قادة تيار
«المحافظين الجدد»، وليام كريستول وروبرت كاغان، إلى اقتراح مشروعهما
المسمى «من أجل قرن أمريكي جديد»؛ فلم تكن عناصره التنظيرية أقلّ من
إعادة إنتاج/ إعادة تدوير/ إعادة تشغيل لاستيهامات لوس منظّر السردية
الأبكر، ولم تكن خلاصاته أدنى شأناً من بوّابات فضفاضة لاستدخال
تنويعات شتى من الفكر الفاشي.
طريف، إلى هذا، أنّ طرازاً مختلفاً من هوس «العلامة المسجلة» الفاشية
كان قد استهوى رئيساً أمريكياً أسبق هو جورج بوش الأبن، الذي أغراه عدد
من مستشاريه باستخدام توصيفات مثل «الإسلام الفاشي»، أو «الإسلاميّ
الفاشيّ»، أو «الفاشو ـ إسلاميّ»؛ فكان أن ترددت هذه على لسانه خلال
خطبة اشتهرت بدورها على هذا الصعيد، ألقاها بوش الابن في «المعهد
الوطني للديمقراطية»، وليس في أيّ مكان آخر! ولعلّ تلك البرهة بالذات
كانت واحدة من ذرى التقاء الخطّ المتشدّد للمحافظين الجدد إزاء
الإسلام، والمزاج الشخصي التبشيري شبه العصابي عند رئيس أمريكي أَنَسَ
في ذاته جبروتَ محاربة الشرّ على خطى الملك آرثر وفرسان المائدة
المستديرة. خذوا ما جاء في مستهل تلك الخطبة العصماء:
«البعض يطلق على هذا الشرّ تسمية الراديكالية الإسلامية، والبعض الآخر
يعتبره جهادية إسلامية، ويوجد كذلك مَن يسمّيه إسلاموـ فاشية. هذا
الشكل من الراديكالية يستغلّ الإسلام لخدمة رؤيا سياسية عنيفة عمادها
التأسيس، عن طريق الإرهاب والانحراف والعصيان، لإمبراطورية شمولية تنكر
كلّ حرّية سياسية ودينية. هؤلاء المتطرفون يشوّهون فكرة الجهاد
فيحوّلونها إلى دعوة للإجرام الإرهابي ضدّ المسيحيين واليهود والهندوس،
ولكن أيضاً ضدّ المسلمين من مذاهب أخرى، ممّن يعتبرونهم هراطقة». وجاء
في ختام الخطبة أنّ «الراديكالية الإسلامية، مثل الأيديولوجيا
الشيوعية، تحتوي على تناقضات موروثة تحتّم فشل تلك الراديكالية. وفي
كراهيتها للحرّية، عن طريق فقدان الثقة في الإبداع الإنساني ومعاقبة
التغيير والتضييق على إسهامات نصف المجتمع، تنسف هذه الأيديولوجيا
السمات ذاتها التي تجعل التقدّم الإنساني ممكناً، والمجتمعات الإنسانية
ناجحة».
وبين الاستهلال والخاتمة أعاد بوش التشديد على ما يستهويه أكثر في
حكاية الحرب على الإرهاب: «أنّ الأيديولوجيا الإجرامية للإسلاميين
الفاشيين هي محكّ القرن الجديد الذي نعيشه. غير أنّ هذه المعركة تشبه،
في أوجه كثيرة، الكفاح ضدّ الشيوعية خلال القرن المنصرم. فالراديكالية
الإسلامية، تماماً كالأيديولوجيا الشيوعية، تتصف بأنها نخبوية، تقودها
طليعة تعيّن ذاتها بذاتها، تنطق باسم الجماهير المسلمة. بن لادن يقول
إنّ دوره تعليم المسلمين ما هو خير لهم وما هو ليس بخير. وما يعتبر هذا
الرجل، الذي تربى في الرخاء والثراء، خيراً لفقراء المسلمين ليس سوى أن
يصبحوا قتلة وانتحاريين. وهو يؤكد لهم أنّ طريقه هو وحده الدرب إلى
الجنّة، رغم أنه لا يسير فيه هو نفسه».
لا عجب، استطراداً، أنّ بعض توصيفات بايدن بصدد أنصار ترامب من جماعة
الـ
MAGA،
أو طرائق القدح التي يعتمدها ضدّ سلفه ترامب شخصياً، ترجّع أصداء خطاب
بوش الابن بحقّ «الإسلامي الفاشي» عموماً، وشخص بن لادن خصوصاً؛ لجهة
استهداف الركائز الدستورية للجمهورية الأمريكية، وللحقوق الشخصية
والمدنية، ولأنّ هؤلاء «يتغذون على الفوضى، لا يعيشون في ضوء الحقيقة
بل في ظل الأكاذيب»… ومن جانبها لم تتردد صحيفة «واشنطن تايمز»
الأمريكية اليمينية في توظيف «العلامة المسجلة» ذاتها، ولكن من جهة
اليمين هذه المرّة، فاتهمت بايدن بـ«اغتصاب السلطة التشريعية»، وأن
قادة الحزب الديمقراطي تحولوا إلى «فاشيين».
وعلى هدي ترامب وجمهوريوه، يغفل بايدن وديمقراطيوه حقيقة كبرى تقول
التالي: إذا كان الإسلام، مثل اليهودية والمسيحية، نتاج المشرق وعقيدة
مئات الملايين في مشارق الأرض ومغاربها؛ فإنّ الفاشية نتاج أوروبي صرف
انفلت من عقاله الديمقراطي الفكري والفلسفي ذات يوم، فامتدّت عواقبه
الكارثية إلى مشارق الأرض ومغاربها. العقبى، مع ذلك، تتجلى في إعادة
تجهيز الجاهز، وإعادة رشقه على ما قد يكون فيه، أو لا يكون!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
مصادفات بوتين:
سوريا 2015 والقرم 2022
صبحي حديدي
شاءت مصادفات التاريخ الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة تلك
الجوانب التي تشدد على نزوعاته القيصرية إمبراطورية الطابع، أن تتزامن
الذكرى السابعة للتدخل العسكري الروسي إلى جانب نظام بشار الأسد، أواسط
أيلول (سبتمبر) 2015؛ مع المنحنيات الأكثر جدية، والأعلى دلالة،
لانكسارات الاجتياح العسكري الروسي في أوكرانيا، هنا وهناك في العمق
الأوكراني، أو على جسر القرم الأيقوني الشهير الكبير.
وكي لا تخلو مصادفات التاريخ، العامّ الكوني هذه المرّة، من المفارقات
الأقرب إلى النقائض؛ كانت مقادير تبادل العبارات المقذعة بين الكرملين
والبيت الأبيض تتجاوز ما عوّدت عليه البلاغة الفردية لكلّ من بوتين
والرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابل الثواني الـ13,5، عدّاً وحصراً،
التي كانت قد جمعت الرئيس الروسي مع نظيره الرئيس الأمريكي الأسبق
باراك أوباما، في لقطة بروتوكولية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة،
أيلول (سبتمبر) 2015 أيضاً، قبيل أيام معدودات سبقت بدء هبوط عشرات
المقاتلات الروسية المختلفة والحوامات وطائرات الشحن العملاقة في مطار
حميميم على الساحل السوري. ولن يطول الوقت حتى بات المطار الصغير
نسبياً، الذي كان النظام قد أطلق عليه تسمية «مطار الباسل» بن حافظ
الأسد، بمثابة قاعدة جوية هي الأضخم في رصيد موسكو على شواطئ المتوسط،
والرديف الجوي للقاعدة البحرية الروسية الاستثنائية في ساحل مدينة
طرطوس السورية.
يومذاك لم يكن بوتين بصدد إحياء، أو استئناف، أي طور أو طراز من الحرب
الباردة القديمة، حتى ضمن مختلف صياغات الحروب المتخيَّلة والافتراضية؛
بل كان ينتهج سياسات يمكن أن تقنع الغرب، والولايات المتحدة خصوصاً،
بقبول روسيا شريكاً في شراكات سياسية وأمنية واقتصادية على امتداد
العالم. العقدة، مع ذلك، كانت أنه مصمم على التذكير بأدوار يتوجب أن
تُسند إلى موسكو في تلك الشراكات، وبعضها يستحق أن يُحتكر روسياً فقط؛
بعد جورجيا والقرم والمغامرة الأولى في أوكرانيا، وقبل سوريا كتدخّل
عسكري مباشر واسع النطاق، ثمّ ليبيا أو السودان أو الجزائر أو هنا
وهناك في أفريقيا. وكلّ هذا على سبيل الذهاب أبعد من مستوى الشراكة،
نحو حلحلة متاعب روسيا المختلفة، وفي طليعتها العقوبات الاقتصادية،
وكذلك حروب أسعار النفط وستراتيجيات أنابيب الغاز العابرة للقارّات.
وفي أواخر شباط (فبراير) 2018 سوف يتذوّق الجيش الأمريكي، غير بعيد عن
ضفاف نهر الفرات في شرق سوريا هذه المرّة، طعم الاصطدام مع تكتيكات
بوتين العسكرية، غير المباشرة كما يصحّ القول؛ حين أغار على المعسكر
الأمريكي مرتزقة يفغيني بيروجين، «طبّاخ بوتين» في اللقب الكاريكاتوري
ومؤسس وصاحب ميليشيات «فاغنر» العاملة تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية.
قبلها بأيام كان بيروجين قد عقد صفقة، عن طريق شركة «إيفرو بوليس»
المرتبطة به، لـ»تحرير» عدد من المناطق النفطية والمصافي في ريف دير
الزور، واستثمارها بالتعاون مع شركة نفط النظام وبعض مهرّبي البترول من
رجال الأعمال المقرّبين من النظام والمتعاقدين مع «تنظيم الدولة» في آن
معاً. ذلك الاصطدام الدامي ذكّر ساسة البيت الأبيض، وجنرالات
البنتاغون، أنّ ردود أفعال الولايات المتحدة على التدخل العسكري الروسي
في سوريا لم تتجاوز اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي جون
كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، واتصالاً ثانياً من وزير الدفاع
الأمريكي أشتون كارتر مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.
وهكذا، في مصادفة التزامن بين أيلول (سبتمبر) 2015 والشهر ذاته 2022،
يظلّ بوتين مخلصاً لهوس التذكير بأنّ موسكو في عداد جبابرة الكون
عسكرياً (وهذا صحيح، بالطبع)؛ ثمّ جيو ـ سياسياً (وهذا مصدر شك، لأنّ
تكبيل روسيا اقتصادياً، وتخبطها في مغامرات عسكرية قصيرة الأجل وقاصرة
الأغراض، لا يخدمان هذه الغاية بالضرورة)؛ الأمر الذي يتوجب أن يُلزم
الغرب والولايات المتحدة بالتعامل مع موسكو كندّ وشريك (وهذا مشكوك فيه
أيضاً، في المدى المنظور على الأقل).
من سمرقند إلى كييف:
أقطاب تتعدد وعواقب تتفاقم
صبحي حديدي
تحتضن أستانا عاصمة كازخستان ثلاث فعاليات ذات طابع دولي، لا تغيب عنها
أبعاد خاصة آسيوية، أو غير أوروبية على وجه التخصيص؛ وتصبّ في جهود
روسية وصينية أساساً، بتضامن من دول أخرى في المحيط الجيو – سياسي أو
على تخومه: القمة السادسة لما يُعرف باسم «مؤتمر التفاعل وتدابير بناء
الثقة في آسيا «
CICA،
ومجلس رؤساء «كومنولث الدول المستقلة «
CIS،
و«قمّة روسيا – آسيا الوسطى» الأولى. وفي أواسط أيلول (سبتمبر) الماضي،
كانت سمرقند عاصمة أوزبكستان قد احتضنت الاجتماع الـ22 لزعماء دول
«منظمة شنغهاي للتعاون»، بحضور الرئيسن الروسي فلاديمير بوتين والصيني
شي جين بينغ، وقادة كازخستان وقرغيزستان وطاجكستان والهند وباكستان
والبلد المضيف أوزبكستان؛ فضلاً عن مراقبين مثل الرئيس البيلاروسي
ألكسندر لوكاشينكو، والإيراني إبراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب أردوغان،
وآخرين.
هذه، وسواها على مستويات أخرى اقتصادية وتجارية وتنموية وأمنية، تبدأ
من افتراض مفاده أنّ العالم ليس أحادي القطب من جهة أولى، وأنه من باب
أولى ليس رهينة الاستقطاب الغربي في صياغاته المختلفة التي تبدأ من
الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وقد لا تنتهي عند مجموعة الـ7 أو حتى
مجموعة الـ20 حيث لا تقتصر هذه الأخيرة على قادة الدول بل تضمّ أيضاً
محافظي المصارف المركزية في غالبية الدول ذات الاقتصادات المتقدمة.
الافتراض، استطراداً، يفتح سؤال الإمكانية ضمن تشعبات عديدة، جيو ـ
سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وثقافية، وأخرى ذات صلة بتعدد
انتسابات الدول الأعضاء الساعية إلى تعددية الأقطاب؛ كأن تكون الهند
صديقة الولايات المتحدة وروسيا في آن معاً، وأن تفرّق بينها وبين الصين
والباكستان خلافات حدودية بعضها شديد الاستعصاء؛ أو أن تكون تركيا
عضواً في الحلف الأطلسي، طامحة على قدم المساوة إلى عضوية الاتحاد
الأوروبي ومنظومة شنغهاي…
وعند تأسيسها في سنة 2001، كانت «منظمة شنغهاي للتعاون» قد ابتدأت
لائحة عضويتها من روسيا والصين وكازخستان وقرغيزستان وطاجكستان
وأوزبكستان، منتقلة بذلك من تشكيلة أولى أقدم تأسست سنة 1996 واتخذت
تسمية «خمسة شنغهاي»؛ كما طوّرت أغراضها المباشرة، في التنسيق والتعاون
الإقليمي، وشخّصت «الشرور الثلاثة» في التطرّف والنزعة الانفصالية
والإرهاب، ثمّ توجّب تلقائياً أن تنأى أكثر فأكثر عن المحاور والكتل
الغربية على أصعدة سياسية واقتصادية وعقائدية. التوجه المركزي نحو
تعددية الأقطاب استوجب، أيضاً، انفتاحاً أوسع على توطيد التجارة
المشتركة والاستثمار في ميادين الطاقة، بل بلغ الأمر درجة تطوير نظام
مصرفي للتحويلات المالية في كلّ من روسيا (SPFS)
والصين (CIPS)
موازٍ للنظام الدولي/ الغربي عموماً المعروف (SWIFT).
وكان لافتاً، يحمل الكثير من المغزى، أنّ البيان الختامي للمنظمة في
سمرقند، مؤخراً، شدّد أكثر من ذي قبل على هدف ناظم طبع فلسفة تأسيس
مجموعة شنغهاي، فأكدت الدول الأعضاء «على التزامها بإنشاء نظام عالمي
أكثر تمثيلاً وديمقراطية وعدالة وتعددية أقطاب».
غير خافٍ، بالطبع، أنّ غالبية غير قليلة من دول منظمة شنغهاي لا تخرق
مبادئ النظام الذي تزعم الدعوة إليه، وتنتهك أبسط اشتراطاته، فحسب؛ بل
إنّ بعضها، الأكبر والأبرز مثل روسيا والصين، يعتمد الاستبداد في أنماط
شتى وأنساق متغايرة، ولا يتردد في اجتياح الجوار أو احتلال المناطق
وضمّها وإلحاقها، أو يمارس عمليات التطهير العرقي والثقافي. وهذه في
رأس المعضلات التي أعاقت، وتعيق اليوم أيضاً، إطلاق منظومات ومجموعات
وتحالفات تكفل تطوير تعددية قطبية حيوية وخلاقة ومعافاة؛ بل إنّ تفشّي
الركون إلى العوائق، وما تؤدي إليه من تفاقم العواقب الناجمة عن تلك
المعضلات، إنما يمنح القطبية الغربية، الأمريكية على وجه الخصوص،
أفضلية واضحة في التسابق على إخضاع أطراف العالم، ويزوّدها بهوامش
مناورة أوسع نطاقاً من حيث تضييق الخناق على أيّ جهود ثالثة مستقلة عن
القطبين الغربي/ الأمريكي مقابل الروسي/ الصيني على سبيل المثال.
من سمرقند إلى كييف، وعلى قدم المساواة ربما: من البيت الأبيض إلى الكرملين مروراً بقرارات «أوبك +»، ثمة ما يصطرع في ميادين تشكيل الأقطاب أو تفكيكها أو إعادة تشكيلها؛ وثمة، على نحو متزامن، عواقب تتفاقم وتتضاعف وتتفجر
ضبط آسيا الوسطى والتحكم في ثرواتها وأنظمتها وامتيازاتها الجيو ـ
سياسية وإدخالها في شبكات محاور أو ولاء أو حتى هيمنة مباشرة هي، غنيّ
عن القول، سلسلة الأغراض الأعرض خلف المسعى المشترك الروسي/ الصيني؛
ولا غرابة في ذلك بالطبع، إذْ أنّ المنطقة تحفل بمخاطر دول غير مستقرة،
وصعود دائم متعاظم للجماعات الجهادية الإسلامية المتشددة، وانتشار
الجريمة المنظمة على اختلاف أنواعها وأهوالها، وتجارة المخدرات بوصفها
«صناعة ثقيلة» ومصدراً للعملة الصعبة. لا يُستثنى من هذا المشهد، من
زوايا الإبصار الروسية ـ الصينية هنا أيضاً، أنّ المحاور الغربية
والأمريكية لم تعتمد ستراتيجية عمل جدّية شاملة إزاء آسيا الوسطى إلا
في سنة 2007 عملياً، حين اتضحت أكثر فأكثر الأهمية الجيو ـ اقتصادية
لثروات المنطقة، وحين تأكد أنّ نزوعات الكرملين في التوسع وبسط النفوذ
أخذت تستثمر في بلدان آسيا الوسطى، مستعيدة ما يمكن من بقايا نفوذ عائد
إلى حقبة الاتحاد السوفييتي.
وإذا صحّ الافتراض بأنّ الأقطاب آخذة في التعدد بالفعل، هنا وهناك على
مستوى آسيا الوسطى أوّلاً، وكذلك لدى دول غير قليلة الشأن مثل الهند
وإيران وتركيا ترغب في الانضمام إلى «منظمة شنغهاي للتعاون»؛ فإنّ
الآخذ في التفاقم، على الضفة الموازية، هو مقدار العواقب الكارثية
الناجمة عن بؤس التغيير ومحدودية التأثير لدى الغالبية الساحقة من
مراكز العالم الأخرى التي تعاني من التخلف والفاقة والحاجة والديون
والكوارث والمجاعات والحروب الأهلية. ولم يكن بعيداً، وقد يتكرر في أية
حقبة متغيرة مقبلة، ذلك الزمن الذي شهد ائتلاف الأقطاب الكبرى ضدّ
«بؤساء» العالم حيثما اقتضت قوانين السوق والاستثمار والإخضاع
والسيطرة؛ وقادة الغرب الذين أدخلوا الصين إلى نادي الكبار في مجلس
الأمن الدولي كانوا يدركون، كما هو إدراكهم اليوم، أنّ الفيتو الذي
يمكن أن يستخدمه الوافد الجديد سوف ينقلب عليهم، هم أنفسهم، مراراً
وتكراراً.
ومن جانب آخر، يخصّ القطب الغربي الأمريكي، ما يزال على قيد الحياة،
أسوة بتنظيراته وتشخيصاته، الفيلسوف السياسي البريطاني جون غراي
(اليميني عموماً، على سبيل الإيضاح المفيد)، الذي نعى يوتوبيات
الليبرالية المعاصرة في كتابه «الفجر الزائف: ضلال رأسمالية العولمة».
والرجل اعتبر أنّ الديمقراطية واقتصاد السوق في حال تنافس، وليستا
البتة في حال شراكة؛ وتجارب اقتصاد السوق القديمة والحديثة برهنت ــ
خلال أوقات التأزم خصوصاً ــ على سطوة الدولة أكثر من سطوة السوق، وعلى
خضوع اليوتوبيا للسياسة الواقعية (الـ
Realpoitik
في عبارة أوضح)، التي تفرضها المصالح والأجندات السرّية، وليس
الاستثمار والتنافس الحرّ وقوانين الأسواق. هذا، بالطبع، لم يكن رأي
القائلين بأنّ انتصار القِيَم الغربية ساعة سقوط جدار برلين (أو
لاحقاً: ساعة سقوط بغداد تحت الاحتلال الأمريكي، فكيف بضمّ القرم
واجتياح أوكرانيا!) هو في الآن ذاته انتصار لليوتوبيا الوحيدة المتبقية
في حوزة الإنسانية: اليوتوبيا العليا والقصوى والأخيرة، الآتية على
هيئة خاتم البشر كما توهمه فرنسيس فوكوياما، واليوتوبيا التي يُراد لنا
أن نسلّم بخلوّها تماماً من الأزمات والهزّات والتشوّهات.
ومن سمرقند إلى كييف، وعلى قدم المساواة ربما: من البيت الأبيض إلى
الكرملين مروراً بقرارات «أوبك +»، ثمة ما يصطرع في ميادين تشكيل
الأقطاب أو تفكيكها أو إعادة تشكيلها؛ وثمة، على نحو متزامن، عواقب
تتفاقم وتتضاعف وتتفجر، في مستويات ندرة الطاقة واشتعال الأسعار في
العوالم المصنّعة المتقدمة ذاتها، فكيف بعوالم كانت تسمى «ثالثة» ذات
يوم، ثمّ صارت «نامية» بعدئذ، وهي اليوم تتسمى بأيّ وكلّ ما يجسّد بؤس
التاريخ.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
بريطانيا: متجر التبادل
بين (المحافظين) و(العمال)
صبحي حديدي
«بلغ السيل الزبى»، إذا شاء المرء اختيار مرادف ملائم من الفصحى لترجمة
الأصل الإنكليزي لحركة
Enough is Enough،
التي لم تتأسس في بلد فقير نامٍ أو متخلف أو «عالمثالثي» كما كانت تقول
الرطانة القديمة؛ بل في المملكة المتحدة، الدولة العظمى، المتقدمة
المصنّعة الغنية، والإمبراطورية الاستعمارية السابقة التي شهدت حقبة لم
تكن فيها الشمس تغرب تماماً عن أطراف مستعمراتها. صحيح أنّ اثنين فقط
من أعضاء مجلس العموم البريطاني شاركا في تأسيس الحركة، هما زارا
سلطانة وإيان بيرن، إلا أنّ الحجم اللافت للجهات النقابية ومنظمات
المجتمع المدني المنخرطة في أنشطتها ينطوي على الكثير من الدلالات؛
خاصة وأنّ انطلاقتها الأولى، من الوجهة المطلبية أوّلاً، لا تنهض من
فراغ ولا تتعزز في فراغ على سلسلة الخلفيات الاقتصادية/ الاجتماعية
التي باتت تأخذ صفة الأزمات المتعاقبة في البلاد؛ وخاصة، أيضاً، وأنها
تترافق مع صعود رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، واتضاح العواقب الأولى
لسياساتها المبكرة في المعدلات القياسية لتدهور قيمة الجنيه
الإسترليني.
ليس مدهشاً، وإنْ كان يتوجب أن يلفت الانتباه بسبب صدوره في بريطانيا
العظمى تحديداً، أنّ الحركة تقوم على خمسة مطالب: زيادة حقيقية في
الأجور، تخفيض في فواتير الطاقة، إنهاء الفقر الغذائي، مساكن لائقة
للجميع، والضرائب من الأغنياء. طرائق العمل المعلَنة (حتى الساعة على
الأقلّ، إذْ لا تُستبعَد احتمالات تطوّرها إلى صيغ أشدّ جذرية)، هي
التظاهرات والاعتصامات، وإنشاء مجموعات العمل على نطاق التجمعات
المختلفة، تنظيم صفوف التضامن، ومقاضاة الشركات والأفراد المستفيدين من
الأزمة الراهنة. نبرة الخطاب العامة لا تبدو، من جانبها، وكأنها تقتصر
على التحشيد المطلبي بل تذهب إلى مستوى الدعوة إلى أخذ زمام الأمور
ذاتياً وتنظيمياً، والانفضاض عن «المؤسسة التي لا يمكن الركون إليها
لحلّ مشكلاتنا» كما يقول البيان التـأسيسي؛ ويضيف: «هذا يقع على
عاتقنا، في كلّ مكان عمل وكلّ جماعة. فإذا كنتَ تجهد للبقاء على قيد
الحياة، وكان أجرك لا يغطي فواتيرك، وضقتَ ذرعاً بالعمل الأقسى مقابل
الأجر الأقل، وينتابك القلق على مستقبلك، ولا تستطيع تحمّل ما يجري
لبلدنا ــ فلتنضمّ إلينا».
وحين خاطبت تراس مؤتمر حزب المحافظين مؤخراً، وسط أجواء من التطبيل
والتزمير لم يكن الإعداد المسرحي المسبق خافياً عنها، كان الاقتصاد
البريطاني يترنح لتوّه تحت ضربات سياسات ضريبية متخبطة متناقضة وقاصرة؛
وكانت الفئات الشعبية تتلقى، من جانبها، أولى صدمات أكلاف السكن
والعقارات والغذاء والطاقة؛ ولم تتأخر فئات العمال في استلام هدية تراس
المتمثلة في اتهام النقابات بمعاداة «النموّ». ولم يدرك، إلا بعض
أنصارها والأكثر تكاذباً في صفوف قيادات «المحافظين»، كيف لها أن تنجز
وصفة نموّ سحرية عجز أسلافها من رؤساء الحكومات عن بلوغها، طوال 12
سنة؛ بل يصحّ التذكير، أيضاً، أنّ آخر 50 سنة من عمر المملكة المتحدة
لم تشهد أيّ نموّ أعلى من ذاك الذي سبقه. الشارع الأعرض من جانبه، وكما
تعكسه استطلاعات الرأي، كان يشير إلى تقدّم حزب «العمّال» بمعدّل 54٪
(+ 9 نقاط)، مقابل «المحافظين» 21٪ (- 7)، و«الأحرار» 7٪ (- 2)،
و«الخضر» 6٪ (- 1).
سيّان إذن، مع فوارق معتادة لا تبدّل الجوهر، أن يتبادل إدارة المتجر أمثال توني بلير أو بوريس جونسون، وأن يتعاقب خلف منصات الشراء والمبيع أمثال ليز تراس أو كير ستارمر
لكنّ هذا الاستطلاع يعيد طرح الأسئلة العتيقة إياها، التي تثير إشكالية
تبادل الأدوار بين الحزبين الرئيسيين: لماذا، إذن، مُني «العمال»
بخسارة مهينة في الانتخابات الأخيرة، وخرج «المحافظون» بنصر كاسح؟ وما
الذي تغيّر هكذا حتى تنقلب الأحوال بينهما، رأساً على عقب تقريباً؟ وما
الذي سيتغير حقاً؟ ولقد اختار بعض مراقبي هذه الإشكالية (كيت بروكتور،
في «الغارديان»، على سبيل المثال) حفنة أسباب «تقنية» تجيب عن بعض
الأسئلة السالفة؛ كالقول، مثلاً، إنّ شخصية زعيم العمال السابق جيريمي
كوربن كانت عائقاً، أو أنّ برامج الحزب كانت مستعادة ولا جديد فيها، أو
أنّ متاعب بريكست هيمنت على ستراتيجية «العمال» المتقلبة، أو تراجع
الحزب في مواقعه التاريخية وسط عمال المناجم والصناعات الثقيلة، وما
إلى هذا وذاك. صحيح أنها أسباب تجيب على بعض الإشكالية، ولكن الأصحّ هو
أنها لا تتوغل عميقاً نحو أسباب أخرى «مزمنة» تخصّ ما أصاب عقائد
الحزبين من جمود أو ترهّل أو تشوّه، جعلهما أقرب إلى وجهَين لعملة
واحدة، يقلّبها نظام سياسي وديمقراطي شاخ طويلاً وندر أنه تجدد وتبدّل.
ففي جانب واحد من تفاقم معضلات بريطانيا، حكاية بريكست مثلاً وحمى خروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (مقابل حمّى أخرى سابقة في سنة 1975، حول
انضمامها إلى السوق الأوروبية بمعدّل موافقة وصلت إلى 67.23٪!)؛ تصحّ
العودة، مجدداً ودائماً ربما، إلى كتاب دانييل دورلمان وسالي توملنسن
«احكمي يا بريطانيا: بريكست ونهاية الإمبراطورية»، الذي يقترح لائحة
مفصّلة بحيثيات منطق عالٍ مهيمن يجعل الصلة وثيقة تماماً بين انحسار
الإمبراطورية من جهة، واستيهامات البحث عن هوية بديلة تستلهم الماضي
التليد أو توحي بإمكان استرجاع بعضه من جهة ثانية. ولم يكن هذا العصاب
الجَمْعي يحتاج، كي يزداد اشتعالاً، إلا إلى توقّد تيارات شعبوية جارفة
على امتداد القارّة العجوز أوروبا، في فرنسا وهنغاريا وإيطاليا
والنمسا، فضلاً عن الشقيقة الكبرى أمريكا دونالد ترامب.
وقد لا تكون أقلّ فائدة، ولا أقلّ صواباً، عودةٌ تمليها الأحوال
الراهنة إلى المفكر البريطاني جون غراي؛ مؤلف أعمال إشكالية وسجالية
ذات صلة، مثل «الفجر الزائف: ضلال رأسمالية العولمة»، و«يقظة الأنوار:
السياسة والثقافة عند خاتمة العصر الحديث»، و«هرطقات: ضدّ التقدّم
وأوهام أخرى»، و«روح مسرح الدمى: تحقيق موجز حول الحرّية الإنسانية».
ففي مقالة مستفيضة، نشرتها «نيو ستيتسمان» البريطانية بعنوان «إغلاق
الذهن الليبرالي»، يبدأ غراي من استعراض المشهد الكوني الراهن (أوروبا،
حروب التبادل، دونالد ترامب، فلاديمير بوتين، أمواج اللجوء، الصين…)،
كي يبلغ خلاصة أولى تسير هكذا: «النظام الليبرالي الذي لاح أنه ينتشر
عالمياً بعد نهاية الحرب الباردة، يتلاشى من الذاكرة». ورغم اتضاح هذا
التلاشي يوماً بعد آخر، يتابع غراي، فإنّ الليبراليين يجدون صعوبة في
مواصلة العيش من دون «الإيمان بأنهم في الصفّ الذي يحلو لهم اعتباره
الصواب في التاريخ»؛ وبالتالي فإنّ إحدى مشكلاتهم الكبرى هي عجزهم عن
تخيّل المستقبل، إلا إذا كان استمراراً للماضي القريب! وحين يختلف
الليبراليون حول كيفية توزيع الثروة والفرص في السوق الحرّة، فالمدهش
في المقابل أنّ أياً منهم لا يُسائل نمط السوق المعولَمة التي تطورت
خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وبعد الاستفاضة في مناقشة أزمة الليبرالية المعاصرة كما تتجلى في
بريطانيا، في محاور أزمات «العمّال» و«المحافظين» واقتصاد البلد ما بعد
الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ يردّ غراي السجال إلى جذور الفكر
الليبرالي الحديث، في أنه نتاج متأخر من التوحيدية اليهودية والمسيحية:
«من تقاليد هذَيْن الدينَيْن، وليس من أيّ شيء في الفلسفة الإغريقية،
نبعت القِيَم الليبرالية حول التسامح والحرية. وإذا ساد اليقين بأنها
قيم كونية، فذلك بسبب الاعتقاد بأنها فرائض إلهية. ومعظم الليبراليين
علمانيون في النظرة العامة، لكنهم يواصلون الإيمان بأنّ قيمهم إنسانية
وكونية». المعضلة، بعد هذا التوصيف، أنّ الذهن الليبرالي الحاضر عاجز
عن الاشتغال إلا إذا أغلق الواقع، أو عرضه كبضاعة أحادية، في… المتجر
الليبرالي الوحيد. سيّان إذن، مع فوارق معتادة لا تبدّل الجوهر، أن
يتبادل إدارة المتجر أمثال توني بلير أو بوريس جونسون، وأن يتعاقب خلف
منصات الشراء والمبيع أمثال ليز تراس أو كير ستارمر…
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
كيسنجر الأحدث:
القيادة والتلصص على التاريخ
صبحي حديدي
في السطور الأولى من مقدمة كتابه الأحدث، «القيادة: ستّ دراسات في
الستراتيجية العالمية» والذي صدر صيف هذا العام ضمن منشورات بنغوين
راندوم في نيويورك؛ يبدو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر
وكأنه – من دون أن يقصد، بالطبع – يُسلْم قارئه المناهض، المعادي لشخص
كيسنجر وتسعة أعشار أفكاره وسياساته وسلوكياته، مفتاحاً استهلالياً
بليغاً يؤكد صلاحية معارضة الكتاب أو حتى الإعراض عن قراءته. فهو يكتب
التالي: «إنّ أيّ مجتمع، أياً كان نظامه السياسي، هو في حال انتقال
دائم بين ماضٍ يشكّل ذاكرته ورؤية للمستقبل تلهم تطوّره. وعلى هذا
المنوال، لا غنى عن القيادة: قرارات يتوجب أن تُتخذ، وثقة تُكتسب،
ووعود تُوفى، وطريق إلى الأمام يُقترح».
ذلك لأنّ نقائض هذه كلها، وسواها أخرى كثيرة في الواقع، ظلت بمثابة سنن
«القيادة» التي تولاها كيسنجر من مواقع بالغة الحساسية في السياسة
الخارجية الأمريكية: مستشاراً للأمن القومي، ووزيراً للخارجية،
ومهندساً للوفاق مع الاتحاد السوفييتي والصين، ومحرّكاً في مفاوضات
باريس التي وضعت خاتمة/ مخرجاً لعقود من جرائم الحرب الأمريكية في
فييتنام؛ فضلاً، بالطبع، عن هندسة الانقلابات العسكرية هنا وهناك في
العالم خاصة تشيلي ضدّ الرئيس المنتخب ديمقراطياً سلفادور أللندي،
والتواطؤ على المجازر الأشنع في باكستان وبنغلادش وهنا وهناك في العالم
أيضاً، واستنفار الإنذار النووي الأقصى في البيت الأبيض من دون علم
الرئيس للضغط على السوفييت وعكس اتجاه الحرب على الجبهتين المصرية
والسورية سنة 1973، وما إلى ذلك كثير متنوع شائن…
ثمة بالتالي حاجة إلى منظور نقدي مبدئي يصلح عوناً لقارئ من طراز آخر،
يعنيه الوقوف على زبدة ما يرى كيسنجر وما ينظّر ويستشرف وهو يتمّ 99
سنة من عمره، ويصدر الكتاب الـ19 من مؤلفاته في السياسة الدولية وفنون
الدبلوماسية والتبشير بالحروب وفرض سياسة الأمر الواقع وسنوات الاضطراب
والغليان والهياج والأزمات… صحيح أنّ فصول «القيادة» تتناول الألماني
كونراد أديناور (ستراتيجية التواضع) والفرنسي شارل دوغول (ستراتيجية
الإرادة) والأمريكي ريشارد نكسون (ستراتيجية التوازن) والمصري أنور
السادات (ستراتيجية التعالي) والسنغافوري لي كوان يو (ستراتيجية
التميّز) والبريطانية مارغريت تاتشر (ستراتيجية اليقين). ولكن هل يصحّ،
عقلياً أوّلاً ثمّ نقدياً ثانياً وأخلاقياً ثالثاً، أن يتابع القارئ ما
يتنطح له كيسنجر عن هؤلاء الستة، من دون التسلّح بمرشِّحات صارمة عالية
التمييز والتدقيق، تُدرج آثام المؤلف إياه بحقّ الشعوب ذاتها التي
يتناول ساستها بالتحليل؟
«في قلب المؤسسات الإنسانية، الدول والأديان والجيوش والشركات
والمدارس، القيادة تقتضيها الحاجة لمساعدة الناس للوصول من حيث هم إلى
حيث لم يكونوا قطّ سابقاً أو حيث لم يتخيلوا الوصول إلا نادراً
أحياناً» هكذا يكتب كيسنجر في التوطئة لمفهومه عن القيادة؛ وغير بعيد
يتوجب أن يبقى القارئ في استذكار ما بلغه صاحب هذه التمثيلات المجازية
عندما قاد السياسة الخارجية الأمريكية في مشارق الأرض ومغاربها، وفي
استعادة أكثر من «وصفة» قاتلة وآثمة وإجرامية لمعالجة الأزمات
والمشكلات والصراعات. هنا ما لا يتوجب أن يُنسى من بنود لائحة كيسنجر:
ـ نصح دولة الاحتلال الإسرائيلي بسحق الانتفاضة الأولى، «على نحو وحشيّ
وشامل وخاطف»؛ وهذه كلمات كيسنجر الحرفية كما سرّبها عامداً جوليوس
بيرمان، الرئيس الأسبق للمنظمات اليهودية الأمريكية.
ـ الموقف «التشريحي» المأثور من الاحتلال العراقي للكويت، في دعوة بوش
الأب إلى تنفيذ ضربات «جراحية» تصيب العمق الحضاري والاجتماعي
والاقتصادي للعراق (البلد والشعب، قبل النظام وآلته العسكرية
والسياسية).
ثمة حاجة إلى منظور نقدي مبدئي يصلح عوناً لقارئ من طراز آخر، يعنيه الوقوف على زبدة ما يرى كيسنجر وما ينظّر ويستشرف وهو يتمّ 99 سنة من عمره، ويصدر الكتاب الـ19 من مؤلفاته في السياسة الدولية وفنون الدبلوماسية والتبشير بالحروب
ـ الدعوة علانية إلى «نزع أسنان العراق من دون تدمير قدرته على مقاومة
أي غزو خارجي قد يراود جيرانه المتلهفين على ذلك» في مقالة مدوّية
بعنوان «جدول أعمال ما بعد الحرب» نشرها مطلع 1991.
ـ توبيخ فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، لأنّ ما
تعاقدوا عليه مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في أوسلو ثمّ في البيت
الأبيض، ليس سوى «إوالية»
Mechanism
متحرّكة ستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى دولة فلسطينية (وهي التي يرفضها
كيفما جاءت، وأينما قامت، ويستوي لديه أن تتخلق من محض «إوالية» أو
تنقلب الى أقلّ من بلدية).
ـ السخرية من بعض «الفتية الهواة» في البيت الأبيض، ممّن يخلطون
«البزنس» بالأخلاق، والتجارة بحقوق الإنسان (في مثال الصين)؛ ولا
يميّزون في حروب التبادل التجارية بين العصبوية الأورو ـ أمريكية وشرعة
التقاسم الكوني لسوق شاسعة بقدر ماهي ضيقة (مواثيق الـ «غات»
وأخواتها)…
وفي مقالة مسهبة بعنوان «دروس من أجل ستراتيجية مخرج» تعود إلى صيف
2005، باح كيسنجر بكثير ممّا كان مسكوتاً عنه، وإن ظلّ مفضوحاً عملياً
منذ البدء، حول النظائر القائمة أو المحتملة بين التورّط العسكري
الأمريكي في فييتنام، والاحتلال الأمريكي للعراق، من جهة أولى؛ ومآلات
الهزيمة العسكرية هناك، وعواقب استعصاء المخرج الأمريكي هنا، من جهة
ثانية؛ فضلاً، من جهة ثالثة، عن ذلك الدرس العتيق الكلاسيكي الصائب أبد
الدهر: أنّ كسب أية حرب لا يعني كسب سلامها، أو إنجاز أيّ سلام ربما!
ولقد احتوت المقالة على تلك الفقرة الصاعقة: «مؤكد أنّ التاريخ لا
يكرّر نفسه بدقّة. فييتنام كانت معركة تخصّ الحرب الباردة؛ وأمّا
العراق فهو أحدوثة
Episode
في الصراع ضدّ الإسلام الجذري. لقد فُهم أنّ تحدّي الحرب الباردة هو
البقاء السياسي للأمم ـ الدول المستقلة المتحالفة مع الولايات المتحدة
والمحيطة بالاتحاد السوفييتي. لكنّ الحرب في العراق لا تدور حول الشأن
الجيو ـ سياسي بقدر ما تدور حول صدام الإيديولوجيات والثقافات والعقائد
الدينية. ولأنّ التحدّي الإسلامي بعيد النطاق، فإنّ الحصيلة في العراق
سيكون لها من المغزى العميق أكثر ممّا كان لفييتنام». وما كان صاعقاً
في هذه الخلاصة لم يقتصر على اختزال الغزو العسكري الأمريكي (ثمّ
البريطاني، للتذكير المفيد) إلى تنميط سطحي وضحل حول الإسلام الجذري،
فحسب؛ بل على عجز أستاذ التاريخ عن استيعاب دروس التاريخ، التي لن يطول
الوقت حتى تتكشف وتترسخ، ويطول عمر كيسنجر ليبصرها بأمّ العين، حتى وهو
يضع السطور الأخيرة في مخطوط كتابه الـ19.
ليس أقلّ إدهاشاً، بالطبع، أنه يختتم الفصل الخاصّ بالسادات على نحو
مجازي ركيك يمزج بين رغبة الفرعون المصري أخناتون بترسيخ ديانة توحيدية
على نقيض الآلهة المصرية، وبين شراكة السادات مع غولدا مائير وإسحق
رابين ومناحيم بيغن؛ وكيف أنّ خطوات التطبيع الراهنة بين دولة الاحتلال
وكلّ من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان يعود الفضل فيها إلى
مبادرة السادات، التي تظلّ مع ذلك «إرثاً ناقصاً» وغير مكتمل حسب تعبير
كيسنجر نفسه. أكثر نقصاناً، وأشدّ فضحاً لمنهجيات الكتاب عموماً، أنّ
الشعوب تظلّ الغائب الأكبر، المغيّب عن سابق قصد وتصميم، على امتداد
528 صفحة من مجلد يزعم
قراءة إشكالية القيادة عبر محورَين: الأوّل، بين الماضي والمستقبل؛
والثاني، بين القيم الثابتة ومطامح أولئك الذين يقودون. ذلك بعض السبب
في أننا لا نقف على رأي كيسنجري، إذا جازت النسبة هكذا، حول مآلات
القيادة في أمريكا نكسون، حيث فضيحة «ووترغيت» تنقل القائد إلى مصافّ
المتلصص المتنصت؛ أو في بريطانيا ثاتشر، حيث القبضة القيادية لم تطرق
بقوّة أكثر مما فعلت ضدّ النقابات والقطاع العام؛ وأمّا في مصر، فللمرء
أن يحدّث ويفصّل ولا حرج.
وأياً كان الرأي في الستراتيجيات الستّ كما يشخصها كيسنجر، فإنّ
استخدام المرشِّحات الصارمة لقراءة الكتاب تبقى ستراتيجية مسبقة لا غنى
عنها، أولى أو سابعة… سيّان!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
بوتين والسلاح النووي:
حافة الأطلسي التي تُستعاد
صبحي حديدي
نطق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بالعبارة التي أفزعت عقول واقشعرت لها أبدان، لأنها هذه المرّة اختلفت
عن جميع سابقاتها بصدد استخدام أسلحة التدمير الشامل، والنووية منها
خاصة: «إنني لا أتحايل» أو في التعبير العاميّ السوري الأدقّ: «لا
أزعبر» هكذا اختتم بوتين الجملة المفتاحية: «إذا تعرضت وحدة أراضينا
للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا» خلال خطبته
المتلفزة التي توجهت إلى الشعب الروسي مؤخراً، وتضمنت، أيضاً، موافقته
على طلب وزارة الدفاع باستدعاء 300 ألف احتياطي، للمرّة الأولى في
تاريخ البلد بعد الحرب العالمية الثانية. المحتوى الآخر، المخفيّ عمداً
في تعبير «وحدة أراضينا» كان يُراد به التأكيد على أنّ المناطق
الأوكرانية الأربع، التي تشهد معارك كرّ وفرّ ضارية وينوي بوتين ضمّها
بعد إجراء استفتاء صوري مسرحي، هي جزء لا يتجزأ من روسيا الأمّ، حتى
بمعنى مستقبلي أو افتراضي.
وأن يعلن امرؤ أنه لا يتحايل فهذا خيار لفظي لا ينفي بالضرورة أنه إنما
يتحايل بالفعل، لألف سبب وسبب، وذلك من قلب حيلة عتيقة تقوم على نفي
التحايل إياه؛ الأمر الذي لا يبيح، في المقابل، استسهال الحال التي
يكون فيها صاحب هذا التكتيك، أو التقليل من شأن الملابسات التي تدفع به
إلى طراز من النواس بين الوعيد الكاذب والتهديد الجدّي. بذلك فإنّ نبرة
بوتين الأخيرة، بصدد «كل» الوسائل المتاحة» لا يصحّ أن تقتصر على
تأويلات معتادة تتصل بالحرب النفسية والضغط المعنوي واستعراض العضلات
أو إبراز أوراق القوّة في أيّ جولات تفاوضية مقبلة، وما إلى هذا وسواه؛
ولا يصحّ، كذلك، تحميلها درجات عالية من الصدقية، ليس لأنّ سيّد
الكرملين «أعقل» من أن يتهوّر فيضغط على أزرار نووية، بل ببساطة لأنه
غير مضطر إلى هذا، في المرحلة الراهنة من «التعرّض للتهديد» على الأقل.
صحيح أن جيشه لقي مؤخراً، ويواصل مجابهة، انتكاسات ميدانية في جبهات
لاح أنها حُسمت لصالحه، خاصة في الشمال؛ وأنّ استدعاء الاحتياط مؤشر
بالغ الدلالة، يسجّل تحوّلاً خطيراً في سائر المنطق الذي اتخذته
«العملية الخاصة» الشهيرة؛ إلا أنّ اللجوء إلى أيّ طراز من الأسلحة
النووية، بما في ذلك تلك التي تُعتبر أقرب إلى «قُنيبلة» محدودة
التأثير وضيّقة النطاق من حيث الإشعاعات، ليس هو اليوم العامل الذي
يمكن أن يحسم الحرب في أوكرانيا بصفة نهائية لصالح الجيش الروسي، خاصة
وأنّ خطوط الانتشار الميداني على الأرض أكثر تعقيداً وتشابكاً من أن
تسمح بفرز العدوّ من الصديق تحت طائلة الأذى النووي المباشر. ما يبقى
صحيحاً أيضاً، ومنطوياً على أمّ المخاطر إذا جاز القول، أنّ بوتين هو
سيّد نفسه ومالك القرار الأوحد والأقصى في تشغيل هذه «الوسيلة»
العسكرية أو تلك، واستحقاقات المنطق السليم الأبسط تفرض وَضْع ما
يتفوّه به، أو ما يلمّح إليه، على محمل أعلى إنذاراً من مجرّد التحايل.
تلك ذاكرة تنفع في استعادة مناخات الحوافّ النووية التي أطلقها الحلف الأطلسي أوّلاً وسبقت تلميحات بوتين الراهنة، بل لعلها كانت وتظلّ العتبة القصوى لوضع احتمالات المواجهة النووية بين القوى العظمى على محكّ التمحيص والتدقيق
في جانب آخر هامّ من المسألة
النووية ذاتها، وكي ينصف المرء هواجس الكرملين في حقبة أخرى سبقت حرب
بوتين الأوكرانية بـ39 سنة، ويومها كان الغرب والولايات المتحدة والحلف
الأطلسي هي الجهات المحرّضة على تغذية حافّة نووية لعلها كانت الأخطر
حتى الساعة؛ بافتراض أنّ قصف هيروشيما وناغازاكي كان مجابهة نووية من
طرف واحد، بقرار الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان، في آب (أغسطس)
1945. مراحل بلوغ تلك الحافة بدأت مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 1983، مع
إطلاق الحلف الأطلسي التمرين الذي يشتهر اليوم تحت الاسم العملياتي
Able Archer،
والذي انطوى على إدخال سلسلة جديدة من طرائق الاتصال والتشفير والراديو
بين رؤساء الدول والحكومات، بهدف التدريب على طور من التصعيد العسكري
ينتهي إلى التصدي لهجوم نووي، وما يقتضيه من تفعيل نظام الدفاع النووي
الأمريكي الشهير المعروف باسم
DEFCON 1..
وفي أعمال لاحقة كتبها مؤرخون أمريكيون سوف تتكشف معلومات مذهلة عن قلق
البنتاغون ومستشاري البيت الأبيض إزاء حقيقة عسكرية تقول إنّ السبّاق
إلى تنفيذ الضربة النووية الأولى سوف يحيل المواجهة إلى «حرب الدرجة
صفر» حيث لن يكون في وسع المدافع أن يردّ بما يكفي لشلّ ضربات المهاجم
المتعاقبة؛ وهذا فضلاً عن مصدر قلق أمريكي خاص هو قدرة الغواصات
النووية السوفييتية على التسلل سرّاً إلى مواقع في عرض المياه
الأمريكية، تتيح قصف واشنطن بأسلحة نووية.
كانت الحرب الباردة في عقودها الأخيرة، مع رئاسة رونالد ريغان في
واشنطن ويوري أندروبوف في موسكو، ولكنها أيضاً كانت في واحدة من أسخن
مواضعاتها لجهة التجسس والتجسس المضاد، ولهذا لم تشأ القيادة
السوفييتية أخذ ذلك التمرين النووي على محمل «الزعبرة» فاستنفرت ما
تملك من وسائل دفاع نووية، وكاد التاريخ أن يعيد تكرار الاحتقان
الأمريكي ـ السوفييتي حول صواريخ كوبا سنة 1962، ولكن مع فارق التهديد
النووي الوشيك هذه المرّة. ولسوف يقف العالم على بعض أخطار تلك الحافة
مع انشقاق ضابط الاستخبارات السوفييتية أوليغ غوردييفسكي بعد سنتين،
وحرص ريغان على استقباله في البيت الأبيض وسط مظاهر حفاوة وتكريم غير
مسبوقة. قبل ذلك كانت معلومات غوردييفسكي، حول مظاهر الاستنفار والقلق
الشديد التي انتابت القيادة السوفييتية بصدد ذلك التمرين، قد وصلت إلى
المخابرات العسكرية البريطانية، فنقلتها إلى مارغريت ثاتشر، رئيسة
الوزراء البريطانية يومذاك، التي خشيت من مضاعفات التمرين فاتصلت
بالرئيس الأمريكي وطلبت التخفيف ما أمكن من الجوانب الاستعراضية
والاستفزازية.
تلك ذاكرة تنفع في استعادة مناخات الحوافّ النووية التي أطلقها الحلف
الأطلسي أوّلاً وسبقت تلميحات بوتين الراهنة، بل لعلها كانت وتظلّ
العتبة القصوى لوضع احتمالات المواجهة النووية بين القوى العظمى على
محكّ التمحيص والتدقيق؛ حتى أنّ البعض لم يعد يجد حرجاً في الحديث عن
«تفكيك» مشاهد الخراب والدمار، إذا استُخدمت «قُنيبلة» نووية صغرى وليس
أياً من شقيقاتها القنابل الكبرى. وبعد 21 سنة انقضت على تمرين الـAble Archer، كان بوتين قد بشّر
العالم، خلال اجتماع مع أركان القيادة العسكرية الروسية، بأنّ روسيا
سوف تنشر في الأعوام القليلة القادمة أنظمة صواريخ نووية جديدة،
متفوّقة على كلّ ما تمتلكه جميع القوى النووية الأخرى. وتابع يقول، في
تصريحات نُقلت مباشرة على شاشات التلفزة الرئيسية، إنّ بلاده لا تكتفي
بالأبحاث النووية والاختبارات الناجحة للأنظمة الجديدة، بل هي ستتسلّح
بها فعلياً خلال السنوات القليلة القادمة: «أنا واثق أنّ هذه التطوّرات
والأنظمة غير متوفرة لدى الدول النووية الأخرى، ولن تكون متوفرة في
المستقبل القريب».
لم يكن بوتين يتحايل يومذاك، كما قد يقول أيّ عاقل، ولكنّ الناطق باسم
البيت الأبيض، سكوت ماكليلان أعلن في حينه أنّ هذه الأخبار ليست جديدة
على الإدارة، وطمأن العالم: «نحن على إطلاع تامّ حول جهودهم الثابتة
لتحديث آلتهم العسكرية. ونحن اليوم حلفاء في المعركة العالمية ضدّ
الإرهاب».
بعد 4 سنوات فقط، كان الرئيس الأمريكي الـ44 باراك أوباما قد اختار
بوّابة براندنبورغ في برلين، لإعلان البشارة بأنّ الولايات المتحدة
اتفقت مع روسيا حول محاربة الإرهاب، وعلى الدعوة إلى خفض الترسانة
الصاروخية النووية بمقدار الثلث! وبالأمس فقط كان الرئيس الأمريكي
الـ46 جو بايدن قد اعتلى سدّة الأمم المتحدة ليذكّر العالم بأنّ حافة
بوتين النووية ليست قائمة منذرة بالمخاطر فقط، بل هي تعبر روسيا، ونحو
أوكرانيا والعالم بأسره… تتقدّم!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
روسيا وأوكرانيا:
مدّ الحسابات وجزر الكوابيس
صبحي حديدي
الجيش الروسي، سلاح القوة الكونية الثانية عسكرياً، صرف أسابيع ممضة
منذ أيار (مايو) الماضي لاجتياح مناطق واسعة من أوكرانيا، تحت طائلة
خسائر باهظة في الأرواح والمعدات؛ وكان أنه، خلال أسبوع واحد وفي إطار
هجمات أوكرانية مضادة، خسر نحو 6,000 كم مربع في عمق منطقة خاركيف،
ضمنها 3,000 كم مربع في جبهة الشمال. مبكّر، بالطبع، الحديث عن منعطف
حاسم يمكن أن يقود الاجتياح الروسي إلى أعتاب تعثّر جديدة، لا يُستبعد
أن يرقى بعضها إلى سوية الانتكاسات الموجعة؛ ولكن قد يكون مواتياً
تصنيف المجريات العسكرية الراهنة في خانة التحوّل النوعي في ميادين
القتال، الأمر الذي سوف يفرز أكثر من منطق متغيّر في ميادين السياسة،
أو سياسة الحرب على وجه التحديد.
على صعيد الداخل الأوكراني، ليست محطة عابرة أن يسارع الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي إلى زيارة مدينة إزيوم، التي تمّ تحريرها مؤخراً من
الاحتلال الروسي، فيرفع علم بلاده على وقع النشيد الوطني؛ ثمّ أن يقرن
رمزية هذه الخطوة بما يقارب ابتزاز أوروبا والولايات المتحدة، والبناء
على هذا الانتصار للمطالبة بمزيد من شحنات الأسلحة الثقيلة التي ستكفل
إنجاز انتصارات أخرى. وزير خارجيته لم يتردد في الغمز من قناة المستشار
الألماني أولاف شولتس، المتردد في إرسال مدرعات «ليوبارد 2» وعربات
«ماردير»، قائلاً: ما الذي يخيف برلين، إذا كانت كييف غير خائفة؟
وللمرء أن ينتظر صدى هذه التصريحات في باريس ولندن، بما يُترجم بالفعل
إلى «سياسة صلبة» في تزويد الجيش الأوكراني بالأحدث والأكثر تطوراً في
ميادين التسلّح، اقتداء أيضاً بما فعلت واشنطن في حزمة مساعدات جديدة
بقيمة 675 مليون دولار، تُضاف إلى مليارات سابقة خرجت من صندوق
البنتاغون المستقلّ عن الصندوق الرئاسي للبيت الأبيض.
وكان تطوراً منطقياً، كذلك، أن تصل أصداء مكاسب الجيش الأوكراني إلى
الداخل الروسي، ولكن على هيئة خيبات وجراح نرجسية؛ فيحدث، للمرة الأولى
منذ بدء الاجتياح العسكري الروسي في أوكرانيا، أن يتوافق حفنة من
مسؤولي 18 بلدية في محيط موسكو وبطرسبورغ على توقيع بيان مشترك يطالب
باستقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن يضطرّ دمتري بيسكوف الناطق
باسم الكرملين إلى منحهم الحقّ في التعبير (فهم منتخبون، في نهاية
المطاف)؛ وألا يفوته، في الآن ذاته، تذكيرهم بأنّ تعدّد الآراء يحكمه
خطّ رفيع للغاية لا يصحّ تجاوزه. وليس من المبالغة الافتراض بأنّ
انتكاسات الجيش الروسي في خاركيف كانت على الأجندة المضمرة في مباحثات
قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في سمرقند، خاصة لقاءات بوتين مع أمثال
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (حيث الخلافات الروسية – التركية تُطبخ
عادة على نيران إقليمية خافتة)، أو رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي
(حيث الخلافات الروسية – الهندية أقرب إلى نار تحت الرماد). ورغم أنّ
الإدارة الأمريكية ابتهجت تماماً، وكما يُنتظر منها، إزاء انتكاسات
الجيش الروسي الأخيرة، فإنّ «الحكماء» من مستشاري البيت الأبيض، خاصة
العارفين بما يمكن لأيّ دبّ روسي جريح أن يذهب إليه ضمن ردّات الفعل،
نصحوا بالتريث في تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى تتجاوز أمديتها 300
كم.
البعض في الغرب يذهب، على سبيل تثمين المكاسب الأوكرانية الأخيرة، إلى
درجة استرجاع الحقيقة التي تقول إنّ آخر اختراق عسكري ميداني شهدته
أوروبا كان في صيف 1995 حين نجح الجيش الكرواتي في تحرير 17,000 كم
مربع من أٍراضي كرايينا الصربية، متناسين أنّ نحو 150,000 صربي هُجّروا
يومئذ من مساكنهم. ولا عجب أن يترافق رفع العلم الأوكراني في إزيوم مع
الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية تحوي 445 جثة، فهذا تفصيل شبه محتوم في
حرب روسية بدأت من مفاجآت حساباتها المتضاربة، ولا تكفّ عن المسير نحو
مدٍّ في تطوراتها وجزرٍ، يُبقي الكثير من كوابيسها معلّقة محتمَلة.
بعد 21 سنة: ماذا تبقى من
أكذوبة «الحرب على الإرهاب»؟
صبحي حديدي
ذات مفترق جيو ـ سياسي غير بعيد في الزمن، لم يتردد البعض في إسباغ
البُعد التاريخي على منعرجاته، بات مصطلح «الحرب على الإرهاب» أقرب إلى
تعبير مفرَغ من أيّ معطى عملي يتصل بمضمونه العملي والفعلي؛ وذلك رغم
رواجه الواسع والسريع، والميل الأسرع إلى استخدامه كيفما اتفق، بصرف
النظر حتى عن تفسيراته اللغوية المحض. في ذاك الزمن، حقبة الرئيس
الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وهيمنة المحافظين الجدد على مفاصل
الإدارة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية، كان للسير مايكل
هوارد، المؤرّخ البريطاني الأخصائي بتواريخ الحروب، رأي آخر لافت لا
يسير على خطوط مناهضة تماماً لمحتوى التعبير، فحسب؛ بل أيضاً نحو سجال
مناهض يتوخى التسفيه والتعرية، قبل النقض والدحض. لقد أسقط عن الصراع
ضدّ الإرهاب صفة الحرب، وسخر استطراداً ممّن يتشدّقون بالقول إنها «حرب
عالمية» وأعاد التشديد على حقيقة مزدوجة، ليست البتة جديدة في واقع
الأمر: أنّ أمريكا ترى نفسها في صفّ الخير ضدّ الشرّ، كالعادة، وأنّ
خصمها الفعلي الراهن هو الإسلام المتشدد (بعد أن كان الشيوعية، أساساً)
وليس أيّ مفهوم مجرّد لـ«الإرهاب». ولقد تساءل هوارد عمّا إذا كانت
تسمية «الحرب» تمنح الفريق الثاني، أي «الإرهابيين» أنفسهم، صفة شرعية
تستوجب حصولهم على الحقوق، مثل خضوعهم للواجبات، المنصوص عنها في
المواثيق الدولية الخاصة بالحروب؟
والذكرى السنوية لهجمات 11/9، وهي في أيلول (سبتمبر) الجاري تسجّل 21
سنة بالتمام والكمال، تردّ إلى الذاكرة سلسلة محاور ومواقف وقرارات
وأحلاف ومعارك وُضعت على برامج «الحرب على الإرهاب» ولكن تعددت
أجنداتها أو تقاطعت أو تناقضت، ويندر أنها تكاملت، على مبعدة مثيرة من
معترك الحرب ذاتها، أية حرب بأية صيغة. بين الأكثر دراماتيكية، حيث
الميلودراما أيضاً، كان ذلك الوعيد الشهير الذي أطلقه جيمس وولزي، من
رئاسة وكالة المخابرات المركزية ولكن من حرم جامعة كاليفورنيا، ربيع
2003، ضدّ «أضراب مبارك» و«العائلة الملكية السعودية»؛ من أنّ عليهم أن
«ينرفزوا» بشدّة لأنّ أمريكا تعتزم، بعد احتلال العراق، الانفتاح على
الشعوب المقهورة في الشرق الأوسط، وخوض الحرب العالمية الرابعة معها،
كتفاً إلى كتف! وأمّا الترجمة العملية لذلك «الانفتاح» على الشعوب، فقد
تولّته وزيرة الخارجية الأمريكية يومذاك، كوندوليزا رايس، حين عقدت
اجتماعاً رباعياً مع رئيس مجلس الأمن الوطني السعودي الأمير بندر بن
سلطان، ومدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان، ومدير
المخابرات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ هزاع بن زايد، ومدير
المخابرات الأردنية محمد الذهبي!
بيد أنّ خواتيم الـ21 سنة، كما تأتي أكلها هذه الأيام، هي انتصار
الطالبان في أفغانستان، ومشهد الاستعصاء الذي يشهده العراق داخل الصفّ
الشيعي تحديداً؛ إذا صرف المرء النظر عن عشرات الحركات الجهادية
والإرهابية التي توالدت وتكاثرت سنة بعد أخرى، في أعقاب لافتة بوش
الابن الشهيرة على متن البارجة أبراهام لنكن مطلع أيار (مايو) 2003،
التي أعلنت أنّ «المهمة اكتملت». أو وضع المرء جانباً ستراتيجيات/
تخبطات ثلاثة رؤساء أمريكيين بعد تلك اللافتة، الأشبه بفضيحة معلنة سوف
يحتاج صاحبها إلى خمس سنوات قبل أن يضطرّ إلى الاعتذار عن هرطقاتها. أو
إذا ذهب أبعد فتبصّر حصاد «انتصارات» أمريكية عسكرية واستخباراتية
استعراضية، مثل اغتيال أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي وأيمن
الظواهري؛ على ضوء ما أسفرت عنه تلك العمليات من تصفية الأجساد دون
اجتثاث جذورها في النفوس، أو في خلايا يقظة وأخرى نائمة.
ما تبقى من تلك «الحرب» هو الرسوبات العديدة، والكثير منها بات تشوّهات مستعصية، متخلقة عن تلك النظرية الثابتة واليقينية والتبسيطية التي ابتدعها بوش الابن: 11/9 كانت جولة للشرّ ضدّ الخير، ولا وسيلة لانتصار الخير على الشرّ إلا بما فعلنا في أفغانستان والعراق
أو، أخيراً وليس آخراً، إذا شاء المرء إقامة روابط (ليست خاطئة ولا
افتراضية) بين الكثير من مظاهر الهوس الجماعي الشعبوي في مساندة «الحرب
على الإرهاب»؛ وبين صعود دونالد ترامب، والترامبية عموماً، وما اقترن
به وبها من شروخ شعبوية وعنصرية وانعزالية وميليشياتية في قلب المجتمع
الأمريكي.
جوانب أخرى ليست أقلّ أهمية كانت، وتظلّ، مدى تمسّك قطاعات مختلفة من
الجمهور الأمريكي بمصطلح «الحرب على الإرهاب» اتكاءً على محطة كبرى في
تطويره هي الاجتياح الأمريكي للعراق سنة 2003؛ وما تبقى من ذلك الهوس
الذي اكتسب هيئة الظاهرة في حينه، الشعبية والشعبوية في آن معاً، وكانت
قواسمه العظمى ترتدّ إلى معاني الولاء الوطني والأمن الجَمْعي. من
الخير في هذا الصدد العودة إلى أنتوني ديماجيو، أستاذ العلوم السياسية
في جامعة ليهاي، بنسلفانيا، ومؤلف كتاب «فاشية صاعدة في أمريكا: يمكن
أن تحدث هنا»؛ الذي أشرف على استطلاع رأي أجرته الجامعة مؤخراً
بالتعاون مع مجموعة هاريس المعروفة، أظهر أنّ ٪79 من الأمريكيين
المستطلَعين يناهضون الحرب التي شُنّت ضدّ العراق، تحت لافتة «الحرب
على الإرهاب» بالطبع. أسبابهم تتنوّع، وهذا أمر جدير بالتمعّن:
٪20اعتبروا أنها كانت خطأ ولا تقود إلى الظفر، و٪17 بسبب كثرة الضحايا
في صفوف الأمريكيين، و٪15 لأنها لم تكن مبررة أخلاقياً، و٪11 لأنّ
كلفتها كانت عالية من منظور مالي. ليس خافياً، إلى هذا، مغزى غياب أيّ
نسبة تناهض تلك الحرب لأنّ أكلافها البشرية والمادية والعمرانية
والبيئية كانت باهظة وفادحة على الشعب العراقي ذاته، في المقام الأوّل.
غير أنّ الجديد الهامّ في استطلاع الرأي الذي أشرف عليه ديماجيو هو طرح
السؤال الحاسم، ربما للمرّة الأولى في تاريخ استطلاعات الرأي حول
«الحرب على الإرهاب»: ما الذي تعتقد أنّ مناهضي الحرب على العراق
يقصدونه في قولهم إنها غير مبررة أخلاقياً؟ هنا، أيضاً، تنوّعت
التأويلات: ٪64 اعتقدوا أن الحديث عن أخلاقيات تلك الحرب على صلة
بالمزاعم الكاذبة، خاصة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل؛ ٪31 اعتبروا
أنها تخصّ بالأعداد الكبيرة من الضحايا، في صفوف الجنود الأمريكيين؛
و٪31 افترضوا أنها ناجمة عن حرب شُنّت بغرض الهيمنة على العراق ونفطه؛
واللافت، أخيراً، أنّ ٪22 ربطوا انعدام أخلاقية الحرب بالأعداد الكبيرة
من الضحايا في صفوف المدنيين العراقيين. وفي ظنّ هذه السطور، وبصرف
النظر عن التباينات المختلفة عند قراءة نتائج ذلك الاستطلاع، أنّ
الخلاصة الأبرز قد تكون قناعة 8 من كلّ 10 أمريكيين أنّ «الحرب على
الإرهاب» كانت خديعة مدروسة، أو تضليلاً متعمداً، أو حتى أكذوبة
مصنّعة.
وهكذا فإنّ ما تبقى من تلك «الحرب» هو الرسوبات العديدة، والكثير منها
بات تشوّهات مستعصية، متخلقة عن تلك النظرية الثابتة واليقينية
والتبسيطية التي ابتدعها بوش الأبن: 11/9 كانت جولة للشرّ؛ ضدّ الخير
(الذي ينبغي أن يبدأ من هنا: من واشنطن، والقِيَم الأمريكية، و«طرائقنا
في العيش» وديمقراطيتنا، وفلسفات سياستنا واجتماعنا واقتصادنا…)؛ ولا
وسيلة لانتصار الخير على الشرّ إلا بما فعلنا في أفغانستان والعراق
(ثمّ في فلسطين ولبنان وسوريا… بالإنابة، أو بالتفويض، ضمن الشراكة مع
دولة الاحتلال الإسرائيلي)؛ وهذه الحرب على الإرهاب، بقيادة أمريكية
دائماً، هي سمة القرن الحادي والعشرين. مع فارق أنّ 21 سنة انقضت من
هذا القرن، والانتكاسات لا تتعاقب هنا وهناك في أفغانستان والعراق
خاصة، والحليف الإسرائيلي لا ينحطّ أكثر فأكثر نحو أسوأ أنماط
الأبارتيد، فحسب؛ بل لقد بلغ الأمر درجة الانقلاب الداخلي على «طرائقنا
في العيش» إياها، سواء عبر التمرّد على صناديق الاقتراع ونتائج
الانتخابات الرئاسية، أو مهاجمة الكابيتول قلعة الديمقراطية الأمريكية،
أو النكوص عن مكاسب وحقوق مدنية تبدأ من حرية المعتقد ولا تنتهي عند
الحقّ في الإجهاض…
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
فسيفساء ليبيا
ومسارح السيسي
صبحي حديدي
وزير الخارجية المصري سامح شكري مشهود له بمواقف دراماتيكية، يرقى
الكثير منها إلى الميلودراما، ناجمة عن كونه صوت سيّده على منوال
غالبية حاملي هذه الحقيبة في أنظمة الاستبداد والفساد والتبعية، في
المقام الأوّل؛ ولكنها، في المقام الثاني، ليست بعيدة عن، أو من
المنطقي أن تعكس، تمثيل شخصيته المولعة بالأداء المسرحي. يُذكر له،
مثلاً، أنه خلال أحد المؤتمرات الصحفية أبعد ميكروفون قناة «الجزيرة»
عن الطاولة الحاشدة بميكروفونات شتى، ثمّ ألقى به إلى الأرض؛ وذلك
تجسيداً لقرارات مقاطعة قطر التي كان نظام عبد الفتاح السيسي قد انخرط
فيها، صحبة السعودية والإمارات والبحرين.
انسحابه، مؤخراً، من الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على
المستوى الوزاري، احتجاجاً على تسليم الرئاسة إلى نجلاء المنقوش وزيرة
الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية؛ لم يكن من طينة واقعة
الميكروفون لجهة الوفاء بالميلودراما، ولكنه في المقابل ظلّ أميناً
للنزوع المسرحي الذي دأب عليه شكري. لقد علم مسبقاً أنّ المنقوش ستترأس
الجلسة، ولكنه حضر وجلس واختار أن ينسحب لحظة وصول الوزيرة الليبية إلى
سدّة الرئاسة. وعلم، كما يعلم جيداً ودائماً، أنّ الأمين العام للجامعة
هو صوت سادته في الرياض وأبو ظبي أساساً، وأنّ هؤلاء السادة لم يقرروا
الانسحاب وإلا لاستُبعدت المنقوش قبل انعقاد الجلسة. وكان، أخيراً وليس
آخراً، يعلم أنّ الزعم بانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة تناقضه
مزاعم أخرى تؤكد شرعية بقائها حتى تنظيم الانتخابات، طبقاً لاتفاقيات
تمّ إبرامها في باريس والصخيرات وسواها.
غير أنّ سلوك شكري ليس سوى تفصيل تراجيكوميدي، ما دُمْنا في سياق
مصطلحات المسرح، بالمقارنة مع التفاصيل الأشدّ جسامة والأكثر انطواء
على مخاطر راهنة وأخرى وشيكة أو ينذر بها المستقبل القريب؛ جراء تكريس
حكومة أولى في طرابلس يقودها الدبيبة وأخرى في طبرق ترأسها فتحي باشاغا
بقرار من البرلمان، وما يتفرّع عن هذا الانشطار الثنائي من انقسامات
متعاقبة تصنعها سلطات وصلاحيات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
هذا فضلاً عن ضباط مجموعة الـ5+5 في ما تبقى لهم من أصداء حضور الغائب،
وضباط على شاكلة أبو راس والضاوي والتاجوري والجويلي ممّن قادوا أو سوف
يقودون تجارب اجتياح العاصمة بالنيابة عن مطامح باشاغا وصالح وربما
بالأصالة عن المشير الانقلابي خليفة حفتر في الخلفية المعتمة…
فوق هذا وذاك فإنّ فسيفساء انشطارات القوّة هذه لا ترقى، إلا في هوامش
استدراكية ضئيلة، إلى الشطرنج السياسي والعسكري والميليشياتي الذي
تنخرط فيه قوى تشمل مصر والإمارات والسعودية وروسيا وتركيا وفرنسا
والولايات المتحدة وإيطاليا؛ ومجموعات مسلحة أو إرهابية تمرّ من «تنظيم
الدولة» المنتعش والمزدهر والمنتشر في الجنوب، ولا تنتهي عند مرتزقة
«فاغنر» الروسية ورفاقهم في الارتزاق من المجموعات التشادية
والسودانية. وأمّا خارج اليابسة، في عباب البحر الأبيض المتوسط،
فالتحالفات المصرية/ اليونانية/ القبرصية/ الإسرائيلية في ميادين
استثمار الغاز لا تواجه المنافس التركي في المياه وحدها، بل كذلك في
هدير مسيّرات «بيرقدار» التي تؤرّق جنرالات باشاغا وحفتر مثلما تُطمئن
نظرائهم في صفّ الدبيبة.
وهذه حال تعيد الذاكرة إلى أيّ أثر متبقٍّ من «الخط الأحمر» الذي رسمه
السيسي ذات يوم غير بعيد، وحدّد أمن مصر القومي في تجاوز محور سرت
والجفرة؛ بحيث يلوح اليوم أنّ المسرح الذي يمثّل على خشبته أمثال
الوزير المصري شكري هو الشطرنج الأبرز الذي تدير القاهرة حركاته، بين
عقيلة/ باشاغا/ حفتر من جهة أولى؛ ولعله، من جهة ثانية، أطلال نظرية
السيسي حول «شرعية» تدخّل مصر في ليبيا. وأمّا مصائب أبناء ليبيا،
المعيشية والإنسانية قبل السياسية والعسكرية، فإنها ليست في حسبان
الخطوط الحمراء، ولا حتى على خشبة المسرح.
اعتزال الصدر ورمزية الغيبة:
مَنْ يلوم رامي مخلوف؟
صبحي حديدي
في وسع المرء أن يضرب أخماساً بأسداس إذْ يقف على ظاهرة الزعيم الشيعي
العراقي مقتدى الصدر كما تقرأها أسبوعية الـ»إيكونوميست» البريطانية
العريقة، غير البعيدة عن أن تكون المنبر الأهمّ لبيوتات المال والأعمال
والشركات العملاقة ومناهج اقتصاد السوق، فضلاً عن تمثيل الفلسفات
الليبرالية المختلفة، متوحشة كانت أم «مُؤنْسَنة». وما دامت جولات
الصراع الراهنة في العراق تدور أساساً بين الأطراف الشيعية، «التيار
الصدري» مقابل «الإطار التنسيقي»، أو على وجه أقرب: بين مقتدى الصدر
ونوري المالكي؛ فلم لا تعود الـ»إيكونوميست» القهقرى إلى 1149 سنة خلت،
حيث يروي التراث الشيعي عن غيبة الإمام محمد بن حسن بن علي المهدي،
واقتراح تأويل عصري لاعتزالات الصدر المتكررة يضعها في مصافّ الغيبات!
وقد يقول قائل، محقاً في وجهة واحدة على الأقل هي استمرار سطوة التراث
الشيعي الإثني عشري: لِمَ ملامة الأسبوعية البريطانية في هذه العودة
إلى سنة 873 حين غاب المهدي، إذا كان رامي مخلوف (ابن خال رأس النظام
السوري، وتمساح النهب الأشرس والأجشع المُطاح ببعض نفوذه مؤخراً لصالح
ناهبات/ ناهبين صاعدات وصاعدين)، قد استعاد رمزية المهدي مؤخراً،
متشكياً من ظلم الأرض: «العلامات الكبرى ستظهر (والله أعلم) في الأشهر
القليلة القادمة وستقتلع الظلم من جذوره على مستوى العالم بأسره ليتمّ
التحضير لدولة الحق بقيادة سيدنا المهدي عليه السلام». فارق
الـ»إيكونوميست» أنها، مع ذلك، لا تسبغ على الصدر سمات قداسية من أي
نوع، بل تحرص على ردّه إلى ما هو فيه: «رجل الدين والسياسي المثير
للشغب»، الذي يبدو كمَن يقتفي أثر رمزية الغيبة لإلهام المؤمنين به
وتحدّي ظالميهم.
ومع استبعاد فوري لأيّ مستوى من المقارنة بين شخص الصدر وشخص مخلوف
(وهذه خطوة ليست ضرورية إلا عند هواة التسطيح والقراءة البليدة عن سابق
قصد)، فإنّ اللجوء إلى التلويح بعودة المهدي عند الثاني ومنهجية
الاعتزال/ الغيبة عند الأول تنتهي إلى مراد متماثل، حتى إذا تشعبت
عناصره وأغراضه: تجييش الأنصار عبر تسخير رمزية مذهبية شيعية، حتى إذا
كانت فاعلية التوظيف متضاربة أو حتى متناحرة. فمن المعروف أنّ الصفّ
المناوئ للتيار الصدري شيعي بدوره، ولا يفتقر البتة إلى رمزيات كثيرة
مستمدة من التراث الإثني عشري ذاته؛ بل يكفي المرء استذكار اسم
الميليشيات الأكثر تورطاً في الممارسات المناوئة (على غرار «عصائب أهل
الحق» بقيادة قيس الخزعلي) لإدراك مدى انخراط الميليشيات في استهلاك،
وانتهاك، الرمزيات الشيعية.
ليست خافية، كذلك، آمال مخلوف في تحشيد فئات من أبناء الطائفة العلوية
باتت تميل باضطراد إلى الفقه الشيعي الكلاسيكي أو الإثني عشري، حتى مع
بقائها وفية للمكوّنات التقليدية النصيرية؛ والمطمح هنا جرّ بعض أنصار
رأس النظام السوري إلى التعاطف، ولكن على خلفية انخراط مخلوف في
«التظلّم» إلى المهدي. وثمة مغزى خاصّ، كذلك، في أنّ مخلوف لم يكتفِ
بالإتيان على اسم المهدي، بل تقصد استخدام تعبير «صاحب الزمان»… الأثير
عند حسن نصر الله في خطب عديدة؛ بما يفضي إلى طراز (أحمق بالطبع، وغير
مُجْدٍ) من الإيحاء بالانضواء في صفّ «حزب الله» وأدبياته، ضدّ خصوم
مخلوف (أسماء الأخرس، ثمّ بشار الأسد شخصياً وأوّلاً).
مَن يلوم مخلوف، إذن، في هذا الاستدعاء الوصولي لشخصية المهدي؟ وهل
تُلام الـ»إيكونوميست»، استطراداً، في هذا الابتسار الاستشراقي وتوصيف
اعتزال الصدر بمصطلح غيبة المهدي؟ وإذا صحّ أنّ كلا الاستدعاء
والابتسار يقتضي ما هو أبعد من الملامة، وأقسى من تهمة الانتهاز
المفضوح عند الأول والتسخيف الهجين عند الثانية؛ فإنّ الحقيقة الأخرى
تظلّ ماثلة وساطعة، لجهة تكرار اعتزالات الصدر ورجوعه عنها، والتسبب في
كلّ مرّة بأوجاع إضافية لا يكون دافع أثمانها الباهظة أو الدامية سوى
المواطن العراقي البسيط والمعذب.
مجزرة الغوطة: إليوت
هغنز وصحافة المواطن
صبحي حديدي
في الذكرى التاسعة للضربة الكيميائية التي نفذّها جيش النظام السوري
وطالت بلدات زملكا وعربين وكفر بطنا وعين ترما والمعضمية ومواقع أخرى
من الغوطتين الشرقية والغربية في محيط العاصمة دمشق يوم 21 آب (أغسطس)
2013، يظلّ استذكار الضحايا (بين 1127 و1450 قتيلاً، في عدادهم 201
امرأة و107 أطفال) هو الأجدر بالاستعادة، وطنياً وإنسانياً وأخلاقياً.
ثمة، في المقابل، عناصر أخرى تستحق وقفة خاصة لاعتبارات أخرى تتجاوز
أسباب تكريم الشهداء، أو تظهير وحشية النظام، أو عجز المجتمع الدولي،
أو تسجيل مناسبة جديدة فاضحة لتكريس مبدأ الإفلات من المساءلة والعقاب؛
تتصل بجانب محدد يغيب عادة عن المظاهر المعتادة في إحياء الذكرى: دور
الصحافة الاستقصائية، وما بات يُعرف باسم “صحافة المواطن”، في كشف
الخفايا التي يحرص الإعلام التقليدي على طمسها عن سابق عمد أو نزولاً
عند ضغوطات تمويلية وسياسية وأمنية مختلفة.
آلاف، وربما عشرات الآلاف، من أشرطة الفيديو ذات القيمة التوثيقية
والتسجيلية العالية، صوّرها مواطنون متطوعون وناشطون ملتزمون بينهم
شهود عيان يصحّ تصنيفهم في خانة الناجين من المجزرة؛ جرى نشرها تباعاً
على منصة يوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولعبت وما تزال
تلعب دوراً حاسماً في تثبيت جريمة الحرب وتبيان الكثير من تفاصيلها
الأقرب إلى أدلة جنائية. وإذْ يضيق المقام، أيّ مقام في الواقع، عن
إنصاف أولئك الجنود المجهولين؛ فإنّ واحداً على الأقلّ من أبرز ممثّلي
صحافة المواطن يمكن أن يُساق نموذجه نيابة عن العشرات، أو المئات، من
نظرائه: البريطاني إليوت وارد هغنز
Higgins (1979
ــ)، الذي أطلق في آذار (مارس) 2012 مدوّنة أولى بالاسم المستعار براون
موزس، اتخذ لها لاحقاً تسمية
Bellingcat،
اختصت بتغطية “الربيع العربي” من زاوية موادّ الفيديو المختلفة التي
ينشرها النشطاء؛ ثمّ تخصصت، أكثر فأكثر، في تحليل أنواع الأسلحة
المستخدمة في النزاعات المسلحة، ولم يطل الوقت حتى باتت المدوّنة
مرجعاً لا غنى عنه لدى وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية الكبرى.
ولقد نشر هغنز عن سوريا مجموعة تدوينات متفرقة مبعثرة، انصبت عموماً
على تشخيص أنواع المعدات العسكرية التي كانت تصل إلى فصائل المعارضة
المسلحة، وتوصيف مصادرها، واستنتاج دلالاتها السياسية والعسكرية؛ لكنّ
أولى مدوّناته، “المنظمة” كما يصفها، كانت سلسلة تعليقات حول مجزرة
الحولة التي نفذّها النظام ضدّ بلدة تلدو يوم 25 أيار (مايو) 2012،
وأوقعت 108 ضحايا، من بينهم 34 امرأة و49 طفلاً. ونزعة التوثيق
المتأصلة لديه قادته إلى تصنيف أشرطة الفيديو طبقاً للجهات التي
تنشرها، بحيث باتت لديه مجموعة ذات مواصفات مشتركة بلغت في البدء 15
قناة، وانتهت إلى 550. كذلك كانت تصنيفات هغنز للقنابل العنقودية قد
قادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إلى التعاقد معه للعمل على
تحليل قرابة 500 شريط توثّق استخدام تلك القنابل. بعد مجزرة الغوطة،
سوف يحتلّ هغنز موقع المرجع الأوثق في تدقيق الملابسات، سواء في تفنيد
منكري مسؤولية النظام عن ارتكابها، أو إعانة فريق التحقيق الأممي في
العثور على الأدلة.
المأساوي أنّ مجرم الحرب الذي أمر باستهداف الغوطتين لا يخضع اليوم إلى أيّ طراز من المساءلة القانونية، ويتمرّغ في أحضان رعاته وسادته المجرمين الكبار، بل وينتظر استكمال إعادة تأهيله وتبييض صفحته الإجرامية وغسل يديه من دماء الضحايا الأبرياء
ومن باب إنصاف الرجل أن تُقتبس هنا حكاية موقع “منت برس” الإخباري
الأمريكي الذي كان، بعد أسبوع فقط على المجزرة، قد نشر تقريراً مثيراً
بعنوان
“سوريون في الغوطة يزعمون أنّ ثوّاراً تزوّدهم السعودية بالسلاح هم
وراء الهجمة الكيميائية”؛ جاء في خلاصته الأكثر دراماتيكية أنّ سوء نقل
أسلحة كيميائية أسفر عن انفجارها، وأدى إلى وقوع أعداد كبيرة من
الضحايا. كان أمراً طبيعياً أن تسارع وكالات الأنباء إلى تلقّف
الحكاية، خاصة على خلفية ما كان يتردد من عزم إدارة الرئيس الأمريكي
باراك أوباما على توجيه ضربة إلى النظام السوري عقاباً على تجاوز
“الخطّ الأحمر” لاستخدام السلاح الكيميائي؛ وكان المنتظَر أكثر أن تكون
وسائل إعلام إيرانية رسمية، وأخرى روسية (بلسان وزير الخارجية سيرغي
لافروف نفسه) هي أوّل مَنْ يتبنى المزاعم ويروّج لها.
أولى خيوط التشكيك في هذه الرواية العجيبة جاءت من هغنز، الذي ساق جملة
معقدة من المعطيات الدقيقة المضادة، الموثقة بمشاهد الفيديو المتقاطعة
وذات المصادر المتعددة، حول الصواريخ التي حملت الرؤوس الكيميائية إلى
الغوطة؛ وكيف أنها في عهدة قوّات النظام وحدها، وانطلقت من المواقع
التي يسيطر عليها، في جيل قاسيون بصورة خاصة. أكثر من ذلك، دقّق هغنز
في هوية موقِّعي التقرير، الأمريكية ديل غافلاك وزميلها الأردني يحيى
عبابنة؛ وإذا كان الأخير مغموراً شبه مجهول، فإنّ الأولى كانت مراسلة
الأسوشيتد برس، وتقيم في العاصمة الأردنية عمّان منذ عقدين، وتغطي
المنطقة في إذاعتَيْن جبارتين، الـ
NPR
الأمريكية والـ
BBC
البريطانية، وهي ــ كما تعرّف عن نفسها، على الأقلّ ــ “أخصائية”، تحمل
الماجستير في الدراسات الشرق ـ أوسطية من جامعة شيكاغو.
وهكذا افتُضحت الأكذوبة تباعاً، فكتبت غافلاك إلى هغنز، وإلى صحافيين
في مواقع أخرى بينهم روبرت ماكي من “نيويورك تايمز”، تقرّ بأنها لم
تذهب إلى سوريا، ولم تستمع بنفسها إلى أقوال أهل الغوطة، ودورها في
التقرير هو نقل أفكار زميلها عبابنة إلى الإنكليزية؛ وأنها أوصت تحرير
“منت برس” بالامتناع عن وضع اسمها على المادة، لكنهم رفضوا، ولهذا
فإنها تنوي مقاضاة الموقع. من جانبه، توارى عبابنة عن الأنظار، فمسح
المعلومات القليلة المتوفرة عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهرّب
من الصحافيين الذين حاولوا التحقق من صحة تقريره؛ قبل أن يتضح أنه دائم
الزيارات إلى روسيا، ويكتب في “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية باسم “يان
بركات”، وله باع طويل في تقديم الخدمات السياحية للإسرائيليين!
هذه التفاصيل، وسواها الكثير الدامغ حول الضربات الكيميائية التي نفذها
النظام السوري في مواقع مختلفة من سوريا، يجمعها اليوم كتاب هغنز “نحن
البلينغكات: وكالة استخبارات من أجل الشعب”، الذي صدر هذا العام عن
منشورات بلومزبري في لندن، وضمّ خمسة فصول طافحة بالمعطيات. وإذا كانت
صفحات الكتاب تميط اللثام عن جرائم الحرب التي يرتكبها طغاة هنا وهناك،
من بشار الأسد في سوريا إلى فلاديمير بوتين في أوكرانيا؛ فإنها، أيضاً،
تكشف قسطاً غير قليل من عورات مؤسسات إعلامية عملاقة، تتستر على
الحقيقة بقدر ما تتواطأ على الفظائع. ولعلّ طرافة عنوان الفصل الرابع،
“فأر يصطاد هرّاً”، ليست سوى وجه الكوميديا الدموي الذي تعتمده أجهزة
استخبارات الكرملين، لاغتيال المعارض الروسي سيرغي سكريبال باستخدام
غاز الأعصاب نوفيتشوك.
ويكتب هغنز أنّ ملابسات هذه الجريمة، ودور الـ”بلينغكات” في تسليط
الضوء على مضامينها الكيميائية تحديداً، كانت بمثابة إعادة إنتاج
للكثير من العناصر التي كانت وراء تعرية الضربة الكيميائية التي
استهدفت الغوطتين الشرقية والغربية: “جريمة بأسلحة كيميائية، حكومة
متسلطة تكذب على العالم وتتوقع الإفلات من العقاب، حملة تضليل معلومات
على الإنترنت، سلطات غربية تجهد لحلّ القضية، ومحققون مواطنون يتصدّون
وليس في حوزتهم سوى الحقائق ذات الصلة، وأنّ الدليل ظاهر بادٍ للعيان،
والتدقيق مطلوب ومثله المحاسبة”. المأساوي، في المقابل، أنّ مجرم الحرب
الذي أمر باستهداف الغوطتين لا يخضع اليوم إلى أيّ طراز من المساءلة
القانونية، ويتمرّغ أكثر فأكثر في أحضان رعاته وسادته المجرمين الكبار،
بل وينتظر استكمال إعادة تأهيله وتبييض صفحته الإجرامية وغسل يديه من
دماء الضحايا الأبرياء.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
نووي إيران
وجرعات السمّ المحتوم
صبحي حديدي
إذا صحت التقارير عن موافقة طهران
على «تسوية نهائية» اقترحها الاتحاد الأوروبي لإحياء اتفاق 2015 حول
البرنامج النووي الإيراني، وبافتراض أنّ الصيغة الأوروبية لم تكن أصلاً
بعيدة عن استئناس بالرأي الأمريكي يصحّ وضعه في مصافّ التنسيق الوثيق؛
فإنّ حصيلة الشدّ والجذب التي استغرقت جلسات مطوّلة شاقة بين جنيف
والدوحة وفيينا لن تسفر، حتى إشعار آخر يثبت العكس، عن انتصار مشهود
للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفريقه، ويجوز بالتالي أن تُحتسب حصيلة
عجفاء هزيلة.
في صياغة أخرى، ما كان فريق الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، خاصة
وزير الخارجية محمد جواد ظريف صاحب الشخصية الضاحكة المرنة، قد مهّد له
طيّ بنود «خطة العمل الشامل المشترك» مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا
وروسيا والصين، ثمّ الولايات المتحدة في الخلفية غير المباشرة؛ هو، على
أكثر من وجهة تخصّ العقوبات والاقتصاد والنفط وتخصيب اليورانيوم، نسخة
مستعادة من الاتفاق الوشيك الذي اقترحته أوروبا وتبدو إيران موشكة على
القبول به. مع تعديلات «تجميلية» هنا وهناك، بالطبع، لا تطمس مع ذلك
قسطاً غير قليل من خسائر إيران: عزل «خطة العمل» الجديدة عن ملفات
أثيرة لدى طهران، مثل شطب الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب
الأمريكية، والإبقاء على مؤسسات «الحرس» المالية والاقتصادية تحت طائلة
العقوبات، والامتناع عن تقديم ضمانات بأنّ أيّ رئيس أمريكي مقبل لن
يمتلك حقّ الانسحاب من الاتفاق.
ما كُشف عنه النقاب حتى الساعة من التفاصيل العملية للاتفاق المرجّح،
وهي في توصيف آخر الثمار التي سوف تجنيها طهران منه، تتحدث عن تحرير 17
مصرفاً و150 مؤسسة اقتصادية من العقوبات، ورفع التجميد عن 7 مليارات
دولار من ودائع إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، والسماح بتصدير 2,5
مليون برميل نفط يومياً بعد 120 يوماً من توقيع الخطة الجديدة. سلّة
النفوذ الإقليمي الإيراني في المنطقة، ابتداء من اليمن والعراق وليس
انتهاء بسوريا ولبنان؛ فضلاً عن برامج التسلّح الإيرانية، خاصة في قطاع
الصواريخ بعيدة المدى؛ ليست بنوداً صريحة التحديد بالطبع، لكنها في صلب
التفاهمات الضمنية أو ما قد ينقلب إلى «ملاحق» غير معلَنة.
ومع ذلك، قد يتوفر أكثر من اعتبار خلف استعداد حكومة رئيسي، والمرشد
الأعلى علي خامنئي شخصياً، لقبول الصفقة المطروحة، وذلك على صعيدَين في
الحدّ الأدنى. الأوّل أنّ إبرام الاتفاق لن يمسّ، إنْ لم يعزّز، أجندات
التدخل الإيراني الخارجي لصالح الطغاة وأنظمة الاستبداد والفساد، وخدمة
مبدأ «تصدير الثورة» الإسلامية، وتمدّد الوجود العسكري والأمني
والمذهبي الإيراني هنا وهناك في المنطقة. والثاني، الأخلاقي والإنساني،
هو أنّ الإفراج عن عشرات المليارات المجمدة، وتمكين الاقتصاد الإيراني
من الانعتاق في قطاعات شتى، سوف ينتهي أيضاً إلى التخفيف من مشاقّ
الحياة اليومية ومصاعب العيش وسلسلة المشكلات البنيوية التي تثقل كاهل
المواطن الإيراني في المقام الأوّل، وربما الحصري أيضاً.
وإذْ لا ينتظر المرء، أو كما علّمت تجارب الماضي، أن يذعن آيات الله
ومتشدّدو السلطة في إيران لمقتضيات الصعيد الثاني، مقابل انغماسهم أكثر
فأكثر في تفضيل الصعيد الأوّل؛ فإنّ ضرورات الاقتصاد القصوى تبيح بعض
محظورات التعنت خلف رفض القبول بمشروع الاتفاق الجديد، عملاً بالقاعدة
القديمة التي تشير إلى إذعان مُكرَهٍ لا بطل. وكان الإمام الخميني نفسه
سباقاً إلى الأخذ بقاعدة أخرى مماثلة، حين أعلن قبل 34 سنة أنه تجرّع
«كأس السمّ» حين وافق على وقف إطلاق النار مع عراق صدّام حسين.
وقد لا يكون ما تعاقد عليه روحاني سنة 2015، ويضطرّ رئيسي إلى استئنافه
اليوم معدّلاً أو حتى منتقَصاً، من طراز السمّ القديم أو لا يقتضي
الترياق إياه؛ الأرجح أنه، إلى هذا وذاك، جرعة محتومة لا مهرب منها،
ولا مفرّ.
جفاف أوروبا:
غضب الطبيعة أم غلواء الرأسمالية؟
صبحي حديدي
خير أن تُقرأ جيداً، وبتبصّر لائق وتأمّل عميق، تصريحات أندريا توريتي
الخبير الإيطالي وأستاذ علوم المناخ في جامعة برن، سويسرا: جفاف سنة
2018 كان شديداً إلى درجة أنّ معدّلاته لا سابق لها خلال 500 سنة في
الماضي، ولكنّ معدّلات هذه السنة 2022 أسوأ مما كانت عليه قبل ثلاث
سنوات. والرجل لا يتحدث عن أفريقيا أو أستراليا هذه المرّة، ولا عن
مناطق الجفاف المعتادة المألوفة، بل يقصد أوروبا على وجه التحديد؛
ومثاله الأبرز، على غرار سواه من علماء مناخ أوروبيين، هو ما يتعرّض له
نهر كبير عريق مثل الراين، على أصعدة انحسار المياه إلى مستويات مرعبة
قد لا تسمح بأيّ شكل من أشكال الملاحة فيه.
من جانبه يشير “مرصد الجفاف الأوروبي” إلى أنّ 64% من أراضي الاتحاد
الأوروبي تتأثر اليوم بظواهر جفاف مختلفة الشدّة والنطاق، وأن” 47%
منها تقع تحت وطأة شروط “الإنذار”، و17% باتت تُصنّف في دائرة
“الاستنفار”؛ الأمر الذي يدفع مركز أبحاث المفوضية الأوروبية إلى تبنّي
أطروحة توريتي بأنّ قارّة أوروبا العجوز لم تشهد ظواهر جفاف مماثلة منذ
500 سنة، والمثال هنا نهر آخر آخر عريق كبير هو الدانوب أطول أنهار
القارّة. وليس انحسار المياه هو وحده سمة هذه التبدلات العاصفة، إذْ
بات نهر بو في إيطاليا عاجزاً عن تأمين سقاية حقول الأرز أو حضانة
المحار، كما أدّت سخونة مياه نهرَيْ رون وغارون في فرنسا إلى تعطيل
طاقة تبريد المفاعلات النووية. والمعطيات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة
سوف تنطوي، في يقين توريتي نفسه، على “مخاطر جفاف شديد يضرب أوروبا
الغربية والوسطى، إلى جانب بريطانيا”.
أسماك أوروبا، بسبب درجات حرارة المياه العالية وانخفاض محتوى
الأوكسجين، تنفق بالملايين؛ وعلى مدّ النظر بات نهر أودر، الذي ينبع من
جمهورية التشيك ويتفرّع في بولندا ويحاذي ألمانيا، مغطى بالأسماك
الميتة، لأنّ غضب الطبيعة تلاقى هنا مع التلويث الصناعي للنهر فصار
انحسار المياه حاضنة مفتوحة لتدفّق سموم الصناعات الكيميائية وركودها
في الحوض. زراعات الحبوب الأوروبية هبطت بنسبة 20 إلى 40% في إيطاليا،
و20% في فرنسا، فأضافت مشقة على عسر استيراد الحبوب الأوكرانية؛ وأمّا
زيتون إسبانيا الشهير، الذي يعادل قرابة نصف الصادرات إلى العالم، فإنّ
أرقامه اليوم تشير إلى ربع المحصول المعتاد المسجّل خلال السنوات الخمس
الماضية. وحتى في البلدان الأعلى رطوبة، مثل النروج، فإنّ تدنّي معدلات
المياه في الأحواض تسفر تلقائياً عن انخفاض قدرتها على توفير الطاقة
الهدروكهربائية، وهذا يضيف المزيد إلى حرج تغييب مقادير النفط والغاز
التي اعتادت روسيا تأمينها.
غلواء الرأسمالية تفرض طرازاً من التغيير قادماً لا محالة، في قلب مظاهر الرعب كما توثّقها مشاهد الجفاف والفيضانات والحرائق؛ وليس للمواطن الأوروبي خيار في هذا، غير أن يقاوم ويرفض ويسعى إلى التبدّل والتبديل
مسؤولية النظام الرأسمالي عن قسط أكبر من هذه الظواهر المميتة تبدأ،
كما يقول المنطق البسيط، من حقيقة أنّ الغالبية الساحقة من حكومات
أوروبا الغربية والوسطى تعتمد هذا الشكل أو ذاك من تنويعات اقتصاد
السوق في المنظور الرأسمالي. القطاع الخاصّ، في المقابل، يدين أيضاً
لاشتراطات السوق وقوانين العرض والطلب، من جهة أولى؛ ويظلّ غير ملزَم،
حتى ضمن منطوق العقيدة الشهيرة: “دَعْه يعمل، دعه يمرّ”، بالحدّ من جشع
تكديس الأرباح على سبيل الإسهام في خدمة الطبيعة والمناخ وكبح جماح
غضبات الجفاف والفيضان والحرائق، من جهة ثانية. ذلك يتجلى بصفة خاصة في
ميدان الزراعة، إذْ تشير معطيات وكالة “ناسا” إلى أنّ 13 ضمن 37 من
أحواض المياه الجوفية الكبرى يتمّ استنزافها بأسرع مما يمكن إعادة
تعبئتها؛ وأنّ الزراعة تستهلك 70% من استخدام المياه العذبة، مقابل 20%
في قطاع الصناعة. لكنّ البلوى تبدأ من جشع توظيف الزراعة لتحقيق أرباح
فلكية، سواء عبر طرائق الريّ عالية الاستهلاك للمياه، أو زراعة
المحاصيل ذات المدى القصير والربح السريع في مناطق غير ملائمة مائياً
أو حتى مناخياً، أو احتطاب مساحات واسعة في الغابات لتحويلها إلى حقول
زراعية.
وقبل أقلّ من سنة اجتمع في غلاسكو، برعاية الأمم المتحدة، 120 من زعماء
العالم على مختلف المستويات، وأكثر من 22 ألف مندوب و14 ألف مراقب؛
وعكفوا على قراءة وتحليل مختلف جوانب التغيّرات المناخية، كما درسوا
العلوم والحلول والسياسات؛ واختصر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش الحصيلة هكذا: “النصوص المعتمدة هي حل توافقي”. بالطبع، لأنها
“تعكس المصالح والظروف والتناقضات وحالة الإرادة السياسية في العالم
اليوم”، والمشاركون اتخذوا “خطوات مهمة، ولكن لسوء الحظ لم تكن الإرادة
السياسية الجماعية كافية للتغلب على بعض التناقضات العميقة”. وبالطبع،
استطراداً، لأنّ التخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعيدة
عن المستوى الذي يتوجب أن تكون عنده للحفاظ على “مناخ صالح للعيش”،
و”لا يزال الدعم المقدّم للبلدان الأكثر ضعفاً والمتضررة من آثار تغير
المناخ ضعيفاً للغاية”، كما اعترف تقرير غوتيريش.
وكان مؤتمر غلاسكو مناسبة جديدة لتأكيد النتائج الميدانية الهزيلة التي
انتهت إليها توصيات مؤتمر المناخ الأشهر، باريس 2015؛ حيث لم يكن قرار
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب كلياً من التزامات
أمريكا في ذلك المؤتمر هو وحده رصاصة الرحمة الأكثر دوياً في الإجهاز
على روحية التوصيات، بل كذلك لأنّ هذه الأخيرة لم تكن في الأصل ملزِمة
للدول الموقّعة عليها! وكان المعنى الأجدى بالاستخلاص يقود إلى أنّ
دولاً أخرى في عداد كبار الملوِّثين، أمثال الصين وروسيا والهند
والبرازيل، لها أن توقّع على التوصيات في غلاسكو صباحاً، وأن تنقع
توقيعها بالماء مساء في بكين أو موسكو أو نيو دلهي أو برازيليا… وأمّا
بعض فضائل غلاسكو القليلة فقد تمثلت في إتاحة منبر عالمي يعيد التشديد
على تعبير “الإبادة المناخية”
Climate Genocide
الذي، للمفارقة الصارخة، كان من نحت الأمم المتحدة ذاتها في التقرير
الشهير المفزع الذي صدر مطلع آب (أغسطس) 2021. وللتذكير المفيد، كانت
أبرز خلاصات تلك المذبحة أنّ استقرار ثاني أكسيد الكربون في الغلاف
الجوي أعلى في العام 2019 ممّا كان عليه خلال مليونَيْ سنة من عمر
البشرية؛ ودرجة حرارة الأرض قفزت، ابتداء من 1970، بشكل أسرع من أيّ
زمن عرفته المعمورة منذ 2000 سنة على أقلّ تقدير.
وليس الأمر أنّ غضب الطبيعة لا رادّ له، أو أنّ الحلول مستعصية أو
مستحيلة، بل أنّ جوهر العلاج يبدأ من خلاصات علوم المناخ حول إرضاء
الطبيعة وحُسْن التعامل مع متغيراتها؛ وهذا، غنيّ عن القول، مشروط بما
يُستطاع من إرغام الأنظمة والشركات الكبرى والصناعات الملوِّثة ذات
التوجهات الرأسمالية الصرفة على اعتماد سياسات صديقة للمياه، مطيعة
للبيئة، خادمة للإنسان وحاجاته في المقام الأوّل، وليس لمراكمة الأرباح
وتكديس المليارات. ليس مثالياً هذا المآل، أو غير قابل للتحقق كما قد
يقول قائل متشكك، لأنّ صندوق الاقتراع الذي يتيح للناخب الأوروبي
اختيار أمثال إمانويل ماكرون وأولاف شولتس في أعلى هرم القرار السياسي
والاقتصادي، يُلزمه كذلك بإرغام الساسة على تطويع توحّش رأس المال
وانفلات الاستغلال من كلّ عقال، في ميادين حيوية مثل الصناعة والزراعة
والمياه والطاقة النووية.
صحيح أنّ سيرورة كهذه قد تستوجب تغيير النظام في كثير أو قليل، غير أنّ
غلواء الرأسمالية تفرض طرازاً من التغيير قادماً لا محالة، في قلب
مظاهر الرعب كما توثّقها مشاهد الجفاف والفيضانات والحرائق؛ وليس
للمواطن الأوروبي خيار في هذا، غير أن يقاوم ويرفض ويسعى إلى التبدّل
والتبديل.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
الجنائية الدولية في سنّ العشرين:
قضاء هزيل وحصيلة عجفاء
صبحي حديدي
مرّت، قبل أيام قليلة، الذكرى العشرون لإطلاق محكمة الجنايات الدولية،
المنبثقة عن قانون روما المنقلب إلى معاهدة بعد توقيع 60 دولة عليه؛
ولم يخلُ الاحتفال من منغصات كبرى، ليست البتة صغرى على هدي المشكلات
المعتادة المقترنة بمنظمات ومؤسسات دولية تطمح إلى تطبيق القانون
الدولي وإعلاء شأن حقوق الإنسان والسعي إلى المساءلة. العلّة الأهمّ
كانت، وتظلّ، ماثلة في أنّ ثلاثة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن
الدولي، الولايات المتحدة وروسيا والصين، لا تعترف بالمحكمة أو تعرقل
عملها بقوّة حقّ النقض (الفيتو)؛ فضلاً عن حقيقة أنّ 70 من 193 دولة
عضو في منظمة الأمم المتحدة ليست منتسبة إلى محكمة الجنايات الدولية.
العلّة الثانية هي نهج الكيل بمكيالين، طبقاً لمدى تمتّع الملفّ
المطروح على المحكمة بمساندة/ مناهضة قوى عظمى، خاصة تلك التي تملك
بالفعل سلطة التعطيل، أو حتى فرض عقوبات شتى على المحكمة وقضاتها؛ كما
فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خريف 2018 حين أبلغ
الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنّ المحكمة لا شرعة لها ولا شرعية ولا
سلطة في الولايات المتحدة، ثمّ أعقب ذلك بعد سنتين بفرض قيود وعوائق
تأشيرة على موظفي المحكمة جراء التحقيق في ممارسات أفراد أمريكيين على
أرض أفغانستان. الولايات المتحدة ذاتها، ولا فرق أن يكون رئيسها قد صار
اسمه جو بايدن، حثت المحكمة ذاتها على التحقيق في ممارسات الجيش الروسي
خلال غزو أوكرانيا، رغم أنّ روسيا انسحبت من المحكمة في سنة 2014
احتجاجاً على قرا الجنائية اعتبار ضمّ القرم “عدواناً متواصلاً”، ورغم
أنّ قانون المحكمة التأسيسي لا يجيز محاكمة دولة ليست عضواً منتسباً
إليها.
هذه، في المقابل الفاضح للكيل بأكثر من مكيال، ليست ولم تكن قطّ حال
رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ إذْ منذ العام 2015 سارعت فاتو بنسودا،
المدعية العامة السابقة للمحكمة، إلى إصدار توضيح رسمي قالت فيه إنّ
الفظائع المزعومة في سوريا تشكل بالفعل “جرائم خطيرة تثير قلق المجتمع
الدولي وتهدد السلم والأمن والرفاه في المنطقة وفي العالم”، إلا أنّ
سوريا ليست طرفاً في نظام روما، وبالتالي لا تتمتع المحكمة بالاختصاص
الإقليمي للتحقيق في الجرائم المرتكبة على الأراضي السورية. زميلها
كريم خان، المدعي العام الحالي، لم يتردد في إصدار بيان ذي منطوق
قانوني مناقض تماماً: “أعلنت قراري حول استصدار إذن بفتح تحقيق في
الحالة في أوكرانيا، مستنداً إلى استنتاجات سابقة توصل إليها مكتبي،
وتشمل جرائم مزعومة جديدة تدخل في اختصاص المحكمة”. ولم يطل الوقت حتى
أرسلت الجنائية إلى أوكرانيا الفريق الأضخم على امتداد تاريخها،
للتحقيق وجمع الأدلة. ليس هذا فقط، بل إنّ المحكمة تملصت، وتواصل
التملّص، من جهود المحامي البريطاني رودني دكسون برفع دعوى أمام
المحكمة ضدّ بشار الأسد بالنيابة عن مواطنين سوريين في مخيمَيْ الزعتري
والأزرق، بتهمة الترحيل الإجباري من وطنهم، وارتكاب جرائم التهجير
التعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري واستخدام أسلحة محرّمة بينها
الكيميائي؛ كما تتهرّب من قبول الدعاوى السورية قياساً على قبولها
ملفات أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.
الصحيح الآخر الموازي يقود إلى ما انتهت إليه المحكمة من قضاء هزيل وحصيلة عجفاء، خاصة حين يتصل الأمر بالمبدأ الأكبر في كلّ وأية عدالة: التساوي في الخضوع للقانون، وفي إسباغ العقاب والحساب على صحيح الجرم والجناية
العلل الأخرى قد تكون أقلّ وطأة، مثل افتقار المحكمة إلى مفارز شرطة
خاصّ بها يتولى تنفيذ قراراتها وإجراء التحقيقات في أوقات وقوع
الانتهاكات وإحضار المتهمين، الأمر الذي يُلزمها بالتعاون مع السلطات
المحلية، التي يندر أن تتعاطف مع مطالب المحكمة. إنها، في المقابل،
تقوم على جهاز بيروقراطي ومالي لا يستهان به، مثل 900 موظف، ينتمون إلى
قرابة 100 دولة؛ ومقرّ ضخم في مدينة لاهاي الهولندية، ومكاتب اتصال
فرعية ملحقة بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وفي 7 دول أخرى؛ بميزانية
بلغت 154,855 مليون يورو في سنة 2022 الجارية. الحصيلة، مع ذلك، عجفاء
هزيلة: أوّل إدانة تعود إلى آذار (مارس) 2012، وطالت الكونغولي توماس
لوبانغا دييلو بتهمة تجنيد أطفال في الحرب؛ واستمعت المحكمة إلى 31
قضية أمام المحكمة، وأصدرت 37 أمر توقيف، ونفذّت 21 حالة اعتقال، وخلصت
إلى 10 إدانات، و4 قضايا تبرئة.
وبمعزل عن آل الأسد والعشرات من مجرمي الحرب في جيشه وأجهزة مخابراته
وميليشياته، ثمّ العشرات من نظائرهم هنا وهناك في طول أنظمة الاستبداد
وعرضها؛ لا يصحّ أن تُذكر محكمة الجنائيات الدولية من دون أن تتوجه
أصابع الاتهام الصريح إلى عجزها الفاضح عن مساءلة عتاة مجرمي الحرب
الكبار؛ أمثال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، الأب مثل الابن، في
غزو العراق وأفغانستان (1,2 مليون ضحية، وعشرات الفظائع التي تتجاوز
حتى تصنيفات جرائم الحرب )؛ ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير
في الملفات ذاتها، خاصة جنوب العراق، والبصرة؛ ورؤساء حكومات الاحتلال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيهود أولمرت، إيهود باراك، إسحق شامير،
إسحق رابين، مناحيم بيغن؛ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار ضباطه،
ليس في القرم وبلاد الشيشان وجورجيا وأوكرانيا فقط، بل حيثما يقصف
طيرانه الحربي في سوريا وأينما تنتشر قواته الغازية…
صحيح، من جانب آخر، أنّ تأسيس قانون روما وما أسفر عنه من إطلاق
المحكمة الجنائية كان، وهكذا يظلّ، إنجازاً للمجتمع المدني الإنساني،
لا سجال حول أهميته من حيث الرمز أولاً، ثمّ الفعل أياً كانت العوائق
وأنماط القصور والعجز. غير أنّ الصحيح الآخر الموازي، الذي لا يقلّ
مغزى وحساسية، يقود كذلك إلى ما انتهت إليه المحكمة من قضاء هزيل
وحصيلة عجفاء، خاصة حين يتصل الأمر بالمبدأ الأكبر في كلّ وأية عدالة:
التساوي في الخضوع للقانون، وفي إسباغ العقاب والحساب على صحيح الجرم
والجناية. وأمّا شانئة الكيل بأكثر من مكيال في التعامل مع الملفات
التي يتوجب أن تنظر فيها المحكمة، فإنه سمة عامة مزمنة في تسعة أعشار
المؤسسات الدولية التي تُناط بها مهامّ كبرى جليلة مثل إرساء القانون
الدولي وتطبيقه.
وفي سنة 2013 أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً مفصلاً عن أنماط
الاحتجاز والتعذيب التي كان مواطنون سوريون قد خضعوا لها في مختلف
مقارّ ومعتقلات استخبارات النظام السوري؛ وكتبت المنظمة إلى مجلس الأمن
الدولي، باسم الحكومة السويسرية وبالنيابة عن 57 دولة (بينها فرنسا
وبريطانيا وألمانيا والنمسا وبلجيكا وفنلندا واليونان والنروج
والبرتغال وهنغاريا وأستراليا واليابان…)، تطالب بإحالة الوضع في سوريا
إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكنّ الرسالة ذهبت أدراج الرياح ليس
بسبب كابوس الفيتو الروسي أو الصيني فقط، بل كذلك لأنّ إدارة باراك
أوباما لم تجد نافعاً رشق الآخرين بالحجارة وبيتها مبنيّ من زجاج.
وقد تكون مفيدة هنا العودة إلى مثول الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش
أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، خريف العام
2002، أي قبل أشهر من إطلاق محكمة الجنايات الدولية. ولعلّ بين أفضل
التعليقات على تلك المحاكمة كان ذاك الذي كتبه المعلّق البريطاني
الراحل هوغو يونغ، حين اعترف بأنّ الزعيم الصربي لا يقف في قفص الاتهام
لأنه ارتكب سلسلة من الجرائم بحقّ الإنسانية؛ بل، بالأحرى، لأنه ارتكب
الخطأ القاتل المتمثّل في اجتياح كوسوفو عسكرياً في زمن غير ملائم. أي،
للإيضاح المفيد: في زمن فرض الوصاية الأمريكية ـ الأوروبية على
الإقليم، إذْ أنّ الجرائم التي حوكم ميلوسيفيتش بموجبها، بما في ذلك
فظائع كرواتيا والبوسنة، كانت لن تُثار، أو ستُنسى تماماً، لو أنها
ارتُكبت في سياقات أخرى!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
تعليم فلسطين
ومدارس السكاكيني
صبحي حديدي
للمؤرّخ والأكاديمي الفلسطيني نور مصالحة أعمال عديدة بالغة الأهمية،
تغطي مسائل شائكة وحساسة ومفتوحة المفاعيل والعواقب؛ مثل النكبة، وطرد
الفلسطينيين وترحيلهم في إطار مفهوم الترانسفير، والنفي الإجباري
والتهجير القسري، وسياسات التوسّع، وخرافة أرض بلا شعب، ونهج الإنكار
الإسرائيلي. مفضّلة لدى هذه السطور، في المقابل، أعمال تذهب أبعد من
التأريخ والتوثيق إلى خلفيات ثقافية وأنثروبولوجية، على غرار «التوراة
الصهيونية: السابقة التوراتية، الاستعمار، ومحو الذاكرة»، الذي صدر سنة
2013 بالإنكليزية عن منشورات
Routledge؛
وكتاب «لاهوتيات التحرير في فلسطين ــ إسرائيل: منظور متأصّل وسياقي
وما بعد استعماري»، الذي حرّره مع ليزا إشروود وصدر بالإنكليزية سنة
2014، عن
Lutterworth Press.
كتابه الأحدث «فلسطين عبر الألفيات: تاريخ التعليم، التعلّم، والثورات
التربوية» صدر بالإنكليزية أيضاً عن منشورات
I.B. Tauris،
ويتناول كما يشير العنوان جوانب شتى من سيرورات محو الأمية وعصورها
المتعاقبة في فلسطين؛ مبتدئاً من فجر الكتابة في الهلال الخصيب
والمدارس السومرية في بلاد الرافدين والحاضنة السورية والفلسطينية
للكتابة المصوّرة، قبل 5,000 سنة؛ مارّاً بما يسميه مصالحة «الثورات
الفكرية» في فلسطين البيزنطية (القرون الثالث وحتى مطلع السابع)؛
وتحويل اليونانية والسريانية إلى العربية، وحركات الترجمة الفلسطينية
في ظلّ الإسلام؛ فالتعليم اللاتيني خلال ممالك الصليبيين، ومكتبة
الناصرة؛ وصولاً إلى «العصر الذهبي» مع مدارس الشريعة الإسلامية في
القدس، خلال عهود الأيوبيين؛ ثمّ دور الأزهر القاهري، و»الأزهر
الفلسطيني» متمثلاً في مدرسة عكا الأحمدية؛ وصولاً إلى العصور اللاحقة،
مع العثمانيين والكتاتيب والمدارس الحديثة، التي ضمّت المسلمين
والمسيحيين واليهود.
كان السكاكيني نموذجاً خاصاً، فريداً على أكثر من صعيد، اختزل صعود شريحة داخل الإنتلجنسيا العربية ــ الفلسطينية؛ بدأت بصيغة جنينية من القومية العروبية الراديكالية، ولعلها انتهت إلى صيغة وليدة من القومية الشعبية الليبرالية.
الفصل التاسع، من أصل 11 فصلاً ومقدّمة وخاتمة، يتناول قضايا التربية
والتعليم من زاوية أَنْسُنية نهضوية؛ ويشدد، بالتالي، على شخصية المربي
والأديب الفلسطيني الكبير خليل السكاكيني (1878-1953)؛ و»المدرسة
الدستورية» التي أنشأها في مدينة القدس سنة 1909 صحبة علي جار الله
وجميل الخالدي وآخرين، وتولى إدارتها بعد عودته من أمريكا قبل سنة، وفي
ضوء ثورة «تركيا الفتاة» التي اعتنقت المبدأ الدستوري وأتاحت حرّية
الصحافة واللامركزية للولايات العربية. ويفصّل مصالحة سمات تلك المؤسسة
التعليمية الرائدة، واستئناسها بفلسفات يونانية قارّة (أرسطو وأفلاطون
وسقراط) حول التعليم، تقاطعت أيضاً مع كتابات السكاكيني «الاحتذاء
بحذاء الغير»، 1896؛ و»النهضة الأرثوذكسية»، 1913؛ وكذلك مئات الصفحات
من مذكراته والتي وقعت في 3,500 صفحة، ويكتب مصالحة أنّ مواضيعها
المركزية كانت «النهضة، اليقظة الثقافية والفكرية، الحرية، الوطنية،
الهوية الثقافية، التسامح الديني، تعليم النساء، الكرامة الإنسانية،
وتحريم العقوبة الجسدية».
اهتمام مصالحة بالجوانب التعليمية والتربوية في شخصية السكاكيني دفعه
إلى تشديد أقلّ، متعمد غالباً ومفهوم، على الأبعاد السياسية لدى ناشط
فلسطيني تحمّس بقوّة للملك فيصل الأوّل، والتحق مع بعض رفاقه بالثورة
العربية الكبرى عند إعلانها عام 1916، ثم اتصل مع الأمير في العراق،
وسافر إلى مصر ضمن مهامّ سياسية خاصة بالثورة. كذلك انضمّ السكاكيني
إلى «جمعية الاتحاد والترقي» في القدس، وشغل أمانة سرّ اللجنة
التنفيذية لـ»لمؤتمر العربي الفلسطيني»، الذي تأسس في سنة 1920 وتحوّل
بعدئذ إلى «الحزب العربي الفلسطيني». وخلال إدارة «المدرسة الدستورية»
خاض السكاكيني سلسلة معارك شجاعة لإصلاح المناهج الدراسية وتقوية
التوجهات العلمانية في تدريس التراث والتاريخ والأدب والعلوم، فعاقبته
السلطات العثمانية بإبعاده عن القدس أوّلاً، ثم سجنته في دمشق.
بعد الإفراج عنه بكفالة مالية، عاد السكاكيني إلى القدس وشرع في تأسيس
دار المعلمين، التي استقال منها بعد وقت قصير احتجاجاً على تعيين هربرت
صموئيل مندوباً سامياً لبريطانيا في فلسطين. لكنه لم يقلع عن التزاماته
التربوية، فسافر إلى القاهرة ليمارس التعليم، ويكتب مقالاته اللاهبة
والساخرة في منابر كبرى مثل «المقتطف» و»الهلال» و»السياسة». ثمّ درّس
في بيروت بتكليف من الجامعة الأمريكية، وأسس في القدس «كلية النهضة»،
وانتُخب عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق، وفي مجمع اللغة العربية
بالقاهرة. ويُذكر أنّ العديد من وزارات التربية العربية تحتفظ بمؤلفات
السكاكيني التدريسية، خصوصاً كتابه الضخم «الجديد في القراءة العربية»
الذي يقع في أربعة أجزاء.
وهكذا فإنّ كتاب مصالحة، إذْ يستكشف الكثير من الجوانب الخافية ذات
الصلة بقطاع هامّ في تاريخ فلسطين هو التربية والتعليم، فإنه أيضاً
يعيد إنصاف شخصية السكاكيني من زوايا كانت أثيرة لدى المربّي الكبير،
ويصحّ أن تبقى ماثلة في وعي الأجيال الفلسطينية الراهنة على وجه
التحديد. ذلك لأنّ السكاكيني كان، أيضاً، مثقفاً ومناضلاً ومعلّماً على
تماسّ مباشر مع هواجس أهل فلسطين في ميادين شتى، فمثّل ضمن الكنيسة
الأرثوذكسية تياراً عروبياً ــ إسلامياً لم يكن مألوفاً آنذاك؛ وشارك
في تكوين تيّار قيادي طليعي ضمن صفوف الفئات الشعبية المسيحية، في زمن
شهد استئثار الأُسَر التقليدية (مثل آل القطان وآل عطا الله) بالنفوذ
والعمل السياسي؛ كما مثّل، أخيراً وليس آخراً، أحد أهمّ وأخطر التيارات
الداعية إلى إعادة النظر الجذرية في المناهج التربوية، وتسليحها برؤية
علمانية وعلمية معاصرة.
ومن الجائز القول إنّ السكاكيني كان نموذجاً خاصاً، فريداً على أكثر من
صعيد، اختزل صعود شريحة داخل الإنتلجنسيا العربية ــ الفلسطينية؛ بدأت
بصيغة جنينية من القومية العروبية الراديكالية، ولعلها انتهت إلى صيغة
وليدة من القومية الشعبية الليبرالية.
بيوت البرلمان
العراقي وحوزاته
صبحي حديدي
البرلمان العراقي، من حيث التعريف والوظيفة والمبنى، ليس حوزة أو
حسينية تحتشد في أروقته القوى الشيعية العراقية، فتتفق أو تختلف وتأتلف
أو تتصارع؛ ولكن في الوسع وقوع ذلك، من حيث الشكل والمظهر على الأقلّ،
حينما يوجّه الزعيمُ الشيعي مقتدى الصدر، وربما حين لا يضطر إلى
التصريح فيكتفي بالتلميح.
ذلك لا يعني، كما أوضحت مشاهد الأيام القليلة الماضية، أنّ زعيماً
شيعياً ميليشياتياً منافساً مثل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لا
يستطيع التجوّل في محيط البرلمان وشوارع «المنطقة الخضراء»، حاملاً في
اليد اليمنى بندقية آلية، وفي جيب القميص جواز سفر أحمر اللون (إيرانيّ
الجنسية؟)؛ باسم الشيعة عموماً كما يزعم، ولكن خصيصاً باسم شيعته هو
ونيابة عن محازبيه وحلفائه الآتين من كلّ فجّ سطحي أو عميق.
خارج البرلمان، في تسميته الرسمية أو في انقلاباته إلى حوزة أو حسينية،
تظاهر أيضاً أنصار «التيار التنسيقي» لتذكير الشارع (الشعبي، فضلاً عن
الإقليمي والدولي، قبل المرجعية الشيعية العليا و»التيار الصدري»،
فضلاً عن الكتل الممثلة للسنّة، وصولاً إلى فئات الكرد…)؛ بأنّ
انتخابات تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، وإنْ لم تكن رياحها مواتية
تماماً، لم تبدّل في شيء جوهر ولاء «التيار» لإيران سياسياً ومذهبياً،
ومثاقيل ذلك الولاء في المشهد المحلي.
وذات يوم غير بعيد شاءت طهران تلزيم شؤون «العراق ما بعد الاحتلال»،
كما سار التعبير الفاسد الزائف يومذاك، إلى ساسة أقرب إلى أتباع أمثال
نوري المالكي وحيدر العبادي وإبراهيم الجعفري؛ وإلى قادة ميليشيات أشدّ
ولاء وتبعية، أمثال أبو مهدي المهندس وهادي العامري وقيس الخزعلي؛ وكان
قاسم سليماني على قيد الحياة، يصول ويجول في مشارق «هلال الممانعة»
ومغاربه، فلا تحدّ صولاته وجولاته حدود بين بغداد وبيروت. في المقابل،
كانت هذه الخيارات الإيرانية البائسة، الحمقاء سياسياً وأخلاقياً كما
يتوجب القول، قد دفعت غالبية ساحقة من جماهير الشيعة، في مدن الصفيح
وقرى وبلدات الجنوب الفقيرة خاصة، إلى الهتاف بحياة مقتدى الصدر وعلي
السيستاني والحوزة العلمية، ضدّ «البوّاقين»، لصوص الشعب الفاسدين
المفسدين، الطائفيين اللاوطنيين. قسط غير قليل من تلك الشرائح الشعبية
كانت، قبل أزمنة غير بعيدة بدورها، قد اعتادت الهتاف بحياة أحمد الجلبي
أو إياد علاوي أو موفق الربيعي أو عدنان الباجه جي أو حتى عبد العزيز
الحكيم…
استعادة هذه الخلفيات لا تبدو صالحة لتوفير منطلقات شتى تتيح فهم
الأنواء التي تعصف اليوم بالبيت الشيعي العراقي، فحسب؛ بل لعلها أقرب
إلى قواعد اشتباك لا تتغيّر في الجوهر إلا لماماً، وعلى نحو طفيف
دائماً، متماثل المحتوى ومتغاير المآزق ليس أكثر. ذلك لا لأيّ اعتبار
آخر يسبق حقيقة نواس القوى الشيعية في ارتباطاتها مع طهران، بين 1)
ولاء تامّ أقصى وأعمى، و2) تطوّع في خدمة سلّة المصالح الإقليمية
الإيرانية ضمن «دفتر شروط» محليّ الطابع يخصّ اقتسام المصالح ومحاصصة
السلطة، و3) تحالف أكثر ترجيحاً للميزان المحلي وأعلى استجابة
لانتفاضات الشعب ضدّ «البوّاقين» ورعاة الفساد والنهب وانحطاط الخدمات.
وفي إسباغ هذا الاسم أو ذاك، أو هذه المجموعة السياسية والميليشياتية
أو تلك، على أنساق النواس الثلاثة المشار إليها؛ للمرء أن يتخفف من حرج
التدقيق في التصنيف أو الفرز، إذْ في الوسع دائماً إيجاد قواسم مشتركة
بين زيد هنا أو عمرو هناك، خاصة حين تنأى مرجعية السيستاني العليا عن
أيّ مقدار من الانحياز أو الترجيح أو التفضيل.
فالخلاصة الأهمّ قد تكمن في قراءة انقلابات البرلمان العراقي إلى حوزة
أو حسينية على قاعدة اشتباك من نوع آخر مختلف، سياسي واجتماعي وأخلاقي
قبل أن يكون مذهبياً أو مناطقياً؛ وهذا سبيل صالح، أيضاً، لإدراك
الأنواء التي تعصف ببيوت عراقية أخرى، سنّية وكردية وتركمانية ومسيحية…
بين دمشق 2007 وتايبه 2022:
بيلوسي ومكاييل المخاتلة
صبحي حديدي
الفارق بين مطلع نيسان (أبريل) 2007، حين قامت رئيس مجلس النواب
الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة دمشق والاجتماع مع رأس النظام السوري
بشار الأسد؛ وبين مطلع آب (أغسطس) 2022، حين زارت العاصمة التايوانية
تايبه؛ ليس 15 سنة في حساب الزمن فقط، بل ثمة تلك الفوارق الجيو ـ
سياسية التي تخصّ الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والتوازنات العليا بين
القوى العظمى، فضلاً عن اعتبارات إيديولوجية تبدلت في قليل أو كثير،
وأخرى أخلاقية نالت حظّها من تبديل الشكل مع الاحتفاظ بقسط كبير من
عناصر المضمون. قيل الكثير في الزيارة التايوانية، ولا يلوح أنّ ما سيق
من عواقب محتملة قد انطوى معظمه اليوم، وبذلك فإنّ هذه السطور تتوقف،
أكثر عند محطة بيلوسي السورية، التي سبقتها أيضاً محطات في دولة
الاحتلال والضفة الغربية ولبنان والسعودية.
قد يصحّ القول أنّ السذّج وحدهم (صحبة أجهزة إعلام نظام آل الأسد،
بالطبع) صدّقوا ما أعلنته بيلوسي ضمن أهداف محطتها السورية: «جئنا من
موقع الصداقة، والأمل، والتصميم على أنّ الطريق إلى دمشق هو طريق إلى
السلام» و«ليست لدينا أوهام، بل أمل كبير» لمحادثات سوف تتركز على
«محاربة الإرهاب». غير أنّ ساعات قليلة فقط تكفلت بفضح أكذوبة أولى
كبرى، حين أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال يومذاك، إيهود أولمرت، أنه لم
يحمّل بيلوسي أية رسالة إلى الأسد (على نقيض ما روّجت في تصريحاتها؛
وأنّ النظام السوري في ناظر الحكومة الإسرائيلية يظلّ داخل «محور
الشرّ» الشهير، الذي سبق أن شخّصه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش
الابن.
أكذوبة ثانية، فضحها البيان الرسمي ذاته الذي أصدره وفد مجلس النواب
الأمريكي الزائر (وتألف من بيلوسي، توم لانتوس، هنري واكسمان، نك رحال،
لويز سلوتر، وكيث إليسون) حين أوحى بأنه التقى مع «قادة المعارضة
وممثلي عوائل المنشقين» ونقل لهم «اهتمامنا القوي بحالات الناشطين
الديمقراطيين العراقيين أنور البني، عارف دليلة، كمال اللبواني، محمود
عيسى، ميشيل كيلو، وعمر عبد الله». الخطأ، الفاضح الفادح، الذي وقع فيه
النصّ الرسمي، لجهة انعدام التمييز بين ناشطين سوريين وآخرين عراقيين،
كان بمثابة الكاشف الأشدّ تأكيداً على ضآلة هذا الجزء المزعوم من زيارة
بيلوسي وصحبها؛ وتفاهة التلميح إلى وضع المعارضة في حسبان الزائرين،
خاصة عند نظام استبداد وفساد وتوريث ومزرعة عائلية وطائفية مثل الذي
جاءت رئيسة مجلس النواب الأمريكي لمصافحته/ معانقته في الواقع.
البيان (المتوفر، حتى الساعة، على موقع بيلوسي الرسمي) انطوى من جانب
آخر على فضيلة الإفصاح عن بعض الأهداف الأخرى الأعمق من زيارة سوق
الحميدية أو المسجد الأموي، وخاصة تلك التي كانت تسترضي صقور الحزبين
الديمقراطي والجمهوري معاً، وأقطاب المحافظين الجدد في إدارة بوش الابن
ومن حولها؛ إلى جانب «لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية» الـAIPAC،
أقوى مجموعات الضغط اليهودية/ الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
في وسع بيلوسي أن تمزج بين مجالسة دكتاتور ومجرم حرب في سوريا، واستفزاز الصين بداعي التعاون والحكم الديمقراطي في تايوان؛ الأمر الذي لا يبدّل في الحالتين، وفي سواهما، جوهر الكيل بشتى مكاييل النفاق والخداع والمخاتلة
الوفد جاء، مثلاً، من أجل: 1) حثّ الأسد «بقوّة على ضبط الحدود السورية
مع العراق ومنع تدفق المقاتلين الأجانب الذين يشكلون تهديداً لقوّات
الولايات المتحدة وللشعب العراقي»؛ و2) إبلاغ الأسد أنّ «السلام مع
إسرائيل جوهري للعلاقة الأمريكية ـ السورية» وإعلامه أنّ أولمرت منفتح
على السلام «حين تتخذ سوريا خطوات لوقف دعم الإرهاب»؛ و3) التشديد على
أنّ «الاختبار» يكمن في مدى «انخراط سوريا في جهد مثمر وواقعي لحلّ
خلافاتها مع دولة إسرائيل والعيش معها بسلام»؛ و4) مطالبة الأسد
«بالمساعدة في تحرير جنود إسرائيليين مفقودين أو مخطوفين» بمن فيهم
جلعاد شاليت، إيهود غولدفاسر، إلداد رغيف، غاي خيفر، زخاري بوميل، تزفي
فلدمان، إيهودا كاتز، ورون عراد.
وهذه المرّة لم يخطئ الوفد في تسمية جنسية الجنود الإسرائيليين
المخطوفين أو المفقودين، على غرار ما فعل مع الناشطين السوريين الذين
فضّل أن يمنحهم الجنسية العراقية، أو «المنشقين» الذين لم تطالب بيلوسي
بإطلاق سراحهم خلال ساعات اجتماعها مع الأسد، أو حتى لدى استقبالها في
مطار دمشق من جانب وليد المعلم وزير خارجية النظام في حينه. صحيح،
بالطبع، أنّ وفوداً من الكونغرس زارت النظام السوري قبل بيلوسي، وكذلك
فعلت وفود بعدها، والأمر تكرر وسوف يتكرر ولا يبدو البتة خارجاً عن
مكاييل المشرّعين الأمريكيين؛ قياساً، من حيث المبدأ، على سلوك إدارات
جمهورية وديمقراطية شتى. غير أنّ زيارة بيلوسي لم تكن إلى سوريا البلد
إلا بالمعنى الجغرافي والسياحي، وكانت بالمعاني الجيو- سياسية
والأخلاقية والرمزية بمثابة انفتاح على نظام الاستبداد والفساد ذاته
الذي لا تغفل بيلوسي عن المجازر الأشنع التي ارتكبها بحقّ السوريين،
الابن الوريث بعد الأب المورِّث.
وإذا ساجل البعض بأنّ نظام آل الأسد ليس، أو لم يكن تاريخياً، صديقاً
للولايات المتحدة على غرار الصداقات الكويتية أو السعودية أو المصرية
مثلاً؛ فهل يجوز للمساجلين الاستطراد بأنّ النظام عدوّ لدود للولايات
المتحدة؟ كلاّ، أجاب على الدوام عدد من دبلوماسيي أمريكا المخضرمين،
ممّن امتلكوا بعض الحصافة في قراءة خرائط الشرق الأوسط، لا سيما طبائع
الحاكم والحكم، والاجتماع والعقيدة، والاستبداد والفساد. حجج هؤلاء لم
تكن في حاجة إلى نقاش حامي الوطيس، فالسجلّ أوضح، كما أنه أغنى
بالوقائع، من أن يحتمل الإنكار: على العكس، ساجل هؤلاء، نظام «الحركة
التصحيحية» أحد أفضل الأنظمة التي حكمت سوريا من حيث خدمة المصالح
العليا الأمريكية؛ منذ «اتفاقية سعسع» 1974، التي أدخلت نظام فصل
القوّات وجعلت الجولان منطقة هدوء قصوى للاحتلال الإسرائيلي، وأمان
مطلق للمستوطنين؛ وصولاً إلى التعاون الأمني الوثيق بين الأجهزة
السورية والأمريكية، في ما تسمّيه واشنطن «الحرب على الإرهاب»؛ من دون
نسيان الانخراط العسكري الرسمي في عداد الجيوش التي شكّلت تحالف «حفر
الباطن» قبيل انطلاق عمليات «درع الصحراء» 1991.
وأمّا الأسد الوريث فإنه، منذ مطلع 2002 وكان في السنة الثانية من
توريثه السلطة، استقبل وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي، وتناول الحديث
مفاعيل 11 أيلول (سبتمبر) التي كانت ساخنة وطازجة، وكذلك طرائق محاربة
الإرهاب. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية قول الأسد إنّ «في إمكان
الولايات المتحدة الاستفادة من تجارب الدول التي حاربت الإرهاب بنجاح،
وخاصة سوريا». صحيح أنه لم يخصّ «تجربة» مجزرة حماة بالذكر، ولكنّ شبح
الواقعة ـ سيما وأنّ ذكراها العشرين كانت على الأبواب يومذاك ـ لم يغبْ
عن الأذهان، إلا عند مَنْ تقصد عن سابق عمد تغييب واحدة من أبشع جرائم
الحرب والعقاب الجماعي والإرهاب. وحقّ للوريث الاستذكار، ببهجة خاصة
وتفاخر مفرط، أنّ الوفد الأمريكي الذي حضر من واشنطن لتعزيته عند وفاة
أبيه ترأسته مادلين ألبرايت، أوّل امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ
الولايات المتحدة.
بيلوسي أيضاً، إذْ الشيء بالشيء يُذكر، كانت أوّل امرأة تحمل مطرقة
رئاسة مجلس النوّاب، مرّتين: 2007 إلى 2011، و2019 حتى الساعة. وكان
صعودها إلى السدّة الأعلى في قيادة الحزب الديمقراطي، والموقع الثالث
في هرم السلطة الأمريكية، بمثابة ذروة فريدة في استقرار مزيج عجيب
ليبرالي/ كاثوليكي في قلب النخب الأعلى للحزب الديمقراطي. في وسع
بيلوسي، إذن، أن تمزج بين مجالسة دكتاتور ومجرم حرب في سوريا، واستفزاز
الصين بداعي التعاون والحكم الديمقراطي في تايوان؛ الأمر الذي لا يبدّل
في الحالتين، وفي سواهما، جوهر الكيل بشتى مكاييل النفاق والكذب
والخداع والمخاتلة.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
الاعتذار والتعامي:
الفاتيكان بين كندا وسوريا
صبحي حديدي
في سنة 1883 كان سير جون ماكدونالد، أوّل رئيس وزراء لحكومة كندا التي
ولدت سنة 1867، قد خاطب مجلس العموم هكذا: «حين تكون المدرسة في منطقة
التحفظ يعيش الطفل مع ذويه، وهم همج؛ وهو محاط بالهمج، ورغم أنه قد
يتعلم القراءة والكتابة فإن عاداته وتلقينه ونمط تفكيره هندية. إنه
ببساطة همجي يستطيع القراءة والكتابة. لقد آليت على نفسي بقوّة، بوصفي
رئيس الإدارة، أن أسحب الأطفال الهنود بعيداً قدر الإمكان عن تأثير
ذويهم، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك سوف تكون وضعهم في مدارس تدريب
صناعية مركزية حيث يتوجب أن يتلقوا عادات وأنماط تفكير الرجال البيض».
كان ماكدونالد وراء التشريع المعروف باسم «القانون الهندي» الذي أقرّه
البرلمان الكندي في سنة 1876 وأسفرت بعض تعديلاته اللاحقة عن إقامة
مدارس داخلية سيق إليها نحو 150 ألف طفل انتُزعوا قسراً من عائلاتهم
وأسرهم المنتمية إلى الأقوام الأصلية من سكان البلاد، والتي أطلقت
عليها الرطانة الحكومية الكندية تسمية «الهنود». كان الهدف، كما أوضحه
ماكدونالد أمام مجلس العموم، هو سلخ هؤلاء الأطفال عن محيطهم «الهمجي»
وتربيتهم على نحو يجعلهم ينفصلون عن ثقافتهم «الهمجية» ويتشربون ثقافة
الإنسان الأبيض. وفي أكثر من 139 مدرسة تعيّن على الأطفال بين 7 إلى 16
سنة أن يتعلموا مهناً صناعية مثل الحدادة والزراعة والتنظيف بالنسبة
إلى الفتيان، والخياطة والتدبير المنزلي والطبخ بالنسبة إلى الفتيات؛
كما تحتم، استطراداً، أن يتعرضوا لانتهاكات شتى وضروب العقاب والتعذيب
والاستغلال الجنسي.
وفي سنة 2015 أنهت «هيئة الحقيقة والمصالحة» الكندية تقريرها النهائي
عن حقبة المدارس الداخلية تلك، وجاء في المقدمة: طوال ما يزيد على قرن،
كان الهدف المركزي لسياسة كندا حول الأقوام الأصلية قد تمثّل في تصفية
حكومات هذه الأقوام، وفي إهمال حقوقهم، وإبطال الاتفاقيات، واعتماد
سيرورة استيعاب أدّت إلى إعدام وجود الأقوام الأصلية ككيانات قانونية
واجتماعية وثقافية ودينية وعرقية في كندا. وكانت إقامة وتشغيل المدارس
الداخلية عنصراً مركزياً في هذه السياسة، التي يمكن أن توصف على نحو
أفضل بـ«الإبادة الثقافية». ويضيف التقرير: «الإبادة الفيزيائية هي
القتل الجماعي لأعضاء جماعة مستهدَفة، والإبادة البيولوجية هي تدمير
قدرة التكاثر لدى الجماعة، وأمّا الإبادة الثقافية فإنها تدمير تلك
البنى والممارسات التي تتيح للجماعة أن تواصل البقاء كجماعة.
والدول التي تنخرط في الإبادة الثقافية تستهدف تدمير المؤسسات السياسية
والاجتماعية للجماعة المستهدَفة. الأرض تُصادر، والسكان يُجبرون على
الانتقال وتقييد الحركة، واللغة تُحظر، ويُضطهد القادة الروحيون، وتمنع
الشعائر الروحية، وتُصادر الموادّ ذات القيمة الروحية. وما يتسم بمغزى
أهمّ في هذا أنّ الأُسَر يجري تفكيكها لمنع تناقل القيم الثقافية
والهوية من جيل إلى جيل».
ولأنّ الحكومة الكندية أوكلت إلى الكنائس الكاثوليكية إدارة تلك
المدارس الداخلية والإشراف عليها، ثمّ لأنّ الحكومة الكندية اعتذرت
رسمياً عن تلك السياسة في سنة 2008 ودفعت المليارات على سبيل التعويض
للضحايا، وأخيراً لأنّ مصادفة رهيبة شاءت أن تنكشف في سنة 2015 مقبرة
جماعية في منطقة بريتيش كولومبيا احتوت على 1000 مقبرة… فقد تقدّم
أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في كندا باعتذار رسمي عن أدوار كنائسهم في
ذلك النظام الشائن، ثمّ أبدى البابا فرنسيس أسفه في نيسان (أبريل)
الماضي لدى استقباله في الفاتيكان وفداً من الأقوام الأصلية، وها هو
اليوم يطلب الصفح صراحة خلال زيارته الحالية إلى كندا، بصدد «الطرق
التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة والجماعات الرهبانية، وأيضاً
عبر ما أظهروه من اللامبالاة، في تلك المشاريع المدمّرة للثقافات وفي
الاستيعاب القسري، والذي بلغ ذروته في نظام المدارس الداخلية
الإجبارية».
حين أعلن البابا فرنسيس أنّ قلبه «مجروح بعمق بسبب ما يحدث في سوريا، ومهموم من التطورات المأساوية الماثلة أمامنا» سارع أساقفة دمشق إلى إصدار بيان يعيد إنتاج خطاب النظام السوري، ذاته، حول نظرية المؤامرة الخارجية؛ ليس على سوريا وحدها هذه المرّة، بل على المنطقة بأسرها
وأن يصل الفاتيكان متأخراً إلى طور الاعتذار خير من ألا يصل أبداً؛
الأمر الذي لا يمنحه فضيلة الشكّ دائماً، مسبقاً، أو على طول الخطّ.
المثال على هذا موقف الفاتيكان من جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها
النظام السوري، خاصة تلك التي تُصنّف بسهولة في خانة الفظائع والمجازر
وأنساق العقاب الجماعي والإبادة. على سبيل المثال، في صيف 2013 حين
افتُضحت أخبار المجازر الكيميائية في الغوطتَين الشرقية والغربية،
اكتفى الفاتيكان بالدعوة إلى «الحذر في التعامل مع الادعاءات والمزاعم»
حول مسؤولية جيش النظام عن استخدام أسلحة كيميائية هناك؛ كما حضّ على
«عدم إطلاق أحكام إلا بعد الحصول على دليل واضح» حسب الأسقف سيلفانو
توماسي، المراقب الدائم للفاتيكان لدى مقرّ الأمم المتحدة في جنيف.
أيضاً، في مقابلة مع إذاعة الفاتيكان الرسمية، اعتبر توماسي أنّ
«السؤال الحقيقي المطروح بهذا الصدد هو من المستفيد الحقيقي من هذه
الجريمة اللاإنسانية». وكي لا يظلّ المشهد خالياً من هوية المذنب، أشار
الأسقف إلى أنّ «التسرّع في إصدار الأحكام خلال أزمنة الحرب والنزاع،
خاصة من جانب وسائل الإعلام، لا يقود دائماً إلى الحقيقة، ولا يجلب
السلام!»
من جانبه كان الأب أدولفو نيكولاس، الرئيس العام للرهبانية اليسوعية،
قد أدلى بدلوه أيضاً، ضمن توجّه مماثل لا يتعمد تبرئة النظام السوري من
المجازر الكيميائية، فحسب؛ بل يلقي باللائمة على الآخرين، في صفوف
المعارضة السورية أو خارج البلد. لقد انتقد الضربات التي تردّد أنّ
الولايات المتحدة وفرنسا على وشك توجيهها إلى النظام السوري، وهذا حقّه
بالطبع، وثمة كثيرون يوافقونه الرأي من منطلق التعاطف مع الشعب السوري،
ضحية كلّ تدخل أجنبي، وليس بسبب أيّ تعاطف مع النظام. غير أنّ نيكولاس
اعتبر أنّ الضربات هذه ـ وليس المجازر الكيميائية، البتة! ـ هي التي
تدفع البشرية إلى «ردّة نحو الهجمية»؛ فتخسر فرنسا موقعها كـ»مرشد
حقيقي للفكر والذكاء، له إسهام كبير في الحضارة والثقافة» وتفقد
الولايات المتحدة ما كان الأب اليسوعي يكنه لها من إعجاب بالغ!
والحال أنّ ذلك المشهد الفاتيكاني ـ البائس سياسياً والمتعامي أخلاقياً
عن رؤية الحقائق الدامغة، والمرتاح إلى مساواة الضحية بجلاّدها… ـ لم
يكن جديداً على مواقف الصرح البابوي من الملفّ السوري، ولا يلوح أنه
سيكون خاتمة التعامي. وثمة مقدار فاضح من التشويه، فضلاً عن التهويل،
طبع تغطيات وكالة أنباء الفاتيكان للوقائع السورية منذ انطلاق
الانتفاضة الشعبية؛ يشدد، بالطبع، على أوضاع مسيحيي سوريا، ويكيل شتى
التهم إلى المعارضة عموماً، والفصائل الإسلامية بصفة خاصة؛ بحقّ
نادراً، ودون وجه حقّ غالباً. وثمة، في هذا المضمار، سوابق كثيرة سارت
على المنوال ذاته، واتضح أنها عارية عن الصحة تماماً، في المقام
الأوّل؛ كما أنها، في المقام الثاني، تكشف تلك المنهجية القصدية التي
تتوخى التضخيم، وتتلقف التقارير المغالية، أو الكاذبة عن سابق قصد،
وتتبناها كحقائق مسلّم بصدقيتها.
يومذاك، حين أعلن البابا فرنسيس أنّ قلبه «مجروح بعمق بسبب ما يحدث في
سوريا، ومهموم من التطورات المأساوية الماثلة أمامنا» سارع أساقفة دمشق
إلى إصدار بيان يعيد إنتاج خطاب النظام السوري، ذاته، حول نظرية
المؤامرة الخارجية؛ ليس على سوريا وحدها هذه المرّة، بل على المنطقة
بأسرها، فقال البيان إنّ دعوة البابا «تأتي فى وقت تتعرض فيه سوريا إلى
حرب من قبل دول وأنظمة جلّ همها القضاء على سوريا وتاريخها ومستقبلها،
إضافة إلى خلق حالة من الفوضى والرعب في جميع دول المنطقة»!
كأنّ البابا في واد، يعتذر بقلب حزين؛ وكثير من أساقفته في واد آخر،
يتغافلون ويتعامون.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
قمّة طهران: وهن
الأضاليل وسطوة المساومات
صبحي حديدي
بين طرائف القمة الثلاثية الإيرانية/ الروسية/ التركية طراز كان
معلَناً خلال الخطب التي ألقاها إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين ورجب
طيب أردوغان؛ بصدد الملفّ السوري إجمالاً، ثمّ خصوصاً حول التواجد
العسكري لكلّ من إيران وروسيا وتركيا على الأراضي السورية. لا أحد من
الرؤساء الثلاثة ضمّ قواته العسكرية إلى صنف «الوجود الأجنبي»، معتبراً
من جهة أولى أنه إنما يستجيب لطلب شرعي من النظام السوري؛ وغامزاً،
تالياً وضمنياً، من قناة الآخرين الذين لا يتمتعون بتلك السمة الذهبية
الخاصة بـ«شرعية» التواجد.
لا أحد كذلك ألمح إلى أنّ الجيوش الإيرانية والروسية والتركية المرابطة
هنا وهناك في سوريا هي، في أوّل المطاف ونهايته، قوى احتلال صريح
مباشر، لا شرعية على الإطلاق يمكن أن تغطيه أو تجمّل قبائحه ومصائبه.
ولا أحد من الفرسان الثلاثة نطق بما يمكن أن يفضي إلى حقيقة ساطعة
بسيطة، تفيد بأنّ فوارق نسبية فقط تميّز الاحتلالات الإيرانية والروسية
والتركية عن الاحتلالَين الأمريكي (في المثلث الحدودي مع الأردن
والعراق، وفي منطقة رميلان النفطية، وقاعدة عين العرب/ كوباني…)،
والإسرائيلي على امتداد الجولان المحتل.
طراز آخر من الطرافة، السوداء هذه المرّة وغير المعلَنة رغم أنها جلية،
هي مقادير التوتر والشحن والتضاد والتجاذب بين الاحتلالات الثلاثة، على
أصعدة لا تبدأ من اللوجستيات العسكرية الأبسط ولا تنتهي عند أجندات
المصالح الجيو – سياسية والأمنية والاقتصادية الأعقد. وبهذا فإنّ أيّ
مستوى متقدّم من تفاهم طهران وموسكو على اعتماد الريال الإيراني
والروبل الروسي في التعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين، على
حساب الدولار بالطبع؛ لن ينعكس في حال مماثلة من التفاهم حول انتشار
القوات الروسية في موازاة انتشار القوات الإيرانية، في هذه أو تلك من
بقاع سوريا.
تركيا من جانبها لا تكره إقناع روسيا بأن تغضّ النظر عن عمليتها
الوشيكة في الشمال السوري، ولكنّ صمت الكرملين لا يبدّل الكثير في
برامج قاعدة حميميم الروسية وجداول قصف إدلب والمناوشات المتفرقة بين
الوحدات الروسية المتقاطعة مع مساحات تواجد الاحتلال التركي وفصائل
المعارضة السورية المسلحة الموالية لأنقرة؛ ولا يغيّر الكثير، أيضاً،
في قواعد الاشتباك المستقرة مع ميليشيات موالية لطهران أو تابعة لها
مباشرة. اللافت أكثر، لكنه ليس الأشدّ غرابة، أن تواصل القاذفات
الإسرائيلية طلعات القصف في العمق السوري، إلى درجة استهداف المفارز
الإيرانية المرتبطة بالفرقة الرابعة في قلب دمشق، فلا يُحدث ذلك كلّه
أي أثر في قمة طهران الثلاثية.
فإذا وضع المرء جانباً أضاليل بحث الملفّ السوري في قمة طهران
الثلاثية، بعد أن يكون المرء ذاته قد أخذ بعين الاعتبار الحصيلة
العجفاء الهزيلة لمسار أستانا، منذ إطلاقه مطلع 2017 وحتى الساعة؛ فإنّ
الهموم الثنائية أو الثلاثية، منفردة أو مجتمعة، التي جعلت اللقاء
ممكناً في الأصل، تبدو أقرب إلى تحصيل حاصل يداني درجة الصفر من حيث
البناء على ما سبق القمة، وما سيليها: في الاعتبارات الجيو – سياسية
والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية كافة، كما يجوز القول من
دون كبير تحفظ.
كلا الدولتين، إيران وروسيا، واقعة تحت عقوبات أمريكية وأوروبية وأممية
شديدة الوطأة، ولا منفذ نجاة منها على النحو الجذري الذي يصنع فارقاً
عملياً؛ بل تسير الحال من سيء إلى أسوأ مع انصراف الصين والهند عن
النفط الإيراني إلى الخام الروسي الأرخص، ومع تعطّل الدور الروسي في
مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني. تركيا تستثمر الوقت
الضائع، حتى من دون الاضطرار إلى اللعب فيه، إذْ لم تكن بحاجة إلى قمة
طهران كي تنجز نصراً دبلوماسياً مشهوداً بصدد الإفراج عن الحبوب
والأسمدة الأوكرانية.
وَهَنُ الأضاليل اجتمع، إذن، مع سطوة المساومات؛ فكان طبيعياً ألا
تنتهي القمّة إلى ما يتجاوز المزيج الفاسد بين هذه وتلك.
أطفال سوريا: حين تساوي الأمم
المتحدة بين الضحية والجلاد
صبحي حديدي
السيدة فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة
لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، لا تفتقر إلى البلاغة والشحنة العاطفية
العالية ودفق الحزن والأسى، وما إلى هذه وسواها من مستويات إبداء
الألم؛ كلما توجّب أن تعرض الخلاصات الكبرى لتقرير المنظمة الدولية
السنوي حول الأطفال والنزاع المسلّح(CAAC،
وصدرت مؤخراً أحدث طبعاته التي تغطي العام المنصرم 2021. ومع ذلك فإنها
لا تتردد في الجزم: «لا توجد كلمات قوية بما يكفي لوصف الظروف المروّعة
التي عانى منها الأطفال في النزاعات المسلحة»؛ خاصة وأنّ «أولئك الذين
نجوا سوف يتأثرون مدى الحياة بندوب جسدية وعاطفية عميقة» و«عندما يُفقد
السلام، يكون الأطفال أوّل من يدفع ثمن هذه الخسارة المأساوية».
حصّة الشرق الأوسط من الانتهاكات ضدّ الأطفال وفيرة، بالطبع، وهي تشمل
العراق ودولة الاحتلال الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية ولبنان وليبيا
والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن؛ والأخطار تتضمن تصعيد
النزاع المسلح، والانقلابات العسكرية، والاستيلاء على السلطة بالقوّة،
وما يسمّيه التقرير «الصراعات المطولة والجديدة» إلى جانب انتهاكات
القانون الدولي الكلاسيكية والصراعات القبلية والإثنية. والأرقام تشير
إلى قرابة 24,000 انتهاك جسيم ضدّ الأطفال تمّ التحقق منها، بمعدل 65
انتهاكاً يومياً، وجرى احتجاز أكثر من 2,800 طفل على خلفية ارتباطهم
الفعلي أو المزعوم بأطراف النزاع، وخضعوا بالتالي إلى التعذيب الجسدي
والعنف الجنسي وأنماط أخرى من الانتهاكات.
كذلك يسجّل التقرير أنّ نسبة 15٪ من الانتهاكات لم تشهد التعرّف على
الجناة، الأمر الذي يجعل المحاسبة اللاحقة صعبة أو حتى مستحيلة؛ وثمة
نحو 5,242 فتاة تعرّضن لانتهاكات جسيمة في 21 منطقة؛ وقُتل، أو تعرّض
لتشوّهات مختلفة، قرابة 8,070 طفلاً جراء الألغام والعبوات الناسفة؛
وخضع 6,310 أطفال لتجنيد إجباري، كما تمّ التحقق من منع وصول المساعدات
إلى الأطفال خلال 3,945 حادثة. الأرقام الأعلى للانتهاكات رُصدت في
أفغانستان ودولة الاحتلال الإسرائيلي والصومال وسوريا واليمن، وانطوت
على ارتفاع بمعدّل 20٪ في حالات الاختطاف، ونسبة الزيادة ذاتها بخصوص
الاعتداءات الجنسية، كما تضاعفت الاعتداءات على المدارس والمشافي أو
إغلاقها لصالح الانتشار العسكري…
منافع هذه التقارير السنوية لا تطمس، في الآن ذاته، معضلة مركزية باتت
سمة تكوينية لصيقة بها؛ تبدو أخلاقية أوّلاً ومن حيث المبدأ، ولكنها
تظلّ أيضاً سياسية بامتياز: أنها لا تفلح، إلا نادراً، في التمييز بين
الضحية والجلاد عند استعراض مناطق نزاع لا تقتضي التفريق الصريح الواضح
والضروري فحسب، بل تتطلب أيضاً ذلك المستوى المبدئي والابتدائي من
الاستنكار والشجب والإدانة. أكثر من هذا، تواصل الأمم المتحدة اعتماد
منهج مزدوج في التعامل مع قوانين الأنظمة الحاكمة وإجراءاتها المختلفة
بخصوص الانتهاكات ضدّ الأطفال: إمّا اعتبارها ممارسة سيادية لا يصحّ
الطعن فيها أو المساءلة حولها، أو منحها نطاقاً عريضاً مذهلاً من فضيلة
الشكّ وبالتالي الانخراط في طرائق تنفيذها وما يعنيه ذلك من تواطؤ
(مباشر وغير مباشر، على حدّ سواء) في شرعنة الانتهاكات ذاتها التي
تستعرضها التقارير السنوية.
تقرير الأمم المتحدة لا يكتفي بغضّ النظر عن انتهاكات جسيمة متفق عليها كونياً، وتلك طامّة كبرى؛ بل يعمد كذلك إلى ما يشبه تلطيفها أو تجميلها، حين يضع الضحية والجلاد على مسافة واحدة من الحساب والمساءلة، وتلك طامّة عظمى
ولعلّ الانتهاكات بحقّ أطفال سوريا هي النموذج الأوضح على، والأشدّ
فضحاً لتلك، الازدواجية الفاسدة في تطبيق المعيار ونقيضه؛ إذْ، من جهة
أولى وبلسان الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً، يجري «الترحيب
بالحوار» بين النظام السوري والمنظمة الدولية حول الإجراءات «الكفيلة
بمنع الانتهاكات الجسيمة ضدّ الأطفال» والترحيب أكثر بـ«إعادة تفعيل
اللجنة الوزارية المختلطة، وتنظيم ورشات لحماية الأطفال» تحت رعاية
النظام؛ والإشادة بالقانون 21 للعام 2021 حول الحقوق وإجراءات الحماية
الخاصة بالأطفال، والتزام النظام بدعم «الاستجابة الإنسانية للأمم
المتحدة وشركائها».
وأمّا من جهة ثانية فإنّ أرقام الأمم المتحدة ذاتها تقول إنّ البلد شهد
2,271 حالة انتهاك جسيم ضدّ الأطفال في سنة 2021، بينهم 235 فتاة و143
غير محدد جنسهم؛ بالإضافة إلى 74 انتهاكاً جسيماً، بينهم 14 فتاة، في
سنة سابقة ولكن لم يتمّ التحقق منها فعلياً إلا في سنة 2021. ولا يجد
التقرير حرجاً، غنيّ عن القول، في تحديد هوية الجناة هنا: جيش النظام
بمختلف صنوفه، فروع الاستخبارات المختلفة وخاصة مخابرات القوى الجوية
والمخابرات العامة، «قوات الدفاع الوطني» وسواها من ميليشيات شبابية أو
مناطقية أو طائفية. وفي الإجمال، تحقق التقرير من مقتل 424 طفلاً،
وإعاقة 474 آخرين، على أيدي قوات النظام وأجهزته الاستخبارية
وميليشياته الموالية.
إلى جانب هذا وسواه من عناصر تفرض التمييز بين الضحية والجلاد، ثمة تلك
الركائز التي يعتمدها علم الاجتماع البسيط في تعريف «الأمن» وتُدْرجها
منظمات الأمم المتحدة بدورها؛ وآثارها بعيدة المدى ليست أقلّ أهمية من
عواقب الانتهاكات الجسيمة المباشرة: أمن غذائي، أمن اقتصادي، أمن صحي،
أمن بيئي، أمن مجتمعي، أمن تعليمي. وبصدد الأمن الأخير تسجّل اليونسيف،
منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أنّ أكثر من ثلاثة ملايين طفل سوري، داخل
سوريا وخارجها، محرومون فعلياً من التعليم سواء بسبب تدمير المدارس في
الداخل (خُمْس أعدادها، أو نحو 4,000 مدرسة) أو استخدام المئات منها
كمقارّ لقوّات النظام وميليشياته، أو تحويلها إلى ملاجئ للمهجرين
والمشردين عن بيوتهم؛ أو، في المقابل، بسبب غياب المدارس فعلياً، أو
توفيرها بسويّة متدنية في المخيمات. المشكلة الأخرى الموازية هي اختلاف
المناهج الدراسية تبعاً للجهة المسيطرة على المنطقة، بين تلك التي
يفرضها النظام مقابل أخرى عدّلتها المعارضة، وما ينجم عن هذه
الاختلاطات من تبعات سياسية وثقافية وتربوية وسلوكية.
وقد لا يلوح، للوهلة الأولى، أنّ اختلال الأمن المجتمعي، أو حتى فقدانه
بدرجات عالية، يمكن أن يشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق أطفال سوريا؛ الأمر
الذي سبق لمجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة، دون سواه!) أن
توقف عنده؛ من زاوية أولى هي اضطرار الأطفال إلى تحمّل عواقب
الانقسامات الطائفية على مستويات ديمغرافية متعددة، تبدأ من القرية
الصغيرة ولا تنتهي عند أحياء المدن الكبرى؛ ومن زاوية ثانية هي كون
الأطفال أسهل ضحايا السلوكيات الطائفية لكثير من قوى النظام
وميليشياته. هذا بالإضافة إلى تدفّق ميليشيات أجنبية مذهبية الطابع،
وما تفرضه على المشهد الطفولي من انحيازات قسرية تبدأ مضطربة ومشوّشة،
لكنها تظلّ بالغة الأذى في تشويه التوازن النفسي والعاطفي للطفل، وفي
خلخلة انتمائه المجتمعي.
والأمن الصحي لا يقتصر على انتشار الامراض والأوبئة، وفقدان الأدوية،
وسوء الخدمات الصحية والمرافق العامة، سواء في داخل سوريا أو في
المخيمات خارجها؛ بل يرتبط أيضاً، ولعله يتجلى عند الأطفال أكثر،
بالصحة النفسية والعقلية أو اعتلالها على وجه التحديد، خاصة في مضمار
اضطرابات توتر ما بعد الصدمة، أو الـPTSD،
كما تشير دراسات كثيرة عكفت على تحليل أوضاع أطفال المهجّرين في
المخيمات أساساً. والأخطار هنا لا تقتصر على هذه الشريحة وحدها، بل
ابتداءً منها إلى ما سوف يتشكل عنها من أجيال لاحقة تشمل الطفولة
واليفاعة ومطالع الشباب؛ وهنا لن تكون الصدمة نفسية أو عقلية أو عاطفية
فقط، بل سلوكية أيضاً تمتدّ إلى العنف والاختلال والإدمان والاغتراب
المَرَضي.
تقرير الأمم المتحدة لا يكتفي بإغفال انتهاكات جسيمة متفق عليها
كونياً، وتلك طامّة كبرى؛ بل يعمد كذلك إلى ما يشبه تلطيفها أو
تجميلها، حين يضع الضحية والجلاد على مسافة واحدة من الحساب والمساءلة،
وتلك طامّة عظمى يصعب أن تُغتفر عموماً، أو أن تُفهم خصوصاً من منظمة
تزعم حماية الأطفال من شرور النزاعات المسلحة.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
عودة جاك أتالي:
عماء الديمقراطيات في 6 مراحل
صبحي حديدي
اختار الكاتب والاقتصادي الفرنسي جاك أتالي لوحة الرسام الإيطالي جوليو
رومانو «سقوط العمالقة» 1534، كي ترافق مقالته «نحو العماء، في 6
مراحل» التي نشرها على مدونته الشخصية مطلع تموز (يوليو) الجاري؛
ويفتتحها بالقول: «المرء سوف يكون آخر العميان إذا لم يبصر أنّ بنية
المؤسسات الديمقراطية ذاتها تتكسّر في العديد من البلدان، خاصة الغنية
منها». مثاله الأوّل هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي، بعد
أن حشد في أعلى المؤسسات القضائية قضاة مصممين على تقويض المكاسب
الديمقراطية الرئيسية خلال الـ60 سنة المنصرمة؛ حاول القيام بانقلاب
للبقاء في السلطة، قبل أن يصبح الشخصية المفضلة في الانتخابات الرئاسية
المقبلة، و«ضمن مناخ من مواجهة ضارية شرسة».
مثاله الثاني هو ولاية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التي
«بدأت في هيئة مهرجان كوميدي، وتنتهي في هيئة مهزلة محزنة، سوف تخرج
الديمقراطية منها أشدّ ضعفاً، في غمرة تصفيق صحافة التابلويد وغضب
ضحايا البريكست». مثال ثالث من ألمانيا، حيث يجهد تحالف منهك للحفاظ
على حياة حكومة تتوالى عليها الهجمات من «دعاة التحالف مع روسيا» ومن
أولئك المطالبين بـ«خضوع أكثر للولايات المتحدة». حتى في «هولندا
الحكيمة» فإنّ المعالجة المرتبكة للإصلاح الزراعي الهادف إلى التخفيف
من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري دفعت بجميع المزارعين إلى شوارع
الاحتجاج، والإضرابات المتعاقبة. وأمّا في فرنسا فإنّ حكومة الأغلبية
النسبية في الجمعية الوطنية، وما تتعرض له من هجوم اليسار واليمين على
حدّ سواء، ليست قادرة على وضع خطة واقعية للحكم، وسط نُذُر الإضرابات
ومظاهر الغضب حتى قبل انتظار انتهاء عطلة الصيف.
وقبل استعراض، وجيز بالطبع، للمراحل الستّ التي يشخصها أتالي على طريق
العماء، أي الفوضى في توصيف آخر؛ ثمة ما يجيز التذكير هنا بشخص الرجل،
وتاريخه، وموقعه. فهو، بادئ ذي بدء، ليس بالمراقب العادي لخرائط
التأزّم الاقتصادية والجيو- سياسية التي يناقشها، إذْ عمل مستشاراً
وكاتم أسرار في حاشية الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتيران، فوقف على
الكثير من خفايا السياسة الدولية خصوصاً في طور انهيار المعسكر
الاشتراكي وحرب الخليج الثانية؛ فضلاً عن الأروقة السرّية لذلك التوافق
الوطيد بين الاشتراكي ميتيران، واليميني الألماني هلموت كول. وأتالي،
ثانياً، اقتصادي بارز، شغل منصب المدير العام لأوّل بنك أوروبي موحّد،
وُضع تحت تصرّف وإدارة الاتحاد الأوروبي. وهو، ثالثاً، يهودي الديانة
يراقب العالم بذلك النوع الحصيف، والمرتاب والمتنبّه، إلى نُذُر
الكارثة؛ كلما ادلهمت السماء أو ثار العصف.
وإذْ يرجّح أنّ دكتاتوريات مثل روسيا والصين، حسب توصيفه، ترى أنّ
الزمن يعمل لصالحها، وقد لا تكون مخطئة بالنظر إلى الوقائع الكثيرة
الراهنة؛ فإنه يتوصل إلى الخلاصة التالية: «إذا تابعنا المسير هكذا،
فإنّ التاريخ يكون قد كُتب في كثير أو قليل: الديمقراطيات تسير حثيثاً
نحو العماء، على ستّ مراحل»؛ هي التالية:
ــ فقدان الأمل، إذْ لم يعد الناس يفهمون كيف أنهم، وقد وُعدوا بالرفاه
والنمو والتقدم الاجتماعي، يواجهون اليوم الندرة والكوارث الطبيعية
وانهيار الرافعة الاجتماعية.
ــ التظاهرات، حيث يتصدرها أولئك الأكثر تضرراً، وقد تبدأ من الفلاحين،
ثمّ المطرودين من الحداثة، وخاصة في المناطق المهملة.
يتناسى أتالي أنّ الكثير من جوهر التأزم/ العماء يخصّ الاجتماع الاقتصادي الفعلي، وحياة البشر اليومية، ومعيش الفئات الفقيرة والوسطى، ومفاعيل البطالة، وانكماش سوق العمل، والغلاء، وعشرات المشكلات الأخرى، الصغرى والكبرى
ــ خسران الشرعية، بسبب عجز النخب عن تنظيم الاقتصاد والمصالحة مع
الأهداف المتناقضة، مما يُفقد الناس الثقة في الساسة والقادة.
ــ سوء التنظيم، ففي هذه الظروف تتعطل الخدمات العامة، ولا تُحترم
قواعد الأمان، وتُهجر المشافي والمدارس وتتفوق المشكلات على طاقة قوى
الشرطة.
ــ الثورة، إذْ حين تشعر السلطة الديمقراطية أنها عرضة للهجوم على هذا
النحو، فإنها تتوتر وتحتقن وترتكب الأخطاء ولا يطول الوقت حتى تفقد
السيطرة على الوضع؛ وهنا يحين أوان الثورات، التي ينجح بعضها ويُسفر عن
سقوط أنظمة.
ــ الثورة المضادة، ويعرّف أتالي طبيعتها ابتداء من قوى البرجوازية
التي تحالفت ذات يوم مع الشعب للتخلص من النخب التي كانت قد خلقتها
بنفسها.
ليس هنا المقام المناسب لمناقشة أفكار أتالي، خاصة نزوعه إلى طرائق في
التعميم تمزج، عن سابق قصد، بين الديمقراطية كصيغة في الحكم عموماً،
وبين الأنظمة القائمة في أمريكا أو بريطانيا أو ألمانيا أو هولندا أو
فرنسا حيث يسود هذا التطبيق أو ذاك من مفهوم الديمقراطية. وقد يكون عرض
أفكاره أكثر جدوى من مساجلته فيها، لا لأيّ سبب يسبق حقيقة أنه يعيد
إنتاجها من دون إقرار بأنّ الحياة أثبتت مقادير عالية من بطلان طبعاتها
القديمة؛ على غرار أفكار ساقها أتالي قبل 12 سنة، تحت عنوان/ سؤال لا
يقلّ انفلاتاً نحو الدراما: هل نسير، جميعاً، نحو الخراب؟ هكذا تساءل،
قبل أن يُصدر كتاباً حمل روحية التطيّر ذاتها في العنوان: «هل سينهار
كلّ شيء خلال عشر سنوات؟». يومها بلغت طبعة الكتاب الأولى 70 ألف نسخة،
ليس لأسباب تخصّ علوّ كعب المؤلف في الاقتصاد السياسي؛ بل لأنّ توقيت
نشر الكتاب كان حاسماً تماماً، لجهة التناغم مع حال الرعب العامة،
الجَمْعية على نحو أو آخر، إزاء مآزق الاقتصادات الغربية، في المصارف
والبورصات، كما في خزائن الدول وديونها العامة.
قبلها بسنوات قليلة، كان أتالي قد اعتبر أنّ السمة الجوهرية السائدة
اليوم/ حينذاك هي «انهيار»
Crash
الحضارة الغربية، وليس «صراع»
Clash
هذه الحضارة مع سواها؛ في إشارة نقدية واضحة إلى نظرية صمويل هنتنغتون،
حول صدام الحضارات. أكثر من هذا، ذهب الرجل إلى حدّ التكهن بأنّ
الحضارة الغربية موشكة على الانهيار، وكتب بالحرف: «بالرغم من القناعة
السائدة القائلة بأنّ اقتصاد السوق اتحد مع الديمقراطية لتشكيل آلة
جبارة تساند وتُطوّر التقدّم الإنساني، فإنّ هاتين القيمتين عاجزتان عن
ضمان بقاء أية حضارة إنسانية. إنهما حافلتان بالتناقضات ونقاط الضعف.
وإذا لم يسارع الغرب، ثمّ الولايات المتحدة بوصفها قائدة الغرب
المعيّنة بقرار ذاتي، إلى الاعتراف بنقائص اقتصاد السوق والديمقراطية
وأزماتهما، فإنّ الحضارة الغربية سوف تأخذ في الانحلال التدريجي، ولسوف
تدمّر نفسها بنفسها».
أيّ تطيّر هو الأشدّ وطأة، انحلال الحضارة الغربية بالأمس، أم المراحل
الستّ للعماء الديمقراطي اليوم؟ الأحرى، بالطبع، إعادة تركيب السؤال
بحيث يتفرّع إلى أسئلة من هذا الطراز: ما الفارق، جوهرياً وفي ما يخصّ
نظام التقاسم الرأسمالي الراهن، بين أزمات العام 2010 المالية
والمصرفية؛ وبين أزمات العام 2022، البادية لتوّها والموشكة على
المجيء، جراء الاجتياح الروسي في أوكرانيا وعواصف الطاقة والغذاء وهبوط
اليورو بدل نظيره الروبل الروسي؟ وفي هذا الملفّ تحديداً، أي تعادل
اليورو مع الدولار مؤخراً، لماذا يسكت أتالي عن ذلك القانون المعروف
باسم فريتس بولكشتاين، المفوّض الأوروبي السابق والليبرالي الهولندي
الشهير، الذي بشّر المجتمعات الأوروبية بأنّ جميع مؤسسات القطاع العام،
في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سوف تُطرح على السوق
كبضاعة، أي سوف تدخل بالضبط في ذلك النوع من المنافسة غير المتكافئة مع
الاحتكارات العملاقة؟ وهل، عن سابق قصد هنا أيضاً، يتناسى أتالي أنّ
الكثير من جوهر التأزم/ العماء يخصّ الاجتماع الاقتصادي الفعلي، وحياة
البشر اليومية، ومعيش الفئات الفقيرة والوسطى، ومفاعيل البطالة،
وانكماش سوق العمل، والغلاء، وتخبّط أنماط الضمان الاجتماعي، وعشرات
المشكلات الأخرى، الصغرى والكبرى؟
وفي خلاصة القول، لماذا يتوجب أن تكون عودة أتالي الأحدث، هذه، مختلفة
عن مناسبات سابقة شهدت الإعادة والاستعادة والاستئناف، أكثر مما شهدت
الإفادة؟
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
البحر الأسود: كم من
الدماء قبل احمرار المياه؟
صبحي حديدي
تحت عنوان «مرحباً بكم في حقبة حرب البحر الأسود» نشرت مجلة «فورين
بوليسي» مقالة لافتة وقّعها البريطاني ماكسمليان هيس، الباحث المختصّ
بشؤون آسيا الوسطى في «معهد أبحاث السياسة الخارجية» الأمريكي، ينبّه
فيها إلى أنّ الغزو الروسي في أوكرانيا يتوجب أن يُقرأ، إلى جانب
أبعاده الجيو-سياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية المعروفة، في إطار
المناسبة الأحدث حول أهمية البحر الأسود، أوّلاً؛ والمخاطر العديدة
التي كان، أو يمكن أن يكون، ذلك البحر حاضنة لها، تالياً. ولا عجب،
بالطبع، إذا استذكر المرء ما يشدد عليه هيس من أنّ مياه هذا البحر كانت
الأكثر دموية بعد انطواء صفحة الحرب الباردة، بالمقارنة مع مياه العالم
الأخرى، واللائحة تتضمن التالي، سواء في مياهه الفعلية أو على مقربة
منها: مواجهات ترانسنيستريا في مولدوفا، المعارك الجورجية الأبخازية،
الحرب الأهلية افي جورجيا، المواجهة الروسية الجورجية، الحربان الأولى
والثانية في شيشنيا، روسيا وأوكرانيا في جولتَيْ 2014 و2022، أرمينيا
وأذربيجان في صراعَيْن حول ناغورني قره باخ.
أمّا الدول، وبعضها قوى عظمى كونية، التي تشاطئ البحر الأسود أو تدانيه
أو تتقاطع مع سواحله فإنها، بمعنى الكتل الكبرى أيضاً، تشمل روسيا،
الحلف الأطلسي (أي الولايات المتحدة ضمناً) الاتحاد الأوروبي، وتركيا.
الصين، كما يشير هيس، تقترب حثيثاً من موقع القوّة الناشئة، تجارياً
واستثمارياً بادئ ذي بدء؛ ثمّ، استطراداً، حَصْد عقود الإنشاء والإعمار
وتطوير البنى التحتية في جورجيا وبلغاريا ورومانيا، في انتظار عقود
أوكرانيا ما بعد مآلات الغزو الروسي. وإذا جاز للأرقام أن تنطق في
مضمار الأهمية التجارية للبحر الأسود كوسيط نقل وشحن وعبور، هنا أمثلة
بليغة: بحر الشمال الروسي استضاف حمولة 34.9 مليون طنّ متري بضائعي سنة
2021، بالمقارنة مع 898 مليون طنّ متري عبر بوابة الدردنيل في البحر
الأسود خلال السنة ذاتها، وهذا يعادل قرابة 70٪ من 1.27 مليار طنّ متري
نُقلت عبر قناة السويس.
على مستوى عسكري صرف، لا يلوح أنّ القيادة العسكرية الروسية (أمثال
وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف) قبل
هرم القيادة المدنية كما يتصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ سوف
تصحو، بمعنى أن تبرأ، من صدمة إغراق طرّاد أسطول البحر الأسود الروسي
«موسكوفا» أواسط نيسان (أبريل) الماضي، بواسطة صواريخ «نبتون» وما
أعقبه من ارتباك قياسي في تدبّر حلول دفاعية ساحلية، وضمان أمن شواطئ
روسيا الجنوبية الغربية. ولم تعد خافية الطرائق التركية في استخدام
مياه البحر الأسود للمناورة بين موسكو وكييف خدمة للمصالح التركية،
سواء عبر إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية تارة أو التلويح
بفتحها لنقل الحبوب إلى مطاحن العالم تارة أخرى.
وقبل أيام كان أولكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في
أوكرانيا، قد حثّ جورجيا على فتح «جبهة ثانية» ضدّ روسيا، مستنكراً
وضعية «الحياد» التي تتخذها تبليسي، ورفضها المشاركة في فرض العقوبات
على روسيا. وإذا كان الرجل لا يعيد تكرار الأصداء ذاتها التي تتردد في
أروقة الحلف الأطلسي، لجهة استدراج موسكو إلى حماقة أخرى جديدة عسكرية
المحتوى؛ فإنه، على أقلّ تقدير، يستذكر سلسلة الحقائق الشائكة التي
تربط بين روسيا وجورجيا، وكيف يمكن أن تنقلب إلى مواجهات ساخنة عمادها
اعتراف موسكو باستقلالية إقليمَي أبخازيا وأوسيتيا، ومهادها القوقاز
التاريخي. يتناسى دانيلوف، عامداً بالطبع، أنّ جورجيا واحدة من أشنع
فضائح الاتجار الغربي، الأوروبي والأطلسي والأمريكي، مع بوتين ما بعد
مؤتمر ميونخ 2007؛ الذي شهد، من جانب أوّل، مغازلة روسيا وسماع حسرات
سيد الكرملين على سحب القواعد السوفييتية من مولدوفا وجورجيا؛ كما شهد،
من جانب ثانٍ أخطر، شروع موسكو في تأسيس معادلة قوّة أمنية رئيسية في
البحر الأسود عبر غزو جورجيا.
تمركز القوى الرئيسية والتنافس متعدد الأجناس في البحر الأسود يثير السؤال الحارق الجارح: كم من الدماء القانية قبل انقلاب لون المياه، قبل استبدال تسمية البحر من أسود إلى… أحمر
ليس عسيراً عثور المرء على خلفيات اقتصادية جيو – سياسية، كونية أكثر
منها إقليمية أو محلية، تتيح قراءة عشرات التطوّرات التي شهدتها
وتشهدها بلدان أوروبا الشرقية، فهذا «المعسكر الاشتراكي سابقاً» لم يكن
قد استكمل نصف العقد الأوّل من ثوراته الديمقراطية ـ الليبرالية حتى
استعجل الانقلاب إلى النقائض القديمة بعد أن أضفى عليها أكثر من مسحة
واحدة مصطنعة. سياسات القوى الكبرى، قبل مشكلات المجتمع الكبرى، ظلت
الهادي في هذه الأنظمة الجديدة، لأنها ببساطة كانت في رأس الأسباب
الجوهرية لصعود تلك الثورات، واتكائها أكثر ممّا ينبغي على الغرب
وأمريكا. وفي ملفّ جورجيا تحديداً، لم تكن خافية المصالح الاقتصادية
الستراتيجية الكامنة خلف ما لاح أنه نزاع بين واشنطن وموسكو في جورجيا،
فالموقع الهامشي الذي تشغله أبخازيا وأوسيتيا لا يطمس حقيقة أنهما
بمثابة «شرارات اللعبة الكبرى للقرن الحادي والعشرين، حيث القضية هي
التالية: مَنْ سيحظى بالسيطرة على حوض بحر الخزر، مخزون مصادر الطاقة
الأغنى بعد الشرق الأوسط؟» كما تساءل يومئذ رجل عليم ببواطن الأمور مثل
جوزيف جوفي، رئيس تحرير الجريدة الألمانية المحافظة «داي تزايت».
بالطبع، ليس ثمة سبب واحد يدفع المرء إلى تبرير التدخّل العسكري الروسي
في جورجيا، وبعده اجتياح أوكرانيا، أو اللجوء إلى سياسة منهجية لتأجيج
النزعات الانفصالية هنا وهناك في «الجمهوريات» السوفييتية السابقة. غير
أنّ الثابت، في المقابل، هو أنّ رهانات الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل
ساكاشفيلي (المنضوية ضمن الإطار العريض لسياسات واشنطن، في نهاية
المطاف) لم تكن تستفزّ موسكو في المسائل المتصلة بفتح الباحة الخلفية
لروسيا أمام امتداد الحلف الأطلسي، فحسب؛ بل كان القصف الجورجي
العشوائي لعاصمة أوسيتيا الجنوبية بمثابة إلقاء قفاز التحدّي في وجه
موسكو، التي كانت في الأصل تتحرّق لاستقبال ذلك القفاز. وقبل شهر فقط
من طور التسخين ذاك، كانت وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق كوندوليزا
رايس تزور تبليسي، كي تدشن الخطوة الأولى على درب انضمام جورجيا إلى
الأطلسي من جانب أوّل، وكي تعطي إطاراً سياسياً ودبلوماسياً لمناورات
عسكرية أمريكية- جورجية مشتركة، أشرف على تنفيذها قرابة 1000 عسكري
أمريكي.
وفي استعراض تاريخ النفاق الأمريكي والكيل بأكثر من مكيال إزاء المسائل
المتماثلة، لم يكن مدهشاً أن تسكت واشنطن عن الاستفزازات العسكرية
الجورجية، وأن تستنكر في الآن ذاته لجوء موسكو إلى القوّة العسكرية؛
أو، في تتمة اخرى مضحكة/ مبكية، إعابة موسكو بسبب «الاستخدام غير
المتناسب» للقوّة، وكأنّ البنتاغون استخدم مبدأ القوّة المتناسبة في
غزو أفغانستان والعراق! أو كأنّ موسكو، وليس واشنطن، هي صاحبة مئات
القواعد العسكرية الدائمة في طول العالم وعرضه، وعشرات الأساطيل
الجاهزة أبداً للتدخل والغزو! وآنذاك، بعد اتضاح الخسران المبين
للخيارات الأمريكية في جورجيا، وبعد إنفاق ما يزيد عن ملياري دولار
أمريكي في تسليح جيشها بدل تنمية اقتصادها، لم يجد الرئيس الأمريكي
الأسبق جورج بوش الابن ما يفعله سوى إرسال المزيد من الأساطيل، حتى إذا
جرى تمويهها تحت قناع المساعدات الإنسانية.
وفي العودة إلى مقالة هيس، يساجل الرجل بأنّ إهمال البحر الأسود كفضاء
ستراتيجي وحقيقة أنه شهد الكثير من النزاعات، هما أمران ينتهيان إلى
النتيجة ذاتها: أنّ شواطئه تسجّل التمركز الأعلى للقوى الرئيسية
المتحوّلة؛ الأمر الذي لا يعني أنّ التنافس متعدد الأجناس يبيح النظر
إليه بعدسة التناظرات المتعاكسة فقط. ما لا يقوله هيس، حياءً أو خشية،
هو السؤال الحارق الجارح: كم من الدماء القانية، قبل انقلاب لون المياه
واستبدال تسمية البحر من أسود إلى… أحمر!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
روبرت مالي والنووي الإيراني:
طَرْق الحديد البارد
صبحي حديدي
ليست مبالغة، ولعلها كذلك لا تدخل في باب الخطأ، أن يساجل البعض بأنّ
ممثل الولايات المتحدة الخاصّ للشؤون الإيرانية، روبرت مالي؛ هو
المفاوض الأمريكي الأفضل الذي يمكن أن تحصل عيه طهران بصدد برنامجها
النووي وإحياء اتفاق 2015، ويستوي أن يدور المزيد من الجولات في
العاصمة القطرية الدوحة، أو أن تُستأنف في العاصمة النمساوية فيينا.
صحيح أنه مفاوض غير مباشر في نهاية المطاف، إلا أنّ الأصحّ يبقى
الاعتبار الأساس الماثل، أو الجاثم على طاولات التفاوض إنْ اتضح مرّة
أو غُيّب مرّة أخرى، أي ذاك الذي يشير إلى أنّ واشنطن هي الطرف
الأَوْلى بتحريك العجلة أو تجميدها أو حتى تعطيلها؛ وهذا منذ قرار
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب، في سنة 2018، من اتفاق
«خطة العمل المشترك الشاملة»، وفرض عقوبات خانقة وشاملة ألحقت وما تزال
تلحق أفدح الأضرار بالاقتصاد الإيراني وخاصة في ميدان النفط والقطاعات
المصرفية.
وكان تعيين مالي في هذا الموقع بمثابة إشارة عملية من جانب الرئيس
الأمريكي الحالي جو بايدن بأنّ الإدارة تزمع جدياً إعادة إحياء الاتفاق
القديم، ليس بالضرورة عن طريق تقديم تنازلات من أيّ نوع، إذْ قد يكون
العكس هو الصحيح في المحصلة؛ بل بواسطة وضع الملفات الشائكة إياها في
يد كادر مخضرم، يحدث أنه شابّ أيضاً، تحلى على الدوام بصفات فكرية وجيو
– سياسية «عالمثالثية»، واعتنق جملة من الخيارات الدبلوماسية، وضعته في
مرمى صقور وزارة الخارجية الأمريكية ومجموعات الضغط الإسرائيلية، رغم
أنه (أم لأنهً؟) يهودي بالولادة.
وحين شارك مالي، بفاعلية عالية وملموسة، في صياغة اتفاق 2015 فإنّ
عدّته إلى جلسات التفاوض الشاقة تلك لم تكن خبراته بصدد المفاوضات
الفلسطينية – الإسرائيلية أيام الرئيس الأسبق بيل كلنتون، أو تلك
المهارات وقد انتقلت خلال إدارة الرئيس الثاني الأسبق باراك أوباما إلى
ملفات البرنامج النووي الإيراني، فحسب؛ بل كانت أحماله تتضمن انتساباً
إلى أبيه، سيمون مالي، الصحافي الأمريكي المصري/ الحلبي الأصل الذي
كلّفته مواقفه الشجاعة من قضايا الشعوب سحب الجنسية المصرية بقرار من
أنور السادات، والاعتقال من الشارع ثمّ الطرد الفوري من فرنسا بقرار من
الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان. كذلك كان الفتى ابن أبيه في
أطروحته للدكتوراه، التي تناولت النزعة العالمثالثية والثورة والتحوّل
إلى الإسلام.
تفصيل آخر كان قد أغوى المفاوض الإيراني سنة 2015، ويصحّ الافتراض بأنه
قد يغويه اليوم أيضاً، هو أنّ نصائح مالي إلى رؤسائه في مختلف مواقع
البيت الأبيض، والرئيس الأسبق أوباما بصفة خاصة، كانت تدعو إلى انتهاج
البراغماتية في التعامل مع الأنظمة موضوع انتفاضات الشعوب في العالم
العربي بعد 2010؛ وأمّا بصدد الانتفاضة الشعبية السورية، ذات الصلة
المباشرة بسلال النفوذ الإيراني في المنطقة، فقد كانت آراء مالي في
عداد الأسوأ، والأشدّ انحيازاً إلى ترجيح الحوار مع النظام السوري (أي:
إيران) وتبخيس قيمة الحراك الشعبي الداخلي (وليس مؤسسات المعارضة
الخارجية).
يبقى، غنيّ عن القول، إنّ مالي مجرّد موظف في إدارة حاشدة معقدة تتولى
شؤون القوّة الكونية الأعظم، وهو تالياً ليس صانع قرار حتى إذا امتلك
وسائل الحثّ على صياغة سياسة هنا أو اعتماد خيار هناك؛ الأمر الذي لا
يبدّل أيضاً من حقيقة أنّ زميله في التفاوض غير المباشر، علي باقري،
أتى إلى الدوحة أو سيعود إليها وإلى فيينا مراراً ربما، يحمل من جانبه
أثقال الفارق بين مقاربة الملفات من وجهة نظر الرئيس الإيراني السابق
حسن روحاني، بالمقارنة مع خَلَفه الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي. والأمر
ذاته لا يتوجب، في المقابل ومن حيث المبدأ، أن يسدّ شهية طهران إلى
استنفاد ما يُتاح استثماره من أهواء مالي وانحيازاته الشخصية؛ حتى من
قبيل طرق الحديد البارد!
البيت الأبيض: من أحلام
الآباء إلى كاتشب الأحفاد
صبحي حديدي
ثمة أكثر من وجه لاستقبال شهادة كاسيدي هتشنسن، المساعدة السابقة لرئيس
أركان البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وذراعه اليمنى باعتراف الكثيرين،
التي أدلت بها مؤخراً أمام لجنة الكونغرس المختارة للتحقيق في وقائع
اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 كانون الثاني (يناير) 2001؛ خاصة دور
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تشجيع الزحف على العاصمة، رغم
علمه المسبق بأنّ العديد من أنصاره الزاحفين يحملون أسلحة نارية وبيضاء
بينها بنادق ثقيلة العيار من طراز
AR-15.
وجهة أولى قد تفضّل الدراما، وثمة الكثير من فصولها ومشاهدها وتفاصيلها
التي لا سوابق لها في تاريخ البيت الأبيض، وبعضها يصعب أن يُصدّق لولا
تكاتف الملابسات التي تؤكد الصدق بدل التشكيك؛ مقابل وجهة ثانية تساجل
بأنّ لا عجب ولا غرابة مع هذا الرئيس تحديداً، في شخصيته الفردية وفي
سلوكياته الرئاسية، ومع جمهوره وأنصاره ومحازبيه والعاملين معه، بصرف
النظر عن مواقعهم ومستوياتهم الاجتماعية والعقلية والمهنية.
بصدد الدراما ثمة حكاية أولى سردتها هتشنسن في شهادتها، تقول إن ترامب
غضب، أشدّ الغضب كما يصحّ الاستنتاج من ردود أفعاله، حين استمع إلى
مقابلة أجرتها وكالة أسوشيتد برس مع وزير العدل وليام بار، مطلع كانون
الأول (ديسمبر) 2020، صرّح خلالها الأخير أنّ وزارته لا تملك أدلة
واضحة على وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية، التي خسرها ترامب لصالح
جو بايدن. ردّ الفعل الأوّل كان «رئاسياً»، والحقّ يُقال، لأنّ ترامب
خبط بيده على الطاولة حين عرض بار تقديم استقالته إذا لم يكن الرئيس
راضياً عن أدائه، وأردف سريعاً: «قُبلت!». بعد ذلك، ولكن في صالة
الطعام، بلغت غضبة ترامب أوجها فقذف بالطعام وكسر صحن الخزف الثمين
(الذي يُفترض أنّ الديمقراطية الأمريكية استخدمته مراراً في إطعام سادة
البيت الأبيض)؛ ولم يكتفِ بهذا، بل رشق الحائط (الأبيض، كذلك) بسائل
الكاتشب. وفي برنامج ساخر شهير، اقترح مذيع أمريكي تخليد بقعة الجدار
التي شهدت الرشقة الحمراء عن طريق إعادة رشقها وتجفيفها وتثبيت لوحة
نحاسية تقول: هنا كان الرئيس الأمريكي الـ45 قد رشق الجدار بالكاتشب!
في سياق الدراما أيضاً، ولكن على نحو أكثر تشديداً على مخاطر شخصية
عصابية ميغالومانية بكلّ ما تتضمنه هذه التوصيفات من مظاهر اعتلال،
تقول الحكاية الثانية إنّ ترامب أنهى خطابه اللاهب أمام أنصاره، وبعد
أن حثهم على التوجه إلى مبنى الكابيتول واعداً بالانضمام إليهم، أراد
التوجه بالفعل إلى حيث يجتمع الكونغرس لفتح صناديق اقتراع الولايات
وتثبيت فوز بايدن. في «الوحش»، اللقب الذي يًطلق على الليموزين
الرئاسية، انتبه ترامب إلى أنّ السيارة لا تتجه إلى الكابيتول، فاستفسر
من المسؤول الأمني بوبي إنغل الذي أخبره أن اعتبارات أمنية تحول دون
الذهاب إلى الكابيتول. وتروي هتشنسن أنّ ترامب مدّ يده الأولى إلى مقود
السيارة ليحرف اتجاهها، فأمسك إنغل بيده قائلاً: «سيدي الرئيس يتوجب
ألا تمسك بالمقود»؛ فردّ ترامب صوتياً: «انا الـF…..
President
وأريد التوجه إلى الكابيتول»، ثمّ ردّ جسدياً بيده الثانية وأمسك
بترقوة الرجل! هذا فرد يتحكم بأزرار السلاح النووي وكان تلك الساعة
يترأس القوة الكونية الأعظم، التي تزعم أيضاً أنها الديمقراطية الأولى
وحارسة «العالم الحرّ»…
سوف يُتاح للمراقب المتشكك في طرائق اشتغال الديمقراطية الأمريكية أن يضع شهادة هتشنسن على المحكّ العملي الأوّل: هل ستجد وزارة العدل الامريكية في فظائع ما أوردته موظفة البيت الأبيض السابقة أساساً قانونياً لإحالة الرئيس الأسبق إلى القضاء
الوجهة الأخرى في قراءة شهادة هتشنسن تقود المرء، أو هذه السطور على
الأقلّ، إلى فكرة أولى مركزية أغلب الظنّ؛ مفادها أنّ هذه الموظفة
الشابة التي استيقظ ضميرها ففتحت أبواب فضائح البيت الأبيض على وسعها،
لم تكن قد انتخبت ترامب في سنة 2016، حين لم تكن تتجاوز الـ 20 سنة،
فحسب؛ بل كانت في عداد الأكثر حماسة له وفخراً به، من موقع انتمائها
إلى الحزب الجمهوري أوّلاً، ثمّ عملها مساعدة لهذا أو ذاك من أقطاب
الحزب في الكونغرس. تقول اليوم إنها شعرت بالاشمئزاز إزاء الزحف على
الكابيتول، ورأت فيها خطوة «غير أمريكية» تسعى إلى تقويض رمز ديمقراطية
أمريكا بناء على أكذوبة (تزوير الانتخابات الرئاسية). هذه الصحوة
الضميرية الشابة تقابلها، حتى إشعار آخر غير معلوم، خيانات ضمائر أكبر
سنّاً من هتشنسن، وأعلى موقعاً في مسؤوليات البيت الأبيض؛ على غرار
رئيس أركان البيت الأبيض السابق مارك ميدوز الذي لم يخترْ التزام الصمت
عن تلك الوقائع، وسواها كثير مما شهده في ذلك اليوم وقبله، فقط؛ بل سأل
ترامب أن يمنحه عفواً رئاسياً، ثمّ صرف الأسابيع اللاحقة على مغادرة
البيت الأبيض في تدبيج كتاب حافل بالأكاذيب حول الوقائع تلك وغيرها.
وهذا وجه يحيل استطراداً إلى الموقع الذي ما يزال ترامب يتمتع به في
صفوف أنصاره ناخبي 2016، الذين تكاثروا كما تقول المعطيات بدل أن
يتناقصوا؛ ثمّ في صفوف الحزب الجمهوري، على صعيد الأعضاء في طول
الولايات المتحدة وعرضها، ممّن رفضوا نتيجة الانتخابات الرئاسية وضغطوا
على قيادات الحزب كي تتبنى مزاعم ترامب؛ ثمّ في قلب الشريحة الأعلى من
ممثلي الحزب في مجلسَيْ النواب والشيوخ، حيث ظلّ ترامب الثقيل يخيّم
على مرشحي الانتخابات التكميلية المقبلة. هذه، من جانب آخر ليس أقلّ
أهمية، حال تمتدّ إلى قطاعات أوسع في المجتمع الأمريكي الراهن، أو
المعاصر إجمالاً في الواقع، تتماهى تماماً مع أفكار ترامب الانعزالية
والعنصرية والشعبوية؛ ولن تجد فارقاً فاضحاً في انقلاب «الحلم
الأمريكي» على يدّ الروّاد الآباء المؤسسين، إلى كاتشب يُرشق على
الجدران ذاتها التي شهدت مراحل ولادة الديمقراطية الأمريكية.
ولعلّ المثال الأحدث عهداً، بصدد يوم اقتحام مبنى الكابيتول تحديداً،
هو استجواب الجنرال المتقاعد مايكل فلنت، أوّل مستشار للأمن القومي في
رئاسة ترامب، والقائد الميداني خلف الكثير من جرائم الحرب التي
ارتكبتها القوات الغازية الأمريكية في أفغانستان والعراق، ومدير وكالة
استخبارات الدفاع؛ من جانب زميلة له في الحزب، عضو الكونغرس ليز شيني،
يحدث أنها أيضاً إبنة ديك شيني نائب الرئيس في عهد جورج بوش الأب وأحد
كبار مهندسي اجتياح العراق. هنا طرائف أسئلة امتنع فيها الجنرال عن
الإجابة مستخدماً حقّه في اللجوء إلى التعديل الخامس:
ـ هل تعتقد أنّ عنف 6 كانون الثاني كان مبرَّراً معنوياً؟
ـ الخامس
ـ هل تعتقد أنّ عنف 6 كانون الثاني كان مبرراً قانونياً؟
ـ الخامس
ـ هل تؤمن بالانتقال السلمي للسلطة؟
ـ الخامس
وأن يمتنع جنرال متقاعد، أقسم يمين الولاء للدستور، عن تأييد الانتقال
السلمي للسلطة أمر لا يشير إلى خيانة القسم فقط، بل إلى اعتناق العنف
والنهج الانقلابي في حيازة السلطة؛ وهذا بدوره لا يصنع أية مفارقة
سياسية أو قانونية أو أخلاقية أو دستورية بصدد التيار الترامبي الجارف
الذي تحكّم ويتحكم بملايين الأمريكيين، فيشمل الجنرال مثل ضابط
الاستخبارات ورئيس أركان البيت الأبيض مثل محامي الرئيس الشخصي،
والصحافي في قناة «فوكس نيوز» مثل رئيس بلدية هنا أو عضو كونغرس هناك.
ولأنّ الأمور بخواتيمها، سوف يُتاح للمراقب المتشكك في طرائق اشتغال
الديمقراطية الأمريكية أن يضع شهادة هتشنسن على المحكّ العملي الأوّل:
هل ستجد وزارة العدل الامريكية في فظائع ما أوردته موظفة البيت الأبيض
السابقة أساساً قانونياً لإحالة الرئيس الأسبق إلى القضاء بتهمة
التحريض على العصيان الدستوري أو حتى تنظيمه؟ والادهى من هذا، هل ستؤكد
انتخابات الكونغرس التكميلية أنّ ترامب ليس حيّاً مهيمناً فاعلاً
مؤثراً، فحسب، بل… يتمدد، أيضاً وأيضاً؟
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
)سلّة خبز العالم(: حصار روسيا
لا يجوّع سوى فقراء الكون
صبحي حديدي
بصدد أزمة الحبوب الكونية الناجمة عن، أو من حول، الغزو الروسي في
أوكرانيا، ثمة معطيات إحصائية صلبة لا مقام فيها للتفذلك أياً كانت
حنكة المتفذلك، ولا للتلفيق أنّى ذهب الملفّق في ليّ عنق الحقائق.
المعطى الأوّل هو أنّ روسيا استحقت، بجدارة تسندها الأرقام، لقب «سلّة
خبز العالم» لأنها تصدّر إلى أبناء الكرة الأرضية خارج روسيا ما يعادل
17% من القمح، فكيف تكون الحال إذا كان الطرف الآخر في المعادلة
الكارثية، أي أوكرانيا، يصدّر 12%. مأساوية المعادلة هنا لا تحتمل أيّ
مقدار من تخفيف الوطأة أو ترحيل العواقب: إمّا أن تخرق عشرات الدول
العقوبات الامريكية والأوروبية والأطلسية المفروضة على الصادرات
الروسية، وتقع بالتالي تحت طائلة إجراءات عقابية وتأديبية؛ أو أن تنتظر
ساعة فرج تأتي ولا تأتي، حين يتبدّل الوضع في قليل أو كثير حول الألغام
التي تشلّ الموانئ الأوكرانية وتعيق بالتالي تصدير محاصيل الحبوب؛ أو
ثالثاً، وهو الأرجح السائد، أن تجابه ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في
أسعار القمح، وبالتالي يبلغ مئات الملايين من السكان حافة الجوع
والتجويع والمجاعة.
المعطى الثاني الصلب يقول إنّ سوق الحبوب العالمية عالية التركيز لأنّ
85% من الصادرات العالمية تنحصر في سبعة مصادر: روسيا، أوكرانيا،
الاتحاد الأوروبي، أستراليا، كندا، الولايات المتحدة، والأرجنتين.
وأمّا صادرات الذرة، فإنها تنحصر في أربعة مصادر: الولايات المتحدة،
الأرجنتين، البرازيل، وأوكرانيا. وللأرقام أن تختصر، على نحو مثير
للقلق ومأساوي هنا أيضاً، مقادير اعتماد بعض دول الجنوب والمجتمعات
النامية على الصادرات الروسية والأوكرانية: 90% في الصومال، 80% في
الكونغو، 40% في اليمن، وهكذا… ولا يتوجب أن تغيب عن الذاكرة حقائق
المجاعة التي ضربت الصومال، في الجانب الذي يخصّ الحبوب وانفجار
أسعارها وأزمات الخبز والغذاء، فأودت بحياة 250 ألف آدمي. أسعار شهر
نيسان (أبريل)، بعد أسابيع على بدء الغزو الروسي، قفزت على نطاق عالمي
بمعدّل 17% عن شهر شباط (فبراير) من العام ذاته، ولأنّ الحرب قائمة
وآخذة في الاتساع، وبالتالي لن تتأخر أسعار الحبوب في القفز أعلى
وأعلى؛ فإنّ عشرات الدول سوف تصبح عاجزة ببساطة عن سداد أثمان
الواردات، بافتراض أنّ الندرة الحادة لن تكون سيّدة المشهد أصلاً.
إذا كان واضحاً تماماً مقدار ابتهاج البيت الأبيض بتورّط الكرملين في غزو أوكرانيا، فإنّ ما لا يقلّ وضوحاً هو انعدام الاكتراث لدى القوى التي تحاصر «سلّة خبز العالم» إزاء حقيقة كبرى ساطعة تقول إنّ فقراء العالم وجياعه هم المحاصَرون في المقام الأوّل.
وليس خافياً، استطراداً، أنّ هذه السطور تساجل ضدّ العقوبات الاقتصادية
إجمالاً، وتلك التي تؤذي الشعوب قبل أن تمسّ الحكام خصوصاً، على غرار
العقوبات التي فًرضت ضدّ نظام صدام حسين أو التي تُفرض راهناً ضدّ
النظام السوري؛ ليس لأنها لا تملك هذه الدرجة أو تلك من التأثير على
الأنظمة، بل جوهرياً لأنّ تأثيراتها السلبية على الشعوب والمجتمعات
والبنى التحتية أضخم بما لا يُقاس. على سبيل المثال، العقوبات المندرجة
ضمن «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» لم تمنع وكالات الأمم
المتحدة المختلفة من تمرير 30 مليار دولار إلى أجهزة نظام بشار الأسد،
مقنّعة كانت أم صريحة، تحت ستار «المساعدات الإنسانية»؛ بعلم، وإقرار،
الولايات المتحدة وجميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين. والتاريخ لا
يسجّل سقوط أيّ نظام «مارق»، بحسب التعبير الأمريكي الشهير، جرّاء
عقوبات اقتصادية من أيّ صنف؛ أكانت «غبية» أم ّذكية»، وقاسية أم رحيمة.
وفي كلّ ما يتصل بالعقوبات التي تحول دون تصدير الحبوب الروسية
والأوكرانية، لا صوامع روسيا طفحت وفاضت وأُلقي بمخزونها إلى البحر،
ولا المخابز تأثرت، ولا الروبل هبط إلى حضيض.
والذين يغلقون اليوم منافذ الجياع إلى «سلّة خبز العالم»، في واشنطن
وبروكسيل وعواصم الحلف الأطلسي، يدركون جيداً أنّ الحصار المفروض على
قمح روسيا لن يوقف الحرب ولن يدفع سيّد الكرملين إلى مراجعة فصول غزو
أوكرانيا، أو الجنوح إلى سلم من أيّ صنف، أو قبول تسويات مرحلية لا
تحقق سلسلة أغراض مركزية كانت وراء قرار الغزو. في الآن ذاته، يتناسى
قادة أمريكا والاتحاد الأوروبي والناتو أنّ معضلة النظام الرأسمالي
الكونية الراهنة أشدّ مضاضة وأبعد أثراً من حكاية نقص الحبوب أو انقطاع
الغاز والوقود؛ لأنّ كوابيس ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1,5 مئوية
(2,7 فهرنهايت)، قياساً على المعدّل ما قبل الصناعي، هو المعضلة
الكبرى؛ الجاثمة على الصدور، غير القابلة للحلّ لأنها في حال تعارض
تامّ مع الجشع الرأسمالي إلى التصنيع وتلويث كوكب الأرض. ولعلّ الأمين
العام للأمم المتحدة خرج عن القاموس الدبلوماسي المعتاد في إبداء
القلق، فقال بفم ملآن هذه المرّة: إنّ نتائج التغيرات المناخية يمكن أن
تسفر عن «مدن غارقة تحت الماء، وموجات سخونة غير مسبوقة، وعواصف مثيرة
للذعر، وحالات نقص في الماء واسعة الانتشار، واندثار مليون من أنواع
النبات والحيوان».
وفي مناسبة موجات الحرارة العالية التي تضرب أوروبا هذه الأيام، يصحّ
أن تُستذكر هنا واقعة فارقة شهدتها فرنسا صيف 2005 حين قضى أكثر من
5,000 فرنسية وفرنسي نحبهم جرّاء موجة طقس حارّ لم تدم أكثر من أسبوع.
لا أحد، بالطبع، يعترض على أطوار الطبيعة حين تقسو على الكائن، غير أنّ
الطبيعة ليست مسؤولة وحدها عن إزهاق كلّ هذه الأعداد الهائلة من
الضحايا، وثمة مسؤولية مباشرة يتحملها الإنسان الذي امتلك من أسباب
التكنولوجيا ما يكفي لقهر ــ أو في الحدّ الأدني السيطرة على ــ سورات
غضب الطبيعة. والإنسان، في هذه الحالة، لم يكن سوى فرنسا: الدولة
الرأسمالية، المنتَخبة حكومتها ديمقراطياً كي تكون مسؤولة، وكي تلعب
دور راعية الرفاه والرخاء والأمن والطمأنينة. ومصرع هذا العدد الكبير،
خاصة في صفوف المسنّين، بسبب أيّام معدودات من المناخ الحارّ، لاح في
جانب مشروع من المسألة أشبه بـ 11 أيلول ‘سبتمبر) من طراز آخر؛ مع فارق
أنّ الضحايا الفرنسيين لم يسقطوا على يد الإرهابيين من انتحاريي
الطائرات الخارقة للأبراج، وإنما سقطوا ضحية مزيج من تعبيرات الطبيعة
العشوائية وإهمال الدولة التي لا يتوجّب أن تكون عشوائية.
من جانب آخر سجّل تقرير، صدر مؤخراً عن «وكالة البيئة الأوروبية»، أنّ
ظواهر قصوى من اضطراب المناخ أودت بحياة 142 ألف شخص، وكلّفت 510
مليارات يورو، خلال الـ40 سنة المنصرمة فقط؛ وأنّ 3% من إجمالي الظواهر
المتطرفة في الطقس كانت وراء 60% من الأضرار المادية خلال الفترة
المذكورة. الدولة الرأسمالية، هذه التي تنتج كوابيس المناخ وتخشى
عواقبها في آن معاً، هي ذاتها التي تستطيب تحويل الغزو الروسي الأحمق
والوحشي والتوسعي إلى مناسبة وعتبة وذريعة لإطلاق منظومة جديدة من حرب
باردة لم تندلع أصلاً لأنها بقيت في إطار المخيّلات الإمبريالية/
السوفييتية؛ ولكنها الحرب التي ألحقت أبلغ الأذى وأشدّ الضرر بمصالح
الملايين في مشارق الأرض ومغاربها، وفي جنوب العالم والمجتمعات النامية
على وجه الخصوص. وإذا كان واضحاً تماماً مقدار ابتهاج البيت الأبيض
بتورّط الكرملين في غزو أوكرانيا، وأوضح منه سعادة الصناعات العسكرية
باشتعال حرب جديدة تتيح الإنتاج والتصدير والتدمير والمزيد من التصدير؛
فإنّ ما لا يقلّ وضوحاً هو انعدام الاكتراث لدى القوى التي تحاصر «سلّة
خبز العالم» إزاء حقيقة كبرى ساطعة تقول إنّ فقراء العالم وجياعه هم
المحاصَرون في المقام الأوّل.
وبئس مثل هذا الحصار، استطراداً، وأبأس منه أغراضه المنافقة المخادعة؛
التي يحدث، مع ذلك، أنها لا تخون تقاليد عريقة دأب النظام الرأسمالي
على إنتاجها وإعادة إنتاجها.
)سلّة خبز العالم(: حصار روسيا
لا يجوّع سوى فقراء الكون
صبحي حديدي
بصدد أزمة الحبوب الكونية الناجمة عن، أو من حول، الغزو الروسي في
أوكرانيا، ثمة معطيات إحصائية صلبة لا مقام فيها للتفذلك أياً كانت
حنكة المتفذلك، ولا للتلفيق أنّى ذهب الملفّق في ليّ عنق الحقائق.
المعطى الأوّل هو أنّ روسيا استحقت، بجدارة تسندها الأرقام، لقب «سلّة
خبز العالم» لأنها تصدّر إلى أبناء الكرة الأرضية خارج روسيا ما يعادل
17% من القمح، فكيف تكون الحال إذا كان الطرف الآخر في المعادلة
الكارثية، أي أوكرانيا، يصدّر 12%. مأساوية المعادلة هنا لا تحتمل أيّ
مقدار من تخفيف الوطأة أو ترحيل العواقب: إمّا أن تخرق عشرات الدول
العقوبات الامريكية والأوروبية والأطلسية المفروضة على الصادرات
الروسية، وتقع بالتالي تحت طائلة إجراءات عقابية وتأديبية؛ أو أن تنتظر
ساعة فرج تأتي ولا تأتي، حين يتبدّل الوضع في قليل أو كثير حول الألغام
التي تشلّ الموانئ الأوكرانية وتعيق بالتالي تصدير محاصيل الحبوب؛ أو
ثالثاً، وهو الأرجح السائد، أن تجابه ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في
أسعار القمح، وبالتالي يبلغ مئات الملايين من السكان حافة الجوع
والتجويع والمجاعة.
المعطى الثاني الصلب يقول إنّ سوق الحبوب العالمية عالية التركيز لأنّ
85% من الصادرات العالمية تنحصر في سبعة مصادر: روسيا، أوكرانيا،
الاتحاد الأوروبي، أستراليا، كندا، الولايات المتحدة، والأرجنتين.
وأمّا صادرات الذرة، فإنها تنحصر في أربعة مصادر: الولايات المتحدة،
الأرجنتين، البرازيل، وأوكرانيا. وللأرقام أن تختصر، على نحو مثير
للقلق ومأساوي هنا أيضاً، مقادير اعتماد بعض دول الجنوب والمجتمعات
النامية على الصادرات الروسية والأوكرانية: 90% في الصومال، 80% في
الكونغو، 40% في اليمن، وهكذا… ولا يتوجب أن تغيب عن الذاكرة حقائق
المجاعة التي ضربت الصومال، في الجانب الذي يخصّ الحبوب وانفجار
أسعارها وأزمات الخبز والغذاء، فأودت بحياة 250 ألف آدمي. أسعار شهر
نيسان (أبريل)، بعد أسابيع على بدء الغزو الروسي، قفزت على نطاق عالمي
بمعدّل 17% عن شهر شباط (فبراير) من العام ذاته، ولأنّ الحرب قائمة
وآخذة في الاتساع، وبالتالي لن تتأخر أسعار الحبوب في القفز أعلى
وأعلى؛ فإنّ عشرات الدول سوف تصبح عاجزة ببساطة عن سداد أثمان
الواردات، بافتراض أنّ الندرة الحادة لن تكون سيّدة المشهد أصلاً.
إذا كان واضحاً تماماً مقدار ابتهاج البيت الأبيض بتورّط الكرملين في غزو أوكرانيا، فإنّ ما لا يقلّ وضوحاً هو انعدام الاكتراث لدى القوى التي تحاصر «سلّة خبز العالم» إزاء حقيقة كبرى ساطعة تقول إنّ فقراء العالم وجياعه هم المحاصَرون في المقام الأوّل.
وليس خافياً، استطراداً، أنّ هذه السطور تساجل ضدّ العقوبات الاقتصادية
إجمالاً، وتلك التي تؤذي الشعوب قبل أن تمسّ الحكام خصوصاً، على غرار
العقوبات التي فًرضت ضدّ نظام صدام حسين أو التي تُفرض راهناً ضدّ
النظام السوري؛ ليس لأنها لا تملك هذه الدرجة أو تلك من التأثير على
الأنظمة، بل جوهرياً لأنّ تأثيراتها السلبية على الشعوب والمجتمعات
والبنى التحتية أضخم بما لا يُقاس. على سبيل المثال، العقوبات المندرجة
ضمن «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» لم تمنع وكالات الأمم
المتحدة المختلفة من تمرير 30 مليار دولار إلى أجهزة نظام بشار الأسد،
مقنّعة كانت أم صريحة، تحت ستار «المساعدات الإنسانية»؛ بعلم، وإقرار،
الولايات المتحدة وجميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين. والتاريخ لا
يسجّل سقوط أيّ نظام «مارق»، بحسب التعبير الأمريكي الشهير، جرّاء
عقوبات اقتصادية من أيّ صنف؛ أكانت «غبية» أم ّذكية»، وقاسية أم رحيمة.
وفي كلّ ما يتصل بالعقوبات التي تحول دون تصدير الحبوب الروسية
والأوكرانية، لا صوامع روسيا طفحت وفاضت وأُلقي بمخزونها إلى البحر،
ولا المخابز تأثرت، ولا الروبل هبط إلى حضيض.
والذين يغلقون اليوم منافذ الجياع إلى «سلّة خبز العالم»، في واشنطن
وبروكسيل وعواصم الحلف الأطلسي، يدركون جيداً أنّ الحصار المفروض على
قمح روسيا لن يوقف الحرب ولن يدفع سيّد الكرملين إلى مراجعة فصول غزو
أوكرانيا، أو الجنوح إلى سلم من أيّ صنف، أو قبول تسويات مرحلية لا
تحقق سلسلة أغراض مركزية كانت وراء قرار الغزو. في الآن ذاته، يتناسى
قادة أمريكا والاتحاد الأوروبي والناتو أنّ معضلة النظام الرأسمالي
الكونية الراهنة أشدّ مضاضة وأبعد أثراً من حكاية نقص الحبوب أو انقطاع
الغاز والوقود؛ لأنّ كوابيس ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1,5 مئوية
(2,7 فهرنهايت)، قياساً على المعدّل ما قبل الصناعي، هو المعضلة
الكبرى؛ الجاثمة على الصدور، غير القابلة للحلّ لأنها في حال تعارض
تامّ مع الجشع الرأسمالي إلى التصنيع وتلويث كوكب الأرض. ولعلّ الأمين
العام للأمم المتحدة خرج عن القاموس الدبلوماسي المعتاد في إبداء
القلق، فقال بفم ملآن هذه المرّة: إنّ نتائج التغيرات المناخية يمكن أن
تسفر عن «مدن غارقة تحت الماء، وموجات سخونة غير مسبوقة، وعواصف مثيرة
للذعر، وحالات نقص في الماء واسعة الانتشار، واندثار مليون من أنواع
النبات والحيوان».
وفي مناسبة موجات الحرارة العالية التي تضرب أوروبا هذه الأيام، يصحّ
أن تُستذكر هنا واقعة فارقة شهدتها فرنسا صيف 2005 حين قضى أكثر من
5,000 فرنسية وفرنسي نحبهم جرّاء موجة طقس حارّ لم تدم أكثر من أسبوع.
لا أحد، بالطبع، يعترض على أطوار الطبيعة حين تقسو على الكائن، غير أنّ
الطبيعة ليست مسؤولة وحدها عن إزهاق كلّ هذه الأعداد الهائلة من
الضحايا، وثمة مسؤولية مباشرة يتحملها الإنسان الذي امتلك من أسباب
التكنولوجيا ما يكفي لقهر ــ أو في الحدّ الأدني السيطرة على ــ سورات
غضب الطبيعة. والإنسان، في هذه الحالة، لم يكن سوى فرنسا: الدولة
الرأسمالية، المنتَخبة حكومتها ديمقراطياً كي تكون مسؤولة، وكي تلعب
دور راعية الرفاه والرخاء والأمن والطمأنينة. ومصرع هذا العدد الكبير،
خاصة في صفوف المسنّين، بسبب أيّام معدودات من المناخ الحارّ، لاح في
جانب مشروع من المسألة أشبه بـ 11 أيلول ‘سبتمبر) من طراز آخر؛ مع فارق
أنّ الضحايا الفرنسيين لم يسقطوا على يد الإرهابيين من انتحاريي
الطائرات الخارقة للأبراج، وإنما سقطوا ضحية مزيج من تعبيرات الطبيعة
العشوائية وإهمال الدولة التي لا يتوجّب أن تكون عشوائية.
من جانب آخر سجّل تقرير، صدر مؤخراً عن «وكالة البيئة الأوروبية»، أنّ
ظواهر قصوى من اضطراب المناخ أودت بحياة 142 ألف شخص، وكلّفت 510
مليارات يورو، خلال الـ40 سنة المنصرمة فقط؛ وأنّ 3% من إجمالي الظواهر
المتطرفة في الطقس كانت وراء 60% من الأضرار المادية خلال الفترة
المذكورة. الدولة الرأسمالية، هذه التي تنتج كوابيس المناخ وتخشى
عواقبها في آن معاً، هي ذاتها التي تستطيب تحويل الغزو الروسي الأحمق
والوحشي والتوسعي إلى مناسبة وعتبة وذريعة لإطلاق منظومة جديدة من حرب
باردة لم تندلع أصلاً لأنها بقيت في إطار المخيّلات الإمبريالية/
السوفييتية؛ ولكنها الحرب التي ألحقت أبلغ الأذى وأشدّ الضرر بمصالح
الملايين في مشارق الأرض ومغاربها، وفي جنوب العالم والمجتمعات النامية
على وجه الخصوص. وإذا كان واضحاً تماماً مقدار ابتهاج البيت الأبيض
بتورّط الكرملين في غزو أوكرانيا، وأوضح منه سعادة الصناعات العسكرية
باشتعال حرب جديدة تتيح الإنتاج والتصدير والتدمير والمزيد من التصدير؛
فإنّ ما لا يقلّ وضوحاً هو انعدام الاكتراث لدى القوى التي تحاصر «سلّة
خبز العالم» إزاء حقيقة كبرى ساطعة تقول إنّ فقراء العالم وجياعه هم
المحاصَرون في المقام الأوّل.
وبئس مثل هذا الحصار، استطراداً، وأبأس منه أغراضه المنافقة المخادعة؛
التي يحدث، مع ذلك، أنها لا تخون تقاليد عريقة دأب النظام الرأسمالي
على إنتاجها وإعادة إنتاجها.
غاز لبنان المسال
وزواريب نصر الله الضيقة
صبحي حديدي
هذه المرّة لم تكن في جعبة حسن نصر الله مفاجآت من الطراز الذي خرج به
على اللبنانيين، مساء 14/7/2006: «الآن في عرض البحر في مقابل بيروت،
البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية
وعلى بيوت الناس وعلى مدنيين، انظروا إليها تحترق». منصّة التنقيب عن
النفط والغاز المسال، التي استأجرتها دولة الاحتلال وتركزت مؤخراً في
حقل كيشان المتنازع عليه قبالة السواحل اللبنانية، عبرت قناة السويس
قادمة من سنغافورة تحت حماية البحرية الإسرائيلية، وهكذا تواصل العمل
حتى إشعار آخر يسبق الإعلان عن بدء الاستخراج والاستثمار.
ذلك لأنّ مضيّ نصر الله في اجترار البلاغة الجوفاء العتيقة، من طراز
أنّ «المقاومة تملك قطعاً القدرة، مادياً وعسكرياً وأمنياً، على منع
العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش»، لا يصحّ أن يدخل في عداد
مفاجآت الأمين العام لـ«حزب الله»؛ حتى في مستوى ما عوّد عليه جمهوره،
خاصة بعد اختيار القتال إلى جانب بشار الأسد ضدّ الشعب السوري، من
جعجعة بلا طحن حول وعود لم تعد صادقة بأيّ معنى، لأنها ببساطة باتت في
منزلة رثّة بين المخادَعة والمكاذَبة.
مثير للسخرية في المقابل أنّ نصر الله، في خطاب التعليق على القرصنة
الإسرائيلية (وهي هكذا بالفعل: ليس أقلّ، ولكن أكثر وأشدّ صفاقة)؛ ذهب
بالوعظ إلى هذه الدرجة الفضاحة له شخصياً: «في المعركة الوطنية الكبرى،
يجب الارتقاء إلى مستواها، والخروج من الزواريب السياسية الضيّقة». ذلك
لأنه الأَوْلى، قبل رؤساء لبنان الثلاثة بل قبل أيّ من ساسة لبنان
الكبار والصغار، بالخروج من الزواريب الضيّقة، وليس تلك التي تخصّ
السياسة والسياسات والأثلاث التي تعطل وتهيمن وتخرّب، فحسب؛ بل تلك
التي يشخّصها المعنى المادي للمفردة، في الأقبية المعتمة والسراديب
الخفية والتحركات المموّهة.
وقد يصحّ أخذ نصر الله بجريرة ما يقول حول الزواريب، من جهة أولى لا
تحثّ عليها الروابط بين المجازي والمادّي طيّ مفهوم «الزاروب» فقط؛ بل
يُخوّل للمرء أن يأخذه بجريرة ما يستعرض من أخطار وتحديات تكتنف ملفات
النفط والغاز المسال على وجه التحديد، وهي عنده ثلاثة أصناف: «سلخ
مساحة كبيرة جداً من لبنان، بما تحويه من حقول وثروات»، و«لبنان ممنوعٌ
من استخراج نفطه»، و«إفراغ الحقول». هذه لائحة تحصيل حاصل، أين منها
بروق نصر الله ورعوده في الماضي، عدا عن أنّ منصّة التنقيب جاثمة على
مرمى البصر، تحرسها البحرية الإسرائيلية، غير بعيد عن مرفأ شهد كارثة
انفجار هيروشيمية الأذى بشرياً ومعمارياً؛ ولا يلوح أنّ أية «مفاجأة»
تنتظرها، آتية من داخل الزاروب إياه تحديداً.
إلى هذا، وكما هو ديدنه الأثير، تغافل نصر الله عن الإشارة إلى مسؤولية
شريكه في الحكم، أو تابعه إذا توخي المرء بعض الدقّة في التوصيف،
الرئيس اللبناني ميشيل عون نفسه؛ الذي أبى توقيع مرسوم تعديل الخط
البحري 6433، متوهماً أنّ وسطاء من أمثال دافيد ساترفيلد وفردريك هوف
ودافيد شنكر يمكن أن يسايروه في تخفيف ضغط الإدارة الأمريكية عن صهره
جبران باسيل، مقابل إحالة حقوق لبنان في ثرواته إلى ثلاجة التجميد.
ولعلّ نصر الله صدق، والحقّ يُقال، في أمر واحد جاء على لسانه صريحاً
هذه المرّة، عارياً من نفحات التهديد أو الوعيد أو التنافخ أو التبجح:
«إننا لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها ولا نخافها»، ومع حفظ الفوارق
بين الخشية والخوف، و«السيد» مفوّه متفاصح عادة، فما العاقبة سوى هذه:
«كل الخيارات مفتوحة لدى المقاومة». وكانت الكليشيه ذاتها قد نفعت
«الحرس الثوري» الإيراني تحت وابل القاذفات والصواريخ الإسرائيلية هنا
وهناك في سوريا، حتى تنفع مخفر إيران السياسي والمذهبي قبالة بحر
بيروت، من جهة الضاحية الجنوبية!
اليسار يتقدم في كولومبيا ورهانات
واشنطن لا تحول ولا تزول
صبحي حديدي
إذا تمكن المرشح الرئاسي غوستافو
بيترو (62 سنة) وزميلته المرشحة لنائبة الرئيس فرانسيا ماركيز (40 سنة)
من الفوز في دورة الإعادة لانتخابات كولومبيا، يوم 19 حزيران (يونيو)
المقبل، فإنّ هذا البلد سوف يشهد ولادة فريق رئاسي يساري وتقدّمي
وشعبيّ المنبت للمرة الأولى على امتداد 212 سنة من عمر الاستقلال عن
التاج الاستعماري الإسباني. دورة الاقتراع الأولى منحت الثنائي صدارة
صريحة أمام مرشح اليمين المنافس رودولفو هرنانديز، وبدا جلياً تماماً
أنّ المعركة اجتماعية المحتوى تدور حول انحطاط المستويات المعيشية
وإخفاق الحكومات اليمينية المتعاقبة وشيوع الفساد؛ لا تغيب عنها
السياسة بالطبع، وخاصة تجذّر التبعية للولايات المتحدة، وموقع البلاد
في تراث ما بعد الاستعمار ومحيط أمريكا اللاتينية عموماً.
بيترو وماركيز ترشحا على بطاقة «الحلف التاريخي من أجل كولومبيا» وهو
تجمّع سياسي وانتخابي رأى النور في شباط (فبراير) 2021 فقط، وكان
واضحاً أنه إنما يتأسس لاعتبارات تحالفية تخصّ الانتخابات التشريعية
والرئاسية لعام 2022؛ وبالتالي توفّر مقدار غير قليل من المرونة في
ترحيل الخلافات الإيديولوجية بين أطرافه، اليسارية إجمالاً ولكن تلك
التي تختلف حول نهج راديكالي أو وسيط أو متشدد أو حتى ذاك الذي يقبل
مسحة ليبرالية. غير أنّ السمات الشخصية للمرشحين لم تكن البتة بعيدة عن
لعب الدور الأبرز في ترجيح الكفة، لأنّ بيترو مخضرم في الممارسة
السياسية، وسجّله يبدأ وهو في سنّ 17 سنة من الانضمام إلى حرب العصابات
و«حركة 19 نيسان (أبريل)» ويمرّ من دوره في تطوّر المجموعة المسلحة إلى
«تحالف
M ـ
19 الديمقراطي» الأكثر ميلاً إلى السياسة، ولا ينتهي عند انتخابه في
مجلس الشيوخ وحيازة المرتبة الثانية في عدد الأصوات على امتداد البلاد،
أو حلوله رابعاً في الانتخابات الرئاسية لعام 2010، أو انتخابه عمدة
للعاصمة بوغوتا في سنة 2011.
ماركيز، من جانبها، ناشطة نسوية وبيئية بارزة، ومحامية تحظى بشعبية
واسعة، وقد أحرزت سلسلة نجاحات كان من النادر أن تفلح في إنجازها امرأة
كولومبية من أصول أفريقية؛ بينها، على سبيل المثال فقط، قيادة مسيرة
نسائية ضمت 80 امرأة وقطعت 350 ميلاً للاحتجاج على ما يلحق البيئة من
أضرار بسبب أعمال التنقيب غير الشرعية عن الذهب. هي، إلى ذلك، شوكة
دائمة في حلق السفير الأمريكي فيليب غولدبرغ الذي لا يفوّت فرصة من دون
استغلالها لتأييد المرشح اليميني، واتهام «الحلف التاريخي» بالعمالة
لأطراف خارجية على راسها كوبا. وإذْ كان اختيارها، كنائبة للرئيس على
بطاقة بيترو، يعكس إقراراً من سواد اليسار الكولومبي بضرورة استحداث
تآلف أعمق وأعرض قاعدة بين السياسة والمجتمع والبيئة؛ فإنه في الآن
ذاته يمثل خطوة متقدمة لتعزيز أدوار المرأة، سواء على أصعدة حقوقية
ومدنية ونسوية عموماً، أو لجهة توطيد الحضور الإثني والأفرو ـ كولومبي
خصوصاً في الحياة السياسية.
رهانات الإدارة الأمريكية، هذه الحالية أو الإدارات السابقة كافة في
الواقع، لا تستهين بتطورات المشهد السياسي الداخلي في كولومبيا؛ أسوة،
غنيّ عن القول، بخياراتها التقليدية الشائعة بصدد التدخل في مصائر شعوب
أمريكا اللاتينية، حتى إذا توجّب تنظيم انقلاب عسكري دامٍ تارة، أو آخر
«أبيض» من حيث الشكل ولكنه ليس أقلّ عنفاً في المضامين تارة أخرى. وحتى
الساعة، وبعد نجاح الثنائي بيترو وماركيز في العبور إلى الدور الثاني،
تبدو أعين إدارة جو بايدن، عبر مجلس الامن القومي أو المخابرات
المركزية أو البنتاغون، شاخصة إلى جنرالات الجيش الكولومبي وزعماء
مافيات المال والمخدرات والميليشيات.
اليسار الكولومبي يتقدم، وإذا فازت بطاقة بيترو ـ ماركيز في انتخابات الإعادة فإنّ معطيات كثيرة سوف تتبدّل في قلب المجتمع والدولة؛ ولا يغيّر من هذه الحال أنّ مناهج البيت الأبيض سوف تبقى جامدة متماثلة، لا تحول ولا تزول
ولم يكن غريباً أن الجنرال
الكولومبي إدواردو زاباتيرو خالف الأعراف الدستورية وتدخّل في مجرى
الانتخابات، فاتهم بيترو بمضايقة الجيش وبتلقّي تبرعات مالية غير
شرعية. من جانبها لم تتردد الجنرال لورا ريشاردسون، رئيسة القيادة
الجنوبية للجيش الأمريكي، في الاجتماع علانية مع الجنرال الكولومبي
لويس نافارو، والتأكد منه على بقاء القواعد الجوية الأمريكية في
البلاد، واستمرار «كولومبيا شريكاً أمنياً متيناً» للولايات المتحدة.
رهانات باقية عند معطيات تقرير معهد «راند» الأمريكي المختصّ بأبحاث
«الدفاع الوطني» حول تلك الأرقام المذهلة لتهريب السلاح والإتجار به
استيراداً وتصديراً، في بلد تقول أكثر الإحصائيات تفاؤلاً إنّ نسبة
الجريمة فيه هي الأعلى على نطاق العالم؛ وهذه الحقيقة، حول العلاقة بين
تجارة السلاح وارتفاع معدّل الجريمة، ليست مدعاة ذهول أكثر من الحقيقة
الأخرى التالية: أنّ معظم هذا السلاح يأتي من مصدر واحد هو ما يُسمّى
«مستودعات الحرب الباردة» أي تلك الكميات الهائلة من الأسلحة التي سبق
أن خزّنتها الولايات المتحدة في بلدان أمريكية لاتينية مثل الهوندوراس
والسلفادور ونيكاراغوا. ليس هذا فحسب، بل إنّ الوجود العسكري الأمريكي
الراهن في كولومبيا، ومعونات أمريكية تتجاوز 3.5 مليار دولار، فضلاً عن
مئات العسكريين الأمريكيين المرابطين، تكفلت بنقل البلد إلى المرتبة
الثالثة في ترتيب الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية. وبالطبع،
ليس من جديد في القول إنّ الهدف الرئيسي للوجود العسكري الأمريكي إنما
ينحصر في حماية خطّ أنابيب البترول التابع لشركة «أوكسدنتال بتروليوم»
في قلب منطقة أروكا النفطية.
كولومبيا بلد شهد حرباً أهلية طاحنة تجاوز عمرها نصف قرن، وذهبت بأرواح
أكثر من 53 ألف قتيل، وانخرط فيها عشرات الآلاف من أعضاء الميليشيات
يميناً ويساراً. لكنّ البيت الأبيض، وبصرف النظر عن هوية شاغله الأوّل
وما إذا كان جمهورياً أم ديمقراطياً، اعتاد اختصار هذا الاحتشاد المعقد
إلى مجرّد حرب أمريكية ضدّ المخدرات.
والاختزال ينطوي، بالطبع، على طمس الحقائق السياسية والاجتماعية وراء
تلك الحرب الأهلية، وكيف أنّ الجوهريّ فيها هو مصادرة أراضي مئات
الآلاف من الفلاحين، وطردهم من مئات القرى على امتداد ثلاثة عقود؛
الأمر الذي أطلق شرارة عصيان شعبي تزعمته «جبهة القوات المسلحة الثورية
الكولومبية» أو الـ
FARC.
الحقيقة، في المقابل، تشير إلى أنّ زمرة عسكرية مهيمنة هي التي تسهّل
زراعة المخدرات وتصنيعها والاتجار بها، لأنها شريكة مباشرة في الـ
«بزنس» بل هي الشريك الأوّل الذي لا غنى عنه. وفي عام 1998، لتقديم
مثال مضحكٍ ـ مبكٍ، هبطت طائرة رئيس أركان سلاح الجوّ الكولومبي في
مطار ميامي (أي في الولايات المتحدة، للتذكير!) وشاءت الصدفة وحدها أن
تُكتشف على متن الطائرة الرسمية كمية من الكوكايين لا تقلّ عن… نصف طن!
وثمة سابقة تفيد بأنّ الرئيس الكولومبي الأسبق أندريس باسترانا كان قد
سارع إلى فتح حوار مع جبهة الـ
FARC،
رافضاً التصنيف الأمريكي الذي يضعها في خانة عصابة مخدرات، ومعتبراً
أنها حركة ثورية ذات مطالب سياسية واجتماعية. فمَن الذي فرمل الحوار
سوى الولايات المتحدة، سواء عن طريق الضغط المباشر على الرئيس، أو عن
طريق تحريض الطغمة العسكرية على تصعيد العمليات العسكرية ضد الـ
FARC
بالتزامن مع إطلاق مفاوضات السلام، أو ــ أخيراً ــ عن طريق الزيادة
الدراماتيكية في حجم ونوعية المساعدات العسكرية الأمريكية ورفع تلك
المساعدات إلى مستوى التدخل العسكري.
اليسار الكولومبي يتقدم، وإذا فازت بطاقة بيترو ـ ماركيز في انتخابات
الإعادة، فإنّ معطيات كثيرة سوف تتبدّل في قلب المجتمع والدولة،
والأرجح أنها سوف تعبر الحدود إلى أكثر من جوار واحد أمريكي لاتيني؛
ولا يغيّر من هذه الحال أنّ مناهج البيت الأبيض سوف تبقى جامدة
متماثلة، لا تحول ولا تزول.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
بندقية اليانكي
وأشلاء التعديل الثاني
صبحي حديدي
الراغب في الاطلاع على أبحاث جدية معمقة تتناول ظواهر إطلاق النار
العشوائي على التجمعات البشرية في أمريكا، حيث تستوي المدرسة والكنيسة
والمتجر؛ لن تفوته أنساق التشابه الهائل في الأسئلة المطروحة، ومثلها
التطابق المدهش في الإجابات، وكيف تنتهي هذه وتلك إلى استعصاء مذهل في
تلمّس الحلول. الحصيلة بأسرها، في ابتداء إشكالياتها مثل بلوغها العجز
والعطالة، لا تغادر بندَين اثنين؛ على ما يفرّق بينهما أو يجمع، وكيف
تسفر هذه الحال عن نتيجة صاعقة: توافق التناقض وتصالح التنافر.
البند الأوّل هو التعديل الثاني على دستور الولايات المتحدة، الذي يعود
إلى أواخر 1791 ويحمي حقّ المواطن الأمريكي في حيازة الأسلحة بقصد
الدفاع عن النفس؛ والذي يواصل الصمود في وجه عشرات حوادث القتل
المأساوية الناجمة عن سهولة التسلّح، وضدّ محاولات شتى لتعديله أمام
المحكمة العليا أو التضييق على اقتناء الأسلحة قياساً على السنّ أو
السجل العدلي أو الحالة النفسية.
وأمّا البند الثاني فهو «الرابطة الوطنية للبندقية»، ويعود تأسيسها إلى
سنة 1871، وتفاخر بعضوية سبعة من رؤساء أمريكا (ثيودور روزفلت، وليام
تافت، دوايت أيزنهاور، جون كنيدي، ريشارد نكسون، رونالد ريغان، جورج
بوش الأب، ودونالد ترامب). إنها بين أقوى مجموعات الضغط في أمريكا،
وتزعم كتلة من خمسة ملايين منتسب، ويندر أن يسلم من نفوذها عضو في مجلس
الشيوخ أو النوّاب، خاصة في صفوف الحزب الجمهوري. والمعادلة بسيطة
هكذا: إمّا أن يقاوم التعديل الثاني، فتواصل الانتعاش تجارة بيع السلاح
إلى العموم؛ وإمّا أن يتعدّل التعديل أو حتى تُعاد صياغته، فتغلق
أبوابها متاجرُ المسدسات والرشاشات الخفيفة منها والثقيلة.
لا فارق عند هؤلاء بين تمزيق أشلاء التعديل الثاني وتقديس بندقية اليانكي، بل قد يكون التماهي بين الدماء والرصاص هو الراية المشتهاة، الأحبّ والأعلى
وأفضل المجلدات التي تتناول الظاهرة لا تغفل مناقشة أسئلة مثل: هل
حوادث القتل العشوائية الجماعية مشكلة جدية، ولا غرابة في طرح السؤال
هكذا، إذْ ثمة من يقول (وأشهرهم اليوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد
ترامب وعضو مجلس الشيوخ الحالي تيد كروز) إنها ليست مشكلة على الإطلاق؛
وهل وضع القيود على اقتناء الأسلحة يمكن أن يخفّض حوادث القتل تلك، أم
لا تأثير لأيّ إجراءات تقييدية؛ وهل ألعاب الفيديو التي تُدرج العنف
المفتوح بالسلاح ذات أثر، أم أنّ ثقافة العنف العريضة هي الأصل؛ وهل
تلعب حالات الاعتلال النفسي دوراً مباشراً في تغذية حوافز العنف، أم
أنّ الصلة غائبة؛ وأخيراً، وليس آخراً أغلب الظنّ، أليست ثقافة العنف
ضاربة الأطناب في بنية نفسية أمريكية مستقرّة ومتجذرة، لم يبدأها راعي
البقر وحده ولم تنحسر مع مذابح الجيش الأمريكي في فييتنام ثمّ ضدّ شعوب
أخرى عديدة؟
وثمة قاسم مشترك بين العديد من حوادث القتل هذه يؤكد انطلاقها من دوافع
التمييز العنصري وكراهية الآخر وما بات يُسمّى «المركزية البيضاء»؛ كما
في إطلاق النار الذي شهده مخزن بوفالو، نيويورك، مطلع هذا الشهر؛ حيث
كان القاتل قد وضع على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي «مانيفستو» من 180
صفحة يبشّر فيه بالتفوّق الأبيض، ويحذّر من سود ساعين إلى استبدال
البيض، ويسوق سلسلة أفكار حول تدنّي تكوينهم الخَلْقي وأنّ جيناتهم
مسؤولة عن ميلهم إلى الجريمة، كما يحضّ على رفض اللاجئين لأنهم بمثابة
«غزو» منظّم يجتاح أمريكا. وهذا القاتل لم يكن يتجاوز الـ18 سنة،
والسلاح الذي استخدمه كان هدية قدّمها له والده في مــناسبة عيــد
الميلاد.
وليست سمة عجيبة، قياساً على هذه الحال من التعبّد للبندقية والسلاح
الناري الثقيل، أن يكون مستوى قادة «الرابطة الوطنية للبندقية» ضحلاً
غالباً وهابطاً أقرب إلى الجهل؛ كما في المثال الذي قد يظلّ الأبرز:
الممثل الشهير شارلتون هستون، الذي تولى رئاسة الرابطة خلال أعوام 1998
وحتى 2003، واعتاد أن يختم خطابه في كلّ مؤتمر برفع بندقية والهتاف: لن
تُنتزع إلا من أصابع باردة قتيلة! وذات يوم، في سنة 2001، وخلال
المحاضرة الافتتاحية لمركز الآداب الآسيوية والأفريقية في جامعة
SOAS
البريطانية؛ تحدّث الراحل إدوارد سعيد عن ظاهرة الجهل التي تعمّ
المجتمع الأمريكي، صغاره وكباره.
ولقد ضرب المثل الأوّل في يافع لا يعرف أين تقع إيطاليا، على خريطة
العالم؛ والمثل الثاني في شيخ (وأيّ شيخ!) عجز عن تسمية دولة واحدة
تشترك في الحدود مع العراق، إذْ قال بعد تردّد: روسيا، ربما؟ كان هستون
هو صاحب الحدود المشتركة بين العراق وروسيا، وكان أيضاً من أشدّ
المتحمسين لاجتياح بغداد، هو ذاته الذي لعب دور موسى في الفيلم الشهير
«الوصايا العشر»، جاهلاً أنّ بلاد الرافدين هي نفسها العراق الحديث.
وقد تكون المصادفة وحدها وراء انعقاد المؤتمر السنوي لـ»الرابطة
الوطنية للبندقية» في هوستون، تكساس، بعد أيام على مجزرتَيْ بوفالو
ومدرسة يوفالدي، في سنة شهدت حتى الساعة 213 واقعة إطلاق نار عشوائية
جماعية؛ غير أنّ الصدفة لا صلة لها البتة بحضور أسماء مثل ترامب،
والسناتور عن تكساس كروز، وحاكمة ساوث داكوتا كريستي نويم، وحاكم نورث
كارولاينا مارك روبنسون… لا فارق عند هؤلاء بين تمزيق أشلاء التعديل
الثاني وتقديس بندقية اليانكي، بل قد يكون التماهي بين الدماء والرصاص
هو الراية المشتهاة، الأحبّ والأعلى.
فرنسا ومبضع «ميديابارت»:
النكش مقابل الطمر
صبحي حديدي
حكومة إليزابيث بورن الجديدة، التي عيّنها الرئيس الفرنسي إمانويل
ماكرون بعد إعادة انتخابه، لم تتلقَّ ضربة الإرباك النجلاء الأولى من
أيّ أطراف المعارضة، وهم كثر: لا من تجمّع اليسار الذي بات يقوده جان ـ
لوك ملنشون ويطمع في حيازة أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية،
الشهر المقبل؛ ولا من مارين لوبين، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني
المتشدد ومنافسة ماكرون الفاشلة في الانتخابات الأخيرة؛ ولا من اليمين
الديغولي، الذي يلعق جراح هزيمة نكراء ويعاني من التشرذم واحتمالات
التفكك؛ ولا من مجموعات الخضر المختلفة، غير المنضوية في ائتلاف
ملنشون؛ ولا حتى من التجمعات التروتسكية، على تباين خطوطها وبرامجها.
هذه كلها لم تتأخر البتة في معارضة حكومة بورن، بالطبع، كلّ على طريقته
وأسلوبه وأجنداته؛ وتفاوتت الحملات بين استهداف الشخوص، بورن نفسها
ورئيسها ماكرون وهذه أو هذا من الوزيرات والوزراء؛ أو نبش دفاتر الماضي
عند مَن غادروا القوارب الموشكة على الغرق للالتحاق بركب ماكرون، أو
عند من يحمل بشرة غير بيضاء وغير شقراء، وسوداء أو سمراء، لأنه أيضاً
سليل مستعمرات فرنسية سابقة أو حامل أفكار «ما بعد استعمارية» تراجع
الصفحات الأبغض في تاريخ فرنسا…
لكنّ الضربة النجلاء، ولعلّ الصفة هذه تليق تماماً بالموصوف، جاءت من
موقع «ميديابارت» الإخباري الإلكتروني المستقلّ، ضمن تقرير صاعق عن
داميان أباد وزير التضامن وشؤون المعاقين المعيّن لتوّه في حكومة بورن،
والملتحق بصفوف توليفة ماكرون قادماً من حزب «الجمهوريين» الذي يزعم
الانتماء إلى اليمين التقليدي كما تولاه في الجمهورية الخامسة أمثال
شارل ديغول وجاك شيراك ونيكولا ساركوزي. التقرير نقل تفاصيل أوردتها
امرأتان اتهمتا أباد بإجبارهما على إقامة علاقات جنسية، سنة 2010
و2011، وذكرت إحداهما أنها تقدمت بشكوى إلى الشرطة، ولكن تمّ حفظها ولم
تقترن بإجراءات تحقيق معتادة؛ وأمّا السبب في خروج الضحيتين إلى العلن
اليوم فهو الإعراب عن الاحتجاج إزاء تسمية أباد في منصب جمهوري رفيع،
بما يعني مكافأته أو تكريمه. الوزير سارع إلى النفي التامّ والقطعي،
مشيراً كذلك إلى أنه (هو المعاق المصاب بمرض اعوجاج المفاصل) عاجز
فيزيولوجياً عن ممارسة الفعل الجنسي من دون مساعدة شريكته.
ردّ فعل الحكومة كان ذكياً ومنطقياً كما يصحّ القول، إذْ أعلنت بورن
أنها لم تكن على علم بالواقعة ولا بالشكوى عند تسمية أباد، والحكومة
تشجع جميع النساء ضحايا الاعتداءات المماثلة على كسر الصمت ولسوف
يُستمع إليهنّ بالتأكيد، كما أنّ القضاء هو وحده الجهة المخوّلة
والملزَمة بالتحقيق وتبيان الحقائق، والوزير في نهاية المطاف يتمتع مثل
أيّ مواطن فرنسي بالقاعدة القانونية التي تقول إنّ المتهم بريء حتى
تثبت إدانته. لكنّ الضرر كان قد وقع، على مستويات متعددة ولدى الأطراف
المتربصة كافة: منتقدو قصر الإليزيه، الذين اتهموا ماكرون وفريق
مستشاريه بإخفاء الواقعة عن رئيسة الحكومة، أو حتى خداعها وتضليلها؛
و«الجمهوريون» الذين سبق لإحدى الضحيتين أن كاتبتهم مشتكية على أباد
حين كان يتزعم كتلتهم النيابية فلم يردوا عليها، وجدوا سانحة للثأر منه
لأنه غادر صفوفهم؛ وملنشون جاءته الفضيحة على طبق من ذهب، فانقضّ على
رئيسة حكومة يحلم بأن يحلّ محلها مطلع تموز (يوليو) المقبل؛ ولوبين لا
تحتاج أصلاً إلى ذريعة كي تشتم الجميع، بلا استثناء.
وهذا الضرر الذي لحق بالحكومة الجديدة، والأحرى التذكير بأنه أصاب
ماكرون نفسه أوّلاً وربما قبل بورن وأكثر منها، يسجّل لموقع «ميديابات»
المستقل ضربة معلّم جديدة بارعة، تُضاف إلى سجلّ عريق من كشف سلسلة من
الفضائح المالية والسياسية والأخلاقية؛ الأحدث بينها كانت تورّط الرئيس
الفرنسي الأسبق ساركوزي مع دكتاتور ليبيا معمّر القذافي؛ والأخرى
المسماة «فضيحة بيغماليون» التي انطوت على استعانة ساركوزي بشركة
علاقات عامة لتزوير فواتير وحسابات تتجاوز سقف النفقات المحددة في
الحملات الانتخابية؛ وفضيحة فرنسوا فيون بصدد شبهات إهدار المال العام
ومنح زوجته امتيازات مالية، وهي التي قوّضت آماله في الترشح لرئاسة
فرنسا؛ وفضيحة ألكسندر بينالا المستشار الأمني المقرّب من ماكرون، في
اعتدائه على متظاهرين وفي إبرام عقود مع مستثمر روسي مثير للجدل؛
وسواها فضائح أخرى كثيرة.
وقبل قرابة عقد، وعلى امتداد أربعة أشهر ونيف، ظلّ موقع «ميديابارت»
يلحّ، ويقدّم الدليل تلو الدليل، على أنّ وزير الموازنة الفرنسي
يومذاك، جيروم كاوزاك، كان خلال سنوات طويلة يمتلك حساباً مصرفياً
سرّياً في سويسرا، هدفه التهرّب من الضرائب؛ ثم أغلقه سنة 2010، ونقل
ودائعه إلى مصرف في سنغافورة. وخلال الأشهر ذاتها ظلّ كاوزاك ينكر
ويكذّب، أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان والصحافة؛ وتضامن
معه عدد من زملائه الوزراء، وأصدقائه في «الحزب الاشتراكي» الفرنسي؛
كما تعاطف معه عدد من الصحف والصحافيين، ممّن وجدوا أنّ «ميديابارت»
تغالي في طرائقها.
وحين أخذ التحقيق القضائي الرسمي، في فرنسا وسويسرا، يطبق الخناق على
كاوزاك، اضطرّ إلى تقديم استقالته من الوزارة، أوّلاً؛ ثم لم يجد
مفراً، في نهاية المطاف، من التقدّم إلى القضاء بنفسه، والاعتراف أنه
بالفعل كان يمتلك ذلك الحساب.
وإذا كانت تلك القضية مجرد ملفّ يُضاف إلى عشرات ملفات الفساد، هنا
وهناك في العالم؛ فإنها، في جانب جوهري آخر، تخصّ سلطة الصحافة عموماً،
وصحافة التحقيق خصوصاً، في الديمقراطيات الغربية. وبين دروسها البليغة
أنّ ابن المهنة، الصحافي ذاته، يمكن أن يكيل بمكيالين في الحكم على
مادّة تحقيق محرجة أو متفجرة: يعارض، سياسياً وإيديولوجياً، الوزير
كاوزاك ولحزبه؛ ولكنه «يستهجن» المضيّ أبعد مما ينبغي في نشر الغسيل
القذر، للشخص ذاته. ولم تكن مصادفة أنّ «ميديابارت» كانت المبضع الذي
تجاسر على تشريح القضية، لأنها أوّلاً ليست موقعاً مستقلاً فقط، بل هي
أيضاً «منشقّة» عن تقاليد التيار العريض لمؤسسات الصحافة الفرنسية.
وكان إدفي بلينل، مدير الموقع، قد أطلقه في سنة 2008، بعد أن استقال من
رئاسة تحرير صحيفة «لوموند» العريقة بسبب خلاف تحريري وسياسي مع كبار
مالكي الأسهم فيها. ولأنّ اشتراكات القراء هي وسيلة التمويل الوحيدة،
تمكن الموقع من حيازة هامش حرّية واسعاً في فتح ملفات الفساد بصفة
خاصة.
وفي عام 1906 كان ثيودور روزفلت، الرئيس الأمريكي السادس والعشرون، قد
نحت عبارة طريفة، فظّة بعض الشيء، في وصف طراز خاص من الكتابة
الصحافية: «النكش في الطين «
Muckraking؛
أو، بمعنى أدقّ: تقليب القاذورات، وإظهار ما هو مستور من أوساخ وقبائح.
واستمد روزفلت ذلك التوصيف من شخصية حامل المِدَمّة، أداة تسوية العشب
وتقليب التربة والسماد، في رواية الإنكليزي جون بنيان «رحلة الحاج»
1678؛ فقال: «إنه رجل ليس في وسعه أن ينظر إلا إلى أسفل، والمِدَمّة في
يده؛ وقد بُورك بتاجٍ سماويّ لكنه لم يكترث حتى بإبصار التاج، وظلّ
يشغل نفسه بنكش القاذورات في الأسفل». والحياة، وتطوّر تقاليد الكتابة
الصحافية وأخلاقياتها، تكفلت بتطهير التعبير من مضمونه السلبي الفظّ،
وبات على العكس صفة حميدة لذلك الصحافي ـ المحقق، الذي يكشف أستار قضية
سياسية أو اجتماعية أو مالية تمّ إخفاؤها عن المجتمع، بتواطؤ من هذه
السلطة أو تلك.
محزن، بالطبع، أنّ هذه التقاليد الاستقصائية غير شائعة، حتى ضمن حدودها
الدنيا، في صحافة العالم العربي؛ ليس بسبب الافتقار إلى صحافيين حاملي
مدمّات، أغلب الظنّ، بل لأن شيمة غالبية وسائل الإعلام العربية هي
الطَمْر وليس النكش!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
آل مبارك بعد رفعت الأسد:
القضاء الأوروبي والمعضلة الكافكاوية
صبحي حديدي
قد تكون الفوارق عديدة، في الكمّ
كما في النوع، بين نجاح مجرم حرب مثل رفعت الأسد في مغادرة الأراضي
الفرنسية وكأنه سائح طيب بريء نظيف اليد، رغم مساءلات قضائية جدّية
وملموسة كانت تفترض التحفظ عليه ومنعه من السفر؛ وبين نجاح تماسيح فساد
وأبناء استبداد مثل جمال وعلاء مبارك، في تبرئة ساحتهما من كلّ سوء
أمام القضاء الأوروبي، مؤخراً. والأرجح أنّ القواسم المشتركة بين
الملفين ليست أية نظرية مؤامرة حول فساد القضاء في الحالتين، أو تواطؤ
القضاة مع أجهزة سياسية وأمنية عليا في فرنسا أو سويسرا أو الاتحاد
الأوروبي؛ فالمنطق، وحيثيات وقائع مختلفة مترامية الأطراف والمحتويات،
تحثّ على استبعاد فرضيات كهذه، من دون أن تنفيها قطعياً غنيّ عن القول.
وقد يتوفر قاضٍ فرنسي يساجل (بعد أن يشترط إغفال اسمه، بالطبع) أنّ
الأسد كان بالفعل قيد المحاكمة في قضايا عديدة، لكنّ أياً منها لم
يقترن بإجراء قانوني يمنعه من مغادرة فرنسا، أو يصادر جواز سفره مثلاً
(والنكتة، هنا، أن يحمل جواز سفر واحداً يتيماً، وهو شقيق حافظ الأسد
وعمّ بشار الأسد والقائد السابق لوحدات «سرايا الدفاع» الأشدّ بطشاً،
وأحد أكثر مرتكبي مجزرة حماة 1982 دموية وهمجية وتعطشاً للدماء). وليس
مستبعداً أن يتوفر قاضٍ سويسري يتذرّع بأنّ ما امتلكه المدعي العام
الفدرالي السويسري من وثائق وأدلة لم تكن تكفي لإدانة سوزان وجمال
وعلاء مبارك؛ وليس مبدأ استغلال النفوذ، الصريح الواضح المتوفر لدى
أسرة حسني مبارك، وثيقة في ذاتها لأنّ أيّ حكم قضائي استناداً إليها لن
يصمد أمام أبسط طعن أو استئناف.
كلا القاضيَيْن هلى حقّ بالمعنى القانوني، يتوجب القول، وليس لقاضٍ
أوروبي أن يحكم اعتماداً على ضمير تلقائي يدفعه إلى اليقين بأنّ أمثال
رفعت وجمال وعلاء يستحقون الإدانة؛ وليس له، على قدم المساواة، أن
يستنبط أو يبتكر أو حتى يخترع أيّ عدد من الوثائق والأدلة التي قد
تساعده في تحكيم ذلك الضمير والنطق بالإدانة. وهذه بامتياز حال
كافكاوية، نسبة إلى فرانز كافكا وعمله الشهير «المحاكمة» حيث دهاليز
المحاكم وأقواسها ليست أقلّ من متاهات عويصة، تخصّ المصير والوجود قبل
القوانين والحدود. وما خلا تلك السراديب الكافكاوية، ما الذي حال دون
صدور قرار من القضاء الفرنسي يمنع الأسد من السفر، أو حجب عن المدعي
العام السويسري الحقّ في إلزام الحكومة المصرية بتوفير أيّ وكلّ وثيقة
يحتاجها القاضي لإدانة آل مبارك؟
وفي تنزيه القضاء الفرنسي من التواطؤ أو الخضوع لسلطات سياسية أو
أمنية، يُشار إلى أنّ المحكمة أخذت بما كان قد أوصى به ممثلو الادعاء
العام بحقّ الأسد، في الاتهامات بغسل الأموال المنظم والاحتيال الضريبي
والكسب غير المشروع واختلاس أموال الدولة السورية وبناء إمبراطورية
عقارية في فرنسا قيمتها نحو 90 مليون يورو، فحُكم عليه بالسجن أربع
سنوات، وسداد غرامة بقيمة 10 ملايين يورو. في المقابل، ليس أقلّ نزاهة
الافتراض بأنّ القضاة الذين أصدروا الحكم كانوا على جهل، في كثير أو
قليل، بما توفّر لعموم المواطنين الفرنسيين من معلومات متاحة علانية،
وردت في كتب ومذكرات منشورة.
نعرف، كما القضاة عرفوا، أنّ 36 سنة من إقامة الأسد في كنف القوانين
والأنظمة الأوروبية، بين سويسرا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا ولوكسمبورغ،
بدأت من علاقة وطيدة مع الأجهزة الأمنية في فرنسا بصفة خاصة، وهذه
باشرت التنسيق معه منذ الأيام الأولى التي أعقبت وصوله إلى سويسرا، حين
زاره في جنيف فرنسوا دوغروسوفر «رجل الظلّ» والمهمات الخاصة في قصر
الإليزيه، موفداً خاصاً من الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتيران،
حاملاً دعوة للانتقال إلى فرنسا والإقامة فيها. المحطة التالية كانت
تقليده وسام الشرف برتبة فارس (بسبب «تقديم خدمات إلى الأمّة»!) على
نقيض من يقين الاستخبارات الفرنسية بأنه كان على صلة بقرار اغتيال
السفير الفرنسي في بيروت لوي دولامار، خريف 1981.
المؤسسة العسكرية التي تحكم مصر منذ سنة 1952 يمكن أن تقدّم مشيراً ما، قابعاً اليوم في الظلّ، ينتظر ساعة الانقضاض. وليس مستبعداً أن يكون آل مبارك على مبعدة منظورة من هذه النقلة، إذا لم يكونوا في قلبها، وبعض صنّاعها
فهل كانت تلك الملابسات، إذا جازت
تسميتها هكذا، كافية للامتناع عن إصدار قرار قضائي بالتحفظ عليه ومنعه
من مغادرة الأراضي الفرنسية؟ بالمعنى الكافكاوي يمكن للإجابة أن تعتمد
هذا الاعتبار، ويمكن لها ألا تعتمد أيّ اعتبار؛ إذْ الأصل في المعادلة
أنّ الأسد غادر مثل أيّ زائر سائح نظيف اليد بريء الساحة.
عالية التماثل، أياً كانت الاختلافات والتمايزات، ظلت علاقات آل مبارك
الاقتصادية والمالية والاستثمارية والمصرفية مع أوروبا والولايات
المتحدة وجُزُر الأمان الضريبي هنا وهناك في العالم؛ لأنها إنما تبدأ
من موقع الأب حسني مبارك في رئاسة مصر، بما تعنيه عربياً وإسرائيلياً
وإقليمياً ودولياً، وتمرّ استطراداً بما كانت الديمقراطيات الغربية،
وما تزال، تفرده للطغاة وساسة الاستبداد والفساد، تحت مسمى «الحفاظ على
الاستقرار»؛ وليس لها أن تنتهي عند المغانم التي تكسبها جراء هذه
«الصداقة» مصارفُ وصناعات سلاح واستثمارات ذات عيار ثقيل في أوروبا.
فهل من عرق جبين جمال وعلاء أنهما يستردان اليوم مبلغ 400 مليون فرنك
سويسري (429 مليون دولار) كان الادعاء العام السويسري قد جمدها؟
وهذه، وسواها، عناصر تتكئ أصلاً على حقيقة أنّ انقلاب عبد الفتاح
السيسي ليس معادياً لآل مبارك، ولا للفساد والاستبداد استطراداً؛ ولهذا
فالمحاكمة الوحيدة التي خسرها آل مبارك كانت قضية القصور الرئاسية،
وتلك تمت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. ولم يكن عسيراً على أجهزة
السيسي، لو شاءت إلحاق الأذى بآل مبارك، أن ترسل إلى القضاء السويسري
والمحكمة العامة الأوروبية ملفات شركة «العاشر من رمضان للإنشاءات»
التي كان جهاز الكسب غير المشروع المصري يحقق فيها، ويسندها بلاغ رسمي
من النائب العام وتقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات. صحيح أنّ القضاء
المصري نظر في الملف، غير أنّ إحالته إلى قضاء أوروبي كان من المتوقع
أن يتخذ وجهة أخرى أكثر جدّية ورصانة.
وإذا كان مستقبل رفعت الأسد في سوريا لا ينذر بالكثير، ما خلا المزيد
من الاستثمارات في أعمال المافيا ذاتها التي كدّست ثرواته داخل سوريا
وخارجها؛ فإنّ مستقبل جمال مبارك في حياة مصر لا يبدو بالضآلة ذاتها،
خاصة بعد استقباله من رئيس الإمارات محمد بن زايد تحت ذريعة تقديم
العزاء. وقد يؤخذ في الاعتبار أيضاً واقع النوستالجيا إلى عهد مبارك
لدى بعض أبناء مصر، سواء على سبيل التذمر من نظام السيسي أو ضمن انحياز
بعض شرائح الطبقة الوسطى إلى منظومة سالفة اختلطت فيها برامج جمال عبد
الناصر وأنور السادات ومبارك نفسه. وكما خال بعض المصريين أنّ السيسي
هو المهرب من الإخوان المسلمين، قد يقع أولئك أنفسهم، ومعهم فئات
جديدة، في الاستيهام ذاته: الفرار من السيسي بالرجوع إلى آل مبارك!
ولأنّ المؤسسة العسكرية هي التي تحكم مصر منذ سنة 1952، ولم تُكسر هذه
القاعدة جوهرياً حتى خلال الفترة القصيرة التي شهدت رئاسة محمد مرسي؛
فإنّها، مثلما قدّمت محمد نجيب وعبد الناصر والسادات ومبارك ومحمد حسين
طنطاوي والسيسي، يمكن أن تقدّم مشيراً ما، قابعاً اليوم في الظلّ،
ينتظر ساعة الانقضاض عبر انقلاب يسوق الذرائع ذاتها التي اعتُمدت، أو
تمّ تلفيق بعضها، خلال مليونيات تموز (يوليو) 2013. وليس مستبعداً أن
يكون آل مبارك على مبعدة منظورة من هذه النقلة، إذا لم يكونوا في
قلبها، وبعض صنّاعها.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
الأسد في طهران: مأساة
الشنكليش وملهاة المعكرونة
صبحي حديدي
توجّب الاستماع إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده سعيد خطيب زادة، الناطق
باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وقراءة تقرير صحيفة
Tehran Times
بالإنكليزية؛ كي تُتاح للمرء فرصة أفضل للوقوف على تصريحات رئيس النظام
السوري بشار الأسد خلال لقائه مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي
خامنئي؛ ضمن برنامج الزيارة الأخيرة الخاطفة، غير المعلن عنها مسبقاً،
التي قام بها الأسد إلى طهران مؤخراً. بين «الدرّ الثمين» الذي نطق به
الأخير هذا المثال الأوّل: «مقاومة إيران وموقفها الثابت على امتداد
العقود الأربعة الأخيرة في المسائل الإقليمية، وخاصة مسألة فلسطين،
أظهرت لشعوب المنطقة قاطبة أن الدرب الذي سلكته إيران هو الدرب الصحيح
المستند إلى المبادئ». «درّة» ثانية سارت هكذا: «يعتقد بعض الناس أنّ
دعم إيران لجبهة المقاومة يعني الدعم بالسلاح. لكنّ المساندة والمساعدة
الأشدّ أهمية هي نفخ روح المقاومة في المنطقة ومواصلة القيام بهذا».
وأمّا النموذج الثالث، التالي، فلعلّه صاحب السبق في الضلال والتضليل
وإضافة الإهانة إلى جراح الملايين من أبناء سوريا وفلسطين وإيران في آن
معاً: «الدمار الذي أحدثته الحرب يمكن إعادة بنائه، ولكن لو دُمّرت
الأسس والمبادئ فهذه لا يمكن إعادة بنائها. ومقاومة الأمّة الإيرانية
على أساس الركائز والمبادئ التي أقامها الإمام الخميني، وتواصلت مع
جهود سيادتكم، تعبّد الطريق إلى انتصارات الأمّة الإيرانية وشعوب
المنطقة، خاصة الشعب الفلسطيني».
المرشد الأعلى، من جانبه، لم يفوّت الفرصة لممارسة الطراز الخاصّ به من
تنافخ لا يتوسل سوى التضليل، فأثنى على الدور الشخصي الذي لعبه الأسد
لضمان «انتصار سوريا في الحرب الدولية» التي شُنّت عليها؛ بحيث بات
«رئيس البلد وشعب سوريا محطّ تشريف حقيقي في أنظار أمم المنطقة». وإذْ
غمز من قناة «رؤساء بعض البلدان المجاورة الذين يتلقون مع قادة النظام
الصهيوني ويحتسون القهوة معهم» تناسى خامنئي أنّ الأسد الجالس إلى
يساره احتسى القهوة مع أحد هؤلاء، محمد بن زايد، قبل أسابيع معدودات
فقط؛ ولا يغيّر من الحال أنّ الفناجين الإماراتية قُدّمت في مرآب، وليس
في قصر منيف. وضمن إطراء «الشهيد» قاسم سليماني، حرص خامنئي على ربط
سلال النفوذ الإيراني، وحروب طهران الأسبق والأوسع في المنطقة، فاستذكر
أنّ «حماس الشهيد في سوريا لم يختلف عن نهجه خلال ثماني سنوات من دفاع
إيران المقدس» في إشارة إلى الحرب العراقية -الإيرانية.
وخلال المؤتمر الصحافي المشار إليه أعلاه، لم يُطرح على خطيب زادة أيّ
سؤال يخصّ الـ«معكرونة غيت» أو الفضيحة التي باتت تُنسب إلى الرئيس
الإيراني إبراهيم رئيسي، على خلفية الارتفاع الخرافي في أسعار الأكلة
الشعبية الإيرانية، والارتفاع المماثل في أسعار الخبز؛ بتأثير أوّل
مباشر هو خفض الدعم الحكومي عن الدقيق المستورد، الذي لا علاقة له بما
تشيعه السلطة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد الغزو الروسي في
أوكرانيا. انتقاد سياسات رئيسي في هذا الملف جاء من جهات متعددة
الأغراض والمواقع، كما في رأي عبد الناصر همتي الرئيس السابق للبنك
المركزي ومنافس رئيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الذي اعتبر أن
خطط الرئيس لن تخفف أي عبء عن ذوي الدخل المحدود؛ أو الانتقاد، اللافت
تماماً، الذي خرج به قائد وحدة الفضاء الإلكتروني لمنظمة الباسيج
الاستخباراتية (مالكة الاسم الرسمي»قوّات تعبئة الفقراء والمستضعفين»)
الذي اتهم رئيسي بالانشغال عن قضايا الشعب والتفرّغ لتفكيك شبكات
التهريب التابعة للرئيس السابق حسن روحاني!
خامنئي لم يفاتح ضيفه/ تابعه الأسد حول الـ«معكرونة غيت» مثلاً بعد أن حدّثه عن قهوة الصهاينة، لا لشيء إلا لأنّ الأسد آت وهو محمّل بمئات الفضائح الغذائية والمعاشية التي تطحن حياة السوريين اليومية
والصلات الوثيقة بين مشكلات الشعب الإيراني المعيشية وسياسة التدخل
الإيراني المباشر في سوريا، بما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية في
المقام الأوّل؛ ليست البتة جديدة، وهي تحتلّ مكانة الصدارة في أحاديث
الإيرانيين اليومية، لأنها في الآن ذاته تحظى بموقع متقدّم في برامج
الساسة قبل آيات الله. والأمر يمكن أن يبدأ من القلق على مصير النظام
السوري، ويمرّ إلى ضرورات مساندة «حزب الله» المتورط في قتال مباشر مع
نظام الأسد، ولا ينتهي عند مباركة الحملات المحمومة والهستيرية الداعية
إلى تطويع الإيرانيين للذهاب إلى سوريا والدفاع عن المقامات الشيعية
هناك. وأياً كان المبتدأ والمنتهى، فإنّ عناصر مثل رغيف الخبز اليومي
الإيراني، على شاكلة ربطة المعكرونة هذه الأيام، يصعب أن تغيب عن هذا
المشهد من جهة أولى؛ ويندر، من جهة ثانية، أنها لا تخلّف عواقب حساسة
وجسيمة وبعيدة الأثر.
وليست بعيدة في الزمن مواقف الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي في
التحذير من «تشويه أفكار الإمام الخميني» واتهام السلطات الايرانية
بـ«تصدير» العنف الى بلدان أخرى (في غمز من مفهوم «تصدير الثورة»
الشهير)؛ وكذلك اقتراح تأويل مضادّ للمعنى الذي قصده الإمام الخميني من
المصطلح: «هل نحمل السلاح ونتسبب بانفجارات في بلدان أخرى؟ هل نشكّل
مجموعات للقيام بعمليات تخريب في بلدان أخرى؟ الإمام كان يعارض بشدّة
أعمال الإرهاب ويدعو في المقابل إلى نموذج يقوم على وضع اقتصادي جيد،
واحترام البشر، ومجتمع يتجه الى الرخاء وتحسين ظروف الجميع». يومذاك
كانت ردود الفعل الرسمية، أو شبه الرسمية، قد بلغت شأو الدعوة إلى
«محاسبة» خاتمي على تصريحاته «غير الوطنية» التي «لا ينجم عنها سوى
تلطيخ سمعة الجمهورية الإسلامية وتأكيد اتهامات لا أساس لها يطلقها
الاستكبار العالمي» كما قالت صحيفة «كيهان» الناطقة باسم المرشد
الأعلى.
وذات يوم غير بعيد بدوره اشتدّ التأزّم بين الرئيس الإيراني الأسبق
محمود أحمدي نجاد وعدد من كبار البرلمانيين المحافظين، على خلفية
سياساته الاقتصادية، وازدياد معدّلات التضخم، وانخفاض قيمة الريال
الإيراني؛ فانقلب إلى تجاذبات عقائدية تمسّ بعض أقدس مبادئ الفقه
الشيعي، فوضعت نجاد في مواجهة مع بعض آيات الله وحجج الإسلام، حول
أقواله بأنّ «يد الله سوف تظهر وترفع الظلم عن العالم» وأنّ «أعداء
إيران يعلمون أنّ عودة المهدي الغائب حتمية». يومها اعتبر حجّة الإسلام
علي أصغري أنّ «من الأفضل لأحمدي نجاد الاهتمام بمشاكل المجتمع مثل
التضخم»؛ وتهكم حجة الإسلام غلام رضا مصباحي هكذا» «إذا كان نجاد يريد
أن يقول إنّ الإمام الغائب يدعم قرارات الحكومة (…) فمن المؤكد أنّ
المهدي المنتظر لا يقرّ التضخم الذي بلغ 20 في المئة، وغلاء المعيشة،
والكثير غيرهما من الأخطاء» التي ترتكبها الحكومة!
إيران اليوم أسوأ من إيران البارحة على هذه الأصعدة المعاشية اليومية،
ولم يكن منتظراً من خامنئي أن يفاتح ضيفه/ تابعه الأسد حول الـ»معكرونة
غيت» مثلاً بعد أن حدّثه عن قهوة الصهاينة؛ لا لشيء إلا لأنّ الأسد آت
وهو محمّل بمئات الفضائح الغذائية والمعاشية التي تطحن حياة السوريين
اليومية، وقد تندرج في تسميات مثل الـ» البطاقة الذكية غيت» أو
الـ»سكّر غيت» أو الـ»أوكتان غيت» أو… «الشنكليش غيت».
وللقارئ الذي لم يسمع به بعد، مضى زمن انطبقت خلاله على أقراص الشنكليش
صفة «طعام الفقراء» قبل أن يصبح امتياز «الأكابر»؛ لأنّ سعر الكيلوغرام
الواحد كان، في سنة 2010 فقط، لا يتجاوز 350 ليرة سورية، وهو اليوم لا
يقلّ عن 11 ألف، وثمة مَن يروّج لأصناف فاخرة منه بقيمة 18 ألف ليرة.
هذا محض نموذج واحد على الوضعية «المشرّفة» للبلد، كما تفاخر بها
خامنئي أثناء استقبال الأسد؛ ومع الاعتذار من عنوان قصيدة محمود درويش
الشهيرة، فإنّ حال المضيف ومضيفه أقرب إلى تشخيص مأساة الشنكليش وملهاة
المعكرونة؛ وما كذّبوا تكذيبا!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
مجزرة
«التضامن» والمثقف العطّار
صبحي حديدي
كشفت الانتفاضة السورية، آذار (مارس) 2011، الكثير من سوءات المثقف السوري؛ أي سلسلة الأفعال والأقوال التي تندرج في أبواب الخيانة والانتهاز والتضليل والتواطؤ والتستر والعمالة، وغيرها كثير متعدد متشعب. وإذْ تبدأ هذه السطور من صاحب العلاقة، النموذج السوري، فلأنّ الإنصاف يقتضي الابتداء من أهل البيت أنفسهم، وليس البتة على أساس المبدأ القائل بأنّ أهل مكة أدرى بشعابها، لأنّ «الشعاب» هنا أشدّ جلاءً وبروزاً ورسوخاً من أن تخطئها أيّ عين غير متعامية. والتشوّهات، كي تستقرّ هذه السطور على توصيف الحدّ الأدنى، لحقت بالمثقف السوري على خلفية الانتفاضة، لكنها تواصلت وتكاثرت وتعاظمت؛ كلما اتضح جانب مشرق أو مظلم في سيرورة تلك الانتفاضة، وكلما اختلطت مأساة بمهزلة (في صفّ مدّعي تمثيل «المعارضة»، تحديداً)، وكلما اتضح جانب مضيء وصانع أمل في حياة السوريين أو افتُضحت مجزرة وجريمة حرب…
«شطارة» التخفي اثناء الاصطفاف المكين على هامش قطبَيْ العزلة والانحياز، بدل انتزاع موقف نقدي وسيط بينهما، جدير بالمثقف الذي لا يليق به أن يكون واحداً من اثنين: صانع إجماع كاذب، أو بائع كليشيهات وحقائق مسبقة الصنع، حسب تعبير ادوارد سعيد
شاعر سوري (واجتناب الأسماء، هنا، ليس له من دافع آخر سوى التشديد على
النموذج التمثيلي النمطي وليس الشخص الفرد المنفرد)، تباكى على الحرية
والعذاب الإنساني والشقاء اليسوعي طوال سنوات وسنوات، ومجموعة شعرية
إثر أخرى؛ لكنه أعلن اللجوء إلى مسدس كلما ذُكر له مثقف منحاز
للانتفاضة، ونعى الديمقراطية بعد أن أشبعها قدحاً وذمّاً. القلّة التي
لم يفاجئها موقفه هذا تذكرت أنه امتدح وجود النظام السوري العسكري في
لبنان، واعتبر خروجه/ إخراجه بمثابة مهانة للكرامة الوطنية السورية؛
كما استذكرت أنه امتدح التدخّل العسكري الروسي لصالح النظام، بل أطرى
شخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحثّه على اعتماد قاعدة «إضربْ، لا
ترحم أعداءك». القلّة إياها وجدت ما يشفع لغياب الدهشة إزاء مواقف كهذه
أنّ الشاعر ذاته توجّه بالمناشدة التالية للجيش الروسي في أوكرانيا:
إذا كان الإمبرياليون يتهمونكم بارتكاب المجازر، فخير لكم أن… ترتكبوا
المزيد منها!
مأساوي، في جانب آخر من المشهد البائس، أن تلك التشوهات انقلبت إلى ما
يشبه قواسم مشتركة تجمع شرائح واسعة من مثقفي العرب؛ من المحيط الهادر
حتى الخليج الثائر، طبقاً للشعار الشهير الذي ساد خلال خمسينيات
وستينيات القرن المنصرم، ثمّ باد كما يليق به وبطراز العقوبة التي
ينزلها التاريخ بنماذجه. وقد يحزن المرء إزاء «ممانع» من لبنان، أو
«عمّالي» من تونس، أو «نسوية» من الأردن، أو «ناصري» من مصر، أو
«بوتفليقيّ» من الجزائر… يقف في صفّ النظام السوري؛ متعامياً عن كلّ
مجزرة بدم بارد أو ببرميل متفجر أو بقذيفة كيميائية، بذريعة أنّ النظام
«ممانع» و»مقاوم» و»أنتي إمبرالية». لكنّ الحزن إياه ينقلب إلى خيبة
أمل وإحباط وفجيعة حين ينخرط في صفّ النظام هذا النموذج «اليساري» أو
ذاك «الإسلامي» من أبناء فلسطين، تحت الذريعة ذاتها؛ التي تتجاسر على
وقاحة نسيان جرائم آل الأسد في تل الزعتر ومخيم اليرموك.
شاعر فلسطيني (إذْ من اللافت أنهم، غالباً، شعراء!)، طليعي يكتب قصيدة
النثر ولا يعجبه عجب، أقام الدنيا ولم يقعدها (محقاً، بالطبع، فهذا أمر
آخر) لأنّ أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية اعتقلته بضع ساعات من داخل
اعتصام في إحدى ساحات رام الله؛ يساري المحتد، لكنه اليوم مفتون بشخصية
يحيى السنوار البطولية، مبتدئاً من مستوى خطابات الأخير التي ترعب دولة
الاحتلال. لا يلوح أنّ الشاعر إياه قد سمع بمجزرة حي التضامن، أو بلغه
واحد على الأقل من تفاصيلها الرهيبة يفيد بوجود فلسطينيين من مخيم
اليرموك ضمن الضحايا؛ بحيث يبدي الأسف مثلاً، وليس الاستنكار أو
الإدانة، لأنّ النظام «المقاوِم» الذي يشبّح له منذ 11 سنة ارتكب تلك
الجريمة الوحشية البربرية النكراء.
شاعرنا السوري وشاعرنا الفلسطيني، وأشباههما في طول العالم العربي
وعرضه، هما أوضح النماذج على حال قديمة، لكنها دائبة التجدد والتحديث،
تختصر التنازل الطوعي (الانتهازي بالضرورة) عن واجب التمثيل بوصفه أحد
أبرز مسؤوليات المثقف؛ والتحلل من عبء الالتزام بصوت مميز، يسهل ضبطه
متلبساً بهذه «الجناية» الفكرية – السياسية أو تلك؛ وتسطيح الموقف
بوسيلة تفتيته الى عشرات «الاجتهادات»، المشروطة بخضوعها جميعاً للدرجة
صفر من التجانس الفكري والوضوح الأخلاقي. كلا الشاعرَين «عطّار» لا
يبيع سوى أرباع الحقائق في هذه الضيعة – المنبر، وأنصاف الحقائق في تلك
البلدة – المؤسسة؛ ولكنها في النموذجين ليست الأرباع والأنصاف المرشحة
لتأسيس حقيقة واحدة من جهة، أو لتعريض العطار إلى أي مساءلة في حلّه
وترحاله بين القرى والبلدات من جهة ثانية.
الحال ذاتها تفرّخ نسقاً من تمويه العطارة بحيث تبدو الخيانة مظهراً
مشرّفاً للتغريد خارج السرب والانشقاق والرفض والاحتجاج؛ خاصة وأنّ
الخيانة هنا ليست من طراز «شبه قسري» اعتبر ميشيل فوكو أنّ المثقف
يمارسه وهو يرابط وسط شبكة معقدة من السلطات والأنظمة والقوى. إنها، في
مثال شاعريَنا بصفة خاصة، «شطارة» التخفي اثناء الاصطفاف المكين على
هامش قطبَيْ العزلة والانحياز، بدل انتزاع موقف نقدي وسيط بينهما، جدير
بالمثقف الذي لا يليق به أن يكون واحداً من اثنين: صانع إجماع كاذب، أو
بائع كليشيهات وحقائق مسبقة الصنع، حسب تعبير ادوارد سعيد.
وليس عجيباً أنّ العطّار، لغةً، ليس بائع العطر فقط، بل كذلك حوّاج
التوابل، والتاجر المتاجر في كلّ ما هبّ ودبّ!
الحرب الباردة:
من برقية X إلى طائرة )يوم القيامة(
صبحي حديدي
علائم أواخر الثمانينيات ومطالع التسعينيات من القرن المنصرم كانت تؤكد
طيّ صفحة الحرب الباردة بين المعسكرين «الرأسمالي» و»الاشتراكي»، ولا
تُستخدم أهلّة الاقتباس لحضر المفردتين السالفتين إلا لأنّ معدّلات
النسبية، أو حتى انعدام التناسب المنطقي، كانت وتظلّ قرينة التوصيفات
المختلفة لكلّ ما هو رأسمالي أو اشتراكي. غير أنّ حقبة «النظام الدولي
الجديد» التي أعلنها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، تصادت
سريعاً مع نظرية مواطنه الأمريكي فرنسيس فوكوياما حول «نهاية التاريخ».
على الخرائط وفي الوقائع الفعلية يشير ميل غرتوف، أستاذ العلوم
السياسية في جامعة بورتلاند ورئيس تحرير فصلية «المنظور الآسيوي»، إلى
هذه السلسلة، على سبيل الأمثلة الأبرز ليس أكثر: توحيد ألمانيا، انهيار
الاتحاد السوفييتي، التنسيبات الجديدة إلى الحلف الأطلسي، ربيع
الديمقراطية في بولندا وهنغاريا، استقلال أوكرانيا، إزالة الأسلحة
النووية من أوروبا الشرقية (بما في ذلك أوكرانيا، للتذكير المفيد!)،
اعتناق البيريسترويكا والغلاسنسوت في روسيا، إدخال العولمة إلى أجزاء
واسعة من «المعسكر الاشتراكي» المتفكك مع ضمّ بعضها إلى الاتحاد
الأوروبي… ألم تكن هذه، وسواها الكثير، لائحة كافية لتشييع مواضعات
الحرب الباردة إلى سلال مهملات التاريخ؟
ليس تماماً، أو ليس بعد، أو الأحرى القول أيضاً: حتى إشعار آخر يطول أو
يقصر؛ إذْ أنّ واقعة واحدة، فاصلة وفارقة مع ذلك، مثل الاجتياح الروسي
في أوكرانيا، بدت كافية لتذكير الغافلين بأنّ تلك الحرب الباردة (التي
لم تقع أصلاً، للتذكير الأكثر فائدة!) لا تعود من جديد بين موسكو وكلّ
من واشنطن والحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي على الأرض الأوكرانية،
فحسب؛ بل الأرجح، والجليّ يوماً بعد يوم، أنها لم تنتهِ أصلاً كي يُقال
إنها تُستأنف من جديد. وبعض ما يسعى إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
من بناء قطب «شرقي» خاضع لهيمنة موسكو، مقابل قطب «غربي» تقوده واشنطن
وأوروبا الأطلسية؛ لا تتردد أصداؤه في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم
وجورجيا وروسيا البيضاء وبلاد الشيشان (أو حتى لدى تابع قزم مثل نظام
بشار الأسد، أو عمليات ميليشيات «فاغنر» هنا وهناك في أفريقيا والشرق
الأوسط)، فقط؛ بل يتوجب أيضاً تعقُّب طراز آخر من أصدائه في ابتداء
تفكيك «الحياد» التاريخي الذي اتسمت به فنلندا والدانمرك والسويد،
مثلاً.
لا نتذكّر ما تردد من خرافات حول طيّ الحرب الباردة، بقدر ما نستفيق مجدداً على استقطابات متخمة بمزاعم التكنولوجيا والعلم والليبرالية والاقتصاد الحرّ، لكنها أيضاً مختنقة بمشاهد الحروب والمجازر والأهوال والفظائع
وكلّ هذا إذا أجاز المراقب لنفسه أن يضرب صفحاً عن صعود الصين كعملاق
منشطر الجسد بين أقصى الرأسمالية من حيث المحتوى وأدنى الاشتراكية من
حيث الشكل، مقابل انحطاط النظام السياسي في روسيا إلى مستويات
أوتوقراطية وأوليغارشية قصوى، وصعود الإسلام السياسي وتفرّعه إلى طوائف
ومذاهب وتيارات حاكمة متسلطة تارة أو جهادية متشددة وإرهابية تارة
أخرى. أو، أيضاً، إذا شاء المراقب إياه، أو حتى إذا استسهل، وضع
انتفاضات العالم العربي جانباً، وإهمال تبعاتها المختلفة التي لا تبدأ
من السياسة والاقتصاد ولا تنتهي عند الاجتماع والثقافة وتكريس تعاقدات
القوى العظمى السابقة مع أنظمة الاستبداد وقد ارتدت لبوس الثورات
المضادة. ولا يصحّ، هنا، أن تُنسى الأدوار التي يمكن أن تلعبها قوى
آسيوية وازنة مثل الهند والباكستان وماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا في
إعادة ترتيب الانحيازات القديمة والاصطفافات الجيو -سياسية والجيو –
اقتصادية المتجددة أو المستحدثة؛ على خلفية كبرى بالغة الحساسية هي
إطلالة الصين على عواقب، لكن أيضاً: على مغانم ومكاسب ومزايا؛ استئناف
حرب باردة لم تضع أوزارها، لأنها لم تنشب أصلاً.
ذلك لأنّ الحرب الباردة هي في المقام الأوّل «حرب المخيّلة» حسب تعبير
ماري كالدور، الباحثة البريطانية المرموقة المختصة بالعلاقات الدولية
وسياسات التسلّح؛ لأنّ فريقَي تلك الحرب، التي ظلّت افتراضية كما هو
معروف، لم يكونا بصدد التحضير لمواجهة عسكرية فعلية تردع الطرف الخصم؛
واكتفيا بالترويج لها على نطاق المخيّلة، وعن طريق تضخيم الإحساس بأنها
استمرار للحرب العالمية الثانية التي لم تنتهِ بعد، حتى إذا كانت قد
وضعت أوزارها. ولهذا فإنّ عشرات المفردات، المستلّة من قاموس تلك الحرب
الباردة المتخيَّلة، ما فتئت تجري على ألسنة وأقلام ساسة وكتّاب كثر،
في الغرب عموماً وأمريكا خصوصاً؛ وليس بالضرورة لأنهم من رعيل
المحافظين الجدد. الاجتياح الروسي الراهن في أوكرانيا يحدّث معجمها في
مستوى الخطاب، لكنه أيضاً يحرّك سعارها القديم إلى السلاح والتسلّح،
فيستخدم الجيش الروسي الأسلحة الـ231 الجديدة التي جرّبها ضدّ الشعب
السوري منذ خريف 2015؛ ولا يتردد بوتين في إصدار الامر بتحليق
«الكرملين الطائر»، أو طائرة «يوم القيامة»، أو الـ»إليوشن إيل -96-400
إم» في سماء موسكو.
واستطراداً، حول تلك الحرب ومواضعاتها، تُستعاد تلك «البرقية الطويلة»
التي أرسلها إلى واشنطن، شباط (فبراير) 1946، جورج كينان القائم
بالأعمال في السفارة الأمريكية في موسكو؛ والتي ستدخل التاريخ بوصفها
التبشير الإيديولوجي الأوّل بحرب باردة سوف «تنشب»، في ميادين المخيّلة
دائماً، بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. بعد البرقية، سوف
يكتب كينان المقال الشهير في مجلة «فوريين أفيرز»، بتوقيع
X،
فيستحق عليه لقب «نبيّ الحرب الباردة» بلا منازع. وفي البرقية، كما في
المقال، ساجل كينان بأنّ الولايات المتحدة لا تستطيع الوقوف مكتوفة
الأيدي إزاء ما سيجرّه خراب أوروبا الاقتصادي من خراب إيديولوجي؛ وهذا
سوف يكون في صالح الاتحاد السوفييتي والمعسكر الشيوعي، وسيقلب
الانتصارات العسكرية الأمريكية إلى هزائم عقائدية للقِيَم الرأسمالية.
لكن المحتوى البراغماتي لم يكن يدور حول ملء البطون الجائعة، بقدر ما
كان يستعجل تطويق الانهيار الوشيك في أوروبا، والسيطرة على تعطش الزعيم
السوفييتي جوزيف ستالين إلى ملء فراغ القوّة هنا وهناك، واستخدام سلاح
المعدة الخاوية لضبط الأرواح الهائمة والعقول التي تفسّر الخراب. وكان
كينان يريد للولايات المتحدة أن تتولى زمام «العالم الحر»، وتقبض
بالتالي على أعنّة العالم بأسره خارج الملكوت الشيوعي؛ عن طريق استخدام
كيس الطحين، الذي سوف يكمل العمل الذي قامت به الدبابة والقاذفة أثناء
سنوات الحرب وتحرير أوروبا. ذلك التنظير تلاقى مع انعطافة نوعية في
السياسة الخارجية الأمريكية، مثّلتها «عقيدة ترومان»؛ مثلما تقاطع،
إيجابياً، مع التطبيق العسكري الأوّل لتلك الانعطافة (التدخل في
اليونان وتركيا).
وحين انهار جدار برلين، وبدأت «جحافل» الحرب الباردة المتخيَّلة تجرجر
أذيالها صوب مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية عويصة، وليدة الواقع
الفعلي هذه المرّة، وليس الخيال؛ تقاطر، وتكاثر، المبشرون بأنّ انتصار
القِيَم الغربية ساعة سقوط الجدار، هو في الآن ذاته انتصار لليوتوبيا
الوحيدة المتبقية في حوزة الإنسانية، اليوتوبيا العليا والقصوى
والأخيرة على هيئة «خاتم البشر» الذي بشّر به فوكوياما؛ واليوتوبيا
التي يُراد لنا أن نسلّم بخلوّها، تماماً وأبداً، من الأزمات والهزّات
والتشوّهات. كأنّ التاريخ لم يعرف فترات الركود الرأسمالية الطاحنة،
وكأنّ اقتصاديات السوق الحرّ لم تشهد آلام العيش اليوميّ في كنف سياسات
مفقِرة وظالمة، وكأنّ دروس أرباب رأس المال الجدد، على غرار إيلون ماسك
أو جيف بيزوس أو سوندار بيشاي، ليسوا السلف الأشدّ توحشاً في عكس
الشعار الرأسمالي المقدس «دعه يمر»، دعه يعمل» إلى «لا يمرّ إلا إذا
عمل هنا».
ومن برقية السيد
X
إلى «الكرملين الطائر»، إذا اكتفى المرء بهذَين النظيرَين، لا نتذكّر
ما تردد من خرافات حول طيّ الحرب الباردة، بقدر ما نستفيق مجدداً على
أمثولة فاضحة لاستقطابات متخمة بمزاعم التكنولوجيا والعلم والليبرالية
والاقتصاد الحرّ، لكنها أيضاً مختنقة بمشاهد الحروب والمجازر والأهوال
والفظائع؛ «شرقاً» و»غرباً» على حدّ سواء.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
ما بعد “تويتر” إيلون ماسك:
أيّ “ما قبل”؟
صبحي حديدي
قد يساجل البعض بأنّ الآثار السلبية (وثمة مَن يتحدث عن العواقب
الكارثية) الناجمة عن استيلاء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على
منصّة “تويتر” لن تتضح على المدى القريب والمباشر؛ ومن الخير،
استطراداً، انتظار مفاعيل هذا التحوّل في مؤشرات أخرى فاعلة مثل
البورصات ومصارف الإقراض الكبرى (خاصة تلك التي أكملت التغطية المالية
لصفقة الـ44 مليارا التي تكفل ماسك بسدادها ثمناً للمنصّة). هنالك
وجاهة، وإنْ بدت نسبية من حيث المبدأ، خلف هذه المساجلة؛ التي لا تلغي
في المقابل تقديرات أخرى تحرص على وضع الواقعة ضمن سلسلة نظائر فارقة،
أقرب إلى منعطفات كبرى، في حياة النظام الرأسمالي المعاصر إجمالاً،
واقتصاد السوق والليبرالية الهوجاء بصفة خاصة.
وبمعزل عن مآزق اهتزاز العلاقات التعاقدية بين مواطن العالم المعاصر،
في مغارب الأرض ومشارقها، مع شركات كونية كبرى على غرار “يوتيوب”
و”أمازون” و”غوغل” و”أبل”، أو حيث تتجلى عصبة الـPayPal
Mafia
في فاشية رقمية تجمع أمثال ماسك مع دافيد ساكس (Geni)
ورايد هوفمان (LinkedIn)
وبريمال شاه (Kiva)
ورولوف بوتا (Sequoia)؛
هنالك ما هو أدهى وأعمق على صعيد مؤسسات رأسمالية عتيقة نافذة، مثل
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واتفاقيات الـ
GATT
ومنظمة التجارة الدولية. الطرفة السوداء هنا أنّ هذه، وما يتماثل معها
أو يتكامل ضمن أعرافها، ما تزال قائمة وفق الوظائف ذاتها التي سنّها
لها حكماء الاقتصاد الرأسمالي قبل سبعة عقود ونيف، بل هي اليوم أعلى
شراسة وأشدّ جبروتاً ونفوذاً؛ لأنّ روحية اتفاقيات بريتون وودز، حيث
انعقد مؤتمر النقد الدولي سنة 1944 وأنشأ هذه المؤسسات، هي ذاتها التي
تتعرّض اليوم لارتجاج بنيوي عميق، يبرّر تلك التوصيفات الكابوسية
للمآزق الراهنة، في أنها أشبه بـ 11/9 أو بيرل هاربور على صعيد
البورصات والأسواق.
وفي إسار هذا المشهد بمعطياته كافة، ما بان منها علانية وما احتجب
لأسباب لا صلة لها بالخشية من الإعلان، لسنا نفتقد منظّراً هنا، أو
متفلسفاً هناك، يطالبنا بأن نعيش حقبة ما بعد سقوط منصّة “تويتر” في
قبضة ماسك؛ تماماً كما طولبنا بأن نعيش ما بعد انهيار مصارف “وول
ستريت” وبورصاته، وما بعد هزّات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وما بعد الحرب
الباردة، وما بعد الحداثة، وما بعد المجتمع الصناعي، وما بعد
الإيديولوجيا، وما بعد التاريخ، وما بعد السياسة… كأنما بات من النافل
الحديث عن أيّ سابق على الـ”ما قبل”، أو كأنّ كل شيء حدث لتوّه، كما
استغرب الباحث الأمريكي دافيد غريس في كتابه المثير “دراما الهوية
الغربية”: يريدون من العالم أن يخلع أرديته واحدة تلو الأخرى، من
العقلانية والرومانتيكية والثورية، إلى تلك الرجعية والوثنية
والمحافظة، مروراً بالليبرالية والرأسمالية والاشتراكية، فضلاً عن
الأصوليات والعصبيات والهمجيات.
“ما بعد” استيلاء ماسك على “تويتر”، غير البعيدة عن أن تكون المنصّة الأهمّ والأخطر ضمن وسائل التواصل الاجتماعي، لا يصحّ أن يُجرّد، أو يُسلخ حرفياً، عن الـ”ما قبل” في ظواهر التأزّم الرأسمالي، ما شابهها أو تماثل معها أو دانى عواقبها
ولكن إذا توجّب، بالفعل، أن نعيش في أحقاب الـ”ما بعد”، المتغايرة
المتتابعة هذه، فلماذا يتوجّب ألا تكون هذه حقبة التبدّلات الكبرى التي
تطرأ، أيضاً، على ملفّات لاح أنها استقرّت أو رسخت أو “انتصرت”
نهائياً؛ مثل بداهة العولمة، وحتمية اقتصاد السوق، وقدرية انكماش
العالم إلى محض “سيليكون فالي”؟ ولماذا لا تكون حقبة ما بعد انهيارات
“وول ستريت”، أسوة بشقيقتها ما بعد 11 أيلول، نذيراً باقتراب مراحل الـ
“ما بعد” في هذه الأقانيم التي يتغنّى بها الغرب كلّ يوم: العولمة،
اقتصاد السوق، العالم في هيئة قرية صغيرة؟
ألا يبدو التبشير هذا أشبه بصيغة مستحدثة، ولكن على عجل وخفّة وضحالة،
لليوتوبيا العليا والقصوى والأخيرة التي اتخذت هيئة “خاتم البشر” كما
بشّر به فرنسيس فوكوياما (قبل أن يتراجع ويعدّل ويطوي…)؛ حيث لا أزمات
ولا هزّات ولا انكسارات؟ ألا يلوح عندهم، أو كما يريدوننا أن نبصر،
وكأنّ التاريخ لم يعرف فترات الركود الرأسمالية الطاحنة، أو كأنّ
اقتصاد السوق الحرّ في إنكلترا (مهد ولادة هذا الاقتصاد، وميدان تطبيقه
الأوّل) لم يشهد شظف العيش اليوميّ في إسار سياسات مُفقِرة وظالمة
اجتماعياً، من اللورد بالمرستون وصولاً إلى مارغريت ثاتشر؟
وفي حقبة غير بعيدة، حين تبدّت أولى مظاهر التأزم في الاقتصاد
اليوناني، كانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية سبّاقة إلى كشف النقاب
عن تواطؤ كبرى بيوتات المال الأمريكية، وعلى رأسها مصرف “غولدمان
ساكس”، في صناعة الأزمة. فعلى امتداد عقد كامل، وبالأحرى منذ دخول
اليونان في منطقة اليورو، أغدقت تلك البيوتات قروضاً سخية على حكومات
أثينا المتعاقبة، وكانت تموّه عمليات الإقراض تحت بنود شتى ومسمّيات
مختلفة، تسمح في المقام الأوّل بالتملّص من القيود التي كان الاتحاد
الأوروبي قد فرضها على سقوف التضخم الحكومي.
وتلك، على مأساوية عواقبها بالنسبة إلى المواطن اليوناني، كانت فرصة
لاكتشاف جديد حول معضلات النظام الرأسمالي، ممثلاً في فرعه الأبرز
الأمريكي: أنّ مجموعة “غولدمان ساكس” ليست قصة نجاح رأسمالية باهرة
تعود إلى سنة 1869 فحسب، بل هي “أخطبوط عملاق يمتصّ الدماء” في تعبير
مجلة “رولنغ ستون”. وعلى نقيض المبدأ الشهير “دعه يمرّ، دعه يعمل”،
بوصفه أحد أكثر أقانيم اقتصاد السوق قدسية وعراقة، كانت المجموعة تعتمد
مبدأ النقيض الأقرب إلى هذا الشعار “لا تدعه يعمل، إلا إذا مرّ من
هنا”؛ أي من تعاملات الزبائن مع مصارف المجموعة. الأمر الذي لم يوقف،
في كلّ حال، العزف المديد على نغمة انتصار اقتصاد السوق، والتنظير
المكرّر المملّ حول عبقرية النظام الرأسمالي.
قبلها، في حقبة غير بعيدة بدورها، نشبت معركة قانونية ضدّ قصة نجاح
رأسمالية ليست أقلّ بريقاً، بل لعلّها أكثر كونية وانضواء في حاضنة
العولمة؛ أي قضية وزارة العدل الأمريكية (ومن ورائها أكثر من عشرين
ولاية، وعشرات شركات الكومبيوتر الصغيرة والكبيرة) من جهة أولى، ضدّ
الملياردير الأمريكي بيل غيتس وشركة “ميكروسوفت” العملاقة من جهة
ثانية. وفي الجوهر الأعمق من تلك المواجهة الضارية، كان مبدأ “دعه
يمرّ، دعه يعمل” يتعرّض للمساءلة والمراجعة، ليس في ميدان التنظير
الفلسفي او الاقتصادي كما جرت العادة، وإنما في خضمّ السوق، وفي ظلّ
قوانين العرض والطلب دون سواها.
وتلك، من جانب آخر، معركة أطلقت شرعية التذكير بأنّ هذا الطراز من
المواجهات سوف يشكّل بصمة الأيام القادمة من أزمنة الرأسمالية الكونية،
وأطوار العولمة، وحصيلة إغلاق “قرن أمريكي” وافتتاح آخر لا كما حلم
الفرقاء الكبار الذين صنعوا منعرجات الماضي. كان ثمة، غنيّ عن القول،
الكثير من المغزى في أن تهبّ الرأسمالية ضدّ واحد من خيرة أبنائها
البرَرة، غيتس؛ وضدّ واحدة من كبريات معجزاتها، “ميكروسوفت”؛ كي نقتبس
تشخيص أسبوعية الـ”إيكونوميست” العليمة بأسرار الآلة الرأسمالية.
وهكذا فإنّ “ما بعد” استيلاء ماسك على “تويتر”، غير البعيدة عن أن تكون
المنصّة الأهمّ والأخطر ضمن وسائل التواصل الاجتماعي على أصعدة سياسية
واقتصادية وفكرية، لا يصحّ أن يُجرّد، أو يُسلخ حرفياً، عن الـ”ما قبل”
في ظواهر التأزّم سالفة الذكر، وفي الكثير سواها، شابهها أو تماثل معها
أو دانى عواقبها. وإذا كانت البورصات “فاتيكان اقتصاد السوق” حسب تعبير
الاقتصادي الأمريكي المعروف كنيث غالبرايث، فإنها بدرجات أعلى بمثابة
متحف الذاكرة الرأسمالية، ومستقرّ الأفراح والأتراح، الأرباح والخسائر،
والدموع التي تنهمر حزناً أو تفيض غبطة.
وها هنا ميدان ما بعد “تويتر” الذي في قبضة ماسك، لا لأيّ اعتبار آخر
يسبق حقيقة أنّ البورصة هي ميدان الـ”ما قبل”؛ أو، ببساطة أكثر: حلبة
المعترك… من قبل ومن بعد!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
لوبين والنظام السوري:
مَنْ كان منهم بلا خطيئة؟
صبحي حديدي
صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، وليدة حركة 1968 والتي كان جان – بول
سارتر ثاني مؤسسيها صحبة سيرج جولي سنة 1973، والتقدمية اليسارية بصفة
إجمالية؛ نشرت قبل أيام غلافاً تركيبياً يحمل صورة مارين لوبين مرشحة
أقصى اليمين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحيط لها صور الرئيس
الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس
النظام السوري بشار الأسد والرئيس الهنغاري فكتور أوربان، وسار العنوان
هكذا: “العالم حسب مارين لوبين”. وفي حدود ما أُتيح لهذه السطور أن
ترصد، كان ذلك الغلاف بمثابة الإعلان الأوضح في أية وسيلة إعلامية
فرنسية بصدد العلاقات، الوطيدة القديمة المتجددة؛ بين اليمين الفرنسي
المعتدل أو المتشدد من جهة، والنظام السوري من جهة ثانية.
قبل “ليبيراسيون” كان موقع “ميديابارت” الإخباري المستقلّ قد نشر
تقريراً مفصلاً عن منظمة “أنقذوا مسيحيي الشرق” الفرنسية، التي تقدّم
أشكال دعم مختلفة إلى ميليشيات موالية للنظام وتعلن هوية دينية مسيحية
في مدن وبلدات مثل محردة والسقيلبية؛ وسبق لمنظمات حقوقية محلية
وعالمية أن وثّقت ارتكاب تلك الميليشيات جرائم حرب موصوفة وأعمال سلب
ونهب و”تعفيش” وتهجير في ريف محافظة حماة على نحو خاص. التقرير شدّد،
من جانب آخر، على أنّ وزارة الدفاع الفرنسية منحت المنظمة صفة “مؤسسة
شريكة في الدفاع الوطني” منذ شباط (فبراير) 2017؛ وأنّ ممثليها
يتمتعون، استطراداً، بصلاحيات اعتبارية فعالة حتى إذا كانت غير رسمية
أو غير مباشرة.
ومؤخراً، خلال مؤتمر صحافي عرضت فيه الخطوط العريضة للسياسة الخارجية
في حال انتخابها رئيسة للجمهورية، أعلنت لوبين أنها أسفت لقطع فرنسا
العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وهذا “أعمانا في ميدان مكافحة
الإرهاب الإسلامي، وربما في لحظة كانت الأخطر التي تمرّ بها البلاد”.
تيري مارياني، مستشارها الإقليمي والعضو في البرلمان الأوروبي، زار
النظام السوري 6 مرّات بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا ربيع
2011؛ ورافقه رهط من رجالات حزب لوبين، ولم يكن عجيباً أن يكون في
عدادهم نيكولا باي الذي لن يطول الوقت حتى تصدّر موقعاً قيادياً في حزب
“الاسترداد” اليميني العنصري المتطرف الذي أسسه إريك زيمور مؤخراً.
تفاصيل كثيرة تحضّ على استعادة القول المأثور الشهير: مَن كان منهم بلا خطيئة، في صفوف اليمين الجمهوري مثل اليمين المتطرف والعنصري، فليرجمْ لوبين وحزبها بأوّل حجر
وخلال المناظرة التقليدية التي تسبق الانتخابات عادة، والتي جمعت لوبين
مع الرئيس الفرنسي المرشح إمانويل ماكرون، كان الأخير هو الوحيد الذي
نطق بمفردة “سوريا” مرّة واحدة على مدار 170 دقيقة؛ وليس بصدد جرائم
حرب النظام كما قد يتبادر إلى الذهن، بل في ملفّ انتقاد مواقف لوبين
المتعاطفة مع بوتين وما ترتكبه جيوشه في أكثر من مكان. وهذا محض تفصيل
أوّل بين تفاصيل شتى كثيرة (موقف اليساري الراديكالي جان – لوك ميلنشون
المصادق على الدور الروسي في سوريا، مثلاً، ولهذا مقام آخر بالطبع)،
تحضّ على استعادة القول المأثور الشهير: مَن كان منهم بلا خطيئة، في
صفوف اليمين الجمهوري مثل اليمين المتطرف والعنصري، فليرجمْ لوبين
وحزبها بأوّل حجر!
وهكذا، كان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، المنتمي إلى
الديغولية، هو “الرائد” على نطاق الاتحاد الأوروبي في تدشين سياسة حوار
مع النظام السوري صيف سنة 2008، من خلال مشروع “الاتحاد المتوسطي”،
الذي وُلد ميتاً في الأصل، ولم يكترث أحد حتى بدفنه! آنذاك برّر
ساركوزي دعوة الأسد (وكان عندئذ، مثلما كان في البدء ويظلّ حتى ساعة
سقوطه، دكتاتوراً ابن دكتاتور)، بالقول إنّ سوريا بلد متوسطي، وليس ثمة
سبب واحد يبرّر عدم دعوتها إلى القمة المتوسطية، غير المكرّسة لمناقشة
احترام أو انتهاك حقوق الإنسان على ضفاف المتوسط. ذاك كان منطقاً
صورياً سليماً تماماً، وبموجب اعتباراته الشكلانية كان استبعاد سوريا
من هذه القمة هو الذي سيشكّل القرار الشاذّ غير الطبيعي. ومن جانب
ثانٍ، مَنْ الذي كان سيعيب على ساركوزي دعوة الأسد إلى منصّة الاحتفال
بالثورة الفرنسية، يوم العيد الوطني لفرنسا، ما دام الحابل اختلط يومها
بالنابل على تلك المنصة: ديمقراطيات غربية، ودكتاتوريات شرقية أو
أفريقية، جنباً إلى جنب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي… “واحة
الديمقراطية” في الشرق الأوسط؟
لهذا فإنّ النداء الذي وجهته إلى ساركوزي، يومئذ، ثماني منظمات حقوق
إنسان دولية (بينها العفو الدولية، وميدل إيست واتش، والاتحاد الدولي
لروابط حقوق الإنسان، والشبكة الأورو – متوسطية، والمنظمة العالمية
لمناهضة التعذيب…)؛ ظلّ حبراً على ورق بصدد مطلب الفقرة الأولى:
“تناشدكم منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذه الرسالة إيلاء اهتمام
لوضع حقوق الإنسان في ذلك البلد في إطار محادثاتكم” مع الأسد. وزير
الخارجية الفرنسي برنار كوشنر (حامل كيس الرزّ بوصفه أيقونة الغوث
الدولي، وصاحب نظرية التدخّل الإنساني في الشؤون السيادية للدول، و”غير
المبتهج شخصياً” بزيارة الأسد إلى باريس) تكفّل بهذا الأمر، كما قيل؛
ودسّ في جيب وليد المعلّم، وزير خارجية النظام، لائحة بأسماء حفنة من
المعتقلين السياسيين السوريين الذين ستبتهج فرنسا بإطلاق سراحهم!
لكنّ ساركوزي لم يكن أوّل رئيس فرنسي يراقص طغاة الشرق الأوسط، سواء في
العقود الأخيرة من عمر الجمهورية الخامسة في فرنسا؛ أم في عقودها
الوسطى؛ إذْ كانت أوّل زيارة يقوم بها حافظ الأسد قد تمّت في عهد
فاليري جيسكار – ديستان، سنة 1976، بعد أشهر قليلة على دخول قوّات
النظام السوري إلى لبنان. هذا إذا اعتبر المرء الأنشطة الدبلوماسية في
تلك الأحقاب بمثابة تمرينات مبكّرة، واستطلاعية، على ما ستسميه
التنظيرات الديغولية “السياسة العربية لفرنسا”. الرئيس الفرنسي الأسبق
جاك شيراك، الديغولي بدوره، أعلن مقاطعة احتفالات فرنسا بالعيد الوطني
لأنّ الأسد سوف يكون على المنصّة، بدعوة من ساركوزي؛ متناسياً أنه، هو
نفسه شيراك الأمس القريب: الذي دعا الأسد الابن (ولم يكن الأخير يشغل
آنذاك أيّ منصب رسمي، ما عدا رئاسة “الجمعية المعلوماتية السورية”!)
إلى قصر الإليزيه، بترتيب مباشر من رئيس الوزراء اللبناني رفيق
الحريري… قتيل النظام السوري، وهنا وجه آخر للمفارقة.
ماكرون، الرئيس الحالي، لا يختلف عن أسلافه أهل اليمين بخصوص الموقف من
النظام السوري، إلا بمقدار اختلاف يمين ليبرالي وسطي اعتاد الإمساك
بالعصا من المنتصف؛ من دون حاجة حتى إلى التلويح بها، أو جعلها تهشّ
على شيء أو على أحد. خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2017، ثمّ بعد
أيام قليلة أعقبت انتخابه، سارت أقوال ماكرون هكذا: “خطوطي واضحة.
محاربة مطلقة لكل المجموعات الإرهابية، إنهم هم أعداؤنا، هذا أوّلاً.
نحن بحاجة لتعاون الجميع من أجل استئصالهم، وخصوصا تعاون روسيا”؛ ثمّ:
“لم أقل إنّ إزاحة الأسد تشكل شرطا مسبقا لكل شيء”، وذلك لأنّ “الأسد
عدوّ للشعب السوري ولكن ليس عدواً لفرنسا”. وكان في وسع لوبين، خلال
المناظرة الأخيرة، أن تذكّره بأنّ مواقفه هذه كانت أقرب إلى المصادقة
على خيارات بوتين والتدخل العسكري الروسي في سوريا لصالح النظام.
إريك شوفالييه، آخر سفير فرنسي في دمشق والمندوب الفرنسي السامي لدى
تابعيات “المعارضة” السورية في إسطنبول لاحقاً والسفير في العراق
حالياً، قد يكون حامل قصب السبق ضمن مساحة المواقف الفرنسية من النظام
السوري بعد انتفاضة 2011؛ إذْ لم يقرّب رامي مخلوف وتماسيح فساد أخرى
فحسب، بل مال إلى ترجيح تفسير النظام حول “العصابات المسلحة” وطالب
“بإعطاء الأسد وقتاً”، ولم يستبعد وجود “أياد أجنبية” خلف تظاهرات
الاحتجاج. يتوجب، استطراداً، أن يُستبعد تماماً، ورؤساؤه ورعاته، من
رهط حَمَلة الحجارة في وجه مارين لوبين؛ فالخطيئة هنا سابقة وسبّاقة.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس:
حمّى الاستيهام الصهيوني
صبحي حديدي
في صيف 1967 كان الجنرال الإسرائيلي عوزي ناركيس، قائد المنطقة الوسطى
والوحدات التي استولت على القدس القديمة، قد وافق على إجراء حوار مع
صحيفة «هآرتز» الإسرائيلية، اقترن بشرط غريب غير مألوف: ألا يُنشر
الحوار إلا بعد وفاة جميع الأشخاص المذكورين فيه، بما في ذلك الجنرال
نفسه. الأمر الذي التزمت به الصحيفة، نظراً للمعلومات «الديناميتية»
التي تضمنها وكان الكشف عنها كفيلاً بإحراج أصحاب العلاقة، وفي عدادهم
قادة الجيش الإسرائيلي وكبار مسؤولي الاحتلال، فنشرت الحوار بعد وفاة
ناركيس سنة 1997.
في ذلك الحوار يروي ناركيس أنه، بعد ساعات معدودات أعقبت دخول الاحتلال
الإسرائيلي إلى القدس القديمة، في حزيران (يونيو) عام 1967؛ هرع إليه
كبير حاخامات الجيش الإسرائيلي آنذاك، شلومو غورين، كي يحثه على إصدار
أمرَين: الأوّل هو تدمير قبّة الصخرة، والثاني هو تقويض المسجد الأقصى.
وحسب ناركيس، دار الحوار التالي يوم 7 حزيران (يونيو) 1967 في ساحة
المسجد الأقصى:
ــ الحاخام غورين: الآن هو الوقت المناسب لوضع 100 كغ من الموادّ
الناسفة، وتدمير مسجد عمر، وتخليصنا منه مرّة وإلى الأبد.
ــ الجنرال ناركيس: كفّ أيها الحاخام!
ــ ولكن يا عوزي اسمك سوف يدخل التاريخ من أوسع أبوابه!
ــ اسمي دخل لتوّه في كتب التاريخ الخاصة بأورشليم.
ــ أنت لا تدرك المغزى الهائل لهذا الفعل. هذه فرصة يتوجب اغتنامها
الآن بالذات. غداً سوف تفوت الفرصة نهائياً.
وتقول بقية الحكاية إنّ الحوار تناهى إلى أسماع الجنرال موشيه ديان،
وزير الدفاع آنذاك، ولكنه لم يتخذ أيّ إجراء رادع بحقّ الحاخام، بل
بالعكس: سمح له أن يلقي خطبة نارية أمام عدد كبير من الضباط، قال فيها
بالحرف: «إنها لمأساة أن تكون إسرائيل قد تلكأت في تدمير مسجد عمر».
تلك واحدة من عشرات الوقائع التي تثبت وتعيد تثبيت الاستيهام الصهيوني
المَرَضي بصدد الأقصى وقبّة الصخرة، لأنّ الجنرال نفسه الذي لم يأخذ
بنصيحة الحاخام كان يحدّث ضميره هكذا، طوال الاشتباكات والمعارك التي
سبقت سقوط القدس تحت الاحتلال: لن نكرر خطأ 1948، ويتوجب أن نحتلّ
البلدة القديمة. وهو أقرّ، صراحة ومن دون حرج يخصّ الأشخاص الأحياء،
أنه «أورشليميّ الولادة»، ويعزّ عليه ألا يدخل قلب القدس فاتحاً؛ ومن
هنا كان حرصه على التواجد، في صورة واحدة شهيرة، مع موشيه ديان وإسحق
رابين على مداخل المدينة العتيقة.
شحنة الفانتازيا عالية في الوجدان اليهودي بحيث يلوح أنّ الأسس العقلية والنفسية للدولة اليهودية سوف تنهار أو تتآكل إذا قامت دولة فلسطينية واتخذت، بالتالي، صيغة فانتازيا موازية للفانتازيا اليهودية
هوس قطعان المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وحاخامات «السنهدرين
الجديد» على إقامة طقس القرابين في باحة المسجد الأقصى، أو حتى داخل
الحرم كما قد تذهب المخيّلة الهستيرية، ليس سوى أحدث وقائع الفانتازيا
الشائهة تلك؛ وهذا المسّ المقدسي كان ويظلّ ديدن شرائح واسعة في مجتمع
الاحتلال، هي الغالبية القصوى عملياً: الديني المتشدد مع العلماني
المعتدل، واليميني المستنير مع اليساري الليبرالي، وعمدة مدينة ليكودي
صقري مثل إيهود أولمرت، أو سلفه الليبرالي الحمائمي تيدي كوليك، والحبل
على الجرار عند أمثال أوري ليوبينسكي (الذي دعا إلى هدم المسجد
الأقصى!) وصولاً إلى نير بركات (الذي اقترح على الفلسطينيين أن تكون
رام الله عاصمتهم، ثمّ تكرّم وتنازل فوافق أن تُسمّى «القدس
الشمالية»!)…
لا تختلف الحال كثيراً عند مواطن أمريكي، لكنه يهودي ويحمل الجنسية
الإسرائيلية، مثل رجل الأعمال إرفنغ موسكوفيتز، الملياردير الذي تتكدّس
ملايينه عبر آلات القمار؛ الذي زار القدس بهدف واحد وحيد، صريح فاضح
ولا حرج في إعلانه، هو تقديم «الكفارة التوراتية». وفي داخل النفق
الحاسموني الشهير، وعلى مرمى حجر من المجارير الهيرودية، أعلن
موسكوفيتز التبرّع بملايين إضافية لشراء المزيد من الأراضي والبيوت
الفلسطينية؛ وقال: «السيطرة اليهودية على أورشليم، على الهيكل والحائط
الغربي، أهمّ من السلام. واليهود على مرّ العصور لم يصلّوا من أجل
السلام مع العرب، بل من أجل بسط السيطرة اليهودية على أورشليم».
والحال أنّ بعض الفضل في الربط المعمّق بين الدولة والهوس والفانتازيا
يعود إلى البريطانية جاكلين روز، الناقدة والأكاديمية اللامعة التي
تشتغل منذ سنوات على الأسس النفسية للخطابات النسوية وما بعد
الاستعمارية في الرواية والشعر؛ وهي يهودية أيضاً، وتنتمي إلى صفّ
الأقلية التي تعترف بهذا القدر أو ذاك من حقوق الشعب الفلسطيني، وتعترض
على هذا التفسير أو ذاك لمفهوم دولة إسرائيل بالمعاني الحقوقية
والتاريخية والسياسية والأسطورية. وكتابها «دول الفانتازيا» ينهض على
سؤال مشروع وشجاع: ما هو دور الفانتازيا في قيام الأمم وتأسيس الدول؟
هل ينبثق الاعتراض الإسرائيلي الجوهري على الدولة الفلسطينية من حقيقة
خضوع الوجدان الجمعي اليهودي إلى فانتازيا الدولة اليهودية بالذات؟
دولة الاحتلال، المدججة بالاستيطان والعنصرية والفلسفات الصهيونية، لا
تستطيع منح الفلسطينيين الحقّ في إقامة دولة مستقلة، ليس بسبب خطر وشيك
داهم أو بعيد قادم، فحسب؛ بل لأنّ شحنة الفانتازيا المناهضة لهذه
الإمكانية عالية في الوجدان اليهودي، بحيث يلوح أنّ الأسس العقلية
والنفسية للدولة اليهودية سوف تنهار أو تتآكل إذا قامت دولة فلسطينية
واتخذت، بالتالي، صيغة فانتازيا موازية للفانتازيا اليهودية.
وأمّا في القدس المحتلة، فالهوس والهستيريا والسعار والجنون هي مرادفات
إضافية عليها تقتات حمّى الاستيهام.
باكستان التأزّم: ديمقراطية
ناقصة واستقرار غائب
صبحي حديدي
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان دخل تاريخ البلد السياسي
الحديث والمعاصر من زاوية فريدة، وبالتالي منفردة: ليس لأنه لم يكمل
ولايته، فتلك كانت حال 18 رئيس حكومة لاقوا المصير ذاته قبله، بل لأنه
كان الأوّل الذي أُقصي عن المنصب نتيجة تصويت بسحب الثقة في البرلمان.
وإذا كان هذا الفارق بمثابة تنويع واحد على سلسلة مظاهر تؤكد غياب
الاستقرار في الحياة السياسية، لأسباب شتى بالطبع؛ فإنه في الآن ذاته
مؤشر جديد على اعتلال الديمقراطية الباكستانية من حيث النقصان بادئ ذي
بدء، لأنّ التصويت على حجب الثقة استوجب تدخّل السلطة القضائية متمثلة
في المحكمة العليا، التي أعادت إلى السلطة التشريعية صلاحية كانت
السلطة التنفيذية قد عطلتها متمثلة في رئيس برلمان موالٍ لرئيس الحكومة
رفض عقد الجلسة أساساً.
وفي أعقاب الإطاحة بحكومة خان نشرت مؤسسة “غالوب” استطلاعاً للرأي أفاد
بأنّ 57% من المشاركين في الاستفتاء كانوا سعداء برحيل خان، مقابل43%
في صفّ الساخطين؛ والفريق الأوّل أقام رأيه على أساس تقصير الحكومة في
ميادين الاقتصاد والتضخم والغلاء وهبوط قيمة العملة المحلية، وأمّا
الفريق الثاني فقد اعتنق رواية خان القائلة بأنّ الولايات المتحدة
تآمرت عليه بسبب مواقفه الاستقلالية واعتمدت سيناريو “تغيير النظام”
واستمالت بعض أعضاء حزبه من البرلمانيين الذين انشقوا عنه وصوتوا ضده
في البرلمان. والمنطق السليم يمكن أن يقود إلى التصديق على أنّ مزيجاً
من الموقفين يكمن في خلفية المصير الذي انتهى إليه لاعب الكريكيت
السابق، الآتي إلى السياسة من خارج سلالاتها الحاكمة التقليدية التي
تمتدّ من بوتو إلى آل شريف… العائلة التي ينحدر منها رئيس الوزراء
البديل شهباز شريف.
ولأصحاب الرأي الأوّل أن يسوقوا عشرات الحجج ضدّ رئيس الوزراء السابق،
ولهم أن يبدأوا من عبارته الشهيرة بأنه يفضّل الموت على التعامل مع
صندوق النقد الدولي (الأمر الذي حنث فيه، بعد أشهر قلائل)؛ أو تعهده
القاطع بعدم تأهيل أيّ من الساسة الفاسدين الذين باتت لوائح أسمائهم
على كل شفة ولسان (وقد لجأ سريعاً إلى التعاون مع بعضهم، بل قرّب مَن
كان بينهم على رأس اللائحة). أصحاب الرأي الثاني يمكن أن يساجلوا هكذا:
أليس الرجل أوّل رئيس حكومة باكستاني يقول لا للإدارة الأمريكية، في
ملفات مثل “الحملة على الإرهاب” واستهداف النشطاء عبر الطائرات
المسيّرة؛ ويذكّر البيت الأبيض بأنّ الباكستان ليست عبداً عند أمريكا،
إلى درجة أنّ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا
دونالد لو ألمح إلى تغيير النظام خلال محادثة غير رسمية مع دبلوماسي
باكستاني سابق؟
استقطابان على هذه الشاكلة ليسا سوى صيغة تعكس ثنائيات تناقض أخرى من
نوع التوتر بين المدنيين والعسكر، وبين التقليديين والحداثيين، وبين
توترات الطبقة والمدينة والريف والجندر والمؤسسات الدستورية المختلفة،
وما يترتب على هذا كلّه من اصطفافات سياسية واجتماعية ودينية وقبائلية
وثقافية. والبلد لا يستأثر بهذا المشهد المضطرم، إذْ لعله سمة غالبة في
الكثير من مجتمعات شرق آسيا، غير أنّ خصوصية الباكستان التاريخية
والإثنية أو حتى اللسانية كانت عاملاً حاسماً في تصعيد قوّة نفوذ باتت
الكبرى في البلد، أي ائتلاف مؤسسة الجيش والاستخبارات الذي يحكم ضمناً
على نحو يتجاوز أحياناً الصيغة الشائعة حول الدولة العميقة.
خصوصية الباكستان التاريخية والإثنية أو حتى اللسانية كانت عاملاً حاسماً في تصعيد قوّة نفوذ باتت الكبرى في البلد، أي ائتلاف مؤسسة الجيش والاستخبارات الذي يحكم ضمناً على نحو يتجاوز أحياناً الصيغة الشائعة حول الدولة العميقة
وكان انقلاب الجنرال برويز مشرف أواخر عام 1999 بمثابة أحدث التمرينات
على تدخّل الجيش السافر في الحياة السياسية، ضمن تزامن غير مفاجئ مع
هزّة 11/9 والغزو الأمريكي لأفغانستان، ومهزلة الانتخابات التشريعية
خريف العام التالي، والتصالح المذهل مع المقاربة الجيو – ستراتيجية
التي اعتمدتها الولايات المتحدة بصدد التعامل مع ذلك الشطر الفريد من
شبه القارّة الهندية، حيث تمتزج التجارب الديمقراطية بالتجارب النووية،
والنزاع الهندي – الباكستاني بالنزاعات الإثنية والدينية والثقافية.
وقد يقتضي الإنصاف التذكير بأنّ الجنرال مشرّف كان قد تعشّى برئيس
الوزراء نواز شريف، بعد أن ظنّ الأخير أنه يستطيع تناول العسكر لقمة
سائغة على مائدة الغداء. ولقد تبيّن سريعاً أنّ الجيش منحاز إلى العشاء
العسكري أكثر من الغداء المدني، وأنّ المؤسسة الأمنية (هذه التي اعتمد
عليها شريف في قمع الصحافة والأحزاب المعارضة والشارع العريض، وكانت
بمثابة سيف مسلط على عنق المؤسسات المدنية)، ليست قادرة على تنفيذ
مناورة مضادّة لهجوم الجيش. تلك تقنيات تنفيذ سلسة، بل إنّ جدواها كانت
مدهشة بالفعل لأنّ طلقة واحدة لم تُطلق دفاعاً عن حكومة شريف.
من جانب آخر لا يقلّ أهمية، كانت البساطة في مفردات “السياسة” التي
استخدمها العسكر ناجمة عن حقيقة كراهية الشارع لحكومة شريف، إلى جانب
عشرات الحقائق الأخرى ذات الصلة بالفساد والتقصير والتسلّط والمحسوبية
العائلية والقبائلية، فضلاً عن حقيقة كبرى حديثة العهد هي تعريض
المؤسسة العسكرية (وربما الوجدان الباكستاني القومي والشعبوي بصفة
عامّة) إلى مهانة انسحاب الجيش والميليشيات من سفوح هيملايا لصالح
الهند… تحت ضغط أمريكي! وكان طبيعياً أن تهيمن البساطة ذاتها على خطاب
مشرّف حين استتبع الانقلاب العسكري بما لزمه من تتمات مدنية ودستورية:
حلّ البرلمان ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية، إعفاء الرئيس محمد رفيق
ترار من مهامّه (بطريقة تخلو تماماً من اللياقة واللباقة!)، وتنصيب
الجنرال نفسه رئيساً وقائداً للجيش وزعيماً مطلق الصلاحيات، قبل
استفتاء الشعب على بقائه رئيساً للبلاد بصلاحيات خرافية، وفتح صناديق
الاقتراع أمام تزوير جديد لإرادة الشعب.
ذلك مشهد لم ينطوِ على غياب “السياسة” عن مجتمع يبسّط العسكر علاقاته
ومعادلاته وتوازناته، فمن المعروف أنّ لعبة تبادل السلطة بين “حزب
الشعب” وبنازير بوتو من جهة، و”حزب الرابطة الإسلامية” ونواز شريف من
جهة ثانية، كانت قد تحوّلت إلى لعبة كراسٍ موسيقية: لا تذهب الأولى إلا
لكي يأتي الثاني، ثم لا يذهب الثاني إلا لكي تأتي الأولى! شروط الفساد
والتردي الاقتصادي وسوء المعيشة هي التي كانت تمنح شريف فرصة الانقضاض
على حكومة بوتو، والشروط ذاتها تماماً كانت تمنح الأخيرة فرصة تقويض
حكومة الأوّل، وهكذا…
بهذا المعنى كان قدوم خان من مضمار الكريكيت إلى معترك السياسة في سنة
1996 بمثابة اختراق للمعادلة، بدأ مع صعود حزبه “حركة الإنصاف” في
انتخابات 2011، ثمّ تكلل في سنة 2018 مع نجاحه في تشكيل تحالف حاكم ضمن
له موقع رئاسة الحكومة؛ في غمرة قبول لا يخفى من المؤسستين العسكرية
والأمنية. ورغم أنّ حكومته أدخلت إصلاحات تلبي حاجة ماسة في برامج
الرعاية الاجتماعية والبيئة، وكانت خططه في مواجهة جائحة كوفيد-19 مضرب
مثل في الكفاءة؛ إلا أنه، في المقابل، ضيّق على الحريات المدنية
والصحافية، وزعم الاستقلال عن السياسة الأمريكية ولكنه في الآن ذاته
تقرّب من روسيا والصين وسكت عن مظالم أقلية الإيغور.
وليس من الواضح أنّ قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا ينتمي اليوم
إلى صفّ السعداء بقرار البرلمان الإطاحة بحكومة خان أو الساخطين عليه،
غير أنّ الأرجح منطقياً أنّ الجنرالات الذين ساندوا لاعب الكريكت
المنقلب إلى سياسي شعبي وشعبوي، انفضوا عنه حين باتت مشكلات البلد
الاقتصادية والمعيشية أشدّ تعقيداً وإلحاحاً من أن تديم شهور العسل مع
“حركة الإنصاف” وزعيمه.
.. أو أن تضع خاتمة سعيدة لتأزّم البلد الدائم، بين ديمقراطية ناقصة
واستقرار غائب.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
تحريم التعذيب في سوريا:
صفاقة الأسد وتعدّد الاقتداء
صبحي حديدي
إذا لم ينتزع امرؤ عقله من مكانه ويضعه على الكفّ، كما يقول المثل
السائر في توصيف الغرائب والعجائب، فلن يكون يسيراً تصديق القانون رقم
16 تاريخ 29/3/2022 الذي أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد؛ حول
تجريم التعذيب، ومعاقبة مرتكبه بلائحة عقوبات تبدأ من 3 سنوات وتنتهي
بالإعدام. وإذا جاز، من حيث المبدأ، انتظار أيّ سلوك من نظام همجي
السياسات وحشي الأدوات إجراميّ النشأة والتاريخ ولا حدود لسعاره في
اقتفاء النجاة وحفظ البقاء؛ فإنّ هذه الخطوة كفيلة بنقل مدارات السلطة
إلى مستوى من الصفاقة غير مسبوق، سواء على صعيد 52 سنة من حكم آل
الأسد، أو حتى على صعيد التواريخ التي دوّنتها الإنسانية للعهود
البربرية.
فإذا صدّق المرء ذاته، صاحب العقل الملقى على الكفّ، إحصائيات الأمم
المتحدة أو منظمة “العفو الدولية” أو منظمة “هيومان رايتس ووتش”، أو
العشرات سواها؛ فإنّ الفترة ما بعد 2011 شهدت إعدامات صورية لأكثر من
13000 مواطن سوري في سجون ومعتقلات النظام، وأنّ 75000 آخرين اعتُقلوا
وباتوا في عداد المفقودين. وإذا صحّ، منطقياً، أنّ الغالبية الساحقة من
هؤلاء تعرضوا لأشكال شتى من التعذيب؛ فإنّ موادّ قانون الأسد يتوجب أن
تعاقب (بالسجن 3 أو 6 أو 8 سنوات، أو المؤبد، أو الإعدام) قرابة 80,000
على الأقلّ من سجاني وعناصر أجهزة الأمن العاملة في عشرات السجون
والمعتقلات في سوريا، والمتورطة حكماً في صنوف التعذيب المختلفة. هذا
إذا استبعد المرء الفظائع التي كشفتها صور التعذيب المسرّبة من المصوّر
العسكري المعروف باسم “قيصر”، وبلغت أكثر من 55,000 معتقل/ قتيل.
ومنذ سنة 2013 كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أصدرت تقريراً مفصلاً
عن أنماط الاحتجاز والتعذيب، التي كان مواطنون سوريون قد خضعوا لها في
مختلف مقارّ ومعتقلات استخبارات النظام السوري (أمن الدولة، المخابرات
العسكرية، مخابرات القوى الجوية، الأمن السياسي، والأمن الجنائي). وفي
خلاصات التقرير جاء أنّ “الأنماط الممنهجة للمعاملة السيئة والتعذيب”
التي وثقتها المنظمة، “تشير إلى وجود سياسة انتهجتها الدولة، تتلخص في
تعذيب وإساءة معاملة الأفراد، ومن ثمّ فهي ترقى لكونها جريمة ضدّ
الإنسانية”. واتكاءً على معلومات متقاطعة، جُمعت من أفراد معتقلين
نُقلوا إلى أكثر من 17 فرعاً أمنياً مختلفاً، كتبت المنظمة إلى مجلس
الأمن الدولي، باسم الحكومة السويسرية وبالنيابة عن 57 دولة (بينها
فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وبلجيكا وفنلندا واليونان والنروج
والبرتغال وهنغاريا وأستراليا واليابان…)؛ تطالب بإحالة الوضع في سوريا
إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما “يعطي الزخم للجهود الدولية الرامية
إلى وقف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة”. كذلك ألحّت المنظمة على “انضمام
الدول الأخرى إلى هذه الدعوة، من أجل دفع أعضاء مجلس الأمن المترددين
إلى إدراك ضرورة الاهتمام بقضية المحاسبة على وجه السرعة”.
غير أنّ الرسالة تلك سقطت على آذان صمّاء وأعين عمياء داخل المجلس،
وظلّت الدول الغائبة عن اللائحة مترددة في التوقيع، أو رافضة للفكرة من
الأساس. المرء يفهم بسهولة أسباب امتناع دولتين مثل روسيا والصين، لانّ
ركائز حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلدين قائمة على بيوت من زجاج،
ولا تشجّع كثيراً على رشق أجهزة الأسد بالحجارة؛ هذا فضلاً عن مواقف
موسكو وبكين المعطِّلة، إجمالاً، لأيّ قرار أممي حول النظام السوري.
ولكن… ماذا عن الولايات المتحدة، “راعية حقوق الإنسان” كما يحلو
لساستها أن يرددوا كلما رنّ ناقوس؟ هنا أيضاً كان سبب الامتناع هو بيت
الزجاج ذاته، حتى إذا اختلفت أحجام الحجارة التي يمكن أن تهزّ أركانه،
وتباينت مقادير الانتهاكات، وتنوعت أنساق التعذيب (إذْ أنها ليست،
البتة، نسقاً واحداً متماثلاً) هنا وهناك، حيث تنشط أجهزة العمّ سام
الأمنية.
إذا لم يكن أوباما هو قدوة الأسد في تحريم التعذيب قانوناً والسكوت عنه أو ممارسته فعلياً، فإنّ قدوة أخرى يمكن للنظام السوري أن يستمدها من موسكو في تعذيب النشطاء الشيشان على وجه الخصوص وإنكار الممارسات كلما رنّ ناقوس
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد ماطل طويلاً، حتى مغادرة
البيت الأبيض، في الوفاء بواحد من أبرز وعوده الانتخابية، حول إصدار
إذن رئاسي بنشر ما يُسمّى اليوم “مذكرات التعذيب” الصادرة عن كبار
مسؤولي وزارة العدل والبنتاغون في الإدارة السابقة. وإذا جاز أن تُسجّل
باسم أوباما خطوات إيجابية، مثل حظر التعذيب رسمياً (على الأراضي
الأمريكية فقط، كما يتوجب التذكير دائماً!)، وإصدار الأمر بإغلاق معتقل
غوانتانامو منذ الولاية الرئاسية الأولى (ثمّ التلكؤ في التنفيذ، حتى
النهاية)؛ فإنّ سياسات البيت الأبيض الأخرى، وعلى رأسها اغتيالات
الأفراد عبر الطائرات من دون طيار، والسكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان
هنا وهناك في العالم، والتراخي في محاسبة مجرمي الحرب، وتشجيع البعض
منهم عن طريق رسم “خطوط حمراء” زائفة… كلّ هذه تجعل واشنطن قدوة حسنة،
ومثالاً يُحتذى، وذريعة في ممارسة التعذيب.
وفي سنة 2004 نشر صحافي التحقيقات الأمريكي سيمور هيرش تحقيقاً على
الموقع الإلكتروني لمجلة “نيويوركر”، أوضح فيه أنّ ما نُشر من صور
تعذيب وتحقير وإهانة الموقوفين العراقيين في معتقل أبو غريب لم يكن سوى
دفعة أولى حول ما خفي وكان أعظم وأدهى، وأبشع وأشنع. وأثبت هيرش أنّ
الإدارة الأمريكية كانت تعرف، في ضوء التقرير الذي أعدّه العميد
أنتونيو م. تاغوبا، وسلّمه إلى البنتاغون، وانطوى على 53 صفحة حافلة
بوقائع رهيبة حول واقع السجون العراقية في ظلّ الاحتلال الأمريكي. وقال
تاغوبا إنّ الجيش الأمريكي ارتكب أعمال تعذيب “إجرامية، سادية، صاخبة،
بذيئة، متلذّذة”، سرد بعضها هكذا: صبّ السائل الفوسفوري أو الماء
البارد على أجساد الموقوفين، الضرب باستخدام عصا المكنسة والكرسي،
تهديد الموقوفين بالاغتصاب، واستخدام الكلاب العسكرية لإخافة الموقوفين
وتهديدهم.
فإذا لم يكن أوباما هو قدوة الأسد في تحريم التعذيب قانوناً والسكوت
عنه أو ممارسته فعلياً، فإنّ قدوة أخرى حسنة يمكن للنظام السوري أن
يستمدها من موسكو، في تعذيب النشطاء الشيشان على وجه الخصوص وإنكار
الممارسات كلما رنّ ناقوس هنا أيضاً؛ بل شنّ حملات هجومية منتظمة ضدّ
منظمات حقوقية مشهود لها بترصّد الحقائق، أو ضدّ لجنة مناهضة التعذيب
التابعة للأمم المتحدة. التقارير الحقوقية وثّقت طرائق روسية في
التعذيب تبدأ من الضرب والصعق الكهربائي وتسميات “الفيل” و”السنونو”
و”المغلّف” و”صلب المسيح”؛ وليس عجيباً أنها تتصادى مع 72 طريقة تعذيب
شاعت في معتقلات النظام السوري، تحت مسميات مثل “الكرسي الألماني”
و”بساط الريح” و”الغسالةّ و”الشبح”…
وقد يتساءل متسائل، مولع بالتَمَنْطُق الأجوف غالباً: ولكن لماذا يصدر
الأسد قانوناً مثل هذا، إذا كانت “الجهات المختصة” لن تلتزم به؛ وهنا
أيضاً فإنّ اعتصار إجابة ما، من أيّ طراز، قد يستدعي نقل العقل مجدداً
إلى الكفّ، قبيل التذكير بأنّ هذا النظام/ المزرعة لا دستور يحكمه ولا
قانون يسري فيه، وليس ذرّ الرماد في العيون واستغفال عقول الناس عن
طريق القوانين الخلبية والمراسيم التهريجية سوى التكتيك الأكثر شيوعاً
في تحويل الأباطيل الكاذبة إلى مكاسب أكثر كذباً. فمنذا الذي، في وزارة
عدل النظام أو على صعيد قضاته ومحاكمه، سوف يجرؤ على استدعاء عريف عامل
في أيّ من عشرات الأجهزة الأمنية؛ وهذه هي الرتبة الدنيا، فما بالك
بالألوية والعمداء والعقداء…؟
الأجدى قد يكون الأخذ في الاعتبار طبائع الاقتداء، أمريكية كانت أم
روسية أم كورية شمالية أم بريطانية أم فرنسية، التي دفعت الأسد إلى
إصدار هذا القانون اليوم؛ ولا خلاف، من حيث المبدأ أيضاً، في أن يكون
سياق إقليمي أو دولي قد حثّه على اتخاذ الخطوة، أو زُيّنت له محاسنها…
المسرحية منها، في المقام الأوّل.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
تحريم التعذيب في سوريا:
صفاقة الأسد وتعدّد الاقتداء
صبحي حديدي
إذا لم ينتزع امرؤ عقله من مكانه ويضعه على الكفّ، كما يقول المثل
السائر في توصيف الغرائب والعجائب، فلن يكون يسيراً تصديق القانون رقم
16 تاريخ 29/3/2022 الذي أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد؛ حول
تجريم التعذيب، ومعاقبة مرتكبه بلائحة عقوبات تبدأ من 3 سنوات وتنتهي
بالإعدام. وإذا جاز، من حيث المبدأ، انتظار أيّ سلوك من نظام همجي
السياسات وحشي الأدوات إجراميّ النشأة والتاريخ ولا حدود لسعاره في
اقتفاء النجاة وحفظ البقاء؛ فإنّ هذه الخطوة كفيلة بنقل مدارات السلطة
إلى مستوى من الصفاقة غير مسبوق، سواء على صعيد 52 سنة من حكم آل
الأسد، أو حتى على صعيد التواريخ التي دوّنتها الإنسانية للعهود
البربرية.
فإذا صدّق المرء ذاته، صاحب العقل الملقى على الكفّ، إحصائيات الأمم
المتحدة أو منظمة “العفو الدولية” أو منظمة “هيومان رايتس ووتش”، أو
العشرات سواها؛ فإنّ الفترة ما بعد 2011 شهدت إعدامات صورية لأكثر من
13000 مواطن سوري في سجون ومعتقلات النظام، وأنّ 75000 آخرين اعتُقلوا
وباتوا في عداد المفقودين. وإذا صحّ، منطقياً، أنّ الغالبية الساحقة من
هؤلاء تعرضوا لأشكال شتى من التعذيب؛ فإنّ موادّ قانون الأسد يتوجب أن
تعاقب (بالسجن 3 أو 6 أو 8 سنوات، أو المؤبد، أو الإعدام) قرابة 80,000
على الأقلّ من سجاني وعناصر أجهزة الأمن العاملة في عشرات السجون
والمعتقلات في سوريا، والمتورطة حكماً في صنوف التعذيب المختلفة. هذا
إذا استبعد المرء الفظائع التي كشفتها صور التعذيب المسرّبة من المصوّر
العسكري المعروف باسم “قيصر”، وبلغت أكثر من 55,000 معتقل/ قتيل.
ومنذ سنة 2013 كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أصدرت تقريراً مفصلاً
عن أنماط الاحتجاز والتعذيب، التي كان مواطنون سوريون قد خضعوا لها في
مختلف مقارّ ومعتقلات استخبارات النظام السوري (أمن الدولة، المخابرات
العسكرية، مخابرات القوى الجوية، الأمن السياسي، والأمن الجنائي). وفي
خلاصات التقرير جاء أنّ “الأنماط الممنهجة للمعاملة السيئة والتعذيب”
التي وثقتها المنظمة، “تشير إلى وجود سياسة انتهجتها الدولة، تتلخص في
تعذيب وإساءة معاملة الأفراد، ومن ثمّ فهي ترقى لكونها جريمة ضدّ
الإنسانية”. واتكاءً على معلومات متقاطعة، جُمعت من أفراد معتقلين
نُقلوا إلى أكثر من 17 فرعاً أمنياً مختلفاً، كتبت المنظمة إلى مجلس
الأمن الدولي، باسم الحكومة السويسرية وبالنيابة عن 57 دولة (بينها
فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وبلجيكا وفنلندا واليونان والنروج
والبرتغال وهنغاريا وأستراليا واليابان…)؛ تطالب بإحالة الوضع في سوريا
إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما “يعطي الزخم للجهود الدولية الرامية
إلى وقف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة”. كذلك ألحّت المنظمة على “انضمام
الدول الأخرى إلى هذه الدعوة، من أجل دفع أعضاء مجلس الأمن المترددين
إلى إدراك ضرورة الاهتمام بقضية المحاسبة على وجه السرعة”.
غير أنّ الرسالة تلك سقطت على آذان صمّاء وأعين عمياء داخل المجلس،
وظلّت الدول الغائبة عن اللائحة مترددة في التوقيع، أو رافضة للفكرة من
الأساس. المرء يفهم بسهولة أسباب امتناع دولتين مثل روسيا والصين، لانّ
ركائز حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلدين قائمة على بيوت من زجاج،
ولا تشجّع كثيراً على رشق أجهزة الأسد بالحجارة؛ هذا فضلاً عن مواقف
موسكو وبكين المعطِّلة، إجمالاً، لأيّ قرار أممي حول النظام السوري.
ولكن… ماذا عن الولايات المتحدة، “راعية حقوق الإنسان” كما يحلو
لساستها أن يرددوا كلما رنّ ناقوس؟ هنا أيضاً كان سبب الامتناع هو بيت
الزجاج ذاته، حتى إذا اختلفت أحجام الحجارة التي يمكن أن تهزّ أركانه،
وتباينت مقادير الانتهاكات، وتنوعت أنساق التعذيب (إذْ أنها ليست،
البتة، نسقاً واحداً متماثلاً) هنا وهناك، حيث تنشط أجهزة العمّ سام
الأمنية.
إذا لم يكن أوباما هو قدوة الأسد في تحريم التعذيب قانوناً والسكوت عنه أو ممارسته فعلياً، فإنّ قدوة أخرى يمكن للنظام السوري أن يستمدها من موسكو في تعذيب النشطاء الشيشان على وجه الخصوص وإنكار الممارسات كلما رنّ ناقوس
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد ماطل طويلاً، حتى مغادرة
البيت الأبيض، في الوفاء بواحد من أبرز وعوده الانتخابية، حول إصدار
إذن رئاسي بنشر ما يُسمّى اليوم “مذكرات التعذيب” الصادرة عن كبار
مسؤولي وزارة العدل والبنتاغون في الإدارة السابقة. وإذا جاز أن تُسجّل
باسم أوباما خطوات إيجابية، مثل حظر التعذيب رسمياً (على الأراضي
الأمريكية فقط، كما يتوجب التذكير دائماً!)، وإصدار الأمر بإغلاق معتقل
غوانتانامو منذ الولاية الرئاسية الأولى (ثمّ التلكؤ في التنفيذ، حتى
النهاية)؛ فإنّ سياسات البيت الأبيض الأخرى، وعلى رأسها اغتيالات
الأفراد عبر الطائرات من دون طيار، والسكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان
هنا وهناك في العالم، والتراخي في محاسبة مجرمي الحرب، وتشجيع البعض
منهم عن طريق رسم “خطوط حمراء” زائفة… كلّ هذه تجعل واشنطن قدوة حسنة،
ومثالاً يُحتذى، وذريعة في ممارسة التعذيب.
وفي سنة 2004 نشر صحافي التحقيقات الأمريكي سيمور هيرش تحقيقاً على
الموقع الإلكتروني لمجلة “نيويوركر”، أوضح فيه أنّ ما نُشر من صور
تعذيب وتحقير وإهانة الموقوفين العراقيين في معتقل أبو غريب لم يكن سوى
دفعة أولى حول ما خفي وكان أعظم وأدهى، وأبشع وأشنع. وأثبت هيرش أنّ
الإدارة الأمريكية كانت تعرف، في ضوء التقرير الذي أعدّه العميد
أنتونيو م. تاغوبا، وسلّمه إلى البنتاغون، وانطوى على 53 صفحة حافلة
بوقائع رهيبة حول واقع السجون العراقية في ظلّ الاحتلال الأمريكي. وقال
تاغوبا إنّ الجيش الأمريكي ارتكب أعمال تعذيب “إجرامية، سادية، صاخبة،
بذيئة، متلذّذة”، سرد بعضها هكذا: صبّ السائل الفوسفوري أو الماء
البارد على أجساد الموقوفين، الضرب باستخدام عصا المكنسة والكرسي،
تهديد الموقوفين بالاغتصاب، واستخدام الكلاب العسكرية لإخافة الموقوفين
وتهديدهم.
فإذا لم يكن أوباما هو قدوة الأسد في تحريم التعذيب قانوناً والسكوت
عنه أو ممارسته فعلياً، فإنّ قدوة أخرى حسنة يمكن للنظام السوري أن
يستمدها من موسكو، في تعذيب النشطاء الشيشان على وجه الخصوص وإنكار
الممارسات كلما رنّ ناقوس هنا أيضاً؛ بل شنّ حملات هجومية منتظمة ضدّ
منظمات حقوقية مشهود لها بترصّد الحقائق، أو ضدّ لجنة مناهضة التعذيب
التابعة للأمم المتحدة. التقارير الحقوقية وثّقت طرائق روسية في
التعذيب تبدأ من الضرب والصعق الكهربائي وتسميات “الفيل” و”السنونو”
و”المغلّف” و”صلب المسيح”؛ وليس عجيباً أنها تتصادى مع 72 طريقة تعذيب
شاعت في معتقلات النظام السوري، تحت مسميات مثل “الكرسي الألماني”
و”بساط الريح” و”الغسالةّ و”الشبح”…
وقد يتساءل متسائل، مولع بالتَمَنْطُق الأجوف غالباً: ولكن لماذا يصدر
الأسد قانوناً مثل هذا، إذا كانت “الجهات المختصة” لن تلتزم به؛ وهنا
أيضاً فإنّ اعتصار إجابة ما، من أيّ طراز، قد يستدعي نقل العقل مجدداً
إلى الكفّ، قبيل التذكير بأنّ هذا النظام/ المزرعة لا دستور يحكمه ولا
قانون يسري فيه، وليس ذرّ الرماد في العيون واستغفال عقول الناس عن
طريق القوانين الخلبية والمراسيم التهريجية سوى التكتيك الأكثر شيوعاً
في تحويل الأباطيل الكاذبة إلى مكاسب أكثر كذباً. فمنذا الذي، في وزارة
عدل النظام أو على صعيد قضاته ومحاكمه، سوف يجرؤ على استدعاء عريف عامل
في أيّ من عشرات الأجهزة الأمنية؛ وهذه هي الرتبة الدنيا، فما بالك
بالألوية والعمداء والعقداء…؟
الأجدى قد يكون الأخذ في الاعتبار طبائع الاقتداء، أمريكية كانت أم
روسية أم كورية شمالية أم بريطانية أم فرنسية، التي دفعت الأسد إلى
إصدار هذا القانون اليوم؛ ولا خلاف، من حيث المبدأ أيضاً، في أن يكون
سياق إقليمي أو دولي قد حثّه على اتخاذ الخطوة، أو زُيّنت له محاسنها…
المسرحية منها، في المقام الأوّل.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
مادلين أولبرايت: مستقر
مستحَق في سلة مهملات التاريخ
صبحي حديدي
في قسط غير ضئيل من الذاكرة العربية عن حصار العراق، سنوات التسعينيات
من القرن الماضي وقبيل الاجتياح الأمريكي للبلد، ثمة تلك العبارة
الشهيرة التي أطلقتها مادلين أولبرايت (1938-2022)، وكانت يومها مندوبة
دائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، حول وفاة أكثر من نصف
مليون طفل عراقي بسبب الحصار، والعدد هذا أكبر من ضحايا قنبلة
هيروشيما: “أعتقد أن الخيار صعب للغاية، ولكننا نعتقد أن الثمن مستحق”.
قسط غير قليل من الذاكرة السورية، في المقابل، حفظ زيارة أولبرايت،
وكانت يومها وزيرة الخارجية، لتعزية بشار الأسد بوفاة والده شكلاً،
ولتثبيت مساندة واشنطن لتوريثه السلطة مضموناً. لكن قارئ 2500 كلمة من
مادة الرثاء التي كرستها صحيفة “واشنطن بوست” في مناسبة رحيل أولبرايت،
لن يجد أي ذكر للعبارة الأولى الرجيمة؛ ولن يعثر، أيضاً، على أية إشارة
إلى مباركة الولايات المتحدة تكريس وريث في نظام استبداد وفساد وإرهاب.
وإذا صح أن المعلومة الأكثر جاذبية هي تلك التي تقول إن أولبرايت كانت
أول امرأة تشغل حقيبة الخارجية في الولايات المتحدة، فإن تتمة المعلومة
قد لا تجذب إلا ضحايا سياسات الولايات المتحدة في الغزو والهيمنة
والإخضاع، أو منتقدي تلك السياسات هنا وهناك في العالم: أن أولبرايت
كانت الأكثر توقاً (وشهوة، كما يتوجب القول) إلى استخدام القوة
العسكرية في خدمة السياسات، أو بالأحرى تطويعها. وذات يوم، حين تحفظ
كولن باول رئيس هيئة الأركان المشتركة على إرسال قوات أمريكية إلى
البوسنة، سارعت أولبرايت إلى توبيخه هكذا: ما جدوى هذه القوة العظمى
إذا لم نستخدمها؟ وخلال خطبة توديع منصبها في وزارة الخارجية، بحضور
خَلَفها باول نفسه، لم تتورع أولبرايت عن القول إن التاريخ أثبت صواب
رأيها وخطأ رأي باول، بصدد استخدام القوة العسكرية الأمريكية في عمليات
التدخل الخارجية. وفي مذكراته اللاحقة سوف يروي باول أن قشعريرة أصابته
لدى سماعها، وكادت شرايينه أن تتصلب!
هذا تفصيل لا يهمله كاتب مرثية أولبرايت في الـ”واشنطن بوست”، بل لعله
كان أكثر انجذاباً إلى تفصيل آخر، عجيب صعب التصديق، هو حكاية اكتشاف
أولبرايت أنها يهودية الأصل، وذلك بعد أن بلغت من العمر… 59 سنة، فقط
لا غير! كانت الصحيفة تجري معها حواراً، في سنة 1997، حين أعلمها
المحاوِر أن أسرتها يهودية، لكنها اهتدت إلى الكاثوليكية بعد الفرار من
تشيكوسلوفاكيا إلى لندن خلال الحرب العالمية الثانية؛ فكان أن “فوجئت”
أولبرايت بهذه المعلومة، زاعمة أن أهلها لم يخبروها، وأنها لم تكترث
بإجراء أي أبحاث حول تاريخ أسرتها. ولم يكن الخبثاء وحدهم هم الذين
شككوا في هذه “البراءة”، الصاعقة في زيفها وتكاذبها؛ إذْ كيف يعقل
لسيدة تحمل شهادة الدكتوراه في القانون الأهلي والحكم منذ سنة 1976،
واشتغلت مع أمثال زبغنيو بريجنسكي، وعملت في إدارة الرئيس الأسبق جيمي
كارتر، وكانت وراء تشجيع بيل كلنتون على الترشح للرئاسة الأولى… كيف
لها، حقاً، أن تغفل عن “نَكْوَشة” بسيطة في تاريخ أسرتها، رغم معرفتها
أن بعض أفراد الأسرة، وهي شخصياً، نجوا من الهولوكوست بفضل “أعجوبة
ربانية”؟
كتابها في “الفاشية: تحذير”، الذي صدر سنة 2018، لا يذكر من فاشية
النظام السوري سوى بعض العتب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه
“وضع ثقله الهائل إلى جانب بشار الأسد، الطاغية الذي تلطخت يداه بدماء
آلاف كثيرة”؛ لكن أولبرايت تتجاهل، تماماً، زيارة التعزية والاجتماع مع
الوريث للتصديق على نهج التوريث وتأكيد التعاقد ذاته مع الابن، بعد
أبيه. ولا يتضمن الكتاب الإشارة إلى أي بُعد فاشي خلف عشرات المجازر
التي ارتكبها آل الأسد، الأب قبل الابن، منذ أواخر السبعينيات ومطالع
الثمانينيات، ثم على وجه التحديد بعد 2011 مع انطلاق الانتفاضة
الشعبية. الفاشية عندها تبدأ من أدولف هتلر أولاً، بالطبع، ولكن بصفة
شبه حصرية أيضاً في الواقع؛ وانطلاقاً، كذلك، من ذاكرة الطفولة
التشيكية، مسقط رأس الطفلة ماري آنا كوربولوفا التي ستهاجر مع ذويها
إلى بريطانيا ثم الولايات المتحدة سنة 1948.
كما اعتبرت أولبرايت أن قتل نصف مليون طفل عراقي ثمن مستحَق، فإن طريقها إلى سلة مهملات التاريخ ليس معبداً مضموناً فحسب؛ بل هو مآل مستحَق، ولعله الأجر الأدنى أيضاً
غير أن العالم على اتساعه كان ساحة اشتغال نظريات أولبرايت في بسط
الهيمنة الأمريكية، ومن موقعها في وزارة الخارجية كانت قد أنذرت قادة
الاتحاد الأوروبي ألا ينسوا، وهم يعملون على توسيع رقعة الاتحاد، أن
أمريكا أنقذت أوروبا من غائلة الجوع عبر “خطة مارشال”، وحفظت أمنها
طوال الحرب الباردة من خلال الحلف الأطلسي. وبالتالي، ليس من الوارد،
في التقدير الأمريكي، أن أوروبا الغربية (الرأسمالية، الحرة، المعافاة
نسبياً بسبب من جميل الولايات المتحدة…) يمكن أن تزدهر أكثر من ازدهار
الولايات المتحدة نفسها، وأن توحد صفوفها بالانتقاص من مبدأ الهيمنة
الأمريكية على النظام الدولي! وأما خارج أوروبا، حيث العوالم الثانية
أو الثالثة، فإن “ذاكرة أمتنا طويلة، وسطوتنا واسعة”، صرحت أولبرايت في
أول تعليق لها على انفجارَي السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار
السلام، صيف 1998، قبل أن تعلن تخصيص مكافأة المليوني دولار لمن يدل
على هوية الجناة.
وفي ذلك التصريح الشهير امتزجت نبرة التهديد والوعيد بأطروحات فلسفية
حول الأسباب الكبرى التي تجعل الأمريكي المعاصر رائداً للديمقراطية
والحرية والتسامح، وقائداً للعالم الخير ضد العوالم الشريرة، وهدفاً
للإرهاب والإرهابيين. غير أن أولبرايت أثارت سؤالاً بريئاً في مظهره،
لكنه أوحى بالكثير من السذاجة المعلَنة: “لماذا يحدث هذا الأمر الرهيب
لعدد من الناس كانوا يقومون بعمل خير للغاية”؟ ولقد أجابت بنفسها،
هكذا: “لعلهم تعرضوا للهجوم لأنهم يقومون بعمل خير للغاية. ربما
أُفردوا لأنهم يمثلون بلداً هو الأعظم عالمياً في الدفاع عن الحرية
والعدالة والقانون. ربما لأننا نمثل قِيَم التسامح والانفتاح
والتعددية، التي تنهض الآن في كل جزء من أجزاء العالم. ربما لأننا
أقوياء، ولأننا نستخدم قوتنا لحل النزاعات التي يريد البعض الإبقاء
عليها إلى الأبد”.
ولا تكتمل حصتنا، نحن العرب، من عربدة أولبرايت الدبلوماسية والعسكرية
من دون التوقف عند موقفها المتعنت إزاء إعادة ترشيح بطرس بطرس غالي
لولاية ثانية في الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ وقبل ذلك حول صلاحيات
مجلس الأمن الدولي، حين قالت عن غالي: “أليس من المضحك أن يعتقد أنه
قادر على استخدام الفيتو ضد سياسات الولايات المتحدة”؟ وفي كتابه “طريق
مصر إلى القدس: قصة دبلوماسي عن الصراع من أجل السلام في الشرق
الأوسط”، 1997، يروي غالي أنه مُني بأقدار متتالية لم تضعه في وجه
الأصوليين (كما تمنى: “في مطلع القرن أقدم متطرفون مصريون على اغتيال
جدي [رئيس وزراء مصر آنذاك] لأنه تساهل مع الاستعمار البريطاني؛ ولو
أنني كنت إلى جانب السادات يوم مصرعه، لكان المنطق يقتضي أن أخر إلى
جانبه برصاص المتطرفين أنفسهم، حتى ولو اختلفت التواريخ وتباعدت
الأزمنة”)؛ بل أمام بشر أقرب إلى الأرباب وأبطال الأساطير: السادات،
بوصفه فرعون مصر والعقل الوحيد البراغماتي في العالم العربي؛ أو جورج
بوش الأب، وريث الملك آرثر في عصور ما بعد الحرب الباردة؛ أو أولبرايت،
في هيئة ميدوزا معاصرة تحيل خصمها إلى تمثال حجري…
وكما اعتبرت أولبرايت أن قتل نصف مليون طفل عراقي ثمن مستحق، فإن
طريقها إلى سلة مهملات التاريخ ليس معبداً مضموناً فحسب؛ بل هو مآل
مستحَق، ولعله الأجر الأدنى أيضاً.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
صدّام حفتر وبشار حافظ:
لا استثناء للقاعدة
صبحي حديدي
هذا مسار عجيب، أو غير مألوف على الأقلّ، لطائرة ركاب ليبية: إقلاع من
مطار دبي، وهبوط في مطار بن غوريون استغرق 90 دقيقة، وإقلاع إلى
القاهرة بعدئذ؛ حسب وسائل إعلام إسرائيلية، بينها «هآرتس»، نشرت النبأ
مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. غير أنّ العجب سرعان ما يتبدد،
فيحلّ محلّه يقينُ العاديّ والمألوف والمتكرر إذا عُلم أنّ الشخصية
التي استقلّت الطائرة كان صدّام خليفة حفتر، نجل المشير الليبي
الانقلابي والقائد المعيّن ذاتياً في ما يًسمى «الجيش الوطني». وأيّ
عجب، استطراداً، في أن يهرع هذا النجل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي،
متوسلاً الدعم (في شتى أشكاله، كما للمرء أن ينتظر) لمطامع والده في
خوض انتخابات الرئاسة الليبية؛ مقابل الوعد بالتطبيع وإقامة علاقات
دبلوماسية مع الاحتلال، وأصناف أخرى من المغريات والارتماءات تحت القدم
الإسرائيلية.
وكان الليبيون، ومعهم كلّ معنيّ بالشأن الليبي يراقب المشهد من منظار
مبسّط أو عفوي أو ساذج أيضاً، قد اكتشفوا هذا الفتى الصدّام في سنة
2016، حين ظهر فجأة خلال حفل تخريج ضباط ليبيين شهدته كلية الأمير هاشم
للعمليات الخاصة في الأردن، وكان يتقلد رتبة نقيب، ويجلس إلى يمين
اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان العامة لجيش حفتر. أبناء
ليبيا تذكروا، أغلب الظنّ، أنجال العقيد معمّر القذافي من أصحاب الرتب
العسكرية الموزّعة شذر مذر؛ وأمّا أبناء سوريا، فالأرجح أنهم تذكروا
ترفيعات بشار الأسد: التخرّج من الكلية الحربية برتبة نقيب (القوانين
العسكرية تخرّج الطالب الضابط برتبة ملازم)؛ وبعد شهرين فقط رُفّع إلى
رتبة رائد، رغم أنّ القوانين تنصّ على خدمة لا تقلّ عن أربع سنوات قبل
الترفيع إلى رتبة عليا جديدة؛ ولم يمض عام آخر حتى رُفّع الرائد إلى
عقيد، من دون المرور برتبة مقدّم؛ وفي حزيران (يونيو) 2000، بعد ساعات
أعقبت موت أبيه، رُفّع العقيد إلى رتبة فريق أوّل، وقائد عامّ للجيش
والقوات المسلحة؛ قبيل ترشيحه لرئاسة الجمهورية، بعد اجتماع ما يُسمى
«مجلس الشعب» وتعديل الدستور بما يتيح للوريث أن يتجاوز عقبة سنّ الـ40
كشرط للترشيح.
وفي خضمّ الاستعصاء الجديد الذي أعقب لجوء برلمان طبرق إلى تعيين فتحي
باشاغا رئيساً للحكومة وتشبث عبد الحميد الدبيبة بالمنصب ذاته، الأمر
الذي يزجّ ليبيا في أتون تصارع سياسي وعسكري وميليشياتي لا تُستبعد عنه
أشدّ السيناريوهات دموية؛ مَن الذي يبرز على الساحة، فيرافق رئيس
البرلمان عقيلة صالح في اجتماعاته مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد
المشري؟ الصدّام حفتر دون سواه، بالنيابة عن أبيه كما قد يقول قائل
للوهلة الأولى، ولكن بالأصالة عن نفسه أيضاً وكما تعلّمت شعوب عربية
عديدة من التجارب المريرة لتوريث الأبناء، في سوريا والعراق ومصر
واليمن طبقاً للأمثلة الأبرز على الأقلّ. وكان في وسع حفتر الأب أن
يتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي عبر عشرات الأقنية المتاحة، مكتومة كانت
أم معلَنة، إلا أنّ الحرص على إيفاد حفتر الابن يدشّن في الآن ذاته
سيرورة تصعيد الفتى لوراثة أبيه؛ وأية بوّابة خير من تل أبيب لإضفاء
اللمعان السياسي على النجوم المعدنية التي تكلل كتفَيْ الضابط الصدّام!
لا استثناء، إذن، لقاعدة توريث استبدادية سبق أن صعّدت، أو سعت إلى
تصعيد، أمثال جمال حسني مبارك، باسل وبشار حافظ الأسد، سيف الإسلام
معمّر القذافي، عدي صدّام حسين، أحمد علي عبد الله صالح… وفي هذه
النماذج لا يحدث أن يوافق شنّ طبقة، بين المورّث والوريث، بل يثبت
الفرع أنه أكثر من الأصل فساداً واستبداداً ودموية وتبعية وانحطاطاً؛
ولعلّ القاعدة هنا تكمن، وهكذا تتكرر.
استذكار اجتياح العراق
ويتامى “النظام الدولي” البائد
صبحي حديدي
تقول النكتة السوداء، لأنها إذْ تُضحك فهي أيضاً تبعث على الكرب، إنّ
أحد أقطاب “النظام الدولي الجديد”، الذي ترعرع مع جورج بوش الأب قبيل
عمليات “درع الصحراء” و”عاصفة الصحراء”، ثمّ انقرض لأنه لم يكن بالجديد
ولا بالنظام أصلاً؛ سُئل عن العلاقة الأكثر سوريالية بين الغزو
الأمريكي/ البريطاني للعراق سنة 2003، والغزو الروسي لأوكرانيا هذه
الأيام، فأجاب: غزونا العراق للاشتباه في وجود أسلحة دمار شامل، ونمتنع
عن التدخل في أوكرانيا لأنّ روسيا تمتلك ترسانة هائلة من تلك الأسلحة.
وبمعزل عن التنكيت، المفيد تماماً في حالات كهذه، لن تعدم معلقاً
عربياً كان مع “النظام الدولي الجديد” من رأسه حتى أخمص قدميه، لكنه
اليوم يلوم الولايات المتحدة، والغرب عموماً من خلفها، لأنها لا تردع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما يكفي؛ أو لأنها (وهنا بعض ذرى
التنكيت الأسود التلقائي!) إنما تخون “القِيَم” التي نهضت عليها فلسفة
التدخل الإيجابي لصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان على امتداد العالم.
وأمّا ذروة السخف، الذي لا يضحك البتة هذه المرّة، فإنّ المعلّق الهمام
إياه لن يستعيد أحداً أكثر من إدوارد سعيد، ليعلّق على كتفَيْ الأخير
مسؤولية “شحن” الشعوب بالضغينة ضدّ الغرب عبر بوابات نقد الاستشراق!
وللمرء أن يدع أمثال هذا النموذج يواصل تيهه أمام مآلات العالم ما بعد
1990، ثمّ ما بعد اندثار نظريات نهاية التاريخ وصعود إنسان اقتصاد
السوق الأخير، وما بعد 11/9 والكوارث التي انتهت إليها ردود أمريكا في
أفغانستان والعراق؛ فالتوقف عند اجترار الماضي على سبيل مضغ الحاضر عند
هؤلاء لا يجدي فتيلاً، حتى حين يقترب السجال من المأساة الأوكرانية
الراهنة، بعد أن مرّ على مآسٍ أخرى في سوريا وفلسطين المحتلة واليمن
وليبيا… للمرء، في المقابل، أن يتوقف عند التصريحات الأخيرة التي أدلى
بها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ضمن سياق ما يجري راهناً
في أوكرانيا؛ وخاصة إقراره بأنه “قد يكون أخطأ” في قرار غزو العراق
وأفغانستان، ولكنه بالطبع أصرّ على أنه “كان الأمر الصحيح” الذي يتوجب
القيام به. وبين “أخطأ” و”الصحيح”، لا يجدي فتيلاً هنا أيضاً البحث عن
الحلقة المفقودة، أو المضيّعة بالأحرى؛ خاصة وأنّ بلير كان يتحدث صحبة
أسقف كانتربري جستن ولبي، وأضاف التالي بالحرف: “سواء كنتَ على حقّ أم
لا مسألة أخرى. في تلك القرارات الكبرى فعلياً، فإنك لا تعرف ماهية كلّ
المكوّنات المختلفة، وعليك في النهاية أن تتبع غريزتك”.
مزيج من عناصر التشابه والتنافر فرض طرازاً بسيطاً من منطق ابتدائي يدفع بلير إلى الإقرار بخطأ في العراق من جهة أولى، والإعراب من جهة ثانية عن حماس مشبوب في ذمّ اجتياح أوكرانيا
في السياق أيضاً، يتوجب أن يُضاف لقب “سير” إلى اسم بلير لأنّ الملكة
منحته الوسام الأرفع للفارس الأنبل في الرباط، كما يتوجب التذكير بأنّ
أعداد الموقعين على عريضة شعبية تطالب بسحب الوسام منه، بسبب “جرائم
الحرب” التي ارتكبها في العراق، تجاوزت الـ500,000 خلال أيام قليلة
أعقبت إعلان لوائح الأوسمة. وجاء في العريضة أنّ بلير “ألحق ضرراً لا
يمكن إصلاحه، بدستور المملكة المتحدة وبالنسيج المباشر لمجتمع البلاد”،
و”كان مسؤولاً بصفة شخصية عن التسبب في وفاة أعداد لا حصر لها من
المدنيين الأبرياء ورجال الجيش”؛ وبدل تكريمه بهذا الوسام الأرفع،
يتوجب أن “يُحاسَب على جرائم الحرب” لأنه “الأقلّ استحقاقاً لأي تكريم
عام، لاسيما إذا منحته الملكة”. ومن غير الجائز، إذْ لا يتقبل التاريخ،
إغفال إصرار بلير على صحة قراره بزجّ بريطانيا في غزو العراق، بل لقد
أعلن مراراً وتكراراً أنه سيفعلها مرّة ثانية إذا اقتضى الأمر، ولن
يكون في أيّ حال “تابع أمريكا” كما يتهمه خصومه. ذلك من منطلق إيمانه
بأنّ “الولايات المتحدة وأوروبا يجب أن تعملا سوياً في خلق العالم
الجديد”، وأخشى ما يخشاه أن “تعود الولايات المتحدة إلى سياسة العزلة
والتقوقع”، وأن “تترك أوروبا وحدها لمجابهة الإرهاب والفقر والأوبئة
الكونية”…
ومراراً، أيضاً، تفاخر بلير بأنه كان سيشارك واشنطن في الإطاحة بنظام
صدّام حسين حتى من دون الحاجة إلى تأكيد وجود أسلحة الدمار الشامل،
وبلغ به الصلف حدّ التصريح علانية بأنّ عدم العثور على تلك الأسلحة كان
تفصيلاً “فنّياً” محضاً؛ وأمّا “الصورة الأهمّ” في المشروع بأسره، أي
الغزو والاحتلال وقلب النظام، فإنها كانت ثقته القصوى بصواب قراراته،
ومشروعيتها وأخلاقيتها. وبالفعل، فقد زاود بلير على الأمريكيين أنفسهم
في تصعيد الحرب النفسية، خصوصاً حين نشرت حكومته ما أسمتها “تقارير
سرية خطيرة” عن وجود ترسانة عراقية مرعبة: صواريخ سكود سليمة مصانة،
وأطنان (نعم، أطنان!) من المواد الكيماوية الجاهزة للتحوّل إلى أسلحة
كفيلة بإبادة “سكان الأرض بأكملهم”، كما جاء في النصّ الحرفي حينذاك.
وقبل الانخراط التامّ في صفوف الفيالق الأمريكية الغازية للعراق، لم
يترك بلير فرصة تفوته للإعراب عن متانة التوافق الأنغلو ـ أمريكي الذي
جمعه مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ثمّ خَلَفه جورج بوش
الابن. ولم يكن بلير سعيداً بتكديس المدائح على كلينتون فحسب، بل تعيّن
أيضاً أن يسكت عن فضائح الأخير الجنسية؛ مراهناً على رئيس مثخن
بالجراح، مقامراً بخيانة مدوّنة السلوك التي بشّر بها بلير نفسه
طويلاً، خاصة بصدد القِيَم العائلية وتجسيد المعجزة الأخلاقية
للبريطاني النيو ـ فكتوري السائر على سبيل ثالث بين اليمين واليسار!
اليوم يقول إنّ “الهجوم على أوكرانيا، وهذه ديمقراطية مسالمة انتُخب
رئيسها في انتخابات نزيهة وحرّة، لا تبرير له كلياً، والمملكة المتحدة
وحلفاؤنا كانوا على صواب حين رأوا فيه اعتداء علينا جميعاً، وعلى
قِيَمنا”؛ ثمّ يمجّد “شجاعة الشعب الأوكراني”، ويطالب أن يستمدّ الغرب
“الدروس الأعرض مما وقع”. وحين يطلق هذه التصريحات فإنّ الآلاف من
رافضي منحه الوسام الأرفع يذكّرونه بموقفه في سنة 2014 حين اندلع أوّل
اللهيب الأمريكي/ الأطلسي مع روسيا حول أوكرانيا، واعتبر بلير أنّ “على
الفريق الأوّل وضع الخلافات جانباً”، والتركيز على “تنامي ظاهرة
الإسلام المتشدد” في الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان وشمال أفريقيا،
لأنها تمثل “تهديداً كبيراً للأمن الدولي في القرن الحادي والعشرين”.
ولقد ختم بنصيحة ورجاء: “مهما كانت المشاكل الأخرى التي تلقي بثقلها
علينا، ومهما كانت خلافاتنا، علينا ان نكون جاهزين لبذل الجهود
والتعاون مع الشرق خصوصاً روسيا والصين”. نعم، “مهما كانت” إذن، بما في
ذلك ضمّ شبه جزيرة القرم وغزو أوكرانيا، أو إذا صغّرت الصين عقلها وحذت
حذو الكرملين فضمّت تايوان أو اجتاحتها؛ فلا خطر، في المقابل، يعادل
ظاهرة “الإسلام المتشدد”.
ولقد كُتب الكثير في باب المقارنة بين العراق وأوكرانيا، وتلمّس البعضُ
الفوارق العديدة بين الملفّين، وانزلق البعضُ إلى مطابقات سطحية قاصرة؛
غير أنّ مزيجاً من عناصر التشابه والتنافر فرض طرازاً بسيطاً من منطق
ابتدائي يدفع بلير إلى الإقرار بخطأ في العراق من جهة أولى، والإعراب
من جهة ثانية عن حماس مشبوب في ذمّ اجتياح أوكرانيا. وهو ذات الطراز
الذي يحثّ على استدعاء النكتة السوداء سالفة الذكر، ثمّ توسيع نطاقها
لتشمل المقارنات بين لاجئ سوري أو أفغاني أو أفريقي حالك البشرة داكن
العينين، وآخر أوكراني أبيض البشرة أزرق العينين. ولا عجب، والحال هذه،
أن تلتقي أفكار بلير، أحد أبرز أشباح “النظام الدولي الجديد”، مع يتامى
ذلك النظام البائد لجهة ترحيل الخيبة إلى تنظيرات المحافظين الجدد في
أمريكا وأوروبا تارة، أو تارة أخرى معاكسة إلى… إدوارد سعيد، دون سواه!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
سُحُب يلتسين
التي تمطر في أوكرانيا
صبحي حديدي
ليس من الإنصاف، بل لعله أقرب إلى الإجحاف، أن تُلقى على عاتق الرئيس
الروسي فلاديمير بوتين كامل إشكالية روسيا المعاصرة، سواء على أصعدة
داخلية اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية وإعلامية؛ أو على صعيد
الطموحات الجيو – سياسية التي باتت تأخذ صفة تدخل عسكري تارة، أو إلحاق
وضمّ واستتباع تارة أخرى. إنه، ليس من ريب كبير، الأكثر تحمّلاً
لمسؤوليات قرارات الكرملين في هذه الملفات، والأعلى استعداداً لمجابهة
العواقب الوخيمة خلف مغامرات جامحة على شاكلة ما فعل في جورجيا وشبه
جزيرة القرم وأوكرانيا راهناً؛ لكنه أشبه بزارع به مسّ، مصاب بخلائط
جنون العظمة وشهوة الهيمنة والتماهي المَرَضي مع القياصرة، أورثه آخرون
بذار ما يخال أنه يحصد زرعه تباعاً.
وأغلب الظنّ أنّ تاريخ روسيا، وبالتالي تاريخ العالم إبان وبعد تفكك
الاتحاد السوفييتي، لم يحفظ للرئيس الروسي الأسبق الروسي بوريس يلتسين
(1931-2007) تلك الصورة الأيقونية الشهيرة (في آب/ أغسطس من العام
1991)، أمام البرلمان الروسي، حين امتطى دبابة تابعة لجنرالات الجيش
الأحمر الذين أعلنوا الانقلاب على ميخائيل غورباتشيف، قبل أن يفشل
انقلابهم على نحو تراجيكوميدي. وليس، غالباً أيضاً، تلك الصورة
الأيقونية الأخرى (في تشرين الأوّل/ أكتوبر 1993) حين أمر – باعتباره
الرئيس، هذه المرّة، وبعد استدراج ولاء وزارة الداخلية والجيش الروسي –
بقصف مبنى البرلمان الروسي ذاته لفضّ نزاع دستوري مع النوّاب
المعارضين، على نحو غير بعيد عن الروحية ذاتها: المأساة/ المهزلة.
ما حفظه التاريخ أكثر، بدليل ملفات غوغل وغالبية محركات البحث، هو شريط
الفيديو القصير الذي يلتقط الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون عاجزاً
عن كتم موجة من الضحك الهستيري انتابته بعد سماع تعليق من يلتسين
الواقف إلى جانبه، في نيويورك، خريف 1995. لم يكن المشهد مهيناً ومذلاً
وهابطاً، بالنسبة إلى رئيس يتوجب أنه يمثّل القوة الكونية الأعظم
الثانية، فحسب؛ بل كان نمط تفضيح أقصى لطبيعة بذور التحريض الشعبوي
التي سوف يعتمدها بوتين، ربيبه وخليفته لاحقاً، بصدد إحياء نوستالجيا
الإمبراطورية. وقبل بوتين كان هذا المخمور المتهتك، يلتسين، هو الآمر
بغزو بلاد الشيشان عسكرياً، وإخضاعها، و«ضرورة قتل الكلاب المسعورة»
هناك.
وهذه السطور ليست البتة صيغة مواربة من الحنين إلى النظام السوفييتي؛
بل قد يكون مشروعاً التذكير بأنّ صاحبها ينتمي إلى تيار النقد العميق
لماركسية سوفييتية قاصرة وشائهة وستالينية، ولطراز من الاشتراكية
استولد موضوعياً سلسلة العناصر التي حتّمت اندثاره. غير أنّ الليبرالية
الروسية، الحولاء بدورها والأسوأ تشوّهاً وتسطحاً، كانت ولاّدة صعود
حكم الأفراد القلائل المقرّبين من يلتسين، القابضين على زمام الأمور في
السياسة الداخلية والأمن والاقتصاد، وأصحاب المصلحة الكبرى في هندسة
مستقبل روسيا على نحو آمن خالٍ من العواصف «الديمقراطية».
وقبل الحلقة الضيّقة التي يحيط بوتين نفسه بها، كان يكفي المرء أن
يستعرض لائحة أفراد «العائلة» هذه كي يدرك حجم تأثيرها في عقل سيّد
الكرملين، الذاهل الذاهب أبعد فأبعد نحو خريف البطريرك: تاتيانا داشنكو
(ابنة يلتسين)، ألكسندر فولوشين (رئيس أركان الكرملين)، بوريس
بريزوفسكي ورومان أبراموفيتش (أبرز شيوخ المال والأعمال والمصارف).
هؤلاء كانوا «القطط السمان» في التعبير الشائع، أو «الأوليغارشية
الجديدة» في التعبير الروسي الخاصّ، وكانوا يملكون مفاتيح الجبروت
الكبرى: من شركات النفط والصحف اليومية وأقنية التلفزة، إلى مصانع
التعدين والأغذية ومؤسسات الاستيراد والتصدير، وصولاً إلى الأهمّ
والأخطر: المصارف الخاصّة.
وإذا صحّ أنّ شخصية بوتين حمّالة تعقيدات وعُقُد وعقائد أبعد، بكثير
ربما، مما يصحّ أن يُحمّل على شخص يلتسين؛ إلا أنّ علوم الجدل، في
حدودها الدنيا، لا تسمح بإغفال تلك الحقيقة البيّنة: سُحُب الأخير هي
بعض، غير قليل، من هذه التي تمطر اليوم في أوكرانيا.
أجيال السلاح الروسي:
اختبار في سوريا
وتحديث في أوكرانيا
صبحي حديدي
في تموز (يوليو) 2021 زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مصنعاً
للحوّامات في روستفيرتول، وتفاخر بأنّ الجيش الروسي اختبر في سوريا
أكثر من 320 نمطاً من الأسلحة، وقال بالحرف: “إحدى هذه الحوّامات التي
ترونها اليوم هي نتاج العملية السورية”. قبله، ولكن في حزيران (يونيو)
2018، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد سبق شويغو في تثمين الفوائد
التي قدّمها الميدان السوري على سبيل اختبار الأسلحة الروسية: فرصة “لا
تُقدّر بثمن”، قال بوتين، مشدداً على أنّ استخدام السلاح في ساحات
القتال الفعلية لا يعادل أيّ طراز من التدريبات أو المناورات. وقبل
أيام من انطلاق الزحف العسكري الروسي نحو عمق أوكرانيا، أشرف شويغو على
مناورات روسية بحرية في المياه السورية، وبعض القطع المشاركة توجّب أن
تتحرّك بالفعل نحو البحر الأسود للانخراط في العمليات القتالية الفعلية
ضدّ أوكرانيا.
هنالك اعتبارات، لا عدّ لها ولا حصر ربما، تؤكد الفوارق الحاسمة بين
التدخل العسكري الروسي في سوريا، والاجتياح العسكري الروسي الراهن في
أوكرانيا؛ وتلك اعتبارات تتجاوز الأبعاد التاريخية والجيو-سياسية
والأمنية والثقافية، ثمّ النفسية والذاتية عند بوتين شخصياً، إلى
الفوارق بين شخص الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي (على
علاته، غير القليلة كما يتوجب القول)؛ ومجرم الحرب الصغير التابع بشار
الأسد، وبطانة الاستبداد والفساد، في سوريا. غير أنّ واحداً من جوانب
التقاطع، أو التطابق بدرجة عالية، هي حكاية اختبار الأسلحة الروسية
الحديثة، عالية التكنولوجيا، “فوق الصوتية” كما في الرطانة العسكرية،
المحاذية لأسلحة التدمير الشامل في أجيالها الكلاسيكية والمحدّثة؛
والتي، على وجه الدقة، كانت وتظل موضوعاً للتفاخر لدى كبار الجنرالات
الروس، وعند بوتين شخصياً.
وليس الأمر أنّ الجيش الروسي، في عهد بوريس يلتسين قبل بوتين، لم يمتلك
الفرصة أو الميادين لاختبار أجيال السلاح الروسي الجديدة فعلياً؛ فقد
كانت تجارب شيشنيا وجورجيا وشبه جزيرة القرم قد تكفلت ببعض هوامش
التجريب، وأسفرت عن إدخال بعض التغييرات، التي ظلت مع ذلك محدودة. فارق
الميدان السوري تمثّل، أوّلاً، في ضعف الخصم أو حتى عدم وجوده عملياً
أحياناً؛ الأمر الذي أتاح المزج بين اشتراطات الاستخدام القتالي
الميداني والنيران الحيّة، ومقتضيات الاختبار الآمن الذي يقارب
المناورة في بعض الحالات. صحيح أنّ مقاتلات تركية (إف-15 أمريكية
الصنع) تمكنت من إسقاط مقاتلة سوخوي-24 روسية في سماء سوريا، خريف 2015
بعد أسابيع قليلة على التدخل الروسي، إلا أنّ الواقعة لم تندرج في سياق
اختبار أداء الطائرة الروسية، كما أنّ هذه المقاتلة لم تكن في عداد
الصنوف الجديدة الذي عكف الجيش الروسي على تجريبها في سوريا.
الأسلحة الروسية التي تُستخدم في سوريا إنما تجرّبها موسكو تحت احتماليات فريدة من الاحتكاك مع صنوف الأسلحة الأطلسية المختلفة، والأسلحة الإيرانية، وكذلك المقاتلات الإسرائيلية
جانب ثانٍ يسبغ أهمية خاصة على حقول الاختبار السورية، لعلها استثنائية
وفريدة أصلاً، هو أنّ الأسلحة الروسية التي تُستخدم في سوريا (في سماء
الساحل تحديداً، ومناطق حمص وحلب وإدلب بصفة خاصة) إنما تجرّبها موسكو
تحت احتماليات الاحتكاك مع صنوف الأسلحة الأطلسية المختلفة، مباشرة عبر
التحالف أو الجيش التركي في الشمال، من جهة أولى؛ والأسلحة الإيرانية،
الصاروخية والمضادّة للدروع أوّلاً، من جهة ثانية؛ وكذلك المقاتلات
الإسرائيلية التي تقوم بعمليات قصف شبه منتظمة في مختلف المناطق
السورية، من جهة ثالثة. هذه حال تمنح سيرورات الاختبار الروسية قيمة
خاصة يندر أن تتوفر في الصيغة الميدانية المباشرة، لأنها أيضاً تدور في
إطار ثلاثة أصناف من ترجيح المواجهة: 1) مع خصم (متَّفَق معه ضمناً) هو
التحالف والسلاح الأطلسي؛ و2) شريك/ صديق ميدانياً (لا تغيب عنه
المنافسة وبعض الخلاف)، هو السلاح الإيراني؛ و3) حليف غير مباشر
(وأطلسي غير معلَن رسمياً)، هو السلاح الإسرائيلي.
وحال التشابك هذه، التي وحّدت سلسلة من المصالح المتطابقة تحت مظلات
عجيبة من الاختلافات الشكلية والسياسية والتحالفية، أتاحت للولايات
المتحدة والحلف الأطلسي وغالبية الحكومات الغربية أن تسكت عن اختبارات
أكثر من 320 سلاحاً روسياً جديداً، جرى تجريبها تباعاً في سوريا منذ
ابتداء التدخل الروسي خريف 2015. وقد يكون صحيحاً أنّ السكوت ذاك
اقترن، عند مَن امتلك الوسيلة، بمراقبة لصيقة لنتائج التشغيل الروسي
لجديد هذه الحوّامة أو تلك الطائرة المسيّرة؛ لكنّ أياً من المراقبين،
عن كثب أو عن بُعد، لم يتخذ من إجراءات الحدّ الأدنى بصدد واحد من أقذر
الخيارات في الصناعات العسكرية: التجريب الحيّ على البشر المدنيين، في
المشافي والمدارس والمخابز والأسواق الشعبية. حينذاك سكتت واشنطن
وبروكسيل ولندن وباريس وبرلين، هذه العواصم إياها التي تجأر اليوم
بالصراخ (وبعض النحيب كذلك!) احتجاجاً على الاجتياح الروسي في
أوكرانيا، وعلى… تطبيق ما اختُبر ضدّ أطفال ونساء وشيوخ سوريا، ولكن في
كييف وخاركيف وماريوبول…
وخلال دورة 2007 لمؤتمر ميونخ الشهير حول قضايا الأمن والدفاع، أصاخ
المندوبون السمع، والكثير منهم صفّق، خلال خطبة بوتين التي لا تقلّ
شهرة؛ ومن غرائب الصدف أنّ ذكراها الـ15 تمرّ هذه الأيام تحديداً، على
وقع قذائف الجيش الروسي وعذابات الشعب الأوكراني. وكيف يُنسى تركيز
الرئيس الروسي على القول بأنّ مشكلة الأمن الدولي أقرب صلة إلى واقع
الاقتصاد العالمي ومشكلات الفقر والحوار بين الحضارات، منها إلى
الاستقرار السياسي أو العسكري؛ أو الامتناع عن اقتباس لينين أو ستالين
أو الإمبراطورة كاترين، كما فعل مؤخراً في خطبة الزحف على أوكرانيا،
والعودة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق فرنكلين روزفلت، بصدد الحرب
العالمية الثانية: “أينما يُنتهك السلام، فإنّ العالم كلّه يقع تحت
التهديد”. الغرب صفّق، لكنه تنبّه أيضاً إلى المرارة الدفينة في رثاء
بوتين للاتحاد السوفييتي وحلف وارسو، وهجاء تمدّد الحلف الأطلسي نحو
رومانيا وبلغاريا، والتلويح بأنّ الآلة العسكرية الروسية في تطوّر
حثيث.
ولقد عقد بوتين اجتماعاً دراماتيكياً مع أركان القيادة العسكرية
الروسية، وأبلغ العالم بأنّ روسيا سوف تنشر في الأعوام القليلة القادمة
أنظمة صواريخ نووية جديدة متفوّقة على كلّ ما تمتلكه القوى النووية
الأخرى في العالم أجمع. وفي تصريحات ساخنة قال إنّ بلاده لن تكتفي
بالأبحاث النووية والاختبارات الناجحة للأنظمة الجديدة، بل هي ستتسلّح
بها فعلياً خلال السنوات القليلة القادمة: “أنا واثق أنّ هذه التطوّرات
والأنظمة غير متوفرة لدى الدول النووية الأخرى، ولن تكون متوفرة في
المستقبل القريب”. وفي الخلفية كان ثمة تصريح جورج روبرتسون، الأمين
العام الأسبق للأطلسي، بأنّ الحلف بات يضمّ دولاً تمتدّ مساحتها من
فانكوفر في كندا إلى فلاديفوستوك شرق روسيا. وفي خلفية ثالثة كان
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن قد اعتبر أنّ الحرب الباردة
انتهت الآن فقط، مع صدور “إعلان روما” الذي تضمّن تشكيل المنتدى الأمني
الجديد، بعضوية دول حلف شمال الأطلسي الـ19، بالإضافة إلى روسيا: أيّ
أنها لم تنتهِ على يد جورج بوش الأب والرئيس السوفييتي ميخائيل
غورباتشوف، بل جورج بوش الابن ونظيره فلاديمير بوتين!
وما يشعله بوتين اليوم في أوكرانيا قد لا يكون جولة أولى في الحرب
الباردة الثانية، لكنه ليس البتة بعيداً عن التطبيق العملي لحذافير
عديدة في خطبة ميونخ 2007، لجهة كسر نظام القطب الواحد واستئناف
الإمبراطورية الروسية بوسائل الغزو العسكرية ذاتها التي انتبذها بوتين
قبل 15 سنة؛ مع فارق حاسم: لقد اختبر في سوريا، وها أنه اليوم يحدّث
ويستحدث في أوكرانيا… ليس أقل”!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
بين جنون العظمة وصَغار النفس:
قواسم بوتين والأسد
صبحي حديدي
في توصيف حرب الاجتياح والإلغاء والإلحاق التي يشنها الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين ضدّ أوكرانيا الشعب والبلد والتاريخ، يصعب أغلب الظنّ
العثور على اختزال أكثر ضحالة وركاكة وتعبيراً عن الذيلية والتذلل أكثر
من تصريحات رأس النظام السوري بشار الأسد. ومجرم الحرب هذا، سليل عائلة
فاسدة مفسدة طائفية تحكم سوريا منذ 52 سنة بأشدّ صنوف الاستبداد وحشية
وهمجية وتجرّداً من كلّ وأيّ رادع، هو نفسه الذي هاتف بوتين كي يطمئنه
إلى أنّ بربرية الجيش الروسي في أوكرانيا هي «تصحيح للتاريخ وإعادة
للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي». ليس هذا
فقط، بل إنّ «مواجهة روسيا لتوسّع الناتو هو حقّ لأنه أصبح خطراً
شاملاً على العالم»، وتوجّب أن يختم المهووس بالتفلسف الأجوف هكذا:
«الهستيريا الغربية تأتي من أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ».
والأسد هذا هو، نفسه، الذي يواصل تراث أبيه في اغتصاب سوريا وتخريبها
وتدمير بُناها الوطنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والديمغرافية،
ويتمرّغ في إسار احتلال من دولتين أطلسيتين (الولايات المتحدة وتركيا)،
وثالثة بمثابة مخفر أمامي أطلسي (دولة الاحتلال الإسرائيلي)، إلى جانب
روسيا بوتين إياه، وإيران آيات الله مباشرة أو عبر «حزب الله» وشتى
المرتزقة والميليشيات المذهبية. ورغم حرص الكرملين على الإيضاح بأنّ
اتصال الأسد جاء بمبادرة منه، وليس من بوتين؛ فإنّ إعلام النظام، صحبة
هذه أو تلك من الأقنية «الممانعة»، حرص على التشديد بأنّ سيّد الكرملين
«تشاور» مع الأسد قبيل الشروع في اجتياح أوكرانيا.
وهذه حال تذكّر بمسخرة أخرى، من الجانب الروسي هذه المرّة، بصدد
العلاقة مع رأس النظام السوري؛ ساعة انقلاب الأخير إلى وحش أعزل، مطلع
العام 2012. يومذاك بادر فاليري غانيتشيف، رئيس «اتحاد كتّاب روسيا»،
إلى منح الأسد جائزة «أحد أهم رجال الحقل السياسي والاجتماعي
والحكومي»، وذلك بسبب «صموده في مقاومة الهيمنة الغربية في محاولة
إملاء إرادة مستعمري عالمنا الحالي على الشعب السوري». وقال الرئيس
العتيد، في خطبة تسليم الجائزة إلى سفير النظام في موسكو: «توجد
مجموعات متضررة من مقاومة الهيمنة تحاول استثارة الشارع، ونرى ازدواجية
المعايير في التعاطي مع الأحداث في المنطقة»؛ مشدداً على أنّ «سوريا
كإحدى أروع التشكيلات الاجتماعية، تتعرض لهجمات همجية لتفتيتها تحت اسم
ثورة».
وهكذا فإنّ غانيتشيف لم يسمع بمقتل الآلاف وبينهم أطفال ورضّع،
والتمثيل بالجثث، واغتصاب الصبايا والنساء، وممارسة أبشع صنوف التعذيب،
واعتقال عشرات الآلاف، وتحويل المدارس والملاعب والساحات العامة وعربات
القطارات وحاويات السفن إلى سجون. ولم تبلغه أخبار حصار القرى والبلدات
والمدن، واستهدافها بأسلحة ثقيلة شتى، من المدفعية وراجمة الصواريخ،
إلى الحوّامة والقاذفة المقاتلة. وتلك الانتفاضة الشعبية في سوريا ليست
من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة والمستقبل الأفضل، بل هي
«هجمة شرسة»، فقط، تستهدف الأسد «الذي يلاقي تطلعات شعبه».
وأبعد من مبدأ الطيور التي على أشكالها تقع، إذ شتان بين آمر غازٍ نووي
النواجذ مثل بوتين، وتابع صاغر مهين كيميائي الحقد براميلي الضغينة مثل
الأسد؛ ثمة، هنا، طراز لافت من التكامل المَرَضي بين جنون العظمة
ونوستالجيا الإمبراطورية عند الأوّل، وجنون صَغار النفس وهوس التشبث
بالسلطة عند الثاني. وفي تدابير الأحكام الجيو – سياسية، وما يتحكّم في
مسارات هذا أو ذاك من كبار الأباطرة وصغار الطغاة؛ لا تصحّ الاستهانة
بالبواطن الخافية طيّ أباطيل بوتين حول محاربة النازية في أوكرانيا، أو
تخرصات الأسد حول تصحيح التاريخ.
الجاهز للتهديد بالأزرار النووية في تبرير اجتياح بلد وإلغاء شعب، أو
المستعدّ لقصف بلدات وقرى بقذائف إبادة جماعية كيميائية وجرثومية، ليسا
في نهاية المطاف بحاجة إلى وقوع الشكل على الشكل، ويكفي سجود الثاني
أمام الأوّل كي تتضح الصلات، ويُعثر على القواسم المشتركة.
من العراق إلى أوكرانيا:
سكوت ريتر
وذاكرة الأباطيل الأمريكية
صبحي حديدي
مَن يتذكّر سكوت ريتر، المفتش الأشهر عن أسلحة الدمار الشامل في
العراق؛ والفاضح الأكبر لأكاذيب الإدارة الأمريكية حول الملفّ، وكيف
صارت مهاداً لاجتياح العراق وصناعة «عاصفة الصحراء» وعواقبها الكارثية؛
والمُراجِع الأبرز للذات أوّلاً، ثمّ لسنوات وسنوات من صناعة الأباطيل
والأضاليل بصدد العراق وإيران فالشرق الأوسط طولاً وعرضاً، مقابل
السكوت عن كلّ هذه الملفات حين تتصل بدولة الاحتلال الإسرائيلي؟ أو، في
صياغات أخرى لفحوى الأسئلة إياها: لماذا يصحّ استذكار ريتر في هذه
الأيام بالذات: مفاوضات فيينا المتعثرة، حول البرنامج النووي الإيراني؛
والاستعصاءات المتعاقبة بصدد استحقاقات دستورية، مركزية وهيكلية، في
العراق؛ والتسخين على جبهة أوكرانيا بين أمريكا والحلف الأطلسي من جهة،
وروسيا (بانخراط غير تامّ، حتى الساعة، مع الصين) من جهة ثانية؟
سبب أوّل يسوّغ هذه العودة إلى ريتر، هو سلسلة شهادات بليغة بقدر ما هي
إشكالية، حول هذه الملفات وسواها؛ دوّنها الرجل في مناسبات عديدة، لعلّ
أشدّها وضوحاً من حيث التوثيق تلك الفصول الشاهدة في عدد من مؤلفاته
ذات الصلة: «نهاية اللعبة: حلّ مشكلة العراق ـ مرّة وإلى الأبد» 1999؛
«سرّي عراق: القصّة المكتومة عن مؤامرة الاستخبارات الأمريكية» 2005؛
و«هدف إيران: الحقيقة عن خطط الحكومة الأمريكية لتغيير النظام» 2006؛
وكذلك الكتاب الأحدث والأوسع نطاقاً «الملك العقرب: اعتناق أمريكا
الانتحاري للأسلحة النووية من روزفلت إلى ترامب» 2020. سبب ثانٍ هو أنّ
ريتر اتخذ، بعد إنهاء مهامه في تفتيش العراق واضمحلال الشخصية التي
قُدّم بها في الإعلام الأمريكي وتمزج بين رامبو المارينز وشرلوك هولمز
التحقيق، مال عموماً إلى معارضة غالبية سياسات الإدارات الأمريكية
المتعاقبة تجاه الشرق الأوسط. وبالطبع، لم تتجرّد معارضاته من نزوع
التغريد خارج السرب على مبدأ خالفْ تُعرف، وكذلك محاولة الاقتداء بنجوم
التحقيق الصحافي (سيمور هيرش في المثال الأبرز، والموقف من الهجمات
الكيميائية التي استهدفت الغوطة وخان شيخون في سوريا).
حزمة ثالثة من الأسباب هي أنّ ما يقوله ريتر اليوم عن أجواء الحرب
المتصاعدة على الجبهة الأوكرانية تحمل الكثير من المغزى، وتقترح العديد
من التأويلات، حول طبائع التسخين من جانب الإدارة الأمريكية تحديداً؛
وما إذا كان النسق العام يعيد إنتاج مناخات مماثلة لجأ إلى تصنيعها
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب سنة 1990، والرئيس الأمريكي
الأسبق جورج بوش الابن سنة 2003، قبيل غزو العراق في الحالتين. المرء
هنا، في أخذ مقترحات ريتر على محمل التصديق أو التشكيك، يتوجب أن
يتجاوز شخصية المفتش الرامبوي/ الهولمزوي، إلى الموظف (رفيع المسؤوليات
أحياناً) الذي عمل ضابطاً في المارينز خلال 7 سنوات، ومفتشاً في
الاتحاد السوفييتي خلال تطبيق معاهدة القوات النووية متوسطة المدى
INFK
سنوات 1991-1998، وعضواً في أركان الجنرال نورمان شوارزكوف أثناء حرب
الخليج. وبهذا المعنى يجوز فيه اعتماد النصح العتيق الصائب: إسألْ مَن
كان بها خبيراً، في تفاصيل عديدة ليس أقلها أهمية حكاية تلفيق المخاطر
وتصنيع الأوهام وتضخيم المخاوف في التهيئة للحرب.
وهكذا، بادر جون راشيل، مدير «مشروع عوائد السلام» الأمريكي، إلى إجراء
حوار مسهب مع ريتر، مؤخراً، وطرح عليه عدداً من الأسئلة التي تغطي
الراهن في العلاقات الدولية وموقع الولايات المتحدة وأمراض الديمقراطية
الأمريكية؛ ولكنها الأسئلة التي تذهب أبعد من هذه المحاور إلى العديد
من الجوانب الجوهرية التي طبعت، وما تزال، النظام السياسي العالمي
الراهن والموروث معاً، ومعادلات القوى العظمى على أصعدة شاملة. الهاجس
الأول كان «ساعة القيامة» النووية، وهل يتوجب أن تدقّ قبل 100 ثانية
كما يقول العلماء؛ حيث أجاب ريتر بأنّ العقيدة العسكرية الأمريكية لا
تفترض خيار استخدام الأسلحة النووية بقدر ما تعتبره فعلاً منفصلاً
أعلى، أو أبعد، من المهمة العسكرية الموضوعة قيد التنفيذ؛ وهذا لا يعني
أنّ خطر نزاع نووي ليس فعلياً، أو أنّ على العالم ألا يقلق.
أياً كانت مغامرات بوتين وسياساته الإمبراطورية وعربدته الراهنة في سوريا والقرم وليبيا ومالي ومدغشقر وفنزويلا والموزامبيق، أو المقبلة في تخوم أوكرانيا… كم من سكوت ريتر تحتاج الإنسانية في سبيل افتضاح الأباطيل الأمريكية؟
بذلك فإنّ الحديث عن ضبط «ساعة القيامة» ليس مهماً، لأنه إذا اتُخذ
قرار استخدام الأسلحة النووية فهذا يعني أننا فشلنا، وأننا في الساعة
صفر، وبالتالي لن تكون المهلة أكثر من ثانية واحدة قبيل اندثار
البشرية. والأرجح أنّ نبرة التهويل الدرامي في تشخيص ريتر لا تنطلق من
فراغ، قياساً على ذهنية الرجل ومحاكمته لموازين القوى العظمى وعتادها
النووي تحديداً؛ لأنه في إجابة تالية حول علاقات الشدّ والجذب بين
أمريكا وروسيا والصين، مثلاً، يرى أنّ الثلاثة انخرطوا مراراً في
تنويعات على «اللعبة الكبرى» ذاتها، التي تعتمد الجبروت العسكري وسيلة
لاكتساب السيطرة على، وتأمين، الأهداف التي تدخل تحت تصنيف المصالح
القومية العليا.
ويسأل راشيل عن عنصر الإفساد الذي طرأ على فترة علاقات الوفاق بين
واشنطن وموسكو في أعقاب بيريسترويكا ميخائيل غورباتشوف، فيساجل ريتر
بأنّ الولايات المتحدة لم تساند غورباتشوف عملياً، بل قد تكون أسهمت في
تقويض مشروعه، لأنه أرادت أن تتحوّل السلطة هناك على غرار بوريس يلتسين
الضعيف، أو دمتري مدفيديف (الذي كان المفضّل عند الرئيس الأمريكي
الأسبق باراك أوباما، مثلاً). فكان أن جوبهت بطموحات فلاديمير بوتين
إلى روسيا قوّة عظمى متجددة، وإمبراطورية محاصِصة صانعة للقطبية،
وهيمنة تمزج بين مافيا المال والأعمال والغاز والنفط وبين ضمّ جزيرة
القرم وغزو سوريا ونشر ميليشيات «فاغنر» حيثما اقتضت شروط «اللعبة
الكبرى» ذاتها. وخلاصة القول، في أعمال الشدّ والجذب، هي التالية حسب
ريتر: «الجشع يحبّ الفراغ، والبشر باتوا جشعين أكثر فأكثر، وهذا أحد
وجوه القول إنك إذا لم تنشر قوّة كافية للدفاع عن نفسك، فإنّ سواك سوف
يستفيد من هذه الفرصة»؛ ولا جديد، بالطبع، في ما يستذكره من أنّ أمريكا
وروسيا والصين، بعد فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا
واليابان، استخدمت الجبروت العسكري لحيازة مكاسب جيو ـ سياسية على حساب
الآخرين.
والحال أنّ الوقفة الراهنة عند استنتاجات ريتر تبيح استذكار نظائرها
لدى الرجل نفسه، ساعة استقال من المهامّ الرامبوية/ الهولمزوية، وأعلن
جملة أباطيل كانت من تصنيع إدارات أمريكية متعاقبة بعد قبل «عاصفة
الصحراء» وبعدها، في التمهيد لغزو البلد: 1) لا توجد رابطة بين صدام
حسين و«القاعدة»؛ 2) إمكانيات العراق الكيميائية والبيولوجية والنووية
دُمّرت في السنوات التي أعقبت حرب الخليج؛ 3) المراقبة عن طريق الأقمار
الصناعية كانت، وتبقى، قادرة على كشف أيّ مراكز جديدة لإنتاج الأسلحة
في العراق؛ 4) الحصار منع العراق من الحصول على المواد المكوّنة لصنع
الأسلحة؛ 5) فرض مبدأ «تغيير النظام» بالقوّة لن يجلب الديمقراطية
للعراق؛ و6) عواقب حرب أمريكا على العراق خطيرة للغاية على الشرق
الأوسط بأسره.
وفي كلّ حال، وكما اتضح لاحقاً بأقصى جلاء، كانت إدارة بوش الابن عازمة
على غزو العراق، عاد المفتشون أم لم يعودوا، وجرى تجريد البلد من
السلاح أم لا. كان سيد البيت الأبيض في حاجة إلى تلك المغامرة العسكرية
لأسباب ذاتية تخصّ إنقاذ رئاسته الأولى ومنحها المضمون الذي شرعت تبحث
عنه بعد مهزلة إعادة عدّ الأصوات في فلوريدا، وبالتالي صناعة ـ وليس
فقط تقوية ـ حظوظه للفوز بولاية ثانية. فما الذي اتضح من خطأ في
تقديرات ريتر تلك؟ وأياً كانت مغامرات بوتين وسياساته الإمبراطورية
وعربدته الراهنة في سوريا والقرم وليبيا ومالي ومدغشقر وفنزويلا
والموزامبيق، أو المقبلة في تخوم أوكرانيا… كم من سكوت ريتر تحتاج
الإنسانية في سبيل افتضاح الأباطيل الأمريكية؟
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
أوكرانيا: مجازفات النووي
بين أحماض وصواريخ
صبحي حديدي
التصعيد الدرامي الذي يكتنف ملفّ التأزّم في أوكرانيا بين الولايات
المتحدة والحلف الأطلسي وأوروبا من جهة، وروسيا وشخص سيّد الكرملين
فلاديمير بوتين من جهة ثانية، والارتدادات الفرعية في الصين وأسواق
الغاز من جهة ثالثة؛ لم يكن ينقصه سوى تسريبات قصر الإليزيه الأخيرة،
حول امتناع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن الخضوع لفحص فيروس كورونا
في موسكو قبيل لقائه مع بوتين، خشية أن يسرق الكرملين معطيات حمضه
النووي. صحيح أن التسريب يستهدف، بين ما يستهدف، تبديد بعض أجواء
التهكم التي أطلقتها طاولة الاجتماع، الطويلة المتطاولة الغريبة
المضحكة، بين الزعيمين؛ إلا أنّ من الصحيح أيضاً أن تكون سلسلة رسائل،
سياسية قبل تلك البصرية والبروتوكولية، وراء اختيار قطعة الأثاث
الفريدة تلك.
ثمة، بادئ ذي بدء، تباعد في محتوى الوساطة التي جاء ماكرون آملاً في
إنجازها، سواء لجهة الهوّة الفاغرة بين مواقف الاتحاد الأوروبي الذي
تتولى فرنسا رئاسته الدورية حالياً، ومواقف روسيا؛ أو، ليس أقلّ مغزى
بالطبع، بين مواقف ماكرون/ فرنسا مع قسط غير قليل من مواقف دول الاتحاد
الأوروبي إزاء الملف الأوكراني. ويندر، ثالثاً، أن يجازف أحد بالتفاؤل
حول عناصر التطابق أو التنافر في قراءة الإليزيه أمام قراءة البيت
الأبيض حيال الملفّ إياه، إذا وضع المرء جانباً حقائق تقييم باريس
لدراما التهويل التي تعتمدها واشنطن، بشراكة غير مفاجئة مع لندن، لجهة
تأكيد الغزو الروسي في أوكرانيا.
وإذا جاز الافتراض بأنّ للكرملين مصلحة غير ضئيلة في صبّ الزيت على
نيران التهويل الأمريكي بصدد الغزو الروسي، أو أنّ تسعير هذا السيناريو
تحديداً يدغدغ الجوانب «الحربجية» في شخصية بوتين وعلى نحو ذاتيّ
وسيكولوجي في المقام الأوّل؛ فإنّ للعبة، بما تنطوي عليه من أخطار عضّ
الأصابع المتبادل، حدودها القصوى التي لا تسمح بالكثير من اللهو. ثمة
مجازفات نووية الطابع، لا تبدأ من نشر الصواريخ المدججة بالرؤوس إياها
ولا تنتهي عند المناورات الحساسة التي يجريها الروس بأسلحة لا تُجرّب
حتى ضمن عمليات روسيا العسكرية في سوريا؛ ورغم كل الاحتياطات التي
تُتخذ حين يكون الخيار النووي على المحك، فإنّ الحذر لا يُنجي دائماً
من… القدر!
وليست متجردة كثيراً من القيمة، والمغزى، ما تسرّبه إلى وسائل الإعلام
وكالاتُ الاستخبار الأمريكية المختلفة حول مخاطر من نوع آخر مختلف، لا
يخطر على بال أبناء البشر العاديين متواضعي العلم والمعلومات في هذا
المضمار: أنّ الإفراط في التهويل، والإيحاء بأنّ المعطيات الاستخبارية
الأمريكية تبيح القول باحتمال غزو روسي وشيك، قد يقلب السحر على الساحر
إذا لم يقع الغزو فعلياً (وهذا أمر وارد ومرجّح بالطبع)، ويقزّم ما
توحي به أجهزة التجسس الأمريكية من سطوة كبيرة ومكانة عالية ويد طولى.
في المقابل، ليس في وسع بوتين أن يشعل الكثير من النيران في نفوس أبناء
روسيا حول الكبرياء القومية ونوستالجيا القوّة العظمى وأنموذج ضمّ
جزيرة القرم، فضلاً عن التبختر هنا وهناك في طول العالم وعرضه، وإفساد
خطط أمريكا والغرب مباشرة أو عن طريق مرتزقة «فاغنر»… ثمّ الاضطرار إلى
التراجع، أياً كانت مظاهره، بما يعنيه ذلك من انسحاب خارج اللعبة، أو
حتى خسرانها.
جدير بالاستذكار هنا، وفي كلّ نسق مماثل من التأزّم، أنّ الضحية الأولى
لن تسقط في صفوف الوحدات الروسية المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا، ولا
في صفوف أفواج الحلف الأطلسي أو الفرقة 82 الأمريكية الشهيرة؛ إذْ
سيكون المواطن الأوكراني، حتى ذاك الموالي لروسيا أو نصير الرئيس
الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، هو وقود أيّ انتقال للحال من
التصعيد الدرامي الحالي إلى خيارات أخرى ذات صبغة عسكرية.
وليس هذا المآل سوى واحد من أكثر دروس التاريخ صحّة وقسوة، في آن.
فيسبوك الزراعة وغوغل المبيدات:
العملاق الرقمي وقوت البشر
صبحي حديدي
قد يُفاجأ البعض، أو الكثيرون ربما، إزاء معطى يقول إنّ نطاق العولمة
الكونية في قطاع الزراعة وإنتاج الأغذية والتخضير وما يرتبط بها من
توفير مؤشرات مناخية وبيئية وتحليلية، إنما باتت أسيرة احتكار خمسة
عمالقة، مُعولَمين تماماً كما يتوجب القول، لا تخطر أسماؤهم على البال
بسهولة حين يتصل الأمر بالحقول الزراعية السالفة. هؤلاء هم: ميكروسوفت،
ألفابيت (أي غوغل) أبل، أمازون، وميتا (أي فيسبوك وملحقاته)؛ مكوّنات
المركّب المالي/ الرقمي الذي يسيطر، في ميادين الزراعة إلى جانب قطاعات
أخرى كثيرة، على سياسات الحكومات كما يتمّ فرضها مباشرة أو عبر وساطات
البنك المركزي الأوروبي
ECB،
والاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وعمالقة شركاء آخرين أمثال فانغارد
وبلاكروك (اللذين يمتلكان أصولاً مختلفة تفوق ما يمتلكه الـECB
والفدرالي مجتمعين!).
فوق هذا وذاك، تقول أحدث التقارير النقدية (التي، للإيضاح المفيد، لا
يكتبها دائماً أخصائيون ينظرون خلفهم بغضب إلى اقتصاد السوق أو توحّش
العولمة أو تطورات النظام الرأسمالي العالمي المعاصر)؛ إنّ سياسات
المفوضية الأوروبية، وليس في مسائل الزراعة وتشجيع المبيدات والمنتجات
الكيميائية فقط، باتت خادمة مباشرة لاستثمارات العمالقة الخمسة
وشركائهم. وفي بلد/ شبه قارّة، مثل الهند تبسط ولمورت وأمازون سيطرتها
على قطاع البيع الإلكتروني بالمفرّق، تؤازرها في استثمارات مباشرة
شركات أدوية وكيميائيات مثل باير وكورتيفا وكارجيل، والحكومة من جانبها
تسهم في سيرورة الشراكة عن طريق توفير معطيات الإنتاج وخطط التحكم
والبرمجيات التي تفيد العمالقة في تحديد مَن يحتاج ماذا وأين وكيف. وفي
كانون الأول (ديسمبر) الماضي أصدرت منظمة «أوروبا أصدقاء الأرض»
تقريراً قاتماً حول تأثير مجموعات الضغط العاملة لصالح العمالقة في
الدفع باتجاه إبطال علامات الفحص والتدقيق الهادفة إلى ضمان الأمن
الغذائي للمستهلك، وأشار التقرير إلى أنّ تلك المجموعات أنفقت 36 مليون
يورو في هذا السبيل، وعقدت 182 اجتماعاً مع كبار المسؤولين في الاتحاد
الأوروبي.
المرء، مع ذلك وسواه كثير من الوقائع الصارخة، يندر أن يعثر في مؤتمرات
منظمة الأغذية والزراعة، الـFAO،
على سجال فعلي وفعّال حول انحطاط الزراعة، سياسة واقتصاداً وثقافة،
بفعل تأثيرات العمالقة على أصعدة عديدة ومتكاثرة. ويكتسب هذا الغياب
بُعداً أكثر خطورة حين تُعقد مؤتمرات المنظمة لتغطية أوضاع مناطق واسعة
شاسعة، مثل الدورة الـ36 التي احتضنتها العاصمة العراقية بغداد قبل
أيام. النطاق هنا يُدعى «الشرق الأدنى وشمال أفريقيا» حسب رطانة الأمم
المتحدة؛ ودُعيت إلى أعماله الدول التالية: أفغانستان، الجزائر،
أذربيجان، البحرين، قبرص، جيبوتي، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت،
قرغيزستان، لبنان، ليبيا، مالطا، موريتانيا، المغرب، عُمان، باكستان،
قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس،
تركمانستان، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، واليمن. وأمّا الشعار
فإنه لا يقلّ طموحاً عن أعداد الدول الغفيرة هذه: «التعافي ومعاودة
التشغيل: الابتكار من أجل نظم غذائية زراعية أفضل وأكثر اخضراراً وأكثر
قدرة على الصمود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
تحدّث ضيوف عن سباق ضدّ عقارب الساعة لتدارك الإيقاع المتسارع للمجاعة الشاملة القادمة، وحسد قطط العالم المتقدّم وكلابه على ما تنعم به من تسامح حكومي وشعبي إزاء ميزانيات أغذيتها، وناح واشتكى وتباكى
وإذْ يواصل عمالقة أمثال ميكروسوفت وغوغل وأبل وأمازون وفيسبوك تحويل
قوت البشر إلى «بزنس» هابط إلى أدنى أصعدة التوحش، لا يُعنى باعتبار
آخر يسبق تكديس مليارات الأرباح، تواصل منظمة الأمم المتحدة اجترار
اللغة الخشبية العتيقة ذاتها، التي تتكرر في كلّ مؤتمر ومنتدى؛ فلا
تسلم من البلاغة الجوفاء حتى تلك الملتقيات التي تُعقد في قلب أوروبا،
على غرار المؤتمر السنوي الذي تستضيفه برلين. وخلال مشاركته في هذا
المؤتمر (ولكن عبر الفيديو فقط!) اعترف المدير العام للـFAO
شو دونيو بأنّ ما يقارب 95٪ من الإنتاج الغذائي العالمي يعتمد على
التربة، هذه التي «يعاني ثلثها أصلاً من التدهور» وتتعرّض كلّ يوم
لأخطار جسيمة بسبب «الممارسات الزراعية غير المستدامة، والاستغلال
المفرط للموارد الطبيعية». كذلك هتف دونيو: «قلب مسار تدهور التربة أمر
شديد الأهمية إذا أردنا إطعام سكان العالم الذين يزداد عددهم، وحماية
التنوع البيولوجي، والمساعدة في التصدي لأزمة المناخ التي تعصف
بالكوكب».
وغنيّ عن القول إنّ كلام الرجل، وتوصيات مؤتمراته وموائده المستديرة
وتقاريره، في واد لا صلة تجمعه بالوديان التي فيها ينشط العمالقة ومن
داخلها يحتكرون قوت البشر وموارد الأرض الزراعية. ومؤتمر بغداد، مثل
مؤتمر برلين الذي سبقه، لا يقطع خطوة واحدة إضافية على الدرب الذي
اقترحه «إعلان المنتدى الدولي حول الزراعة الإيكولوجية» الذي انعقد
مطلع 2015 في سيلينغي (مالي) على هامش المنتدى العالمي للسيادة
الغذائية؛ ونطق باسم منظمات وحركات دولية مختلفة تمثّل صغار منتجي
أغذية ومستهلكين، ومزارعين، وتجمعات وشعوب أصلية (في عدادها الصيادون
والقاطفون) ومزارعين أسريّين، وعمّال ريفيين، ومربّين ورعاة، وبحارة
حرفيّين وسكّان مناطق حضريّة. جميعهم ينتجون ما يقارب الـ70٪ من
الأغذية التي تستهلكها البشرية، وكانوا بذلك أكبر المستثمرين في
الزراعة على نطاق العالم، وأكبر مصدر للشغل وسبل العيش.
هنا، في ترجمة «شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية» فقرة ثمينة من ذلك
الإعلان الفريد: «قطعت شعوبنا وقطاعاتنا ومنظماتنا وتجمعاتنا شوطاً
كبيراً في تحديد مفهوم السيادة الغذائية باعتبارها راية للنضال
التضامني من أجل العدالة وإطاراً أوسع للزراعة الإيكولوجية. تطورت نظم
إنتاج أجدادنا على مدى آلاف السنين، وسُمّيت زراعة إيكولوجية خلال
السنوات الثلاثين إلى الأربعين الماضية. الزراعة الإيكولوجية، كما
نفهمها، تشمل ممارسات ناجحة وإنتاجاً عالي الجودةِ؛ فهي تنطوي على
علاقات متجذّرة بين المزارعين في مناطقنا، في مراكز التدريب لدينا،
وهياكلنا النظرية والتقنية والسياسية التي تطورت في مناطقنا (…) يولّد
تنوّع أشكال الإنتاج الغذائي على مستوى المستَغلات الصغيرة، والتي
تستخدم المسارات الإيكولوجية، معارف محلية ويعزز العدالة الاجتماعية،
كما يكفل تألق الثقافة والهوية ويعزز الحيوية الاقتصادية للمناطق
الريفية. يدافع صغار المنتجين عن كرامتنا عندما نختار الإنتاج وفق
الزراعة الإيكولوجية».
ولم يكن الإعلان في حاجة إلى استبصار الهيمنة الراهنة التي يمارسها
العمالقة الرقميون، فالقسط الأعظم من المشكلات والعلل التي يواجهها قوت
الأرض بسبب أنساق تلك الهيمنة كانت قائمة لتوها، آخذة في التكوّن
التدريجي والمنهجي، ماضية على طريق الاستقرار كقاعدة وليس كاستثناء.
كانت شركات الصناعات الغذائية، مثلما هي اليوم، تنتج الأطعمة التي
تسمّمنا، وتدمّر خصوبة التربة، وتلوّث المياه، وتجتث أشجار الغابات،
وتفسد شطآن الصيد، وتسرق بذور المزارعين لإعادة بيعها بأثمان باهظة أو
لإعادة إنتاجها طبقاً لتعديلات كيميائية ملوِّثة… كل هذا عدا عن آثار
«اتفاقات التجارة الحرّة والاستثمار وآليات تسوية النزاعات بين
المستثمرين والدول، والحلول الخاطئة مثل أسواق الكربون والسَّلعنة
المتزايدة للأراضي والغذاء» حيث لا تؤدي هذه إلا «إلى تفاقم هذه
الأزمات» كما يقول الإعلان.
وفي قمّة روما 1996 كان جاك ضيوف، المدير العام الأسبق للـFAO،
قد قرع نواقيس الخطر، في كلّ فقرة من فقرات خطاب طويل كان من الممكن أن
يحسده عليه توماس مالتوس، القسّ والمنظّر الأشدّ تشاؤماً حول مآلات
أغذية البشر. ولقد تحدّث ضيوف عن سباق ضدّ عقارب الساعة لتدارك الإيقاع
المتسارع للمجاعة الشاملة القادمة، وحسد قطط العالم المتقدّم وكلابه
على ما تنعم به من تسامح حكومي وشعبي إزاء ميزانيات أغذيتها، وناح
واشتكى وتباكى. ولكنه تأتأ طويلاً بصدد الاتهامات الصارخة المشروعة
التي أشار إليها وسردها تقرير المؤتمر الموازي للمنظمات غير الحكومية،
الذي انعقد على هيئة مؤتمر مضادّ، وطرح حزمة أسئلة، كانت وحدها الجديرة
بالدراسة والتحليل والحلّ.
هي ذات الأسئلة، مع فارق وحشي هائل وهمجي أدخل العمالقة الرقميين إلى
بيت مؤونة الإنسانية وكرّس أمثال فيسبوك الزراعة وغوغل المبيدات.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
الذكرى الـ40 لمجزرة حماة:
التواطؤ المستدام
صبحي حديدي
«فظائع، مجازر، وجرائم حرب» كتاب أشرف على تحريره ألكسندر ميكابريدزه،
المحامي وأستاذ التاريخ في جامعة لويزيانا؛ وصدر سنة 2013 ضمن منشورات
ABC-CLIO.
والعمل أقرب إلى قاموس، بترتيب أبجدي لوقائع تبدأ من سنة 689 قبل
الميلاد، مع مجزرة بابل التي أمر بارتكابها سنحاريب ملك آشور، واسفرت
عن مقتل كامل سكان المدينة، وتحويل مياه الأنهار لتغمرها تماماً؛
وتنتهي في سنة 2012، مع مجزرة الحولة التي ارتكبتها قوات النظام السوري
في بلدة تلدو ومحيطها، وبلغ عدد ضحاياها 108 بينهم 34 امرأة و49 طفلاً
(حسب الأمم المتحدة، التي استند الكتاب إلى أرقامها). تاريخ صدور
الكتاب يفسّر غياب مجازر تالية ارتكبها جيش بشار الأسد والميليشيات
المناصرة له في مواقع وتواريخ أخرى في سوريا، خاصة تلك اتخذت صفة
الهجمات الكيميائية.
لكنّ آل الأسد، الأب حافظ مثل شقيقه رفعت ووريثه بشار وابنه الثاني
ماهر والضباط أو زعماء الميليشيات والعصابات من أبناء العمومة
والخؤولة، لهم نصيب في مادة ثانية أساسية تضمنها الكتاب؛ هي مجزرة
مدينة حماة، 2 شباط (فبراير) 1982، التي تمرّ هذه الأيام الذكرى الـ40
لارتكابها. وصحيح أنّ هذه المادة الثانية تشير، أيضاً، إلى فظائع وقعت
في سجن تدمر، لكنها إشارات وجيزة تماماً لا تتجاوز حفنة كلمات، ضمن
مادّة قوامها 414 كلمة. وكان في وسع ميكابريدزه أن يتوقف، حتى في إطار
الإيجاز ذاته، عند سلسلة من الفظائع التي سبقت مجزرة حماة أو أعقبتها،
وارتكبها النظام بالطرائق الوحشية ذاتها، التي بلغت شأو جرائم الحرب
بامتياز. تلك كانت حال مجازر جسر الشغور (200 ضحية) في قلب المدينة؛
وسوق الأحد (190ضحية) وحيّ هنانو (83 ضحية) وحي المشارقة (86 ضحية)
وبستان القصر (35 ضحية) في مدينة حلب… وليس غيابها عن الكتاب سوى مظهر
صريح فاضح لطبائع قصور الرأي العام العالمي، والإعلام الدولي من خلفه،
عن الالتفات إلى ما كانت سوريا تشهده من فظائع وشنائع وجرائم حرب.
في مؤلفات غربية أخرى، وباستثناء شبه حصري لأعمال عدد من المؤرخين
الإسرائيليين الذين عنوا بالملفّ لأسباب تتصل بمصالح دولة الاحتلال
وهواجسها ورهاناتها على البيت الأسدي (موشيه ماعوز وأفنير يانيف، في
«سوريا تحت الأسد» 1986، على سبيل المثال)؛ كان نادراً تماماً أن يجد
القارئ الغربي مادّة معقولة في الحدود الدنيا، وليس البتة مفصلة أو
شاملة، حول تلك المجازر. البريطاني باتريك سيل، مؤلف سيرة عن الأسد
الأب شديدة التعاطف والذي ظلّ صديقاً للنظام حتى آخر يوم في حياته،
اعتبر معركة حماة «الفصل الأخير في صراع طويل مفتوح» خلف «العداءات
القديمة متعددة المستويات بين الإسلام والبعث، والسنّة والعلويين،
والريف والمدينة». وهذا تأويل لم يكن قاصراً وضحلاً وتنميطياً فحسب، بل
هو كلّ هذه السمات مُضافة إليها نزعة التعمّد إلى التسطيح التضليلي
والتبسيط التشويهي.
كان سيل يعرف أنّ المجازر المنظمة التي شهدتها المدينة وقعت من دون سبب
ظاهر أو مباشر، مثل اندلاع قتال مع المسلحين الإسلاميين مثلاً؛ وكان
الهدف منها إنزال العقاب بالمدينة وأهلها، وتثبيت ما سيتجاسر مراقب
غربي آخر هو الأمريكي توماس فردمان على تسميته «درس حماة». لقد شهدت
المدينة مجازر في حيّ «حماة الجديدة» حيث تمّ تجميع الأهالي في الملعب
البلدي، ونهب بيوتهم، ثمّ العودة إليهم وقتل قرابة 1500، بنيران
الرشاشات؛ وفي حي «سوق الشجرة» وأسفر عن مقتل 160 مواطناً، رمياً
بالرصاص أو دفناً تحت الأنقاض، وحشر 70 آخرين في متجر لبيع الحبوب
وإشعال النار فيه؛ وفي «حي البياض» حيث قُتل 50 وأُلقيت جثثهم في حفرة
مخصصة لمخلفات معمل بلاط؛ و«سوق الطويل» حين أُعدم 30 شاباً على سطح
السوق، وحُشر 35 آخرون في متجر للأدوات المنزلية؛ و«حي الدباغة» حين
حُشر 35 مواطناً في منشرة للأخشاب، وتمّ إشعال النار فيها؛ و«حي
الباشورة» الذي شهد إعدام عائلات بأكملها، من آل الكيلاني والدباغ
والأمين وموسى والقاسية والعظم والصمام وتركماني؛ وتفاصيل رهيبة مماثلة
تكرّرت في مجازر أحياء العصيدة والشرقية والبارودية ومقبرة سريحين
والمستشفى الوطني…
خاتمة تلاوين التواطؤ المستدام لن تكون تهافت بعض الأنظمة على إعادة تأهيل النظام السوري؛ فمَنْ يهُن مع دولة الاحتلال كيف لا يسهل عليه الهوان مع البيت الأسدي، أو مع ما تبقى من جدرانه المتداعية
أسبوعية الـ«إيكونوميست» البريطانية، العريقة ومنبر اقتصاد السوق ورجال
المال والأعمال، كتبت (ولكن بعد قرابة شهرين على المجزرة!) أنّ
«الرواية الحقيقية» لما جرى في مدينة حماة «لم تُعرف بعد، ولعلها لن
تُعرف أبداً». وإذْ اعترفت بأنّ المدينة صارت «خرائب» بعد أن قُصفت
بالدبابات والمدفعية والطيران على امتداد ثلاثة أسابيع، وأنّ «جزءاً
كبيراً من المدينة القديمة قد هُدم تماماً، وسُوّي بالجرافات»؛ فإنّ
المجلة تفادت تماماً استخدام مفردة «مجزرة» وفضّلت في المقابل اعتماد
توصيف للصراع هو الأشدّ غموضاً وركاكة في آن: متمردون، ضدّ قوّات
حكومية! ولم تكن الـ»إيكونوميست» أفضل حالاً من موقف الحكومة
البريطانية، وتحديداً مارغريت ثاتشر رئيسة الوزراء آنذاك، رغم الجفاء
الظاهر الذي كان يهيمن على العلاقات البريطانية ـ السورية في تلك
الحقبة.
الإنصاف يقتضي، خاصة في هذه الذكرى الـ40، إفراد صحيفة «ليبيراسيون»
الفرنسية التي شذّت عن القاعدة، بفضيلة الروح الفدائية التي تحلّى بها
أحد كبار مراسليها، سورج شالاندون، الذي خاطر بحياته وتسلل إلى حماة
تحت اسم مستعار (شارل بوبت) وصفة كاذبة (باحث في الآثار)؛ وهو الذي سوف
يكون أوّل صحافيّ أجنبي يدخل المدينة الشهيدة، ويسجّل بأمّ العين
الكثير (وليس، البتة، جميع) ما حاق بأهلها وبعمرانها، القديم قبل
الحديث، من قتل وتخريب وتدمير. «الأموات أخذوا يُعدّون بالآلاف أوّلاً،
ثمّ بالمئات، ثمّ بالآلاف خلال الساعات الأولى فقط. لقد رافقني أحد
وجهاء المدينة، فتنقلنا من بيت إلى بيت، ورأينا العائلات الثكلى،
والجثث التي تُجرّ من الأقدام، أو تُحمل على الأكتاف» كتب شالاندون؛
متقصداً أن يخنق في داخله روح الروائي، هو المتمرّس في فنّ السرد
والحائز على جوائز مرموقة، كي ينتصر لواجب الإخبار الفعلي عن الأهوال
التي شهدتها حماة.
وما دام أحد كبار صنّاع المجزرة، رفعت الأسد، قد عاد إلى سوريا على
رؤوس الاشهاد، ليس من دون تواطؤ لا يخفى من جانب الأجهزة الأمنية في
فرنسا، موئل اليعاقبة والثورة الفرنسية والكومونة؛ فإنّ ابسط حقوق
ضحايا مجزرة حماة استذكار ذلك التمهيد الفاشي الذي تولاه الشقيق قائد
«سرايا الدفاع» خلال المؤتمر القطري السابع للحزب (كانون الأول/ديسمبر
1979). يومها أعلن الأسد الشقيق، بوصفه عضو القيادة القطرية للحزب، أنّ
مَنْ لا يقف مع الثورة يقف في صفوف أعدائها حكماً، ودعا إلى شنّ حملة
«تطهير وطني» وطالب بإرسال المعارضين إلى معسكرات عمل وتثقيف في
الصحراء. وكان الأسد الشقيق يستبق حركة الاحتجاج الشعبي التي تبلورت في
إطار الأحزاب المعارضة غير المنضوية في جبهة السلطة، وفي النقابات
المهنية للأطباء وأطباء الأسنان والمهندسين والصيادلة والمحامين، الذين
أعلنوا إضراباً ليوم واحد (31/3/1980) احتجاجاً على غياب الحريات
وشراسة آلة القمع وانتهاك حقوق المواطن. وكان ردّ السلطة الفوري هو حلّ
هذه النقابات، واعتقال عدد من قياداتها، وشنّ حملات اعتقال واسعة ضدّ
أبرز أحزاب المعارضة.
والأرجح أنّ خاتمة تلاوين التواطؤ المستدام، في هذه الذكرى الـ40، لن
تكون تهافت الأنظمة في الإمارات والبحرين والجزائر ومصر وعُمان على
إعادة تأهيل النظام السوري؛ فمَنْ يهُن مع دولة الاحتلال، أو يُمعن في
العسكرة والاستبداد والفساد، أو يتكاذب حول امتلاك عصا «الاعتدال» من
منتصفها… كيف لا يسهل عليه الهوان مع البيت الأسدي، أو مع ما تبقى من
جدرانه المتداعية!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
أخلاق العتمة الحريرية:
عَوْد إلى جوزيف سماحة
صبحي حديدي
ذات حقبة، قبل عقد على الأقلّ من انحيازه إلى صفّ «حزب الله» وأطروحات
«محور المقاومة»؛ كان الصديق الكاتب اللبناني الراحل جوزيف سماحة
(1949-2007) قد ربط، ببراعة جدلية رفيعة، بين ملفات موت مثقف ذهب
ليسامح قَتَلة أبيه، ويصنع فيلماً اسمه «ذاكرة للنسيان»، فقتلته عتمة
واحدة ذات نظائر شتى، من جهة أولى؛ وملفات «تسامح» أعرض مع ماضٍ سياسي
وتاريخي وثقافي، تبدأ أمثلته من ألمانيا واليابان وفرنسا ما بعد الحرب
العالمية الثانية، قبل أن تنتهي عند مثالين محليين: الحرب الأهلية في
لبنان، والسلام العربي – الإسرائيلي، من جهة ثانية.
كتاب سماحة «قضاء لا قدر: في أخلاق الجمهورية الثانية»، 1996، اعتمد
واقعة موت السينمائي اللبناني مارون بغدادي (1950-1993)؛ حيث شاعت
سردية تقول إنه سقط من دَرَج بيته المعتم، ونزف وحيداً حتى فارق
الحياة، فلم يعلم أحد بموته إلا بعد مرور أيام. لكنها، في تقدير سماحة،
كانت أكثر من حادثة «قضاء وقدر» على طراز كلاسيكي، إذْ تتكشف طيّ
تفاصيلها (غير الغنية مع ذلك، وشبه العبثية)، حكاية «جثة أخرى في بلاد
الموت السهل»، وقوّة عتمة سلّم «أضاءت مدى غياب اليسار اللبناني» الذي
لم يتعرف على أحد أبنائه؛ ليس لأنه انشق أو ضلّ أو ارتدّ، بل لأنّ «هذا
اليسار لم يعد يملك القوّة اللازمة لهذا الحدّ الأدنى من التعبير،
ولأنه يخشى النور».
هكذا مضى سماحة ضمن مساجلة وضعت وفاة بغدادي داخل معادلة تختصر
أخلاقيات «الحزب الحريري» والجمهورية الثانية، حيث يقود التواطؤ المعلن
إلى فرضية تقول، ببساطة، إنّ القضاء والقدر قد تسبّب في تدمير واحتراب
و«إسقاط» بلد بأسره؛ فلماذا لا يعتبر مسؤولاً عن إسقاط/ سقوط رجل في
عتمة درج؟ التفريع المدهش التالي لاتهام العتمة بالقتل، هو أنّ «سلطة
المال وكهربة لبنان» تختصران الحريرية (نسبة إلى رفيق الحريري)، التي
ليس في وسعها احتمال عتمة تقتل (إذا كانت «قاتلة» بالفعل، كما تساءل
سماحة) وتثقب أساسات «سوليدير». ذلك لأنه توفّرت، ورسخت واستقرت،
حريرية شاملة ترث «المغلوب» الواضح، وتبحث عن «الغالب» المحلي في حدود
الصلاحيات التي يمنحها الغالب الإقليمي؛ وتوفّرت، في المقابل، معارضة
عاجزة، وبيان نقدي شجاع حول المستقبل… «لئلا يموت اليسار خجلاً»!.
لكنّ لبنان ما بعد اغتيال رفيق الحريري، واضطرار النظام السوري إلى
الانسحاب العسكري مع البقاء سياسياً وأمنياً ومافيوزياً ما أمكن،
استولد سلسلة من المعادلات، لم تُدخل تبديلات جذرية أفقية وشاقولية على
محاصصات القوّة والنفوذ والولاء والتبعية، فحسب؛ بل تكفّلت، خلال أمدية
قياسية حقاً، في تسليم قرار البلد إلى الوالي الفقيه في طهران، ممثلاً
في وكيله المحلي حسن نصر الله وميليشيات «حزب الله». وإذا كان الضرب
بالمندل هو الأقرب إلى توصيف رياضة تزعم التنبؤ بما كان سماحة سوف
يقوله تعقيباً على انسحاب سعد الحريري من الحياة السياسية، فإنّ مواقف
صديقنا الراحل من حكاية المقاومة و«الضباط الأحرار» في قلب النظام
السوري والمغزى الجيو – سياسي لولاية الفقيه، وصولاً إلى إطلاق صحيفة
«الأخبار»… لا تترك هوامش ارتياب ملموسة حول استئناف قَدَر، هذه
المرّة، يتحكم به السيد؛ وليس أيّ قضاء يتولاه أمثال القاضي طارق
بيطار.
وليست عودة هذه السطور إلى سماحة، بصدد مسارح آل الحريري الراهنة، أكثر
من استعادة لسياقات حقبة لبنانية شهدت عداءً مريراً للحريرية، لكنها
انقلبت سريعاً إلى ارتماء في أحضان «المقاومة»، وتسليم بسلطة الأمر
الواقع كما يحتكرها «حزب الله»، واختلاط نقد «سوليدير» بالتعامي عن
فساد «المال الطاهر» وما يديره من شبكات تهريب ومخدرات ومال قذر. ولم
يكن مآلاً مفاجئاً، أو حتى غريباً عن سنّة الحريري الأب نفسه، أن يذهب
الحريري الابن إلى دمشق، أو يحذو حذوه وليد جنبلاط، لمصافحة النظام
قاتل الأبوين.
أو… أن يتقاعد سعد، ليحلّ محلّه بهاء!
بوتين في أوكرانيا:
إغواء الروليت وقفزة الضفدع
صبحي حديدي
الأرجح أنّ مشاعر شتى، مختلطة ومتضاربة، متكاملة تارة ومتنافرة طوراً،
تنتاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يقلّب القرار الأنسب في اختتام
الجولة الراهنة من التوتر مع الولايات المتحدة والحلف الأطلسي حول
أوكرانيا: الاكتفاء بالانتشار العسكري الروسي الراهن (وليس ذلك بقليل
أو ضئيل، مع عشرات الآلاف من الجنود، وصنوف الأسلحة الأكثر تقدماً التي
جرى ويجري اختبار طاقاتها التدميرية في سوريا)؛ أو الاكتفاء بعمليات
قصف جوي، أقرب إلى مظلة تتيح لأنصار روسيا في أوكرانيا تعكير صفو البلد
وعرقلة خطط الضمّ لدى الأطلسي (وفي هذا لا يفعل بوتين أكثر من محاكاة
الخيار الأطلسي في صربيا 1999)؛ أو اجتياح أوكرانيا في مساحات واسعة أو
غير جزئية (على غرار ما فعلت موسكو في جورجيا سنة 2008)؛ أو، في خيار
رابع قد يكون الأقلّ ترجيحاً، إعادة تَمْوضُع القوات الروسية، بما لا
يفيد إعادة الانتشار ولا الانسحاب (إذا تمكن وزيرا الخارجية الأمريكي
والروسي من بلوغ تفاهم ما في مباحثات جنيف اليوم، يرضي واشنطن وموسكو
وبروكسيل).
الأرجح كذلك، على مستوى المعمار السيكولوجي للرئيس الروسي (خرّيج
المخابرات السوفييتية الأشهر، وساكن الكرملين على امتداد آجال شبه
أبدية) أنه لا يكفّ، ومشاريع الخيارات هذه جاثمة على مكتبه تنتظر
الحسم، عن استذكار باعث كبير أوّل حكم سلوكه الرئاسي منذ البدء
تقريباً، أي إعادة وضع روسيا على الخريطة الكونية كقوّة عظمى عائدة
ولاعبة وغازية ومحاصِصة، أياً كانت المخاطر والمجازفات. باعث ثانٍ هو
ذاكرة مريرة، ليست معافاة من الجرح النرجسي القومي والعسكري
والاستخباراتي، تعود إلى تعهّد أمريكي قطعه، في العام 1999، الرئيس
الأمريكي جورج بوش الأب ووزير خارجيته جيمس بيكر، وصدّقه ميخائيل
غورباتشوف، بأنّ انسحاب 380,000 جندي سوفييتي من ألمانيا الشرقية بعد
توحيد ألمانيا لن يفضي إلى تقدّم أمريكي أو أطلسي، حتى بمسافة بوصة
واحدة، نحو حدود حلف وارسو وجمهوريات السوفييت السابقة، كما أنه لن
تكون هناك «قفزة ضفدع» أمريكية أو أطلسية نحو أوروبا الشرقية ودول
البلطيق.
التعهد ذهب أدراج الرياح بالطبع، وتكفّل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل
كلنتون بإطلاق سيرورة توسيع الحلف الأطلسي، أو تضخيمه بالأحرى، لأسباب
قد تبدو للوهلة الأولى جيو ـ ستراتيجية وأمنية تعيد تشديد الضمانات في
عقود ما بعد إسقاط جدار برلين؛ لولا أنّ حوافز كلنتون الأولى كانت
أمريكية داخلية، وانتخابية على وجه التحديد، للمناورة ضدّ محاولة
منافسه الجمهوري روبرت دول التشهير بضعف كلنتون على الجبهة الأطلسية.
ليس هذا فحسب، لأنّ كلنتون كان السبّاق إلى رفد السياسة الخارجية
الأمريكية بأذرع عسكرية ضاربة، بدأت من إلغاء «وكالة مراقبة التسلّح»
وإضعاف موقع الولايات المتحدة في محكمة الجنايات الدولية ومعاهدات
الألغام، والتلذّذ بمهانة روسيا بوريس يلتسين، وتحويل مضاعفة عدد أعضاء
الحلف الأطلسي إلى باعث شعبوي في ناظر بوتين، شاء أم أبى، لاستنهاض
الفخار القومي الروسي وحسّ الإمبراطورية آفلة الأمجاد. معطى واحد بليغ
تماماً يكفي لاختصار حال روسيا بوتين مع الولايات المتحدة والحلف
الأطلسي: بعد أكثر من 30 سنة على انحلال حلف وارسو (والبعض يتابع،
محقاً: وبعد 77 سنة على انتهاء الحرب العالمية الثانية)؛ ما يزال نحو
40,000 جندي أمريكي يرابطون في ألمانيا، بذريعة حماية البلد في وجه…
الاتحاد السوفييتي!
في مناسبات كهذه يحضر تراث غزو خليج الخنازير ربيع 1961، ومعه تحضر موجبات الدرجة صفر في استنفار السلاح النووي؛ ففي هذه، ونظائرها، ما بدّل الطرفان تبديلا
تلك خيانات «قفزة الضفدع» إذن، وهي كفيلة بحشو سيكولوجية بوتين بخلائط
معقدة من المرارة، والثأر للكرامة الجيو- سياسية، واستدراج الشارع
الروسي إلى التفاف شعبوي عماده الفخار القومي وعبق الإمبراطورية؛
فضلاً، بالطبع، عن مغانم شتى ذات صلة بالتجارة والأعمال وأنابيب الغاز
العابرة للحدود، وصناعة السلاح وعقود التسلّح، ثمّ العقوبات التي تُثقل
كاهل الاقتصاد الروسي… كلّ هذه، وسواها مما خفي في الباطن الأعمق من
حافز الإمبراطور في نفس بوتين شخصياً، لاح أغلب الظنّ أنها تضع عواقب
غزو أوكرانيا في حال من التوازي أو التنافس، أو حتى المغالبة، مع
إغواءات لعبة الروليت الروسية الشهيرة. وقد لا يكون بوتين في حاجة إلى
استدعاء مشهد اللعبة القاتلة كما التقطه الشاعر والقاصّ والروائي
الروسي الكبير ميخائيل ليرمنتوف سنة 1840، في قصة قصيرة بعنوان «المؤمن
بالقضاء والقدر»؛ إذْ يُرجّح أنّ ذهنية بوتين سوف تحيله إلى عشرات
الأدبيات الأخرى التي تقتبس اللعبة لا لتأكيد سطوة المصادفة (طلقة
صائبة من مسدس محشوّ عشوائياً) بل سلطة التصميم والتخطيط وحًسْن
التنفيذـ بعد اعتماد مبدأ الرهان والمغامرة والمقامرة بالطبع.
وليس من دون مغزى خاصّ أنّ أحدث ترحيلات المخيال السياسي الأمريكي نحو
مكاسب/ عواقب لعبة الروليت، تناولت دور الاستخبارات الروسية، بإيعاز
شخصي مباشر من سيد الكرملين، للتدخّل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
سنة 2016، وترجيح كفّة دونالد ترامب. لكنّ بوتين قد لا يعبأ كثيراً بما
تتخيّله أمريكا في آدابها السياسية، لأنه خير مَنْ يحفظ السياقات التي
جعلته يراهن على شخص ترامب منذ خريف العام 2013، حين حضر الأخير حفل
انتخاب ملكة جمال الكون في موسكو وتلقى دعوة مفاجئة من الكرملين، حملها
أراس أغالاروف أحد خلصاء الرئيس الروسي، تقول باختصار: «المستر بوتين
يرغب في لقاء المستر ترامب».
وسواء صحّ احتمال الروليت، أم استقرّ بوتين على مناورة أكثر عقلانية
وبُعداً عن المصادفة، فقد أثمر ذلك الرهان كما أثبتت سنوات ترامب في
البيت الأبيض؛ وأتى على الولايات المتحدة حينٌ من الدهر شهد ترجيح
الرئيس الأمريكي صدق رواية الرئيس الروسي مقابل تكذيب تقديرات أجهزة
الاستخبارات الأمريكية.
لكنّ أوكرانيا ليست سوريا، مملكة الصمت والاستبداد والفساد والتوريث
وجرائم الحرب، التي تدخل فيها بوتين لانتشال نظام آل الأسد من الحضيض؛
وليست جورجيا التي شهدت حماقة تبليسي في استفزاز الدبّ الروسي الهاجع
في إقليم أوسيتيا الجنوبية، تحت ستار «شرعي» هو حفظ السلام؛ كما أنها
ليست شبه جزيرة القرم، التي ضمّها بوتين من دون كبير اكتراث بما يربطها
بأوكرانيا تاريخياً وجغرافياً. تلك مغامرات خلت، من حيث اعتبارات كثيرة
جيو – سياسية وعسكرية وأمنية، من روحية المجازفة؛ ولم يكن مؤكداً أنّ
بوتين احتاج فيها إلى المقامرة، أو دغدغته مغانم لعبة الروليت أمام
عواقبها. وإذا صحّ، كثيراً في الواقع، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو
بايدن لن تردّ على أيّ غزو روسي محتمل في أوكرانيا، ولن تجرّ الحلف
الأطلسي إلى حرب بالإنابة على أيّ نحو؛ فإنّ ما لا يقلّ صحة، ومنطقاً
بالطبع، أنّ «الكارثة» التي لوّح بها بايدن مؤخراً، سوف تكون عقوبات
تاريخية لا سابق لها ولا مثيل، لا توجع المواطن الروسي العادي في خبزه
ومحفظته فقط بل تمسّ الفئة الأضيق والأعلى من المافيات التي تسهر على
تغذية سلطة بوتين نفسه.
فهل ثمة، حقاً، هوامش مناورة يملكها الكرملين في الطور الراهن من الشدّ
والجذب؛ وهل، في مستوى آخر يحمل قسطاً غير قليل من المنطق البارد،
تستحق أوكرانيا هذا العناء الأقصى؟ الأرجح أنّ أسئلة كهذه سوف يناقشها
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في
جنيف اليوم، وقد لا تغيب عن الإجابات حقيقة أنّ الولايات المتحدة لن
تتمنّع كثيراً في تهدئة خواطر الكرملين عن طريق استبعاد ضمّ أوكرانيا
إلى الحلف، ففي مناسبات كهذه يحضر تراث غزو خليج الخنازير ربيع 1961،
ومعه تحضر موجبات الدرجة صفر في استنفار السلاح النووي؛ ففي هذه،
ونظائرها، ما بدّل الطرفان تبديلا!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
غوانتانامو في العام 20:
«قِيَم» أمريكا ما وراء البحار
صبحي حديدي
السجين الواحد يكلّف دافع الضرائب الأمريكي 12 مليون دولار سنوياً،
وأمّا منشأة معتقل غوانتانامو ذاتها فإنها تكلّف 540 مليون سنوياً؛
وعلى صعيد «سمعة» الولايات المتحدة كدولة قانون ورافعة رايات حقوق
الإنسان، المعتقل كارثة صريحة فاضحة واضحة، ليس كما تقول المنظمات
الحقوقية الدولية وحدها، بل كذلك باعتراف مذكّرة وقّعها في نيسان
(أبريل) الماضي 24 من كبار أعضاء الكونغرس الديمقراطيين. إلى هذا وذاك،
منذ تحويل القاعدة البحرية إلى معتقل خارج الأراضي الأمريكية، بقرار من
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، تناوب على الوعد بإغلاق
غوانتانامو ثلاثة رؤساء أمريكيين، باراك أوباما وجو بايدن وبوش الابن
نفسه، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب هو الوحيد الذي انسجم مع ذاته
بوعده فأبقى على المعتقل إلى أجل غير مسمى.
وليست مدعاة عجب أنّ الولايات المتحدة أكملت انسحابها التامّ من
أفغانستان بعد 20 سنة، لتعيد تسليم السلطة إلى الطالبان؛ لكنّ أمريكا
هذه ذاتها تظلّ عاجزة عن إغلاق المعتقل سيئ الصيت بعد انقضاء أكثر من
20 سنة على إنشائه، وبعد الوعود الرئاسية وتعهدات البنتاغون. مطالبات
الكونغرس، ضمن صفّ ممثّلي الحزب الديمقراطي على الأقلّ، تساجل هكذا
مثلاً: « على امتداد عقدين واصل سجن الأوفشور هذا إلحاق الضرر بسمعة
أمريكا، وغذّى التعصب المعادي للمسلمين، وأضعف قدرة الولايات المتحدة
على مواجهة الإرهاب والقتال من أجل حقوق الإنسان وحكم القانون على
امتداد العالم، وإلى جانب ملايين الدولارات المبذّرة كلّ سنة من جيب
دافع الضرائب للإبقاء على المنشأة وإدارتها، فإنّ السجن يأتي أيضاً على
حساب ضحايا 11/9 وعائلاتهم، الذين ما يزالون في انتظار بدء المحاكمات».
ليس أقلّ إثارة للعجب، أخيراً وليس آخراً، أنّ السجن الذي غصّ منذ
افتتاحه في 11/1/2002 بما مجموعه 780 معتقلاً من 35 جنسية، لا يحتوي
اليوم إلا على 39، بينهم 13 معتقلاً ينتظرون الترحيل بعد صدور قرارات
بإطلاق سراحهم، و10 لا يُعرف لهم مصير ولا موعد محاكمة. الأرقام الأخرى
تشير إلى أنّ 9 من المعتقلين قضوا في السجن، مرضاً أو بسبب التعذيب
الوحشي أو الانتحار. المنطق البسيط يدعو، بالتالي، إلى تساؤل لا يقلّ
بساطة: علام، إذن، الإبقاء على المعتقل بأكلافه العالية والعدد القليل
من «النزلاء» في زنازينه؟ وما الذي يعيق، حقاً، تحويل الوعود والتعهدات
إلى قرارت تنفيذ فعلية تتماشى في الحدود الدنيا مع المنطق البسيط إياه؟
بعض الإجابة عن أسئلة كهذه، وسواها، يمكن أن يُردّ إلى واقع أنّ المنطق
البسيط شيء، ومنطق الإدارات الأمريكية بسيطاً كان أم معقداً شيء آخر
مختلف تماماً. خذوا، في تفكيك قسط من دلالة هذه المعادلة، ما قاله
السناتور الديمقراطي جو بايدن في سنة 2005: «أظن أننا يتوجب أن ننتهي
إلى إغلاق المعتقل، ونقل السجناء. أولئك الذين لدينا أسباب للإبقاء
عليهم، نبقيهم. وأولئك الذين ليسوا في هذه الحال، نطلق سراحهم».
واليوم، بعد 17 سنة على ذلك التمنطق، البسيط حقاً، وبعد أن صار رئيساً
للولايات المتحدة وليس مجرّد عضو في الكونغرس، ما الذي يعيق بايدن عن
تحويل الرأي إلى قرارات فعلية؟
انتهاك الحقوق الإنسانية والقانونية للأفراد المعتقلين في غوانتانامو مشروع تماماً في منظار أوّل هو عدم اشتراك المتهم في القِيَم الأمريكية؛ وأنّ تلك القيم تتمتع تالياً بصواب أخلاقي مطلق في المنظار الأمريكي
ثمة، بادئ ذي بدء، تلك العبارة المفتاحية التي أطلقها بوش الابن في
تسويغ إنشاء المعتقل العسكري، ضمن حزمة تدابير أخرى خارجة عن القانون
الدولي والقانون الأمريكي ذاته أيضاً، بينها السجون الطائرة والعهدة
إلى أنظمة الاستبداد بإجراء بعض التحقيقات، في سياقات ما أسمته الإدارة
بـ«الحرب على الإرهاب». قال بوش، في مارس (آذار) 2002: « تذكروا… هؤلاء
الأشخاص الموجودون في غوانتنامو قتلة لا يشاركوننا نفس القِيَم». كانت،
إذن، حكاية قيم، أخلاقية أو فكرية أو سياسية أو ثقافية، وليست البتة
قوانين مرعية وقضاء مستقلّ ومحاكم عادلة تنظّم شؤون الجريمة والعقاب.
وبذلك فإنّ أيّ انتهاك للحقوق الإنسانية والقانونية للأفراد المعتقلين
في غوانتانامو، مشروع تماماً في منظار أوّل هو عدم اشتراك المتهم في
القيم الأمريكية؛ وأنّ تلك القيم تتمتع تالياً ـ وفي المنظار الأمريكي
فقط! – بصواب أخلاقي مطلق، وبمنعة قانونية راسخة، فضلاً عن مختلف أنماط
السطوة السياسية والعسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية…
وكانت حيثيات أخرى تقول إنّ المعتقلين في غالبيتهم اعتُقلوا في
أفغانستان، وبعضهم نُقل إلى المعتقل ضمن تكنيك» الخطف غير الشرعي الذي
مارسته وكالة المخابرات المركزية هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها.
جميعهم تعرّضوا ويتعرّضون لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي (ليس
أقلّها قسوة الحرمان من مقابلة أهلهم وذويهم، أو كتابة وتلقي الرسائل…)
فضلاً عن الإهانة والتحقير والقهر المتعمد، والتقييد بالسلاسل، وإجبار
المعتقل على ارتداء نظارات معتمة. وبالرجوع إلى بعض وقائع اليوميات
التي دوّنها المعتقل البحريني جمعة الدوسري ونشرتها منظمة العفو
الدولية، يؤكد الرجل أنّ القوات الباكستانية كانت قد باعته إلى
المخابرات الأمريكية لقاء حفنة دولارات، وأنه خضع للاستجواب 600 مرّة،
ووُضع في زنزانة منفردة من دون تهمة، وتعرّض لتهديدات بالقتل. كما
مورست عليه سلسلة ضغوط نفسية أثناء جلسات التحقيق، بينها إجباره على
الاستماع إلى موسيقى صاخبة، وتركه موثوقاً لساعات طويلة في غرفة باردة
جداً من دون ماء أو طعام، وتعريضه للإذلال بواسطة جندية لا ترتدي سوى
ملابس داخلية، ثمّ إجباره على مشاهدة مجلات إباحية.
أهذه «قِيَم» أمريكية؟ كلا بالطبع، إذا شاء المرء إنصاف القانون
الأمريكي الرسمي أو التعريف الأخلاقي والفلسفي لمفهوم «القِيَم» ولكنها
في المقابل تلك القيم ذاتها التي تكاثرت سريعاً من حول تنظيرات «الحرب
على الإرهاب» وغزو أفغانستان والعراق وجزء غير يسير من فلسفة صدام
الحضارات. فهل يختلف، إلا في التقنيات والأدوات، تعذيب يمارسه ضابط
استخبارات في فرع فلسطين، ضمن «قِيَم» نظام آل الأسد في سوريا؛ عن
تعذيب مارسته الجندية الأمريكية لندي إنغلاند، في معتقل أبو غريب خلال
اجتياح العراق؛ وعن التعذيب عبر إجبار المعتقل على مشاهدة مجلات
البورنو، في غوانتانامو؟
الذكرى العشرون لافتتاح المعتقل، وامتناع إغلاقه رغم جميع الملابسات
التي تحثّ على قرار كهذا، يتوجب أن تحيل إلى سؤال تقتضيه أية منظومة
منطقية صالحة لتفسير السلوك الأمريكي: أهذه وصمة عار منفردة، ينبغي أن
يندى لها جبين الديمقراطية الأمريكية لمرّة واحدة محدّدة؟ أم أنّ
غوانتانامو، مثلها في ذلك مثل «أبو غريب» وسواه من سلسلة انتهاكات حقوق
الإنسان، هي محض أمثلة على ثقافة سياسية ـ حقوقية متكاملة عريقة، تنظّم
العدالة الأمريكية ما وراء البحار؛ أو حتى في كوبا، على مرمى حجر من
أرض أمريكا؟ سؤال آخر بالمقتضى إياه: إذا كان الإرهاب هو الذي يسفك
الدم الأمريكي (الضالع أو البريء، العسكري أو المدني) فما أدوار أمثال
غوانتانامو وأبو غريب في تغذية ذلك الإرهاب عاماً بعد عام، وعملية
دامية إثر أخرى؟
ثمة اعتبارات كثيرة تؤكد وجود ثقافة أمريكية متكاملة تقف في خلفية هذه
الممارسات الخارجة على القانون، وهي ثقافة يمينية متأصلة، وتواصل
التأصّل أكثر فأكثر في الوجدان الأمريكي اليومي؛ كما أنها ثقافة سياسية
ودستورية لأنّ دعاتها يشغلون مواقع عليا في الجهاز التشريعي، في
الكونغرس كما في المحكمة الدستورية العليا، وفي المحاكم كما في مكاتب
التحقيق الفيديرالي. وليست تلك الثقافة سوى خلفية أولى، تتضافر مع
خلفيات أخرى شتى، تقف وراء استمرار معتقل غوانتانامو؛ أو التنويع عليه،
أو استيلاد سواه!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
السودان: مَن يخشى
مبضع عبد الخالق محجوب؟
صبحي حديدي
توهّم عبد الله حمدوك، رئيس
الوزراء السوداني المُقال/ المستقيل تباعاً، أنه قادر على «حقن دماء»
السودانيين عبر التوصّل مع قائد الجيش/ رأس الانقلاب المشير عبد الفتاح
البرهان إلى اتفاق من 14 مادّة؛ قيل إنها تعيد تقاسم السلطة على نحو
عادل يتكفل بوضع البلد مجدداً على طريق التحوّل السلمي الديمقراطي
وتنظيم انتخابات نزيهة شفافة في سنة 2023. ولقد اتضح، بعد ستة أسابيع
يتيمة، أنّ دماء السودانيين أريقت مجدداً حتى تجاوز عدد ضحايا
التظاهرات 50 شهيداً برصاص الجيش ومفارز «الدعم السريع» وقوات الأمن؛
كما فُجع حمدوك (إذا جاز توصيف مشاعره هكذا) بقرار من البرهان يخوّل
أدوات القمع المختلفة ما كانت مخوّلة به زمن الطاغية عمر حسن البشير،
بل أسوأ وأشدّ صلاحيات في التنكيل.
صحيح أنه لم يكن خيار العسكر الأمثل لرئيس وزراء/ دمية يحرّكها أمثال
البرهان ومحمد حمدان دقلو وشمس الدين كباشي، ولكنّ حمدوك حمل سمة واحدة
على الأقلّ أسالت لعابهم وأقنعتهم بإعادته إلى المنصب، بعد تمنّع أبقاه
في الإقامة الجبرية فترة ليست طويلة في كلّ حال: أنه خير مظلّة مدنية
يمكن أن يتظلل بها الجنرالات تكتيكياً، وانتقالياً، قبيل وأثناء عمليات
التطهير والترتيب وإحكام القبضة العسكرية والأمنية أكثر فأكثر. ومن غير
الإنصاف لذكاء الرجل، وهو الخبير والتكنوقراطي خرّيج الطراز الأممي من
البيروقراطية العابرة للسودان ولأفريقيا جمعاء، الافتراض بأنه لم يكن
يدرك حدود اللعبة حين وافق على الانخراط فيها. من غير الإنصاف، على قدم
المساواة، منحه فضيلة الشكّ في أنّ حكمة استقالته تنبع من القاعدة
العتيقة: خير أنها تأخرت من ألا تكون أتت أبداً؛ فالأرجح أنّ العسكر لم
يتركوا له هوامش اختيار ذات معنى، فضاقت حتى استحكمت حلقات تأزّمه
معهم، ومع نفسه أغلب الظنّ.
وفي المقابل، لا يصحّ أن تغيب عن منطق حضوره في المشهد السياسي
السوداني الراهن، أو ابتعاده عنه، حقيقة أخرى تخصّ أنماط القصور الكبرى
في أداء «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وإلى أية درجة كانت بدورها خلف
حال التذبذب التي عاشها حمدوك منذ فجر الانقلاب وحتى استقالته. في
عبارة أخرى، ليست شراهة العسكر إلى السلطة، وهيمنة العقلية الانقلابية
والانفرادية على خياراتهم التكتيكية والستراتيجية، هي وحدها مصدر
الداء؛ بل ثمة ذلك الدواء المرتجى، أياً كانت فاعليته العلاجية، الذي
علّقته بعض الشرائح الشعبية على القوى المدنية، فما ارتقت هذه إلى شرف
المسؤولية، ولا وحّدت صفوفها في الحدود الدنيا المطلوبة في كلّ صراع
شرس مع عسكر انقلابيين؛ بل تعثرت، إذا لم تكن قد فشلت، في صياغة برنامج
موازٍ مناهض يتحلى بوعي سياسي واجتماعي واقتصادي وتاريخي يليق بمشهد
معقد متقلب متفجر.
وقد لا يُلام امرؤ يرى ضالّته، إذْ يحاول تلمّس حال السودان الراهنة،
في العودة إلى الشهيد عبد الخالق محجوب وتلك الورقة الفريدة التي
وقّعها في العام 1963 تحت عنوان «إصلاح الخطأ في العمل بين الجماهير»؛
ليس لأنّ قيادات «الحرّية والتغيير» يمكن أن تستهدي بأيقونة نضالية
فريدة مثل محجوب، وقد يفعل بعض منهم بالفعل، ولكنّ لأنّ تلك الرؤى
والدروس والخيارات لم يمرّ عليها الزمن تماماً، أو بالأحرى ليست أزمنة
أمثال جعفر النميري أو البشير هي القادرة على طمسها أو إبطال
أمثولاتها. وإلى جانب التشخيص المعمّق والصائب، لتركيب المجتمع
السوداني، طبقياً وإثنياً، شدّد محجوب على «أخلاقية» صارمة في مساعي
تنظيم الجماهير، لأنّ التحالفات والائتلافات المتسرعة «سرعان ما تركبها
العزلة، ویذهب شأنها، والذي یبقى من تنظیم هو ما ترتضیه الجماهیر، ما
ینفعها في نضالها السیاسي وفي حیاتها الیومیة، وما یتناسب مع الظروف
الموضوعیة».
ومَن يخشى استخدام مبضع محجوب في تشريح العطب، لن يفلح في أمر آخر أكثر
من تمكين حربة الجنرال وإعادة تدوير نماذج حمدوك.
العراق:
مفارقات صندوق اقتراع
صبحي حديدي
أنزل الناخب العراقي صنوفاً متفاوتة الشدّة من العقاب بحقّ القوى
الحزبية والعسكرية والميليشيات الموالية لإيران، هذه التي استحقت اليوم
تسمية «الفصائل الولائية» حتى بات المسمّى يتباهى بها وإليها ينتسب
بمزيج من الفخار والغطرسة والتنمّر. وهذا العقاب صنع مفارقة صندوق
الاقتراع الأولى، لأنه من جانب آخر منح الكتلة الصدرية الفوز بـ 73
نائباً، من أصل 329؛ رغم أنّ الكتلة هي الجناح الآخر أو الأوّل بالأحرى
ضمن المجموع الشيعي العراقي، ورغم أنها ليست موالية تماماً لطهران وإنْ
كانت لا تعلن أيّ عداء ملموس للنفوذ الإيراني الطاغي في البلد.
فإذا جاز القول، استطراداً، إنّ جذور العقاب اجتماعية ومطلبية، ذات صلة
بانتفاضة العراقيين، فإنّ المفارقة التالية تنبثق من هذه الفرضية
تحديداً: ألم يكن التيّار الصدري بعيداً عن حراك الشارع الشعبي، بل
معادياً له أحياناً إلى درجة كسر الاعتصامات والتستر على عمليات اغتيال
الناشطين؟ صحيح، هنا أيضاً، وكما يساجل البعض، أنّ التيّار قد يكون
تغيّر بصدد الانتفاضة تحديداً، وتحوّلت مواقفه في قليل أو كثير نحو
احتضان بعض المطالب، أو السعي إلى استيعاب بعضها الآخر أو حتى امتصاصه؛
ولكن هل كان نطاق التغيّر واسعاً بما يكفي، جذرياً بما يُرضي الجموع،
متأصلاً في منهاج التيّار على نحو يتجاوز خطاب الحملات الانتخابية
والتحشيد المؤقت؟
مفارقة ثالثة، تستحقّ أن يُستمدّ منطق نشوئها من اجتماع خلاصات منطقية
داخل المفارقتَين السالفتَين، هي أنّ قوى الانتفاضة الشعبية، على شاكلة
«امتداد» و«الكتلة الشعبية المستقلة»، حضرت في صندوق الاقتراع وأفلحت
في تصعيد عدد من النوّاب الملتزمين بالمطالب الشعبية أو المستقلين
المنضوين في ركابها ضمناً. لكنّ حضورها لا يُحتسَب بعدد النوّاب، أو ما
يمكن أن يتحالف معهم من نوّاب كرد ضمن مجموعة «الجيل الجديد»، بقدر ما
يصحّ أن يُنتظَر منه على صعيد تشكيل معارضة فعلية مختلفة، شعبية
التوجهات وأصيلة الأهداف، تواجه التيّار والولائيين على حدّ سواء من
خلال اعتناق شعارات الانتفاضة بادئ ذي بدء.
وإذا كانت المفارقة الرابعة كامنة في طابع التقاسم المذهبي أو الإثني
الذي انتهى إليه النظام السياسي العراقي، لجهة منح رئاسة الجمهورية إلى
الكرد، ورئاسة البرلمان إلى السنّة، ورئاسة الحكومة إلى الشيعة؛ فإنّ
العماد التكويني لذلك التقاسم تحديداً لم يبدأ واهياً وهكذا يتواصل
فحسب، بل كذلك لأنّ الصراعات داخل كلّ حصّة، ومعظم الفرقاء ضمن الحصّة
الواحدة، محتدمة مستعرة مستحكمة من جهة أولى، ولكن ّ الأخطر فيها أنها
من جهة ثانية بمنأى عن مصالح سواد الشعب والقسط الأعظم من حاجاته
ومطالبه وجوهر انتفاضته في تشرين الأوّل (أكتوبر) 2019.
رئاسة الجمهورية رهن بالحزبَين الكرديين في الشمال الكردستاني، وهي
أشبه بالنزاع منها إلى الخصام بين العائلتَين البرزانية والطالبانية؛
ورئاسة البرلمان لن تسهّل حسمها التفاهمات الانتخابية المؤقتة بين محمد
الحلبوسي وخميس الخنجر، لأنّ الصفّ السنّي يعاني من حال التبعثر
والتشتت، التفتت والذوبان؛ وأمّا رئاسة الحكومة فلم تعد كبرى تناقضاتها
الاختلاف على شخص مصطفى الكاظمي، بل على عودة نوري المالكي، صاحب الـ34
نائباً، وزاعم الدفاع عن «دولة القانون»… نفسه، بطل اندحار الجيش
العراقي أمام «داعش» في الموصل، و«قائد» الجيش الوهمي المسجّل على
الورق وجداول الرواتب الكاذبة! هذه، في الوجه الأعمق منها، مفارقة
خامسة تندرج من دون عوائق في البنية الفعلية المختلة للمحاصصات
المذهبية والطائفية والمناطقية والإثنية التي تفاقمت بعد الاحتلال
الأمريكي للعراق، بسبب منه جزئياً وتبعاً لولاءات القوى وارتهاناتها
الخارجية الإقليمية والدولية.
وقد يكون ما خفي خلف هذه المفارقات الستّ أعظم وأدهى: إذا احتكم
الفرقاء إلى السلاح، أو إذا عقدوا صفقات ثنائية وثلاثية ورباعية عمادها
التواطؤ على مصالح الشعب العراقي؛ وليس هذا عليهم بكثير، والتاريخ
شاهد.
(تغيير النظام)في المفهوم الأمريكي:
ألعاب الربح والخسارة
صبحي حديدي
خلال العام 2021 صدرت أعمال عديدة هامة حول شؤون الشرق الأوسط ضمن
معادلات جيو ـ سياسية شتى، داخلية وإقليمية ودولية؛ وبالعلاقة مع القوى
العظمى إجمالاً، والولايات المتحدة بصفة خاصة. وقد يكون كتاب الأمريكي
فيليب غوردُن «خسران اللعبة الطويلة: الوعد الزائف لتغيير النظام في
الشرق الأوسط» بين الأهمّ؛ لأسباب تتصل أوّلاً بمحتوياته واسعة النطاق،
من «الخطيئة الأولى» في إيران 1953، نحو كوارث التدخل الخارجي بأشكاله
المختلفة في أفغانستان والعراق ومصر وليبيا وسوريا؛ كما تعود ثانياً
إلى أنّ الرجل شغل منصب المساعد الخاصّ للرئيس الأمريكي الأسبق باراك
أوباما ومنسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، خلال فترة حرجة بين
2013 و2015، شهدت الكثير من أنماط التحوّل والتقلّب في ملفات «الربيع
العربي».
وحين تضحّي الولايات المتحدة بأرواح آلاف الأمريكيين وأبناء البلدان
التي تشهد التدخل، وتنفق مليارات وتريليونات الدولارات، وتنفّر شركاء
محتملين، وتنهك جيش الولايات المتحدة، وتنتهك القانون الدولي، وتُلهب
نيران الكراهية القومية، وتدمّر دعم الراي العام لمفهوم الانخراط
الدولي، فإنّ استبدال فئة من المشكلات بفئة أخرى ليس جيداً بما يكفي؛
يكتب غوردُن، منتهياً منذ السطور الأولى في المقدمة إلى أنّ «تغيير
النظام» ليس مفهوماً صائباً، بدليل أنّ إدارات عديدة اعتمدته رغم
اختلاف خياراتها وسياساتها، فكانت العواقب الكارثية هي المآل الصريح في
كلّ الحالات. وإذْ يشير المؤلف إلى حالات أخرى خارج الشرق الأوسط، في
غواتيمالا وكوبا وتشيلي ونيكاراغوا وغرينادا وبنما، فلكي يشدد على أنّ
مناهضته لفلسفة تغيير النظام ليست أخلاقية الطابع بل عملية؛ ومن نافل
القول إنّ أمريكا، وشعوب الشرق الأوسط قبلها، سوف تكون في حال أفضل مع
وجود زعماء وأنظمة ومؤسسات من طراز مختلف، غير أنّ المسألة ليست في
التمنّي ولا في السعي إلى فرض الأماني عن طريق الغزو والتغيير بالقوّة.
والحال أنّ غوردُن، وهو ربيب البيت الأبيض في نهاية المطاف، يتناسى أنّ
الإدارات الأمريكية المختلفة ساندت أنظمة الاستبداد والفساد في طول
الشرق الأوسط وعرضه، وتبدّلت الذرائع على مرّ العقود والمحطات الفاصلة
لكنّ النفط والحفاظ على مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي وخرافة
«الاستقرار الداخلي» ظلت قواسم مشتركة حكمت خيارات جميع رؤساء أمريكا،
من دون أيّ استثناء فعلي أو ملموس. كما يتجاهل أنّ مفهوم تغيير النظام
صعد من زاوية الحاجة إلى معالجة معضلة أمريكية هنا أو هناك، مع هذا
النظام أو ذاك؛ وليس من منطلق كراهية مستبدّ في سوريا أو مغامر في
ليبيا، وليس البتة من أجل خدمة شعب مضطهد في العراق أو معذّب في
أفغانستان. وليس خافياً أنّ تركيز كتابه على الشرق الأوسط، وليس مناطق
أخر ملتهبة في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية، راجع إلى أنّ
التأويل الأمريكي لمفهوم تغيير النظام اعتُمد، واختُبر كذلك، في هذه
المنطقة تحديداً، خلال العقود الأخيرة؛ ولأنه أيضاً خضع لسجالات داخل
صفوف مستشاري الإدارات المختلفة، بصدد اللجوء إليه أو الامتناع عنه،
سواء بسواء.
في ابتداء الفصل الذي يعقده لسوريا، يستعيد غوردُن تصريح أوباما، يوم
18 آب (أغسطس) 2011 قبيل مغادرة واشنطن إلى إجازة صيفية: «قلنا
باستمرار إنّ على الرئيس الأسد أن يقود انتقالاً ديمقراطياً أو أن
يتنحى جانباً»؛ وكذلك: « لم يَقُدْ، ومن أجل الشعب السوري، آن الأوان
كي يتنحى الرئيس الأسد»؛ ولكن كذلك أيضاً: «الولايات المتحدة لا
تستطيع، ولن تسعى إلى، فرض هذا الانتقال على سوريا. يعود إلى الشعب
السوري اختيار زعمائه، ولقد سمعنا رغبته القوية بألا يكون هناك تدخّل
أجنبي في تحرّكهم». في المقابل، الولايات المتحدة «سوف تعمل الآن على
إيجاد سوريا ديمقراطية، عادلة، وشاملة لكلّ السوريين. وسندعم هذه
النتيجة عن طريق الضغط على الأسد كي يتنحى عن درب هذا الانتقال». ذلك
التصريح لم يكن ارتجالياً بل مكتوباً، كما يشير غوردُن من باب التشديد
على العناية الفائقة التي بذلها مساعدو أوباما في صياغة أقوال الرئيس
الأمريكي.
يتجاهل غوردُن سلسلة المباحثات المستفيضة التي انخرط فيها ضباط أمريكيون وروس؛ وانطلقت في صيف 2015، وامتدت إلى كامل سنة 2016، وكان موضوعها الأكبر أو شبه الوحيد في الواقع، هو… كيف يمكن إنقاذ نظام الأسد
تلك، كما لا يشير غوردُن في الواقع، كانت صرخة بعيدة كلّ البعد عن
تصريحات أوباما بصدد احتمال لجوء النظام السوري إلى استخدام الأسلحة
الكيميائية، حين ارتجل بعيداً عن النصّ المكتوب فرسم «الخطّ الأحمر»
الشهير: «عندما نرى كمية من الأسلحة الكيميائية تتحرك أو يتمّ
استخدامها، فبالنسبة لكلّ القوى في المنطقة ولنا نحن هذا خط أحمر ستكون
له عواقب هائلة». وحين قصف جيش بشار الأسد الغوطة الشرقية بالأسلحة
الكيميائية، فجر 21 آب (أغسطس) 2013، لم يغب أوباما وحده عن شاشات
الإعلام الأمريكي والعالمي، بل حذا حذوه كبار رجال الإدارة من وزراء
الدفاع والخارجية والعدل إلى رئاسة الأركان المشتركة والمخابرات
المركزية؛ واكتفى الجميع بالنائب الأوّل للسكرتير الصحافي فخرج الأخير
للإعراب عن «قلق» الولايات المتحدة بصدد «تقارير» عن هجمات كيميائية.
ومن حيث المنطق الشكلي يتوجب أن يرحّب غوردُن بهذا المشهد، لأنه يطابق
مواقفه المناهضة لمفهوم تغيير النظام، ويندرج كذلك في «عقيدة أوباما»
الشهيرة التي تنفر من المغامرات العسكرية الخارجية؛ لولا أنه، في
المقابل، يتجاهل عن سابق قصد وتصميم، إذْ لا يعقل أنه كان يجهل، سلسلة
المباحثات المستفيضة التي انخرط فيها ضباط أمريكيون وروس؛ وانطلقت في
صيف 2015، وامتدت إلى كامل سنة 2016، وكان موضوعها الأكبر أو شبه
الوحيد في الواقع، هو… كيف يمكن إنقاذ نظام الأسد! هذا ما كشفته إفادة
أندرو إكسوم، نائب المساعد الأسبق في وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون
الشرق الأوسط خلال رئاسة أوباما الثانية، أمام لجنة فرعية في الكونغرس
بحثت السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال الرجل: «كان
واضحاً لنا أنّ روسيا، رغم إعلانها الانخراط في محاربة الإرهاب، كانت
أكثر اهتماماً بتركيز جهودها العسكرية على تدمير ما تبقى من معارضة
علمانية وإسلامية معتدلة في وجه نظام الأسد. كنّا جميعاً نعرف أين
ينتشر الإسلاميون المتطرفون في مطلع 2016، أي في شرق سوريا وأطراف من
شمالها الغربي حيث كانت النصرة قوية بصفة خاصة. روسيا، على العكس، كانت
تركز على استرداد تلك المناطق المدينية الكبرى مثل حلب ودمشق، والتي
كانت حاضنة مجموعات المعارضة الأكثر اعتدالاً».
وفي ضوء هذا الإغفال الفادح، المتعمد والمقصود، فإنّ أكثر من 12,500
كلمة يدبجها غوردُن في الفصل المكرّس لسوريا لا تفقد الكثير من
مصداقيتها ضمن نطاق استعراض ما يبرر خيارات أوباما، سواء في التدخل أو
في حجبه، فحسب؛ بل تنزلق أيضاً إلى مجاراة «اللعبة الخاسرة» ذاتها التي
يدور الكتاب حولها. فأن ينتقد غوردُن مفهوم تغيير الأنظمة بالقوّة،
ويسهب في شرح عواقبه الكارثية، شيء؛ وأن يتغافل، عامداً، عن تدخل
اثنتين من القوى العظمى للحفاظ على نظام آل الأسد، بدل تغييره، شيء آخر
مختلف ومناقض وفاضح. وكيف تكون الحال إذا كان غوردُن نفسه يشخّص النظام
هكذا: «برهن الأسد على أنه مستعدّ للقتل، والتعذيب، وتهجير الملايين من
مواطنيه، والمناورة على الطائفية بأشكال خبيثة، وتعميق اعتماد بلده على
روسا وإيران».
لكنّ الافتقار إلى المصداقية هو دليل أبرز على أهمية كتاب يحتشد
بتفاصيل غير معروفة، ويقدّم شهادة جديدة على كيل الإدارات الأمريكية
بعشرات المكاييل إزاء مفهوم تغيير النظام، الغائم القلق الرجراج؛ عن
سابق قصد وتصميم، هنا أيضاً.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
تحولات فرنسا الراهنة:
من اليعاقبة إلى (زيمورستان)
صبحي حديدي
كما كان منتظَراً، أعلن الكاتب والصحافي الفرنسي إريك زيمور ترشيحه
للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها فرنسا في نيسان (أبريل) المقبل، ولم
تغب عن نصّ الترشيح سلسلة الآراء والأفكار والمطالب التي جعلت منه أحد
أسوأ شخصيات اليمين المتشدد العنصري في فرنسا المعاصرة؛ ومكّنته،
استطراداً، من تصدّر الموقع الآخر الأثير: أنه الأشدّ صراحة في إبداء
عنصريته، والأوضح تعبيراً عن الرهاب من الآخر وكراهيته واحتقاره
وتحقيره، والأمهر في دغدغة مشاعر مماثلة تخشى الإفصاح عنها شرائح
متنوعة في صفوف اليمين التقليدي/ الجمهوري/ الديغولي واليمين المتطرف
على منوال تياراته الكلاسيكية في فرنسا وأوروبا.
في المقابل، ما لم يكن منتظَراً على نطاق واسع، ولعله باغت البعض من
زاعمي «الخبرة» في شخص زيمور، أن يأخذ إعلان الترشيح تلك الصيغة
الخاصة: اعتماد ديكورات صارخة الرموز، تحاكي خطبة الجنرال دوغول التي
دعت إلى مقاومة الاحتلال النازي، وتبدأ من الميكروفون القديم ولا تنتهي
عند رفوف الكتب المجلدة العتيقة في الخلفية؛ ثمّ القراءة من نصّ مكتوب
بدل الارتجال (رغم لغة زيمور البلاغية والعالية المميزة)؛ وتفادي النظر
المباشر إلى العدسة، وبالتالي ملاقاة الفرنسيين بَصَراً لبصر؛ وحشر
الفيديو بمشاهد نساء محجبات وأناس سود في المترو وأجانب منخرطين في
شجارات وأعمال عنف؛ وأخيراً، وليس آخراً في الواقع، اختيار سيمفونية
بيتهوفن السابعة، البونابارتية التي تُعرف أيضاً باسم «التحرير».
ولن تمرّ إلا حفنة دقائق بعد بثّ شريط الترشيح عبر وسائل التواصل
الاجتماعية، حتى تعاقبت الاستنكارات من جميع الجهات التي انتهك زيمور
حقوق المؤلف لأعمالها، سواء على صعيد الصور والمشاهد، أو الديكور بصفة
عامة؛ على غرار لايتيسيا هوليداي، أرملة المغني الراحل جون هوليداي،
التي أعلنت أنها سترفع دعوى ضدّ زيمور لأنه حشر اسم زوجها في نصّ
ترشيحه. ولم يكن مدهشاً أنّ صحافياً وكاتباً، ولكنه اليوم مرشح لرئاسة
فرنسا أيضاً، لم يجد في تبرير تلك الانتهاكات سوى أنها مجرّد «نسيان»؛
مثلما لم يُدهش كثيرون لأنه لم يجد دفاعاً عن رفعه الإصبع الوسطى في
وجه سيدة، خلال زيارة إلى مرسيليا، سوى أنه قوبل هناك بكثير من
المضايقات.
هذا، في كلّ حال، مواطن فرنسي يهودي ولد لأبوين من الجزائر، وترعرع في
ضواحي العاصمة باريس، ولكنه لا يكره الأجانب وحدهم فقط، بل يستفزّ
اليهود لأنه ينزّه الماريشال الفرنسي فيليب بيتان الذي تعاون مع
الاحتلال النازي في ترحيل اليهود وحُكم عليه بالخيانة العظمى بعد
الحرب؛ بل يضيف إلى التنزيه أنّ الماريشال على العكس: أنقذ اليهود!
وهذا كاتب وصحافي اقتيد مراراً إلى المحاكم بتهمة العنصرية ونشر
الكراهية، وهو يدعو إلى طرد العرب والمسلمين والسود لأنهم، أجمعين،
لصوص ومجرمون وقتلة؛ مثلما يطالب بإعادة عقوبة الإعدام لمحاسبة
أمثالهم، وبمنعهم من إطلاق أسماء «أجنبية» أو «غير فرنسية» على
مواليدهم. وهو أعلن صراحة، وكتب، أنّ راتب المرأة لا يجوز أن يتساوى مع
راتب الرجل بسبب انعكاس الاختلاف الفيزيولوجي بينهما على سوية الأداء
في العمل؛ كما حثّ على إعادة تحريم الإجهاض قانونياً، وإلى حظر
العلاقات بين مثليي الجنس…
هذه الـ«زيمورستان» ليست من طراز الفطر الشيطاني الذي نبت فجأة بسبب أو من حول زيمور وأفكاره، لأنها عتيقة متأصلة وتمثّل شريحة سوسيولوجية، نظيرة لشريحة إيديولوجية
وحين ألمح زيمور إلى أنه ينوي الترشيح لرئاسة فرنسا، ثمّ قالت أولى
استطلاعات الرأي أنه يمكن أن يتقدّم على مرشحة اليمين المتشدد التقليدي
مارين لوبين، انقلب الرجل من كاتب سجالي وصحافي عنصري الأهواء ومرشّح
محتمل إلى طفرة إعلامية ساحقة ماحقة، كما يصحّ القول عملياً وكما تبرهن
المعطيات: لم يتصدر غلاف مجلة «فالور أكتويل» اليمينية خمس مرّات خلال
تسعة اشهر من هذا العام فقط، بل ظهر على أغلفة الغالبية الساحقة من
الدوريات الأسبوعية والشهرية الفرنسية أياً كانت توجهاتها على اليمين
أم اليسار أم الوسط؛ ولم يصبح مادّة يومية في قناة
CNews،
التي يعتبرها الكثيرون «فوكس نيوز» فرنسا، فحسب؛ بل يسجّل موقع
Acrimed
المختصّ برصد محتويات وسائل الإعلام أنه صار إدماناً يومياً في جميع
الأقنية والإذاعات والمواقع الإلكترونية، وبمعدّل 4167 مرّة خلال شهر
أيلول (سبتمبر) وحده؛ حتى أنه كان الموضوع في قناة
BFM
يوم 9 من الشهر ذاته على المدار الزمني التالي: 6.50، 8.30، 10.30،
11.40، صباحاً؛ و12.00، 18.00، 19.00، 20.00، 21.00، 22.00، ظهراً
ومساء وليلاً.
وقد يساجل البعض، محقاً على نحو جزئي فقط، بأنّ هيمنة زيمور على وسائل
الإعلام راجعة إلى ما يحظى به من تأييد الملياردير الفرنسي فنسان
بولوريه، الذي يملك، أو يشكّل أغلبية متحكمة داخل مجموعة «فيفندي»
الإعلامية، في وسائل مرئية أو مسموعة (Canal+،
CNews،
إذاعة أوروبا 1…) ومقروءة («جورنال دي ديمانش» «باري ماتش» وقريباً «لو
فيغارو» كما يتردد). ولم يعد خافياً أن قناعات بولوريه تصبّ إجمالاً في
خانة اليمين المتشدد، لكنّ استقراره على زيمور بدل لوبين وحزب «التجمع
الوطني» يعطي إشارة بالغة المعنى لجهة تفضيل المليارات الفرنسية؛ يتوجب
أن تتكامل مع المؤشرات الأخرى السوسيولوجية، أو غير المالية والمصرفية
والاستثمارية، لجمهور اليمين المتطرف في فرنسا، وفي أوروبا عموماً.
كذلك يحدث أن يكتفي البعض بتصريف زيمور تحت عنوان شبه وحيد، ولكنه
أحادي تماماً في الواقع، هو انجذاب الإعلام إلى رجل/ طفرة، صار ظاهرة
سريعاً أخذت تهدد الموقع الثاني الذي يحتله اليمين المتطرف في الحياة
السياسية الفرنسية؛ وأنّ الأقنية والإذاعات والصحف والدوريات إنما
تنجذب إلى ما انجذبت إليه نسبة 17٪ من مؤيدي زيمور. هذا صحيح بالطبع،
حتى بعد أن أخذت معدلات تأييد زيمور تتقلص، وعاد إلى موقع رابع بعد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولوبين نفسها والمرشح المحتمل لليمين
الجمهوري الديغولي؛ إلا أنّ الأصحّ في قلب هذا الصحيح هو أنّ أفكار
زيمور لم تهبط من علٍ على حين غرّة، وجذورها تضرب عميقاً في التربة
ذاتها التي أنبتت سلسلة من الشخصيات والمواقف والعقائد داخل مختلف
تيارات اليميني الديغولي/ الجمهوري.
ويمكن للمرء أن يدع جانباً شخصية مثل إريك سيوتي، القيادي في حزب
«الجمهوريين» وأحد ستة تنافسوا على بطاقة الحزب وقد استحق لقب «زيمور
الجمهوريين» لأنه سعى إلى مجاراة زيمور الأصلي في الإعراب عن كراهية
الأجانب والإسلام والمسلمين، وحلّ أوّلاً في تصويت الجمهوريين يوم أمس؛
إذْ تصحّ العودة إلى نطاق أوسع، وأبعد في المكان والزمان، نحو تلك
الجذور في تلك التربة. في عبارة أخرى، هذه الـ»زيمورستان» كما يميل
البعض إلى التعبير، ليست من طراز الفطر الشيطاني الذي نبت فجأة بسبب أو
من حول زيمور وأفكاره؛ ليس لأنها عتيقة متأصلة وتكررت هنا وهناك لدى
هذا أو هذه من رجالات اليمين الفرنسي التقليدي فقط، بل أساساً لأنها
تمثّل شريحة سوسيولوجية، نظيرة لشريحة إيديولوجية، قابلة للصعود أو
الهبوط طبقاً لسياقات شتى متنوعة.
و»زيمورستان» هذه تستبدل فرنسا بلد اليعاقبة والأنوار والثورة
الفرنسية، وبات أحد أشغالها الشاغلة متابعة الصراع بين لوبين وزيمور
وسيوتي في ترصّد الأجانب والسود والمهاجرين والعرب والمسلمين، والحملقة
في ما يكمن وراء الأكمة من أخطار ناجمة عن عباداتهم ولباسهم وطعامهم
ولهجاتهم. الغائب الأكبر في هذه الوقائع هي الأبعاد السياسية والثقافية
والتاريخية والاجتماعية لظواهر (لأنّ من السخف اعتبارها محض ظاهرة
واحدة متماثلة متطابقة) معقدة شائكة متباينة ليس من الحكمة أبداً ردّها
إلى باعث عقائدي أو اقتصادي أو سوسيولوجي أو رهابي واحد.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
الرأسمالية المعاصرة:
خمس أزمات وحفار قبر واحد
صبحي حديدي
على سبيل المفارقة، التي لا تخلو من وعيد ساخر أيضاً، يذكّر الكاتب
الأمريكي أشلي سميث بأنّ «العهد الجديد» حسب رؤيا يوحنا، يشير إلى
أربعة فرسان من المبشرين بالقيامة: الوباء، والحرب، والمجاعة، والموت؛
لكننا اليوم أمام خمس أزمات كونية كبرى، يتابع الرجل، هي بأكملها من
صنع النظام السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والتكنولوجي والثقافي…
الذي يُختصر في تسمية واحدة: الرأسمالية المعاصرة. صاحب هذا الرأي أحد
أنشط الكتّاب الاشتراكيين في الولايات المتحدة، وهؤلاء كما هو معروف
كانوا فئة نادرة، أو لاح أنها سائرة إلى ندرة أشدّ وأوسع نطاقاً، خاصة
بعد تفكك «المعسكر الاشتراكي» وشيوع نظريات نهاية التاريخ وانتصار
اقتصاد السوق مرّة وإلى الأبد. لكنّ المنتظَر لم يتحقق على أرض الواقع،
بسبب اندحار تلك النظريات وعودة التاريخ من الأبواب الأوسع للأزمات
القديمة والأخرى المستجدة، فكسب أولئك النادرون أكثر من جولة، وعاد
بعضهم إلى الصدارة، وظفرت تشخيصاتهم المضادّة بقبول وانتشار؛ حتى في
الأوساط الفكرية والاقتصادية الأشدّ تشبثاً بأطروحات الرأسمالية
والإمبريالية والعولمة.
وفي موقع المجلة الإلكترونية الأمريكية
Tempest
نشر سميث مقالة مطولة بعنوان «خمس أزمات للرأسمالية: التحديات التي
تواجه اليسار اليوم» لم يهدف فيها إلى تبيان ما يعانيه النظام
الرأسمالي العالمي اليوم من أزمات جلية، لأنها ببساطة تمسّ مصائر
مليارات البشر، فحسب؛ بل يسعى، كذلك، إلى حثّ حركات المقاومة على البحث
عن برامج مضادة وصياغة بدائل عملية. الأزمات الخمس لا مجاهيل فيها
عملياً، لأنها بالفعل على صلة مباشرة ومأساوية بالحياة اليومية
للمعمورة بأسرها: الركود الاقتصادي، المنافسة الإمبريالية، كارثة
المناخ، الهجرة الشاملة وأنظمة الحدود، ثمّ حقبة الأوبئة في ظلّ
الرأسمالية المعولمة.
وهذه أزمات متجذرة في جوهر النظام الرأسمالي، حسب سميث دائماً، وهي
تواصل تشكيل ديناميات إيديولوجية واقتصادية واجتماعية على امتداد
العالم؛ ولا تتوقف عند عواقب مباشرة أو آنية فقط، بل هي تخرّب مقداراً
غير قليل من الركائز الليبرالية للنظام الرأسمالي ذاته، فتنسف شرعية
الأحزاب السياسية التقليدية والمهيمنة لتفسح المجال أمام ولادة أحزاب
التشدد على اليمين واليسار معاً، وتُطلق موجات احتجاج شعبية هائلة وغير
مسبوقة، كما تعيد إحياء أنظمة الاستقطاب التي لاح أنها اندثرت مع الحرب
الباردة وثنائية القطبين الرأسمالي والاشتراكي؛ فلا يتخذ الاستقطاب
سمات عقائدية وسياسية واقتصادية فقط، وإنما يتجاوزها إلى أقطاب
تكنولوجية ومعلوماتية على غرار الصراع بين ميكروسوفت الأمريكية وهواوي
الصينية…
وإلى جانب جائحة كوفيد ـ 19، التي تعصف موجتها الخامسة بالمجتمعات
المتقدمة في الغرب، رغم نجاح معظم الدول الرأسمالية في احتكار اللقاح
وتطعيم أكثر من 70٪ من السكان؛ لا يكاد يمرّ أسبوع من دون اندلاع أزمة
هنا أو هناك، تعكس واحدة أو أكثر من أنساق التأزّم الخمسة التي شخّصها
سميث في مقالته. إذا لم تتوتر واشنطن مع بكين حول تايوان أو هونغ كونغ،
فإنها تدخل في توتر مع موسكو حول عبور غواصة او تفجير قمر صناعي؛ وإذا
لم تتأزم العلاقات بين باريس وكل من واشنطن ولندن وكانبيرا حول عقد
الغواصات الفرنسية، فإنّ بولندا تقف على شفير مواجهة حدودية مع
بيلاروسيا (وروسيا من خلفها) حول موجات المهاجرين… وفي غمرة هذه البذور
التأزيمية، وسواها كثير بالطبع، ثمة استعصاءات شتى متنوعة المضامين
بالطبع، لكنها تتلاقى بصفة إجمالية وتكاملية مع هذا أو ذاك من المآزق
العضوية التي تصيب النظام الرأسمالي العالمي الراهن.
أزمات متجذرة في جوهر النظام الرأسمالي تواصل تشكيل ديناميات إيديولوجية واقتصادية واجتماعية على امتداد العالم؛ ولا تتوقف عند عواقب مباشرة أو آنية فقط، بل هي تخرّب مقداراً غير قليل من الركائز الليبرالية للنظام الرأسمالي ذاته
وذات زمن غير بعيد، في عمر رأسمالية «ما بعد انتهاء التاريخ» على
الأقلّ، قضى أكثر من 15 ألف فرنسية وفرنسي جرّاء موجة طقس حارّ لم تدم
أكثر من أسبوع، ولم تكن الطبيعة مسؤولة وحدها عن إزهاق كلّ هذه الأعداد
الهائلة من الضحايا، إذْ تحملت الدولة الرأسمالية المعاصرة مسؤولية
مباشرة، لأنها تزعم الحرص على الإنسان/ المواطن أوّلاً، ولأنها تمتلك
من أسباب التكنولوجيا ما يكفي لقهر ــ أو في الحدّ الأدني السيطرة على
ـ سورات غضب الطبيعة ثانياً. وكان مصرع هذه الأعداد بسبب أيّام معدودات
من المناخ الحارّ أشبه بهزّة 11 أيلول/ سبتمبر أخرى، مع فارق أنّ
الضحايا الفرنسيين لم يسقطوا على يد الإرهابيين من انتحاريي الطائرات
الخارقة للأبراج، وإنما سقطوا ضحية مزيج من تعبيرات الطبيعة العشوائية
وإهمال الدولة التي لا يتوجّب أن تكون عشوائية. ومن المدهش أنّ كبش
الفداء الوحيد الذي قدّمته الحكومة الفرنسية، يومذاك، كان مدير الصحة
العامة في فرنسا، الذي قدّر أنّه يتحمّل بعض المسؤولية المباشرة عمّا
حدث. لا وزير الصحة استقال، ولا رئيس الوزراء اكترث بقطع إجازته في
الريف الفرنسي، ولا الرئيس جاك شيراك توقف عن زيارة المتاحف والمعالم
السياحية حيث كان يقضي عطلته السعيدة في كندا.
وقبل مؤتمر غلاسكو الأخير، الذي انتهى بدموع ذرفها رئيسه على هزال
مقررات المحفل وتوصياته، كانت جلسات مؤتمر المناخ والبيئة الذي عقدته
الأمم المتحدة في كيوتو باليابان، أواخر 1997، قد دشنت نهج القصور
والتقصير فتجردت على الفور من طابعها الكوني العالمي وتركت جانباً
هواجس وهموم العالم الأكبر والأفقر والأعرض غير المصنّع؛ وانقلبت إلى
تمرين مستعاد مكرر لما كان قد جرى قبل بضعة أشهر في قمّة دنفر للدول
السبع المصنعة + روسيا. آنذاك مارست الولايات المتحدة ما يكفي من
الخيلاء على حليفاتها الأوروبيات والآسيويات، وطرحت النموذج الأمريكي
في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، بوصفه النموذج الكوني الأصلح
والأنصع والأكثر شباباً. وبعد يوم واحد فقط، في أروقة الأمم المتحدة
ومن منابر مؤتمر الأرض الثاني، مارست الولايات المتحدة الخيلاء ذاتها،
مترجمة هذه المرّة إلى ما يشبه السادية البيئية.
الأرقام، من جانبها، كانت تقول إنّ الأمريكي يسمّم البيئة ثلاث مرات
أكثر من أيّ أوروبي، وثلاثين مرّة أكثر من المكسيكي، وخمسين مرّة أكثر
من أيّ مواطن من مواطني العالم الثالث. والأرقام ذاتها كانت تقول إنّ
إسهام الولايات المتحدة في التنمية البيئية الكونية لا يتجاوز 0.1 من
الناتج القومي الإجمالي، على العكس من تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق
جورج بوش بأنّ الولايات المتحدة ستلتزم بمعدل 0.7، والذي اعتُبر سقف
الحدّ الأدنى في مؤتمر ريو 1992. والإنسانية سوف تنتظر من البيت الأبيض
ما هو أسوأ في الواقع، ففي صيف 2017 أعلن الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، لأنه
يرفض أي شيء يمكن أن يقف في طريق «إنهاض الاقتصاد الأمريكي» ولأنه حان
وقت إعطاء الولايات الأمريكية «أولوية على باريس وفرنسا».
وفي الوسع دائماً، وكلما اقتضت الحاجة بالأحرى، استرجاع ذلك المقال
الحزين الذي نشره جيفري ساكس في أسبوعية الـ»إيكونوميست» البريطانية،
وتضمّن اعترافاً مدهشاً بأنّ اعتلال اقتصادات الكون يفرض علينا إعادة
قراءة معطيات ما بعد الحرب الباردة بأسرها. والرجل، كما هو معروف، أحد
كبار اقتصاديي العالم المعاصر، وأحد آخر أبرز الأدمغة الاقتصادية
الليبرالية، وكان أستاذ التجارة الدولية في جامعة هارفارد، ومدير معهد
هارفارد للتنمية الدولية. شهادته تلك لا تتكامل، للمفارقة المذهلة، مع
توصيف المآزق كما عرضتها هذه السطور هنا، فقط؛ بل يلوح أنّ الليبرالي
ساكس يزاحم اليساري الماركسي أشلي سميث على… استعادة نبوءة كارل ماركس
وفردريك إنغلز، قبل 173 سنة: «الرأسمالية تنتج قبل كل شيء حفّاري
قبرها»!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي ) لندن
ني صدر:
التشيّع الليبرالي واستبداد الولي الفقيه
صبحي حديدي
رحل الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر (1933-2021) في منفاه
الفرنسي الذي لجأ إليه منذ حزيران (يونيو) 1981 وحتى وفاته مؤخراً؛
وطُويت برحيله صفحة بالغة الخصوصية في الثورة الإسلامية الإيرانية،
تخصّ شريحة محدودة العدد من المثقفين التكنوقراط والشباب الذين التفوا
حول آية الله الخميني وجهدوا لدفعه نحو صيغة اجتماعية وإصلاحية من
الإسلام والتشيّع، وكان بعضهم (بني صدر نفسه، وأمثال صادق قطب زاده) في
عداد أبكر ضحايا استشراس الإمام حين استقرّ على نسخة أوتوقراطية
استبدادية متشددة من تشيّع ولاية الفقيه.
وتلك كانت صفحة قصيرة الأمد، بالطبع، استمدّ أفرادها القسط الأكبر من
حضورهم، في المشهد الداخلي الإيراني بعد انتصار الثورة الإيرانية، من
حقيقة الصلات الوثيقة التي جمعتهم مع الخميني خلال سنوات إقامته في
ضاحية نوف لوشاتو قرب العاصمة الفرنسية، بحيث أنّ معظمهم عاد معه على
الطائرة ذاتها التي أقلته من باريس إلى طهران. ولهذا لم يكن غريباً أن
يمحض الإمام بني صدر ثقة عالية، وأن يصغي إلى أفكاره، وأن يكلفه بشغل
هذه الحقيبة الوزارية أو تلك، وألا يغضب عليه حين رفض التوزير مراراً.
لن تطول هذه الحال، كما هو معروف، خاصة حين شرع بني صدر في إعلان خلافه
مع هذا أو ذاك من آيات الله، ومساندة حكومة مهدي بازركان الإصلاحية،
ورفض اقتحام السفارة الأمريكية وأخذ الرهائن، والدعوة إلى إسلام عادل
قائم على حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة.
في الانتخابات الرئاسية لشهر شباط (فبراير) 1980، حقق بني صدر نصراً
كاسحاً بمعدّل 76٪، فكان بذلك أوّل رئيس يُنتخب ديمقراطياً في عهد
الثورة الإسلامية، الأمر الذي لم يرق للخميني، فأمر الفائز بالتنازل
لصالح مرشح مجلس الثورة الإسلامية الذي لم يتجاوز 5٪ من الأصوات، فرفض
بني صدر واندلعت بذلك معركة مفتوحة مع الإمام، بلغت الأوج مع دعوة بني
صدر إلى إجراء استفتاء عام حول صلاحيات الخميني القصوى التي كرّسها
مبدأ ولاية الفقيه. ويحفظ التاريخ للإمام عبارته الشهيرة التي أغلق بها
الباب أمام فكرة الاستفتاء: حتى لو وافق عليه 35 مليون إيراني، فلن
أقبل به! خلال الفترة ذاتها، ورغم أنه كان الرئيس الشرعي المنتخب، فقد
أصدر آية الله جيلاني، رئيس المحاكم الثورية في طهران، سلسلة فتاوى
تقضي بإعدام بني صدر؛ وفي حزيران (يونيو) 1981 حاك المجلس محاولة
انقلابية ضدّ الرئيس، اضطرت بني صدر إلى التسلل من إيران نحو فرنسا.
هذا السجلّ، الحافل بحسّ ثورة إصلاحي ورومانتيكي وإسلامي معتدل وجليّ
الميل إلى مأسسة الثورة الإسلامية على أسس تشاورية أو مناهضة على
الأقلّ لاستبداد ولاية الفقيه، مكّن العديد من الباحثين في تاريخ
الثورة الإسلامية الإيرانية من استسهال إطلاق صفة «اليسار» وبالتالي
«الإسلام الإيراني اليساري» أو حتى «التشيّع الليبرالي» على مسارات بني
صدر. ليست هذه رياضة آمنة، في تقدير هذه السطور، لأسباب شتى معقدة تتصل
أوّلاً بأية حصيلة فعلية وعملية أنجزها جيل بني صدر وقطب زاده، أو ربما
بازركان نفسه، ويصحّ فيها توصيف «اليسار» أو «الليبرالية». الأفكار
ملفّ آخر، بالطبع، وقارئ مؤلفات بني صدر المبكرة، ثمّ تلك التي أنجزها
من منفاه الفرنسي بعد طول اختمار وتأمّل وتحرر؛ ليس في وسعه اعتبارها
سلّة واحدة متكاملة متضافرة تمثّل بني صدر طالب المدرسة الثانوية
المتحمس لثورة محمد مصدّق في وجه الاحتكارات النفطية، أو الطالب
الجامعي المتمرد على متاهة الإيديولوجيات والعقائد في إيران مطالع
الخمسينيات، أو مرشح الدكتوراه في الاقتصاد السياسي؛ فكيف بأوّل رئيس
يتمّ انتخابه في إيران ما بعد الثورة، بحماس كاسح.
بهذا المعنى يُفهم توجس بني صدر من استبداد الإمام الواحد، الذي سيحمل في الفقه الشيعي السياسي الحديث والمعاصر تسمية الولي الفقيه، حتى إشعار طويل أو ربما مرّة وإلى الأبد
والحال أنّ بني صدر كان سليل حركة أعرق تاريخاً، وأعمق جذوراً، ولعلها
أخطر دلالة أيضاً؛ هي «حركة المشروطة» التسمية الثانية لثورة دستورية
رائدة انطلقت سنة 1905 ضدّ الشاه مظفر الدين، وقادها الفقيه الشيعي
الملا محمد كاظم الخراساني (كان بين أنسب ألقابه أنه الأب المؤسس
للدستور والنهضة والإصلاح السياسي في إيران) وعاونه نفر من كبار رجال
الدين الذين تألفوا من الشيعة غالباً. على رأس هؤلاء وقف آية الله
الميرزا محمد حسين الغروي النائيني (1860-1936) الذي لا يتردد بعض
الباحثين في اعتباره طبعة شيعية من مارتن لوثر، لم يقتصر تأثيرها على
إيران أو المشرق الشيعي.
لافت، في المقابل، أن» الصفّ المناهض للحركة، والذي كان ينتهي إلى خدمة
الشاه عملياً، قاده نفر من آيات الله استحقوا بالفعل تسمية «أنصار
المستبدّة» ولم يتحرّج النائيني في وضعهم ضمن فريق «عَبَدة الظالمين»
و«علماء السوء» و«لصوص الدين» و«مُضلّي ضعفاء المسلمين». وكان النائيني
يستلهم جمال الدين الأفغاني وروحية «طبائع الاستبداد» ولكن في ميدان
سياسي فقهي شائك هو الإمامة الغائبة، ومدى حقّ الأمّة في ولاية نفسها،
وتشكيل حكومة زمنية عادلة؛ بدل الركون إلى حكومة لازمنية مطلقة
(ومستبدة بالضرورة، لأنها جزء من «شعبة الاستبداد الديني» حسب
النائيني).
وبهذا المعنى أوّلاً، وضمن توجهات أخرى مركبة، يُفهم توجس بني صدر من
استبداد الإمام الواحد، الذي سيحمل في الفقه الشيعي السياسي الحديث
والمعاصر تسمية الولي الفقيه، حتى إشعار طويل أو ربما مرّة وإلى الأبد؛
ويُفهم واحد من أكثر مؤلفات بني صدر تعبيراً عن مخاوفه كمتشيّع بدأ
ليبرالياً/ خمينياً، وانخرط في الثورة، وترأس الجمهورية الإسلامية، قبل
أن يُجهز عليه استبداد الوالي الفقيه وأجهزته وقضاته وفقهائه. ففي
«عبادة الفرد» 1976، الكتاب الذي لم يفلح بني صدر في إخفاء صلاته
الفعلية والدلالية بالمفهوم الستاليني للتعبير، لا يخطئ القارئ معرفة
المقصود بالفرد الذي يُعبد، من جهة أولى؛ ولا بالفقه التنظيري
والتطبيقي الذي يسيّج تلك العبادة، من جهة ثانية.
ولعلّ معضلة بني صدر الثانية، الجوهرية والمحورية مع ذاك، أنه لم يتمتع
بمقدار كافٍ من الخصال الكارزمية التي مكّنت أمثال علي شريعتي أو محمد
حسين طباطبائي أو محمود طالقاني من إحداث تغييرات جلية في طرائق ترسيخ
فقه شيعي حيوي ومتحرك، خلال الثورة أو بعدها؛ كما أنه افتقر، كرجل دولة
هذه المرّة، إلى العديد من ديناميكية بازركان في التوفيق بين آلة
الدولة والحوزة، خاصة في منعطفات حاسمة مثل أزمة الرهائن الأمريكيين.
ولعلّ المثال الأبرز هنا هو عجز بني صدر عن فضح التواطؤ الإيراني مع
مساعدي المرشح الأمريكي للرئاسة رونالد ريغان، في سياق ما عُرف
بـ«مفاجأة أكتوبر» فلم يكشف ما في جعبته من معلومات إلا بعد خروجه إلى
المنفى الفرنسي.
ومن نافل القول إنّ نظير بني صدر، ولكن على الجانب الآخر من مثقفي
وشباب ورجال الدولة في الثورة الإسلامية، كان محمود أحمدي نجاد الرئيس
الإيراني السادس بين 2005 و2013. هذا رجل دخل تاريخ إيران من بوّابة
تفصيل يقول إنه أوّل رئيس إيراني يقبّل علانية يد المرشد الأعلى/
الوالي الفقيه، ليس لأنه مرشّح خامنئي المفضّل، وألعوبة في يده، فحسب؛
بل أساساً لأنه أيضاً صار رأس الحربة في صفّ المحافظين المتشددين. وذاك
موقع عجز بني صدر عن شَغْله كقائد، وليس رأس حربة بالضرورة، في صفّ
الإصلاحيين أو الليبراليين أو حتى التكنوقراط؛ رغم أنّ رصيده الجماهيري
لم يكن أقلّ من الحشود الشعبوية التي اعتاد أحمدي نجاد استنفارها، وفي
هذا فارق إضافي غير ضئيل في معادلة متشيّع ليبرالي تراءت له القدرة على
مقارعة استبداد الولي الفقيه، انكسرت أحلامه أوّل الدرب.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
خلف العمائم السوداء: ماذا تبقى
من «إسلام يساري» في إيران؟
صبحي حديدي
يُعرف الكثير عن المحطات الأشدّ قتامة في تاريخ الرئيس الإيراني الجديد
إبراهيم رئيسي؛ سواء في ميادين القضاء وأحكام الإعدام وقمع الحريات
والتشدد، أو في التقرّب من السلطات الأعلى والتطبيق الحرفي المفرط
لأحكام ولاية الفقيه. وإذْ استلم رئيسي الأمر التنفيذي بالتعيين من يد
المرشد علي خامنئي شخصياً، ثم أقسم اليمين رسمياً أمام مجلس الشورى،
فإنّ تفصيل القول في ماضي الرجل بات تحصيل حاصل لا يغني مراقبي شؤون
إيران وشجونها؛ إلا إذا شاء المراقب أن يربط بين غلوّ رئيسي القاضي
والمدّعي العام، وما يُنتظر منه على صعيد المغالاة الأشدّ في منصبه
الجديد.
ثمة، إلى هذا، أكثر من ميدان جدير بالمراقبة، أو الترقب على وجه الدقة،
في كلّ ما اتصل أو سوف يتصل بموقعه ضمن المعارك العقائدية والفكرية
والدستورية التي تُخاض في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية على وجه
التقريب، والتي يحلو للعديد من الباحثين المتعمقين في الملفات
الإيرانية أن يطلقوا عليها صفة الصراع بين «يمين إسلامي ثيوقراطي»
و«يسار إسلامي جمهوري»؛ وثمة، غنيّ عن القول، مزالق غير قليلة في
اللجوء إلى تصنيفات كهذه، رغم أنّ معطياتها المعقدة والمتشابكة تبرر
هذا اللجوء إلى عدّة اصطلاحية ميسّرة، كي لا يُقال إنها متخففة من
أثقال الدقة والتدقيق. فإذا شاء المرء القبول، المبدئي على الأقلّ،
بطبائع صراع كهذا، فإنّ مستقبل رئيسي لن ينحصر في ممارسة مهامّ الرئاسة
وصلاحياتها، بل سيمتدّ إلى تشديد ميادين اشتغال أحكام ولاية الفقيه، من
جهة أولى؛ ثمّ توظيفها تدريجياً بما يخدم تهيئة رئيسي للمنصب التالي
الأعلى والأخطر، أي المرشد الأعلى/ الوالي الفقيه، من جهة ثانية؛ الأمر
الذي يعني، من جهة ثالثة، تسخير هذه الديناميات وسواها في صراع
الإسلامَين، اليميني الثيوقراطي واليساري الجمهوري، لصالح الإسلام
الأوّل بالطبع.
أكثر من هذا، عند بايام محسني مدير «مشروع التشيّع والقضايا العالمية»
في جامعة هارفارد، ثمة معطيات كافية تبرر تعريف بنية النظام في
الجمهورية الإسلامية طبقاً لأربعة أقسام فرعية: اليمين الثيوقراطي،
ونظيره اليسار الثيوقراطي، واليمين الجمهوري، ونظيره اليسار الجمهوري؛
حيث يُبنى انقساما اليمين واليسار على موقف كل فريق من مبدأ «العدالة
الاجتماعية مقابل اقتصاد السوق». وهو مقترح يجده الكثيرون مفيداً، خاصة
باولا ريفيتي، أستاذة السياسة والعلاقات الدولية في جامعة مدينة دبلن،
وصاحبة الكتاب المميّز «المشاركة السياسية في إيران من خاتمي إلى حركة
الخضر» الذي صدر بالإنكليزية السنة الماضية. ومن نافل القول إنّ الخضر
ليسوا تياراً سياسياً بيئي التوجهات، على غرار حركات الخضر هنا وهناك
في العالم، فحسب؛ بل ثمة قسط وافر، ولعله ينطوي على مفاجأة لافتة، من
الأطروحات الفكرية والعقائدية والسياسية والثقافية، غير المألوفة في
خضمّ السجالات التي عصفت بالبلد منذ قيام الجمهورية الإسلامية.
ومن الجدير بالتأمل أنّ نُخَب «اليمين» و«اليسار» أو «المحافظين»
و«الإصلاحيين» للذين يفضّلون التعبير الأكثر رواجاً، اتفقت بدرجات
متقدمة على قبول السياسات ذاتها التي تمّ إقرارها منذ أواسط تسعينيات
القرن المنصرم، واقتُرحت من حكومات يمينية أو محافظة أو متشددة،
ابتدأها هاشمي رفسنجاني.
ليس إجحافاً بحقّ اليسار الإيراني، أياً كانت تسمياته، التسليم بأنه في حال من التراجع والانحسار أو حتى المحاق، وأنّ رموزه وشرائح واسعة من جماهيره تسير خلف عمائم آيات الله السوداء، صاغرة تارة أو راضية طوراً.
وكلا النخب ساندت إدراج إيران في أسواق العولمة، كما صادقت على
السياسات الثقافية/ الدينية أو صمتت عن بعضها الذي يجحف بالحقوق
المدنية وحرية التعبير، وكذلك سكتت عن ستراتيجيات «تصدير الثورة» ودعم
أنظمة الاستبداد والفساد هنا وهناك في الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال،
كان رجل مثل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لا يدين بالقسط
الأعظم من شعبيته لمواقفه «المحافظة» أو «المتشددة» بل لطراز من
الشعبوية الفاقعة في مهاجمة الإمبريالية وامتداح الليبرالية الاقتصادية
في آن معاً. ومما له دلالة خاصة أنّ «اليسار الثيوقراطي» لم يعترض على
خيارات الخصخصة التي اعتمدها نجاد، بترخيص من المرشد الأعلى بالطبع
واتكاءً على التعديل الذي أدخله خامنئي في أيار (مايو) 2005 على المادة
44 من الدستور، بحيث أفسح المجال أمام بيع ممتلكات الدولة، فضلاً عن
خصخصة قطاع التأمين الصحي.
وتلك حال أثارت أسئلة جدية حول أسباب التفاف استخبارات «الباسيج»
و«الحرس الثوري» (فضلاً عن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله!)
حول سياسات أحمدي نجاد؛ ثمّ أسباب سكوت أو تواطؤ أو حياء «اليسار»
عموماً، الجمهوري أو الثيوقراطي كيفما شاء المرء؛ وأخيراً، أسباب محاق
الرجل، إلى درجة رفض ملفه للترشيح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ليست أقلّ إثارة للأسئلة حقيقة أنّ «اليسار الإسلامي» في إيران بدأ
خمينياً في الغالب، بمعنى أنّ رجالاته الأوائل كانوا من أشدّ المخلصين
للإمام الخميني، وهيمنوا على الحياة السياسية والعقائدية في البلد طوال
الثمانينيات مع صعود نجم رئيس الوزراء مير حسين موسوي، وسيطرة النوّاب
الإصلاحيين على البرلمان. ثمّ توجّب أن يعطي خامنئي إشارة البدء
بتحجيم، وبالتالي تصفية، ذلك «اليسار» حيث كان رفسنجاني هو الأداة
والقبضة والهراوة. وكان لافتاً، ودراماتيكياً أيضاً، أن يُستبدل تعبير
«المستضعفون» بسلسلة مفردات بديلة تشير إلى الطبقة الوسطى أو الريف أو
المدينة باعتبارها جمهور المرحلة والمعمار الطبقي الذي يستند إليه
«اليمين الثيوقراطي»؛ في غمرة المزيج ذاته من مواقف «اليسار
الثيوقراطي»: الصمت أو التواطؤ أو القبول.
وهكذا يبدو صعود رئيسي، إلى سدّة الرئاسة ثمّ إلى موقع المرشد الأعلى
ساعة وفاة خامنئي، بمثابة تتويج جديد لمحاق اليسارَين الإسلامييَن،
الجمهوري والثيوقراطي، في إيران؛ ونذيراً بأنّ تيار «المحافظين الجدد»
الذي نشأ وترعرع في عهد أحمدي نجاد، إنما يستعيد زمام المبادرة بعد
الفاصل النسبي الذي شهد رئاستَي حسن روحاني. وهو نذير وبال كفيل بردّ
البلد سنوات طويلة إلى وراء، وربما إلى ما قبل رئاسة محمد خاتمي
الأولى، 1997، حين لاح أنّ التيّارات الإصلاحية توشك على إحراز تقدّم.
وليس إجحافاً بحقّ اليسار الإيراني، أياً كانت تسمياته، التسليم بأنه
في حال من التراجع والانحسار أو حتى المحاق، وأنّ رموزه وشرائح واسعة
من جماهيره تسير خلف عمائم آيات الله السوداء، صاغرة تارة أو راضية
طوراً.
وهذا مآل لا يغلق التاريخ الراهن أو يسدّ آفاق المستقبل بالضرورة،
فليست بعيدة في الزمان تلك البرهة التي شهدت اندلاع تظاهرات طلابية
ضخمة في شوارع طهران، طالبت باستقالة خامنئي وخاتمي معاً، وكان الأخير
واجهة الإصلاح؛ كما شهدت إعلان مجموعة مؤلفة من 248 شخصية إصلاحية بأنّ
«وضع أشخاص في موضع السلطة المطلقة والألوهية هو هرطقة واضحة تجاه الله
وتحدّ واضح لكرامة الإنسان» في إشارة عدائية لمبدأ ولاية الفقيه، لعلها
مثّلت النقد الأوضح والأكثر جرأة حتماً منذ انتصار الثورة الاسلامية.
وأمّا في في عام 1911 فإنّ زعيم البلاشفة فلاديمير إيليتش لينين لم
يتردد في القول إنّ واحدة من أبرز علائم اليقظة الآسيوية تتبدّى بعمق
في «حركة المشروطة»؛ التسمية الثانية للثورة الدستورية الإيرانية التي
اندلعت عام 1905 ضدّ الشاه مظفر الدين، وقادها فقهاء ومشايخ شيعة
بارزون من أمثال محمد الطباطبائي وعبد الله البهبهاني وكاظم الخراساني
وعبد الله المازندراني ومحمد حسين النائيني. ومن الإنصاف الترجيح بأنّ
أرحام الإيرانيات لن تعجز عن ولادة نساء ورجال، على غرار قادة
«المشروطة» وعلى نقيض خامنئي ورفسنجاني ونجاد ورئيسي…
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
السودان: درس الجفاء المزمن
بين الجيش والديمقراطية
صبحي حديدي
وحدهم أصحاب النوايا الحسنة، وبعض السذّج بالطبع، انتظروا أن تسير
الانتفاضة الشعبية في السودان من حسن إلى أحسن، وأن تتجاوز العقبات
والمصاعب والإشكالات والاستعصاءات التي شهدتها انتفاضات عربية سابقة،
في تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا، أو حتى الجزائر. ولقد توفّر طراز،
كاذب عن سابق قصد ومخادع، من التغنّي بالسلمية وائتلاف الجيش مع
التكوينات المدنية المختلفة، فضلاً وجود «تكنوقراطي» ربيب مؤسسات
اقتصادية أممية على رأس الحكومة. غير أنّ الحقائق، الصلبة الصارخة
المحتومة أحياناً، تتابعت سريعاً لجهة تأكيد هيمنة الجيش وجاهزية
ميليشيات جنجويد الماضي القريب/ «قوات الدعم السريع» الحاضر لاستعادة
ألوان البطش القديمة إياها؛ ولجهة استئناف تحالفات الهيمنة والفساد، في
مستويات شتى اقتصادية وسياسية واستثمارية؛ ثمّ تنويع شبكات الارتباط
والعمالة الإقليمية، من مصر والإمارات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي
وتشاد وخليفة حفتر.
وقد يساجل مساجل، على نحو مشروع لا يغيب عنه بعض الصواب، أنّ هذه حال
منتظَرة من انتفاضة على الشاكلة التي اتخذتها، وبالقياس والمقارنة مع
شقيقاتها الانتفاضات العربية هنا وهناك؛ ما خلا أنّ سجالاً كهذا يتوجب
أن يردّ الكثير من عناصر التأزّم الراهنة إلى معضلة كبرى شرقية (بل
تكررت بعض الوقت غربياً، كما في اليونان الحديث) هي علاقة الامتناع
الكلاسيكية بين المؤسسة العسكرية ونظيرتها المؤسسة المدنية، أو الجفاء
المزمن بين الجيش والديمقراطية على نحو أعرض.
وفي سياق سجالي مثل هذا لا يصحّ، منهجياً على الأقلّ، استبعاد الفرضيات
التي تقول إنّ حاكم السودان الأقوى اليوم هو عبد الفتاح البرهان رئيس
مجلس السيادة، وأنّ الثاني من حيث القوّة هو محمد حمدان دقلو آمر وحدات
«الدعم السريع»، وللمرء أن يضع رئيس الحكومة في أية مرتبة بعد ذلك!
وليس من كبير فارق، بالنسبة إلى شعب السودان أو مسارات انتفاضته، أن
يتوجه هذا إلى القاهرة أو ذاك إلى أبو ظبي أو ثالث إلى أنقرة أو رابع
إلى واشنطن أو خامس إلى موسكو… ما دامت النتائج تنتهي، في كثير وليس في
قليل، إلى الحصيلة المشتركة: هيمنة الجيش.
وحين يتحدث حمدوك عن «أزمة وطنية شاملة»، يُدرج في تضاعيفها بنود تأزّم
كبرى مثل تعدّد مراكز القرار وتفاقم الفساد وتصاعد الخلاف بين شركاء
الفترة الانتقالية، فيستخلص أنها تنطوي على أخطار تهدد «وجود السودان
نفسه»؛ ألا يبدو وكأنه يرجّع الكثير من أصداء العواقب التي اقترنت
بأطوار ما بعد إعادة إنتاج هذا أو ذاك من أشكال الاستبداد، في أطوار ما
بعد هذه أو تلك من انتفاضات العرب؟ في عبارة أخرى، هل اختلف السودان
كثيراً عن شقيقاته العربيات في مسألة واحدة على الأقل، لكنها مركزية
تماماً، هي موقع المؤسسة العسكرية في تشكيلات ما بعد إعادة تدوير
الأنظمة؟
وأمّا الاشتباكات القبلية الراهنة، في غرب دارفور بصفة خاصة، والتي
أوقعت وتوقع عشرات القتلى؛ فإنّ أسوأ قراءة لها، وأكثرها تخابثاً
وتزويراً، هي تلك التي أخذت تعتمدها مؤسسة الجيش السوداني، من حيث
اختزالها إلى ميليشيات نهب وسلب «عابرة لدول الجوار الإقليمي». هذا، في
أعمق مدلولاته، طراز آخر من إعادة تدوير معضلة سودانية عتيقة، لدولة –
أمّة يتكلم مواطنوها أكثر من مائة لغة، وينقسمون إلى عشرات المجموعات
الإثنية، وتتناهبهم خطوط ولاء قبلية وجغرافية ليس أقلها انقسام الشمال
بثقافته العربية، والجنوب بثقافته الأفريقية أو الوثنية، فضلاً عن
الإسلام والمسيحية بالطبع.
وفي كلّ حال، ليس الجيش هو المؤهل لحمل لواء الإصلاح وملاقاة المطالب
الشعبية والسير بالانتفاضة الشعبية إلى أهدافها العليا، بل من الأصحّ
القول إنّ الصراعات الراهنة التي تحتدم اليوم بين رؤوسه، ثمّ بين هؤلاء
والمكوّنات المدنية للحكم؛ إنما تعيد تكرار مآسي انتفاضات عربية أخرى،
بل هي تقتدي بأشرس ما أفرزته الثورات المضادة من تقاليد ارتداد ونكوص
نحو الاستبداد.
طاسة لبنان وسلال «حزب الله»
صبحي حديدي
قد لا يبالغ مراقب ملمّ بالشأن اللبناني، ملفات ومنعرجات وتقلبات، إذا
رأى أنّ لائحة الاستجواب التي استقر عليها المحقق العدلي طارق بيطار
أقرب إلى مضبطة اتهام تشمل معظم «القرطةّ»، بحسب التعبير الشهير
لأشقائنا اللبنانيين؛ التي يمكن بالفعل أن تكون متورطة في كارثة انفجار
مستودع النترات في مرفأ بيروت. والتي يصحّ، أيضاً، النظر إليها
كـ»عصابة» حاكمة متسلطة فاسدة، عالية التفاهم حول نهب البلد وإفقاره؛
بصرف النظر عن مستويات التدني أو التكامل بين أجنداتها السياسية
والمالية، وارتهاناتها الإقليمية والدولية.
ورغم احتواء اللائحة على أسماء رئيس حكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن
وزراء سابقين، وقائد سابق للجيش ومدير أسبق للمخابرات العامة ومدير
الأمن العام الحالي ومدير عام أمن الدولة والمدير العام للجمارك، وأنّ
اللائحة تصلح مرآة، غير شاملة وغير متكاملة، لاستطالات الأحزاب
والطوائف في مختلف مفاصل الدولة العميقة (إذا جاز الحديث هكذا)؛ فإنّ
ما تعثر فيه المدعي العام السابق القاضي فادي صوان، قبل تنحيته، هو
المآل الذي ينتظر أشغال المحقق الحالي.
لقد أسمعتَ لو ناديت حياً، وذلك رغم أنّ المنادَى ليس حياً يتمتع بكلّ
أسباب القوّة والمنعة والحصانة والقدرة على تنظيم هجومات مضادة شتى،
فحسب؛ بل كذلك لأنه حيّ يُرزق، ضمن أسوأ ما يعنيه الارتزاق من نهب
وفساد وجشع وطمع واستهانة بأبسط مقتضيات الانتماء إلى بلد وشعب، تقول
المؤسسات المالية الدولية إنه يعيش واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية
ومالية ومعيشية لم تعرفها شعوب الأرض منذ عام 1850.
ثمة من يساجل، مع ذلك أو بسبب ذلك على وجه التحديد، أنّ القوى
الإقليمية والدولية التي أتاحت ولادة لبنان في الأساس، وأرادته على هذه
الشاكلة التي تطورت وتبدلت وتقلبت من دون أن تغادر الصيغة الطائفية
والسياسية التي بُني عليها؛ لن تسمح بانهيار كامل لهذا الـ»لبنان»،
المطلوب والمرغوب والخادم الملبّي لسلسلة اعتبارات لا تخرج البتة عن
ضرورات جيو – سياسية عابرة للمحليّ، أو حتى الإقليمي. ومَن يساجل هكذا،
يتوجب أن يقرّ أيضاً بأنّ في طليعة المحرّضات على الانهيار عجز رعاة
لبنان عن تفكيك عُقَد «حزب الله»، وهي في صيغة الجمع لأنها ليست عقدة
واحدة تنبثق من سلّة النفوذ الإقليمي الإيراني، بل تتراكم مجاميعها من
سلال الحزب اللبنانية ذاتها. وهذه لا تبدأ من سلطة السلاح والأمر
الواقع والدولة فوق ما تبقى من ركام «دولة لبنان الكبير»، وتمرّ بالطبع
من حقيقة توزّع السكان على 18 طائفة ومذهبا، ولا تنتهي عند التحالف
العجيب الشيعي – المسيحي الذي ينخرط فيه الجنرال الرئيس ميشيل عون.
والراغب في عدم استرجاع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حتى من
باب تشييعها إلى مثواها، لن يعدم مبادرة بابا الفاتيكان في تخصيص «يوم
التأمل والصلاة من أجل لبنان»؛ الذي شارك فيه عشرة من قادة الكنائس
اللبنانية، وبدا أنّ أية «طاسة» مخلصة مقدسة ليست مرشحة للضياع في
الزحمة هذه، وأنّ لبنان الملقّب بابوياً بـ»عطية السلام» لا يدير حروبه
من روما، ولم تعد شبكات دمشق أو الرياض أو طهران ضرورية لكي تنقلب
الشرارة إلى حرائق؛ لأنّ ما تحت الرماد من اضطرام معيشي يومي كفيل
بتصدير اللهيب، وليس الشرارة وحدها.
وبين أحدث العجائب، في مضمار راهن على الأقل، أنّ الثنائي الشيعي منقسم
حول مبادرة نبيه بري لتسهيل ولادة حكومة سعد الحريري، وأنّ الأنظار
أكثر شخوصاً إلى مفاوضات فيينا منها إلى التراشق اللفظي بين رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وليست لائحة اتهام المحقق العدلي
الجديد سوى العجيبة المرادفة للحال المعلّقة إياها، حين تتوجه أصابع
الاتهام إلى ممثلي «القرطة» من دون أن يهتز رأس كبير أو يُرمى أحد
«الـكلّن يعني كلّن» بوردة؛ أو طاسة لمَن يشاء، من ركام الطاسات
الضائعة المتلاطمة وسط سلال «حزب الله».
رامسفيلد في سلة مهملات التاريخ:
صقر الاجتياح وتجميل الوحشية
صبحي حديدي
لا شماتة
في الموت، يقول المبدأ الأخلاقي العريق، الذي لا يلغي مع ذلك أياً من
حقوق تبيان مساوئ الميت؛ خاصة إذا كان يستحق صفة مجرم الحرب، وفي ذمته
مئات أو آلاف أو حتى ملايين الضحايا ضمن مسؤوليات مباشرة أو غير
مباشرة. هذه حال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد (1932 ـ
2021)، الذي رحل عن عالمنا وفي سجلّه الوظيفي مناصب شتى بينها وزارة
الدفاع مرّتين، وألقاب عديدة حفظ له التاريخ واحدة مزدوجة: بطل اجتياح
أفغانستان، واجتياح العراق. وأمّا في الملفات التفصيلية ضمن الألقاب،
فإنّ أفانين التعذيب الوحشية ضدّ المعتقلين في سجنَيْ أبو غريب
وغوانتانامو هي العلامة المسجلة الأكثر بشاعة وانحطاطاً.
حجب الشماتة في الموت لا يلغي، كذلك، الحق في إحالة الميت إلى سلّة
مهملات التاريخ؛ أو تلك الصيغة الموازية التي عدّلها الثوري والمنظّر
الروسي ليف دافيدوفيتش تروتسكي إلى «مزبلة التاريخ» وشاءت المفارقة أن
يكون هو نفسه بين أوائل ضحايا ذلك التعديل القاسي الرهيب. لقد ربح
معركة تنظيم الجيش الأحمر ومعارك إرسال «القطار البلشفي» إلى آخر أصقاع
روسيا، أو إلى «عين الشمس» كما كان يحلو له القول؛ لكنه نام على حرير
نظرية «الثورة الدائمة» متجاهلاً تلك الحروب الخفية التي كان جوزيف
ستالين يضرم أوارها في اللجان الحزبية والمفوّضيات السوفييتية، فكان أن
وقع القضاء واختار الثوري الرومانتيكي بقعة نائية في المكسيك، لاختتام
دورة التاريخ التي لا ترحم.
وفي ولاية نيو مكسيكو، في أمريكا الراهنة التي أخرجت دونالد ترامب من
البيت الأبيض دون أن تخرجه من أفئدة وعقول قرابة 70 مليون أمريكي محافظ
أو عنصري أو انعزالي أو شعبوي، أغمض رمسفيلد عينيه للمرة الأخيرة؛
محتفظاً، أغلب الظن، بذاكرة فخارٍ صقرية محاربة عسكرتارية نابعة من
اليقين ذاته الذي استخدمه جورج بوش الابن في رثائه: أنه خلّف أمريكا
أكثر أماناً. كلّ هذا رغم أنّ المفارقة السوداء شاءت أن يرحل الصقر
العجوز وجيوش بلاده تحزم الحقائب لمغادرة أفغانستان، بعد أكثر من 111
ألف قتيل أفغاني في صفوف المدنيين، و64100 ضمن أفراد الجيش الوطني
والشرطة، وأكثر من 2300 قتيل أمريكي، حسب تقديرات الأمم المتحدة وجامعة
براون. حصيلة خراب دامية، لكنها لا تضمن البتة أن يسقط البلد مجدداً في
قبضة الطالبان، وكأنّ 20 سنة من التدخل العسكري الأمريكي لم تُنتج ما
هو أوضح من إعادة تمكين الخصم!
وقبيل سطوع نجمه كوزير دفاع الاجتياحات الأمريكية في أفغانستان
والعراق، كان رامسفيلد قد دخل إلى وقائع الشرق الأوسط من بوّابة
الزيارة التي قام بها إلى العراق أواخر العام 1983 مبعوثاً خاصاً من
الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان؛ حيث استقبله صدام حسين، ليسمع
منه أمنيات البيت الأبيض بتفعيل العلاقات بين واشنطن وبغداد، والاتفاق
على صفقات نفط سرّية، وجسّ النبض حول خط أنبوب للنفط عبر الأردن، فضلاً
عن تشجيع النظام العراقي على المضيّ أبعد في الحرب مع إيران. وفي
مذكراته «معروف وغير معروف» 2011، سوف يروي رامسفيلد تفاصيل ذلك اللقاء
من وجهة نظره بالطبع؛ نافياً كلّ ما اقترن به، سابقاً ولاحقاً، من
“تقوّلاتّ”، عاجزاً في كلّ حال عن استبعاد رغبة إدارة ريغان في التودد
إلى النظام العراقي، ضمن أجندة إقليمية واسعة النطاق.
التاريخ من جانبه فتح سلال مهملاته على وسعها لاستقبال رامسفيلد، بوصفه ذلك الصقر الذي صرف جلّ حياته في تبرير اجتياح الأمم وتجميل قبائح التعذيب
في تبرير
اجتياح بغداد سنة 2003، سعى رامسفيلد إلى اختصار المغامرة العسكرية
الأمريكية على النحو الغائم والفاضح والمجازي بالمعنى الأردأ للتزييف،
هكذا: «إعادة العراق إلى العراقيين»! في الآن ذاته كانت جيوشه على
الأرض منهمكة بإنزال أحمد الجلبي في الناصرية من دون سابق إنذار (ونعلم
اليوم ـ من خلال كتاب مايكل غوردن وبرنارد تراينر «كوبرا
II:
القصة المستورة لغزو واحتلال العراق» 2006 ـ أنّ تلك الخطوة جرت من دون
علم الساسة المدنيين، بمَن فيهم الرئيس بوش الابن نفسه، ونفّذها
الجنرالات كما يليق بأعرق الأنظمة العسكرتارية)؛ وفي فتح شوارع البصرة
وبغداد أمام اللصوص وناهبي المتاحف والبيوت والدوائر الرسمية، مع حراسة
مبنى واحد وحيد في بغداد كلّها: وزارة النفط العراقية!
كذلك لم يبخل رامسفيلد في تسويق جملة الأفكار الجيو ـ سياسية التي نظّر
لها رهط المحافظين الجدد، في غمرة تبشيرهم بـ«مشروع قرن أمريكي جديد»؛
والتي اختُصرت يومذاك في ثلاثة أهداف ستراتيجية على الأقلّ: 1) تحويل
العراق إلى قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة وحيوية، تزيل عن كاهل أمريكا
أعباء بقاء قوّاتها في دول الخليج، والسعودية بصفة خاصة، وما يشكّله
هذا الوجود من ذريعة قوية يستخدمها الأصوليون لتحريض الشارع الشعبي ضدّ
الولايات المتحدة وتشجيع ولادة نماذج جديدة من أسامة بن لادن ومنظمات
علي غرار القاعدة؛ و2) السيطرة على النفط العراقي، التي تشير كلّ
التقديرات إلى أنه يقترب من موقع الاحتياطي الأوّل في العالم، أي بما
يتفوّق على السعودية ذاتها، خصوصاً في منطقة كركوك؛ و3) توطيد درس
أفغانستان على صعيد العلاقات الدولية، بحيث تصبح الهيمنة الأمريكية على
الشرق الأوسط، ومعظم أجزاء العالم في الواقع، مطلقة أحادية لا تُردّ
ولا تُقاوم.
في البيت الأبيض كان الرئيس يسبغ على شخص رامسفيلد كلّ ما يحتاجه
الأخير من أجل تجميل الوحشية، متمثلة أولاً في معتقل غوانتانامو، ثم
سجن أبو غريب في العراق؛ ضمن حزمة إجراءات أخرى خارجة عن القانون
الدولي والقانون الأمريكي ذاته أيضاً، في سياقات ما أسمته الإدارة بـ
«الحرب على الإرهاب»: «تذكروا… هؤلاء الأشخاص في غوانتانامو قتلة لا
يشاركوننا نفس القِيَم»…، قال بوش الابن منذ مارس (آذار) 2002. وفي
غوانتانامو احتُجز نحو 500 رجل من قرابة 35 جنسية مختلفة، لم تُوجه تهم
بأية جرائم سوى إلى تسعة منهم فقط. بعضهم اعتُقل في أفغانستان، وبعضهم
نُقل إلى المعتقل ضمن «تكنيك» الخطف غير الشرعي الذي مارسته وكالة
المخابرات المركزية هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها. جميعهم تعرّضوا
لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، فضلاً عن الإهانة والتحقير
والقهر المتعمد، والتقييد بالسلاسل، وإجبار المعتقل على ارتداء نظارات
معتمة. على منوال لا يقلّ وحشية، تعرّف العالم على صورة المجنّدة
الأمريكية لندي إنغلاند وهي تجرّ سجيناً عراقياً عارياً، مقيّداً من
عنقه بطوق جلدي.
كانت إنغلاند بمثابة كبش فداء ينوب عن كبار مجرمي الحرب، في وزارة
العدل والبنتاغون والبيت الأبيض ذاته، ولهذا فإنّ قطاعاً ملموساً داخل
الرأي العام الأمريكي لم يرسل رامسفيلد إلى التقاعد الهانئ، كما فعل
بوش الابن أواخر العام 2006 وبعد هزيمة نكراء للحزب الجمهوري في
الانتخابات التشريعية، كان ملفّ العراق غير غائب عن أسبابها. ولقد صدرت
مؤلفات بارزة تفضح الملفّ الشائن، بينها «فريق التعذيب: مذكرات
رامسفيلد وخيانة القيم الأمريكية» للمحامي البريطاني وأستاذ القانون
فيليب ساندز، وكتاب جميل جعفر وأمريت سينغ «إدارة التعذيب: سجلّ موثق
من واشنطن إلى أبو غريب» وكتاب مايكل راتنر «محاكمة دونالد رامسفيلد:
مقاضاة عن طريق كتاب» بالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية. وفي فرنسا
وألمانيا وإسبانيا جوبه رمسفيلد بدعاوى قضائية تفضح أدواره في ترخيص
التعذيب عن سابق قصد وتصميم، وتلذذ أيضاً.
التاريخ من جانبه فتح سلال مهملاته على وسعها لاستقبال رامسفيلد، بوصفه
ذلك الصقر الذي صرف جلّ حياته في تبرير اجتياح الأمم وتجميل قبائح
التعذيب.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
عراق المليشيات:
ما أشبه اليوم بأمس هنري كيسنجر!
صبحي حديدي
إذا كان تاريخ المقاربة بعيداً بعض الشيء بمعيار الزمن (صيف 2005)،
فإنه ليس كذلك بمعنى عناصر السياق والدلالة والمشهد التي تخصّ العراق
المعاصر؛ هذه الأيام تحديداً، في مشهد «الدولة» التي خلّفها الاحتلال
الأمريكي، وتولتها إيران عبر وكلاء محليين تتقاطع عندهم المرجعيات
الشيعية والميليشيات المسلحة والأحزاب المذهبية، ليس بعيداً عن شبكات
الفساد العابرة للمذاهب والطوائف، وللأقاليم والعوالم.
المقاربة المشار إليها هنا هي مقالة مسهبة بعنوان «دروس من أجل
ستراتيجية مخرج»، نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بتوقيع هنري
كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والأشهر حتى إشعار آخر قد يطول
كثيراً. امتياز المقالة/ المقاربة أنها أفصحت عن المسكوت عنه في صفوف
رجال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، وكذلك على نطاق واسع لدى
المراقبين والمحللين وتلك الفئة الأمريكية النخبوية التي تُطلق عليها
عادة صفة الـThink
Tank.
وأمّا ما أفصح عنه كيسنجر فهو التماثلات الآخذة في التزايد، يومئذ، بين
التورّط العسكري الأمريكي في فييتنام، والاحتلال الأمريكي للعراق، من
جهة أولى؛ ومآلات الهزيمة العسكرية هناك، مقابل عواقب استعصاء المخرج
الأمريكي هنا، من جهة ثانية؛ فضلاً، من جهة ثالثة، عن ذلك الدرس العتيق
الكلاسيكي الصائب أبد الدهر: أنّ كسب أية حرب لا يعني كسب سلامها، أو
أيّ سلام ربما!
ثمة فقرة صاعقة جاءت في مقالة كيسنجر، تقول التالي: «من المؤكد أنّ
التاريخ لا يكرّر نفسه بدقّة. فييتنام كانت معركة تخصّ الحرب الباردة؛
وأمّا العراق فهو أحدوثة
Episode
في الصراع ضدّ الإسلام الجذري. لقد فُهم أنّ تحدّي الحرب الباردة هو
البقاء السياسي للأمم – الدول المستقلة المتحالفة مع الولايات المتحدة
والمحيطة بالاتحاد السوفييتي. لكنّ الحرب في العراق لا تدور حول الشأن
الجيو – سياسي بقدر ما تدور حول صدام الإيديولوجيات والثقافات والعقائد
الدينية».
فهل «أحدوثة» هذه الأيام صراع مع «إسلام جذري»، حقاً؟ أم هو، ببساطة
أكثر وحقيقة أوضح، بين ميليشيات شيعية المذهب على وجه التحديد، مقابل
قوى سياسية وعسكرية وحزبية يختلط في باطنها رئيس وزراء (شيعي مع ذلك،
آت من قلب المؤسسة الاستخباراتية)، وكتلة عسكرية وسياسية شيعية يقودها
مقتدى الصدر، وإقليم كردي شبه مستقلّ في الشمال غالبية مواطنيه من
السنّة، فضلاً عن وجود عسكري أمريكي يتقلص ببطء السلحفاة منذ العام
2003.
ليس غبناً بحقّ أطروحة كيسنجر الافتراض بأنّ «أحدوثة» المواجهة الراهنة
تبدو أقرب إلى ثنائي أمريكي – إيراني، وأنّ مضامينها الراهنة تُترجم في
الثأر لاغتيال قاسم سليماني تارة، أو في تسليح الوفد الإيراني في
مفاوضات جنيف حول برنامج طهران النووي تارة أخرى، وهذه أو تلك من
المغانم الأعمّ في سلال إيران الإقليمية الممتدة من العراق وسوريا
ولبنان إلى اليمن والبحرين ومضيق هرمز. وليس غبناً، استطراداً، أن
«الأحدوثة» إياها تواصل ما يشبه تفكيكاً منهجياً، أقرب إلى التفضيح
والدحر والكسر، للأكذوبة العتيقة حول احتلال أمريكي سوف ينقل «فيروس»
الديمقراطية إلى العراق وسائر المنطقة؛ لأنّ الميليشيات لا تقصف
المعسكرات الأمريكية وحدها، بل تستهدف اعتصامات الاحتجاج السلمية ولا
تتورع عن التصفيات الجسدية للناشطين.
وحين اقترح كيسنجر مقاربته تلك، التي تعمّد ألا تنطوي على تمييز بين
إسلام شيعي وآخر سنّي، كان البيت الأبيض قد حسم خياره في إعادة تركيب
معادلة العراق السياسية على ركيزتَين، شيعية وكردية، وإبعاد السنّة إلى
الهامش بعد تطهير ما سُمّى يومها بـ»المثلث السنّي» وتجريده من كلّ
أسباب المقاومة السياسية أو العسكرية. ولم تكن تلك مقامرة الهواة من
«المحافظين الجدد»، بتشجيع مباشر من كيسنجر وأمثاله، فحسب؛ بل توجّب أن
تسير حثيثاً نحو استكمال ما بدأه اجتياح 2003، أي تمكين إيران أكثر
فأكثر.
وإلا، سوى هذه المآلات، ما الذي يقوله المشهد الراهن!
القدس العربي - لندن
ذاكرة الانتفاضة السورية:
بنية الاستبداد واستعصاء الأكذوبة
صبحي حديدي
في مثل هذه الأيام، ولكن قبل عشر سنوات، صادق بشار الأسد على مشاريع
قرارات كانت حكومته قد اقترحتها حول رفع حال الطوارئ وإلغاء محكمة أمن
الدولة وتنظيم حقّ التظاهر؛ وقيل يومذاك إنّ الأسد يستجيب لواحد من
أبرز المطالب التي رفعتها جماهير الانتفاضة الشعبية. وتلك خلاصة تردّدت
يومها في إعلام النظام، وعلى ألسنة مشايعيه خارج سوريا، وكذلك بعض
«المعارضين» الذين كانوا أصلاً قد توسموا خيراً في «الرئيس الشاب» منذ
مهزلة توريثه وترشيحه للرئاسة؛ وكانت بمثابة الحبكة الابتدائية الأولى
في سردية «الإصلاح» التي قيل إنّ الأسد الابن يعكف عليها.
أمّا آخر المعنيين بتلك القوانين، سواء لجهة الالتزام بها أو المشاركة
على الأقلّ في قرع طبول التهليل لها، فقد كانوا حفنة من أوائل قيادات
الاستبداد الذين لا تتسع مؤسساتهم وفروعهم وشُعَبهم لأيّ مستوى تطبيقي
يخصّ تلك القوانين؛ أو يتيح أيّ انفكاك عن روحية الطوارئ والقمع والعنف
العاري المفتوح. في طليعة هؤلاء كان يسهل على المرء، يومذاك، العثور
على اللواء علي مملوك، واللواء زهير الحمد، والعميد ثائر العمر،
والعميد أنيس سلامة، والعميد حافظ مخلوف (من جهاز المخابرات العامة/
أمن الدولة)؛ أو اللواء عبد الفتاح قدسية (المخابرات العسكرية) واللواء
جميل حسن (مخابرات القوى الجوية) واللواء محمد ديب زيتون (شعبة الأمن
السياسي)؛ وأمّا في الجيش، فثمة أمثال ماهر الأسد، وسائر ضباط الفرقة
الرابعة والحرس الجمهوري بصفة خاصة…
وليس الأمر أنّ هؤلاء كانوا أقلّ استجابة لمشاريع قرارات صدرت عن مجلس
وزراء النظام، وصادق عليها رأس النظام، وصوّت عليها مجلس شعب النظام؛
إذْ أنهم كانوا، بدورهم، أهل النظام وحرّاسه والمنتفعين الأوائل في
مزرعته وبيوتات سلطاته ومكاسبه ومفاسده. الأمر، في المقابل، كان أنهم
على دراية تامة بالطابع المسرحي والزائف لتلك القرارات، وأنها لم تصدر
عن الأسد الابن إلا على سبيل ذرّ الرماد في العيون على السطح والمظهر،
ومواصلة نهج الأسد الأب و«الحركة التصحيحية» في الباطن والعمق. لهذا،
في الآن ذاته، كانت قرية البيضا وقرية بساتين إسلام في ظاهر مدينة
بانياس الساحلية، وحيّ رأس النبع في قلب المدينة ذاتها، قد شهدت ارتكاب
مجازر بحقّ الشيوح والأطفال والنساء، بعد قصف بالمدفعية الثقيلة
وراجمات الصواريخ والهاون.
تقاليد عمل أدوات استبداد ما بعد طيّ الأحكام العرفية لم تختلف في
الجوهر عن تقاليد ما قبل قرارات رأس النظام حول الطوارئ والمحاكم
والتظاهر؛ وإنْ كانت الأسابيع المتعاقبة في عمر الانتفاضة السورية قد
أضافت طُرزاً مختلفة من المهام بدت أكثر تعقيداً في ناظر أولئك الألوية
والعمداء والعقداء وسواهم من ضباط أجهزة أمنية تتوزّع على 17 اختصاصاً!
صحيح أنّ المهامّ الطارئة لم تكن جديدة عليهم تماماً، إلا أنها اكتسبت
صبغة مختلفة، واستدعت تقنيات مستجدة لم يكونوا على دراية كافية بها
قبلئذ، أيام مجازر حماة وجسر الشغور والمشارقة. لقد توجّب عليهم إحياء
أساليب الماضي كافة، واستخدامها في قمع مظاهرة في درعا أو دوما أو
اللاذقية او بانياس أو حمص أو دير الزور، من دون حرج في إراقة الدماء؛
ولكن… بعيداً عن العدسات الصغيرة التي يحملها المواطنون في هواتفهم
الجوالة، أو آلات التصوير البسيطة التي صارت في متناول اليد!
ثمة رباط وثيق، متعدد الأوجه والأنساق والوظائف، بين بنية الاستبداد كما ورثها الأسد الابن من أبيه، وصانها وطوّرها وزادها وحشية وعنفاً وهمجية؛ وبين استعصاء وظائف الأكذوبة، وما أُريد منها أن تشيعه حول «الإصلاح» و«الحساب» و«القانون»
وبالطبع، كان وأد الصورة، مثل استعادة أساليب مجازر أواخر السبعينيات
ومطالع الثمانينيات، خياراً مستحيلاً ينتمي إلى ماضٍ ولّى وانقضى؛ ومعه
انهارت جدران الخوف، الرمزية المجازية أو الواقعية الفعلية، إزاء شبح
عنصر المخابرات، القاهر القاتل المروّع الذي لا يحاسبه قانون، بل تعطيه
القوانين ترخيصاً بالقتل العشوائي، وتمنحه حصانة من أيّ وكلّ حساب.
ولقد اتضح أنّ ثقافة الصورة هذه، واندراجها ضمن ثقافة أخرى في التدوين
والتوثيق والتواصل الاجتماعي أوسع نطاقاً وأبعد اثراً، باغتت تقنيات
الماضي التي اقتاتت عليها الأجهزة طوال عقود، وجبّت ما قبلها من
معادلات في التطويع والترويض والقمع.
من هنا كان استمرار بنية الاستبداد التي شيدتها «الحركة التصحيحية»
يقتضي ايضاً استيلاد أكاذيب «الإصلاح» على شاكلة إلغاء الأحكام
العرفية، و«الحساب» على مقياس مهازل إقالة الرائد أمجد عباس مسؤول
الأمن السياسي في بانياس وبطل تلك الجرائم الهمجية، وتمكين «القانون»
على غرار تكليف وزير العدل الإمّعة تيسير القلا عواد برئاسة ما سُمّيت
«لجنة التحقيق في أحداث درعا واللاذقية» ومحاسبة عاطف نجيب ابن خالة
رأس النظام وبطل مجازر درعا…
فإذا افترض امرؤ أنّ إلغاء الأحكام العرفية سوف يجد أيّ مستوى من
التطبيق (كما استبشر البعض هنا وهناك، وبينهم نفر من «المعارضين»
إياهم) فما الذي كان سيتبقى من «واجبات» أمام اللواء عبد الفتاح قدسية،
رئيس إدارة المخابرات العسكرية؟ هل كان سيكفّ عن اعتقال المعارضين
المدنيين، ويتفرّغ مثلاً لكشف ألغاز ملفّ اغتيال العميد محمد سليمان،
على شواطىء طرطوس، وإماطة اللثام عن الأسئلة الكثيرة التي اكتنفت
العملية: مَن، وكيف، ولماذا؟ وزميله في الاستبداد اللواء جميل حسن،
رئيس مخابرات القوى الجوية، هل كان سيتنطح لكشف أسرار قصف موقع «الكبر»
العسكري السوري، في ظاهر مدينة دير الزور، وسيكاشف السوريين بحقائق ما
جرى، فيجيب على أسئلة مماثلة: مَن، وكيف، ولماذا؟ والزميل الثالث،
اللواء محمد ديب زيتون، كيف سيفهم وظائف شعبة الأمن السياسي إذا كان
إلغاء قوانين الطوارئ سيسمح بحرّية الرأي والمعتقد والتنظيم والتظاهر،
وما الذي سيتبقى من علّة وجود هذه «الشعبة» أصلاً؟
ثمة رباط وثيق، متعدد الأوجه والأنساق والوظائف، بين بنية الاستبداد
كما ورثها الأسد الابن من أبيه، وصانها وطوّرها وزادها وحشية وعنفاً
وهمجية؛ وبين استعصاء وظائف الأكذوبة، وما أُريد منها أن تشيعه حول
«الإصلاح» و«الحساب» و«القانون» طوال عشر سنوات من المجازر والتدمير
والتهجير والتطهير الديمغرافي والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية
والجرثومية، فضلاً عن تسليم سوريا إلى احتلالات إيرانية وروسية وتركية
وأمريكية، انضمت إلى الاحتلال الإسرائيلي. وهو رباط وثيق لا يلغي ذلك
التطوّر الطبيعي المتمثل في إحالة بعض اولئك الضباط، بقرارات من رأس
النظام ذاته، إلى مزابل تاريخ «الحركة التصحيحية»؛ إمّا لأنّ أدوارهم
انتهت على طريقة البطاريات التي نفد شحنها ولم تعد تقبل أيّ تجديد
فباتت أقرب إلى العبء منها إلى المعونة، أو لأنّ عشر سنوات من اهتلاك
آلة القمع ومنظومات الاستبداد تكفلت باهتراء أطقمها أيضاً، أو لأنّ
سلطات النظام الأمنية والعسكرية باتت بيد الضباط الروس في قاعدة حميميم
وضباط «الحرس الثوري» الإيراني هنا وهناك على أرض سوريا.
وليست المصائر المتغايرة الراهنة لأمثال مجرم حرب مثل حافظ مخلوف، أو
شقيقه في السلاح العسكري سهيل الحسن، أو قدوتهم في احتساء دماء
السوريين جميل حسن… سوى أمثولة الأسد الابن لمصائر مماثلة سبق أن آل
إليها أمثال رفعت الأسد وعلي دوبا وعلي حيدر وشفيق فياض وناجي جميل، في
عقود الأسد الأب. وتلك المصائر تنفع، أيضاً، في استقصاء المزيد من
خصائص «الحركة التصحيحية» البنيوية التكوينية التي تأصلت أكثر من ذي
قبل في ظلّ الشعار المبكّر الذي رفعه الوريث: حافظ الأسد يحكمنا من
قبره! ولم يكن عجيباً أنّ عبد الحليم خدام، أكذب «منشقّ» عن النظام، لم
يطرب لإلغاء الأحكام العرفية، فأطلق الهرطقة التالية: ليست الأحكام هي
التي تعتقل الناس!
وكيف لا، وهو أحد صنّاع البنية ذاتها، وممّن استعصت عليهم شتى الطرائق
في تمرير أكاذيبها.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
العسكر في الديمقراطيات الغربية:
رهاب جنرالات فرنسا
صبحي حديدي
حتى ساعة كتابة هذه السطور، بلغ العدد 10.039 من العسكريين الفرنسيين،
العاملين أو المتقاعدين، بينهم 20 جنرالاً وقرابة 100 ضابط كبير، وقعوا
نصّاً بعنوان «رسالة مفتوحة إلى حكّامنا»؛ نُشر أوّلاً، وما يزال
متوفراً، على موقع
Place d’Armes
بتاريخ 14 نيسان (أبريل) الجاري، ثمّ أعادت نشره مجلة «فالور أكتويل»
ذات الاتجاه المحافظ والقريب من اليمين المتطرف؛ مع فارق أنّ المجلة
اختارت للنشر تاريخاً حمّال مغزى، لأنه يتصادف مع الذكرى الستين
لمحاولة الانقلاب التي سعى إلى تنفيذها عدد من جنرالات الجيش الفرنسي
المتقاعدين والعاملين، لمنع رئيس الجمهورية شارل دوغول من منح
الاستقلال للجزائر. وبالأمس أعلن رئيس أركان الجيش، بناء على توصية من
وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، توقيف العاملين من الموقّعين وإحالتهم إلى
لجان تحقيق، في إطار «إجراء استثنائي» يستند إلى تقليد متبّع يحظر على
العسكري العامل إبداء آراء سياسية علنية.
الرسالة تتوجه أولاً إلى رئيس الجمهورية، ثمّ إلى «السيدات والسادة في
الحكومة» وكذلك في البرلمان؛ وتقول الجملة الأولى فيها: «الساعة خطيرة،
وفرنسا في خطر، تتهددها مخاطر عديدة مميتة» قبل أن تذكّر بأنّ
الموقّعين ما يزالون جنوداً لفرنسا حتى وهم في التقاعد، ولا يستطيعون
«البقاء غير مكترثين بمصير بلدنا الجميل». في فقرة لاحقة تبدو نبرة
التهديد بالانقلاب جلية تماماً: «إذا لم يُتخذ اللازم، فإنّ التراخي
سوف يواصل الانتشار في المجتمع على نحو متفاقم، ويسفر في النهاية عن
انفجار وعن تدخل من رفاقنا الناشطين في مهمة محفوفة بالمخاطر هدفها
حماية قيمنا الحضارية وأمان مواطنينا». وفي جملة لا ينقصها الوضوح،
البتة، يقول عسكر فرنسا: «كفى مماطلة، الساعة خطيرة، والعمل جسيم، لا
تضيعوا الوقت واعلموا أننا على استعداد لدعم الساسة الذين يأخذون في
الاعتبار إنقاذ الأمّة».
ليس مدهشاً، في المقام الأوّل، أنّ النصّ يعتنق الكثير من المفردات
والصياغات والمفاهيم التي اتسمت بها خطابات اليمين المتشدد، غير بعيدة
عن الخطابات الفاشية الأوروبية عموماً. ذلك لأنّ كاتب النصّ، وعدد غير
قليل من الجنرالات الموقعين عليه، انتموا ويواصلون الانتماء إلى حركات
عنصرية ويمينية متطرفة وفاشية، وبعضهم شارك جسدياً في مظاهرات معادية
للمهاجرين واللاجئين، تتذرّع بالدفاع عن «القِيَم الحضارية» و«الهوية
الغربية» وكلّ ما يمكن تكديسه اعتباطياً تحت مجمّع «الثقافة المسيحية ـ
اليهودية». وليس مفاجئاً، استطراداً، أن يكون الهجوم على الإسلام
و«جحافل الضواحي» واضحاً من زاوية ميلودرامية وتحريضية تقوم على
استدراج المشاعر العشوائية، وعلى التعاطف العفوي ضدّ جريمة إرهابية
نكراء مثل اغتيال أستاذ التاريخ الفرنسي صمويل باتي؛ وكأنها، كما يقول
النصّ، «يصعب تخيّلها قبل عشر سنوات» ولا سابق لها في كثير من الوقائع
الدامية التي سجّلتها تواريخ العنف الأهلي الأوروبي!
اللافت، حتى إذا لم يكن مدهشاً بدوره، أنّ نصّ العسكر يتطابق مع
«النغم» الذي شاع مؤخراً في فرنسا، حول التيارات الفكرية والثقافية
النقدية التي تتناول العنصرية والأوضاع ما بعد الاستعمارية والأقوام
الأصلية، بوصفها أيضاً مظهراً لحال «التفكك» التي تنخر جسد المجتمع
الفرنسي المعاصر. ولا يُراد من هذه النظريات، حسب رسالة عسكر فرنسا،
سوى «الحرب العنصرية» لأنّ القائلين بها «يحتقرون بلدنا وتقاليده
وثقافته، ويريدون رؤيته منحلاً، وينتزعون منه ماضيه وتاريخه» ولهذا
«يهاجمون التماثيل، والأمجاد العسكرية والمدنية القديمة عن طريق تحليل
أقوال عتيقة عمرها قرون». ولم يكن ينقص الجنرالات سوى التعريض، تماشياً
مع «الموضة» الرائجة، بما بات يُعرف في فرنسا تحت مسمّى «اليساروية/
الإسلامية»؛ مع العلم أنّ النصّ يحتوي الكثير من التلميحات التي تفضي
في نهاية المطاف إلى التوصيف ذاك، فيبرهن العسكر المتقاعدون، اليمينيون
المتشددون والعنصريون والشعبويون، أنهم خير حلفاء لنظرائهم المدنيين
أصحاب التوجهات ذاتها في الصحف والمجلات ومراكز الأبحاث والأحزاب.
رسالة العسكر الفرنسيين تعيد طرح مشكلة متأصلة في الأنظمة الديمقراطية الغربية عموماً، تتصل بإشكالية سيطرة المدني على العسكري، وسلسلة الضوابط التي تحكم العلاقة بينهما. واختلال التوازن، أو انقلاب الإشكالية إلى تعارض وتناقض وتصارع، سيكون مآله الأوّل هو الانقلاب
الطبيعي، والحال هذه، أن يأتي أوّل دعم صريح لرسالة العسكر الفرنسيين
المفتوحة من الجهة السياسية الأولى صاحبة المصلحة في استقبالها
وإشاعتها: مارين لوبين، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتشدد،
التي دعت الموقّعين إلى الالتحاق بصفوف حزبها والمشاركة في «المعركة
التي بدأت للتو» و«هي قبل كل شيء معركة فرنسا». الطبيعي، على المنوال
ذاته، أن يعرب عن تأييد مماثل رجل مثل إريك زيمور، الكاتب والصحافي
والإعلامي الأكثر مثولاً أمام القضاء بتهمة العنصرية، وفي عداد الأشدّ
كراهية للعرب والمسلمين والسود المهاجرين عموماً (رغم أنه سليل أسرة
يهودية جزائرية): «هذا جزء من حالة اللاوعي الجمعي في فرنسا» قال
زيمور، معتبراً أنّ نصّ الجنرالات يعبّر عن مزاج عام سائد في البلد،
ولا ينطوي على عواقب انقلابية.
وفي هذا بعض الصواب، على طريقة الحقّ الذي يُراد به الباطل غنيّ عن
القول، لأنّ فرنسا الراهنة تعيش مناخات رهابية وعنصرية وشعبوية غير
مسبوقة على امتداد كامل التاريخ الذي أعقب سنة 1789 واقتحام سجن
الباستيل وإقرار «إعلان حقوق الإنسان والمواطن». ونقطة التزييف الكبرى
في رسالة الجنرالات هي تلك التي تتهم رئيس الجمهورية بـ«الصمت» على ما
تشهده فرنسا من «تفكك» بسبب صعود النزعات الإسلاموية و«جحافل الضواحي»؛
لأنّ ماكرون ليس صامتاً البتة، بل العكس هو الصحيح، فهو صاحب التنظير
لفكرة «الأزمة» التي يعيشها الإسلام، وهو حتى إشعار آخر الرئيس الأكثر
عرضة للاتهام بعداء الإسلام على امتداد الجمهورية الخامسة، عدا عن كونه
(على رأس حزبه المتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية) صاحب قانون
«الأمن الشامل» الشهير الذي يقيّد الحريات العامة والصحافية لصالح
الشرطة وأجهزة الأمن.
صحيح، بالطبع، أنّ العسكري المتقاعد أو غير العامل يملك من حقّ التعبير
الحرّ ما يملكه أيّ مواطن مدني، وبالتالي فإنّ هذا الصنف من الموقّعين
على الرسالة ليسوا غرباء عن هذا النسق من الحقوق؛ ولكن من الصحيح في
المقابل، ويدخل تحت طائلة القانون أيضاً، أنّ العسكري العامل غير مخوّل
بانتهاك واجب «التحفظ» الذي يفرضه عليه وضعه المسلكي العسكري، فكيف إذا
احتوى تعبيره على إيحاءات بتنظيم انقلاب في نظام ديمقراطي يُخضع العسكر
لسيطرة السلطة السياسية المدنية. بهذا المعنى، البسيط تماماً ولكن
الواضح كذلك في مدى اقترانه بالأخطار والعواقب، أنّ رسالة العسكر
المفتوحة شكّلت لتوّها محاولة انقلاب معلنة على مستوى التعبير السياسي،
في فترة زمنية تشهد أولى أطوار التسخين والاستعدادات للانتخابات
الرئاسية، التي ستجري جولتها الأولى في 23 نيسان (أبريل) والثانية في 7
أيار(مايو) 2022. ولم يكن تفصيلاً عابراً أنّ أحد الموقّعين على
الرسالة هو الجنرال المتقاعد بيار دي فيلييه، الرئيس السابق للأركان،
والذي أجبره ماكرون على الاستقالة صيف 2017 لإعلانه آراء خلافية مع قصر
الإليزيه حول ميزانية الجيوش، ويتردد اليوم أنه قد يرشح نفسه في
الرئاسيات المقبلة.
وفي كلّ حال فإنّ رسالة العسكر الفرنسيين تعيد طرح مشكلة متأصلة في
الأنظمة الديمقراطية الغربية عموماً، تتصل بإشكالية سيطرة السياسي
المدني على الضابط العسكري، وسلسلة الضوابط التي تحكم العلاقة بينهما.
وليس خافياً أنّ اختلال التوازن، أو انقلاب الإشكالية إلى تعارض وتناقض
وتصارع، سيكون مآله الأوّل هو الانقلاب (والتجارب كثيرة، على امتداد
الماضي القريب أو البعيد) ومآله الرديف أو التالي هو صعود الفاشية
واهتزاز النظام الديمقراطي بأسره. فرنسا الدولة بعيدة عن هذا، في المدى
المنظور على الأقلّ؛ ولكنّ عسكر الرسالة المفتوحة، المرضى بهذا النمط
أو ذاك من الرهاب، ليسوا، في نهاية المطاف، سوى أبناء هذا الاجتماع
الفرنسي، السياسي والاقتصادي والثقافي، ذاته.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
صاروخ ديمونة: الطراز الإيراني
في حروب الثأر الصوتية
صبحي حديدي
عديدة هي الخلاصات التي يُتاح استنتاجها من واقعة سقوط صاروخ أرض ـ جو
من طراز
SA
ـ 5 على مقربة من المنشآت النووية التي تقيمها، وتتستر عليها، دولة
الاحتلال الإسرائيلي في منطقة ديمونة، جنوب فلسطين المحتلة. وما
يُستخلَص هنا لا يقتصر على معادلات الاشتباك وقواعده بين دولة الاحتلال
والنظام السوري وإيران فقط، بل يمتدّ استطراداً إلى مناطق نفوذ طهران
في لبنان والعراق واليمن، ويتوسع أيضاً إلى ما يصحّ تسميته
بـ«البروتوكولات» غير المعلنة بين موسكو وتل أبيب حول اعتداءات جيش
الاحتلال المنتظمة ضدّ أهداف إيرانية داخل العمق السوري، ونوعية السلاح
الروسي الذي يُؤذن لجيش النظام السوري باستخدامه ضدّ الغارات
الإسرائيلية.
الخلاصة الأولى هي أنّ منشآت الاحتلال النووية لم تعد بمنأى عن الأخطار
المحدقة، في عصر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة؛ بافتراض أنّ
إرادة سياسية لدى خصوم دولة الاحتلال يمكن أن تكسر قاعدة اشتباك كبرى
ذات صلة بمفاعل ديمونة، أو أنّ شرارة عابرة يمكن أن تطلق اللهيب حتى
بمعزل عن الإرادة والقرار والتصميم. صحيح، بالطبع، أنّ الصاروخ الذي
سقط في النقب غير بعيد عن المفاعل كان من طراز سوفييتي قديم يعود إلى
أواسط ستينيات القرن الماضي، وليس من أيّ طراز معاصر متقدّم يستخدمه
الجيش الروسي ومنح بعض بطارياته إلى جيش بشار الأسد (منظومة
S
ـ 300 على سبيل المثال). غير أنّ مسافة الـ300 كم التي قطعها الصاروخ
من الأراضي السورية قبل أن يسقط قرب ديمونة كافية، في ذاتها، للبرهنة
على الخطورة الكلاسيكية لهذا السلاح، خاصة وأنه يحمل كتلة متفجرات لا
تقل عن 217 كغ.
الخلاصة الثانية هي أنّ إطلاق الصاروخ كان، أغلب الظنّ، قراراً
إيرانياً أكثر من كونه تحولاً دراماتيكياً في منهجية تعامل النظام
السوري مع الغارات الإسرائيلية المتكررة؛ إذْ بات من الثابت، على مدار
عقود وليس سنوات في الواقع، أنّ الأسد اعتمد ردّ فعل وحيد له طابع
لفظي، يتكئ دائماً على حكاية احتفاظ النظام بحقّه في اختيار الزمان
والمكان المناسبين للردّ. فإذا صحّ أن ضابطاً إيرانياً ما، ضمن عشرات
«المستشارين» العاملين مع جيش النظام، كان وراء تفعيل منصّة انطلاق
صاروخ الـ
SA-5؛
فهذا، استطراداً، يعني أنّ طهران بدورها ما تزال تلتزم بالقاعدة
«الانتقامية» ذاتها، حول اختيار الزمان والمكان و… نوعية السلاح أيضاً.
ومن اللافت أنّ وسائل إعلام إيرانية أغدقت المديح على صاروخ ديمونة،
وأشارت إلى أنه كان يمكن أن يتابع طريقه إلى المفاعل، لولا أنّ
«التسبّب في كارثة ليس هو المطلوب»!
في عبارة أخرى، كان في وسع طهران استخدام سلاح صاروخي آخر أكثر ذكاء،
وأعقد توجيهاً؛ لو كانت الإرادة الإيرانية تتوخى فعلاً ثأرياً يلاءم
الردّ على العملية الإسرائيلية في مفاعل نطنز الإيراني، وليس مجرّد
«انتقام» لا يتجاوز تطيير رسالة صوتية مفزعة، محدودة الأثر والجدوى.
وفي هذا خلاصة ثالثة تتصل بالبون الشاسع، كما تشير الدلائل على الأقلّ،
بين السطوة العالية التي يتمتع بها الضباط الإيرانيون في تسيير أمور
جيش النظام وتسخير أسلحته التقليدية، وبين القصور الهائل الأقرب إلى
الانعدام في مقدار تحكّمهم بالأسلحة الروسية المتقدمة التي يستخدمها
الجيش ذاته والتي تخضع ـ في أوّل الأمر وآخره، كما يلوح ـ لقرار الضباط
الروس وسياسة الكرملين في العلاقة مع دولة الاحتلال. ولا تُنسى، في هذا
السياق، مسؤولية الصاروخ القديم ذاته عن إسقاط طائرة استطلاع روسية،
بطريق الخطأ، في سماء اللاذقية خريف 2018، أسفرت عن مقتل 15 عسكرياً
روسياً.
أية كارثة تصيب دولة الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن تقذف إيران في أتون كوارث كبرى لا عدّ لها ولا حصر. خير، إذن، أن يكتفي المرشد الأعلى بالصاروخ الصوتي، ومفردات رسالته، والتوريط هنا وهناك، والزعم بأنّ ثأر نطنز قد تحقق. وكفى الله شرّ القتال
خلاصة رابعة تشير إلى تقارير سبق أن كشفت النقاب عنها أسبوعية
«نيوزويك» الأمريكية، تفيد بأنّ طهران نجحت في تهريب عدد من الصواريخ
بعيدة المدى إلى داخل اليمن، في إطار تزويد الحوثيين بأسلحة ستراتيجية
التأثير قد تتيح تغيير الموازين العسكرية في الحرب الراهنة ضدّ
السعودية. لكنّ بعض أنواع هذه الصواريخ يمتلك أمدية كفيلة بإصابة أهداف
في العمق الإسرائيلي، وأنّ منطقة ديمونة تحديداً ليست بذلك بعيدة عن
قدرات هذه الصواريخ؛ وما دامت طهران ترخّص للحوثيين قصف منشآت سعودية
حيوية مثل المصافي والمطارات المدنية، وحروب الشدّ والجذب مع واشنطن
حول إعادة إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات قائمة ومحتدمة؛ فما الذي
يدفع المرشد الأعلى الإيراني إلى «التعقّل» في دفع الحوثي إلى استهداف
دولة الاحتلال، سوى (في طليعة أسباب أخرى متعددة) الإبقاء على قواعد
الاشتباك في حدود منضبطة، لا ترقى البتة إلى المواجهة الشاملة؟
ورغم تقارير غير مؤكدة تشير إلى احتمال انطلاق صاروخ ديمونة من العراق،
وليس من بطارية في درعا أو مطار الضمير، فالواضح في المقابل أنّ رسالة
طهران الصوتية تتفادى توريط لبنان، أي «حزب الله» تحديداً، في أية
عمليات واسعة النطاق يمكن أن تتخذها الردود الانتقامية الإسرائيلية.
وإذا صحّ هذا الاستنتاج الخامس فإنه يؤكد، من جانب أوّل، أنّ الخيارات
الإيرانية في لبنان باتت أضيق من ذي قبل، أو لا قبل لها بحرب مفتوحة مع
الاحتلال الإسرائيلي؛ وأنّ ذراع إيران في البلد، «حزب الله» ومؤسساته
وميليشياته وأسلحته، ليست من جانب ثانٍ في وضع مريح بالنظر إلى ظروف
لبنان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن الحكمة تجنيب الحزب
المزيد من حرج الخارج إضافة إلى حرج الداخل.
الجانب الثالث، والذي يصلح استنتاجاً سادساً، هو أنّ توريط النظام
السوري في عملية إطلاق صاروخ ديمونة قد يتجاوز، من الوجهة الإيرانية،
إحراج النظام، سواء بمعنى حدود المواجهة مع دولة الاحتلال، أو بمعنى
نطاق الخدمات غير المحدودة التي يقدمها للنفوذ الإيراني العسكري على
الأرض السورية. فالنظام، ابتداء من رأسه وانتهاء بأصغر ضابط في جيشه أو
أجهزته المختلفة، لا حول له ولا طول أصلاً، حتى قبل أن يبلغ التدخل
الإيراني في الشؤون السورية مستويات قصوى غير مسبوقة. ليس مستبعداً،
والحال هذه، أن يسعى التوريط إلى إحراج موسكو، إذْ لم تعد خافية أوجه
التنافس بين طهران وموسكو على ميادين النفوذ والسيطرة في سوريا. وضباط
«الحرس الثوري» الإيراني خير من يقيس، مباشرة وعلى الأرض، سوية
الحساسية التي يمكن أن تبديها موسكو إزاء توريطها مع دولة الاحتلال على
الأرض السورية؛ بل يصحّ القول إنّ الورطة لن تتوقف عند الضباط الروس في
قاعدة حميميم، بل ستصل أصداؤها إلى الكرملين ذاته، وإلى أسماع الرئيس
الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
وتبقى خلاصة سابعة تعيد الارتباط مع الخلاصة الأولى، وقد أحسن التعبير
عنها المعلّق الإسرائيلي سيث فرانتزمان حين كتب، في «جيروزاليم بوست»
أنّ صاروخ ديمونة «يمثّل ذلك النوع من اختزال جميع المخاوف التي ترافق
الناس وهم يأوون إلى الفراش آملين ألا يستفيقوا عليها». لكنها مخاوف
صوتية في نهاية المطاف، على شاكلة الرسالة الإيرانية التي حملها صاروخ
ديمونة، ليس لأنّ طهران تمقت التسبب في الكوارث، فما تفعله في سوريا
ضدّ الشعب السوري أفظع بكثير من صفة الكارثة؛ وإنما لأنّ أية كارثة
تصيب دولة الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن تقذف إيران في أتون كوارث كبرى
لا عدّ لها ولا حصر. خير، إذن، أن يكتفي المرشد الأعلى بالصاروخ
الصوتي، ومفردات رسالته، والتوريط هنا وهناك، والزعم بأنّ ثأر نطنز قد
تحقق.
وكفى الله شرّ القتال!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
البرامج النووية بين حقوق
الشعوب وسمسرة الأنظمة
صبحي حديدي
لن تسمح دولة الاحتلال الإسرائيلي لأيّ برنامج نووي، تعتمده أية دولة
شرق ـ أوسطية، أن يبلغ مستوىً تكنولوجياً متقدماً؛ حتى في ميادين
الطاقة الصناعية الصرفة، فكيف بأن يرتقي إلى أيّ مستوى قريب من إنتاج
أسلحة ذرية. وهذا قرار ستراتيجي متفق عليه، تماماً وبلا أدنى خلاف أو
تباين، مع الولايات المتحدة أياً كان الحزب أو الشخص القائد في البيت
الأبيض؛ ومع القوى الكبرى الأخرى، سواء انتمت إلى تراث استعماري حافل
أو متوسط أو عابر، أو تشارك في هذا النسق أو ذاك من الهيمنة الكونية،
السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية؛ أم تقف على هوامش
تحالفية وتكتلات وائتلافات، على غرار الحلف الأطلسي.
لكن البرنامج النووي الإيراني، بصفة محددة، ينطوي على دلالات خاصة
وهامة لأنه ابتدأ بموافقة أمريكية، وبالتالي بمباركة إسرائيلية، لأنه
ببساطة كان يشغل مساحة حيوية داخل هندسة الحرب الباردة مع الاتحاد
السوفييتي، وكان الحاكم في إيران هو الشاه رضا بهلوي حليف الولايات
المتحدة والحلف الأطلسي والغرب عموماً. وكانت الصناعة الأمريكية، منذ
العام 1975، هي صاحبة السبق إلى تزويد إيران بمفاعل نووي لا تقلّ طاقته
عن 5 ميغاواط، وكان البيت الأبيض هو مانح الإذن بتوفير اليورانيوم
المخصّب اللازم للتشغيل وتمكين إيران من شراء منشأة تتيح فصل
البلوتونيوم (وتلك، للعلم، هي المرحلة الأعلى في برنامج تصنيع القنبلة
النووية).
غير بعيد عن الشرق الأوسط، ولكن ضمن سياقات جيو ـ سياسية متقاربة
ومتقاطعة، كان التمييز الأمريكي بين برنامج نووي هندي مقابل برنامج
نووي باكستاني قد تجاوز، بكثير في الواقع، اعتبارات التبعية العالية
التي اتصف بها ضباط الجيش والاستخبارات الباكستانيون في علاقاتهم مع
نظرائهم الأمريكيين؛ فرجحت كفة الهند، الأقلّ في مقادير التبعية، لأنّ
المعادلة في واشنطن اتخذت صفة الموازنة بين «قنبلة إسلامية» باكستانية
مقابل «قنبلة هندوسية» هندية! ولم يكن مستغرباً أن يلجأ بعض المعلقين
إلى تصنيف قنابل العالم الذرية إلى واحدة مسيحية في الولايات المتحدة
وأوروبا، وثانية بوذية في الصين، وثالثة يهودية في إسرائيل، ورابعة
سيخية في الهند، وخامسة مسلمة في الباكستان، وسادسة ملحدة في الإتحاد
السوفييتي! كذلك كان طبيعياً أن يتذكر ذو الفقار علي بوتو، رئيس وزراء
الباكستان، سنة 1974، أنّ الولايات المتحدة هي ذاتها أوّل مَن زوّد
الباكستان، منذ العام 1961، بمفاعل نووي طاقته 5 ميغاواط.
التكنولوجيا النووية سياسة إذن، في المقام الأمني والعسكري الأوّل الذي
يسبق كل اعتبار آخر صناعي أو تكنولوجي أو علمي أو اقتصادي أو تنموي؛
وليس البرنامج النووي الإسرائيلي سوى الدليل الظاهر الذي يفقأ الأعين
حول الكيل بمكاييل شتى عند مناقشة الملفات النووية، ولن يكون مكيال
تفضيل المخافر المتقدمة للإمبريالية العالمية سوى أبرزها، أو بالأحرى
أكثرها افتضاحاً. وإذْ لا تجادل هذه السطور في حقّ الشعوب بامتلاك
التكنولوجيا النووية لأغراض صناعية وتنموية وعلمية، فإنّ الفارق كبير
بين هذا المطلب المشروع، وبين طموح أنظمة استبدادية أو تسلطية إلى
امتلاك السلاح النووي لأغراض تثبيت سلطة النظام أو تحسين التفاوض حول
البقاء أو مقايضة القنبلة برضا القوى العظمى؛ على حساب الشعوب دائماً،
وحقوقها في الغذاء والدواء والتعليم والكرامة الإنسانية.
وليس إنتاج المزيد من المياه الثقيلة في مفاعل أراك، مثلاً، أكثر أهمية
من رفع الحظر على دراسة الطلبة الجامعيين الإيرانيين في الأقسام
والفروع المرتبطة بالطاقة النووية، أو شراء الطائرات المدنية، أو
السماح بعمليات المصرف المركزي الإيراني، أو تشغيل الشركة الوطنية
للنفط، أو تفعيل نحو 800 من المؤسسات والمصارف الإيرانية الأخرى. هذه
حقوق الشعب الإيراني، ولا يصحّ أن تنقلب إلى بنود سمسرة في يد آيات
الله ونظام ولاية الفقيه، وهي أقرب إلى تشويه معنى التقدّم التكنولوجي
بعد تزييف مضمونه وقيمته وجدواه.
أمريكا وأفغانستان:
رموز الغزو ومخيّلة الإمبريالية
صبحي حديدي
الآن وقد استقرّ الرئيس الأمريكي على سحب القوات الأمريكية من
أفغانستان، بحلول 11 ايلول (سبتمبر) المقبل، لا مناص من استدراج الجانب
الرمزي وراء اختيار هذا التاريخ تحديداً، ليس لأنه يتصادف مع الذكرى
العشرين للهجمات الإرهابية الشهيرة على البرجَين، فحسب؛ بل كذلك لأنّ
وقائع التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان اقترنت أيضاً بإرث معقد من
التخييل الإمبريالي حول البلد، لا يكتفي بالاعتبارات الجيو ـ سياسية
المحلية والإقليمية والعالمية، بل يذهب أبعد نحو التاريخ والديانة
والثقافة، على هدي كلّ غزو أمريكي وإمبريالي في واقع الأمر.
وإذْ يعود المرء إلى بعض كشوفات «أوراق فييتنام» التي خاضت صحيفة
«واشنطن بوست» معركتَين في مستوى القضاء الفدرالي واحتاجت إلى ثلاث
سنوات قبل أن تمتلك الحقّ القانوني في نشرها؛ لن يعدم الكثير، المفاجئ
حقاً في حالات عديدة، من هيمنة الرمز والمخيّلة على مستويات مختلفة من
تفكير رجال الجيش الأمريكي الذين عملوا في أفغانستان، أسوة بوكلائهم
وعملائهم المحليين. ولم يكن الاعتراض على نشر تلك الأوراق وبلوغ الأمر
قاعة المحكمة سوى مستوى السطح من شروخ سياسية ونفسية وعسكرية شتى صارت
قرينة حرب «عبثية» و«لانهائية» كما باتت تُوصف، غابت عنها الانتصارات
مثلما أضحت هزائمها المتعاقبة بمثابة بوّابات مفتوحة على ذاكرة فييتنام
الماضية، أو ذاكرة العراق الحاضرة.
محمد إحسان ضيا، الوزير الأفغاني للتنمية وإعمار الريف، اعتبر أنّ
«الأجانب» وقصد أفراد الجيش الأمريكي والحلف الأطلسي الآتين إلى
أفغانستان، يقرأون رواية «عدّاء الطائرة الورقية» للأمريكي من أصل
أفغاني خالد حسيني، وهم في الطائرة؛ فيساورهم اليقين بأنهم باتوا
«خبراء» حول أفغانستان، ويكفّون بعدئذ عن الإصغاء إلى أي رأي آخر. دوغ
لوتن، الجنرال الأمريكي الذي لُقّب بـ«قيصر أفغانستان» لأنه قضى هناك
ستّ سنوات، وأصبح سفير الولايات المتحدة لدى الناتو، أقرّ بالتالي:
«كنّا خالين من أيّ فهم جوهري لأفغانستان، ولم نكن أصلاً نعرف ما
نفعل». ستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي الأسبق خلال سنوات 2005 ـ
2009، قال: «بعد 2005 بات لدي انطباع بأنّ أمراء الحرب قد عادوا لأنّ
كرزاي أرادهم أن يعودوا ولم يكن يفهم إلا نظام الزبائنية. وكرزاي لم
يكن صلباً أبداً حول الديمقراطية، ولم يعتمد على المؤسسات
الديمقراطية»؛ وهذا لأنّ مخيّلة هادلي كانت مرتاحة تماماً إلى ذلك
النهج الاستشراقي الأحمق الذي هيمن على نساء ورجال إدارتَي جورج بوش
الابن، وسوّل لهم أنّ الغزو الأمريكي لأفغانستان أرسى مؤسسات ديمقراطية
قبل أن يقيم القواعد العسكرية!
وثمة، بين «أوراق فييتنام» هذه الشهادة النبوئية التي نطق بها روبرت
فن، السفير الأمريكي الأسبق في كابول: «هذه مشكلة منهجية عند حكومتنا.
ليس في وسعنا التفكير أبعد من الانتخابات التالية. حين ذهبنا إلى
أفغانستان كان الجميع يتحدثون عن سنة أو سنتين، وقلت لهم إننا سوف نكون
محظوظين إذا خرجنا من هنا بعد 20 سنة». ليس مؤكداً، بالطبع، أنّ نبوءته
سوف تتحقق عملياً يوم 11 أيلول (سبتمبر) المقبل، وأنّ الرئيس الأمريكي
الحالي سوف يفي بالتزامه؛ ففي شباط (فبراير) 2020 وقّعت الولايات
المتحدة اتفاقاً مع الطالبان يقضي بالانسحاب الأمريكي خلال شهر أيار
(مايو) المقبل، وذهب الوعد أدراج الرياح ليس لأنّ ترامب غادر البيت
الأبيض فقط، بل أساساً لأنّ الموعد لم يكن مدروساً بما يكفي، على غرار
الكثير من قرارات الإدارة السابقة.
كيف لكلّ ما تراكم، خلال عقود سبقت 11/9/2011، بل استبقت الغزو السوفييتي ذاته، أن يتفكك إلى معطيات ملموسة واضحة، طبقاً لمعايير علمية في القراءة والتحليل؛ فتتبخر شهوة التزييف والتخييل وإقحام الخلاصات الجوهرانية على كلّ ظاهرة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو تاريخية؟
ليس مؤكداً، في المقابل، أنّ انسحاب القوات الأمريكية (2500 عنصر) وما
سيترافق معه تلقائياً من انسحاب قوات الحلف الأطلسي (9600 جندي ينتمون
إلى جنسيات مختلفة)؛ سوف يسفر عن خاتمة، أو حتى يضع حدّاً، لفيوض
الرموز والتخييلات الإمبريالية حول أفغانستان: الصناعة الرمزية
والإنشاء الزائف والدوغما المعرفية، وليس البتة أفغانستان البشر والأرض
والتاريخ. فأين، بافتراض حدوث العكس، سوف يذهب التخييل حول الشرق،
وآسيا، والمرأة، والإرث الشيوعي/ السوفييتي، والقبائل والعشائر
والأفخاذ، وأسامة بن لادن، والملا عمر، والصراع الإسلامي ـ البوذي،
والطالبان، والكثير الكثير سوى هذا وذاك من معطيات «البحث»
و«الاستنباط» و… الاستشراق؟ وكيف لكلّ ما تراكم، خلال عقود سبقت
11/9/2011، بل استبقت الغزو السوفييتي ذاته، أن يتفكك إلى معطيات
ملموسة واضحة، طبقاً لمعايير علمية في القراءة والتحليل؛ فتتبخر، في
إطار سيرورة مثل هذه، شهوة التزييف والتخييل وإقحام الخلاصات
الجوهرانية على كلّ ظاهرة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو تاريخية؟
ولعل أوضح الأمثلة الصارخة على هذه السيرورات المعرفية، التخييلية/
الاستيهامية بامتياز كما يتوجب التشديد دائماً، هو تشبيه حميد كرزاي
بشخص نلسون مانديلا حين يكون الأوّل صديقاً/ تابعاً وعميلاً للولايات
المتحدة والحلف الأطلسي والغرب عموماً؛ وأمّا حين يسقط عنه وشاح
التبعية، فإنه ذاك الكاره للديمقراطية والمروّج للزبائنية، كما وصفه
هادلي في السطور أعلاه. لكنّ تهمة الزبائنية سوف تهون كثيراً أمام أخرى
أشدّ مضاضة تنسب إليه اللواط بالأطفال، ولكنها لا تكتفي بهذا إذْ توجّب
أن تكون أكثر قرباً من التنميط الاستشراقي الكلاسيكي، فتعتبر سلوكه
جزءاً من تقاليد قبائل البشتون التي ينتمي إليها! كرزاي هذا هو ذاته
الذي وصفته وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق كوندوليزا رايس هكذا:
«لستُ أعرف أحداً يحظى بالإعجاب والاحترام في المجتمع الدولي مثل
الرئيس كرزاي، بسبب قوّته، وحكمته، وشجاعته. أقول هذا وأنا أجالس وزراء
خارجية ورؤساء حكومات على امتداد العالم، وأحضر اجتماعات مجلس الحلف
الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، والناس في مختلف أرجاء العالم».
وقد يكون من حقّ المرء أن يحار في التكهن حول مجريات مؤتمر مقبل حول
أفغانستان، تعتزم تركيا استضافته قريباً ويدوم عشرة أيام، بمعزل عن
ركام المعرفة الزائفة التي تخيّم على البلد في ناظر القوى الغربية التي
سوف تشارك في المؤتمر، أو تعلّق عليه أيّ آمال ملموسة. عسير أيضاً
انتظار نتائج مبشرة بالخير إذا كانت طالبان تعتزم مقاطعته، بعد إعلانها
أنّ الحركة لن تشارك في أي جهد تفاوضي دولي قبل انسحاب القوات
الأجنبية؛ حتى إذا كان المؤتمر يخدم الرئيس التركي أكثر مما يسهم في
إطلاق سيرورة سلام فعلية في أفغانستان. وما تسرّب مؤخراً عن رغبة
الإدارة الأمريكية الجديدة في استبدال الرئيس الأفغاني أشرف غني بحكومة
مؤقتة تضمّ الطالبان، هل يتكامل أم يتناقض مع الحوارات التي استضافتها
العاصمة القطرية وأثمرت عن اتفاق ملموس بين الولايات المتحدة والطالبان
والحكومة الأفغانية؟ وأين يقع مغزى العنف الأخير الذي تصاعد بين
الطالبان والجيش الأفغاني، رغم أنّ المفاوضات كانت تجري على قدم وساق،
وأنّ المبعوث الأمريكي زلماي خليلزاد يواصل جولاته المكوكية؟
شتان، كما قد يصحّ القول، بين عزم الرئيس الأمريكي الحالي على الانسحاب
من أفغانستان، وبين إعلان سَلَفه بوش الابن، يوم 11 تشرين الأول
(أكتوبر) 2011 أنّ نهاية العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان «قد
تحدث غداً، وقد تحدث بعد شهر من الآن، وقد تستغرق سنة أو سنتين، ولكننا
سوف ننتصر». صعب للغاية وضع خواتيم الغزو الأمريكي/ الأطلسي لهذا البلد
تحت أيّ توصيف يتصل بالنصر، وليس شاقاً استذكار العبارة الأخرى التي
جاءت في خطاب بوش الابن يومذاك («لقد تعلمنا بعض الدروس الهامة من
فييتنام»)؛ ولكن بمعنى برهنتها على العكس، أيّ عجز الإدارات المتعاقبة
عن وضع أفغانستان على خلفية غزو فييتنام.
فكيف بوضعها على أيّ محكّ يخفف من حماقات رموز الغزو وغلواء المخيّلة
الإمبريالية!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
نفور اليسار الغربي
من الانتفاضة السورية:
نموذج شومسكي
صبحي حديدي
على مدار السنوات العشر من عمرها شهدت الانتفاضة الشعبية السورية سلسلة
أنماط من المواقف السلبية التي صدرت عن مختلف تيارات اليسار الأوروبي
والأمريكي والغربي عموماً، خاصة تلك التي تلتقي غالباً حول شعارات
عريضة مثل مناهضة الإمبريالية والتدخل العسكري والعقوبات وما إليها.
ورغم أنّ الكثير من القوى الشعبية، خاصة التقدمية واليسارية
والديمقراطية، التي انخرطت في الانتفاضة تشترك مع تلك التيارات في
الشعارات إياها، فإنّ افتراقاً بيّناً، مذهلاً وعجيباً ومحزناً، دفع
باليسار الغربي المشار إليه ليس بعيداً عن مساندة الانتفاضة، فحسب؛ بل
قريباً من بعض مواقف النظام وحلفائه الروس والإيرانيين غزاة سوريا،
وكذلك ـ وهنا ذروة المفارقة ـ على توافق مع مواقف الإمبريالية ذاتها،
ممثلة في الولايات المتحدة تحديداً.
التيارات كثيرة ومتعددة ومتباينة وليس من أغراض هذه السطور أن تأتي على
إحصاء الحدّ الأدنى في تنويعاتها؛ خاصة، كما يتوجب القول، أنّ مرور
السنوات العشر تكفّل بتعديل بعضها من دون أن يأتي بتحوّل جذري أو
مراجعة نقدية. يكفي مثال واحد هو انقلاب كاتب يساري مثل الباكستاني ـ
البريطاني طارق علي من اتهام المعارضة السورية المسلحة (وكان يتحدث من
شاشة الفضائية الروسية!) بتنفيذ مجزرة الحولة، أيار/ مايو 2012، التي
ذهب ضحيتها 108 أشخاص، بينهم 34 امرأة و49 طفلاً؛ إلى الإقرار، ولكن
بعد خمسة أشهر، بأنّ النظام هو الذي يقف وراءها، وأنّ سبب تسرّعه في
الاتهام الأوّل كان زمن المقابلة القصير الذي لم يتجاوز ستّ دقائق!
سيمور هيرش وباتريك كوبرن وروبرت فيسك كانوا في عداد الصحافيين الأكثر
تلقفاً لسرديات النظام، والاجتهاد فيها ولصالحها، حتى أنّ الأخير لم
يتردد في امتداح سجون النظام ومعتقلاته التي أفسح له ضباط النظام
الفرصة لزيارتها ورصدها والتدقيق في أحوالها من دون أيّ تدخل.
هذه السطور تسعى، في المقابل، إلى التركيز على نوام شومسكي الغنيّ عن
التعريف بسبب مواقفه المناهضة للإمبريالية الأمريكية ومناصرة قضايا
الشعوب بصفة عامة، إلى جانب مكانته العلمية العالية في اللسانيات
بالطبع. ولعلّ من الخير البدء من المقدّمة التي وضعها لكتاب الصحافي
الأمريكي ريز إرليك المعنون «داخل سوريا: القصة الخلفية لحربهم الأهلية
وما يمكن للعالم أن يتوقعه» الذي صدر في نيويورك سنة 2014؛ وهو النصّ
الأبكر الذي يكشف عن الخطل الكبير في تفكير شومسكي بصدد الانتفاضة
السورية: أنها حرب بين العلويين والشيعة في مواجهة السنّة، وهي
استطراداً أقرب إلى حرب أهلية منها إلى انتفاضة شعبية؛ وهذا استقراء
(إذا جاز وصفه كذلك) قاد شومسكي إلى استنتاجات أكثر انزلاقاً نحو الخطل
في مناسبات لاحقة، ستأتي هذه السطور على ذكرها.
يكتب شومسكي في المقدمة المشار إليها: «في الفصل الخامس يبيّن ريز
إرليك أنّ النزاع يبقى بين نظام الأسد وقطاعات رئيسية من الشعب السوري.
لكن الحرب أصبحت أكثر تعقيداً بسبب القتال المتزايد بين السنّة،
والعلويين، والشيعة، وسواهم، من المجموعات الدينية والإثنية، ودخول
مجموعات جهادية ذات أجندات متنوعة على النزاع». وبذلك فإنّ شومسكي لا
يختزل تشخيص إرليك فقط (إذْ أنّ الصحافي الأمريكي، في الفصل الخامس
المشار إليه، لا يقول البتة إنّ جوهر الصراع يدور حول الأديان
والطوائف!)؛ بل ينوس، على غير عادته في التزام الدقّة، بين مصطلحَيْ
«النزاع» و«الحرب» متجنباً تماماً أية إشارة توحي بانتفاض الشعب، أو
قطاعات واسعة منه، ضدّ نظام استبداد وفساد لا يخفى طابعه على عقل
تحليلي بارع مثل شومسكي.
قد يكون شومسكي النموذج الأبرز في صفوف اليسار الغربي النافر من الانتفاضة السورية، لكنه بالطبع قد يفسح المجال قريباً لآخرين أكثر بروزاً؛ ليس على صعيد مكانتهم وتمكّنهم ربما، بل في مستوى التجاسر على الحقّ والحقيقة
لافت، إلى هذا، أنّ الفصل الخامس الذي يشير إليه شومسكي يشرح الكثير من
العناصر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي دفعت السوريين إلى
الانتفاض في آذار (مارس) 2011؛ لم يكن في عدادها «قتال» من أيّ نوع بين
السنّة والشيعة؛ وأنّ بشار الأسد كان على يقين من أنّ السوريين، على
نقيض ما جرى في تونس ومصر واليمن، «لن يثوروا أبداً ضدّ نظام عروبي،
معاد لإسرائيل، معاد للإمبريالية». إرليك من جانبه يوضح من دون لبس أنّ
«السوريين عاشوا تحت نظام دكتاتوري حيث نقد الحكومة يعني السجن
والتعذيب» وأنّ الأسد «لم يسمح بأي أحزاب معارضة فعلية، وأنه عاش في
شرنقة سياسية مقتنعاً كلّ الاقتناع بأنه محصّن ضدّ الانتفاضات
العربية». في المقابل، يكتفي شومسكي بإطلاق صفة «الوحشي» على النظام،
في سنة 2014 للتذكير، أي بعد «حادثة الكيميائي» كما يسميها؛ منتقلاً
إلى ما يحلو له انتقاده عادة، أي أكاذيب التدخل الإنساني وسياسات
الولايات المتحدة عموماً.
في مناسبة لاحقة، خلال محاضرة هارفارد 2015، طرح طالب سوري السؤال
التالي على شومسكي: هل تعتبر التدخل الروسي في سوريا إمبريالياً؟ كان
جواب أحد نقاد الإمبريالية الأبرز أنّ ذلك التدخل ليس إمبريالياً، رغم
أنه من الخطأ في نظره أن تقف روسيا إلى جانب «نظام وحشي» مثل نظام
الأسد؛ وزاد، أو الأحرى القول إنه استزاد: «إذا هاجمت الأسد فإنك بذلك
تقوّي النصرة، فهل هذا ما تريده في سوريا؟»× ثمّ: «سواء رغبت في ذلك أم
كرهته، فإنّ نظام الأسد يجب أن يكون جزءاً من التسوية السياسية، وإلا
فإنه سيقاتل حتى الموت». ولعلّ الأخطر في تلك الآراء التي تناولت الوضع
السوري أنّ شومسكي كدّس كامل مجموعات المعارضة السورية للنظام في سلّة
واحدة هي «الجهاد» متمثلاً في «النصرة» المتفرعة عن «القاعدة» ومنذراً
بأنها تتلقى الدعم الكامل من السعودية على سبيل جرّ المجتمع السورية
نحو الوهابية.
هل توفرت في داخل سوريا قوى أخرى غير إسلامية أو غير جهادية، ضعيفة
كانت أم متوسطة الحضور مثلاً؟ وهل توفرت، على مظانها الكثيرة وأخطائها
الفادحة، مؤسسات تخصّ «المعارضة» الخارجية، مثل «الائتلاف الوطني»
وقبله «المجلس الوطني» وبعدهما «لجنة التفاوض» وفي الغضون «الجيش
السوري الحر» و«الحكومة المؤقتة»…؟ لا يلوح أنّ شومسكي معنيّ بتوظيف
هذه المسميات في سياقات ملائمة تليق بعدّته الأثيرة في التحليل
والتركيب والاستنباط؛ وكان تنزيه التدخل العسكري الروسي في سوريا عن
أيّ بُعد إمبريالي، مقابل قدح أيّ جهد للتدخل الإنساني في الشأن السوري
بوصفه مصطلحاً غير موجود أصلاً؛ بمثابة كاشف صريح تماماً حول الأفق
الذي يراه شومسكي مناسباً للحلّ في سوريا: فليدع الشعب انتفاضته
جانباً، لأنها تأسلمت وانقضى الأمر، وليدخل في تسوية مع النظام ذاته
الذي انتفض عليه، ولكلّ مقام مقال!
وفي مقابلة مع إمانويل ستوكس، على موقع
Jacobin،
عنوانها «شومسكي ونقّاده» لا يرفض الأخير فكرة «الممرّ الإنساني» أو
حتى منطقة حظر الطيران، ولكن هل تنفع في إنهاء النزاع؟ شومسكي يرحّل
تساؤله هذا إلى «عارفين» بالشأن السوري (مثل باتريك كوبرن، دون سواه!)
مستخلصاً مثلهم أنّ حلولاً مثل هذه يمكن أن تفيد في منطقة واحدة داخل
سوريا، هي تلك التي يسيطر عليها الأكراد. وفي بلد تحتلّ أراضيه خمس قوى
خارجية (روسيا، إيران، تركيا، الولايات المتحدة، دولة الاحتلال
الإسرائيلي) يساجل شومسكي بأنّ خيارات التدخل الخارجي لم تثبت فعالية،
ولا توحي بأي معونة في التوصل إلى حلول سلمية. ولكن… كيف يمكن لها أن
تفعل أصلاً، حتى إذا شاءت؟
وقد يكون شومسكي النموذج الأبرز في صفوف اليسار الغربي النافر من
الانتفاضة السورية، لكنه بالطبع قد يفسح المجال قريباً لآخرين أكثر
بروزاً؛ ليس على صعيد مكانتهم وتمكّنهم ربما، بل في مستوى التجاسر على
الحقّ والحقيقة، من دون رادع في سجلات الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
انتفاضة القامشلي 2004:
كرامة الجوهر
صبحي حديدي
لا تحضرني، كما هي الحال في كلّ عام، ذكرى الانتفاضة الشعبية العارمة
التي انطلقت من مدينة القامشلي يوم 12 آذار (مارس) 2004، إلا وأستعيد
معها بلدة عامودا، ذات الأغلبية السكانية الكردية؛ لاثنين من أسباب
أخرى كثيرة: 1) أنها شهدت مأساة حريق صالة السينما أثناء عرض فيلم
لتلامذة المدارس، خريف 1960، حيث قضى حرقاً 283 طفلاً لا تزيد أعمارهم
عن 12 سنة؛ و2) أنها البلدة السورية الوحيدة التي انفردت بتحطيم تمثال
حافظ الأسد مرّتين، ربيع 2004 بعد انتفاضة القامشلي، وخريف 2011 مع
تصاعد الانتفاضة الشعبية السورية الشاملة وفي مناسبة اغتيال الناشط
الكردي البارز مشعل التمو.
انتفاضة 2004 بدأت، كما هو معروف، على خلفية مشاحنات أعقبت مباراة في
كرة القدم بين نادي «الجهاد» المحلي، ومعظم جمهوره من الأكراد
المبتهجين لسقوط صدّام حسين، وفي النفوس مجزرة حلبجا وسواها؛ وجمهور
نادٍ ضيف «الفتوة» القادم من مدينة دير الزور، حيث بعض الجمهور ساخط
لسبب مضادّ جوهره التعاطف مع العراق أو مع صدّام حسين شخصياً لدى شريحة
منهم. وكان يمكن للواقعة تلك أن تمرّ مثل سواها من مئات حوادث الشغب في
ملاعب كرة القدم، لولا أنّ النظام سارع فوراً إلى استخدام الرصاص
الحيّ، ولم يتردد في استيحاء مجزرة حماة 1982 لتلقين أكراد سوريا، وليس
منطقة الجزيرة وحدها، درساً في الفاشية يمارسه الوريث من باب استئناف
تراث أبيه: في القامشلي والحسكة وعامودا وديريك والدرباسية وعين العرب
وعفرين، هذه المرّة.
كانت حقيقة انطلاق الانتفاضة من قلب وسط كردي غالباً، ومن مناطق ومحافظات الشمال الشرقي بادئ ذي بدء، لا تخفف من خشية النظام بقدر ما تضاعفها عملياً، وتجعل دقات جرس الإنذار أكثر دفعاً نحو العنف المفتوح واستئناف دروس مجزرة حماة الفاشية
الأرجح أنّ انتفاضة القامشلي قرعت جرس الإنذار الأبكر في عهد الوريث،
وكانت الأخطر أيضاً لأنها ابتدأت من جمهور كردي كان النظام يتخوّف من
إمكانية استثماره من جانب الاحتلال الأمريكي في العراق وتحويله إلى
«حصان طروادة» إذا توجّب الضغط أكثر على نظام آل الأسد، واتخاذ إجراءات
قصوى لوقف لعبة النظام في تمرير الجهاديين إلى الداخل العراقي عبر
الحدود السورية. يومذاك كان نظام الأسد يقوم على «صقور» تتيح تلاقي
أمثال ماهر الأسد وأمّه أنيسة مخلوف وخاله محمد مخلوف وصهره آصف شوكت،
مع نماذج عبد الحليم خدام ومصطفى طلاس وغازي كنعان ومحمد ناصيف، لجهة
تأثيم المواطنين الكرد والتوافق على إخضاعهم لشتى أشكال القهر والقمع
والتضييق والتمييز.
أكثر من هذا، وقبلئذ في الواقع، كان الأسد الأب نفسه يبغض المحافظات
الشرقية ويعتبرها معادية لنظامه وله شخصياً؛ وكان الدليل الأوضح على
مشاعره هذه أنه، بعد أسابيع أعقبت انقلابه عام 1970، قام بسلسلة جولات
استعراضية شملت جميع المحافظات السورية ما عدا دير الزور والحسكة
والرقة. هذه كانت، في رأيه، إما متعاطفة تاريخياً مع العراق لأسباب
اجتماعية وتاريخية وجغرافية ولسانية وثقافية (كما هي حال الرقة ودير
الزور) أو متعاطفة مع كردستان العراق (على غرار غالبية الكرد في
الحسكة).
وفي المقابل كانت حقيقة انطلاق الانتفاضة من قلب وسط كردي غالباً، ومن
مناطق ومحافظات الشمال الشرقي بادئ ذي بدء، لا تخفف من خشية النظام
بقدر ما تضاعفها عملياً، وتجعل دقات جرس الإنذار أكثر دفعاً نحو العنف
المفتوح واستئناف دروس مجزرة حماة الفاشية. فهذه المناطق تعرضت على
الدوام للإهمال والحرمان ومعاملة الدرجة الثالثة، رغم أنها «أهراء
سوريا» على نحو أو آخر؛ وهي حاضنة ثروات البلاد ومواردها الأساسية: في
النفط، وزراعة الحبوب، والأقطان، التي تعدّ محاصيل ستراتيجية؛ وفي
الكهرباء وسدّ الفرات.
محطة أولى في تاريخ التمييز الرسمي الذي حاق بالمواطنين الأكراد في
سوريا سجّلها إحصاء العام 1962، الذي أسفر عن تجريد نحو 200 ألف مواطن
كردي من الجنسية، وتسجيلهم في القيود بصفة «أجنبي»؛ كما جرّد 80 ألفاً
آخرين ولكن من دون تسجيلهم في القيود هذه المرّة، ممّا أستولد حالة
القيد المدني العجيبة: «المكتوم». المحطة الثانية كانت «الدراسة»
الشهيرة، العنصرية بكلّ معنى ومقياس، التي وضعها الملازم محمد طلب هلال
ورفعها إلى قيادة حزب البعث، وشرح فيها طرائق «تذويب» الأكراد في
«البوتقة» العربية. النتيجة الأولى كانت تعريب أسماء عشرات القرى
والبلدات الكردية، وحظر تسجيل الولادات بأسماء كردية، ومنع الطباعة
باللغة الكردية، وسوى ذلك من الإجراءات التمييزية الفاضحة. المحطة
الثالثة كانت الأكثر فاشية، وجرت في مطلع السبعينيات حين فرضت السلطات
إقامة «حزام عربي» بطول 375 كم وعمق يترواح بين 10 – 15 كلم، على
امتداد الحدود السورية التركية؛ اقتضى ترحيل 120 ألف مواطن كردي من 332
قرية، وإحلال سكان «عرب» محلّهم بعد بناء قرى نموذجية لهم.
وإذْ أستعيد، اليوم، الذكرى الـ17 لانتفاضة القامشلي، أقرأ أنّ تظاهرات
جابت شوارع المدينة، أو زارت مقابر الشهداء، أو أقامت فعاليات احتفائية
شعبية مختلفة؛ فضلاً عن حدث خاصّ، لعله الأبرز في يقيني، تمثّل في
إقامة مباراة كرة قدم «كرنفالية» جمعت بين فريق محلي وآخر من دير
الزور، وذلك «للتأكيد على قيم العيش المشترك والأخوّة التي تجمع بين
المكونات السورية، التي حاول النظام البعثي إثارة الفتنة بينها» كما
قالت الجهة المنظمة للفعالية.
هنا الدرس، بالطبع، وهنا الكثير من جوهر الدلالة وكرامة الذكرى.
استفتاء سويسرا:
«صدام حضارات»
من أجل 30 منقّبة؟
صبحي حديدي
إذا صحّ ما تردد في وسائل الإعلام السويسرية من أنّ عدد النساء اللواتي
يرتدين النقاب في سويسرا لا يتجاوز الـ30، في بلد يبلغ عدد سكانه 8.6
مليون نسمة وتشكل النساء فيه نسبة 50.4؛ فإنّ الاستفتاء الأخير حول حظر
تغطية الوجه يبدو أقرب إلى الانطباق على الرجال (مثيري الشغب في ملاعب
كرة القدم مثلاً، ممّن اعتادوا إخفاء الوجوه تفادياً لانكشاف الهوية)
أكثر من النساء. ليست هذه مزحة بالطبع، لأنّ التعديل الدستوري الذي
صوّت لصالحه 51.2٪ من الناخبين في سويسرا، لا يسمّي المرأة بصفة محددة
أوّلاً؛ كما أنه، ثانياً، لا ينصّ بالتسمية الصريحة على حظر النقاب أو
البرقع أو الحجاب؛ عدا عن حقيقة إحصائية تقول إنّ نسبة المسلمين في
سويسرا لا تتجاز 5.5٪.
ليست مزحة، في المقابل، مواقف الحكومة السويسرية المناوئة صراحة لتمرير
الاستفتاء، لأنه «يُلحق الضرر بالسياحة» ولأنّ غالبية المنقبات هنّ
«سائحات يقضين فترات وجيزة في البلاد» و«قلة قليلة في سويسرا ترتدي ما
يغطي الوجه بالكامل، و«الحظر على مستوى البلاد سيقوض سيادة المحليات
ولن يكون نافعا لفئات معينة من النساء». ولهذا بادرت الحكومة إلى طرح
مشروع بديل يُلزم بكشف الوجه كاملاً أمام السلطات عند تدقيق الهوية.
أخيراً، ليست مزحة ما يقوله بعض ممثلي وممثلات مجموعة «إيغركنغر»
المقربة من «حزب الشعب» اليميني، والتي قادت حملة الدعوة إلى الاستفتاء
وجمعت من أجل إجرائه أكثر من
105 آلاف توقيع تحت لافتة «نعم لفرض حظر على إخفاء الوجه». هذا من حيث
توصيف التعديل الدستوري، وأمّا الشعارات فقد بدأت من «أوقفوا الإسلام
الراديكالي» و«أوقفوا التطرف» ولم تنته عند ملصق الحملة الأبرز الذي
يلتقط صورة امرأة منقبة، عاقدة الحاجبين غاضبة متطيرة شرّاً، تنذر
بالويل والثبور.
لم يكن من الممكن، والحال هذه، أن تغيب أسطوانة «القيم الحضارية» عن
مسوغات الحملة، وسارت مسوغات «حزب الشعب» على منوال «المسألة الحضارية»
التي تميّز سويسرا وتاريخها عن أولئك الذين يحجبون الوجه لممارسة
التمييز ورفض المساواة. التصويت بالموافقة على مشروع التعديل ضربة
موجعة لـ«الإسلاموية الراديكالية» في نظر الحزب، وكذلك لأطروحات اليسار
«الاجتماعية الرومانتيكية وغير الواقعية والعبثية». ولم يكن ممكناً،
استطراداً، إلا أن تُعاد المعزوفات ذاتها التي ابتدعتها أحزاب اليمين
المتطرف والشعبوي في بلدان أوروبية أخرى، على رأسها فرنسا غنيّ عن
القول، عندما طغت هستيريا الحجاب وقوانين حظره والتيه في تنويعاته
النقابية والبرقعية؛ وأن تُستعاد، في سويسرا تحديداً، تجربة استفتاء
حظر تشييد المآذن لسنة 2009، التي وافق عليها الناخبون بنسبة أعلى
حينذاك: 57.5.
يومها انتقلت، كالنار في الهشيم، أصناف السجالات الزائفة والسطحية
والضحلة حول موقع المئذنة ودلالاتها ورموزها؛ فقال استطلاع رأي أجرته
على استعجال مؤسسة «إيفوب» إنّ 46٪ من الفرنسيين يؤيدون حظر المآذن،
وقبلت بها نسبة 40٪، ورفضت نسبة 14٪ الإفصاح عن الرأي. لكنّ الخلاصة
الأكثر مغزى كانت أنّ نسبة 19٪ فقط هي المؤيدة لبناء المساجد، فكانت
النسبة الأدنى منذ ثلاثة عقود، بل كانت أضعف حتى من نسبة ما بعد
تفجيرات 11/9 سنة 2001 التي بلغت 22٪. كذلك لم تعدم فرنسا وزيرة سابقة
تنتمي إلى اليمين المسيحي، كريستين بوتان، تشرح لمواطنيها أنّ «المئذنة
ترمز إلى الديانة الإسلامية، ونحن لسنا في دار الإسلام» وكأنهم غافلون
عن حقيقة بديهية مثل هذه؛ أو كأنّ الأمر تناظر بين الإسلام والمسيحية،
وليس واحداً من حقوق الإنسان الجوهرية، أي حقّ المعتقد وممارسته
والتعبير عنه بالوسائل التي يكفلها القانون.
لم يكن غريباً أنّ أولى الاعتراضات على تنظيم الاستفتاء السويسري الأخير أتت من منظمة العفو الدولية مثلاً، ثمّ من مكتب حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، وأن يعتمد منطق الاعتراض في الحالتين على نصوص «الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية»
يومها، أيضاً، لم يتبرع أحد، أو لم يعبأ عابئ ربما، بوضع بوتان أمام
مقارنة جائزة منطقياً: ماذا يمكن أن تقول، وسواها من الرهط المشايع
لها، لو أنّ استفتاء نظيراً جرى في القاهرة أو بغداد أو دمشق أو
الرباط، وهي عواصم مسلمة بامتياز، فأفضت نتيجته (بنسبة 57.5٪، كما في
المثال السويسري) ليس إلى منع تشييد كنائس جديدة، بل حظر تزويدها
بالأجراس، وحظر قرع تلك الأجراس أيام الآحاد والمناسبات الدينية؟ ألا
يشكل استفتاء كهذا اعتداءً على حرّية المعتقد المسيحي، في ديار
الإسلام؟ وهل سيتجاسر أحد من أمثال بوتان، في أيّ من دول الغرب التي
استفتت حول المساجد والمآذن، فيقول إنّ استفتاء هذه «العاصمة المسلمة»
أو تلك خطوة ديمقراطية مشروعة، اتفق المرء معها أو اختلف؛ أم سيعتبره
ممارسة أصولية متشددة، منتظَرة تماماً من ديانة لا تحترم عقائد
الآخرين؟
وفي العودة إلى واحد من جذور الأمر، يصحّ التذكير بأنّ سويسرا ديار
مسيحية، ومن المفهوم أن السويسري المسيحيّ ـ ذاك المتديّن البسيط،
التقليدي أو العصري، سواء بسواء في الواقع ـ يمكن أن يلمس هذا المقدار
أو ذاك من أخطار تتهدد ديانته من ديانة أخرى لا يكفّ أهل النخبة، في
المذياع والتلفاز والصحيفة والكتاب، عن وصفها بالمتشددة والمتطرفة
والمنغلقة، فضلاً عن كونها صانعة الإرهاب. بيد أنّ هذه أيضاً، ولا ريب،
ديار ديمقراطية تعددية أياً كانت المظانّ حول نظامها، وهي موطن أكثر من
شرعة كونية واحدة تعزّز حقوق الرأي والتعبير والمعتقد،؛ بالإضافة إلى
ما اشتهرت به من حياد في الحرب، كما في السلام. هل ثمة تناقض موروث
ومتأصل ومستعصٍ، إذن؟ وكيف، ومن أين ينبثق؟ وإذا كان طراز الديمقراطية
السويسري، أي الاعتماد الدائم على استفتاء الشعب، قد أماط اللثام عن
حقائق ذلك التناقض؛ فكيف يمكن أن تتكشف حقائق مماثلة في طراز آخر من
الديمقراطية، في فرنسا مثلاً؟
لم يكن غريباً، والحال هذه، أنّ أولى الاعتراضات على تنظيم الاستفتاء
السويسري الأخير أتت من منظمة العفو الدولية مثلاً، ثمّ من مكتب حقوق
الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، وأن يعتمد منطق الاعتراض في الحالتين
على نصوص «الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية» الذي يُعدّ واحداً
من المحطات الكبرى التي أنجزتها الإنسانية على طريق تفصيل الحقوق
والواجبات في ميادين الحريات العامة والنظام والسلوك. فكيف إذا كان
النصّ التشريعي المقترح لا يكاد يميّز بين وجه امرأة ووجه رجل، ولكنه
في الآن ذاته يزعم استصدار التشريع في سبيل الدفاع عن حرّية المرأة؟
وكيف إذا كانت أسطوانة «القيم الحضارية» لا تُدار هنا إلا لكي تستعيد
تلك الأنغام العتيقة النشاز التي أبطلتها حركة التاريخ، على غرار نظرية
صمويل هنتنغتون في «صدام الحضارات»؟
وفي التعليق على حكاية المآذن، ومواقع أديان الأقلية مقابل الأكثرية،
كان الأكاديمي الفرنسي جان ـ بول ولايم، الأخصائي البارز في علم اجتماع
الأديان، قد اعتبر أنّ «الصروح الدينية صيغة تعبير عن تحدّيات حيازة
السلطة، إذْ كان الكاثوليك في القرن التاسع عشر مخوّلين ببناء الكنائس
في الشوارع الرئيسية، وتُرك للبروتستانت أن يبنوا معابدهم في الشوارع
الخلفية والجانبية فقط». شيء من هذه المطارحة تردد لدى المستشارة
الألمانية أنغيلا ميركل، التي ساجلت بأنّ من الممكن بناء المآذن، شرط
ألا ترتفع أعلى من برج الكنيسة، حيث يُقرع الجرس. هذا ما أطلق عليه
ولايم تسمية «الكاثو ـ علمانية» نسبة إلى كَثْلَكة حياة يومية علمانية
في المظهر ولكنها في الباطن تواصل بعض تديّنها القديم.
وإلا، بمعزل عن المزاح مجدداً، كيف استنهضت الديمقراطية السويسرية أكثر
من ثمانية ملايين مواطن، في وجه 30 منقبة؟
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
دانييل بايبس: رثاء المحافظين
على سبيل كراهية العرب
صبحي حديدي
التيارات المحافظة في الولايات المتحدة ليست اليوم على حال تسرّ خاطر
ممثليها وأنصارها، حتى قبل هزيمة الجمهوري دونالد ترامب وفوز
الديمقراطي جو بايدن، وقبل لجوء خليط من حشود محافظة وعنصرية وانعزالية
إلى اقتحام مبنى الكابيتول. فالعقود الأخيرة، وليس السنوات أو التطورات
الأحدث عهداً، سجّلت تراجعاً ملحوظاً، لعلّ ذروة انحنائه نحو حافة
المحاق الوشيك كان اندحار التنظيرات التي اقترنت مع غزو العراق سنة
2003 والتبشير بنقل «فيروس الديمقراطية» إلى بلدان الشرق الأوسط
والمجتمعات الإسلامية/ الشرقية/ الآسيوية كافة. ومَن آخر المتباكين على
انقلاب المحافظين إلى «ضبع كريه» بعد عزّ وسؤدد خلال القرن العشرين،
سوى دانييل بايبس، دون سواه: الكاتب الأمريكي اليهودي، المحافظ
واليميني، المتباكي على رحيل ترامب؟
وكيف لا يكون حزن بايبس على انحسار التيارات المحافظة تتمة تلقائية،
ومنطقية منهجية، لرجل أدمن كراهية العرب، وقبلهم المسلمين، ليس من
منطلقات خوافية استيهامية عنصرية من الطراز الرائج على نطاق واسع في
الغرب، فحسب؛ بل كذلك، وأوّلاً، لأنّ الرجل صهيوني العقيدة، إسرائيلي
الانحياز (الأعمى، المطلق، الأقصى…) ليكودي الهوى (في زمن يشهد ندرة
«أصلاء» الليكود بمعزل عن قارعي الطبول خلف بنيامين نتنياهو في مسيره
نحو محاكم الفساد)؟ وكيف، في مزيد من التباكي، لا يربط محاق التيارات
المحافظة بتبدلات كبرى طرأت على «المؤسسة الأمريكية» القياسية
والمثالية والتاريخية، ذاتها: جامعة هارفارد (تأسست سنة 1636) وصحيفة
«نيويورك تايمز» (1851) ومعهد بروكنغز (1916) ومجلس العلاقات الخارجية
(1921) و«مؤسسة فورد» (1936)؟
هذه، ومنذ 40 سنة في تقدير بايبس ضمن مقالة نشرتها «واشنطن تايمز»
مؤخراً، هي اليوم مؤسسات ديمقراطية من حيث التوجه الحزبي، ذات نزعة
تقدمية، تميل إلى التجريب الاجتماعي، والضرائب العالية، والتغيير. لكنّ
هارفارد اعتادت، في الماضي، توظيف أساتذة محافظين، كانت «نيويورك
تايمز» تنشر مقالاتهم، وتستضيفهم «بروكنغز» ويدعوهم مجلس العلاقات
الخارجية إلى ترؤس اجتماعاتها، وتموّلهم مؤسسة فورد. وهكذا، يتابع
بايبس، لا تتورع مجلة
Psychology Today
عن القول بأنّ «النزعة المحافظة شكل من الجنون» أو يرى بعض اليساريين
أنّ المحافظين غلاة متسلطون و«ناكرو تغيّر المناخ» في ما يحيل إلى
ناكري الهولوكوست.
وقائع أخرى، لا يعفّ بايبس عن ضربها كأمثلة لا تصوّر انحسار التفكير
المحافظ بقدر خضوعه للاضطهاد والتنكيل: المعلّق كيفن وليامسون انتهى
عمله في مجلة
The
Atlantic
قبل أن يبدأ، لأنّ تحرير المجلة لم يهضم آراءه حول الإجهاض؛ وجامعة
ماساشوستس طردت الطالب لويس شنكر، لأنه تجرأ على مناصرة ترامب ودولة
الاحتلال الإسرائيلي. جامعة نورثوسترن أنكرت جوزيف إبستين، الذي درّس
فيها 28 سنة، وأسقطته من موقعها الإلكتروني لأنه نصح السيدة الأولى جيل
بايدن ألا تطلق على نفسها صفة دكتورة… والناظر إلى أمثلة بايبس لا
يصدّق أنه يتحدث عن أمريكا التي يعرفها القاصي والداني: هذه التي تطرد
طالباً لأنه إسرائيلي الهوى؟ نعرف أنّ العكس هو الصحيح، إذْ أنّ عدم
نصرة دولة الاحتلال، أو التعاطف مع القضية الفلسطينية، هو الذي يعرّض
للمساءلة!
وعلى مستويات أخرى، يشير بايبس إلى أنّ «المؤسسة الليبرالية» أي تلك
الموازية للمؤسسة المحافظة طبقاً لتشخيصاته، تنامت وانتعشت بقوّة: نسبة
القبول في كلية هارفارد تناقصت من 82٪ في سنة 1933 إلى 20٪ في سنة 1965
وإلى 5٪ اليوم؛ و«مؤسسات أمريكا الجديدة» مثل أمازون وفيسبوك وغوغل،
تخلّت عن مبادئها التحررية وصارت أكثر اقتراباً من اليسار. ليس هذا
فحسب، وهنا أعجوبة رأسمالية لا يتجاسر عليها سوى أمثال بايبس: تفوّق
اليسار على المحافظين في حجم التبرعات، وبالتالي الاستئثار بصناعة
السياسة العامة، بنسبة 3.7 إلى 1٪؛ وهذا ينسحب، أيضاً، على ميادين
التعليم والفنون وسواها. هذا الانعدام في تكافؤ المصادر قابل للتفاقم
أكثر، لأنّ الأثرياء، يا للعجب هنا أيضاً، أكثر ميلاً إلى اليسار، في
حين أنّ «المحافظين يفضّلون رعاية حدائقهم الخاصة»!
خطاب بايبس لم يتغيّر، ولا يلوح أنه سوف يتغيّر، إلا نحو الأكثر ضحالة وسطحية وسوء طوية. رثاء النزعات المحافظة الأمريكية لا يصحّ أن ينفصل اليوم عن تنظيراته السابقة حول مديح توجهات «المحافظين الجدد» في رئاسة جورج بوش الابن وقبل غزو العراق
وما دمنا في الذكرى العاشرة لانطلاقة انتفاضات العرب، جديرة بالاستعادة
تأويلات بايبس لحراك الشارع العربي وحصره في ما اسماه «الحرب الباردة
الشرق ـ أوسطية» تارة، أو «الشطرنج الإقليمي» طوراً؛ ولكن ليس، البتة،
إلى إرادة الشعوب، والتعطش إلى الحرّية والكرامة والديمقراطية، إزاء
قبائح أنظمة الاستبداد والفساد. وبين «التمرّد» و«العصيان» وليس
الانتفاضة أو الثورة، اقترح بايبس ثلاثة مستويات من «التأمل»:
الأوّل هو أنها ثمرة تصارع فريقَيْ الحرب الباردة الإقليمية: معسكر
إيران و«المقاومة» الذي يضمّ سوريا وتركيا وغزّة ولبنان، ويسعى إلى
«هزّ أركان النظام القائم، واستبداله بآخر إسلامي أكثر تقوى، وأشدّ
عداء للغرب»؛ ومعسكر السعودية، وهو صفّ «الأمر الواقع» الذي يضمّ معظم
ما تبقى من دول المنطقة، بما في ذلك دولة الاحتلال، و«يفضّل الحفاظ على
الأمور كما هي، في قليل أو كثير». المعسكر الثاني «يتمتع بخاصية تقديم
رؤية» والمعسكر الأوّل يتميز بـ«القدرة على نشر المدافع، والكثير
منها».
المستوى الثاني هو أنّ «التطورات» في تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين
ذات مغزى كبير، ولكن المغزى الأكبر هو في ما ينتظر «العملاقين» قائدَي
المعسكرين، إيران والسعودية. صحيح أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية
تمكنت من احتواء الاحتجاجات الشعبية في حزيران (يونيو) 2009 على خلفية
الانتخابات الرئاسية؛ إلا أنّ النار ما تزال تحت الرماد، وانهيار «نظام
الخميني» ليس بعيد الاحتمال، وعواقب حدث كهذا تشمل أمن دولة الاحتلال،
والأمن النووي في المنطقة، ومستقبل العراق، وسوق الطاقة الدولي،
و«معسكر المقاومة» ذاته في المقام الأوّل. ورغم أنّ السعودية تتباهي
بنظام مستقرّ، تقوم ركائزه على «مزيج فريد من العقيدة الوهابية،
والسيطرة على مكة والمدينة، واحتياطي النفط والغاز» إلا أنّ «الفوارق
الجغرافية والإيديولوجية والشخصية بين السعوديين يمكن أن تتسبب في
انهيار النظام».
مستوى التأمل الثالث، والأهم في نظر المتأمل بايبس، هو أنّ «حركات
التمرّد» العربية الأخيرة بدت «بنّاءة» و«وطنية» و«ذات روح مفتوحة»؛
فغاب عنها «التشدد السياسي في كلّ أنواعه، اليساري منه أو الإسلامي»
وكذلك غابت الشعارات المناهضة للولايات المتحدة، وبريطانيا، ودولة
الاحتلال! فما الذي يقرأه بايبس في ما يزعم من خصائص، يراها جديدة على
الشارع العربي؟ أنها، ببساطة، انفكت تماماً عن «تشدد القرن الماضي» كما
صنعه رجال من أمثال المفتي أمين الحسيني، جمال عبد الناصر، آية الله
الخميني، ياسر عرفات، وصدّام حسين.
والحال أنّ خطاب بايبس لم يتغيّر، ولا يلوح أنه سوف يتغيّر، إلا نحو
الأكثر ضحالة وسطحية وسوء طوية. رثاء النزعات المحافظة الأمريكية لا
يصحّ أن ينفصل اليوم عن تنظيراته السابقة حول مديح توجهات «المحافظين
الجدد» في رئاسة جورج بوش الابن وقبل غزو العراق، بصدد إيقاظ العرب
والمسلمين من رقاد خارج التاريخ، في حاضنات «الإرهاب الإسلامي» وحدها.
واليوم، كما في كلّ «رثاء» يمارسه بايبس، فإنّ أطروحته المركزية هي
هذه: «المسلمون دخلوا في غيبوبة خلال القرنين الماضيين، وهي محنة أهل
الله الذين وجدوا أنفسهم في أسفل الركام. ولا غرو أنّ بلاد الإسلام
تضمّ معظم الإرهابيين والحجم الأقلّ من الديمقراطيات في العالم».
ولا عجب، في استكمال المعادلة المتلازمة، أنّ بايبس لا يتباكى على
ترامب وحده، بل يحثّ الشارع الإسرائيلي على النظر بعين العطف إلى
«صديقي نتنياهو» في محنته أمام القضاء: «لا تريدونه رئيس حكومة، حسناً،
ضعوه في موقع الرئيس!»؛ يكتب بايبس، في استباق تسطير المرثاة التالية!
(القدس العربي) لندن
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
أمريكا بعد اقتحام الكابيتول:
مَن يجبّ الترامبية؟
صبحي حديدي
قد يصحّ الإقرار، بادئ ذي بدء، أنّ نظام الانتخابات الرئاسية
الأمريكية، على علاته ومظانه الكثيرة، أثبت مرونة عالية في الجوانب
الإجرائية التي تعود قواعدها إلى ما سنّه «الآباء المؤسسون»؛ وتسري
بالتالي على الحزبين الوحيدين، الجمهوري والديمقراطي، ولا تملك مؤسسة
ديمقراطية عليا مثل الكونغرس سبيلاً لتعطيله على نحو يغيّر أصول اللعبة
جذرياً، حتى إذا تعرّضت إلى مسّ هنا أو هناك، رقيق أو عنيف. ذلك ما
تشهد به وقائع ما بعد انتخاب جو بايدن رئيساً وكمالا هاريس نائبة
للرئيس، رغم صنوف المقاومة العنيفة التي اعتمدها الرئيس الخاسر دونالد
ترامب؛ والتي تطورت على نحو منهجي حتى بلغت ذروتها في العصيان الذي
نفّذه أنصاره في قلب العاصمة، واقتحام مبنى الكابيتول أثناء انعقاد
اجتماع مشترك لمجلسَيْ النواب والشيوخ للتصديق على نتائج الانتخابات
الرئاسية.
غير أنّ هذه المرونة لا يصحّ لها أن تجبّ مقدار العطب الداخلي العميق
الذي أصاب، ويواصل إصابة، الديمقراطية الأمريكية المعاصرة كما تعاقبت
فصولها منذ نهايات الحرب العالمية الثانية على أقلّ تقدير؛ بافتراض أنّ
سماتها التكوينية الإيجابية، القياسية إذا جاز القول، خرجت من عباءة
الليبرالية التنويرية لتدخل تحت عباءة النيو ــ ليبرالية، المتوحشة
المناهضة للتنوير إلى درجة الاصطفاف المحافظ واليميني في أمثلة عديدة.
وليس مثال العطب الأبرز، والراهن، سوى صعود ترامب والترامبية، ليس في
مستويات السياسة والاجتماع والاقتصاد والعلاقات الدولية والثقافة،
فحسب؛ بل كذلك في سيرورات متكاملة من استطالة الترامبية في قلب الحزب
الجمهوري، الذي لم يتوقف عند مزيد من الانغلاق المحافظ والعصبوية
البيضاء والعنصرية المبطنة أو حتى الصريحة، بل استمرأ حالة من التبعية
والخضوع و»التقولب» حول شخص ترامب، تكاد تذكّر بظاهرة عبادة الفرد دون
سواها.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، لأسباب داخلية وخارجية في
آن معاً، قدوة غالبية من أنصار الحزب الجمهوري؛ ومن الإنصاف الافتراض،
اليوم، بأنه اهتز في قبره لمرأى مشاهد اقتحام الكابيتول (ولسنا نعرف
حتى الساعة ما إذا كان تمثاله داخل المبنى قد صمد أمام غضبة الجموع
الترامبية). ففي خطبة الوداع، مطلع كانون الثاني (يناير) 1989، ذكّر
ريغان الأمريكيين بأنه لم يكفّ عن التغنّي بـ»»المدينة المضيئة» على
التلّ، رمز الديمقراطية الأمريكية المشيدة على «صخور أقوى من المحيطات»
التي باركها الربّ رغم عصف الأنواء كي تتآخى مع «شعوب من كلّ نوع تعيش
في اتساق وسلام». لم تكن هذه حال التآخي التي خامرت ذهن ريغان حين
أفسحت الصخور الدروب الواسعة لاجتياح الرمز المضيء، بأعلام عنصرية
وعصبوية ونازية، وبشعارات لم تعد تعترف من الديمقراطية إلا باسم ترامب
وإسقاط نتائج الانتخابات الرئاسية؛ في غمرة ذهول أجهزة الأمن
والاستخبارات المحلية والفدرالية في عاصمة القوة الكونية الأعظم، على
مرأى ومسمع العالم بأسره.
وذلك الباب الشهير، في قاعة الكابيتول الكبرى، الذي يدلف منه رؤساء
أمريكا لإلقاء الخطبة السنوية التقليدية حول حال الاتحاد، تجاوزت أحدث
صورة له المخيّلة السوريالية: ثلاثة من رجال الأمن يصوبون مسدساتهم نحو
نفر من أنصار ترامب يحاولون تحطيم الباب. أمّا مكتب نانسي بيلوسي،
رئيسة البرلمان والهيئة التشريعية الأعلى إلى جانب مجلس الشيوخ، فلم
يُشبع غليل المقتحمين أنهم عبثوا به، بل توجّب أن يتركوا لها رسالة
وعيد: عائدون! «انقلاب» جدير بأنظمة العالم الثالث، اهتدى بعض المعلقين
الأمريكيين إلى العبارة الملائمة؛ أو «عصيان» في التعبير المهذب الذي
استخدمه الرئيس المنتخب بايدن؛ وقلّة استعادوا العبارة التي تُنسب إلى
سنكلير لويس، الكاتب والمسرحي الأمريكي حامل نوبل: «حين تصل الفاشية
إلى أمريكا سوف تكون ملفوفة بالعَلَم والصليب»…
وتلك، لا يخفى، سياقات تردّ إشكالية الراهن الأمريكي إلى قيمة عليا
دائمة، لا تحول ولا تزول، هي مفهوم «الحلم الأمريكي»؛ ذاك الذي يعلن
ترامب أنه يريد إحياء جذوته في النفوس عبر الشعار الأثير حول جعل
أمريكا عظيمة مجدداً. المفهوم صوفي بالطبع، وهو سحري سار ويسير على
ألسنة الساسة الأمريكيين في كلّ مناسبة تخصّ، أو تمسّ، علاقة الولايات
المتحدة بالعالم ما وراء المحيط؛ أو، في التكملة، كلما تعيّن عليهم أن
يدغدغوا أنفة الأمريكي أو غطرسته الموروثة بمعنى أدقّ؛ فما بالك إذا
اتصل الأمر بالذات، التي تضخمت خلال أربع سنوات من الترامبية البيضاء
والعنصرية وشبه الفاشية أو بعض الفاشية كاملة متكاملة. التاريخ
الأمريكي من جانبه يروي تفاصيل أخرى عن الحلم، فيسجّل قيامه على
الفلسفة الطهورية أوّلاً، ثم انفتاحه ــ سريعاً ودون مقدّمات لاهوتية
أو أخلاقية ــ على شهوات لاطهورية، قوامها الفتح والتوسع والهيمنة
والأسواق والاستثمار والاحتكار، وما إلى هذه من أخلاقيات رأسمالية.
تكفي متابعة أعمار الجموع التي اقتحمت مبني الكابيتول كي يدرك الناظر أنّ هستيريا الأمريكي السبعيني كانت تكمل سعار الأمريكي العشريني أو الثلاثيني؛ وما بينهما نساء عجائز ونساء صبايا، سواء بسواء
وبالطبع، الحكاية الأشهر في هذا الصدد تقول إنّ المهاجر الإنكليزي جون
ونثروب أبحر في عام 1630 على ظهر السفينة أرابيلا، في طريقه إلى
«العالم الجديد»؛ وعلى مبعدة فراسخ قليلة من شواطىء أمريكا نطق ذلك
البيوريتاني الحالم بالجملة الذهبية: «إنني أحلم بأمريكا على هيئة
مدينة في أعلى هضبة خضراء، تحفّ بها البراري والمراعي والكنائس». هكذا
بعفوية شاعرية رعوية، ولكن بما يكفي من براغماتية جعلته يردف بالقول:
«هدفي هو الحرّية، ولكنّ مخططاتي على المدى البعيد ستكون الاستئثار
بأقصى ما يتيحه لي الربّ من عقارات وثروات». وبالفعل، أرسى ونثروب
قلوعه عند صخرة ماساشوستس الأشهر، ثم أقام مستعمرة بوسطن، وأسّس شركاته
من عرق الزنوج العبيد ودمائهم، وانتُخب حاكماً مدى الحياة.
ومذاك، ما انفكت هذه المشكلة البكر تتفاقم وتتضخّم: أنّ «الأمّة
الأمريكية العظيمة» مصابة بتخمة الحديث عن الصخرة البيوريتانية والحلم
الأمريكي، في التجريد والإطلاق والضبابية والصوفية؛ ولن يعلو نجم
سياسي، جمهوري أم ديمقراطي، ليبرالي يساري أم محافظ يمين، علماني أم
متدين… إلا وبعض بضاعته المستعادة هي الحلم الأمريكي؛ وتستوي في هذا
التنويعات اللفظية، والكثير منها ركيك كسيح الدلالة. المشكلة الأخرى
أنّ صخوراً من نوع مختلف كانت تنتظر خطاب ونثروب الانفتاحي ذاك، وعليها
تكسّر الخطاب الأصلي بسرعة قياسية، بمنأى حتى عن صخرة ماساشوستس التي
يحرسها طهوريون غلاة يرسمون مبادىء الحلم الأمريكي على غرار تقنيات
راعي البقر في جمع القطيع.
هو الحلم ذاته الذي رفع ترامب إلى مصافّ مرشح الحزب الجمهوري في
انتخابات 2016، رغم النقائض والفضائح والعراقيل؛ ثمّ إلى سدّة البيت
الأبيض، وموقع اتخاذ القرارات التي طوت أكثر من صفحة سطّرها رؤساء
جمهوريون أعلى منه شأناً ومكانة؛ وصولاً إلى القبض على مقادير الحزب
الجمهوري وتحريك كبار ممثليه في مجلس النوّاب والشيوخ كما تُساق
النعاج. وإنه، بذلك، الحلم الذي يتوجّب أن يذكّر بمساوئ الديمقراطية
الأمريكية، بعد استذكار محاسنها غنيّ عن القول، وفي الطليعة منها أنّ
صعود ترامب وأمثاله لم يكن مصادفة أو ضربة عشوائية، وليست اعتبارات
الأمن والاقتصاد والشعبوية والعنصرية والبذور الفاشية هي وحدها
المسؤولة؛ إذْ ثمة سوابق كثيرة لا تضرب بجذورها إلا في التربة ذاتها
التي تختصر أزمات النظام الرأسمالي المعاصر.
هذه هي أمريكا المعاصرة، ما قبل ترامب وما بعده أيضاً؛ وتكفي متابعة
أعمار الجموع التي اقتحمت مبني الكابيتول كي يدرك الناظر أنّ هستيريا
الأمريكي السبعيني كانت تكمل سعار الأمريكي العشريني أو الثلاثيني؛ وما
بينهما نساء عجائز ونساء صبايا، سواء بسواء. والسؤال بذلك بسيط مشروع:
أين ينتهي الحلم وتبدأ الديمقراطية، أم العكس؟ وبالأحرى: بعد اقتحام
الكابيتول، مَن يجبّ الترامبية؟
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
بايدن والمحافظون الجدد:
عود على بدء؟
صبحي حديدي
ثمة فرضية واسعة الانتشار في أوساط اليسار الأمريكي بصفة خاصة، ترافقت
مع صعود نجم جو بايدن وتكريسه كمرشح للحزب الديمقراطي؛ مفادها أنه، على
نقيض المنطق المألوف للانقسامات الإيديولوجية الأمريكية، الشخصية
المفضلة لدى «مؤسسة الأمن القومي» لأطوار ما بعد دونالد ترامب. وهو،
استطراداً، الحاضنة الأكثر ملاءمة لما تبقى من شخوص وتنظيرات تيار عريض
بالغ التأثير عُرف في زمن جورج بوش الابن وغزو العراق تحت مسمى
«المحافظين الجدد».
ويذكّرنا جيمي سكاهيل، صحافي التحقيقات المتميز ورئيس تحرير الموقع
الإخباري الهامّ
Intercept،
أنّ رحيل ترامب سوف يجرّد تيارات اليمين العنصرية المختلفة من حليف كان
يتربع على هرم القرار الأعلى في الولايات المتحدة، وأنّ عدداً غير قليل
من سياسات ترامب التي تدغدغ تلك التيارات سوف تتبدّل على نحو أو آخر في
عهد بايدن. كلّ هذا صحيح، ولكن ما يتوجب أن يبقى في الذهن هو أنّ
انتصار الديمقراطيين تحقق بسبب أرقام الوفيات المرعبة جراء جائحة كوفيد
ــ 19 وإدارة ترامب الإجرامية، ولم يتحقق بسبب حماس الناخبين لسياسات
بايدن وأفكاره أو سجّله في الوظيفة العامة على مدار نصف قرن: «بالنسبة
إلى ملايين الناخبين، لم يكن الخيار بين بايدن وترامب، بل كان تصويتاً
على ترامب، واسم بايدن على ورقة الاقتراع كان بمثابة لا رافضة».
لسنا، في المقابل، بحاجة إلى مَنْ يذكّرنا بأن أكثر من 73 مليون ناخب
أمريكي صوتوا من أجل إبقاء ترامب أربع سنوات إضافية في البيت الأبيض،
رغم معرفتهم بفساد إدارته وعجز سياساتها والتدبير الخطيرة التي
اتخذتها، فضلاً عن تشجيع العنف والتيارات العنصرية والكراهية والتفرقة
الاجتماعية والإثنية؛ وأنّ الحزب الجمهوري كان، في المقابل، مجرّد صدى
يردد أقوال ترامب من دون أيّ وفاء للحدّ الأدنى من القيم التي يرفعها
الحزب ويتفاخر بها. الفارق بين بوش الابن وترامب ينحصر، حسب يقين
سكاهيل، في أنّ الأوّل سعى إلى جعل الحزب غطاء أو ستاراً أو مرجعية
عامة، واكتفى الثاني بتحويل الحزب إلى جمهرة من النوّاب وأعضاء مجلس
الشيوخ المصفقين الراضخين الخانعين.
تيار المحافظين الجدد لم يجد في حماقات ترامب ما يشفي غليله، ونفر من مقدار الشعبوية التي اكتنفت التنظير والتبشير قبل السياسة والاقتصاد، والأرجح أنه انتظر عوداً على بدء في شخص بايدن كما يراهن مراقبون كثر
الأسابيع القليلة المقبلة سوف تضع هذه الفرضية، وسواها من آراء تسير
على المنوال ذاته، أمام محكّ السياسات الفعلية في ميادين عديدة لعلّ
قضايا الشرق الأوسط سوف تكون في طليعتها. ونعرف، سلفاً في الواقع، أنّ
رهط المحافظين الجدد، الذين سوف يلتفون حول بايدن من زاوية دفعه إلى
إحياء النظرية القديمة بصدد فرض الديمقراطية على شعوب الشرق الأوسط عن
طريق القوّة إذا اقتضى الأمر؛ لن يتنازلوا عن قاعدة أخرى مقترنة بهذا
الخيار، أي «الغسل الثقافي» لتلك الديمقراطية المصدّرة، على صعيد
التراثات والأديان والعقائد، بما يكفل تطهيرها من سلسلة «أدران
تاريخية» خلقت نزوعات العداء للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب عموماً.
في عبارة أخرى، جرت على لسان كبار المحافظين الجدد: إذا توجّب أن تبلغ
بلدانُ الشرق الأوسط مستوى في الديمقراطية متقدّماً ومقبولاً ومعترفاً
به في الغرب، فإنّ على صندوق الاقتراع ألا يمثّل قناعات المقترعين
الفعلية، بل تلك التي تتناسب مع القناعات التي يقبل بها «العالم الحرّ»
و»المجتمع الدولي»، تحديداً وحصراً!
وهكذا فإنهم، من جديد وعلى منوال القديم، سوف يطالبوننا بأن نعيش مرحلة
الـ»ما بعد» في كلّ شيء، وعلى طول الخطّ: ما بعد الحداثة، ما بعد
المجتمع الصناعي، ما بعد الحرب الباردة، ما بعد الإيديولوجيا، ما بعد
الشيوعية، ما بعد التاريخ، ما بعد السياسة، ما بعد «القاعدة» و»داعش»
وأسامة بن لادن و»الخليفة البغدادي»… وتلك حال يتوجب أن تبدو أقرب إلى
عالم أحادي تماثل وتشابه وتعاقب على ذاته ومن أجل ذاته، حتى بات من
المحال ــ وربما من المحرج ــ الحديث عمّا هو سابق لهذا الراهن وذاك
اللاحق، عن الـ»ما قبل» أياً كانت الظواهر التي سبقته. كأنّ كل شيء حدث
لتوّه، كما يستغرب الباحث الأمريكي دافيد غريس في كتابه المثير «دراما
الهوية الغربية»: العالم يخلع أرديته واحدة تلو الأخرى، من العقلانية
والرومانتيكية والثورية، إلى تلك الرجعية والوثنية والمحافظة، مروراً
بالليبرالية والرأسمالية والاشتراكية والشيوعية.
ولكن، أليس من المشروع إعادة طرح التساؤل القديم، الذي حرّض عليه أقطاب
المحافظين الجدد من أمثال كوندوليزا رايس، ديك شيني، إرفنغ كريستول،
ريشارد بيرل، بول ولفوفيتز، دوغلاس فيث، ودافيد ورمستر: ألا يصحّ أنّ
هذه الديمقراطية المستجلبة، أو أشباهها من ديمقراطيات مفروضة قسراً
بفعل الشرط العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي الخارجي، هي
بدورها حاضنة شروخات مجتمعية مستندة إلى انحيازات إثنية ومذهبية
وطائفية وعشائرية؟ ألا يجوز الافتراض بأنها، أو كأنها، استعادة/ طبق
الأصل لكلّ أحقاب الـ»ما قبل» في السرديات الكبرى للحضارة الغربية، من
اليونان القديم، إلى روما القديمة، إلى رحلة كريستوفر كولومبوس، إلى
عصر الأنوار والحداثة؟
ومن جانب آخر، وحين تقترن هذه المشاهد بما يشبه إصرار الغرب على
استحالة المطابقة بين ديمقراطية صندوق الاقتراع وحرّية اليقين الشخصي،
ألسنا نشهد اهتزازاً عميقاً في الرؤية الراسخة التي اعتنقها وبشّر بها
الغرب معظم القرن الماضي، أو قبله بعقود كذلك؟ ألم تنهض تلك الرؤية على
ثلاثة أقانيم جوهرية: الرأسمالية واقتصاد السوق، وحقوق الإنسان كما
تقترن وجوباً بالشكل الليبرالي (الغربي ــ الأمريكي) من الديمقراطية
العلمانية، وإطار الأمّة ــ الدولة كصيغة هوية معتمدة في العلاقات
الدولية؟
وهذه الأقانيم بالذات، الم تكن تكتسي بهيئة مختلفة تماماً حين يتعلق
الأمر بمجتمعات وثقافات العالم غير الغربي، أو هي كانت تأخذ أكثر من
صيغة توتّر وتناقض مع أية مجموعة من القيم غير الغربية، الأمر الذي ظلّ
يفتح باب الاجتهاد حول تصارع حضاري ــ ديني، على طريقة صمويل هنتنغتون؛
أو توتّر هيلليني ــ آسيوي، على طريقة برنارد لويس؛ أو ولادة
«الأيديولوجية التالية»، على طريقة غراهام فوللر؟ ألم تنجلِ الأقانيم
ذاتها عن هيئة مختلفة حتى في قلب أوروبا، على مبعدة أمتار قليلة من
قواعد الحلف الأطلسي، في البلقان الدامي دون سواه؟
فوللر، من جانبه/ لا يغفل الإشارة إلى التهديد الذي تتعرض له الثقافات
الوطنية بفعل التعميم القسري للقِيَم الغربية، بوسائط تبادل لا قِبَل
لتلك المجتمعات بمقاومتها، مثل ذلك التصدير الأخطبوطي الجبّار للسلعة
الثقافية (الكتاب والفيلم والأغنية ونوع الطعام واللباس والدواء)؛
وصناعة الرمز الثقافي الأعلى الأشبه بالأسطورة في ذلك كله (بحيث تتحوّل
شطيرة الـ»بيغ ماك» إلى رمز للجبروت الأمريكي السياسي والاقتصادي
والعسكري، ليس في بلدان مثل الهند وماليزيا ومصر فحسب، بل حتى في بلد
مثل فرنسا أيضاً). ونتذكّر في هذا الصدد أنّ صدام الحضارات، كما شخّصه
هنتنغتون في البدء، لا يدور بين يسوع ومحمد وكونفوشيوس، بل حول التبادل
غير المتكافىء للقوّة والثروة والنفوذ، وتهميش الأطراف لصالح المركز
(الغربي بالضرورة) وتحويل الثقافة إلى وسيط للتعبير عن الأزمة بدل أن
تكون سبباً فيها.
الثابت، في خلاصة القول، أنّ تيار المحافظين الجدد لم يجد في حماقات
ترامب ما يشفي غليله، ونفر من مقدار الشعبوية التي اكتنفت التنظير
والتبشير قبل السياسة والاقتصاد، والأرجح أنه انتظر عوداً على بدء؛ في
شخص بايدن كما يراهن مراقبون كثر، ولا عزاء للمراهنين في العالم العربي
على تحولات ملموسة لخيارات البيت الأبيض المقبلة، فكيف بانعطافات كبرى
فارقة.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
عشر سنوات على البوعزيزي:
أية معرفة وأيّ دروس؟
صبحي حديدي
احتفت الصحافة الغربية يوم أمس، 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010، بالذكرى
العاشرة لانطلاق «الربيع العربي» حين أقدم المواطن التونسي محمد
البوعزيزي بإضرام النار في جسده احتجاجاً على امتهان كرامته من جانب
شرطية تونسية منعته من ممارسة عمله. لافت، بادئ ذي بدء، أنّ معظم وسائل
الإعلام الغربية التي احتفت بـ»الربيع العربي» انطلقت من ذكرى
البوعزيزي هذه، وليس من تاريخ هرب دكتاتور تونس زين العابدين بن علي
يوم 14 كانون الثاني (يناير) 2011؛ وقد ينطوي هذا على دلالة مختلفة
تخصّ ذلك النسق من الحراك الشعبي الاحتجاجي، أي إضرام النار في الجسد،
وليس النسق الآخر الذي يخصّ انهيار النظام ابتداء من رأسه وذروة الهرم
في بنيته.
طريف أنّ غالبية الكتّاب المحتفين بالمناسبة في وسائل إعلام فرنسية
وبريطانية وأمريكية وقعوا، من دون اتفاق مسبق كما يقول المنطق البسيط،
في حيرة لجهة تحديد التسمية اللائقة بتلك الانطلاقة؛ على غرار تساؤل
يومية الـ»فيغارو» الفرنسية: أكان الحدث، في نهاية المطاف، خلاصة «ربيع
عربي» أم «خريف إسلامي» أم «شتاء جهادي»؟ وما معنى أن تكون تونس هي
الاستثناء الوحيد، مقابل ليبيا وسوريا واليمن؟ وما دلالة الوقائع (إذْ
يعزّعلى الصحيفة إيجاد تسمية محددة، مثل الانتفاضة أو الثورة) في
السودان والعراق والجزائر ولبنان؟ وهل يصحّ القول إنّ «الإسلاموية»
(التعبير الرائج في فرنسا هذه الأيام) أسلمت أقدارها إلى «الجهادوية»
وما دلالة أنّ شرائح واسعة في الشارع الشعبي العريض ما تزال مستعدة
لممارسة الاحتجاج والاعتصام والاعتراض؟
كان أمراً طبيعياً ألا تُطرح الأسئلة بشفافية الحدّ الأدنى، بل يجري تحويرها بما يقوّي حجة القائلين بأنّ الربيع انقلب إلى شتاء أو خريف؛ ولكن، أيضاً، كي تُجرّد انتفاضات العرب من أغراضها الشعبية الكبرى، في الكرامة والحرية والمساواة
أسبوعية الـ«إيكونوميست» البريطانية اختارت مستوى تحليل أكثر رصانة، أو
بالأحرى أكثر انسجاماً مع عراقة الخطّ الليبرالي، أو النيو ـ ليبرالي
بين حين وآخر، الذي تنتهجه الدورية العريقة. «التاريخ ليس خطياً.
الثورات تفشل، ويحدث أحياناً أن ينتصر الأشرار. لا سبب يدعو إلى توقّع
أن تسفر الجولة المقبلة من انتفاضات العرب عن نتائج أكثر مدعاة
للسعادة. وعلى المنوال ذاته، مع ذلك، لا سبب يدعو إلى تصديق
الأوتوقراطيين حين يزعمون أنهم أكثر قدرة على منعها». هكذا يكتب تحرير
الـ»إيكونوميست» في التقديم لملفّ بعنوان «قبل عقد من الزمان انتفض
العرب. فلماذا لم تتحسن الأمور؟» بين الأمثلة على مناورات مستبدّي
«الربيع العربي» تتوقف الأسبوعية البريطانية عند نموذج بشار الأسد:
«لقد أقنع الكثير من أنصاره بأنّ الانتفاضة السورية هي من فعل
المتطرفين. ولم يكن هذا رجماً بالغيب بل كان نبوءة مخططاً لها ذاتياً:
إفراج عن جهاديين كفاية من السجون، وتصفية ما يكفي من المعتدلين،
وتجويع الشعب زمناً كافياً ضرورياً، ولن يطول الوقت حتى تصبح الحركة
السلمية جذرية متشددة».
فماذا عن سؤال الملفّ الأساس، أي لماذا اتخذت الأمور هذا المنحى في
نهاية المطاف؟ لن يفاجئك خطّ التحليل الذي تعتمده الصحيفة الفرنسية
اليمينية، لأنه ببساطة يتراوح بين التساؤل عن قابلية العرب (الإسلام
ضمناً، غنيّ عن القول) لاعتناق الديمقراطية، شعوباً وأنظمة؛ وبين ردّ
الحال إلى مزيج من تحالفات ضمنية بين الاستبداد و»الإسلاموية»
و»الجهادوية». الأسبوعية البريطانية لا تركن إلى السطوح هذه، فتساجل
بأنه لا إجابة على سؤال مسار الخطأ لدى بلدان دون أخرى: «يمكن إلقاء
اللوم على قوى خارجية، من إيران إلى روسيا إلى غرب عاجز غير متسق. يمكن
لوم الإسلاميين، الذين زرعوا التفرقة غالباً في سياق جشعهم إلى السلطة.
وأكثر من هؤلاء وهؤلاء، يتوجب لوم الرجال الذين حكموا الدول العربية
بعد أن نالت استقلالها في القرن العشرين. ورغم أنّ بعضهم فهم شيئاً ما
عن الديمقراطية، فإنّ الأمر اقتضى ما هو أبعد من مجرّد الانتخابات».
الـ»فيغارو» و الـ»إيكونوميست» مجرّد نموذجين بالطبع، وثمة عشرات
الأمثلة الأخرى خاصة في ميادين أكاديمية وعلى صعيد الدراسات والأبحاث
الأكثر التزاماً بمعايير صارمة في القراءة والتحليل والاستنباط. مؤسف،
مع ذلك، وفي يقين هذه السطور على الأقلّ، أنّ الحصيلة الإجمالية لا
تبدو متقدمة بما يكفي عن الحال التي كان عليها المشهد التحليلي الغربي
ساعة احتراق بدن البوعزيزي وانطلاق الحناجر بالهتاف غير المسبوق:
«الشعب يريد إسقاط النظام!». يومذاك توفّر العشرات من أهل الكيل بعشرات
المكاييل، ممّن كانوا هم أنفسهم نفر المراقبين ـ والمحللين والأخصائيين
والمستشارين… أو فقهاء علوم الشرق الأوسط، باختصار ـ الذين رحبوا
بـ»هبوب رياح الديمقراطية» على المنطقة؛ واستسهلوا تسمية ربيع (جاء في
أواخر الخريف، مطلع الشتاء عملياً!) مستمدّ من بطون رطانة اصطلاحية
غربية لا تعبأ باختلاط حابل بنابل.
وكان أمراً طبيعياً، وتلقائياً، ألا تُطرح الأسئلة بشفافية الحدّ
الأدنى، بل يجري ليّها وتحويرها بما يقوّي حجة القائلين بأنّ الربيع
انقلب إلى شتاء أو خريف (على هدي ما تفعل الـ»فيغارو» اليوم!)؛ ولكن،
أيضاً، كي تُجرّد انتفاضات العرب من أغراضها الشعبية الكبرى، في
الكرامة والحرية والمساواة، وتُسحب إلى حيثيات أخرى تَرفع، هنا أيضاً،
راية حقّ لا يُراد منها إلا الباطل. توماس فريدمان، المعلّق الشهير في
«نيويورك تايمز» كتب مقالة بعنوان «الربيع العربي الآخر» بدأها بافتراض
أنّ البوعزيزي أحرق نفسه وسط مناخات ارتفاع أسعار المواد الغذائية
عالمياً؛ وأتبعها بأنّ الفلاحين، في محافظة درعا السورية، ثاروا على
النظام بسبب منعهم من بيع أراضيهم المحاذية للحدود مع الأردن!
وفي فرنسا، بمزيج من السخرية والاستهجان، هتف أوليفييه روا، أحد كبار
الأخصائيين في شؤون الإسلام والشرق الأوسط: «ما الذي دهاكم! هل نبدأ من
جديد؟ صدام الحضارات، وسخط المسلمين، والعالم المسلم الذي يلتهب، وعجز
الإسلام عن قبول الروح النقدية وحرّية التفكير؟»… والرجل، الذي استهلّ
«الربيع العربي» بتوبيخ زاعمي معرفة الإسلام والمسلمين، بمقالة شهيرة
لاذعة عنوانها «ليست ثورة إسلامية»؛ ناشد الناس ألا يجرّموا «الربيع
العربي» اتكاء على أعمال عنف هنا وهناك ضدّ فيلم أو رسوم كاريكاتورية.
صحيح أنها لم تلجأ إلى هذا المستوى من العنف، ولكن ألم تتظاهر جماهير
مسيحية في الغرب، وعلى نحو عنيف أحياناً، ضدّ «الإغواء الأخير للمسيح»
شريط مارتن سكورسيزي، سنة 1988؟ ألم تضغط الكنيسة الكاثوليكية، وإنْ
بطرائق أقلّ صخباً وأكثر فاعلية، ضدّ ملصقات «نزهة الجلجلة» شريط
رودريغو غارسيا، سنة 2011، سأل روا؟
فإذا انتقل المرء إلى الساسة، وأهل الصفّ الأوّل بينهم، توفرت تلك
الخديعة الكبرى، التي انخرط فيها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش
الابن، وكبار مساعديه، وبعض رجالات الصفّ الأوّل من «المحافظين الجدد»؛
والتي سُمّيت «نقل فيروس الديمقراطية إلى العرب» من خلال احتلال
العراق، وإقامة نظام ديمقراطي غير مسبوق، ثمّ تصديره إلى الجوار بطريق
الإغواء أو القسر. خَلَفه، باراك أوباما، تابع نهج السلف مع إضافة
«مسحة أسلوبية» شخصية، هي مداهنة المسلمين (في خطبتَيه أمام البرلمان
التركي ومن جامعة القاهرة) علانية؛ والإمعان أكثر فأكثر في تخريب
العلاقات مع العالم المسلم من خلال سياسات الانحياز المطلق لدولة
الاحتلال الإسرائيلي، ومراقصة الطغاة، وتعليق الأمل على نواياهم
«الإصلاحية» حتى ربع الساعة الأخير قبيل سقوطهم (المرء يتذكّر مدائح
هيلاري كلنتون، لأمثال زين العابدين بن علي وحسني مبارك وعلي عبد الله
صالح، وحتى بشار الأسد نفسه).
عشر سنوات على البوعزيزي علّمت الشعوب الكثير، أغلب الظنّ، ولكن لا
يلوح أنها أضافت إلى معارف النطاسيين في الغرب إلا القليل، وفي مستوى
السطوح وحدها.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
السيسي الباريسي:
عندما يخجل أحفاد الثورة الفرنسية
صبحي حديدي
لم يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيّ حرج في رفض مناشدات عشرات
منظمات حقوق الإنسان العالمية، حول بسط السجادة الحمراء لرئيس النظام
المصري عبد الفتاح السيسي؛ كما لم يجد غضاضة في الإعلان عن معارضته
الربط بين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها أجهزة الأمن
المصرية، وصفقات الأسلحة الفرنسية إلى مصر، رغم أنّ صنوفاً منها لا
تُهرّب إلى الماريشال الليبي الانقلابي خليفة حفتر فحسب، بل تُستخدم
أيضاً ضدّ أبناء الشعب المصري في المدن والبلدات والقرى خلال
الاحتجاجات السلمية.
الذريعة المتوفرة، سواء أعلنتها باريس والقاهرة أم سرّبتها أوساط
النظام المصري بصفة حصرية، هي تطابق المصالح حول مواقف البلدين من
ملفات ليبيا، أو مواجهة السياسات التركية في شرق المتوسط في مستويات
مختلفة لا تقتصر على التنقيب عن النفط والغاز بل تشمل اختراق النفوذ
الفرنسي المتوسطي؛ فضلاً عن تناغم عجيب بعض الشيء، اتفقت باريس
والقاهرة على تسميته “محاربة الإسلاموية”! وضمن قواعد السياسة الواقعية
البراغماتية، أو الـ
Realpolitik
حسب التعبير الكلاسيكي الشائع، لا يبدو هذا التناغم عجيباً أو شاذاً أو
غير مسبوق؛ بل لعله تطبيق القاعدة على أوضح صورها إفصاحاً عن محتوى
التعاطي السياسي أو الدبلوماسي أو الأمني أو العسكري أو التجاري.
طريف، في المقابل، أنّ ماكرون خجل من استقدام العدسات والمراسلين
الفرنسيين إلى حفل احتضنه قصر الإليزيه في ختام زيارة السيسي، وشهد منح
الأخير أرفع أوسمة الشرف الفرنسية؛ الذي، للمفارقة غير الخافية، كان
غازي مصر نابليون بونابرت قد استحدثه قبل 218 سنة. صور الاحتفال تسربت
عن طريق الوفد المصري الذي كان من الطبيعي ألا يخجل من نشرها وأن
يُحتفى بها أيما احتفاء على موقع الرئاسة المصرية. وهو حياء تسلل أيضاً
إلى الفريق الإعلامي لعمدة بلدية باريس، السيدة آن هيدالغو، التي أعربت
عن التطلع إلى مشاريع مشتركة في قطاعات الثقافة والخدمات؛ وإن كانت
تناست تماماً تظاهرات أكثر من 20 منظمة حقوقية وهتافاتها ضدّ الاحتفاء
بجنرال مستبدّ وانقلابي يسرح ويمرح في عاصمة الثورة الفرنسية وبلد حقوق
الإنسان.
والحال أنّ أحفاد الثورة الفرنسية الذين استقبلوا السيسي ليسوا أوائل
في هذا المضمار، إذْ سبق أن فعلها الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك مع
دكتاتور سوريا بشار الأسد، وفعلها رئيس أسبق آخر هو نيكولا ساركوزي مع
الأسد والقذافي وحسني مبارك حين وضعهم على منصة الشرف المكرسة للاحتفال
بالثورة الفرنسية. وحين تجاوز الأسد كلّ “خطّ أحمر” ممكن، فخجل ماكرون
من وسام شرف مماثل كان شيراك قد علّقه على صدر الأسد الابن، وارتأى سحب
الوسام؛ سارع الأسد إلى استباق الدراما ونزع الوسام بنفسه فلم يكن بذلك
يردّ البضاعة إلى أهلها بل يعلن أنها أصلاً زائدة عن حاجة نظامه وحاجته
شخصياً.
وليت الأمر يقتصر على الساسة الأفراد، لأنه في الواقع يمتدّ أيضاً إلى
مؤسسات الجمهورية الخامسة وعلى رأسها الجمعية الوطنية، أي البرلمان،
الذي سبق أن أقرّ مشروع قانون يحظر على المحاكم الفرنسية قبول دعاوى
ضدّ مجرمي الحرب، إلا إذا كانوا يحملون الجنسية الفرنسية، أو كانت
الجرائم المنسوبة إليهم قد ارتُكبت على الأراضي الفرنسية. وكان هذا
القانون مدعاة خزي صريح وفاضح، وشكّل ارتداداً عن تشريعات فرنسية
سابقة، كما تناقض مع القوانين المعمول بها في معظم الدول الأوروبية.
ومن المأساوي أن تكون فرنسا، بلد حقوق الإنسان، هي الملاذ الآمن لأصناف
شتى من الطغاة والقتلة والجلادين ومصاصي دماء الشعوب.
خجل أحفاد الثورة الفرنسية لا يغطّي، بأية حال، مقادير العار التي تجلل
سياسات لا تخون الشعوب وحدها، بل تطعن إرث الثورة ذاتها، وكامل تراث
حقوق الإنسان؛ وكلّ هذا رغم أنّ الحصاد هزيل في نهاية المطاف، والحصيلة
مخجلة عجفاء.
الجولان المحتل يقاوم ونظام
الأسد لا عين رأت ولا أذن سمعت
صبحي حديدي
يخوض أبناء الجولان السوري المحتل معركة أخرى جديدة ضدّ دولة الاحتلال
الإسرائيلي، مشرّفة وملحمية رغم المقدار الهائل من انعدام التكافؤ أمام
قوى الاحتلال العسكرية والأمنية والقضائية، واختلال ميزان الأدوات
النضالية التي تتيح الصمود والتصميم وتسجيل انتصار معنوي تارة أو نقلة
فارقة في روحية وأسلوب المقاومة تارة أخرى. المعركة الجديدة تحمل اسم
«توربينات الرياح» نسبة إلى مشروع شركة الطاقة الإسرائيلية «إنرجكس»
المدعوم تماماً من سلطات الاحتلال، بزرع 32 مروحية بارتفاع 200 إلى 220
متراً في قلب الأراضي الزراعية لسكان الجولان، التي تُزرع فيها منذ
أزمنة سحيقة أشجار التفاح والكرز واللوز. ورغم وجود مستوطنات إسرائيلية
في مرتفعات الجولان، فإنّ شركة «إنرجكس» أبعدت التوربينات عن أراضي تلك
المستوطنات وجنّبتها بالتالي الأضرار البيئية والزراعية والطبيعية
والصحية كي تحمّلها على قرى الجولانيين السوريين الأربع الكبرى، في
مجدل شمس وبقعاثا وعين قنيا ومسعدة.
يقف في وجه هذا المشروع، وعلى أصعدة قانونية وإعلامية وسياسية، عدد من
منظمات حقوق الإنسان السورية أو الفلسطينية وبعض الإسرائيلية أيضاً؛
خاصة «المرصد ـ المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان» والذي يواصل
خوض معركة قانوية شرسة مع «إنرجكس» وذلك في أعقاب إصدار تقريره «في
مهبّ الريح» حول الآثار المدمّرة لمشروع توربينات الرياح على حياة
السكّان السوريّين، والتبعات الخطيرة على صحّتهم وسلامتهم. وكان المرصد
قد سجّل جملة مخاطر، في طليعتها أنّ المزارعين الذين يقضون معظم
أوقاتهم في العمل، وعموم السكّان الذين يمكثون أوقاتاً طويلة في
الأراضي الزراعيّة المجاورة، حيث تنتشر عشرات المنازل الصغيرة، سوف
يكونون الأكثر عُرضة للأذى. متوقّع، كذلك، أن يتقلّص استخدام المزارعين
السوريّين لمئات الدونمات من أراضيهم الزراعيّة التي تنتج محاصيل
التفاح والكرز منذ عشرات السنين، والتي تشكّل ما يقارب ربع أراضيهم
الزراعيّة. هذا إلى جانب حقيقة أنّ إقامة المشروع سوف تسفر عن تقييد
التوسّع العمرانيّ للقرى الواقعة تحت الاحتلال، مما سيُفاقم أزمة السكن
الخانقة فيها. كلّ هذا عدا التشوهات البنيوية التي ستصيب الاقتصاد
والسياحة الزراعيّة والتقاليد الزراعيّة عموماً، وتعريض الحياة البريّة
للخطر، وتحديداً الطيور المحليّة والمهاجرة؛ ما يعني أن هذه الأضرار
ستطال السكّان والزراعة والبيئة سواء بسواء.
وقد أصدرت 17 منظمة حقوقية بياناً مشتركاً أدانت فيه خطط زرع
التوربينات، وأكدت أنّ «هذا المشروع الخطير يشكل خطراً وجودياً على
سكان الجولان السوريين والسوريات، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال الاقتصادي
للجولان على نحو مخالف لحقّ الانتفاع المنصوص عليه في المادة 55 من
اتفاقيّة لاهاي الرابعة المتعلّقة بقواعد وأعراف الحرب البريّة لعام
1907». كذلك طالب البيان دولة الاحتلال، بصفتها السلطة المحتلة
القائمة، بأن تلتزم بالقانون الدولي وتوقف هذا المشروع، وكافة أنشطة
التوسع الاستيطاني، وتمتنع عن إحداث أية تغييرات في الجولان المحتل،
إلا في الحالات التي تخدم أمن ورفاه السكان السوريين، داعين إلى
الامتناع عن استغلال جائحة كوفيد-19 من أجل تمرير هذا المشروع وفرضه
كأمر واقع. كما شدّد بيان الجمعيات على ضرورة احترم حقّ السكان
السوريين في تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية،
بموجب القانون الدولي، وأن تتوقف سلطات الاحتلال عن إصدار تراخيص
لاستغلال الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل، وأن توقف أنشطة
الشركات التجارية الإسرائيلية والمتعددة الجنسيات العاملة فيه، لضمان
احترام المعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان، والحصول على موافقة
السكان السوريين قبل الانخراط في أية مشاريع تستخرج موارد الجولان
الطبيعية.
موقف النظام ليس أضعف الإيمان فقط، بل حال نظام لا عين فيه رأت ولا أذن سمعت بنضالات أبناء الجولان طوال 53 سنة، وهو في واقع الأمر أقصى ما يمكن أن يصدر عن نظام وريث حافظ الأسد، وزير «الدفاع» سنة سقوط الجولان المنيع في يد الاحتلال الإسرائيلي.
ومؤخراً توغل مبعوثو شركة «إنرجكس» في عمق الأراضي الزراعية التابعة
لسكّان الجولان، تحت حماية مباشرة تولتها أعداد كبيرة من قوّات شرطة
الاحتلال ووحدات القوّات الخاصّة، التي لجأت إلى إغلاق الطرقات
المؤدّية إلى أراضي قرابة ألف مزارع سوريّ، لتمكين الشركة من مباشرة
أعمالها في التجهيز للبدء بتنفيذ مشروع توربينات الرياح. وهكذا أقدمت
شرطة الاحتلال على إغلاق الطرق المؤدّية إلى تلك لأراضي الزراعية،
ومنعت الاقتراب من المكان. ولقد احتشد المئات من أبناء الجولان
للاحتجاج على هذه الممارسات وللتأكيد مجدداً على أنّ الاعتراض على هذا
المشروع التدميري ما زال يحظى بإجماع واسع النطاق في صفوف سوريي
الجولان المحتل.
ورأى «المرصد» أنّ قيام شرطة الاحتلال بتأمين الغطاء للشركة، بحجَّة
فحص التربة في أربع قطع من الأراضي، وبدون إبراز أمر قضائيّ بذلك، ومنع
عشرات المزارعين من الوصول لأراضيهم الذي قد يمتد لعدة أيام، فيما يشبه
العقاب الجماعي، واستخدام الكاميرات المحمّلة على طائرات مسيّرة عن
بعد، هو «انتهاك صارخ لحقوق سكّان الجولان، وترهيب مُمنهج من خلال
استقدام المئات من أفراد الشرطة ووحدات القوات الخاصّة، واستعراض
القوّة، ووضعهم قُبالة السكّان المدنيّين الذين يمارسون حقّهم
بالاعتراض السلمي على مشاريع الاحتلال».
وإذْ تتضامن مع حقوق الجولانيين السوريين منظمات حقوقية مثل «الفدرالية
الدولية لحقوق الإنسان» و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و«مركز
رام الله لدراسات حقوق الإنسان» إلى جانب جامعة بير زيت في فلسطين،
وجامعة كورنيل في الولايات المتحدة؛ فإنّ السؤال الذي يُطرح بقوّة،
وبحكم منطق الأمور الأبسط، هو التالي: أين النظام السوري، الذي لم
يسلّم الجولان على نحو طوعي منذ حرب 1967 فحسب، بل لم يتوقف عن التكاذب
بخصوص «الممانعة» و«المقاومة»؟ الإجابة يختصرها بيان وزارة الخارجية
والمغتربين الذي أدان «الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة
والممنهجة لحقوق السكان العرب السوريين في الجولان السوري المحتل». ولم
يفت البيان اقتباس «مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين في سوريا» لجهة
تأكيدها «الوقوف مع أهالي الجولان السوري المحتل، والوقوف خلف القيادة
السورية والجيش العربي السوري لاسترجاع كل شبر من أرض الجولان العربي
السوري المحتل».
والحال أنّ هذا ليس موقف أضعف الإيمان فقط، بل حال نظام لا عين فيه رأت
ولا أذن سمعت بنضالات أبناء الجولان طوال 53 سنة، وهو في واقع الأمر
أقصى ما يمكن أن يصدر عن نظام وريث حافظ الأسد، وزير «الدفاع» سنة سقوط
الجولان المنيع في يد الاحتلال الإسرائيلي. ولعلّ مراسل صحيفة حزب
البعث تناسى، إذْ كيف له أن ينسى حقاً، موقف بشار الأسد الشهير حيال
المقاومة الشعبية السورية في الجولان المحتل، خلال حوار شهير مع
الإعلامي المصري حمدي قنديل. يطرح الأخير السؤال التالي: «أليس في
سوريا غيرة أن حزب الله حقق ما حققه وأن كل السوريين يجب أن تكون لديهم
الغيرة أننا لم نستطع أن نحرر الجولان حتى تاريخه بأي وسيلة سواء كان
بالجيش أم بالمقاومة؟» ويجيب الأسد: «قلتُ إن تحرير الجولان بأيدينا
وبعزيمتنا. لكن هذه العزيمة بالنسبة لنا كدولة تأخذ الاتجاه السياسي
وتأخذ الاتجاه العسكري. كما قلت بالعودة لموضوع المقاومة هو قرار شعبي
لا تستطيع أن تقول دولة ما. نعم. سنذهب باتجاه المقاومة. هذا كلام غير
منطقي. الشعب يتحرك للمقاومة بمعزل عن دولته عندما يقرر هذا الشيء».
وهو تحرّك ويتحرك بالفعل، ليس بمعزل عن «دولته» فقط، بل كذلك لأنّ تلك
«الدولة» تخوض حروبها ضدّ الشعب في الداخل السوري، بعد أن أسلمت
المقادير لاحتلالات إيرانية وروسية وأمريكية وتركية انضمت إلى الاحتلال
الإسرائيلي. فكيف، والحال هذه، لا تقف مشيخية العقل خلف جيش انسحب من
الجولان المحتل ليستدير تماماً نحو درعا وحمص وحماة وحلب ودير الزور!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
ترامب التالي: من محفة
كاليغولا إلى قيثار نيرون
صبحي حديدي
حوليات التاريخ الغربي، العسكري والسياسي والإمبراطوري على وجوه أخص،
وحوليات التاريخ الروماني القديم بصفة خاصة، تحفل بحفنة غير قليلة من
أباطرة جمعوا الطموح الشخصي المفرط، إلى هذا المستوى أو ذاك من مظاهر
الهستيريا وجنون العظمة وبُغْض الديمقراطية. في طليعة هؤلاء، كما يًجمع
المِؤرخ البريطاني الراحل شون لانغ، يعثر المرء على أمثال تايبيريوس
(14ـ37 م)، غايوس كاليغولا (37ـ41)، نيرون (45ـ68)، كومودوس (180ـ192)…
وقد تعترض غالبية من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهبة ولايته، دونالد
ترامب، على تمثيلات يمكن أن تضعه في لائحة عنوان هذا العمود، بالنظر
إلى أن أمريكا الراهنة ليست روما القديمة (وهذه مسألة فيها نظر، غنيّ
عن القول)؛ أو إلى أنّ الديمقراطية الأمريكية، اليوم، ليست النظام
السياسي الذي تسيّده وقاده الأباطرة أولئك؛ أو، ثالثاً، لأنّ ترامب لم
يعطّل المنظومة، بدليل أنّ الانتخابات الرئاسية جرت في نهاية الأمر
ورغم الشكوك الكثيرة حول احتمال بلوغها برّ الأمان، ويستزيد هؤلاء من
واقع أنهم ليسوا محض أنصار للرئيس الأمريكي المنصرف بل هم جمهوره الذين
تغذوا على أفكاره: ألم يحصل ترامب على أقلّ قليلاً من 53 مليون ناخب في
التصويت الشعبي خلال انتخابات 2016، وها أنه في الانتخابات الأخيرة
يحصد ما يقلّ قليلاً عن 74 مليون صوت؟
والحال أن السهولة التي يجدها المؤرخ الغربي لجهة احتساب حفنة الأباطرة
المشار إليهم في الفقرة الأولى، ليست البتة ناجمة عن ضعف جماهيريتهم
إذْ كان العكس هو الصحيح في الواقع، أو لأنّ هذا أو ذاك بينهم لجأ إلى
ممارسات شاذة أو غير منطقية (مثل الصورة السائدة عن غايا في أنه كان
يستهوي إهانة مجلس الشيوخ (قال إنّ حصانه، إذا ترشح ذات يوم، سيكون
أفضل أعضاء المجلس)، أو خرافة لجوء نيرون إلى العزف على القيثار
مستمتعاً بمشاهدة روما تحترق)؛ بل لأسباب أخرى أشدّ تعقيداً وعمقاً
وتتصل بحُسن أو سوء تدبير شؤون السلطان الإمبراطوري، وعقلانية بعض
القرارات الفاصلة والمفصلية ذات الأثر التخريبي المباشر على حياة
الإمبراطورية وشعوبها.
ويخطر لي شخصياً أنّ ترامب ساعة مغادرة البيت الأبيض إلى مستقبل آت، قد
يقدّر أنّ أبسط خياراته أن يترشح للرئاسة في انتخابات 2024، ولكن هذا
خيار دونه خرط القتاد لأسباب عديدة سوف يبدأ أهمها من حقيقة الموقع
الذي سيحتفظ به في صفوف الحزب الجمهوري، ومدى استعداد الجمهوريين،
أعضاء عاديين أو ناخبين أو أعضاء نواب وشيوخ، في الاصطفاف المطلق خلفه
كما فعلوا طوال أربع سنوات مضت. أسباب ليست أقلّ أهمية ستنبثق من معارك
القضاء الأمريكي التي ستحيط بترامب إحاطة السوار بالمعصم، حيث لا حصانة
رئاسية هنا أو مناعة قضائية بل استشراس وإلحاح في الترصد وإحقاق قضايا
تمّ السكوت عنها أو تأجيلها بسبب سلطة سيد البيت الأبيض طوال الفترة
السابقة.
كذلك يخطر لي أن ترامب إذا غادر محفة الإمبراطور غايوس كاليغولا (الذي
أدمن إهانة مجلس الشيوخ لسبب أو بلا سبب، وأصدر أمراً إلى جنوده بطعن
الأمواج بالسيوف لأنه بذلك يهين الإله البحري نبتون)؛ فسوف يختار قيثار
كاليغولا من دون سواه، رغم أنّ الأسطورة كذبت حين نسبت إليه الحريق
والقيثار وهو منهما بريء كما يقول التاريخ الفعلي خارج الأسطورة. كان
نيرون يتلذذ بالعزف على خرائب روما، وهكذا بات ترامب بعد اتضاح نتائج
الانتخابات الأخيرة، إذْ لم يعد عنده هاجس أكثر طغياناً من إلحاق
المزيد من الخرائب في بنية الديمقراطية الأمريكية ونظامها الانتخابي
الشائخ على وجه التحديد.
ولأنّ “الحقيقة صعبة، والضحالة سهلة”، كما يستخلص الآلاف من أنصار
ترامب، فإن”رئيسهم الذي انتخبوه بحماس إنجيلي في سنة 2016، وتشبثوا
بنظرية التآمر عليه في صناديق الانتخابات سنة 2020، سوف يثبت خلال
سنوات 2021ـ 2024 أنه قادر على العودة، بعزيمة أكثر صلابة وقوّة أكثر
رسوخاً: “هل كان رونالد ريغان أو جورج بوش الابن أعلى في المستوى
الفكري من رئيسهم؟” يتساءل الغلاة من أنصاره، وفي هذا الصدد تليق بهم
إجابة واحدة: نعم، وأيم الله! كانوا، وبما لا يُقاس من الدرجات!.
آل الأسد في أرض أوباما:
ذلك الشيطان الذي نعرف!
صبحي حديدي
فور عرضه في مكتبات الولايات المتحدة وكندا، قبل ثلاثة أيام، بيعت 890
ألف نسخة من كتاب «أرض موعودة»؛ الجزء الأول من مذكرات الرئيس الأمريكي
السابق باراك أوباما في البيت الأبيض، والذي يغطي السنوات الأربع
الأولى التي أعقبت صعوده الدراماتيكي كأوّل رئيس أفرو -أمريكي في تاريخ
الولايات المتحدة. في المقابل، لمَن تعنيه المقارنات، كان كتاب زوجته
السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، «وأصبحتُ» حسب ترجمة دار هاشيت
أنطوان، قد باع 725 ألف نسخة خلال اليوم الأول لعرضه في مكتبات أمريكا
الشمالية؛ وكتاب الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون «حياتي» 2005، كان
قد باع 400 ألف نسخة؛ وأمّا كتاب زميلهما في الرئاسة جورج بوش الابن،
وصدر بعنوان «نقاط القرار» 2011، فقد باع 220 ألف نسخة.
لكنّ أوباما يسبق جميع أسلافه الرؤساء في عدد اللغات التي تُرجم إليها
كتاب «أرض موعودة» بالتزامن؛ وهي الألبانية والعربية (هاشيت أنطوان،
«الأرض الموعودة») والبلغارية والصينية والتشيكية والدانمركية
والهولندية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والعبرية
والهنغارية والإيطالية واليابانية والكورية واللثوانية والنروجية
والبولندية والبرتغالية والرومانية والإسبانية والسويدية والفييتنامية.
صحيح أنّ اللغة الروسية غائبة، حتى الساعة على الأقلّ، غير أنّ المرء
يتساءل حقاً: أيّ اللغات الكبرى غابت عنها ترجمة الكتاب! الثابت، خلف
هذه المعطيات وسواها (في انتظار أرقام المبيعات العالمية وعشرات
الملايين التي سيجنيها أوباما) أنّ الرئيس الأمريكي السابق يتمتع
بشعبية أمريكية وعالمية ليست واسعة النطاق وهائلة وغير مسبوقة، فحسب؛
بل لعلها في عداد الجماهيرية العالمية الأكثر استعصاء على التفسير،
بالنظر إلى سجلّ إنجازات أوباما على صعيد دولي.
وقد يكون الجزء الثاني المنتظَر، عن رئاسة أوباما الثانية خلال سنوات
2012 حتى 2017، أكثر غنى لجهة تبيان سلسلة من تفاصيل أمريكية ودولية
حاسمة، وذات مغزى خاصّ ومختلف في ملفات مثل صعود التيارات الشعبوية من
حول شخصية دونالد ترامب، وعودة القطبية الثنائية مع سياسات التدخل
الخارجي التي اعتمدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقضايا المناخ،
والملف النووي الإيراني، ومواقف البيت الأبيض المتغايرة إزاء
الانتفاضات العربية، وسوى ذلك. هذه السطور سوف تعرض، على نحو محدد،
موقف أوباما من الانتفاضة الشعبية السورية؛ وما إذا كان قد تبنى منهجية
متكاملة من أيّ نوع بصدد خمس سنوات على الأقلّ من عمر تلك الانتفاضة،
خاصة وأنها قد شهدت تحولات نوعية جيو ـ سياسية فارقة مثل التدخل
العسكري الإيراني والروسي المباشر إلى جانب النظام السوري، وكذلك لجوء
الأسد إلى السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية واجتياز «الخطّ الأحمر»
الشهير الذي رسمه أوباما.
في الصفحة 364 يأتي ذكر سوريا للمرة الأولى في الكتاب، ولكن ضمن حديث
أوباما عن زعماء عرب افتقروا إلى مجاراة جمال عبد الناصر في التواصل مع
الجماهير، مثل حافظ الأسد في سوريا وصدام حسين في العراق ومعمر القذافي
في ليبيا. ولسوف ننتظر حتى الصفحة 652، من أصل 768 صفحة، حتى يطلّ
أوباما على الانتفاضة السورية؛ فيقول التالي (في ترجمتنا): «اثنان من
البلدان التي شهدت العنف الأسوأ كانتا سوريا والبحرين، حيث الانقسامات
الطائفية شديدة والأقليات المتنعمة حكمت أكثريات عريضة وساخطة.
جوهر الموقف، كما تلخصه ثلاث صفحات عن سوريا في كتاب أوباما لا يخرج عن مقاربة الإدارات الأمريكية المتعاقبة، جمهورية كانت أم ديمقراطية، لنظام «الحركة التصحيحية» من الأب إلى الابن الوريث
في سوريا، آذار (مارس) 2011 كان اعتقال وتعذيب 15 تلميذاً كتبوا على
جدران المدينة شعارات معادية للحكومة قد أطلق احتجاجات رئيسية ضدّ نظام
بشار الأسد ذي الهيمنة الشيعية ـ العلوية، امتدت إلى كثير من جماعات
البلد ذات الأغلبية السنّية. وبعد أن فشل استخدام الغاز المسيل للدموع،
والضرب، والاعتقالات الجماعية في قمع التظاهرات، انتقلت أجهزة أمن
الأسد إلى شنّ عمليات عسكرية واسعة النطاق شملت مدناً كثيرة، ترافقت مع
استخدام الذخيرة الحية، والدبابات، والتفتيش من بيت إلى بيت».
ومن العجيب، بادئ ذي بدء، أنّ رئيس القوّة الكونية الأعظم، بما تمتلك
أجهزة أمريكا ومؤسساتها الأمنية والدبلوماسية المختلفة من معلومات
دقيقة وغزيرة وميدانية؛ يمكن أن يختصر انتفاضة شعبية بذلك الحجم، وعلى
مبعدة تسع سنوات من الحدث، إلى مجرّد صراع بين جماعات ذات أغلبية سنّية
وأقلية «شيعية ـ علوية»! أو قراءة نهج النظام القمعي، العنفي المطلق
منذ أبكر التظاهرات، وكذلك على امتداد 40 سنة من تراث «الحركة
التصحيحية» الدامي، بوصفه ردّ فعل على شعارات احتجاج كتبها 15 تلميذاً.
أو، قبل هذا وذاك، مجرّد عقد المقارنة بين سوريا والبحرين، بصرف النظر
عن مقادير العنف التي لجأ إليها نظام آل خليفة في المنامة، على خلفية
انقسام المجتمعَين إلى أغلبية وأقلية. الأرجح أنّ أوباما شاء اختصار
الملفّ السوري بأسره، متفادياً الغرق في مشهد معقد قد يستغرق أكثر مما
يجب من صفحات (في رأيه، أو في نظر محرّرة كتابه الأولى راشيل كلايمان).
يتابع أوباما: «صرفتُ وفريقي ساعات ونحن نصارع القرار حول كيفية تأثير
الولايات المتحدة في الأحداث داخل سوريا والبحرين. خياراتنا كانت
محدودة على نحو مؤلم. كانت سوريا خصماً للولايات المتحدة منذ أمد طويل،
حليفة تاريخياً مع روسيا وإيران، ومساندة كذلك لحزب الله. وفي غياب
الروافع الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية التي كنّا نمتلكها في مصر،
فإنّ ما قمنا به من إدانات رسمية لنظام الأسد (ثمّ فرض حصار أمريكي
لاحقاً) لم يكن له تأثير فعلي، وكان في وسع الأسد أن يعتمد على روسيا
لاستخدام الفيتو ضدّ أي مجهود لفرض عقوبات دولية عبر مجلس الأمن الدولي
في الأمم المتحدة». والحال أنّ وقائع التاريخ تقول غير ذلك، إذْ أنّ
النظام لم يكن البتة بعيداً عن المدارات الأمريكية، وتصريحات أوباما
خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت الانتفاضة شددت على مطالبة الأسد
بقيادة الإصلاح، حين كانت وحشية أجهزة النظام وجيشه هي القاعدة
الوحيدة. كان ذلك مجرّد تراشق لفظي أجوف، حول إصلاح لم يكن أيّ عاقل
ينتظره من رأس نظام توجّه سريعاً نحو ارتكاب الانتهاكات الأفظع وجرائم
الحرب الأشدّ بشاعة. وقائع التاريخ سوف تقول أكثر حول تكذيب مناقشة
أوباما للملف السوري، حين يصدر الجزء الثاني من الكتاب؛ ولعلّ في
طليعتها ما رشح عن، أو قيل صراحة بقلم أو بلسان، كلنتون نفسها، ثمّ
أمثال زميلها وزير الدفاع روبرت غيتس، ومدير المخابرات المركزية دافيد
بترايوس. كذلك سوف تكون ذات قيمة خاصة إفادة أندرو إكسوم، نائب المساعد
الأسبق في وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط خلال رئاسة باراك
أوباما الثانية، أمام لجنة فرعية في الكونغرس تبحث السياسة الخارجية
الأمريكية في الشرق الأوسط؛ والتي تناولت مفاوضات أوباما مع بوتين حول
طرائق إنقاذ نظام بشار الأسد من سقوط وشيك، صيف 2015. وإذْ يوضح إكسوم
أنه كان طرفاً في سلسلة مباحثات مستفيضة مع ضباط جيش واستخبارات روس،
بدأت في صيف 2015 واستغرقت العام 2016، حول مصير الأسد؛ يستخلص أنّ
إنقاذ نظام الأخير، وشخصه استطراداً، كان هاجساً مشتركاً لدى واشنطن
وموسكو وطهران، بالتكافل والتضامن.
جوهر الموقف، كما تلخصه حفنة سطور عن سوريا في كتاب أوباما، لا يخرج عن
مقاربة الإدارات الأمريكية المتعاقبة، جمهورية كانت أم ديمقراطية،
لنظام «الحركة التصحيحية» من الأب إلى الابن الوريث: النظام خدم
أجنداتنا، ومصالح حليفتنا إسرائيل، وغالبية أتباعنا في المنطقة، رغم
كلّ الضجيج والعجيج حول «الممانعة» و«المقاومة»؛ وهو في أقصى الحالات
ذلك «الشيطان الذي نعرف» ويظلّ استطراداً أفضل، بما لا يُقارن، مع أيّ
شيطان آت لا نعرفه تماماً.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
البرلمان الأردني الجديد:
رصاص الفرسان وخواء البرامج
صبحي حديدي
ذات صباح غير بعيد في الزمن، أواخر أيار (مايو) 2016، صوّت البرلمان الأردني بالأغلبية على حظر مساهمة الشركات الإسرائيلية في صندوق الاستثمار الأردني؛ ولكن، في مساء اليوم ذاته، عاد البرلمان وصوّت من جديد، لصالح المشاركة الإسرائيلية هذه المرّة. مثال كلاسيكي، كما يرى الكثيرون، على الدور الفعلي لمجلس النواب في آلية القرارات ذات الصفة الحساسة، سياسية كانت أم اقتصادية أم أمنية.
فإذا جسّد هذا المثال مفاعيله في انتخابات المجلس ذاته لهذا العام، فإنّ جائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق وزيادة الإصابات ومعدّل الوفيات، ليست السبب الأبرز وراء نسبة المشاركة المتدنية التي لم تبلغ 30%؛ خاصة إذا رُصفت إزاء هذا الرقم سلسلةُ أرقام أخرى مثيرة للاهتمام: 1674 مرشحاً، بينهم 360 امرأة، في تنافس على 130 مقعداً؛ و4.139 مليون ناخب مسجل؛ و1880 مركز اقتراع، على امتداد 23 دارة انتخابية؛ و47 حزباً سياسياً، من أصل 48!
الحصيلة، في المقابل، لا تؤكد استمرار مفاعيل انتخابات المجالس السابقة لجهة عزوف المواطن، إجمالاً، عن محض الثقة، فحسب؛ بل هي تعيد تثبيت الحصيلة النتائج المعروفة مسبقاً، حول سيطرة العشائر ورجال الأعمال، مع فارق ارتدادي إلى الخلف يمثله هذه المرّة عجز المرأة عن الفوز بأيّ مقعد خارج الحصة النسائية المقرّرة، وكذلك تراجع المعارضة (في مثال “جبهة العمل الإسلامي” واجهة جماعة “الإخوان المسلمين”) والفشل الذريع للأحزاب الليبرالية والقومية واليسارية و”الممانعة”… جمعاء!
وفي ورقة بعنوان “تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين”، كتبها مطلع العام 2013 وينشرها في موقعه الشخصي على الإنترنت، أبدى الملك الأردني عبد الله الثاني حماساً واضحاً لانتقال البلاد إلى “الحكومات البرلمانية الفاعلة”، التي تعتمد على “ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب والحكومة”. وإذْ أكد الحاجة إلى “بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق”، فإنّ العنصر الثاني في متطلبات التحوّل الديمقراطي الناجح هو تطوير الجهاز الحكومي “على أسس من المهنية والحياد”، والعنصر الثالث هو “تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب”.
والحال أنّ الانتخابات الأخيرة أعادت إنتاج حصيلة تقريبية مماثلة لتلك التي أنتجتها معظم الانتخابات السابقة منذ عام 1989، من أنّ تمنيات الملك وأداء البرلمان ومجلس الأعيان والحكومات المتعاقبة في واد، والمواطن الأردني وهمومه ومشاغله ومشكلاته ومستوى معيشته وعمله وطالته وخدماته واقتصاده… في واد آخر. ولم تكن مفارقة طارئة أنّ يذكّر الملك بأنّ البلد “دولة قانون”، ليس على خلفية أي انتهاكات دستورية أو قانونية أو برلمانية، بل لأنّ صليات “الرصاص الأحمر” لعلعت في سماءات المحتفلين بفوز هذا النائب أو ذاك، وظهرت بين الأيادي أنواع من الأسلحة التي لا يمكن أن تكون دولة القانون إياها قد رخّصت امتلاكها.
وفي مقابل البلاغة الطنانة في تسميات القوائم (“الإصلاح الوطني”، “الحق”، “فرسان الغد”، “النخبة”، “الشهامة”، “الهمّة”، البيرق”، “النشامى”، الليمونة”…)؛ كان ثمة خواء فاضح في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، سواء المحلية منها التي تخصّ المناطق والمحافظات، أو المركزية التي تشمل كامل البلد. وهذا بدوره مؤشر على عزوف المواطن الأردني عن تلمّس المضمون البرنامجي وراء كلّ قائمة، وفيه أيضاً الكثير من معطيات تفسير الفشل الذريع الذي مُنيت به الأحزاب السياسية، دون استثناء في الواقع.
الأرجح أنّ البرلمان الجديد العتيد لن يعدم “نهفات” مماثلة لتلك التي شهدتها برلمانات سابقة (دعاء “الله ينتقم من إللي جاب الكوتا تحت القبة”، أو “كشرتك بتقطع الرزق، إضحك كي لا تكون سبباً في حجب الثقة”، أو نصائح ابتياع الملوخية، أو العراك والسباب وإشهار السلاح داخل البرلمان…). ولعلّ التراجع عن إشراك الاستثمارات الإسرائيلية لم يكن أكثر تلك الوقائع فداحة، فالقادم قد ينجلي عمّا هو أدهى وأعظم!
خمسون «الحركة التصحيحية»:
زروع الماضي وخرائب الحاضر
صبحي حديدي
مسمّى «الحركة التصحيحية» الذي أطلقه الفريق حافظ الأسد (1930- 2000)
على انقلابه العسكري ضدّ رفاقه في حزب البعث، يوم 16 تشرين الثاني
(نوفمبر) 1970، تقصّد جرّ اليقين الشعبي العامّ في سوريا آنذاك نحو
استيهام حدوث التغيير على مستويات شتى، ذات طابع «انفتاحي»؛ يوحي
بمناقضة طابع «الانغلاق» الذي قيل إنه سمة سياسات ما سُمّي بـ«الجناح
اليساري» في قيادة انقلاب 23 شباط (فبراير) 1966، أي أمثال صلاح جديد
ويوسف زعين ونور الدين الأتاسي وإبراهيم ماخوس. وبقدر ما كان توجّه
الأسد زائفاً من حيث مبادلة الانغلاق بالانفتاح، إذْ كان النهج الفعلي
دكتاتورياً وشمولياً وطائفياً يبني على عدد من الركائز القائمة لتوّها؛
بقدر ما كانت «يسارية» المنقلّب عليهم ليست أقلّ زيفاً من حيث معمار
السلطة (ذاتها التي سمحت للأسد بالصعود والتمكّن) والبرامج الاجتماعية
(التي سهّلت مرور انقلاب 16 تشرين الثاني من دون مقاومة تُذكر)
والعقائدية التي تخصّ الحزب (المأساة هنا اختلطت بالمهزلة في السرعة
القياسية التي تبدى عليها استعداد الرفاق لقلب المعاطف).
وقد يكون أكثر جدوى، منهجياً، تقسيم تلك «التصحيحيات» إلى طرازّين، لا
يتعارض أحدهما مع الآخر من حيث الجوهر وإنْ كانت الوظيفة تختلف، على
نحو حاسم أحياناً: طراز معلّن، سياسي واقتصادي وحزبي وبيروقراطي
ومؤسساتي، تقصد الأسد كشف ميادينه لأغراض استيهام التغيير إياه في فضاء
الاستقبال الجماهيري العريض؛ وطراز غير معلّن، أمني وعسكري وطائفي،
مخفيّ لأنّ ديناميات اشتغاله تتطلب عدم ظهوره في الخطاب الرسمي أو حتى
في مستوى المعلومات العامة. وكانت مقاربة الأسد لدور حزب البعث في
بنيان السلطة أولى «التصحيحات» ضمن الطراز الأوّل، إذْ وجّه بضرورة
تسهيل الانتساب إلى الحزب عن طريق طيّ نهج سابق اشترط توفّر «المنبت
الطبقي» وتفضيل الفئات «الكادحة» واستبعاد أبناء الأغنياء من
الإقطاعيين والبرجوازيين. والأسد فتح باب الحزب على مصراعيه أمام
الجميع، بقصد تمييع التركيب الطبقي، بل جعل الانتساب اليه شرطاً ضمنياً
لا غنى عنه من أجل ضمان دخول المعاهد والجامعات، والحصول على الوظيفة.
النتيجة التالية، التي سعى إليها الأسد، هي تحويل فروع الحزب إلى
مؤسسات انتهازية خاضعة لسلطة الأجهزة الاستخباراتية، بحيث باتت كتابة
التقارير الأمنية واجباً تنظيمياً أمام أعضاء الحزب، فدانوا بالطاعة
لرئيس فرع المخابرات في المقام الأوّل.
تصحيح ثانٍ، لعله الأكثر دهاء وخبثاً، كان الاقتداء بنموذج كيم إيل
سونغ في كوريا الشمالية، واستحداث منظمة «طلائع البعث» التي تتولى
الإشراف على التربية السياسية للأطفال بين سنّ 6 إلى 11 سنة؛ حيث يكون
الانتساب إجبارياً، ولا ينفصل عن مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية.
وهكذا شبّت أجيال، طيلة 50 سنة الآن، على عبارة «بالروح! بالدم! نفديك
يا حافظ!» وكان مبدأ عبادة الفرد يُزرع قسراً في نفوس الأطفال كمبدأ
وطني وتربوي طبيعي، فيستقرّ الأسد في صورة «الأب القائد» والوحيد
القادر على حكم الأهل والمجتمع والوطن. ولأن 49% من سكان سوريا كانوا
فتياناً أقل من 15 سنة، فإنّ منظمة «طلائع البعث» لعبت دوراً تخريبياً
قاتلاً في تنشئة الأجيال الجديدة على قائد واحد وسياسة واحدة؛ كما زرعت
في نفوس الصغار حسّ الطاعة العسكرية والولاء الأعمى للقائد، وجهدت
السلطة أن تكون هذه «التربية» بمثابة لقاح مبكر يحول بين الناشئة وبين
السياسة حين ينتقلون من مرحلة الى أخرى في الدراسة والعمر والوعي
لم تكن مفارقة أنّ البذور الأسدية كانت فاسدة وخبيثة أصلاً، فخلّفت حزباً شائهاً وجيشاً أقرب إلى ميليشيا طائفية وعشائرية، وسلطة تابعة مرتهنة، وبلداً تحتله خمسة جيوش أجنبية.
ضمن الطراز الثاني، وعلى مستوى الجيش، عمد الأسد إلى إعادة ترتيب الفرق
الـ13 التي كان الجيش السوري يتألف منها، فوزّع تسعاً منها على ثلاثة
فيالق تتبع لرئاسة الأركان، وأبقى أربعة منها خارج هذا الترتيب، فتشكلت
بذلك: 1) سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد، وتألفت من ثمانية ألوية مشاة
ومظليين، وأسلحة ثقيلة تشمل الدبابات والحوامات والمدفعية الثقيلة،
وامتيازات خاصة في الراتب والسكن والترفيع، ولعبت دوراً بارزاً في
الدفاع عن النظام أثناء سنوات الصراع مع الإخوان المسلمين، 1979 ـ
1983، كما اشتُهرت بارتكاب العديد من الفظائع وبينها مجزرة سجن تدمر
الصحراوي في حزيران (يونيو) 1980؛ 2) الوحدات الخاصة: وكانت إحدى أبرز
التشكيلات العسكرية المكلفة بالدفاع عن أمن النظام، خاصة خلال حصار
مدينة حماة واقتحامها وتدميرها سنة 1982. ولقد حرص قائدها، اللواء علي
حيدر، على أن تكون أغلبية عناصرها من أبناء الطائفة العلوية، مطعمة
ببعض الأقليات البدوية من ريف محافظة دير الزور (أو الـ«شوايا» في
التعبير الشائع)؛ 3) الحرس الجمهوري: وكان الهدف من تأسيسه هو حماية
المقرات والمواكب الرئاسية، وأُسندت قيادته إلى عدنان مخلوف، ابن عمّ
زوجة الأسد، ولا تنتمي الغالبية الساحقة من عناصره إلى الطائفة العلوية
فقط، بل يتم انتقاؤهم أساساً من داخل أفخاذ عشائرية محددة، شديدة
الولاء للبيت الأسدي وليس للنظام وحده.
على مستوى الأجهزة الأمنية، وضمن الطراز الأوّل دائماً، أدخل الأسد
الأب تعديلاً حاسماً على منظومة المخابرات السورية، عن طريق تطوير
جهازَين من قلب المؤسسة العسكرية، هما «شعبة المخابرات العسكرية»
و«إدارة مخابرات القوى الجوية»؛ وتمكينهما، من حيث الصلاحيات، بما جعل
منهما قطبين موازين لـ»إدارة المخابرات العامة» و«إدارة الأمن
السياسي». كذلك وجّه قادة الأجهزة، في المخابرات العسكرية والجوية على
نحو خاص، إلى تعديل التركيب العشائري (وليس الطائفي فقط!) للضباط
والعناصر في فروع الجهاز؛ بما يجعل كلّ جهاز أكثر تمثيلاً لعشيرة
محددة، خاصة النميلاتية والخياطية والحدادية، وذلك لإبقاء نسق مختلط من
التوازن والتنافس معاً.
تعديل آخر، لجهة الترتيب الهرمي وتوزيع الصلاحيات داخل الجهاز ذاته،
تمثّل في «تفكيك» الجهاز الواحد إلى فروع اختصاصية، بحيث يتقاسم رؤساء
هذه الفروع ما يتيحه لهم الفرع من نفوذ أولاً؛ ثم يتنافسون فيما بينهم،
حتى إذا اقتضى الأمر تجاوز الرئيس المباشر في الجهاز الأمّ تالياً.
وهكذا، في شعبة المخابرات العسكرية على مستوى مدينة دمشق مثلاً، تتوفر
فروع المنطقة، الجبهة، التحقيق العسكري، سرية المداهمة والاقتحام، شؤون
الضباط، الحاسب الآلي، الفرع الخارجي، أمن القوات، فرع فلسطين،
الدوريات، اللاسلكي… فإذا كان رئيس الفرع مقرباً من السلطة أكثر من
سواه (كما حين كان آصف شوكت، صهر النظام، هو رئيس فرع المداهمة) فإنّ
صلاحياته وعلاقته بالقصر الرئاسي لا يمكن أن تُقارَن بأيّ من زملائه في
الفروع الأخرى.
ولقد سهر الأسد على إقامة ميزان محسوب بين العناصر التي تُنهض الطرازين
معاً، كأنْ يكون عضو القيادة القطرية للحزب، أو هذا الوزير السيادي أو
ذاك العادي، أو المدير العام لمؤسسة التبغ والتنباك تارة والمدير العام
للمصرف العقاري تارة أخرى (نموذج محمد مخلوف)؛ على صلة وثيقة، تكاملية
أو اتباعية، مع رئيس هذا الجهاز الأمني أو ذاك، في مستوى الإدارة
المركزية كما في الفروع استطراداً (نموذج علي دوبا في المخابرات
العسكرية، ومحمد الخولي في مخابرات القوى الجوية، وقادة الفرق والأفواج
والتشكيلات الخاصة ضمن معادلات المحاصصة). وهذا مشهد يتضافر مع تعديلات
الأسد في تنشئة شبكات الولاء والفساد والنهب، وتحويل السياسة الخارجية
إلى مصدر ابتزاز…
تلك كانت زروع الأسد الأب، خلال السنوات الأولى من تدشين «الحركة
التصحيحة ـ 1»؛ هذه التي استنبتت الخرائب سنة بعد أخرى، وعقداً بعد
آخر، وصولاً إلى سنة 2000 حين جرى توريث بشار الأسد، ليطلق خرائب
«الحركة التصحيحة ـ 2». ولم تكن مفارقة أنّ البذور الأسدية كانت فاسدة
وخبيثة أصلاً، فخلّفت حزباً شائهاً وجيشاً أقرب إلى ميليشيا طائفية
وعشائرية، وسلطة تابعة مرتهنة، وبلداً تحتله خمسة جيوش أجنبية.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
رابين بعد ربع قرن:
الأصابع ذاتها على الزناد إياه
صبحي حديدي
في حلقة أولى من سلسلة
مقالات تستعيد إرث رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إسحق رابين، الآن وقد
انقضت 25 سنة على اغتياله، تروي صحيفة «هآرتز» أنّ صحافياً اقترب من
ليا، زوجة رابين، وسألها إن كان الأخير يرتدي سترة واقية من الرصاص
خلال اختلاطه بالجموع الحاشدة في ساحة ملوك إسرائيل؛ فضحكت السيدة،
وردّت هكذا: «سترة واقية، حقاً؟ أين نحن، في أفريقيا؟ هذه إسرائيل». هي
كذلك، بالفعل، حيث حملت أيد إسرائيلية أخرى صورة رابين يرتدي الكوفية
الفلسطينية أو ثياب ضابط استخبارات نازي، وحيث شجّع على هذه التمثيلات
بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة ذاته، وحيث كمن في قلب الجموع مستوطن
شابّ متدين متشدد يدعى إيغال عمير تربصت رصاصاته بـ«الخائن رابين».
اليوم، بعد ربع قرن، تسمع داليا، إبنة رابين، عبارات بأعلى الصوت من
فتية إسرائيليين يمجدون عمير بوصفه بطلاً يهودياً بامتياز، كما تقرأ
تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعهد بمتابعة نهج القاتل. رئيس
الكيان، رؤوفيم ريفلين، استذكر واقعة الاغتيال كي يعلن أنّ «الكراهية
تفيض تحت أقدامنا» و«الأرض تشتعل» و«الدولة لا تزال منقسمة بشكل مخيف»
أعاد تذكيره بانشطار البحر الأحمر في الأمثولة التوراتية. إيتمار
رابينوفيتش، الأكاديمي والسفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن، كتب مقالة
بعنوان «كلا، نتنياهو ليس خليفة إسحق رابين» رافضاً اعتبار اتفاقيات
التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان تكملة لتراث رئيس الحكومة
القتيل.
باختصار، تُجمع التعليقات الإسرائيلية، في وسائل الإعلام المختلفة ولكن
على ألسنة الكثير من الساسة أيضاً، أنّ دولة الاحتلال لم تتعلم الكثير
من اغتيال رابين، بل يرى البعض أنها لم تتعلم أي شيء، أو تعلمت الدروس
الخاطئة على وجه الدقة. بيني غانتس، وزير الدفاع وزعيم ائتلاف «أزرق
أبيض» المشارك في الحكومة الحالية، اعتبر أنّ إبرام انفاقيات تطبيع مع
أنظمة عربية أمر جيد، ولكن الأجود منه «أن نعقد السلام مع أنفسنا
أولاً».
وفي استطلاع رأي مؤّلته «المنظمة الصهيونية العالمية» وثمة دلالة خاصة
في هذا، اعتقد 45٪ من الإسرائيليين أنّ مناخات التحريض العامة قد تسفر
عن اغتيالات أخرى لأغراض سياسية؛ وحمّل 31٪ اليمين الذي يقوده نتنياهو
مسؤولية تسعير تلك المناخات، وفي المقابل وجد 46٪ من جمهور اليمين أنّ
وسائل الإعلام هي المسؤولة.
في غضون هذا كلّه، يواصل عمير من داخل زنزانته حلقات مسلسل الدلال
والمطالب، ملتمساً السماح له بالخروج للمشاركة في حفل الـ»بار متسفاح»
لابنه؛ بعد أن كان قد تزوج في السجن عن طريق تفويضه لأبيه بعقد القران
نيابة عنه، وحصل لزوجته على إذن بزيارات زوجية، تقول رواية أولى إنه
تمكن خلال إحداها من معاشرة زوجته، وتقول رواية أخرى إنه جرى تهريب
سائله المنوي إليها. وهو لا يكفّ عن الشكوى من إبقائه في زنزانة
منفردة، بناء على توصية الاستخبارات الإسرائيلية، متسائلاً إنْ كان
أكثر خطورة من مروان البرغوثي أو الشيخ رائد صلاح أو… العالِم النووي
الإسرائيلي مردخاي فعنونو!
ولقد كان في وسعه، ومن حقّه كذلك، أن يضرب قتيله ذاته، رابين الجنرال
ورئيس الحكومة، مثالاً على عنف أقصى جنحت إليه دولة الاحتلال خلال
الانتفاضة الأولى، ضمن فلسفة «تكسير عظام» الفلسطيني؛ فلا يفعل عمير ما
هو أكثر من اقتداء القتيل.
ما عجز رابين عن رؤيته، مثله في ذلك مثل السواد الأعظم من «مهندسي السلام» الإسرائيليين، هو الثقة الضعيفة أو شبه المنعدمة التي اعتاد الصهيوني على منحها للنوع البشري إجمالاً، وللجيران العرب بصفة خاصة
أو كان مفهوماً لو أنه اقتبس أنساق العنف الأخرى التي اجترحها قادة
الاحتلال على الدوام، منذ زرع الكيان في فلسطين بقوّة الحديد والنار،
وطوال عقود سياسات التهجير القسري والمجازر والعقاب الجماعي ومسح قرى
كاملة عن الخريطة. وهل هي مصادفة أن تحلّ الذكرى الخامسة والعشرون
لاغتيال رابين، وحزب القتيل مثخن بالجراح، تلقى ويتلقى ضربات موجعة
متتالية من الناخب الإسرائيلي؛ كما يتفكك داخلياً، وذاتياً، في السياسة
كما في العقيدة؟ وإذا كان عمير قد أعلن أنه اغتال رابين كي يغتال
اتفاقيات أوسلو، فإنّ ما أفصحت عنه خلفيات الفتى الاجتماعية والثقافية
والنفسية والإثنية أكدت أنّ تنكيل نُخب حزب العمل باليهود اليمنيين
(معسكرات، تمييز عنصري في الدراسة والإقامة والعمل، اختطاف أطفال
لإجراء تجارب صحية ونفسية وبيولوجية…) استقرت عميقاً في روح عمير،
وأوقدت فيه نوازع الحقد على المؤسسة، وهي التي حرّكت إصبع يده حين ضغط
على الزناد.
وحين خرّ صريع طلقات يهودية صرفة، كان رابين صاحب سجلّ حافل زاخر
بالمنجزات: قائد فوج في حرب 1948، ورئيس أركان في 1964، وأحد أبطال
«تحرير» القدس، وسفير في واشنطن بين 1968 و1973، ورئيس وزراء مرّة أولى
بين 1974 و1977، ثمّ مرّة ثانية في 1992 حتى نهار اغتياله. غير أنه،
تلك العشية، كان قد وضع جانباً عقيدته الخاصة في استخدام الهراوة
وتكسير عظام الفلسطينيين، لا بسبب من صحوة ضمير أو ارتداد أخلاقي عن
تقنيات الردع والتأديب، بل لأنه قرّر «إلقاء نظرة تذهب خطوتين إلى
الأمام» على حدّ تعبير الروائي الإسرائيلي دافيد غروسمان. تلك كانت
نظرة براغماتية رأت أنّ الاستمرار في الاحتلال سوف يعني استمرار انكفاء
الدولة على ذاتها، وتفاقم أمراضها التاريخية والوجدانية المزمنة. وما
عجز رابين عن رؤيته، مثله في ذلك مثل السواد الأعظم من «مهندسي السلام»
الإسرائيليين، هو الثقة الضعيفة أو شبه المنعدمة التي اعتاد الصهيوني
على منحها للنوع البشري إجمالاً، وللجيران العرب بصفة خاصة.
يد عمير، أو «اليد اليهودية» كما وصفها بنفسه، تعمدت بدم رابين «ذلك
الخائن، واليهودي بالمصادفة» كما أضاف! والقاتل ضحك أكثر فأكثر حين رفض
الناخب الإسرائيلي الانصياع إلى الشعار الذي رفعه حزب العمل أثناء
الحملة الانتخابية التي أعقبت الاغتيال: «لا تمنحوا إيغال عمير سبباً
للضحك». ولقد ضحك، ملء شدقيه في الواقع، بل كان الوحيد الذي صوّت مرتين
كما قال روائي إسرائيلي آخر هو عاموس عوز: مرّة باستخدام الرصاصة،
ومرّة باستخدام ورقة الاقتراع. ومن سخريات الأقدار أن العبارة البليغة
Ballot Not Bullet
(ورقة الأقتراع لا الرصاصة) التي نحتها نتنياهو بعد اغتيال رابين،
برهنت أنّ الفارق اللفظي بين المفردتين لا يصنع أي فارق عملي على
الأرض؛ وأنّ الرصاصة صوّتت تماماً بالفاعلية التي كانت لورقة الاقتراع،
وأكثر بكثير ربما.
وقبل أن يخرّ صريع طلقات يهودي من أصل يمني، متديّن متشدّد وخصم
للصهيونية لأنها «أقلّ يهودية ممّا ينبغي» نطق رابين بهذه الكلمات:
«العنف يقوّض ركائز الديمقراطية الإسرائيلية ذاتها. من الواجب إدانته،
واستنكاره». فهل كان يجهل، حقاً، أنّ إرث العنف الإسرائيلي ضدّ
الفلسطينيين يستنسخ الآلاف من نماذج عمير، وقبله باروخ غولدشتين بطل
مجزرة الحرم الإبراهيمي؟ وهل يبالغ جيلون إذا اعتبر أنّ ابتسامة
«الماركة المسجلة» إياها، تطفح أيضاً على وجوه عشرات الآلاف من مناصري
عمير، الناظرين إليه كبطل وقدوة؟
الأرجح أنّ ضحكات عمير تتردد اليوم أيضاً، على نحو خاصّ مختلف، ليس
احتفاءً بابنه البالغ فقط، بل أساساً لأنّ أزيز رصاصاته يتعالى في
أرجاء كيان يزداد عنصرية وعسكرة وكراهية وانغلاقاً؛ وأنّ ثلاث دورات
انتخابية متعاقية أخيرة لم تفلح في لملمة ذات إسرائيلية، متشظية
ومنكسرة ورهابية؛ وأنّ أحد محرّضي عمير على اغتيال رابين، نتنياهو
نفسه، هو اليوم متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ولكنه أيضاً…
رئيس الحكومة؟
.. في كيان لم تره ليا رابين على شاكلة أفريقيا!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
سكس الجمهورية
ومطابخ العلمانية
صبحي حديدي
في ردود الفعل على الإرهاب الذي يضرب فرنسا هذه الأيام، واتكاءً على جريمة ذبح المدرّس الفرنسي صمويل باتي، صدرت عن بعض المسؤولين الفرنسيين الكبار سلسلة تصريحات لا يبيح العقل تصنيفها إلا تحت مزيج عجيب من التسخيف والتغابي والتخابث؛ في آن معاً، وعن سابق قصد وتصميم، وانعدام اكتراث بالحدّ الادنى من تحكيم الصواب البسيط. قصب السبق، في تقديري شخصياً، انفرد به وزير الداخلية جيرار دارمنان، الذي قال التالي على قناة إخبارية رئيسية: «صدمني دائماً أن أدخل إلى مخزن كبير وأرى وجود قسم خاصّ بمطبخ جماعاتي، إذْ هكذا تبدأ النزعة الجماعاتية». وإذْ أدرك الوزير، أو جرى تنبيهه، إلى عواقب تصريح كهذا، فقد سارع إلى التذكير بأنّ ما يقوله هو رأيه الشخصي، و»لحسن الحظ ليست جميع آرائي جزءاً من قوانين الجمهورية». توجّب، كذلك، أن يلطّف تصريحاته أكثر، في لقاء إذاعي لاحق، فيزعم إنّ تعليقه كان بمثابة استنكار لـ»طراز من الرأسمالية الفرنسية، والرأسمالية العالمية أيضاً، التي تلجأ إلى استخدام التسويق الجماعاتي».
ربْط دارمنان بين رفوف المنتجات والأغذية والثياب المنتمية إلى ثقافات أخرى، وشيوع «النزعة الجماعاتية»؛ ليس جديداً على السجالات الفرنسية الأسخف حول إقحام علاقة مفتعلة بين القيم الجمهورية والعلمانية، والامتناع عن أكل لحم الخنزير مثلاً، أو هذا أو ذاك من خيارات اللباس
ريشار فيران، رئيس مجلس النواب والمنتمي أصلاً إلى حزب رئيس الجمهورية،
قال بوضوح إنه لا يشعر بأية صدمة لمرأى رفوف المطابخ تلك، مضيفاً أنه
حين يدخل إلى مخزن كبير فإنه يتوجه على الفور إلى «المنتجات
البروتونية» لأنه بروتوني الولادة. لورانس روسينيول، عضو مجلس الشيوخ
عن الحزب الاشتراكي والوزيرة السابقة، ذكّرت دارمنان بأنّ المطابخ التي
يقصدها ليست الحلال وحده، بل هناك أيضاً الكاشير والتاي والهندي
والآسيوي، «من دون أن ننسى البيو، هذا الآتي من مطبخ الـ’آميش’
الجماعاتي»، في إشارة إلى الفرقة المسيحية المعروفة. ردّ الفعل الأبرع
والأذكى جاء، في تقديري الشخصي، من رسام الكاريكاتيــر فرنسوا ـ هنري
مونييه (أو «بابوز» حسب اسمه الفني)، في العدد الأسبوعي لصحيفة
«الأومانيتيه» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الفرنسي؛ في رسم بعنوان
«كسكس جمهوري، من إعداد الشيف دارمنان». بابوز استبدل مكوّنات الطبق
المغاربي الشهير بأخرى فرنسية وطنية، إذا جاز التعبير: النقانق
المغاربية (المرغيز) بنقانق تولوز، وسميد الكسكس بالفاصولياء البيضاء،
والخضار بشحم الخنزير المدخن، والدجاج بالبط، والحمّص بالثوم، والماء
بالنبيذ الأحمر؛ وأخيراً… الطاجن بالـ«كاسرولة»!
الأرجح أنّ أحداً من معاوني دارمنان ومستشاريه المقرّبين لم ينبهه إلى
واقعة تحريم الكسكس خلال عقود محاكم التفتيش الإسبانية، بالنظر إلى أنّ
الطبق لم يكن مركزياً في المطبخ العربي والإسلامي الأندلسي، فحسب؛ بل
كان، في الجوهر، رمزاً سياسياً وثقافياً وسلوكياً، على شاكلة مطابخ
العالم حين تتلاقى حضارياً. ولم يكن غريباً، والحال هذه، أنّ الطبق صمد
بقوّة أمام التحريم، وتحايل الناس على الرقيب فطوّروا الكسكس ذاته إلى
طبخات بدّلت المسمّيات واحتفظت بالمكوّنات إلى حدّ كبير؛ وهذا ما يلمسه
المرء في تنويعات كسكسية شعبية قائمة حتى الساعة، ليس في إسبانيا وحدها
بل في المكسيك والبرتغال والبرازيل، وهذا البلد الأخير نجح في الحفاظ
على التسمية ذاتها:
Cuzcuz.
وفي صقلية، حيث التأثير العربي ضارب الجذور ومتصل ومتواصل، وثمة مطبخ
متكامل تتفاعل فيه العناصر العربية والصقلية؛ تحتضن الجزيرة مهرجاناً
سنوياً يدعى «احتفالية الكسكس»، يجتذب 100 ألف زائر، حسب الموسوعات
المتخصصة بالتاريخ الثقافي للطبخ.
كذلك فإنّ ربط دارمنان بين رفوف المنتجات والأغذية والثياب المنتمية
إلى ثقافات أخرى، وشيوع «النزعة الجماعاتية»؛ ليس جديداً على السجالات
الفرنسية الأسخف حول إقحام علاقة مفتعلة بين القيم الجمهورية
والعلمانية، والامتناع عن أكل لحم الخنزير مثلاً، أو هذا أو ذاك من
خيارات اللباس (وليس ارتداء الحجاب بالضرورة). ولعلّ ما استجدّ في
تسخيفات وزير الداخلية الفرنسي أنها تستعيد تراث الرئيس الفرنسي الأسبق
نيكولا ساركوزي وتُدخله في قلب الفلسفة النيو ـ ليبرالية التي يزعم
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتناقها. فمن المعروف أن دارمنان
ينتمي تاريخياً إلى اليمين، وتربى في كنف الطبعة الساركوزية من هذا
اليمين، أكثر من تأثره بنسخة الجنرال ديغول أو نسخة جاك شيراك، وقد
اختاره ماكرون لوزارة الداخلية استجابة لرغبة دارمنان الشخصية وتلبية
لمطالب ذلك اليمين تحديداً، وضمن مطمع لدى الرئيس الفرنسي في دغدغة
اليمين المتشدد أيضاً. ولغير العارفين بمفاصل الإدارة الفرنسية
الراهنة، يُشار إلى أنّ دارمنان عُرف بإساءة استخدام الوظيفة لقاء خدمة
جنسية في عام 2015 حين كان عمدة، وهو اليوم متهم بالاغتصاب (بريء حتى
تثبت إدانته طبعاً).
والحال أنّ الكسكس يمكن أن يكون جمهورياً طبقاً لوصفة «الشيف دارمنان»
ذاتها، في رسم بابوز، وهذا جزء من حرّية الطبخ وحرّية التعبير أيضاً؛
إذْ أنّ مكوّنات الكسكس المغاربي لم تكن في أيّ يوم «متزمتة» لا تقبل
إلا الدجاج، ولا تُدخل لحم الخروف أو العجل أو السمك، فهذه أصناف
مذاقية وثقافية في نهاية المطاف. ولم يكن ممكناً تحويل الوصفة
الدارمنانية إلى ما يشبه «قيمة» جمهورية مطلقة، حتى من زاوية التخييل
الساخر والناقد، إلا في أعقاب تصريحات الوزير حول رفوف المنتجات
«الجماعاتية» وأثرها على الاندماج الاجتماعي الجمهوري. والثابت أنّ هذه
المناخات الجمهورية/ المطبخية ليست سوى مظهر واحد من لهاث ساسة فرنسيين
كثر، للحاق بالخطاب اليميني العنصري المتطرف، دون سواه.
( القدس العربي)
العلمانية الفرنسية:
سجال الدين والدولة
أم عبادة عجل ذهبي؟
صبحي حديدي
في كتابه "العلمانية إزاء الإسلام"، ولعله ضمن الأعمال المعاصرة الأبرز في هذا الميدان، يذكّرنا المؤرخ وعالم الاجتماع الفرنسي أوليفييه روا بالفارق، الجوهري في الواقع، بين العلمانية الفرنسية "Laicité"؛ والعلمانية في مفهومها الأوسع، والكوني ربما، الذي يحمله مصطلح "Secularism".
الثانية، حسب روا، هي حال تحرّر المجتمع من معنى المقدّس، من دون نكرانه بالضرورة؛ والأولى هي لجوء الدولة إلى "طرد" الحياة الدينية إلى حدود عرّفتها الدولة بقانون.
والفارق يمكن أن يتبدى صريحا أو حتى صارخا في إطار سلسلة من المواقف، تلخصها مسائل من النوع التالي: فصل الدين عن الدولة (نعم أم لا) وموقع الدين من المجتمع (قوي أم ضعيف) واحتمال أن تكون دولة علمانية بالمصطلح الثاني وليس الأوّل، لأنها تقرّ دينا رسميا (بريطانيا، الدانمرك) أو أن تفصل الدين عن الدولة وتعترف في الآن ذاته بدور الدين في المضمار العام (الولايات المتحدة، حيث أقرّت المحكمة العليا استخدام مفردة "الله" في أداء القسم داخل المدارس).
أو أن تعلن العلمانية ولا تشير إلى الإسلام في دستورها، لكنها لا تفصل
الدين عن الدولة (تركيا).
والحال أنّ العلمانية الفرنسية وجدت تعبيراتها الأولى في قانون 1905
حول فصل الدين عن الدولة، ويومذاك كان "العدو" هو الكنيسة الكاثوليكية،
أمّا اليوم فإنّ الإسلام حلّ محلّ الكاثوليكية؛ الأمر الذي يثير السؤال
الحاسم: أهذا واقع استمرار، أم انقطاع؟ يتساءل روا: "في نهاية المطاف،
هل يدور نقاش الإسلام حول مكانة الدين في المجتمع الفرنسي، أم ـ على
نقيض الاستمرارية البادية ـ يُنظر إلى الإسلام اليوم كدين مختلف، حامل
تهديد محدد؟ وفي هذه الحالة، أيعود الأمر إلى سمة محددة في الفقه
المسلم، أم في أنّ الإسلام دين المهاجرين بما يُلقي على فرنسا ظلّ
صراعات الشرق الأوسط؟".
وليس خافيا أنّ إشكاليات كهذه، وسواها بالطبع، جثمت بقوّة في خلفيات طرازَين من السجالات حول الإسلام في فرنسا؛ الأوّل يخصّ العلمانية، في نسختها الفرنسية حصريا، وارتباطها بالقِيَم الجمهورية والهوية الوطنية؛ والثاني يخصّ الإرهاب الإسلاموي، الذي استسهل الكثيرون ربطه مباشرة بالدين الإسلامي عموما، وليس بعقائد متشددة أو تيارات جهادية. الحصيلة، في عقود الجمهورية الخامسة أو فرنسا المعاصرة بالأحرى، كانت سلسلة متعاقبة من السجالات، السطحية غالبا والعميقة نادرا، حول "قضايا" مثل الحجاب أو اللحم الحلال أو إضافة لحم الخنزير إلى الوجبات المدرسية، في الطراز الأوّل؛ وما إذا كانت الديانة الإسلامية، بوصفها ثقافة وشريعة أيضا، حاضنة محرّضة في ذاتها على الإرهاب، ضمن الطراز الثاني.
ويندر أن يشهد بلد مثل بريطانيا أو ألمانيا أو الدانمرك انشقاقات كبرى
في صفوف الأحزاب السياسية والرأي العام والصحافة اليومية وأروقة
الجامعات، شبيهة بما شهدته فرنسا في سنوات 1989 و1994 و2003 و2004
و2010 و2016 و2017 حول الحجاب مثلا؛ فاقتضت اللجوء إلى "مجلس الدولة"
الذي أفتى بأنّ غطاء الرأس ليس في ذاته متناقضا مع مبادئ العلمانية؛ أو
تشكيل "هيئة ستاسي" وما أعقبها من إصدار قانون يحرّم في المدارس ارتداء
العلامات أو الثياب التي توحي بالصفة الدينية؛ أو الدخول في جدل عقيم،
مضحك أيضا، حول الفارق بين البرقع والنقاب؛ وصولا إلى الجامعات ونقاش
منع الطالبات من ارتداء الحجاب فيها، أو شواطئ البحر والحقّ في ارتداء
لباس السباحة الذي اشتُهر باسم "البوركيني".
في نطاق الطراز الثاني، تسابق اليمين الجمهوري مع اليمين المتطرف، ولم يتأخر الليبراليون طويلا عن اللحاق بالركب، في تأثيم الإسلام كدين وثقافة تحت لافتة تجريم الإرهاب الذي يُرتكب باسم الدين الإسلامي؛ وبات مصطلح "الإرهاب الإسلامي" منفلتا من كلّ ضابط مفهومي أو عقلاني أو منطقي أو تاريخي.
ولعلّ هذه الهستيريا بلغت الذروة في تفكير رئيس اشتراكي مثل فرنسوا هولاند بسنّ قانون يجرّد ذوي الجنسية المزدوجة من الجنسية الفرنسية، على خلفية الاتهام بأعمال إرهابية.
قد يتفق معظم الذين يتذكرون النقاشات الفرنسية الساخنة حول حظر الحجاب أنها انطوت، في الجانب الصحّي منها، على ضرورة صيانة مبدأ العلمانية؛ وأسفرت، في الجانب العليل، عن مسخ العلمانية إلى ما هو أكثر جاهلية من عبادة عجل ذهبي.
وكما هو معروف، اندلعت الجولة الأحدث من هذه الهستيريا على خلفية
الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبها مراهق شيشاني بحقّ المدرّس
الفرنسي صمويل باتي، الذي شاء تدريس مبدأ حرّية التعبير عن طريق عرض
رسوم كاريكاتورية نشرتها "شارلي إيبدو"، واعتبر القاتل ومشايخه
المحرّضون، أنها تسيء إلى النبي محمد وتستوجب ذبح المدرّس.
وحتى يثبت العكس (لأنّ الحبل على الجرار كما يُقال) انفرد وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمنان بالسبق في التهافت والضحالة، فاتهم المخازن الكبرى في فرنسا بأنها تغذّي النزعات الانفصالية والجهوية حين تعرض على رفوفها أغذية أو ألبسة تدلّ على دين أو محتد! رئيس وزراء فرنسي أسبق مثل مانويل فالس، كان اشتراكيا ثمّ انقلب إلى يميني متسابق مع أقصى اليمين، نفض الغبار عن شخصه (هو الذي عاد إلى أصوله الإسبانية، وفشل في الفوز برئاسة بلدية برشلونة)، فلم يكتفِ بالمطالبة باقتلاع "الإسلامية" من جذورها، فحسب؛ بل فتح النار على ساسة وكتّاب فرنسيين طالبوا بالفصل بين الإسلام وإرهاب أفراد مسلمين.
وبهذا، فإنّ الإدانة الصريحة، بلا تردد أو تحفظ أو تسويغ أو تلاعب، لجريمة اغتيال المدرّس الفرنسي لا يصحّ أن تحجب الحقّ في فتح ملفات الاختلاف، أو حتى التناقض أحيانا، بين علمانية وعلمانية؛ على صعيد المجتمعات التي تحتضن جاليات مسلمة لا خلاف في أنها تعاني الكثير من المصاعب في بلوغ الدرجة المطلوبة من الاندماج الاجتماعي والثقافي والقانوني.
كما لا يجوز للإدانة ذاتها أن تطمس حقوق المساءلة المشروعة لازدواج
الخطاب الفرنسي، والأوروبي بصفة عامة، حول قضايا العلمانية وفصل الدين
عن الدولة والمواطنة والقِيَم الجمهورية؛ وكيف أنّ قسطا غير قليل من
مسائل الحجاب والنقاب واللحم الحلال و"الإرهاب الإسلامي" تبدأ بواعثها
من السياسة والساسة، في سياقات إلهاء الرأي العام عن الهموم الاجتماعية
الكبرى، كالبطالة وانخفاض القدرة الشرائية ومشكلات التقاعد، من جهة
أولى؛ وعلى سبيل استغلال هذه الهموم، أيضا، بهدف تضخيم إحساس المواطن
بأنّ الجزء الأكبر من المتاعب مصدره وجود "الأجانب" وانقلاب ذلك الوجود
إلى عبء على الاقتصاد، من جهة أخرى.
هذه الخلاصة لا تلغي، مع ذلك، حقيقة أنّ المواطن إياه، ذلك النموذج المتوسط الممثّل للشرائح الأعرض في المجتمعات الغربية، أخذ يتأثر أكثر فأكثر بأجواء الخوف من الإسلام والمسلمين، بحيث صار التوجس من مؤشرات المستقبل الاقتصادي، مقترنا بتوجّس من فقدان الهوية الثقافية (في التعبير الملطّف) والهوية الدينية المسيحية (في المحتوى الواقعي الصريح، الذي يطابق الواقع). كما أنها خلاصة لا تمسّ تلك الحقيقة الأخرى الرديفة، التي تشير بوضوح إلى أنّ مسائل العلمانية وحرّية المعتقد وفصل الدين عن الدولة… بريئة من حزمة البواعث التي تحرّك سلوك الساسة واتجاهات السياسة.
وقد يتفق معظم الذين يتذكرون النقاشات الفرنسية الساخنة حول حظر
الحجاب، في المؤسسات التعليمية بصفة خاصة، أنها انطوت في الجانب الصحّي
منها على ضرورة صيانة مبدأ العلمانية؛ وأسفرت، في الجانب العليل، عن
مسخ العلمانية إلى ما هو أكثر جاهلية من عبادة عجل ذهبي. الأمر الذي
يعيد هذه السطور إلى الأسئلة الأبسط: عن أي إسلام تتحدث فرنسا، في
نهاية الأمر؟ ألا تتراوح آراء المسلمين أنفسهم بين إسلام مستنير يرفض
الحجاب، وإسلام أصولي يذبح باسم المقدّس؟ وفي المقابل، ألا تتفاوت آراء
الفرنسيين أنفسهم في معنى النسخة الفرنسية من مفهوم العلمانية، بحيث
تتعايش تحت راياتها مبادئ الحرية والمساواة والأخوّة، مع عنصرية مارين
لوبين وليبرالية إيمانويل ماكرون و… بلاهة دارمنان؟
«نبع السلام»: احتلال يمهد
للضمّ بموجب الأمر الواقع
صبحي حديدي
عملية «نبع السلام» التي أطلقتها تركيا مؤخراً في شمال سوريا، وعلى
مساحات شاسعة تغطي غالبية الشريط الحدودي، ليست بعيدة عن أن تكون
التتويج الأقصى، والتجسيد الأوضح كذلك، لخيار مبكّر اعتمده الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان منذ أربع سنوات على الأقلّ. وبمعزل عن رطانة
الأهداف المعلنة للعملية، وأنها تتوخى إقامة ملاذات آمنة تتيح للاجئين
السوريين العودة إلى بلدهم، وليس بالضرورة إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم
التي هاجروا أو هُجّروا منها؛ فإنّ الهدف الحقيقي الأوّل القريب هو
محاربة «حزب العمال الكردستاني»
PKK،
عبر فروعه السورية المختلفة وفي طليعتها «وحدات حماية الشعب»؛ وأمّا
الهدف التالي، الحقيقي والستراتيجي البعيد، فهو تثبيت احتلال تركي جدير
بأن يتحوّل إلى أمر واقع على الأرض، حتى أمد بعيد مرتبط بالحلول
المختلفة للمسألة السورية.
خيار أردوغان، الذي اتخذ وجهة معلنة وصريحة منذ العام 2015، انطوى على
الدمج بين: 1) ضرورة تقليم أظافر الـPKK
عسكرياً، في مختلف مناطق انتشار أنصاره داخل سوريا، مع إمكانية تحويل
التقليم إلى عمليات بتر جراحية ما أمكن ذلك؛ و2) اعتماد مطلب المناطق
الآمنة، بعد ترقيته إلى مستوى الهاجس الجيو ـ ستراتيجي عند تركيا،
والشكوى من أعداد اللاجئين السوريين الهائلة والمتزايدة؛ و3) نقل
الهاجس إلى أوروبا، ولكن تحت صيغة كابوسية مفادها فتح الحدود التركية
مع أوروبا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين. وذلك الخيار، مثلّث
الأبعاد، كان في الواقع لا يقطع مع سنوات من تقلّب المواقف التركية من
الملفّ السوري، فحسب؛ بل كان أقرب إلى المقامرة الإقليمية والدولية،
بالنظر إلى اشتباك عناصر الخيار مع الوجودين الروسي والأمريكي، ثمّ مع
سياسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في تسليح المجموعات الكردية
لمحاربة «داعش».
ذلك كله، وسواه من معطيات أخرى أقلّ إشكالية، يعيد التذكير بسلسلة
الاعتبارات التي صنعت تاريخ العلاقة بين تركيا المعاصرة والملفّ السوري
إجمالاً، ثمّ هذا الملفّ بعد أن أدخلت عليه الانتفاضة الشعبية السورية
معطيات جديدة بالغة الحساسية. قبيل 2011 كانت العلاقات التركية مع
النظام السوري في أبهى أزمنتها، ثمّ أخذت تتدهور يوماً بعد آخر، وكلما
حنث بشار الأسد بما قطعه من وعود لأردوغان شخصياً (حين كان الأخير رئيس
الوزراء)، وتوجّب أن تنقلب اعتبارات الجوار المزدهرة من مزايا إلى
تحدّيات، ومن مغانم إلى مخاطر.
فعلى الصعيد الجيو ـ سياسي، كان على تركيا أن تتخلى عن ركائز كبرى في
فلسفة وزير خارجيتها يومذاك، أحمد داود أوغلو، التي ظلت ناظمة للسياسة
الخارجية التركية منذ نجاح «حزب العدالة والتنمية» في حيازة أغلبية
برلمانية مريحة. بين تلك الركائز مبدأ تطوير علاقات متعددة المحاور مع
القوقاز، والبلقان، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق
آسيا، والبحر الأسود، وكامل حوض المتوسط؛ وليس الاقتصار على علاقات
أنقرة التقليدية مع أوروبا والولايات المتحدة، أو البقاء في أسر التلهف
على عضوية الإتحاد الأوروبي. ركيزة ثانية هي خيار «الدرجة صفر في
النزاع» مع الجوار، من منطلق أنه أياً كانت الخلافات بين الدول
المتجاورة، فإنّ العلاقات يمكن تحسينها عن طريق تقوية الصلات
الاقتصادية.
وفي الماضي كانت تركيا تحاول ضمان أمنها القومي عن طريق استخدام
«القوّة الخشنة»، واليوم «نعرف أنّ الدول التي تمارس النفوذ العابر
لحدودها، عن طريق استخدام القوة الناعمة هي التي تفلح حقاً في حماية
نفسها’، كما ساجل داود أوغلو في كتابه الشهير «العمق الستراتيجي: موقع
تركيا الدولي».
كذلك، على الصعيد الاقتصادي، ظلّت تركيا حريصة على إدامة ميزان تجاري
رابح تماماً بالنسبة إلى أنقرة، وخاسر على نحو فاضح من الجانب السوري،
بلغ 2,5 مليار دولار في سنة 2010، بزيادة تقارب 43 بالمئة، وكان يُنتظر
له أن يتجاوز خمسة مليارات في السنتين اللاحقتين.
الصادرات التركية كانت تشمل المعدّات الكهربائية، والوقود المعدني،
والزيوت النباتية والحيوانية، والبلاستيك، ومنتجات الصناعات التحويلية
والمؤتمتة، ومشتقات البترول المصنعة، والمنتجات الكيماوية، والإسمنت،
ومنتجات الحديد والصلب، وصناعة القرميد والبلاط، والمنتجات الجلدية،
والأخشاب، والقمح، والدقيق، والسمن النباتي، والملابس الجاهزة…
الاستثمارات التركية في سوريا بلغت أكثر من 260 مليون دولار، واحتلّت
الشركات التركية المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع التابعة لجهات
أجنبية… ولقد اتضح، طيلة أسابيع الانتفاضة، أنّ كبار التجار الأتراك
تكاتفوا مع كبار التجّار السوريين، في حلب ودمشق بصفة خاصة، لإبقاء
العاملين في مؤسساتهم بمنأى عن الحراك الشعبي، حتى إذا كلّفهم ذلك سداد
تعويضات إضافية ومغريات مادية مجزية.
ومن جانب آخر، تغاضى النظام السوري عن شحّ مياه نهر الفرات بسبب تغذية
السدود التركية المتزايدة، وتعاونت الأجهزة الأمنية السورية مع الأجهزة
الأمنية التركية في تعقّب أنصار «حزب العمال الكردستاني»، الـ
PKK؛
الذين كان النظام السوري يزوّدهم بالسلاح ومعسكرات التدريب حتى عام
1998، بل وحدث مراراً أنّ أجهزة النظام سهّلت قيام الأتراك بعمليات
إغارة على القرى السورية المحاذية للحدود مع تركيا، بهدف اعتقال أولئك
الأنصار. الأهمّ من هذه الاعتبارات الاقتصادية، الجيو ـ سياسية بامتياز
ايضاً، أنّ النظام السوري أقرّ، ضمنياً، بالسيادة التركية التامة على
لواء الإسكندرون، وهو منطقة سورية واسعة قامت تركيا بغزوها سنة 1938،
قبل أن تسلخها سلطات الانتداب الفرنسية عن الجسم السوري، وتضمّها إلى
تركيا.
في المستوى الإيديولوجي، لم يكن «حزب العدالة والتنمية» يملك الكثير من
هوامش المناورة في ضبط مشاعر جماهيره وناخبيه، وغالبيتهم الساحقة من
المسلمين السنّة، إزاء ما يرتكبه النظام السوري من مجازر وأعمال وحشية،
وخاصة في مواقع ذات قيمة عاطفية ورمزية عالية مثل مدينة حماة، فضلاً عن
دمشق التي تظلّ «الشام الشريفة» في ناظر الجمهور التركي العريض. وكيف
للفريق التركي الحاكم أن يسكت عن جرائم النظام السوري، فيضحّي بما
اكتسبته تركيا من شعبية واسعة في الضمير العربي العريض، بسبب الموقف من
العدوان الإسرائيلي على غزّة، وانسحاب أردوغان من سجال مع الرئيس
الإسرائيلي شمعون بيريس في ملتقى دافوس، ومأثرة «أسطول الحرية»،
وسواها؟
وهكذا، لم تكن مصادفة أنّ تركيا استضافت غالبية المؤتمرات التي عقدتها
بعض أطراف المعارضة السورية في الخارج، من جهة أولى؛ وأنّ مقرّ قيادة
جماعة الإخوان المسلمين السورية قد انتقل من عمّان ولندن إلى اسطنبول،
من جهة ثانية؛ وأنّ رجال أعمال سوريين معارضين للنظام لأنهم تضرّروا من
سياساته، من أمثال آل سنقر، صاروا يجدون راحة أكبر في إطلاق المبادرات
من أنقرة، بدل القاهرة أو طرابلس (لبنان)، من جهة ثالثة. وهكذا، لم يكن
صحيحاً أنّ المنابر التركية (وهي، في نهاية المطاف، ليست حكومية أو
رسمية البتة) لا تشرع أبوابها إلا للإسلاميين، كما تردّد مراراً؛ إذْ
شهدت المؤتمرات واللقاءات ولجان العمل حضور سوريين من مشارب شتى، من
أهل اليمين واليسار والوسط، المتديّن فيهم مثل العلماني، والماركسي مثل
الليبرالي، فضلاً عن التنويعات الإثنية والدينية والمذهبية كافة. هنا
ولد «المجلس الوطني»، ومثله ولد «الائتلاف»…
تتوغل تركيا اليوم في الأراضي السورية ليس اعتماداً على جيشها الجرار
وحده، بل عن طريق زجّ مجموعات عسكرية سورية أشرفت وزارة الدفاع التركية
على إنشائها وتدريبها وتسليحها، ضمن مساحات شاسعة تمتد من جرابلس إلى
ديريك (المالكية)، على مبعدة أمتار من حقول النفط السورية في رميلان.
وهكذا فإنّ عملية «نبع السلام» تعيد تظهير خيارات أردوغان القديمة،
ولكن تحت صفة الاحتلال العسكري المباشر، الذي يمهّد للضمّ بموجب الأمر
الواقع… أياً كانت التسميات الوردية والشاعرية!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
هل يغرد جيش السودان
خارج سرب العسكرتاريا العربية؟
صبحي حديدي
ثمة الكثير الذي يغري، وينفع الناس أغلب الظنّ، في إجراء دراسة موثقة محكّمة تقارن بين سلوكيات جيوش الأنظمة العربية إزاء انتفاضات الشعوب، منذ 2011 وحتى الساعة؛ ابتداءً من تونس وليبيا ومصر واليمن، وانتهاءً بالبحرين وسوريا والجزائر والسودان. بعض خلاصات دراسة كهذه سوف تسرد قواسم مشتركة عديدة بين عسكرتاريا الأنظمة هذه، في رأسها التشبث بالسلطة وكراهية تسليمها أو تناقلها، ورفض مغادرة القصور الرئاسية مع احتلال الثكنات في آن معاً، وتكريس عبادة السلاح وتقديس “جيش الوطن”. كما ستسرد فوارق، بعضها ملموس وبعضها صارخ، في مدى استعداد كلّ جيش لإراقة الدماء وتخريب البلاد واستخدام أيّ وكلّ سلاح فتاك ضدّ الشعب.
من جانبي، شخصياً، لا أتردد في منح جيش النظام السوري، وتحديداً خلال49 سنة من حكم آل الأسد، بشراكة عوائل الاستبداد والنهب والفساد المعروفة؛ قصب السبق في الوحشية والبربرية والعنف العاري، وفي فقدان حسّ الانتماء إلى الوطن، والانحياز في المقابل إلى العائلة والعشيرة والطائفة أوّلاً وأخيراً. ما من جيش لأيّ من الأنظمة السالفة، بما في ذلك جيش العقيد الملتاث معمر القذافي، اقتلع أظافر الأطفال وأطلق النار على المتظاهرين العزّل منذ الساعات الأولى لاندلاع التظاهرات السلمية؛ وبالتالي للمرء أن يتخيّل، محقاً بالطبع، مآلات جميع الانتفاضات العربية لو أنها جوبهت بجيوش على غرار جيش حافظ وبشار وماهر الأسد.
وتلك دراسة تنفع، راهناً، في قراءة مشهد السودان بعد أن أعلن وسيط أثيوبيا ومنظمة الوحدة الأفريقية التوصّل إلى مسودة لوثيقة اتفاق نهائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرّية والتغيير، يتوجب أن تشمل الإعلانين السياسي والدستوري، كما يتوجب أن تنظّم مسارات الحكم في مستوياتها السيادية والتنفيذية والتشريعية. ومن الخير، هنا، التشديد على مدلولات الفعل “يتوجب”، إذْ أنّ التوقيع على الوثيقة تأجل من الخميس إلى مساء أمس السبت، وليس من المؤكد أن سلسلة القضايا العالقة (مهلة إرجاء تشكيل المجلس التشريعي، النسبة المئوية لقوى “الحرّية والتغيير” بالقياس إلى نسبة العسكر في عضوية المجلس، شخصية رئيس الوزراء، مرجعيات السلطة التنفيذية، مواقف الأحزاب خارج الكتل الستّ التي تشكّل مجموعة “الحرّية والتغيير”، التحقيق في مجزرة فضّ الاعتصام…)؛ سوف تجعل التوقيع سلساً وميسّراً وآمناً.
وحتى لو تمّت مراسم التوقيع، بالأحرف الأولى كما يتردد، وشهد عليها مندوبو دول عربية وأفريقية ودولية، وأقيمت الاحتفالات بانتصار تمهيدي لانتفاضة شعبية سلمية تجاوز عمرها الفعلي الأشهر الستة؛ فإنّ الأسئلة الأخرى، المنبثقة من الباطن العميق لإرث العسكرتاريا العربية وتقاليدها، سوف تظلّ قائمة ومطروحة وملقاة مثل حجر ثقيل على منضدة المستقبل: هل يمكن للجيش السوداني أن يفعلها، فيغرّد خارج سرب الجيوش العربية، وينحني أمام الإرادة الشعبية؟ وهل يفعل ذلك، حقاً، وهو وريث دكتاتوريات عسكرية وانقلابية متعاقبة لم تكن ثلاثة عقود من سلطة عمر حسن البشير سوى أحد فصولها؟ ومَن الذي سيفعلها: أمثال عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو وسواهما من الضباط الأعلى إخلاصاً لشخص البشير حتى عهد قريب، والأشدّ انتماءً اليوم أيضاً إلى الإرث الانقلابي إياه؟ وما معنى الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب عسكرية في هذا الظرف الراهن تحديداً، قبيل ساعات على توقيع مسودة الوثيقة؟
نعرف، في كلّ حال، أنّ المجلس السيادي المزمع تشكيله سوف يحكم لمدّة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات، وفي عضويته سوف يحضر العسكر بعديد ملحوظ، والأهمّ من هذا أنهم سوف يحافظون خارج المجلس على سطوة الجيش دون أيّ مساس بحجمه أو قوّته أو صلاحياته؛ يستوي في هذا أن تبقى بعض الكتائب في صيغتها النظامية، أم يواصل بعضها الآخر صفة الميليشيا الجنجويدية على شاكلة “قوات الدعم السريع”.
ونعرف، استطراداً، أنّ جنرالاً شبّ على الانقلاب، سوف يحلو له المشيب عليه خلال المرحلة الانتقالية!
أبعد من ترامب:
الشعبوية ومآزق
الديمقراطيات الغربية
صبحي حديدي
منذ السطور الأولى يعلن محررو كتاب «الشعبوية وأزمة الديمقراطية»،
غريغور فيتزي ويورغن ماكيرت وبريان ترنر، وجميعهم أساتذة علوم اجتماع
وسياسة في جامعة بوتسدام؛ أنه «ما من خطر يهدد الديمقراطيات الغربية
بالمقارنة مع صعود شعبوية اليمين»، وأنه إذا كانت الشعبوية قد لعبت
دوراً متزايداً منذ تسعينيات القرن الماضي، فإنّ العواقب الاجتماعية
للأزمة المالية العالمية سنة 2008 هي التي منحت التيارات الشعبوية نقلة
أسفرت عن «بريكست» في بريطانيا، وانتخاب دونالد ترامب في الولايات
المتحدة.
وهذا الكتاب، الذي صدر مؤخراً عن منشورات روتلدج في لندن ونيويورك،
يقتصر في جزئه الأوّل على تحديد المفاهيم وتصويب مدلولاتها، على نحو
بالغ الصرامة في الواقع؛ إذْ أنّ أولى الأسئلة في هذا المضمار ذاك الذي
يتساءل ببساطة: هل ثمة شيء اسمه الشعبوية بالفعل، وما كنهه على وجه
التحديد. أسئلة أخرى، يتناولها باحثون متخصصون، تستكشف إشكاليات تعريف
الشعبوية، وصلاتها المباشرة وغير المباشرة بالسياسة، والمقاربات
النظرية في موازاة الاستقصاءات العملية والتطبيقية، والبُعد الانتخابي
في نشوء أو ثبات أو صعود الشعبوية، والروابط الإيديولوجية التي تجمع،
وأحياناً تفرّق، مختلف التيارات الشعبوية، ثمّ أقنية الاتفاق والاختلاف
مع مدارس اليمين التقليدية في قلب الديمقراطيات الغربية.
والحال أنه ما كان للكتاب أن يصدر في توقيت أكثر ملاءمة من هذه الأيام،
الآن إذْ أطلق الرئيس الأمريكي حملة ترشيحه لولاية رئاسية ثانية؛
وانتهت مآزق الـ»بريكست» بالمحافظين البريطانيين إلى خشبة إنقاذ بائسة
اسمها بوريس جونسون، الكاذب والمخادع وشبه المهرّج. كذلك فإنّ نتائج
الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة أتت بنتائج للتيارات
الشعبوية، وضمنها فئات اليمين المتطرف والعنصري، ليست مسبوقة بهذه
المعدّلات في التصويت واتساع الرقعة الجغرافية. غير أنّ هذه كلها ليست
سوى علائم السطح وحده، لأنّ السويّة الأخطر للظاهرة الشعبوية/ اليمينية
المتطرفة إنما تكمن في مكوّنات الباطن العميق الاجتماعي ــ الاقتصادي
والسياسي، غير المنفصل عن قرائنه التاريخية والثقافية أيضاً.
يتوجب، بادئ ذي بدء، تسجيل نقطة خلاف مبدئية مع خلاصة الكتاب التي تعزو
انتخاب ترامب والـ»بريكست» إلى صعود الشعبوية؛ إذْ أنّ ترامب، حتى إذا
لاح بالفعل أنه نموذج صارخ وفاضح للشعبوية المعاصرة، ليس أوّل
الشعبويين في لائحة رؤساء أمريكا، والمنطق البسيط يتيح القول بأنه قد
لا يكون الأخير. ألم يكن انتخاب جورج بوش الابن، في دورتين رئاسيتين
وليس واحدة فقط، بمثابة تجسيد صريح لطراز من الشعبوية الأمريكية،
عنوانه فقدان الاقتراع الشعبي في الرئاسة الأولى، وحيازتها بالضربة
القاضية وبفارق أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون صوت في الرئاسة
الثانية؟ ألم يُدخل أمريكا في حرب خارجية بذرائع كاذبة، فاحتلّ العراق
تحت لواء «حملة صليبية» وبهدي من محافظين جدد عتاة وصقور زرعوا بذور
الشعبوية وأتاحوا حصادها في سجن «أبو غريب» ومعتقل غوانتانامو؛ كلّ هذا
قبل أن تُفتضح أكذوبة أسلحة الدمار الشامل؟
السؤال يضرب بجذوره في أعماق التأزّم الرأسمالي الراهن بين أقطاب اقتصاد السوق أنفسهم، وعلى صعيد مؤسسات مالية كبرى مثل صندوق النقد أو البنك الدولي، أسوة بمؤسسات عسكرية عليا مثل الحلف الأطلسي
وعلى الضفة الأخرى من المحيط، في بريطانيا، ألم يكن رئيس الوزراء
الأسبق توني بلير، شريك بوش في الحملة الصليبية إياها، وفي صناعة
الأكاذيب والنفاق الشعبوي؛ هو السابق الذي كان من الطبيعي أن يعبّد
الطريق أمام اللاحق، بوريس جونسون، رغم انتمائهما إلى قطبَيْ التنافس
التقليديين في الحياة السياسية والحزبية البريطانية؟ في عبارة أخرى،
أيّ فارق جوهري بين اشتغال أمثال جونسون، اليوم، على الرهاب البريطاني
من الاتحاد الأوروبي، ودغدغة المشاعر القوموية، وتغذية حسّ الانغلاق
خلف المانش والمحيط؛ وبين انضمام بلير إلى فريق الحرب الأمريكي، بصفة
تابع عملياً، وتأجيج الأحقاد الإمبراطورية القديمة، واستنهاض «القِيَم»
الأنغلو ــ سكسونية ضدّ شعب لم تكن مصادفة محضة أنه مستعمرة بريطانية
سابقة، وليس البتة ضدّ نظام أياً كانت خطاياه؟
طريف مع هذا، ولافت جدير بالتأمل، أنّ السجالات النظرية والأكاديمية
حول المعضلات التي تجابهها الديمقراطيات الغربية اليوم، لم تعد تستسهل
الاستناد على «الثوابت» التي قيل إنها ولدت مع انهيار جدار برلين؛ سواء
تلك التي جزمت بانتهاء التاريخ، على غرار ما فعل فرنسيس فوكوياما؛ أو
تلك التي تحيل سرديات الصراع الكوني الكبرى إلى صدام الحضارات، كما
بشّر صمويل هنتنغتون؛ أو مدارس اختزال الصراعات الاجتماعية، على
مستويات محلية أو كونية، إلى ثنائيات بائسة وكسيحة بين ليبرالية
كلاسيكية وأخرى جديدة، أو اقتصاد سوق واقتصاد دولة. السجالات اليوم،
وتشخيص الأخطار الكبرى ضدّ الديمقراطيات الغربية، يدور حول أمثال ترامب
في أمريكا، ونايجل فراج في بريطانيا، ومارين لوبين في فرنسا، وفكتور
أوربان في هنغاريا، وماتيو سالفيني في إيطاليا.
نحن، إذن، على مبعدة من تلك الأحقاب التي شهدت التبجيل الغنائي للنظام
الرأسمالي بعد تفكيك نظام القطبين وانتصار المزيج السياسي والاقتصادي
والعسكري الذي تكاتف في صنعه رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر، ثمّ حيازة
الرمز الأيقوني الأعظم بسقوط جدار برلين وقَرْع أجراس انتصار
الرأسمالية الختامي.
يومذاك قيل لنا، بل فُرض علينا، التسليم بأنّ الاختراع الغربي
للرأسمالية ـ وكذلك للعلم والأنوار والديمقراطية الليبرالية… ـ يتقدّم
حثيثاً لاجتياح العالم القديم والعالم الحديث في آن معاً، ما قبل الحرب
الباردة وما بعدها، ما قبل الحداثة وما بعدها، ما قبل التاريخ وما
بعده؛ خالياً تماماً، ومعافى، من أمراض القومية والانعزال والقيود، بعد
أوبئة الشيوعية والنازية والفاشية. فماذا عن الشعبوية؟ السؤال ذاته لم
يُطرح بصيغة الحذر أو التخوّف، فما بالك بالإنذار والخطر، كما يحدث
اليوم؛ في أربع رياح الديمقراطيات الغربية.
غير أنّ الاعتلال الشعبوي، كي لا يتحدث المرء عن وباء يستشري وينتشر
ويستوطن، لا يقتصر على تيار شعبوي بالقياس إلى خصومه على الضفاف
الأخرى، يمينية كانت أم يسارية أم في الوسط؛ بل هو يتصارع داخلياً
أيضاً، ويتفكك في سيرورة الصراع ذاتها، ويفرز بالضرورة شعبوية أقلّ أو
أكثر، وتطرفاً «معتدلاً» أو أقصى، وتكاملاً في هذا كلّه أو تنافراً.
خذوا «الجبهة الوطنية» في فرنسا على سبيل المثال، التي أنشأها جان ــ
ماري لوبين في سنة 1972، ثمّ انقسمت على يد برونو ميغريه في سنة 1998،
وأطاحت بالمؤسس على يد ابنته مارين في سنة 2011 وهي التي تقود الحركة
اليوم تحت اسم «التجمع الوطني»؛ ليس من دون انشقاق آخر يتزعمه فلوريان
فيليبو الناطق باسم الحزب، و«حرد» أشبه بالانشقاق تقوده ماريون ماريشال
حفيدة المؤسس وأوّل نائبة للحزب. كلّ هذا التاريخ الانقسامي دار حول
أفضل التكتيكات، وليس الستراتيجيات، لاكتساب شعبوية أكثر ضمن سقوف
الثوابت التي لا تنازل عنها.
وهكذا فإنّ سؤال الشعبوية يضرب بجذوره في أعماق التأزّم الرأسمالي
الراهن، بين أقطاب اقتصاد السوق أنفسهم، وعلى صعيد مؤسسات مالية كبرى
مثل صندوق النقد أو البنك الدولي، أسوة بمؤسسات عسكرية عليا مثل الحلف
الأطلسي، بحيث يبدو المشهد وكأنه ينسف تماماً صورة الظفر التي شاعت
مطلع تسعينيات القرن المنصرم. على العكس، تبدو المشاهد أقرب إلى
استعادة طبق الأصل لكلّ أحقاب الـ «ما قبل» في السرديات الكبرى للحضارة
الغربية؛ ابتداءً من اليونان القديم، ومنافستها روما القديمة، مروراً
برحلة كريستوفر كولومبوس وعصر الأنوار والحداثة، وصولاً إلى أورلاندو ـ
فلوريا: حيث تُبّح الحناجر في الهتاف بحياة كبير الشعبويين: دونالد
ترامب.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
كلينتون وترامب
على مسارح الكونغرس
صبحي حديدي
في منتصف الأسبوع الماضي نشرت الـ«الغارديان» البريطانية مراجعة دايڤيد
جون تايلور لكتاب جديد وقّعه دوريان لينسكي وصدر مؤخراً تحت عنوان
«وزارة الحقيقة: سيرة رواية جورج أرويل ‘1984’». وفي تصدير مراجعته
هذه، أشار تايلور إلى أنّ مبيعات الرواية قفزت بنسبة 9,500٪ (على ما
يحتويه هذا المعدّل من شطط منطقي في قياس آلاف على مئة!)؛ وذلك في
مناسبة تسلّم دونالد ترامب مهامّ رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد لا يكون الأمر جديداً، أو مفاجئاً تماماً، إذا استعاد المرء
التاريخ «العريق» الذي يجمع بين أمريكا وهذه الرواية تحديداً، ابتداء
من أنساق استغلالها الكثيرة، المبتذلة في معظمها، خلال عقود الحرب
الباردة؛ مروراُ بانقلابها إلى مادّة دائمة على جداول أعمال المكارثية،
في لجان الكونغرس بصفة خاصة؛ وليس انتهاءً بلجوء المخابرات المركزية
إلى توظيفها، في ميادين شتى. كذلك لن يكون جديداً التذكير بقفزات أخرى
دراماتيكية حققتها مبيعات الرواية خلال مراحل إحالة الرئيس الأمريكي
الأسبق بيل كلينتون إلى اللجنة القضائية في الكونغرس، على خلفية فضيحة
مونيكا لوينسكي.
يومذاك، كانت المناخات حافلة بكلّ ما يوفّره المسرح من دراما سياسية
وبوليسية وقضائية، فبات المواطن الأمريكي، المتوسط والقياسي، يصل الليل
بالنهار وهو يكدّس معرفة كاملة الشفافية (نقيض تلك الأرويلية التي
تسردها «1984»)؛ حول تفاصيل الحياة الجنسية لرئيسه الحبيب، الذي انتخبه
مرّتين. كل شيء، تقريباً: أيّة فانتازيا جنسية تستهويه أكثر، أيّ شعر
إيروسي يلهب مخيّلته، أيّ الأماكن هي الأنسب للغرام، أيّ الأوقات، أيّ
الثياب… وآنذاك تحدّث البعض عن الأبعاد النفسية الأعمق وراء هذا السعار
الجماعي المحموم لهتك الأستار الحميمة، وأتيح لنا أن نقرأ بعض كبار
المنظّرين الليبراليين وهم يذكّرون الدهماء بأن تفاصيل الحياة الشخصية
مكوّن أساسي في صناعة الوجود الإنساني المتمدّن (كما ينبغي أن يُقارن
بالوجود الإنساني البربري، في الأدغال على سبيل المثال!).
فإذا صحّ أنّ مراسم تسلّم ترامب مهامّ رئيس القوّة الكونية الأعظم قد
عادت برواية أرويل إلى واجهة المكاتب، فتسللت مجدداً إلى سويداء هواجس
ذلك الأمريكي إياه، القياسي المتوسط؛ فإنّ الصحيح الرديف هو أنها تؤوب
اليوم إلى صدارة القراءات، ليس بصدد الجدل حول نشر تقرير المحقق الخاص
روبرت موللر، منقحاً أم كاملاً؛ بل في ضوء ما يتردد من مشاريع حول
إمكانية محاكمة ترامب بتُهَم عديدة، على رأسها عرقلة العدالة. الزمن
بين كلينتون وترامب تغيّر كثيراً، بالطبع، وحجم استهانة الأخير
بالقوانين المرعية والتحايل عليها لا يقبل المقارنة في الحدود الدنيا؛
إقراراً لحقيقة واقعة، وليس إنصافاً لشخص كلينتون. فهل تغيّر هوس ذلك
المواطن الأمريكي، أو تبدّل شغفه؟
لن يكون جديداً التذكير بقفزات أخرى دراماتيكية حققتها مبيعات الرواية خلال مراحل إحالة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى اللجنة القضائية في الكونغرس، على خلفية فضيحة مونيكا لوينسكي.
رئيس اللجنة القضائية في الكونغرس الحالي، جيرولد نادلر، ديمقراطي هذه
المرّة؛ وليس جمهورياً، كما كانت الحال مع هنري هايد، كبير «المدراء»
الذين أداروا الاتهام حول فضيحة لوينسكي. لكنّ سلسلة خصال شخصية تبدو
وكأنها تساوي بين الرجلين، لجهة وطأة العمر والشيخوخة، وحسّ البلاغة
الكلاسيكية، وتعب الذاكرة، والنسيانات المتكررة، والانضباط بالروتين
القضائي والتمسّك برطانته… بيد أنّ ترامب، بالمقارنة مع كلينتون، محظوظ
والحقّ يُقال، على صعيد أي مقارنة بين نادلر الراهن وهايد الراحل؛
وشتان بين عضوَيْ الكونغرس هذين، من حيث الشطارة والمهارة و… الأداء
المسرحي!
كان هايد ذرب اللسان، تراجيديّ المحيّا، دائم التهدّج، تكاد العبرات
تفيض من عينيه كلما اعتلى المنبر ليشرح هذه أو تلك من حيثيات إدانة
كلينتون. وكان لا يكفّ عن الاستعانة بعبارة من الروائي الأمريكي وليم
فوكنر تارة، ومن قصائد وليام شكسبير أو ديلان توماس طوراً («أعطونا
الحقيقة، وسنمضي لطفاء، في الليل اللطيف»، كان يردّد)؛ من نصوص «العهد
القديم» حيناً (والوصايا العشر بصفة خاصة)، وخُطَب عظماء أمريكا
الأسلاف حيناً آخر.
غير أنّ هذا كلّه أمر مختلف عن سمة أخرى كبرى في شخصية هايد: أنه كان
الدكتور جيكل أيضاً، تماماً كما في رواية ر. ل. ستيفنسون الشهيرة، حيث
ينشطر الآدميّ إلى كائنين متناقضين، خيّر وشرير. ذلك لأنّ هايد كان رجل
فضائح مالية وسياسية وقانونية، وسبق للكونغرس أن أوصى بتغريمه مبلغ 850
ألف دولار، عقاباً له ولعدد من زملائه على إهمالهم الشديد في متابعة
مسؤوليات إحدى اللجان، الأمر الذي كلّف دافع الضرائب الأمريكي خسارة 68
مليون دولار! وفي عام 1983 هبّ للدفاع عن زميله وابن حزبه دانييل كرين،
الذي ثبتت عليه إقامة علاقة جنسية مع وصيفة في الكونغرس عمرها 17 سنة:
«التراث اليهودي ــ المسيحي يقول: أمقتوا الخطيئة، وأحبّوا الخاطىء»،
هتف هايد… متهدج الصوت، كالعادة!
وفي مقالة مسهبة، نشرتها مجلة «نيويوركر» تحت عنوان «1984 أرويل
وأمريكا ترامب»، شرح آدم غوبنك طرائق ترامب في ممارسة الكذب: «إنه
يكذب، ثمّ يكرّر الكذبة، ومستمعوه إمّا أن يجبنوا فزعاً، أو يتلعثموا
غير مصدّقين، أو يحاول بعضهم معرفة إمكانية تحويل الكذبة لصالحهم».
وعلى نحو أو آخر، يذكّر ترامب بما كان أرويل قد أصاب في تشخيصه: محاربة
الكذبة لا تصبح أكثر خطورة فقط، بل ببساطة أكثر إرهاقاً من تكرارها!
ولا مناص من مسرح، إذن، وبلاغة جوفاء، وجعجعة بلا طحن!
(القدس العربي) لندن
لم تَسْخُن بين واشنطن
وطهران إلا لتبترد؟
صبحي حديدي
يتصفح المرء القسم الدولي في موقع صحيفة “نيويورك تايمز” ليوم أمس، السبت 18/5/2019؛ فيجد خبر الصدارة مخصصاً للانتخابات في أستراليا، ثمّ مادة عن احتمالات الإرهاب داخل مجموعة “المهاجرون” في بريطانيا، وثالثة عن خيبة أمل الصينيين في أمريكا كطرف تجاري، ثمّ انهيار فنزويلا من وجهة نظر أهل الاقتصاد… الخبر الإيراني (أنّ أوروبا تُبلغ واشنطن ألا يُحسب حسابها في أية مواجهة أمريكية مع طهران)، يأتي في الترتيب السابع، وبعد تقرير عن صفقة السلام في كولومبيا، وآخر عن الاقتصاد التركي.
ذلك مؤشر جدير بأن يؤخذ بعين الاعتبار، حتى إذا أصرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيف أخبار هذه الصحيفة؛ إذْ كانت، وتبقى في الواقع، حاضنة أبرز التسريبات وأبكرها حول التسخين العسكري الراهن في الخليج العربي، وأسباب انتقال البيت الأبيض إلى مستوى دراماتيكي في حشد الحاملات والفرقاطات والقاذفات الستراتيجية. فهل يعني تراجع أنباء التوتر العسكري بين واشنطن وطهران أنّ السخونة أخذت تبترد تدريجياً، لتبقى في حدود التراشق الكلامي والمناوشات اللفظية، خاصة من جانب ضباط “الحرس الثوري” الإيراني؟
إنه في كلّ حال لا يعني أنّ أيام التوتير، القصيرة نسبياً في الواقع، انقضت من دون أن تسدي خدمات ملموسة لأولئك الذين تقصدوا ضبط إيقاعها على هذا النحو، تحديداً ربما، وفي واشنطن أكثر بكثير من طهران عملياً. ففي المقام الأوّل، ليس مبالغة الافتراض بأنّ أمثال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، خرجوا من الاختبار بحصيلة ملموسة حول الحدود القصوى لردود الأفعال الإيرانية، عسكرياً أوّلاً وفي مياه الخليج تحديداً، ثمّ ستراتيجياً على مستوى تصعيد التهديد بالإنابة (عن طريق الميليشيات التابعة) ضدّ القوات الأمريكية في العراق، وضدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان وجنوب لبنان. وكانت الحصيلة، ببساطة واختصار: جعجعة بلا طحن!
كذلك اختُبرت جيوب إيران المختلفة في المنطقة، وكيف يمكن أن تدخل على خطّ التوتير بين واشنطن وطهران، على نحو غير لفظي، هذه المرّة؛ وما إذا كانت قمينة بتولّي مواجهات عسكرية فعلية بالإنابة، تربك انتشار القطعات العسكرية الأمريكية في المنطقة من دون أن تستدعي تورطاً إيرانياً عسكرياً مباشراً. هنا أيضاً، اقتصر الاختبار على “تخريب” ناقلات النفط الراسية في الفجيرة، واستهداف بعض المنشآت النفطية السعودية بطائرات مسيّرة؛ وتلك حصيلة رمزية، رغم ما انطوت عليه من اختراقات أمنية غير مسبوقة.
وقد يكون الاختبار الأبرز لخيارات الإنابة هو ذاك الذي شهده العراق، ليس بوصفه سلّة النفوذ الإيراني الإقليمية الأولى في المنطقة، فحسب؛ بل كذلك لأنّ الميليشيات التابعة هناك تخضع لإدارة “الحرس الثوري” مباشرة، في نماذج كثيرة؛ ولأنّ بعضها، ثانياً، مندمج قانونياً في تركيب الجيش العراقي النظامي؛ ولأنّ الكثير منها لا يعمل على نطاق العراق وحده، ثالثاً، بل هو منتشر خارجه كذلك. ولقد اتضح، بأسرع مما كان يُظنّ في الواقع، أنّ الاجتماع السياسي العراقي غير مهيأ لفتح البلد ساحة اصطراع إيرانية ــ أمريكية، في ضوء إلى الاشتباك المعقد لتواجد البلدين على أرض العراق؛ وأنّ أحد أبرز عناصر ذلك الاجتماع كان موقف حوزات شيعية كبرى، شاءت النأي بنفسها عن التصعيد العسكري رغم بقائها في حال جلية من التعاطف مع طهران ومناوءة واشنطن.
ويبقى أنّ مبتدأ التسخين كان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضدّ طهران، وأنّ أحد أهدافها غير المعلَنة كان استدراج القيادة الإيرانية إلى فخّ التراجع عن بعض بنود الاتفاق النووي، الأمر الذي يدقّ إسفيناً في علاقات طهران مع رعاة ذلك الاتفاق. من نافل القول، إذن، أنّ تراجع أخبار الاحتقان العسكري إلى مراتب خلفية ليس سوى علامة، بين أخرى مقبلة أغلب الظنّ، على أن جرعات الابتراد أو التبريد باتت سيدة اللعبة.
القوتلي وعبد الناصر
والآلهة السورية
صبحي حديدي
في سنة 1961، ضمن واحد من مقالات «بصراحة» التي اعتاد نشرها في
«الأهرام» المصرية، روى محمد حسنين هيكل أنّ شكري القوتلي (1891 ــ
1967)، الرئيس السوري يومذاك، وجّه إلى الرئيس المصري جمال عبد الناصر
العبارة التالية، تعليقاً على توقيع اتفاقية الوحدة بين البلدين في
شباط (فبراير) 1958: «أنت لا تعرف ماذا أخذت ياسيادة الرئيس! أنت أخذت
شعباً يعتقد كلّ من فيه أنه سياسي، ويعتقد خمسون فى المائة من ناسه
أنهم زعماء، ويعتقد 25 فى المائة منهم أنهم أنبياء، بينما يعتقد عشرة
فى المائة على الأقل أنهم آلهة».
للتذكير، بادئ ذي بدء، كتب هيكل مقالته تلك بعد وقوع الانفصال، في
أيلول (سبتمبر) 1961، وكان استطراداً يبرئ ساحة عبد الناصر وزعماء مصر
الآخرين إزاء صعوبات حكم الشعب السوري؛ إذْ كيف يمكن، حقاً، حكم شعب له
هذه المواصفات الخارقة، والخرقاء! العبارة، ثانياً، وعلى جري عادة هيكل
في سرد أقاصيص جرت بين أموات ولم يعد يشهد على صدقها سواه، لم تجرِ على
لسان القوتلي أغلب الظنّ؛ فلا سند يثبت صحتها أوّلاً، كما أنها لا تشبه
شخصية الرجل سلوكاً وخطاباً ثانياً، ولا تقترب البتة من أيّ من آرائه
النقدية في أبناء بلده.
الطريف، مع ذلك، أنها عادت إلى أذهان بعض المتابعين الغربيين للملفات
السورية المعاصرة، خاصة بعد انطلاقة الانتفاضة الشعبية في آذار (مارس)
2011؛ وباتت أقرب إلى «مسطرة» تُقاس على معطياتها معضلات قراءة المشهد
السوري الراهن، سياسة واجتماعاً وعلم نفس وتربية وثقافة ومزاجاً… توماس
هيغهامر، الباحث المخضرم في «مؤسسة أبحاث الدفاع» النرويجية، يصف
العبارة بأنها «اقتباس خالد»، متناسياً (أم لعلّه لم يدرك البتة) مقدار
التنميط السطحي والغبي في تصنيفات كهذه؛ خاصة إذْ تأتي من هذا الرجل
تحديداً. نيكولاس فان دام، مؤلف «الصراع على السلطة في سوريا: السياسية
والمجتمع تحت حكم الأسد والبعث» ومؤخراً «تدمير أمّة: الحرب الأهلية في
سوريا»، يتواضع قليلاً فيرتاب في أنّ العبارة منتحلة، لكنه يحيل
المعجبين بها إلى كتّاب سيرة القوتلي!
ثمة نزوع استشراقي مبطّن، يسعى إلى ترسيخ «حقيقة» أخرى نمطية خالدة، حول واحد من أكثر شعوب الشرق الأوسط انغماساً في السياسة؛ شاءت أقداره أن تستبدّ به عائلة طغيان وفساد واستئثار عائلي وطائفي، اشتغلت منهجياً على قتل السياسة في النفوس، طوال نصف قرن تقريباً.
وسوى الطرافة، ثمة نزوع استشراقي مبطّن، أو هو صريح مكشوف لدى الكثيرين
في الواقع، يسعى إلى ترسيخ «حقيقة» أخرى نمطية خالدة، حول واحد من أكثر
شعوب الشرق الأوسط انغماساً في السياسة؛ شاءت أقداره أن تستبدّ به
عائلة طغيان وفساد واستئثار عائلي وطائفي، اشتغلت منهجياً على قتل
السياسة في النفوس، طوال نصف قرن تقريباً. وهذه، إذن، خلاصة تبيح القول
إنّ حافظ الأسد، وبعده وريثه بشار، ورهط مجرمي الحرب والقتلة واللصوص
والأزلام الذين شاركوهما السلطة على نحو أو آخر، بلغوا المرحلة الراهنة
من تدمير سوريا لأنّ البلد استعصى قبلهم على القوتلي، ثمّ على عبد
الناصر، فكيف لا يستعصي على آل الأسد أيضاً!
ولعلّ هذه مناسبة لاستعادة واحدة من أنصع الصور الفوتوغرافية وأندرها،
ليس في تاريخ سوريا الحديث وحده، بل في تاريخ العرب أيضاً كما أجيز
لنفسي القول. الصورة تعود إلى عام 1955، وتحديداً يوم 6 أيلول
(سبتمبر)، وتُظهر رجلين يتبادلان التوقيع على وثيقة من نسختين: الأوّل
هو هاشم الأتاسي (1875 ــ 1960) رئيس الجمهورية آنذاك، والثاني هو
القوتلي رئيس الجمهورية المنتخب، وأمّا الورقة التي تبادلا التوقيع
عليها فهي وثيقة انتقال السلطات الدستورية. ألا يصحّ الافتراض بأنّ هذه
الممارسة، الديمقراطية والحضارية والراقية، باتت اليوم غريبة على أبصار
العرب وأسماعهم في مشارق أرضهم ومغاربها؛ وافتقدتها ــ إذْ لم يحدث
أنها تكرّرت مراراً في حياة ــ الأجيال العربية بعد ذلك التاريخ؛ حين
استولى أصحاب العروش والتيجان والقبعات العسكرية على مقاليد الأمور،
وتراجعت السياسة إلى الباحة الخلفية، أو قبعت في الزنازين، أو تلقفتها
المنافي هنا وهناك؟
للصورة فتنة أخرى زاهية الألوان غير جمالياتها بالأبيض والأسود، يصنعها
نصّ تلك الوثيقة التي جاء في سطورها: «جرى انتقال السلطات التي خوّلها
الدستور لحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد هاشم الأتاسي إلى
حضرة صاحب الفخامة السيد شكري القوتلي الذي انتخبه مجلس النوّاب رئيساً
للجمهورية (…)، وقد شهد ذلك صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسي رئيس مجلس
النواب والأستاذ صبري العسلي رئيس مجلس الوزراء والسيد وجيه الأسطواني
رئيس المحكمة العليا…». وبالطبع، لا يفوتكم ملاحظة ترتيب السلطات
الثلاث الشاهدة على التوقيع: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية!
وللتذكير بسجايا الرجل الذي اختزل قامته أمثال هيكل ونفر المستشرقين
الهواة، يُشار إلى قول آخر مأثور أطلقه في وجه ونستون تشرشل حين اجتمع
به في السعودية، فخاطبه بعد أن التفت إلى البحر القريب: «شعبنا لن
يكبّل وطنه بقيد العبودية والذلّ والاستعمار حتي لو أصبحت مياه هذا
البحر الزرقاء حمراء قانية». هذا إلى جانب أنه تخلى طواعية عن منصبه
كرئيس للجمهورية السورية، منتخب ديمقراطياً ومحبوب من شعبه وصاحب حظوة
واحترام في العالم، مقابل تحقيق الوحدة السورية ــ المصرية.
لكنّ أطرف ما في حكاية هيكل أنّ عبد الناصر، الألمعي اللماح، لم يتملكه
الفضول فيسأل عن الفئة التي يضع القوتلي نفسه فيها: الزعماء أم
الأنبياء أم الآلهة!
(القدس العربي) لندن
سؤال القرن أم حلم طوباوي:
هل تعود الاشتراكية حقاً؟
صبحي حديدي
في كتابه الجديد «هل خسر الغرب»، الذي يضيف مفردة «استفزاز» كعنوان
فرعي للكتاب، يساجل السنغافوري كيشور محبوباني، الأكاديمي والدبلوماسي
السابق، بأنّ الرهانات التي خسرها الغرب منذ مطلع القرن الحادي
والعشرين ليست كثيرة ومتعددة فقط؛ بل هي حمّالة تبعات جسيمة عابرة
للعقود، وعابرة للمفاهيم والتصورات التي يصنفها الغرب اليوم في باب
المسلّمات والبديهيات. المتغيّر الأكبر في تباشير القرن الراهن كان
التالي، من وجهة نظره: منذ السنة 1 وحتى 1820 ميلادية، كانت الأمّتان
الأبرز على صعيد الاقتصاد العالمي هما الصين والهند. بعد ذلك فقط تمكنت
أوروبا، لتلتحق بها أمريكا بعدئذ، من الهيمنة؛ إلا أنّ تفوّق هذين
القطبين في الأداء أمام الحضارات الأخرى ظلّ نسبياً، وهو اليوم يشهد
تراجعاً أقرب إلى النكوص، ومقادير متفاوتة من الركود كذلك.
والكاتب الألماني يوخن بيتنر، المحرر السياسي لصحيفة «دي تسايت»، يقتبس
محبوباني في التعليق على ظاهرة الحنين إلى الاشتراكية، التي أخذت تزحف
بتؤدة منهجية إلى قلب الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، وخاصة
منظمات الشبيبة فيه. وقبل أيام استضافته صفحة الرأي في «نيويورك تايمز»
حول هذا الموضوع، فكتب مقالة بعنوان «لماذا تعود الاشتراكية إلى
ألمانيا؟»؛ تناول فيه بصفة خاصة تصريحات كيفن كوهنيرت زعيم منظمة
الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حول طراز «النيو ــ
اشتراكية» كما يرى الأخير أنها باتت ضرورة تاريخية في ألمانيا
المعاصرة. فلننسَ الاشتراكيات الأمريكية كما يدعو إليها أمثال بيرني
ساندرز أو ألكساندرا أوكازيو كورتيز، ينصحنا بيتنر، فاشتراكية كوهنيرت،
ابن الـ29 سنة، تذهب نحو الصميم: السيطرة الديمقراطية على الاقتصاد،
واستبدال النظام الرأسمالي وليس إعادة ضبطه أو تعديل معاييره.
ولا يتردد كوهنيرت في الحديث عن إجراءات أقرب إلى التأميم بخصوص شركات
مثل
BMW،
حيث يتوجب على العمال أن يمتلكوا فيها حصصاً حقيقية وفعلية وفاعلة، فمن
دون حلول مثل هذه «لا يمكن التغلب على الرأسمالية»، يقول الرجل. وأمّا
بخصوص الأنظمة العقارية، فإنّ كوهنيرت لا يستوعب شرعية «نموذج في
البزنس ينطوي على كسب العيش عن طريق مساحة معيش أناس آخرين. لكلّ امرئ
الحقّ في امتلاك مساحة معيش خاصة به يسكن فيها». لا شرعية، كذلك، لفحوى
نظام رأسمالي قائم على المعادلة التالية: «سباق يشرع فيه ملايين الناس،
فلا يصل إلى خطّ النهاية سوى قلائل، يصرخون على اللاهثين في الخلف أنه
كان في وسعهم بلوغ نهاية السباق!».
أسباب المعلّق السياسي الألماني في تفسير هذا التطلّع إلى الاشتراكية،
داخل الشرائح الشبابية في بلده ألمانيا، تبدأ من حيث يشاء إفراغ
الظاهرة من مضامينها الاجتماعية، رغم أنّ هذه المضامين تحديداً هي جوهر
أيّ تجسيدات فعلية على الأرض لما يحلم به القيادي الشابّ في الحزب
الاشتراكي الديمقراطي. بيتنر يتحدث، مثلاً، عن إغواء مواجهة ردّ فعل
ما، على شاكلة الزعم بانتصار الرأسمالية ونهاية التاريخ وسيادة السوق؛
بردّ فعل معاكس، هو الحنين إلى اشتراكية ديمقراطية مختلفة عن أنظمة
المعسكر الاشتراكي البائد، واستعادة نبض التاريخ. بل هو يعود إلى
الآباء المؤسسين للنظام الاقتصادي في ألمانيا الغربية، في الحزب
الديمقراطي المسيحي سنة 1947 مثلاً، ممّن اعتبروا أنّ «النظام
الاقتصادي الرأسمالي لا يخدم مصالح الشعب الألماني». لهذا فقد بُنيت
ألمانيا الغربية على فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث يجري تثمين
التنافس الفردي، وفي الآن ذاته يُجبر الأثرياء على معاضدة الأقلّ حظاً.
واليوم، في عيد العمّال العالمي، وفي قلب اعتمالات اجتماعية ــ سياسية صاخبة ليس عسيراً أن نشهد استقطابات عميقة تتحرّك في السطوح الأعمق من السياسة اليومية، الميدان المعلن الذي يتبدّى فيه عجز الاقتصاد الرأسمالي عن تطويع الحياة اليومية
بمعزل عن هذا، وسواء اتخذت حكاية عودة الاشتراكية إلى ألمانيا صفة
الحلم الطوباوي (نقيض «الحلم الأمريكي» البغيض، كما يساجل كوهنيرت)، أو
باتت سؤال القرن بامتياز؛ فإنّ ظواهر الخلل في المجتمعات الرأسمالية
المعاصرة لا تخفي على ذي بصيرة، ولا ينكرها أو يتنكّر لمفاعيلها كبار
أساطين التفكير الرأسمالي الاقتصادي والاجتماعي الراهن. وفي الوسع
العودة إلى عقدين سابقين في عمر الرأسمالية المعاصرة، ثمّ ضرب المثال
من اقتصاديات الشطر الآسيوي في النظام الرأسمالي، وليس الغربي وحده
(الذي سوف تكفيه الأزمة الكبرى لأصول المصارف والرهون العقارية لسنة
2007).
ففي عام 1997 كانت شركة «يامايشي» للسندات والأسهم والمضاربات قد أعلنت
إفلاسها (وعلى نحو دراماتيكي جدير بأكثر تراجيديات وليام شكسبير توتراً
ومأساة، إذْ ظهر المدير التنفيذي للشركة في نقل حيّ على الهواء، وانخرط
في بكاء مرير، معلناً الإفلاس). تلك كانت الشركة التي احتلّت المرتبة
الرابعة في لائحة كبرى بيوتات السندات المالية الخاصة في اليابان،
وعراقتها تعود إلى عام 1897، ولها فروع في 31 عاصمة رأسمالية، بكادر من
المستخدمين يتجاوز 7000 موظف. ذلك كله لم يحصّنها ضدّ سلسلة من الفضائح
المالية، وسلسلة ثانية من تقلبات أسعار الأسهم، وسلسلة ثالثة من صعوبات
تأمين التمويل؛ الأمر الذي أفضى إلى خسارة صافية مقدارها 25 مليار
دولار أمريكي، وإلى إعلان الإفلاس والإغلاق.
وفي معظم أطراف المعسكر الرأسمالي المعاصر (إذْ لا يزال يستحقّ صفة
«المعسكر»، حتى مع غياب المعسكر الاشتراكي النقيض)، في فرنسا كما في
الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان؛ تتابع أخلاقيات السوق
العيش وفق قواعد «ثقافة الرضى» حسب تعبير المفكر الاقتصادي الكبير جون
كينيث غالبرايث. إنها جسم إيديولوجي اجتماعي ـ اقتصادي يلبس لبوس
الديمقراطية (حين لا تكون هذه خيار مجموع المواطنين، بل أداة أولئك
الذين يقصدون صناديق الاقتراع دفاعاً عن امتيازاتهم الاجتماعية
والاقتصادية)؛ وتفرز أجهزة حكم لا تنطلق في تطبيقاتها السياسية من مبدأ
التلاؤم مع الواقع والحاجة العامة، بل من طمأنة الخلايا الدقيقة
المنعمة والراضية، التي تصنع الأغلبية الناخبة. والفكر الاجتماعي
الرسمي من حول هذه الثقافة لا يلحّ على قضية أخرى قدر إلحاحه على
الطبقة، أو بالأحرى على غياب مفهوم الطبقات. وبدلاً من هذا التوصيف
الكابوسي الذي يرجّع أصداء الماضي، يلجأ ذلك الفكر إلى البلاغة؛ فيتحدث
في أمريكا عن «الطبقة السفلى»
Underclass،
وفي فرنسا عن الذين «بلا عنوان دائم»
SDF،
وفي بريطانيا عن «المشردين»
Homeles.
لكنّ المحتوى في جميع الأحوال يصف ملايين الفقراء والعاطلين عن العمل،
ويصف طبقات جديدة، وأخرى عتيقة.
لكنّ الموقف من الزمن التاريخي (أي ذاك الذي يرتد إلى الماضي من
المستقبل، مروراً بالحاضر) هو إحدى السمات المكوّنة في لاهوت ثقافة
الرضى التي تحدث عنها غالبرايث. إنها لا تنكر التأزّم (حيث يتعذر
الإنكار)، لكنها تسعى إلى تأجيل الفعل اللازم لحلّه، وتنحّي جانباً كلّ
ما يثير الاضطراب: مظاهرات، إضرابات، نتائج انتخابية تقلب المعادلات
الراسخة رأساً على عقب… واليوم، في عيد العمّال العالمي، وفي قلب
اعتمالات اجتماعية ــ سياسية صاخبة مثل «السترات الصفراء» في فرنسا،
وبعد مرور أكثر من عقد ونصف على النظريات التي تبشّر ببزوغ فجر
الرأسمالية واقتصاد السوق مرّة وإلى الأبد؛ ليس عسيراً أن نشهد
استقطابات عميقة تتحرّك في السطوح الأعمق من السياسة اليومية، الميدان
المعلن الذي يتبدّى فيه عجز الاقتصاد الرأسمالي عن تطويع الحياة
اليومية. ويكفي أن يتابع المرء ما يجري في أيّ من البلدان الرأسمالية
الأساسية، في أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، بصدد السياسة أو
الاقتصاد أو الاجتماع أو الثقافة أو الحرب أو السلام… لكي تبدو المساحة
الدلالية بين الحلم الطوباوي وسؤال القرن وكأنها تعيد إحياء، أو لعلها
تعيد التحريض على التفكير في، نبوءة ماركس الرهيبة: حول برجوازية لا
تملك سوى أن تخلق حفّاري قبورها!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
مجزرة سريلانكا وأسئلة
الإرهاب غير الكلاسيكية
صبحي حديدي
ما الذي يدفع اثنين من أبناء محمد يوسف إبراهيم، أحد مليارديرات
سريلانكا وتاجر البهار والتوابل الأبرز في البلد، إلى حمل عبوة ناسفة
وتفجيرها في كنيسة اجتمع رعاياها للاحتفال بعيد الفصح؟ وأية سلسلة
معقدة من الحوافز، إذْ لا يعقل أنها أحادية الطابع، دينية متطرفة أو
تستمدّ عناصرها من مظلومية إثنية وتاريخية، شاءت لهذَين المنعمَين برغد
العيش وأرفع الدراسة وأهنأ البال وأدفأ الحياة العائلية، أن يختارا
صيغة انتحار «جهادي» أو «استشهادي» تودي بحياة عشرات الأرواح البريئة؟
وهل تكفي الخلاصة المعتادة، الصائبة مع ذلك، التي تشير إلى أنّ
الإرهابي أعمى، وأنّ الانتحاري لا يُبصر إلا ما يُزيّن له من مثوبات
وغنائم في الحياة الآخرة التي تعقب إزهاق روحه بيديه؟
هي أسئلة كلاسيكية أثارتها «مجزرة الفصح» الأخيرة في كنائس وفنادق على
امتداد الجزيرة، وستظلّ تثيرها مجازر الإرهاب المماثلة هنا وهناك في
العالم؛ حيث يبقى البحث عن إجابات ملموسة مسقوفاً بالاعتبارات
الكلاسيكية ذاتها، التي يحدث مراراً أنها تحجب فرصة الذهاب أبعد نحو
الجذور، واستقصاء الظاهرة من زاوية التعليلات الخارجة عن التقليدي
والمستعاد والمتكرر. على سبيل المثال الأوّل، لماذا ضرب الإرهاب
الكنائس المسيحية وليس المعابد البوذية، رغم أنّ تاريخ المظالم بحقّ
المسلمين يشير بالاتهام إلى أتباع الديانة الثانية، وليس الأولى؟ سؤال
آخر يمكن أن يتوقف عند التوقيت، وما الذي يمكن أن تخدمه هذه الرسالة
الوحشية الدامية، في هذه المرحلة من حياة سريلانكا، أو ربما في هذا
الطور من واقع الإسلام والمسلمين في شرق وجنوبي شرق آسيا إجمالاً؟
وأخيراً، هل ثمة بالفعل مقدار من حسّ الضحية لدى إنصاف وإلهام، نجلَيْ
ملياردير البهار والتوابل، على وجه التحديد؛ يكفي لاقتيادهما إلى هذه
الدرجة القصوى من إراقة الدماء؟
للمرء أن يبدأ من حقيقة تاريخية، أو بالأحرى اجتماعية ــ تاريخية،
مفادها أنّ عمر الجالية المسلمة في سريلانكا يعود إلى 1000 عام على
الأقلّ؛ أياً كانت تصنيفات هذا الإسلام: أصول تعود إلى التجار العرب،
أو تنويعات على إسلام شبه القارّة الهندية، أو مجرّد ديانة منفصلة
إثنياً عن الغالبية السنهالية ومختلطة من جانب آخر مع أقلية التاميل.
التفصيل الأهمّ في هذا أنّ العلاقات بين البوذية والإسلام، وبين
السنهالية والإسلام التاميلي استطراداً، ظلت قائمة على وئام وسلام حتى
أواخر القرن التاسع عشر، مع دخول عاملَين حاسمين على الواقع
السريلانكي: الاستعمار البريطاني، ثمّ صعود النظام الإقطاعي على خلفية
ما أقامته السلطات الاستعمارية من شبكات ولاء وامتيازات. في أيار
(مايو) سنة 1915 سوف تقع أولى أعمال العنف الإثنية بين البوذيين
السنهاليين والمسلمين، ولسوف تتكرر في سبعينيات القرن المنصرم، وكان
انتهاء الحرب الأهلية (1983 ــ 2009) بانتصار الجيش السريلانكي
واستسلام «نمور التاميل» فرصة سانحة لنهوض تيارات بوذية متطرفة وضعت
استهداف المسلمين ضمن سلّة مطالب قومية ومذهبية وهوياتية.
ما الذي يمكن أن تخدمه هذه الرسالة الوحشية الدامية، في هذه المرحلة من حياة سريلانكا، أو ربما في هذا الطور من واقع الإسلام والمسلمين في شرق وجنوبي شرق آسيا إجمالاً؟
غير أنّ تاريخ سريلانكا الحديثة الذي يبدأ من منتصف القرن التاسع عشر
هو أيضاً، كما يشير م. أ. نعمان أستاذ دراسات التاميل في جامعة
بيرادينيا، تاريخ تطوّر الوعي الإثني وصراعات الأقليات: بين السنهال،
والتاميل، والمسلمين. ولعب الدين، إلى جانب اللغة، أدواراً رئيسية في
التشكيلات الإثنية خلال مراحل الاستعمار وما بعد الاستعمار؛ حيث كان
لكلّ من الناطقين باللغة السنهالية أو التاميلية أقليات فرعية في صفوف
البروتستانت والكاثوليك والبوذيين والمسلمين، وتشكلت على أساس ذلك
مجموعة لغوية سنهالية تضمّ البوذيين والمسحيين معاً، ومجموعة لغوية
تاميلية تضمّ الهندوس والمسيحيين. هذا فضلاً عن لجوء النًخب السياسية
والاقتصادية، الإقطاعية على وجه الخصوص، إلى توظيف العوامل الدينية
واللغوية في استقطاب الجماعات الإثنية وممارسة مختلف أنساق الهيمنة
والاستغلال. هذه الفسيفساء الغنية، والمتزاحمة المتنافسة في آن معاً،
خضعت لاعتبارات شتى في عقود ما بعد الاستقلال، وأسفرت عن انحيازات أعلى
توتراً واحتقاناً بعد انتهاء الحرب الأهلية، وشيوع الفساد وحكم
العائلات.
كذلك يصحّ وضع حال المسلمين في سريلانكا ضمن خريطة أوسع، تشمل مظالم
أشدّ وطأة في الواقع، تبدأ من الروهينغا في ميانمار، ولا تنتهي عند
مسلمي المالاوي في تايلاند. وهنا أيضاً يُثار تساؤل منطقي: ألم يكن
حرّياً بحاضنة الإرهاب أن تترعرع في أوساط مسلمي هاتين الفئتين، بدل ما
شهدناه من نماذج التشدد الجهادي والتطرّف العقائدي لدى زهران هاشم
و«جماعة التوحيد الوطنية» في سريلانكا؟ الإجابة تصبح نافلة، في واقع
الأمر، لأنّ خريطة هذا الطراز من الإرهاب الجهادي لا تبدأ من السؤال
المنطقي، ولهذا فإنها لا توفّر إجابة منطقية من أيّ نوع؛ وفي هذا
الإطار من البحث عن جذور الظاهرة، وخلفياتها السياسية والاجتماعية
العابرة للمؤثر العقائدي والآصرة الإثنية. بهذا المعنى فإنّ استهداف
الكنائس، والفنادق التي استقبلت «المحتفلين بعيدهم الكفري» حسب بيان
«داعش» الذي أعلن تبنّي المذبحة، ليس له من معاني المظلومية أو ثأر
الضحية إلا النزر القليل والصلة الواهية.
وهكذا يتوجب أن تعيدنا هذه الحال إلى ما يشبه «كتلة منطق» مبسطة تحكم
كلّ واقعة إرهابية، ربما مع استثناءات جدّ محدودة وقليلة ونادرة: 1)
أنّ الضربة الإرهابية لا تميّز، قبل التنفيذ وخلاله وبعده، بين «بريء»
و«مذنب»، أياً كانت الدلالة التي يقرنها التنظيم الإرهابي بهاتين
المفردتين؛ ولكنها 2) لا توحّد بالضرورة، ولا تقيم موازنات انسجام أو
حتى تنافر، بين هذا أو ذاك من الأيدي المنفذة، ممّن يلتقون حول الوسيلة
والغاية من دون تباين أو تلاقٍ في عناصر الاجتماع والثقافة والتجنيد
العقائدي. لهذا فإنّ السؤال الكلاسيكي، حول دافع نجلَيْ ملياردير
التوابل والبهار في الانتحار وإزهاق الأرواح، يصبح غير ذي معنى في
مستوى تشخيص الجريمة؛ لكنه يحمل الكثير من المعنى، والإلحاح والضرورة،
في مستوى الذهاب نحو الجذور. قبل مظالم مسلمي آسيا، وقبل تسيّد أسامة
بن لادن و«القاعدة» و«داعش»، ضرب الإرهاب في عشرات الأماكن، واختلطت ــ
في قراءة نوازعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية… ــ تفاصيل التربية
العائلية والحياة اليومية والسلوك العام والأمزجة النفسية والنزوعات
الفكرية والثقافية، وما إليها.
وبالطبع، في وسع المرء أن يعدّ، فلا يستنفد مهما أحصى، سلسلة الجرائم
التي ارتكبتها «داعش» في العراق، أوّلاً، ثمّ في سوريا بعدئذ؛ وأن يسرد
مجلدات في جرائم هذه المنظمة الإرهابية، وفظائعها ومباذلها؛ وأن يختار
من سجلّها الحافل أية واقعة شنيعة، مهما خفّت بشاعتها، لكي يستخلص أنّ
«داعش» ليست من الإسلام في شيء، وأنها ـ على نقيض تامّ ممّا تعلن ـ
ظهيرة الطغاة وأنظمة الاستبداد والفساد. ليس هذا هو المطلوب الملحّ، مع
ذلك، على أهمية ممارسته دائماً، ودون كلل أو ملل. ما يُطلب على نحو
أهمّ، وأشدّ إلحاحاً، هو التيقّظ على العوامل المختلفة، السياسية
والاجتماعية والثقافية، التي أتاحت صعود «داعش»، وتتيح وضعها في القلب
من معظم سيناريوهات التخريب والتفكيك والتقسيم، فضلاً عن التجهيل
والاستغلال والتحريف، التي يتعرّض لها الاجتماع الوطني في كلّ من
العراق وسوريا على حدّ سواء.
وليس أسهل من إدانة الإرهاب الأعمى، والتضامن مع الضحايا، وتأثيم
«داعش» وسواها بأشنع الألفاظ. الأجدى، في المقابل، والأصعب بالطبع، هو
محاولة اختراق دماغ إنصاف وإلهام محمد يوسف إبراهيم، السريلانكيَين
اللذين انتبذا عن المليارات مسافة دامية قصوى، وذهبا إلى سفك الدماء
البريئة دون أن يرفّ لهما جفن. هنا مكمن الأسئلة غير الكلاسيكية، التي
تضرب عميقاً في الجذور، ولا تكتفي بخدش السطوح وحدها.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
أفي شلايم
ومراثي تشييع الصهيونية
صبحي حديدي
تحت عنوان «بنيامين نتنياهو وموت الحلم الصهيوني» احتلت مقالة أفي
شلايم، المؤرّخ الإسرائيلي البريطاني من أصول عراقية، صدارة الصفحة
الأولى في صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس؛ وشاء التحرير استكمال الطابع
الدرامي، الذي انطوى عليه العنوان أصلاً، فأضاف الاقتباس الاستهلالي
التالي: «آباء إسرائيل المؤسسون يتقلبون في قبورهم». ورغم أنّ هذه
النبرة النقدية والاتهامية الحادّة ضدّ نتنياهو، واليمين الإسرائيلي
القوموي والديني إجمالاً، ليست جديدة على شلايم (مؤلف «الجدار الحديدي:
إسرائيل والعالم العربي» كما تشير الصحيفة، وقبله «تواطؤ عبر نهر
الأردن» و»سياسة التقسيم» و»الحرب والسلام في الشرق الأوسط» كما تجدر
الإضافة)؛ فإنّ خلاصات المقالة، المستمدة جوهرياً من فوز نتنياهو في
الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، ليست جديدة تماماً: لا بمعنى جديد
شلايم نفسه، أوّلاً؛ ولا جديد دولة الاحتلال، ثانياً وأساساً.
منذ عشرينيات القرن الماضي، يساجل شلايم، انقسمت الحركة الصهيونية إلى
مجموعتين طرحت كلّ منهما أفكاراً متنافسة حول الدولة اليهودية: الأولى
ليبرالية، جسّدها دافيد بن غوريون، الأب المؤسس، قائد حزب العمل، ورئيس
الوزراء الأطول عهداً في المنصب؛ والثانية يمينية، قادها زئيف
جابوتنسكي، مؤسس «الصهيونية التنقيحية». الأوّل، حسب شلايم دائماً،
جسّد «الحلم الصهيوني الليبرالي بدولة يهودية حرّة، مستقلة متساوية»؛
والثاني طالب بـ»دولة يهودية قوموية تفرض سيادتها على كامل الأراضي بين
ضفتي نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط». وأمّا نتنياهو، الذي يوشك على
تجريد بنغوريون من لقب رئيس الوزراء الأطول ولاية، فإنه يدشن انتصار
«الصهونية التنقيحية» بعد 100 عام على ولادتها، لكنه في واقع الأمر
أكثر محافظة وتطرفاً من المؤسس جابوتنسكي؛ لأنّ الأخير آمن، على
الأقلّ، بطراز من «عدم الاكتراث المهذّب» تجاه المطامح الوطنية
للفلسطينيين، وأمّا الأوّل فإنه يعتمد تجاههم مبدأ «العداء النشط
المتعنت».
وبمعزل عن واقعة ولاية نتنياهو الخامسة، التي أسقطت بن غوريون عن عرش
الديمومة الأطول، فهل نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة هي
المناسبة الأولى، أو حتى الأبرز، لتشييع ما يُسمّى «الحلم الصهيوني»
إلى مدافن التاريخ؟ وما ذاك الحلم، في المقام الأوّل؟ وهل تجاوز حقاً
صياغاته الفلسفية، أو حتى تنظيراته السياسية، على أيدي «يسار»
الصهيونية أو «اليمين» فيها، أو حتى ما يُشاع أنه «الوسط»؟ يحقّ للمرء
أن يستذكر، هنا، وبصدد «الآباء» المؤسسين، مكانة أحدهم، أو آخر ممثليهم
في الواقع، شمعون بيريس: صانع البرنامج النووي الإسرائيلي، والآمر بقصف
ملجأ قانا (في جنوب لبنان، ربيع 1996)، ومفوّض جهاز الـ»شاباك» باغتيال
النشطاء الفلسطينيين («المهندس» يحيى عياش، مثلاً)، والشريك في حكومة
أرييل شارون… من جانب أوّل؛ وصاحب نظرية «الشرق الأوسط الجديد»، و»شيخ»
ما يُسمّى «معسكر السلام»، وحامل نوبل للسلام، من جانب آخر. بِمَ
اختلف، في ذلك النزوع المتأصل إلى ممارسة الإرهاب العاري، عن جميع
«ملوك إسرائيل الجدد»، ابتداءً من دافيد بن غوريون وغولدا مائير وموشيه
دايان ومناحيم بيغن، وليس انتهاء بأمثال إسحق رابين ونتنياهو وإيهود
باراك وشارون…؟
أم نعود أبعد في تاريخ دولة الاحتلال، فنذهب (مع شلايم أيضاً، وليس مع
مؤرّخ إسرائيلي آخر أكثر نزاهة مثل إيلان بابيه) نحو بن غوريون نفسه،
مؤسس «الحلم» دون سواه؛ لجهة أوهام «فريق الاستشراق» الذي هيمن على
تفكيره وصاغ معه أبكر حلقات التعنت الإسرائيلي تجاه التوسع والاستيطان
والسلام ومنظور «الدولة اليهودية» (في دراسة بعنوان «مقاربات متصارعة
في علاقة إسرائيل مع العرب، بن غوريون وشاريت، 1953 ــ 1956»، نُشرت
سنة 1983). بعد ثلاث سنوات، سوف ينشر شلايم بحثاً متميزاً بعنوان «حسني
الزعيم وخطة إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا»، تؤكد أن
الزعيم وفّر للحكومة الإسرائيلية فرصاً عديدة للتوصل إلى تعايش سلمي
بعيد المدى؛ رُفضت جميعها انطلاقاً من قناعة بن غوريون أنّ انقلاب
الزعيم كان لعبة بريطانية (واتضح لاحقاً، عند مايلز كوبلان في «لعبة
الأمم»، أنّ اللعبة كانت من صنع المخابرات المركزية الأمريكية).
أم نستذكر غولدا مائير، ابنة حزب العمل، ورابع رؤساء الحكومة
الإسرائيلية، وأوّل امرأة تتولى المنصب؛ التي اعتادت الشكوى من أنّ
المحاور العربي غير موجود، وأنها مستعدة دائماً للقاء أيّ زعيم عربي
لبحث السلام؛ حتى شاعت، حينذاك، نكتة تقول إنّ مغسلة مائير مفتوحة أمام
المفاوضات 24 ساعة يومياً. لكنها كانت صاحبة العبارة الشهيرة «يمكننا
أن نسامح العرب على قتلهم أطفالنا، ولكن لا يمكننا أن نصفح عنهم
لإجبارهم إيانا على قتل أطفالهم»؛ والتي وقفت ذات يوم قبالة شاطئ
العقبة، وقالت: «إنى أشمّ رائحة أجدادى في خيبر».
إنّ نتائج الانتخابات الأخيرة لا تمنح نتنياهو رقماً قياسياً في الحكم، ولا تشكّل استفتاءً إسرائيلياً على شعبية أفكاره وسياساته، فحسب؛ بل هي أيضاً النعوة الأحدث عهداً لحزب العمل، الحاضنة التاريخية للخطّ «العلماني» في الفلسفة الصهيونية
كانت مائير واجهة جيل من يهود أوكرانيا تقاطروا على «موطن الحلم»، لكي
ينقلبوا إلى صنّاع كابوس سوف يهيمن سريعاً، وحتى الساعة، على وجدان
غالبية ساحقة من مهاجرين شذّاذ آفاق؛ اغتصبوا أرض فلسطين وأقاموا
المستوطنات وفقدوا تدريجياً آخر الأوهام حول الـ»كيبوتز» بوصفه تجسيد
الفردوس الصهيوني في أرض الميعاد. ولم تكن مراسلاتها مع أنور السادات،
على طريق إبرام اتفاقية فكّ الاشتباك لعام 1974، سوى طبعة ما بعد حرب
تشرين الأول/ أكتوبر 1973 من ذلك المزيج الدائم بين بن غوريون
وجابوتنسكي.
رئيس الوزراء القتيل إسحق رابين كان جنرالاً أقطع الصهاينة من أرض
فلسطين ما لم يتوفر حتى للملك داود والملك سليمان، وبفضله تمكن
الحاخامات من التجوال في بطاح اعتبر أنبياء إسرائيل أنّ الربّ منحها
لهم إلى الأبد. وإلى جانب تعاليمه في سحق عظام» الفلسطينيين أثناء
الانتفاضة الأولى، فإنّ قارىء مذكرات رابين يدرك أنه، مثل السواد
الأعظم من الإسرائيليين يميناً ويساراً، كان يبغض الانفكاك عن حدود
1967 وما تستثيره في الوجدان اليهودي من غبطة ومشاعر قيامية. وقد
استخدم تعبير «نهار العمر كله» في وصف تلك البرهة الأكثر قداسة ورهبة
وغبطة في السنوات الـ45 التي انصرمت من عمره، حين توجّه في 7 حزيران
(يونيو) 1967 برفقة وزير الدفاع موشيه دايان لزيارة الحائط الغربي في
القدس: «يسهل عليّ أن أسترجع المشاعر التي انتابتني ساعتئذ، ولكن يصعب
كثيراً أن أترجم تلك المشاعر إلى كلمات. الحائط كان وما يزال واحداً من
معالم أمجاد الاستقلال اليهودي في غابر الأزمان. حجارته تمتلك قوّة
مخاطبة قلوب اليهود في العالم بأسره، وكأنّ الذاكرة التاريخية للشعب
اليهودي استقرّت في في شقوق مكعباته».
هؤلاء نماذج أربعة من حزب العمل، أو الرهط الذي يوحي شلايم أنه رفع
راية «الحلم الصهيوني»، ثمّ جاء أبناء جابوتنسكي وأحفاده لكي يشيعوا
إلى المدافن الإسرائيلية كلّ ما روّج له ذلك الحلم من «ليبرالية»
و»مساواة»؛ فلا تبرهن سجلاتهم، على امتداد تاريخ دولة الاحتلال، بما هو
أكثر سوءاً من سجلات أقرانهم في صفوف اليمين والأحزاب المتدينة. لهذا
فإنّ نتائج الانتخابات الأخيرة لا تمنح نتنياهو رقماً قياسياً في
الحكم، ولا تشكّل استفتاءً إسرائيلياً على شعبية أفكاره وسياساته،
فحسب؛ بل هي أيضاً النعوة الأحدث عهداً لحزب العمل، الحاضنة التاريخية
للخطّ «العلماني» في الفلسفة الصهيونية. لقد واصل هذا الخطّ هزائمه
المتعاقبة، وانتقل من مأزق إلى آخر، منذ أيار (مايو) عام 1977، حين
مُني بهزيمة تاريخية ماحقة جاءت بحزب الليكود واليمين القومي والديني
المتطرف إلى السلطة، للمرّة الأولى في تاريخ دولة الاحتلال.
فعلام، إذن، يفترض شلايم أنّ «الآباء المؤسسين» يتقلبون في مقابر تلك
الصهيونية العتيقة، التي سادت… وعلى أيدي أنبيائها بادت!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
نتنياهو الولاية الخامسة:
بين سرطان وخدش في القدم
صبحي حديدي
ليس من المبكر التثبّت من قيمة هدايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتننياهو، في فوز الأخير
بولاية خامسة على التوالي خلال انتخابات الكنيست الأخيرة؛ إذْ أنّ هذا
التأثير لم يكن هو الفارق، أصلاً، في ترجيح كفّة التحالف اليميني/
الديني الذي سوف يقوده نتنياهو، من موقع تحكّم أفضل وليس أسوأ. وعلى
المنوال ذاته يجوز أن تُقرأ هدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في
تسليم رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، القتيل في معركة السلطان
يعقوب في لبنان، 1982: تساعد قليلاً في تلميع صورة نتنياهو، لكنها ليست
ــ مثل هدايا ترامب أيضاً ــ «بيضة القبان» التي رجحت كفة الولاية
الخامسة.
في المقابل، كانت هدايا نتنياهو إلى نفسه، وإلى الأحزاب التي سوف
تتحالف معه (من قبيل إعلان العزم على فرض السيادة الإسرائيلية في مناطق
من الضفة الغربية لا تشمل أراضي المستوطنات وحدها، بل تذهب أبعد
وأوسع)؛ أرجح كثيراً في نفس الناخب الإسرائيلي القياسي، وأعمق تأثيراً
وسطوة. وهذه حال تعيد إلى الذاكرة تأويلات المؤرّخ الإسرائيلي ميرون
بنفنستي، على سبيل المثال فقط، لما أطلق عليه صفة «كارثة إسرائيلية»
تجسدها سيرورات ضخّ النزوعات الإيديولوجية في كلّ مناحي الحياة
الإسرائيلية، السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية: «حين سيكتب
المؤرّخ وقائع الكارثة ذات يوم، سوف يُتاح له على الأقلّ أن يضع هامشاً
أسفل الصفحة يقتبس فيه مراثي أنبياء القيامة ممّن ساروا على درب
الكارثة».
وفي وسع المرء أن يذهب إلى ليكودي، أمريكي هذه المرّة، هو دانييل بايبس
الذي رأى «فلسفة» الهدايا من زاوية خاصة تماماً، شديدة الارتباط
بجدليات العلاقات الأمريكية ــ الإسرائيلية؛ أي الصهيونية المسيحية،
ليس في عهد ترامب وحده، للإيضاح المفيد، بل طوال عهود سابقة وإدارات
متعاقبة. ومنذ مطالع رئاسة باراك أوباما، ورغم أنه أشبعه شتماً وقدحاً،
اعتبر بايبس أنّ هذا الطراز من الصهيونية هو «أفضل أسلحة إسرائيل»،
بالنظر إلى أهمية مواقف اليمين الأمريكي المسيحي المتعاطف مع دولة
الاحتلال، وكيف يتبنى هذا الصفّ مواقف متشددة تبدو خيارات بعض الساسة
الإسرائيليين «حمائمية» تماماً إلى جانبها.
تفسيره البسيط، أو التبسيطي تماماً في الواقع، يقول إنّ هذا النسق
السياسي ــ الفلسفي، الذي عبّر ويعبّر عنه أمثال غاري باور وجيري
فالويل وريشارد لاند، يعود بجذوره إلى العصر الفكتوري في بريطانيا،
وإلى العام 1840 حين أوصى وزير الخارجية اللورد بالمرستون بأن تبذل
السلطات العثمانية كلّ جهد ممكن من أجل تشجيع وتسهيل عودة يهود أوروبا
إلى فلسطين. كذلك كان اللورد شافتزبري هو الذي، في العام 1853، نحت
العبارة الشهيرة في وصف فلسطين: «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض». غير أن
ما يتحاشى بايبس الوقوف عنده هو السؤال التالي: لماذا لا يكون حماس
هؤلاء هو الوجه الآخر لفتور معظم الحماس الصهيوني عند الصهاينة، وميلهم
إلى اعتناق فكر بديل، نازي أو عنصري؟ ولماذا لا يكون رجال من أمثال
شمعون بيريس وإيهود باراك وأرييل شارون وإيهود أولمرت ونتنياهو… أكثر
راحة وهم يتمترسون خلف «عقلية نازية مضمرة»، من راحتهم وهو يتصرفون
كصهاينة؟
الارتباط العاطفي بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال بلغ درجة فاقعة صارخة فاضحة، تستدعي وضع كتاب كامل يرصد محطاتها منذ العام 1947
وذات يوم غير بعيد واجه نتنياهو تهمة الخيانة من هاجي بن ــ أرتزي،
شقيق زوجته، والقيادي البارز في «الحزب الديني القومي»، أو (المفدال)،
الذي حلّ نفسه وانضمّ أعضاؤه إلى حزب ديني متطرف آخر، هو «البيت
اليهودي». «حين يكون المرء مصاباً بالسرطان، فإنه لا يكترث بخدش في
القدم»، كتب بن ــ أرتزي؛ قاصداً بالسرطان الخطر النووي الإيراني،
وبالخدش فكرة الحلّ القائم على دولتين، إسرائيلية وفلسطينية. وهذا
اليهودي اليميني المتدين المتشدد، الذي يقيم في مستوطنة بيت إيل عن
سابق قصد وتصميم، يرفض خيار الخدش، ويعلن أنّ إقدام صهره نتيناهو على
القبول به سوف يجعل من الأخير خائناً بحقّ التوراة، ليس أقلّ!
خلال الحقبة ذاتها، وفي تعليقه على زيارة نتنياهو الأولى إلى الولايات
المتحدة خلال رئاسة أوباما، شاء الكاتب الإسرائيلي اليساري جدعون ليفي
أن يتمنى على الرئيس الأمريكي الاقتداء بسلفه الأسبق ريشارد نكسون في
إنقاذ دولة الاحتلال؛ مع فارق حاسم بالطبع: الأخير أنقذها من الجيوش
العربية سنة 1973، والأوّل ينبغي أن ينقذها من… نفسها! والحال أنّ
سلسلة التطوّرات السياسية الإسرائيلية الداخلية التي أعقبت توقيع
اتفاقيات أوسلو (اغتيال رابين، انتخاب نتنياهو في غمرة تحقير شمعون
بيريس، انتخاب إيهود باراك وتحقير نتنياهو، انتخاب شارون وتحقير باراك،
ثمّ انتخاب نتنياهو وتحقير «كاديما» وباراك معاً…)؛ لم تكن إلا سبيل
الإسرائيليين في التأكيد على أنّ نسبة ساحقة منهم لم تخرج من شرنقة
الانعزال العتيقة.
ومن محاسن أقدار الصهر والنسيب معاً، وسوء طالع ليفي، أنّ أوباما لم
يحرج ضيفه نتنياهو إلى أيّ مستوى قريب من ارتكاب الخيانة، أو الخدش في
القدم، يومذاك؛ فاكتفى بالعموميات والتأتأة الدبلوماسية في كلّ ما يخصّ
الحقوق الفلسطينية، وصال وجال في البلاغة والخطابة، مشدداً على التزامه
المطلق بأمن «إسرائيل، الدولة اليهودية». ولقد بدا أنّ أوباما ونتنياهو
قد اتفقا، ضمن صيغة مكتومة من التواطؤ المكشوف، على تناسي ما دار
بينهما من حديث أثناء زيارة أوباما إلى إسرائيل؛ حين كان الأخير محض
مرشّح للرئاسة، وكان نتنياهو زعيم حزب «ليكود» الطامح إلى هزيمة
«كاديما». آنذاك، كما روى نتنياهو للصحافة، انزوى الرجلان بعيداً عن
الحشد، فقال الأوّل للثاني: «أنت وأنا نشترك في الكثير. لقد بدأتُ على
اليسار وانتقلتُ إلى الوسط. وأنت بدأتَ على اليمين وانتقلتَ إلى الوسط.
كلانا براغماتي يرغب في إنجاز الأمور».
الهدايا، إذن، ليست «عينية» بالضرورة بين دولة الاحتلال وأصدقائها
الخلّص، في البيت الأبيض كما في الكرملين؛ إذ سبق لها أن اتخذت صفات
رمزية «فلسفية»، أو توراتية/ مسيحية/ صهيونية، أو سلوكية وذاتية لها
صفة «الهوى» الشخصي المحض كما هي عليه اليوم حال ترامب. وفي قلب السجلّ
الكوني لعربدة الولايات المتحدة على صعيد العلاقات الدولية، تظلّ
الروابط الأمريكية ــ الإسرائيلية حجر زاوية، حيث يجري التضامن على
مبدأ نصرة الحليف ظالماً أو مظلوماً. وذات يوم بعيد هذه المرّة ــ في
سنة 1796! ــ حذّر الرئيس الأمريكي جورج واشنطن الأمّة الأمريكية من
الانخراط في «ارتباط عاطفي» مع أية أمّة أخرى؛ لأنّ «ذلك سوف يخلق
وهماً عامّاً بوجود مصلحة مشتركة، والحال أنه لا توجد مصلحة مشتركة بين
الأمم». بعد أكثر من قرنين ارتأى جورج بول (الدبلوماسي المخضرم، وأحد
أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي) أنّ هذا الارتباط
العاطفي بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال بلغ درجة فاقعة صارخة
فاضحة، تستدعي وضع كتاب كامل يرصد محطاتها منذ العام 1947.
ولقد نصح الساسة الأمريكيين باعتماد مبدأ المثلّث في تمحيص العلاقة،
بحيث يكون ضلع أوّل هو المصلحة القومية الأمريكية، وضلع ثان هو المصلحة
القومية الإسرائيلية، وضلع ثالث هو المصلحة القومية العربية. الأيّام
أثبتت، وما تزال، أن أضلاع المثلث الراهنة تسير على نحو مختلف تماماً:
ضلع أوّل هو المصلحة القومية الأمريكية، وضلع ثان هو المصلحة القومية
الإسرائيلية، وضلع ثالث هو المصلحة القومية… لليهود الأمريكيين! ولا
حاجة للتثبّت من مقادير خسائر وأرباح هذا المثلث عند رجل مثل نتنياهو،
في عهد رجل مثل ترامب؛ أو ما شاء المرء من زعماء على الطرفين، فالفوارق
ليست قاطعة.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
مناهضة الصهيونية
وانحطاط التشريع الفرنسي
صبحي حديدي
مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي سرق الـ»سكوب» من قصر
الإليزيه، ومن غالبية وسائل الإعلام الفرنسية، حين استبق الجميع فأعلن
أنّ بنيامين نتنياهو اتصل هاتفياً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وهنأه على… ما سيعلنه، الليلة، من مفاجأة سارّة، خلال خطبته في العشاء
السنوي لـ«المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا»، الـCRIF.
فعلى امتداد 34 سنة من عشاءات مماثلة، تردد عليها كبار مسؤولي فرنسا
وقادة أحزابها السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنقابية،
ابتداءً من رؤساء الجمهورية وليس انتهاءً بالصحافيين؛ حلم رجال الـCRIF
ونساؤه بهذه البرهة الإعجازية: أن يعلن رئيس الجمهورية اعتناقه مبدأ
التطابق بين العداء للسامية والعداء للصهيونية، أوّلاً؛ ثمّ، ثانياً
وليس أقلّ أهمية، الوعد بتشريع قانوني يجرّم أولئك الذين يرتكبون
«الإثم» الثاني، وكأنهم ارتكبوا الجرم الأوّل.
«العداء للصهيونية هو واحد من الأشكال الحديثة للعداء للسامية»، قال
ماكرون وصوته ليس أقلّ تهدجاً منه في تلك الفقرات التي حرص خلالها على
تعداد أسماء ضحايا العداء للسامية في فرنسا؛ مشدداً، حتى من باب انتهاج
الدراما، على أنّ الشرور واحدة في كلّ الأشكال، والتشريع المقترح سوف
يضيف العداء لدولة الاحتلال (من باب افتراض أنها روح الصهيونية ورمزها
ومؤسستها ودولتها…) إلى كلّ الأشكال الأخرى، قديمها وحديثها. ثمّ توجّب
أن ينافق قليلاً، من موقعه النيو ــ ليبرالي قبل ذاك الذي يخصّ رئاسة
جمهورية اليعاقبة، فيميّز هكذا: «الأمر لا يدور حول تعديل قانون
العقوبات، ولا أيضاً على منع أولئك الراغبين في نقد السياسة
الإسرائيلية من القيام بهذا». فعمّ يدور، إذن؟ «السماح بإقرار توصيات
تتيح التدريب الأفضل للموظفين العموميين من أجل مكافحة العداء
للسامية»، أردف ماكرون، الذي تفادى النطق بالعبارة الأصدق توصيفاً
للفارق بين العداء للسامية والعداء للصهيونية: أنّ الأوّل سلوك عنصري
وتمييزي ينطوي على خطاب الكراهية، والثاني حقّ مشروع في التعبير عن رأي
بصدد فلسفة سياسية ومؤسسة استيطانية وعنصرية.
وجهة النفاق الأولى كانت تنبثق من حقيقة أنّ ماكرون أعلن مرجعية كبرى
للتشريع الفرنسي الوشيك، تتمثل في الالتزام الرسمي بتعريف العداء
للسامية كما أقرته منظمة «التحالف الدولي لاستذكار الهولوكوست»، أو الـIHRA،
في مؤتمر بوخارست، صيف 2016. وهذا قرار ينصّ، بين حيثيات أخرى، على أنّ
العداء للسامية يمكن أن يتخذ المظاهر التالية: 1)»اتهام اليهود كشعب،
أو إسرائيل كدولة، باختراع الهولوكوست أو المبالغة فيه»؛ و2) «اتهام
المواطنين اليهود بأنهم أكثر ولاءً لإسرائيل، أو الأولويات المزعومة
لليهود على نطاق عالمي، من ولائهم لمصالح الأمم التي يتحدرون منها»؛
و3) «إنكار حقّ اليهود في تقرير المصير، أي الزعم بأنّ وجود دولة
إسرئيل مشروع عنصري»؛ و4) «استخدام رموز وصور مرتبطة بالشكل الكلاسيكي
من العداء للسامية (مثل الزعم بأنّ اليهود قتلوا المسيح) لتوصيف
إسرائيل أو الإسرائيليين»؛ و5) «عقد مقارنات بين السياسة الإسرائيلية
المعاصرة وسياسة النازيين…
الفارق بين العداء للسامية والعداء للصهيونية: أنّ الأوّل سلوك عنصري وتمييزي ينطوي على خطاب الكراهية، والثاني حقّ مشروع في التعبير عن رأي بصدد فلسفة سياسية ومؤسسة استيطانية وعنصرية
فما الذي يتبقى، والحال هذه، من هوامش في نقد السياسات الإسرائيلية،
على غرار الاستيطان (غير الشرعي في القانون الدولي)، أو مصادرة البيوت
والأراضي، أو تهديم المنازل السكنية، أو التصفيات الجسدية، أو اقتلاع
الأشجار، أو التمييز العنصري الصريح وفق قانون «هوية الدولة
اليهودية»…؟ وكيف للقانون أن يعامل آلاف اليهود الذين يعلنون، قولاً
وفعلاً، مناهضتهم للصهيونية، فلسفة ومؤسسات وكياناً وجيشاً؛ هل
يُعاملون معاملة أبناء الديانات الأخرى من حيث جناية العداء للسامية،
أم يتوجب اختراع تعريف آخر لهم، يتيح إمكانية استصدار تشريعات تكفل
تجريمهم؟ وكيف سيردّ مشرّعو حزب الرئيس الفرنسي على المؤرّخ الفرنسي
اليهودي دومنيك فيدال، حين يكتب: «إذا اعتبرنا معارضة نظرية تيودور
هرتزال عداءً للسامية، فإننا عندها نقول إنّ ملايين اليهود الذين لا
يرغبون بالعيش في فلسطين والأراضي المحتلة، معادون للسامية»؟
وهذه حال تعيد التذكير بسجال يهودي ــ يهودي جمع روجيه كوكيرمان، وكان
يومها يترأس الـ
CRIF،
وتيو كلاين الذي سبقه إلى رئاسة المجلس التمثيلي ذاته. الأوّل كان
يُسائل حقّ أيّ يهودي في انتقاد الحكومة الإسرائيلية، بل حقّ أيّ
متراخِ في الدفاع عن الكيان الصهيوني، وقد نشر في صحيفة «لوموند»
مقالاً شنّ فيه الهجوم على «قادة هذا البلد ممّن يقللون من أثر الأفعال
المعادية لليهود»؛ وعلى «السلطات التي يحلو لها أن ترى في الهجوم على
كنيس مجرّد عمل من أعمال العنف وليس فعلاً معادياً للسامية»؛ وعلى «بعض
اليهود الذين فقدوا الصلة بالواقع اليهودي»؛ وعلى «وسائل الإعلام التي
يطيب لها إعطاء أكبر صدى ممكن للأصوات التي تنتقد إسرائيل واليهود،
خصوصاً حين تكون تلك الأصوات يهودية.»… القضاء الفرنسي لم يسلم من
المضبطة الاتهامية، رغم أنّ الفرنسيين لا يحبّون مَن يشكك في نزاهة
قضائهم، فكيف إذا ذهب الإتهام إلى درجة الحديث عن غضّ نظر وتساهل
وتسامح مع «أعداء إسرائيل»؟
وكيف ستحكم محكمة فرنسية، في ضوء التشريع الجديد، على دعوى قضائية قد
يرفعها مواطن فرنسي (يهودي) ضدّ مواطن فرنسي آخر (مسيحي أو مسلم أو
بوذي، أو حتى يهودي…) نشر بحثاً تاريخياً حول «قضية كاستنر»، مثلاً؛
وهل سيجد القاضي فقرة في القانون تدين الباحث، على خلفية العداء
لليهود، أو العداؤ للكيان الصهيوني؟ معروف أنّ هذه القضية بدأت سنة
1945 حين بادر اليهودي الهنغاري مالكئيل غرينفالد (أحد الناجين من
الهولوكوست) إلى نشر كرّاس صغير يتهم فيه اليهودي الهنغاري رودولف
كاستنر (القيادي الصهوني البارز وأحد أقطاب الـ»ماباي»، حزب دافيد بن
غوريون) بالتعاون مع النازيين خلال سنتَي 1944 و1945. وفي الوقائع أنّ
كاستنر وافق، بعد تنسيق مباشر مع الضابط النازي المعروف أدولف إيخمان
قائد الـ»غستابو»، على شحن نصف مليون يهودي هنغاري إلى معسكرات
الإبادة؛ بعد أن طمأنهم كاستنر وبعض معاونيه إلى أنّهم سوف يُنقلون إلى
مساكن جديدة، حتى أنّ البعض منهم تسابقوا إلى صعود القطارات بغية
الوصول أبكر! وكان الثمن، في المقابل، هو إنقاذ حياة كاستنر وبعض
أقربائه، وغضّ النظر عن هجرة 1600 يهودي إلى فلسطين.
ماكرون اعتبر أنّ «العداء للسامية ليس مشكلة لليهود، بل هو مشكلة
للجمهورية»، وهذا صحيح بالطبع، مثله في ذلك مثل العداء لأية فئة إثنية
أو دينية على ركائز عنصرية او تمييزية، وليس على أسس الاختلاف في الفكر
أو السياسة أو الثقافة أو الاجتماع. وبهذا المعنى فإنّ جميع المعطيات
الإحصائية المتوفرة تشير إلى أنّ العداء للسامية بدأ، ويتواصل، كمشكلة
غربية (وليست البتة شرقية، في الأصول والعناصر والوقائع والنطاقات)،
تتجاوز أنظمة الحكم في الجمهوريات والملكيات والإمارات. «وكالة الحقوق
الأساسية»، التابعة للاتحاد الأوروبي، استفتت أكثر من 16 ألف مواطن
يهودي، في 12 بلداً أوروبياً؛ فاستخلصت أنّ 90٪ منهم شعروا بأنّ العداء
للسامية يتنامى في بلدانهم، وأنّ 30٪ منهم تعرّضوا بالفعل للمضايقة على
أساس الانتماء للديانة اليهودية. الأمر لا يقتصر على الجمهورية
الفرنسية، إذن، ولكنه من جانب آخر لا يتخذ بُعداً متماثلاً: يقول
استطلاع رأي آخر قام به الاتحاد الاوروبي في 28 بلداً، إنّ 98٪ من
اليهود أكدوا ازدياد العداء للسامية في بلدانهم، مقابل 36٪ من غير
اليهود قالوا إنهم لم يشعروا بذلك الازدياد.
صحيح أنّ الجمعية الوطنية الفرنسية لن تمرر القانون، الذي يزمع حزب
الرئاسة طرحه، دون تمحيص وتدقيق؛ إلا أنّ إقرار أية صيغة للمطابقة بين
العداء للسامية والعداء للصهيونية سوف يشكّل نقلة انحطاط كبرى في تاريخ
التشريع الفرنسي عموماً، والجمهورية الخامسة خصوصاً، وشطرها الذي يخصّ
ماكرون على وجه أخصّ.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
بوتفليقة وجنرالات الجزائر:
تعاقد التمديد المفتوح
صبحي حديدي
تقول النكتة إن أحد أطباء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فارق
الحياة، بعد صراع طويل مع أمراض الرئيس! احترام المرض، بوصفه ظاهرة
طبيعية تصيب الآدمي فتُقعده إلى كرسيّ نقّال، أو تعطّل وظائف جسمه
الحيوية أو تشلّ ملكاته العقلية، لا يُبطل المغزى السياسي والأخلاقي
الذي تثيره النكتة؛ عن حاكم يتربّع على رأس السلطة منذ 20 سنة، ويعتزم
اليوم الترشح لولاية خامسة، في انتخابات 18 نيسان (أبريل) المقبلة.
الأدقّ، بالطبع، هو القول بأنه لم يعلن هذا الترشيح الخامس بنفسه،
لأسباب شتى بينها أغلب الظنّ أنه لم يعد قادراً على النطق السليم؛ بل
أعلنت ترشيحه أحزاب التحالف الرئاسي: جبهة التحرير الوطني، التجمع
الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية.
صحيفة «الوطن» الجزائرية، التي تصدر بالفرنسية، كتبت تخاطب المواطن
الجزائري هكذا: «تخال نفسك في سنة 2019، ونقول لك كلا. إنما أنت ما
تزال في سنة… 2014»؛ لأنّ الزمن، عند «البطانة الرئاسية»، ما يزال
متوقفاً عند الدورة الرابعة للانتخابات الرئاسية! فمن الواضح، تتابع
الصحيفة، أنّ مظاهر الجمود والتلفيق والعنف الاستبدادي تظلّ هي ذاتها
خصائص السلطة الراهنة، رغم كلّ الضغوط الأخلاقية والسياسية والاقتصادية
التي مورست من أجل الانفتاح على حقائق الجزائر في العالم المعاصر.
وهكذا، لا حرج على الجزائري، الذي يصغي اليوم إلى أسباب التحالف
الرئاسي في إعادة ترشيح بوتفليقة، إذا تراءى له أنه إنما يصغي إلى
الأسباب ذاتها التي سيقت في امتداح «المجاهد» بوتفليقة سنة 2014:
«تقديراً لحكمة وسداد خياراته وتثميناً للإنجازات الهامة التي حققتها
الجزائر تحت قيادته».
لا جديد على مستوى الطرافة، أيضاً، إذْ بلغ عدد المتنطحين للمنصب 172
مرشحاً، أغلبهم دمى في أيدي الأجهزة الأمنية لإسباغ مقدار أدنى من روح
المسرح على الانتخابات؛ والقليل منهم يتزعمون أحزاباً وحركات سياسية،
لا تخفى مساهماتهم الحميدة في تصنيع الدراما ذاتها؛ وثمة مَنْ سبق له
أن ترأس الحكومة، أو حتى نافس بوتفليقة إلى آخر الشوط؛ ولا يعدم المشهد
جنرالات متقاعدين، وضباط أمن أفلت نجومهم… وفي قلب الكواليس، ثمة شقيق
الرئيس الذي يدير الكثير من الخيوط، ولا يحتاج المرء إلى كبير اتفاق مع
الصحافي الجزائري الإشكالي محمد سيفاوي لكي يصادق على توصيفه التالي:
«سعيد بوتفليقة في الجزائر هو ما كانت عليه ليلى طرابلسي في تونس»!
الأرجح، في المقابل، أنّ المرء يخطئ إذا ساجل بانّ بوتفليقة لا يحكم في
الجزائر، ليس خلال الدورات الثلاث الأولى وحدها، بل كذلك على امتداد
السنوات الخمس الماضية؛ التي صرف معظمها مقعداً، صامتاً، نزيل المشافي
العسكرية الفرنسية، مستبدلاً شخصه الفيزيائي بصورة فوتوغرافية. لقد حكم
بالفعل، ويواصل الحكم اليوم، ولعله سوف يواصله خلال الولاية الخامسة،
بعيداً عن أيّ لغز أو سرّ أو خفاء خارج المبدأ الأوّل والأخير: أنه رأس
البطانة الحاكمة والواجهة لها، في آن معاً؛ ومصدر توافقها وتصالحها
وتفاهماتها، في السراء كما الضراء؛ والقيّم على الفساد، والمافيات،
واقتسام ثروات البلاد؛ وأخيراً، ولس آخراً البتة: الخيار الأفضل للقوى
الخارجية، الجبارة، ذات الصلة بالجزائر وصاحبة المصلحة في الحفاظ على
«استقرار» النظام.
بلغ عدد المتنطحين للمنصب 172 مرشحاً أغلبهم دمى في أيدي الأجهزة الأمنية لإسباغ مقدار أدنى من روح المسرح على الانتخابات
هل في وسع رجل مريض، قعيد الفراش والكرسي النقال أن يتولى كلّ هذا؟
نعم، غنيّ عن القول، ما دامت معادلة حضوره في هذه العناصر كافة لا
تتطلب إلا احتلال مقدّمة المسرح، الذي في كواليسه يتوافق أعضاء
البطانة؛ بل حدث أحياناً أنهم إلى الواجهة احتكموا، ومن خلاله صدّروا
الانطباعات للجزائريين بإسقاط هذا الرأس أو الإطاحة بذاك، طبقاً
لقرارات الرئيس القعيد إياه. وفي بلد ترتعش الأفئدة فيه لدى استرجاع
سنوات الحرب مع الإرهاب الداخلي، وذاكرة 250 ألف قتيل سقط الكثيرون
منهم جراء مجازر ممسرحة دبرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية ذاتها؛ كيف
لا يبدو هذا الرئيس القعيد، أو حتى الرئيس/ الكفن، بمثابة أفضل خيارات
السوء؛ أو، على وجه الدقة، بديل خيارات الدم؟
الوقائع أشارت إلى أنّ الجزائر، خلال الأسابيع القليلة التي أعقبت
اندلاع انتفاضات ما يسمى بـ«الربيع العربي»، في 2010 تحديداً، شهدت
أكثر من 112,000 حالة تظاهر أو اعتصام أو احتجاج؛ لأسباب تتصل أولاً
بلقمة العيش والغلاء واشتراطات صندوق النقد الدولي، وليس إسقاط النظام
على وجه التحديد. لكنّ البطانة الحاكمة، في توظيف مناخات ترهيب
الجزائريين من عودة الإرهاب والمجازر تحديداً، تمكنت من إسكات الشارع
الشعبي، وإخماد موجات السخط المتعاظمة؛ بل أفلحت، كذلك، في جعل المواطن
رهينة البحث عن أسباب العيش اليومي البسيطة، الأمر الذي أتاح تمرير
برامج التعديل الاقتصادية والاجتماعية البغيضة. ولقد بدا أنّ التخوّف
من عودة عمليات «الجماعة الإسلامية المسلحة» و«الحركة الإسلامية
المسلحة» و«الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح» و«الجيش الإسلامي
للإنقاذ»، وسواها… أمّن للسلطة خير ساتر إزاء دائرة النقد الاجتماعي،
وبالتالي أتاح قبول بطانة بوتفليقة كجهة إنقاذ بديلة وحيدة، أياً كانت
موبقاتها.
وليست بعيدة عن المشهد تدخلات الولايات المتحدة في الجزائر، لصالح
الإبقاء على الوضع القائم عن طريق محاباة البطانة الرئاسية، في جانب
أوّل؛ والإشراف، في جانب ثانٍ، على ضمان ولاء الأجيال الشابة من ضباط
الجيش الجزائري، ممّن يتمّ تأهيلهم في الكليات العسكرية الأمريكية.
وليست بعيدة تلك المرحلة التي شهدت صمت البيت الأبيض عن حمامات الدم
التي وقفت وراءها أجهزة أمنية وعسكرية جزائرية، كانت الاستخبارات
المركزية الأمريكية على علم تامّ بها، وتجاهلها تماماً أمثال ريشارد
بيرل وبول ولفوفيتز ودونالد رمسفيلد وكوندوليزا رايس. ومن هنا كان حسين
آيت أحمد محقاً في إقامة الصلة بين مشروع بوتفليقة حول المصالحة
الوطنية (والهدف الفعلي هو تبييض ساحة الجنرالات بما يتيح استمرار
تحالفهم مع بوتفليقة، تمهيداً لتعديل الدستور)؛ وبين ما حظيت به رئاسة
بوتفليقة من تأييد فرنسي وأمريكي صريح، بدا فاضحاً أحياناً.
كذلك فإنّ ما حدث يوم 11 كانون الثاني (يناير) 1992 لم يكن أقلّ من
انقلاب عسكري صريح نفّذه جنرالات الجيش ومؤسسات الحكم المدنية
المتحالفة مع مختلف أجهزة السلطة. وباسم الدولة وحفاظاً عليها، بذرائع
صيانة السلم الأهلي ودرء الأخطار المحدقة بالوطن، انقضّ الجيش على
المؤسسات ابتداءً من رئيس الجمهورية آنذاك الشاذلي بن جديد، وانتهاء
بأصغر مجلس بلدي. كما فرض قانون الطوارئ، وألغى نتائج الانتخابات،
فانفتح الباب عريضاً على السيرورة (الطبيعية والمنطقية) للتحوّلات
الكبرى في الحياة السياسية عموماً، وتصاعدت خيارات العنف ضمن تيارات
الإسلاميين وأجهزة السلطة العسكرية والأمنية على حدّ سواء. من هنا بدأ
مشروع التعاقد مع الرجل/ الواجهة، وجرى تمديد آجال العقد حتى يشاء
الله!
أخيراً، كان مشروع «الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية»، الذي
اقترحه بوتفليقة، ضمن مسعى طيّ العقد الدامي الذي عاشته الجزائر بين
1992 و2003، قد حظي بنسبة «نعم» ساحقة بلغت 97٪، كما كان متوقعاً. لكنّ
ذلك المآل لم يطمس الضيق الشعبي الواسع إزاء النقص الفادح الذي اتسم به
المشروع، في ملفّين حاسمين وأساسيين: ملفّ المفقودين (إذ لم ينصّ
الميثاق على أية صيغة إجرائية ملموسة تضمن الكشف عن مصائرهم)؛ وملفّ
محاسبة الجنرالات والمافيات الأمنية، أو أية جهات حكومية سلطوية مارست
الخطف والاعتقال التعسفي والتنكيل بالمواطنين، فضلاً عن ممارسة الفساد
ونهب البلاد.
لم يطمس، ولكنه أيضاً لم يُطلق حركة معارضة شعبية كافية، منظمة وعابرة
للحساسيات المناطقية والثقافية؛ ولهذا فإنّ الدورة الانتخابية الخامسة
ليست سوى فقرة التمديد التلقائي في العقد القديم، بين الرئيس القعيد
وجنرالاته وبطانته.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
بندر بن سلطان وآل الأسد:
كم يوافق شنّ طبقة!
صبحي حديدي
في صحيفة «إندبندنت عربية»، أحدث مقتنيات ولي العهد السعودي محمد بن
سلمان في ميادين الإعلام، أجرى رئيس التحرير عضوان الأحمري حواراً
مستفيضاً مع بندر بن سلطان، «أمين عام مجلس الأمن الوطني السابق ورئيس
الاستخبارات في السعودية وسفيرها في واشنطن لأكثر من 22 عاماً»، حسب
توصيف المحاور. وفي ختام الجزء الأوّل، أسهب بندر في الحديث عن آل
الأسد، حافظ وبشار، خلال زيارات كثيرة قام بها إلى دمشق؛ حيث نقرأ عن
لقاءاته مع الأسد الأب، ثمّ وريثه، ثمّ بعض «رجال الرئيس»، أمثال عبد
الحليم خدام وفاروق الشرع؛ وبعض رجال الوريث، أمثال مناف طلاس. أقاصيص
الأمير تفوح منها، بقوّة في الواقع، روائح الاختلاق والتباهي الكاذب،
وادعاء دور في التسوية بين الأسد الأب ودولة الاحتلال الإسرائيلي لا
يقرّه العقل البسيط ولا مسرد وقائع تلك السياقات.
هو، مع ذلك، سلوك ليس غرض هذه السطور، التي تحاول تصويب ما يسرده بندر
لصالح إحقاق خلاصة كبرى، لعلها الأكثر فائدة في نهاية المطاف: أنّ آل
سعود، في شخص بندر تحديداً؛ وآل الأسد، في شخص الأب والوريث؛ يجسدون
خير تجسيد ذلك المثل العربي الشهير، عن شنّ الذي وافق طبقة؛ مع فارق
انعدام الدهاء والتدبير والذكاء والصدق، لدى الطرفين هنا، غنيّ عن
القول. لا بأس، إلى هذا، من اقتباس نموذج واحد على طريقة الأمير في
التكاذب؛ إذْ يروي أنّ أوّل مرّة سمع فيها «بشيء اسمه بشار الأسد» كانت
حين ناشده صديق سوري أن يتوسط لدى الحكومة البريطانية كي تقبل تخصص
طبيب العيون نجل الأسد، وأنه فعل، ووافق البريطانيون، وهكذا جاء بشار
إلى لندن.
يستغفل الأمير العقول، على النحو الأكثر ابتذالاً، حين يفترض أنّ قبول
أي طبيب أجنبي للتخصص يحتاج إلى موافقة حكومية بريطانية، وليس موافقة
الجامعة أو المشفى المعنيّ بالطلب، بمعزل عن إجراءات التأشيرة العامة
بالطبع. أو حين يتناسى حقيقة أنّ مجيء طبيب العيون ذاك إلى بريطانيا
كان ميدان تسابق محموم بين رجال أعمال سوريين، بعضهم مليارديرات تجارة
واستثمارات ونفط؛ ورجال مناصب دبلوماسية، بما في ذلك الجامعة العربية؛
ورجال جامعات عريقة وأكاديميات وبيوتات أبحاث، حتى تلك البريطانية
الكولونيالية العتيقة. ذلك لانّ الأسد الأب، ليس في حينه فحسب، بل على
امتداد سنوات حكمه منذ انقلابه العسكري في تشرين الثاني (نوفمبر) 1970؛
كان أثيراً لدى الحكومات البريطانية المتعاقبة، بسبب من سياساته التي
خدمت مشاريع الغرب في سورية والمنطقة عموماً، وكذلك لأنّ دولة الاحتلال
الإسرائيلي كانت راضية عن نظامه، كلّ الرضا.
ويروي بندر بعض تفاصيل تنصيب الوريث، وكيف (في حضرة الأمير شخصياً!)
كان يغلظ في القول لجنرالات الجيش، أو يطرد الشرع من الغرفة، أو يحكي
(للأمير دائماً) أنهم، بعد وفاة الأب، «أتوا بـ 10 عمادات مع قادة
المناطق ودخلتُ عليهم وقاموا بإلقاء التحية وبعضهم يترحم، وقلت لهم:
اششش… أنت ستغادر غداً، وأنت هذه السنة الأخيرة لك، أنت ستبقى، ما
سمعته على لسانك عني أعجبني، أنت سأقطع لسانك… أنت أخذت كم مليون دولار
حنحاسبك وأنت كذا وكذا… وبدأ بشار بتوزيع الـ «أنت» وبعدها ما سيفعله
بكل عماد والعماد هو أعلى رتبة عسكرية». ويسرد، أيضاً، خشية الأمير عبد
الله، ولي العهد يومذاك، من أنّ بشار «غليّم ما يعرف يحكي»، وأنّ
«سوريا تهمنا، ما نبغاها تسقط»؛ وكأنّ المملكة لم تكن على علم بتفاصيل
التوريث كافة، منذ موت باسل الأسد سنة 1994، وكيف تمّ سريعاً استبداله
بالوريث الثاني بشار.
سوى إعادة تثبيت المثل العربي، عن انطباق آل سعود وآل الأسد، ما الذي ترمي إليه صحائف محمد بن سلمان من نبش القبور اليوم، أمواتاً وأحياء
النقطة الأهمّ في الحوار هي ما ينقله بندر، على لسان الأسد الأب، عن
«الألم» الذي أصابه من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، حين
قرر الأخير «أن يغيّر المعادلة، وأعطى خطاباً لوزير الخارجية الأمريكي
موجهاً للرئيس الأمريكي يقول فيه أبلغ الأسد أنني موافق على الانسحاب
من الجولان، إذا تعهد لكم أنتم لا نحن، بإعادة العلاقات وغيرها، وأحد
الطلبات سحب الأسلحة الثقيلة إلى الحدود التركية». ويتابع بندر، على
لسان الأسد دائماً، أنه لو استغل تلك الفرصة «لكان الجولان لنا،
ولفتحنا سفارة لا نجعل أحد [كذا في أصل «الإندبندنت»] يعمل فيها، لكن
الفرصة ضاعت». في عبارة أخرى، الأمر هنا يتصل بما اتخذ بعدئذ تسميةً
شهيرة هي «وديعة رابين»، التي حملها وارن كريستوفر، وزير الخارجية
الأمريكي يومذاك، في آب (أغسطس) 1993. وهذه حكاية سوف يستعيدها الوريث،
كما استعادها الأب مراراً وتكراراً، وكلما دار حديث عن استئناف مسارات
التفاوض بين النظام ودولة الاحتلال.
ففي صيف 2007، خلال خطاب تتويجه لـ«رئاسة» ثانية، تحدث الأسد الابن عن
الوديعة هكذا (مرتجلاً، وفي الارتجال فضيلة افتضاح مكنون أوسع):
«المطلوب بالحدّ الأدنى تقديم وديعة على طريقة وديعة رابين أو شيء
مكتوب.. لكى نضمن بأنّ الحديث هو ليس حول الأرض التى ستعود.. لأن الأرض
ستعود كاملة. نحن نفاوض على أمور أخرى.. نحن نحدد هذا الخط.. خط الرابع
من حزيران/يونيو على الخارطة.. يتم النقاش حول موضوع الترتيبات
الأمنية.. العلاقات.. كما حصل فى التسعينيات أيام رابين». وكان الطرح
ذاك غريباً، من وجهة أولى مفادها ثقة الأسد في أنّ الأرض ستعود على
يديه وفي عصر نظامه، ولم يكن أحد سواه يدري بأيّ الوسائل سينجز هذه
المعجزة، وكيف.
غرابة ثانية هي جهل الوريث، أو تجاهله، بأنّ تلك الوديعة اقترنت منذ
البدء بخطأ من نوع ما، ارتكبته الأطراف الثلاثة في آن معاً. رابين أخطأ
حين حمّل كريستوفر رسالة «غير مدوّنة»، أو «لا ـ رسالة»
Non – Letter
كما استطاب البعض وصفها، ليست ملزِمة للإسرائيليين من الناحية
القانونية، ولكنها انقلبت إلى «زلّة تفاوض» إسرائيلية تمسّك بها الأسد
الأب وحوّلها على الفور إلى وثيقة مدوّنة ملزمة. وكريستوفر أخطأ حين
نكث بوعده لرابين (أن يبقي الرسالة في عهدته، وأن يضعها في خلفية
التفكير والمناورة ليس أكثر)، فباح بها أو ببعض عناصرها إلى الأسد،
ظانّاً أنه بذلك سوف يساعد في دفع الأمور. والأسد أخطأ حين تلكأ في
اغتنام الفرصة، ثم عاد ليطالب بها، ولكن بعد فوات الأوان.
الطريف أنّ بندر ينصّب نفسه مندوباً عن الجميع: الملك فهد، وليّ عهده
عبد الله، الرئيس الأمريكي بيل كلنتون، وزير خارجيته كريستوفر، رابين،
شمعون بيريس بعد مقتل رابين… كلّ هؤلاء، دفعة واحدة، خلال اجتماع مع
الأسد الأب في دمشق: «وقتها كنا أنا وحافظ نضع على الطاولة الخارطة
التي يمكن أن يعمل عليها الطرفان السوري والإسرائيلي، حتى ينتهي موضوع
الجولان»! وأمّا وجه الطرافة فإنّ المعلومات التي يسردها بندر عن
إشكالية الأمتار المتنازع عليها في محيط بحيرة طبرية، كان يعرفها أبسط
صحافي دولي مشتغل بالشأن التفاوضي هذا، وكان ضابط الاستخبارات السوري
بهجت سليمان يوجّه رجاله في الإعلام السوري لترويجها.
الأطرف، مع ذلك، هو أنّ الأمير بات نجماً ساطعاً في الملفّ السوري بعد
انتفاضة 2011، وكان بعض أقطاب «المعارضة» السورية الإسطنبولية يحجون
إليه، فرادى وجماعات؛ ثم أفل نجمه هنا، أسوة بنجومه كافة في ما بعد.
وسوى إعادة تثبيت المثل العربي، عن انطباق آل سعود وآل الأسد؛ ما الذي
ترمي إليه صحائف محمد بن سلمان من نبش القبور اليوم، أمواتاً وأحياء؟
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
قواعد الاشتباك الإسرائيلية:
مقوّمات العربدة
صبحي حديدي
أشارت تقارير صحفية إلى أنّ السفارة الأمريكية في بغداد حذّرت السلطات العراقية من احتمال قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقصف مواقع داخل الأراضي العراقية، تابعة لـ”الحشد الشعبي” ويديرها “الحرس الثوري” الإيراني بالطبع، تأوي مصانع أسلحة صاروخية مخصصة للتصدير إلى “حزب الله” اللبناني. فإذا صدقت هذه الأنباء، ووضع المرء في الاعتبار حقيقة أنّ واشنطن يندر أن تُفشل مسبقاً عمليات أمنية إسرائيلية حساسة، فإنّ المراد هو متابعة الضغط الأمريكي على الحكومة العراقية بصدد نفوذ إيران، عبر منظمات مثل “الحشد”، وميليشيات أخرى تدور في فلك طهران.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد ألمح، أثناء اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد مطلع الشهر، إلى أنّ واشنطن لن تتدخل ضدّ هجمات كهذه. كما نقل تقديراً إسرائيلياً صريحاً يفيد بأنه من غير المجدي قصف فصائل “الحشد” داخل سوريا (على غرار ما فعل الطيران الحربي الإسرائيلي في حزيران/يونيو الماضي، شرق دير الزور)؛ لأنها “تعود كلّ مرة إلى تنظيم صفوفها، والانطلاق من العراق مجدداً”.
وهكذا، بين عربدة، باتت دائمة ومتواصلة، في أجواء سوريا جنوباً وشرقاً وغرباً؛ وتدمير أنفاق “حزب الله” في الجنوب اللبناني، والانطلاق من الأجواء اللبنانية لقصف سوريا والعراق، الأمر الذي يرقى إلى أعمال الحرب الصريحة؛ ثمّ القصف، أيضاً، في العمق العراقي وليس على الحدود السورية ــ العراقية وحدها… تواصل دولة الاحتلال تثبيت قواعد اشتباك مع إيران، هي بمثابة مقوّمات واضحة المعالم، متماسكة العناصر، عالية الفاعلية، لا رادع لها ولا رقيب أو حسيب!
إنها، بادئ ذي بدء، تحظى بمصادقة واشنطن، وسكوت موسكو، وإغضاء أنقرة؛ بالنظر إلى أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي يتفادى، بمهارة واحتراف، ارتكاب “الضرر المجاور” حين يقصف هنا وهناك، فلا يصيب التحالف الدولي ولا الروس ولا الأتراك. وحين يقع المحظور (كما في إسقاط طائرة “إيل ـ 20” الروسية في سماء الساحل السوري، أيلول/سبتمبر الماضي)، فإنّ الخطأ وقع من جانب بطاريات النظام السوري، والحادثة ذات “أسباب عارضة” حسب تعبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وهي، تالياً، قواعد اشتباك تخدم غرضاً ستراتيجياً تتفق عليه القوى الكبرى الثلاث المنخرطة في الملفّ السوري راهناً، أمريكا وروسيا وتركيا؛ أي تحجيم النفوذ الإيراني، العسكري بصفة خاصة، على الأرض في سوريا؛ وخفض أوراق طهران عندما يحين أوان المحاصصة الفعلية وتقاسم الراهن والمستقبلي في البلد، وربما على نطاق الـLevant بأسره، وفقاً للتعبير العجيب الذي أحياه مؤخراً الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.
والقواعد، ثالثاً، لا تتوسل إشعال حرب إيرانية ــ إسرائيلية فعلية، شاملة، أو ساحقة ماحقة كما يقول التوصيف الشهير؛ بل هي نزالات مصغّرة تقصّ، ولا تقلّم فقط، أيّ أظافر إيرانية يمكن أن تستطيل أو تتقوى على امتداد كامل النطاق الجيو ــ سياسي الذي يقرّر الكيان الإسرائيلي أنّ خطوطه حمراء بالنسبة إلى أمنه. وبهذا فإنّ الغرض ليس استهداف قاسم سليماني شخصياً، ومثله حسن نصر الله، أو أبو مهدي المهندس قائد “الحشد” الفعلي؛ ولا حتى المقارّ، على الأراضي السورية، التي تختزن رموزاً “سيادية” إيرانية، مذهبية أو استخباراتية.
والقواعد، رابعاً، تعتمد في العمق السياسي على تبعية أنظمة عربية متهالكة مستبدة، فاسدة وفاشلة، تغدق مئات المليارات على عقود أسلحة لا يلوح أنها سوف تُستخدم في أيّ يوم، إلا ضدّ الشعوب. وتنخرط، سعيدة أو صاغرة، في مشاريع وصفقات تعلن تسوية النزاعات، لكنها تستبطن تصفية القضايا وإهدار الحقوق؛ فضلاً عن تورطها في صراعات عسكرية عربية وإقليمية، غايتها العظمى الأولى هي تهدئة المخاوف الداخلية إزاء آفاق انتفاض الشعوب وثوراتها.
فمنذا الذي يمكن أن يواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في سوريا أو في العراق أو في تلك الجثة الهامدة التي سُمّيت ذات يوم بـ”المقاومة اللبنانية”؟ وما الذي ينقص الكيان، أو ينغّص عليه، بعد اعتراف عبد الفتاح السيسي بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي يعمل في سيناء برخصة من… الرئاسة المصرية؟
أربعون الثورة الإيرانية:
زراعة بني صدر
وحصاد سليماني
في سنة 1979، وتحت عنوان «تحية إلى الثورة الإيرانية»، كتب أدونيس
(الشاعر السوري، النصيري بالولادة): «أفقٌ، ثورةٌ، والطغاةُ شَتات/ كيف
أروي لإيران حبي/ والذي في زفيري/ والذي في شهيقي/ تعجز عن قوله
الكلمات/ سأُغنّي لقُمٍّ لكي تتحول في صبواتي/ نارَ عصفٍ، تطوف حول
الخليج/ وأقول المدى والنشيج/ شعب إيران يكتب للشرق فاتحةَ الممكنات/
شعب إيران يكتب للغرب وجهُكُ يا غربُ مات/ شعب إيران شرقٌ تأصلَّ في
أرضنا ونبيّ/ إنه رفضنا المؤسِسُ، ميثاقنا العربي».
ولكي لا يبقى أدونيس وحده في الميدان، فيُعزى حماسه المشبوب هذا إلى
نوازع مذهبية، كتب نزار قباني (الشاعر السوري، السنّي بالولادة)،
ممتدحاً الثورة ذاتها: «زهّر اللوز في حدائق شيراز/ وأنهى المعذبون
الصياما/ ها هم الفرس قد أطاحوا بكسرى/ بعد قهر، وزلزلوا الأصناما/
شاهُ مصر يبكي على شاه إيران/ فأسوان ملجأ لليتامى/ والخميني يرفع الله
سيفاً/ ويغنّي النبيّ والإسلاما».
على الجبهة السياسية السورية، المعارِضة تحديداً، صدرت صحيفة «نضال
الشعب»، المطبوعة السرّية الناطقة بلسان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
السوري ـ المكتب السياسي (كما كان يُعرف يومذاك، قبل أن يتبنى الاسم
الجديد «حزب الشعب الديمقراطي»، بقرار من المؤتمر السادس، ربيع 2005)؛
وقد حملت على صفحتها الأولى ثلاث موادّ خاصة بانتصار الثورة الإيرانية،
ذات نبرة احتفائية عالية. «وجاءت القارعة»، «الثورة الإيرانية المنتصرة
تضع إيران على درب الحرية والديمقراطية والتقدم»، و«أصداء أولى للثورة
الإيرانية». وإذْ كانت الموادّ تهلل للثورة الإيرانية، من حيث النبرة
المعلنة، فإنّ النبرة الضمنية كانت تشير إلى استبداد حافظ الأسد:
«الوضع الإيراني مرتب، لا مجال لاختراقه. ومع ذلك تبيّن أنّ هذا
البنيان العظيم ضعيف الأساس. لقد تهاوى حجراً إثر حجر، فيا للثورة
المظفرة! لقد تفجرت إرادة الملايين من الناس مرّة واحدة ضدّ الظلم
والظلام. ملك الملوك أصبح لاجئاً عند أحد الملوك العرب الضالين، ذلك
أنّ شبه الشيء منجذب إليه. ينسى الطغاة دائماً وأبداً درس التاريخ
البسيط المكرر: العدل أساس الملك»….
اليوم، بعد 40 سنة على ذلك الحماس، حصد نظام آل الأسد، الأب والابن
الوريث معاً، ما حصدته غالبية أبناء سوريا من المآلات الراهنة للثورة
الإيرانية: التدخل العسكري المباشر لصالح النظام، عبر «الحرس الثوري»
وفيالق الجنرال قاسم سليمان، أو عبر عشرات الميليشيات المذهبية التي
يتصدرها «حزب الله» اللبناني. واليوم، لأسباب لا صلة لها بموقف إيران
من النظام السوري أو انتفاضة آذار (مارس) 2011؛ يصعب أن يتوقف أدونيس
عند الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية طبقاً لمنطق العام 1979، وبروحية
وجه الغرب الذي مات، أو أنّ شعب إيران هو النبيّ والرفض المؤسِّس
والميثاق العربي. وأمّا «حزب الشعب الديمقراطي» فلم يعد يرى في تلك
الثورة أقلّ من نظام آيات الله الثيوقراطي المذهبي الاستبدادي، المساند
لأنظمة الاستبداد والفساد؛ وهذا شبيه بمواقف معظم اليسار السوري
المعارض، حتى حين يرى البعض ذريعة ما، تمرّ من ثقوبها خرافات
«الممانعة» و«محور المقاومة».
لكنّ الجوهري أكثر هو ما آلت إليه تلك الثورة في حياضها الإيراني
تحديداً، وكيف تسارعت انقلاباتها الداخلية على ذاتها فلم تتوقف ــ منذ
شباط (فبراير) 1979، حين عاد آية الله روح الله الخميني من منفاه
الفرنسي إلى طهران ــ عن التهام صنّاعها تباعاً، ثمّ الإجهاز على
أبنائها المقرّبين، وصولاً إلى خيانة آمال تلك الشرائح الشعبية التي
انخرطت فيها وظلت رائدة لها حتى تكفلت بانتصارها. السيرورة ابتدأت من
رهط الإصلاحيين الأوائل، رئيس الوزراء الأوّل مهدي بازركان، ورئيس
الجمهورية الأول أبو الحسن بني صدر؛ إذْ لم يمض زمن طويل، يُعدّ
بالاشهر في الواقع، وليس بالسنوات، حتى كشّر آيات الله عن الأنياب
الحقيقية، المحافظة والمتشددة والمستبدة، التي تمقت الحريات العامة
وتبغض الحقوق المدنية وتحارب الرأي الآخر وتسعى إلى قتله في المهد.
خامنئي أبرز المتمسكين بالنصّ عليه في الدستور، بل وتشديد وتوسيع صلاحيات الوليّ الفقيه المنصوص عنها حالياً. الأسباب جلية، لا تخصّ الفقه بقدر ما تُبقي على ميزان القوّة في صفّ السلطة الدينية، على حساب السلطات المدنية
الأوّل كان ابن تاجر أذربيجاني مرموق، درس الهندسة الحرارية في باريس،
وعاد إلى جامعة طهران ليتولى عمادة كلية التكنولوجيا، ويقود سلسلة
احتجاجات ضدّ الشاه ودعماً لحركة محمد مصدّق. ورغم سجنه مراراً لم
يتوقف بازركان عن ممارسة الأنشطة المعارضة، فأسس «حركة المقاومة
الوطنية» سنة 1953، و«حركة التحرر الوطنية» سنة 1961؛ وبالتالي كان في
طليعة قادة التظاهرات المبكرة في طهران، التي آذنت بأفول عهد الشاه.
وكان أمراً طبيعياً أن يختاره الخميني لرئاسة أوّل حكومة مؤقتة، ثمّ
كان أمراً طبيعياً كذلك أن يناهضه المحافظون المتشددون، هاشمي رفسنجاني
وعلي خامنئي، على خلفية خططه الاقتصادية، ومعارضته لواقعة رهائن
السفارة الأمريكية. وهكذا، بعد تسعة أشهر في المنصب، تقدّم بازركان
باستقالته فقبلها الخميني؛ وتابع خصومه التنكيل به إلى درجة منعه من
الترشيح لانتخابات الرئاسة في دورة 1985، فكان المنفى السويسري هو
الخيار الوحيد المتبقي أمامه، حيث قضى في زيورخ سنة 1995.
الثاني كان أحد أبرز قادة المعارضة الطلابية لنظام الشاه، وقد سُجن
مرتين، وجُرح خلال انتفاضة 1963 المجهضة، والذي درس الاقتصاد في جامعة
السوربون وآمن بتلك الثنائية العصية التي تجمع الاقتصاد القومي
بالإسلامي، وكان في عداد قلّة من العائدين مع الخميني على الطائرة
ذاتها. ومن موقعه، الشرعي المنتخَب، كرئيس للجمهورية، ورئيس للمجلس
الثوري بقرار من الخميني، توجّب على بني صدر أن يجابه المحافظين إياهم،
رفسنجاني وخامنئي؛ فكتب إلى الخميني تلك الرسالة الشهيرة التي تقول إنّ
عجز الوزراء المحافظين أشدّ خطورة على الثورة من الحرب مع العراق، كما
عارض الإبقاء على رهائن السفارة الأمريكية، فلقي من البرلمان المحافظ
المصير الطبيعي: الإدانة بتهمة العجز والتقصير، والإقصاء من الرئاسة،
و… الفرار مجدداً إلى فرنسا، تحت جنح الظلام، بعد أقلّ من سنتين على
انتخابه.
من الإنصاف الافتراض، إذن، أنّ الزراعة الريادية، التي دشنها أمثال
بازركان وبني صدر؛ سوف يؤول حصادها إلى المرشد الأعلى الراهن علي
خامنئي، وإلى جنرالات «الحرس الثوري» أمثال قاسم سليماني. هذا على
مستوى الأمن والسياسة والأدوار الإقليمية، وأمّا على صعيد الاجتماع
البشري والعقيدة، فإنّ مبدأ «الوليّ الفقيه» هو الضمانة العليا
لاستمرار آيات الله في الاستئثار بالسلطات، كافة في الواقع. هذا
المبدأ/ القانون هو الركيزة الكبرى في صرح المدرسة الخمينية، وخلافتها
الخامنئية، وليست مبالغة أن يساجل المرء اليوم أنّ الأمل منعدم في
السير خطوات أبعد على الطريق الذي وُعدت به إيران في مثل هذه الأيام من
سنة 1979، وتحقيق انفراج داخلي إيراني، سياسي واجتماعي واقتصادي
وثقافي؛ ما لم يقف الإيرانيون موقف مراجعة راديكالية شاملة لعلاقة هذا
المبدأ بالحياة والحقّ والحقوق.
ففي نهاية المطاف، هذا مبدأ في «الحكم الإسلامي» صاغه الإمام الخميني
على عجل سنة 1971، حين كان منفياً في مدينة النجف العراقية، وخضع منذ
البدء لأخذ وردّ، واختلف فيه وحوله عدد كبير من فقهاء الشيعة. الثابت،
مع ذلك، أنّ خامنئي هو اليوم أشدّ المدافعين عنه، وأبرز المتمسكين
بالنصّ عليه في الدستور، بل وتشديد وتوسيع صلاحيات الوليّ الفقيه
المنصوص عنها حالياً. الأسباب جلية، لا تخصّ الفقه بقدر ما تُبقي على
ميزان القوّة في صفّ السلطة الدينية، على حساب السلطات المدنية؛ الأمر
الذي يفسّر الحماس للمبدأ في صفوف «حزب الله»، وحسن نصر الله شخصياً.
ذلك لأنه المبدأ الذي يحيل زراعة الاقتصادي بني صدر، إلى حصاد بمنجل
الجنرال سليماني!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
انتفاضة السودان:
مَنْ يتذكر الترابي؟
صبحي حديدي
اعتبر محمد مختار الخطيب، الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني، أنّ أطراف المعارضة التي تخرج اليوم من الحكومة لا مكان لها في قلب المعارضة المساندة للاحتجاجات الشعبية؛ ورغم أنّ الشعب “ربما يحفظ لهم صحوة ضميرهم”، إلا أنّ المطلوب هو “أن يلعبوا دوراً فعلياً في الاحتجاجات، ولا بدّ أن نراهم في الشارع مع المحتجين”.
طاغية السودان نفسه، عمر حسن البشير، يبدو غير مستعدّ بدوره لمنح الخارجين فضيلة التحاقهم بصفوف نظامه، وبعضهم انشقّ عن حزبه في هذا السبيل؛ فيسخر منهم (ويخصّ اثنين من حلفائه السابقين، غازي صلاح الدين من “حركة الإصلاح”، ومبارك الفاضل من حزب “الأمة”) هكذا: “إنهم درجوا على القفز من المركب كل مرّة، بحسبان إنها أوشكت على الغرق”.
غير أنّ الجدير بالمراقبة، في المقام الأوّل، هو أفق التحولات التي شهدها وسوف يشهدها حزب “المؤتمر الشعبي”، الذي أنشأه الشيخ حسن الترابي (1932 ــ 2016)؛ إنْ على صعيد العلاقة مع نظام البشير، أو في مستوى الحركات الإسلامية السودانية، وإزاء تطور شعارات الانتفاضة الشعبية ذات الصفة الطبقية والسياسية بصفة خاصة. يقرأ المرء تصريحاً لأحد قادة الحزب، الأمين عبد الرازق، ينصح فيه البشير بـ”مكافحة القطط السمان بدءاً من نفسه ثمّ أهل بيته”؛ مطالباً إياه بالاقتداء بالخليفة عمر بن عبد العزيز عندما بدأ مكافحة الفساد بنفسه فخلع ملابسه الثمينة، ثم أكمل فخلع من زوجته الذهب الذي جاءها هدية من والدها! أو يقرأ المرء خلاصة من قيادي ثان، إبراهيم الكناني، تعلن أنّ “تجربة الإسلاميين في الحكم كانت فاشلة ويا ليتها لم تكن”؛ متهماً شخصيات نافذة داخل حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم بوضع “متاريس أمام إنفاذ مخرجات الحوار الوطني”. وأمّا إدريس سليمان، الأمين السياسي للحزب، فقد رفض استخدام القوّة والعنف ضدّ المحتجين (!)، وطالب الحكومة بالتحقيق في حوادث القتل (!!) وحثّ السلطات على محاسبة المسؤولين (!!!).
علامات التعجب آتية من حقيقة أولى راهنة تشير إلى أنّ الحزب مشارك في الحكومة، وتولى أعضاؤه حقائب وزارية عديدة، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الجمهورية؛ ومن حقيقة ثانية، بعيدة الغور في الواقع، تخصّ العلاقة الأمّ بين الترابي وانقلاب البشير في العام 1989. فالشيخ لم يكن حليف، ومهندس الكثير من، سياسات البشير فقط، رغم خلافات لاحقة بينهما بلغت درجة اعتقال الأوّل؛ بل كان المنظّر الأوّل خلف واحدة من كبرى ذرائع الانقلاب، أي مفهوم “الحكم الإسلامي”. وبسبب من هذا، قيل ذات يوم إنّ الدول العربية تنزلق، مرغمة، في حمأة “الأصولية”؛ أما السودان فإنه الدولة الوحيدة التي اختارت ــ طواعية ــ أن يكون الإسلام هو نظام الحكم فيها!
“ما الذي يمكن أن يعنيه الحكم الإسلامي؟” سأل الترابي في واحدة من تنظيراته، وأجاب: “النموذج بالغ الوضوح، أما أفق الحكم فهو محدود، والقانون ليس توكيلاً للرقابة الاجتماعية لأنّ المعايير الأخلاقية والضمير الفردي شديدة الأهمية، وهي مستقلة بذاتها. لن نلجأ إلى ضبط المواقف الفكرية من الإسلام، أو قنونتها، ونحن نثمّن ونضمن حرية البشر والحرية الدينية ليس لغير المسلمين فحسب، بل للمسلمين أنفسهم حين يحملون قناعات مختلفة. إنني شخصياً أعتنق آراءً تسير على النقيض تماماً من المدارس السلفية في التشريع حول مسائل مثل وضع المرأة، وشهادة غير المسلم في المحاكم، وحكم الكافر”.
لكن نبرة الانفتاح والتسامح في فكر الشيخ كانت تعاني من قصور التطبيق الميداني والمواقف العملية، أوّلاً؛ وكانت، ثانياً، قد وُضعت في خدمة نظام استبداد وفساد، هيهات أن ينفع معه اليوم مطلب البدء من بيت الطاغية في تطهير السلطة، أو الاقتداء بالخليفة عمر بن عبد العزيز. “الشعب يريد إسقاط النظام”، يقول الحراك الشعبي الذي انطلق من عطبرة، البلدة العمالية بامتياز، وهيهات أن يتجمل ذلك النظام بأيّ قناع، قديم أو جديد.
(القدس العربي)
حكمة الحيوان
في البيت الأبيض
صبحي حديدي
تشيلسي كلينتون، ابنة بيل الرئيس الأمريكي الأسبق، وهيلاري المرشحة
السابقة للبيت الأبيض؛ غردت هكذا إلى متابعيها على تويتر، ويبلغ عددهم
1.73 مليون متابع: «هل ثمة مَنْ يفكر معي أن الرئيس ترامب قد يستفيد من
قراءة خرافات إيسوب؟ القطة والديك والفأر مثلا؟ النسر والسهم؟» الآلاف
اتفقوا مع التغريدة، بالطبع، خاصة وأنّ الحكايات التي تشير إليها
تحديدا، وسواها الكثير؛ جديرة بتعليم الرئيس الأمريكي الحالي دروسا شتى
في الأخلاق، والرأفة، والتآخي، و… التبصر والحكمة، بصفة خاصة!
والحال أنّ «خرافات إيسوب» تظلّ الأكثر شيوعا على النطاق العالمي؛ في
عداد الآداب التي تضع فلسفة الحياة والسياسة والحكمة والحكم على ألسنة
الحيوان، مصوغة في حكايا طريفة وممتعة، ذات مغزى مبسط وترميز خفيف لكنه
غير خافٍ. ثمة، كما هو معروف، «كليلة ودمنة»؛ وكتاب الأقاصيص الهندي
الكلاسيكي «بانشاتانترا»، الذي يضمّ خمسة مجلدات من الحكايات، على غرار
ما سوف تتخذه مطارحات مكيافيللي في «الأمير».
ولا تكاد تمرّ سنة دون أن يصدر جديد حول حكايات إيسوب، في أكثر من لغة،
على صعيد دراسة العمل، أو إعادة تحقيق نصوصه، أو إصدار طبعات مختلفة
منه. ولعلّ طبعة «بنغوين» البريطانية، بترجمة جديدة ومقدّمة وافية من
روبرت وأوليفيا تيمبل، هي بين أفضل الطبعات المتوفرة، لسبب جوهري هو
أنّها تدرج الحكايات كاملة غير منقوصة. وكما هو معروف، كانت معظم
الطبعات البريطانية (منذ سنة 1484، حين أنجز وليام كاكستون أولى
الترجمات) قد غربلت هذه الحكايات، وراقبت ما يخلّ منها بالآداب العامة،
فحذفت عشرات من أصل 350 حكاية. وإلى جانب الحذف، بذل الفكتوريون، خاصة،
جهدا خارقا لتجريد الحكايات من دلالاتها السياسية والأخلاقية
والفلسفية، وتحويل الأثر إلى محض قصص مسلّية تدور في عالم الحيوان
إجمالا، وتُروى للأطفال قبيل الإغفاءة.
ويجمع الباحثون على أن إيسوب عاش في جزيرة ساموس الإغريقية في القرن
السادس قبل الميلاد، وكان قد وُلد عبدا، وهكذا مات أيضا. باحثون آخرون
يعتبرونه شخصية مختلَقة، أحالت إليه المخيلةُ الإغريقية طائفة من
الحكايات اللاذعة التي كان من المستحيل نسبها إلى البشر، بسبب من وطأة
رموزها السياسية والأخلاقية. وإلى هذه الحكايات ندين بأمثولات راسخة،
مثل حكمة السباق بين الأرنب والسلحفاة، أو الذئب في جلد الحمل، أو حصّة
الأسد، أو العنب الحامض…
هنالك حكاية الدبّ الذي تباهى بأنه صديق صدوق للإنسان، يأنف من ملامسة
جثة ابن آدم. الثعلب ابتسم وردّ عليه: ليتك أكلتَ الجثة الميتة، وأبقيت
على الإنسان الحي! أو حكاية تحالف الصيد المشترك الذي عقده الأسد مع
الحمار البري، الأوّل لأنه قويّ وملك، والثاني لأنه سريع الركض وحمّال
أثقال. الأسد اعتمد الحسبة التالية في تقسيم الطرائد: حصّة أولى للأسد
بوصفه ملك الغابة، وحصّة ثانية للأسد لأنه الأقوى، وحصة ثالثة للحمار…
ولكن من الحكمة أن تُترك للأسد أيضا، ثمنا لبقاء الحمار على قيد
الحياة!
وهذه حكاية ثانية: وقع نسر في قبضة صياد قاسي القلب، سارع إلى قصّ
جناحَيْه، وحبسه في القنّ مع الدجاجات. أشفق رجل على النسر فاشتراه،
وأبقاه تحت رعايته حتى نبت ريش جناحيه، فأطلق سراحه. النسر سارع إلى
اقتناص أرنب، وأهداه إلى الرجل الثاني من قبيل ردّ الجميل. الثعلب خاطب
النسر بسخرية: كان الأحرى بك تقديم الهدية إلى الذي اصطادك وليس إلى
الذي ردّ لك كرامتك. الثاني لن يؤذيك في كلّ حال، والأوّل هو الجدير
بالرشوة!
حكاية أخيرة: ذات يوم لاحظ القرويون أنّ الجبل يتمخض، إذْ تصاعد الدخان
من قمّته، وارتجّ السفح، وتهاوت أشجار، وتدحرجت صخور، وكان محتما أن
تشهد الأرض وقوع حدث جلل. ثمّ انشقّ الجبل عن أخدود صغير، فارتعدت
فرائص الناظرين خوفا وترقبا، حتى هالهم أنّ فأرا أطلّ برأسه من الشقّ،
ليس أكثر؛ فكان أن اجترحوا ذلك القول المأثور: تمخض الجبل فولد فأرا!
وقد لا يكون معروفا على نطاق واسع أنّ سوريا هي الموطن الأصلي
لـ«خرافات إيسوب»، وأنّ المواطن السوري الذي تدين له الإنسانية بهذا
الفضل الكبير هو بابريوس؛ الذي عاش في القرن الأوّل الميلادي، ولا نعرف
عن حياته إلا النزر اليسير، وكان اسمه سيظلّ مغمورا منسيا لولا أبحاث
ريتشارد بنتلي (1662 ـ 1742)، العلاّمة الإنكليزي البارز في الآداب
اليونانية الكلاسيكية. ففي كتابه «أطروحة حول خرافات إيسوب»، تعمّق
بنتلي في تحليل لغة الحكايات المنسوبة إلى إيسوب (الذي يرجح هيرودوت
أنه عاش في جزيرة ساموس اليونانية في القرن السادس قبل الميلاد، مقابل
باحثين آخرين يعتبرونه شخصية مختلَقة كما سلف القول)؛ فوقع على عدد
كبير من الصياغات والجُمَل والفقرات التي تعود إلى بابريوس وحده.
الدليل القاطع جاء سنة 1842، على يد الباحث اليوناني مينويديس ميناس
الذي عثر، في أحد أديرة جبل آثوس، على مخطوط بتوقيع بابريوس، يضمّ 123
خرافة مطابقة لتلك التي ذاعت باسم إيسوب.
.. الأمر الذي يعني أنّ عالم الحيوان هذا، تحديدا، قد يكون عالي
الفائدة في أروقة البيت الأبيض، وربما في المكتب البيضاوي تحديدا!
صبحي حديدي
عرسال نصر الله:
ذرّ الرماد الدامي
صبحي حديدي
كما بات معتاداً في كلّ «خطبة نصر» يلقيها حسن نصر الله، الأمين العام
لـ»حزب الله»، طفحت البلاغة اللفظية التي تزعم التجرّد من المذهب
الضيّق، وتتوجه إلى «كل المسيحيين بكل طوائفهم ومذاهبهم وكل المسلمين
بطوائفهم ومذاهبهم»؛ وتنأى، في اللفظ وحده، عن مصالح الحزب ومَن يمثّل
وبمَنْ يأتمر، لكي تغازل «جميع اللبنانيين وكل شعوب المنطقة التي تعاني
من الإرهاب التكفيري»، وتهديهم «النصر» الأخير في عرسال. وبالطبع، كما
في كلّ خطاب أيضاً، كانت فلسطين حاضرة (لأنها روح الحزب وجوهر نضالاته،
غنيّ عن القولّ)، فتوجّه نصر الله بالتحية إلى «المرابطين في القدس».
وإلى «أهل الضفة، وكلّ الفلسطينيين».
هذا ما طفا على السطح، أولاً، لكي يُخلي العمق سريعاً لخطاب آخر؛
مذهبيّ صريح، حزبيّ تعبوي ضيّق، لا تأتأة فيه ولا غمغمة: «أوجّه التحية
إلى كلّ المضحين، إلى الشهداء والجرحى المجاهدين وعوائلهم، وأقول إنّ
فيكم الحسين والعباس وزينب»، هكذا هتف نصر الله، و»غصّ بدموعه» حسب
توصيف صحيفة «الأخبار» اللبنانية. كذلك أهدى نصر الله «نصر» حزبه إلى
«ورثة أهل البيت، بكم أخرجَنا الله من ذلّ الاحتلال والهوان والضعف
والخوف والهزيمة». وليس ذكر الجيش اللبناني، في خانة فريدة حقاً، هي
«شريك وعمدة المعادلة الذهبية»؛ إلا من قبيل ذرّ الرماد في العيون،
وإشراك جيش خانع أمام سلاح «حزب الله»، ذليل وتابع وذيلي، لم يعد يملك
استقواءً إلا على النازح السوري في مخيماته.
والحال أنّ نبرة نصر الله تعيدنا إلى خطاب سابق، قبل ثلاث سنوات، كان
أشدّ وضوحاً في تحديد الانتماء المذهبي الإقليمي والعالمي للحزب، وليس
هويته المحلية وحدها؛ حين هتف نصر الله: «نحن شيعة علي بن أبي طالب في
العالم»؛ و»نحن الحزب الإسلامي الشيعي الإمامي الإثنا عشري». وبالطبع،
كان ذلك الإعلان لا يأتي بجديد لا يعرفه العباد، ولا يعيد تعريف الحزب
المعرّف جيداً لتوّه؛ بقدر ما يدخل في خصومة مذهبية علنية مع الآخرين،
لجهة التشديد على الركنَيْن، «الإماميّ» و»الإثنا عشري»، تحديداً. وكان
القصد، يومها كما في كلّ لجوء إلى هذا التشخيص المذهبي، هو التعبئة
العقائدية والتحشيد الشعبي من جهة أولى؛ ثمّ التشديد، أكثر وأوضح، على
أنّ الانتماء الإمامي والإثنا عشري لا يقتصر على الدين والمذهب، بل
يشمل الدنيا والسياسة، وينتهي إلى طهران، حيث الوليّ الفقيه.
جديرة بالاستعادة، أيضاً، تلك الروحية التي امتاز بها نصر الله الشاب،
قبيل صعوده السريع في سلّم قيادة الحزب؛ وحين كان الشحن المذهبي،
دائماً وأوّلاً، ركيزة تنظيمة كبرى، قبل أن يكون خياراً في العقيدة.
يُسأل الأمين العام عن شكل نظام الحكم الذي يريده الحزب في لبنان،
فيقول (وننقل بالحرف): «بالنسبة لنا، ألخّص: في الوقت الحاضر ليس لدينا
مشروع نظام في لبنان. نحن نعتقد بأنّ علينا أن نزيل الحالة الاستعمارية
والإسرائيلية، وحينئذ يمكن أن يُنفّذ مشروع، ومشروعنا الذي لا خيار لنا
أن نتبنى غيره، كوننا مؤمنين عقائديين، هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم
الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من
الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان، ونائبه بالحقّ
الوليّ الفقيه الإمام الخميني».
ثمّ يُسأل عن علاقة الحزب بإيران، فيقول: «هذه العلاقة، أيها الأخوة،
بالنسبة لنا أنا واحد من هؤلاء الناس الذين يعملون في مسيرة ‘حزب
الله’، وفي أجهزته العاملة، لا أبقى لحظة واحدة في أجهزته لو لم يكن
لديّ يقين وقطع في أنّ هذه الأجهزة تتصل، عبر مراتب، إلى الولي الفقيه
القائد المبرئ للذمة الملزم قراره. بالنسبة لنا هذا أمر مقطوع
ومُطْمَأن به (…) وهذه المسيرة إنما ننتمي إليها ونضحي فيها ونعرّض
أنفسنا للخطر لأننا واثقون ومطمئنون بأنّ هذا الدم يجري في مجرى ولاية
الفقيه». ورغم أنه يعتب، خلال الجلسة ذاتها، على تصريح آية الله كروبي
بأنّ الحزب «هنن جماعتنا في لبنان»؛ فإنّ نصر الله لا يجد عيباً في
التصريح إلا من حيث المستوى الإعلامي: «هيدا مش صحيح، إعلامياً مش
صحيح»!
ثالثاً، يسألونه مَن أعلم بالحالة السياسية ومتطلباتها في لبنان»،
فيجيب نصر الله (نبرة جازمة وعصبية، بعد أن يلقي بورقة السائل على
الطاولة أمامه، كما يُظهر الفيديو): «الأعلم هو الإمام الخميني! لماذا؟
لأنني سابقاً ذكرت بأنّ الحالة السياسية في لبنان ليست حالة معزولة عن
حالة المنطقة. هي جزء من حالة الصراع في الأمّة، هي جزء من وضع الأمّة،
فكما أنّ إمام الأمّة يعرف هذا الجزء، يعرف هذا الجزء (…) الإمام الذي
يخطط، هو يخطط للأمّة. المجتهدون تأتي أدوارهم في كلّ بلد، مكمّل [كذا]
لخطّ الإمام، ولمشروع الأمّة الإسلامية الواحد. فلا يجوز أن نجزئ صراع
الأمّة مع أعدائها، ما دام الأعداء يخوضون صراعاً واحداً مع الأمّة،
فيجب أن يكون [كذا] إدارة الأمّة في صراعها واحدة، وهي من خلال
الإمام».
الأرجح أنّ أحداً، في أجهزة الحزب ومؤسساته الإعلامية تحديداً، لن يجد
جسارة كافية للزعم بأنّ هذه الاطروحات لصيقة بسياقات محددة، وبالتالي
لا يجوز إخراجها منها، ولا قراءة مواقف نصر الله وسياسات حزبه على
ضوئها. ثمة استمرارية عضوية، أقرب إلى مبادئ كبرى ناظمة، حكمت علاقة
الحزب بالمشهد اللبناني الداخلي ثمّ الجوار الفلسطيني والسوري
والعراقي، واليمني لاحقاً (للتذكير فقط: في خطبته الأخيرة توجه نصر
الله بالتحية إلى «السيد عبد الملك الحوثي، الذي أعلن بوضوح وقوفه مع
اليمنيين إلى جانب لبنان في أي معركة مع العدو الإسرائيلي، وهذا تأكيد
لمعادلة القوة التي تريد أمتنا أن تكرّسها»؛ رغم أنّ «نصر» نصر الله
كان في جرود عرسال وليس في مواجهة أية «إسرائيل»، فعلية كانت أم
متخيَّلة). وفي هذا كلّه، ثمة «الإمام الذي يخطط»، وهو الذي «يخطط
للأمّة».
وفي كلّ حال، ليس للغطاء المذهبي العقائدي أن يحجب حقائق حروب «حزب
الله» في عرسال، هذه وسواها التي سبقتها؛ وأنها، في أوّل المطاف وآخره،
امتداد طبيعي لحروب الحزب إلى جانب نظام بشار الأسد، وضدّ الشعب
السوري؛ قبل أن تكون ضدّ «النصرة» أو «داعش»… قبلها، وأقدم منها كثيراً
في الواقع. ثمة، في البدء، ستراتيجية ركيكة للإيحاء بأنّ حروب الحزب في
عرسال (حتى بذرائع أشدّ ركاكة، تتصل بحروب الجيش اللبناني العتيد) تبرر
تدخل الحزب العسكري في دمشق ودرعا وحمص وحلب وحماة ودير الزور. وثمة،
بالتوازي التامّ، تعمية خبيثة على جرائم الأجهزة الأمنية والعسكرية
اللبنانية ضدّ النزوح السوري، وعقاب لأهل عرسال اللبنانيين على تعاطفهم
المبكر مع الانتفاضة السورية.
وتبقى خلاصة ثالثة، تخصّ التهويل العاطفي الذي تُغطى به مقولة
«الالتفاف الوطني» حول الجيش اللبناني، وأنه «خطّ أحمر»… حين يتصل
الأمر بالنزوح السوري، حصرياً. أمّا أنّ هذا الجيش منتهَك الكرامة،
عسكرياً ومعنوياً، أما سلاح «حزب الله» أوّلاً، والميليشيات كافة
ثانياً؛ وأنّ الجوهر الأقصى لوظائفه بات منحصراً في ترقية قائد إلى
رتبة رئيس الجمهورية، حيث يسود الوئام الوطني ساعة، وتهيمن الانشطارات
الطائفية والمذهبية والطبقية كلّ ساعة… فهذه اعتبارات لا يُسكَت عنها،
فحسب؛ بل يُكمّ كلّ فم يتجاسر على تظهير حقائقها الساطعة.
وهكذا فإنّ «نصر» عرسال اليوم، مثل جميع «انتصارات» حزب الله» منذ
تدخله العسكري في سوريا: ذرّ لرماد دامٍ في العيون، وهزيمة نكراء لبلد
كان يسمى لبنان، وصار محض «جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى»!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
ماكرون وأفريقيا:
التفضّل «الحضاري»
على ثلث أرحام العالم
صبحي حديدي
في نيسان (أبريل)، هذا العام، كان إيمانويل ماكرون مجرد مرشح للرئاسة
في فرنسا. وحين سُئل عن القارة الأفريقية، خلال ندوة مع صحافيي
«لوموند»، قال التالي: «حين أنظر إلى أفريقيا، أرى بالفعل قارّة
المستقبل. أفريقيا توشك على إنجاز تحوّل لا سابق له، بنموّ متواصل منذ
سنة 2000، وعمران وطفرة في الطبقات الوسطى، وتنمية للقطاع الخاص،
وشبيبة خلاقة ودينامية. هنالك بالطبع تحديات يتوجب أن تواجهها أفريقيا:
الديموغرافيا، الأوبئة، الاختلالات المناخية التي تعاني منها، حالات
انعدام التكافؤ، وضعف الحكم. ولكنني مقتنع أنّ أفريقيا سوف تفاجئ
العالم بديناميتها. إنّ من مصلحتنا أن نكتب صفحة جديدة في علاقتنا مع
أفريقيا».
فماذا عن ماكرون، الرئيس الفرنسي المنتخب؟ بادئ ذي بدء، كانت خطوته
«الأفريقية» الأولى هي زيارة القوات الفرنسية المتمركزة في مالي؛ ليس
للإعراب عن تضامن الرئاسة مع أبناء فرنسا من العسكريين الذين يتولون
مهامّ قتالية حافلة بالمخاطر خارج فرنسا، فحسب؛ بل كذلك لإتمام أولى
الرموز ذات الطابع العسكري المحض في رئاسة ماكرون، أي صعود جادة
الشانزيليزيه على متن عربة عسكرية، وليس في سيارة مدنية كعادة رؤساء
فرنسا. وقد يرى البعض أنّ ماكرون، في اللمسة العسكرية تجاه أفريقيا،
يتذكر ـ ولعله كان يذكّر، أيضاً ببعض ـ ماضي فرنسا العسكري التليد مع
القارّة؛ منذ الجنرال شارل دوغول، وحتى فرنسوا هولاند (في عهد الرئيس
الاشتراكي فرنسوا ميتيران، بلغ عدد الجنود الفرنسيين المنتشرين في
أفريقيا الفرنكوفونية 60 ألف عسكري).
لكنّ ماكرون الرئيس ذهب أبعد في التبشير بسياسته الأفريقية، خلال مؤتمر
صحافي على هامش قمة العشرين في هامبورغ، رداً على سؤال من صحافي أفريقي
حول إمكانية توفير «خطة مارشال» خاصة بالقارة؛ وكانت نُذُر البشرى،
تلك، حافلة بالمفاجآت! لقد ابتدأ بالقول إنّ خطة مارشال تدور أولاً حول
«إعادة البناء، المادي»، في بلدان تمتلك «توازنها، وحدودها،
واستقرارها»؛ وهذا، غنيّ عن القول، تشخيص خاطئ تماماً، في ما يخصّ خطة
مارشال بمعناها الكلاسيكي، وفي سياقاتها التاريخية المحددة. ذلك لأنّ
تلك الخطة انطوت على عون أمريكي هائل لأوروبا أربعينيات القرن الماضي،
حين كانت القارّة العجوز خربة ومنهارة وممزقة (أي نقيض صفات التوازن
والحدود والاستقرار التي ساقها ماكرون)؛ تتضور جوعاً إلى ما ستحمله
الشاحنات الأمريكية من موادّ إغاثة، كانت تبدأ من الدقيق والحليب، ولا
تنتهي عند قلم الرصاص وكيس الإسمنت.
وللتذكير، في يوم الخامس من حزيران (يونيو) 1947، ألقى وزير الخارجية
الأمريكي آنذاك، جورج مارشال، خطبة قصيرة في حفل تخريج دفعة جديدة من
طلاب جامعة هارفارد؛ ضمّنها إطلاق المبادرة الدبلوماسية الأضخم،
والأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة في حينه: ما سيعرف فيما بعد
باسم «خطة مارشال» لانتشال أوروبا من أوزار الحرب العالمية الثانية.
يومها لم تكترث الصحافة الأمريكية بخطبة من سبع دقائق، ألقاها رجل جافّ
الروح وصارم الملامح، لا تنفرج شفتاه عن ابتسامة مجاملة حتى عندما يطلق
فرانكلين روزفلت واحدة من النكات الرئاسية المأثورة. ولأنّ أحداً لم
ينتبه، كما يتوجب، فإن أحداً لم يناقش خطورة مشروع فريد عكفت على
هندسته أكبر أدمغة الإدارة آنذاك (مارشال نفسه، بمعونة دين أشيسن، جورج
كينان، وليام كلايتون، وشارلز بوهلن)؛ وسوف يقلب العالم رأساً على عقب،
وسيتكلف 13 مليار دولار (أكثر من 90 مليار في حسابات هذه الأيام).
المفاجأة الثانية لم تتأخر، بعد ذلك التوصيف الخاطئ لمفهوم «خطة
مارشال» وسياقاتها التاريخية؛ إذْ انتقل ماكرون إلى خلاصة أخرى صاعقة:
«تحدّي أفريقيا مختلف تماماً، إنه أعمق بكثير، إنه حضاري اليوم»! فهل
ذهبت أدراج الرياح، بين نيسان الماضي وتموز (يوليو) الراهن، تلك الصفات
التي خلعها ماكرون على أفريقيا؛ لجهة نموّها، وعمرانها، وطبقاتها
الوسطى، وشبيبتها، وأنها «أفريقيا المستقبل»؟ وحين تحدّث ماكرون،
المرشح الرئاسي، عن تحديات أفريقيا (الديموغرافيا، الأوبئة، الاختلالات
المناخية التي تعاني منها، حالات انعدام التكافؤ، وضعف الحكم)؛ لماذا
لم يعتبرها «حضارية» في حينه، كما اعتبرها اليوم ماكرون الرئيس؟ وإذا
جاز للمرء أن ينزّه الرئيس الفرنسي عن التفكير العنصري، لأنه في الواقع
ليس عنصرياً، فهل يجوز تنزيه مفردة «حضاري» عن المعاني المرذولة التي
انطوت عليها تاريخياً، خاصة في إطار «المهمة التمدينية»
Mission civilisatrice،
أو «رسالة الحضارة» الفرنسية الأشهر على امتداد التاريخ الاستعماري؟
وكيف تناسى ماكرون أنّ تلك «المهمة التمدينية» اقترنت، حرفياً، بتاريخ
استعماري بغيض ودام، صنّفه هو بنفسه في خانة «جريمة حرب ضدّ
الإنسانية»؛ حين كان مرشحاً للرئاسة، بالطبع؟ ألم يكن مجرمو الحرب،
أولئك، من الإسبان في الأمريكتَيْن، والفرنسيين في الجزائر وأفريقيا
الوسطى والغربية، والبريطانيين في الهند، والبلجيكيين في الكونغو،
والبرتغاليين في أنغولا، والهولنديين في جنوب أفريقيا؟ الإسبان أبادوا
قرابة 70 مليون «هندي أحمر»، كما ستصبح تسمية أبناء الأقوام الأصلية؛
وفي ذمّة الملك البلجيكي ليوبولد الثاني، وحده، أكثر من عشرة ملايين
أفريقي كونغولي، قضوا في سخرة صيد العاج؛ ولائحة أهوال الاستعمار
الغربي تنطوي على صفحات من البربرية العارية المفتوحة، تتجاوز بكثير
حدود ما يمكن أن تشمله معنى الإجرام بحقّ الإنسانية.
المفاجأة الثالثة أنّ ماكرون، الذي اعتبر أفريقيا قارّة المستقبل، بات
ـ في إهاب الرئيس، مجدداً! ـ يرى أنّ المشكلة في أرحام نسائها، التي
تلد سبعة أطفال أو ثمانية؛ وأياً كانت المليارات التي تصرفها (باسم
المهامّ التمدينية، كافة)، «فإنك لن تحقق أيّ استقرار»! شاقّ، حقاً،
على امرئ ينزّه ماكرون عن العنصرية، أن يفلح في تنزيهه عن الاستكبار
والتفضّل والتكرّم على «الآخر»، الذي يحدث أنه، أو أنهنّ بالأحرى، ثلث
نساء العالم! هنا، أيضاً، تناسى ماكرون أنّ المشكلة الديمغرافية ليست
أحادية الجانب، تتصل فقط بإنجاب أطفال أكثر؛ وأنها متعددة الأبعاد،
اقتصادياً وتنموياً ودينياً واجتماعياً وثقافياً. وهي، لعلم سليل دولة
مارست جرائم الحرب الاستعمارية، مشكلة سياسية أيضاً، تضرب بجذورها في
التاريخ الاستعماري ذاته. ولعله تناسى، إذْ يصعب على مثله نسيان، أنّ
بعض أهمّ عناصر «المهمة التمدينية» كان فرض الهداية إلى المسيحية
الكاثوليكية، التي تحظر منع الحمل والإجهاض، ويلتزم ملايين الأفارقة
المسيحيين بهذا الحظر كواجب ديني لا محيد عنه.
وعلى ذكر المليارات، كان جديراً بالرئيس الفرنسي ـ التكنوقراط، سليل
قطاعات الصيرفة والاستثمار ـ أن يتوقف عند بُعد آخر في علاقة فرنسا
بالقارة الأفريقية، أو شطرها الفرنكوفوني على الأقلّ: أنّ الشركات
الفرنسية تستأثر، على نحو أقرب إلى الاحتكار، بالميادين الأكثر
ستراتيجية في الاقتصادات الأفريقية، من قطاعات الكهرباء والاتصالات،
إلى الموانئ والمطارات والبنى التحتية، مروراً بالتعدين والنفط والماس
والذهب… فهل، سريعاً بعد انتخابه، انقلب ماكرون المرشح، ليبراليّ الوسط
المؤمن بالأسواق ومكامن الاستثمار و»أفريقيا المستقبل»؛ إلى ماكرون
النيو ـ ليبرالي، المتفضّل اقتصادياً على الأسواق التي يستثمر فيها،
العازف عن تطويرها لأنّ عوائقها «حضارية»، المتكبّر على أرحام نسائها،
الذي يأنف من مشكلاتها المستعصية في الديمغرافيا وفشل الدولة والإرهاب
الإسلامي؟
في كلّ حال، لا يلوح أنّ الأوّل، المرشح، احتاج إلى زمن طويل كي تتكشف
في داخله، ثمّ على لسانه وسلوكياته وسياساته، بعض الخصائص النوعية
التكوينية، التي كانت خبيئة على نحو أو آخر؛ وكان بلوغ ذروة هرم السلطة
كفيلاً بدفعها إلى العلن، حتى حدود الافتضاح، وتكشير الأنياب
«الحضارية»!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
الموصل: طريق
سليماني إلى اللاذقية!
صبحي حديدي
رغم أنّ تنظيم «الدولة الإسلامية» لم يعد يسيطر إلا على مساحات ضئيلة
في مدينة الموصل وجوارها، فإنّ عناصره أفلحت، منذ أواسط حزيران (يونيو)
الماضي، في شنّ سلسلة هجمات مضادة مباغتة؛ أسفرت عن تفكيك خطوط الدفاع
الأولى للجيش النظامي العراقي، خاصة الفرقة 16 التي تتولى قتال «داعش»
في المدينة القديمة. آخر تلك الهجمات وقعت يوم الجمعة الماضي، حين نجح
عشرات من مقاتلي التنظيم في اختراق صفوف الفرقة، وإجبارها على التراجع
عشرات الأمتار خلف الأبنية السكنية، وبعيداً عن أحد الطرق الرئيسية.
قبل هذا كان مقاتلو «الدولة»، متخفين في ثياب عناصر «الحشد الشعبي»، قد
باغتوا الجيش العراقي عند الأطراف الغربية للمدينة، فانهارت القطعات
التي تعرضت للهجوم، في مشهد أعاد التذكير بالأيام الأولى لسقوط المدينة
السهل في أيدي جحافل «داعش»، قبل ثلاث سنوات.
ذلك يعني أنّ طريق تحرير المدينة ما يزال طويلاَ، من جانب أوّل، بالنظر
إلى ما يعدّه تنظيم «الدولة» من تكتيكات مضادة، على أصعدة عسكرية
تقليدية وأخرى أقرب إلى حرب العصابات. كما يعني، من جانب آخر، أنّ
مفهوم «التحرير» محفوف بإشكاليات شتى، وتعقيدات سياسية وعسكرية ومذهبية
وإثنية، من جهة ثانية. أوّل العناصر التي تضع علامات ارتياب كبرى حول
مصداقية تحرير المدينة، هو موقع «الحشد الشعبي» في المعادلة: أهو تابع،
أولاً، لقيادة العراق السياسية والعسكرية الرسمية (رئيس الوزراء حيدر
العبادي، وكبار قادة الجيش النظامي)؛ أم يأتمر، عسكرياً وسياسياً
ومذهبياً، بالجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الإيراني
أيضاً؟ وكيف تُفسّر مشاعر البغضاء الفاضحة تجاه سنّة الموصل، والعراق
عموماً، التي لا يجد أبو مهدي المهندس، القائد الفعلي الميداني
لـ«الحشد»، أيّ حرج في الإعراب عنها؟ وماذا عن حقائق الأرض، وأعمال
التصفيات والتعذيب والتطهير المذهبي والمناطقي، التي مارستها وتمارسها
قوات «الحشد» أينما انتشرت إجمالاً، وفي الموصل تحديداً؟ وأيّ مهامّ
«تحريرية» يتولى «الحشد» تنفيذها داخل الأراضي السورية، ضمن مشروع حلم
سليماني بالسفر عبر طريق برّي يقوده من إيران إلى اللاذقية، عبر
العراق؟
هذه الأسئلة، التي تخصّ «الحشد» وحده بادئ ذي بدء، سوف تتوالد عنها
أسئلة أخرى كثيرة تخصّ تكوينات الموصل المذهبية والإثنية الأخرى؛ إذْ
ليس من المنتظَر أن يتقبّل السنّة والكرد والكلدان والتركمان، في
الأمثلة الأبرز، طراز الهيمنة التي تبشّر به ممارسات ميليشيات أبو مهدي
المهندس، في أطوار ما بعد «التحرير». وليس خافياً، بالطبع، أنّ «الحشد»
لم يعد مجرد ميليشيات عسكرية، وليس البتة على غرار ما أفتى به السيد
علي السيستاني، المرجع الشيعي الكبير، حول استحقاقات «الجهاد الكفائي»؛
بل صار «الحشد» قوّة كبرى، فاعلة وفعلية، في المستويات السياسية
والحزبية، وتحديداً بعد النقلة الحاسمة في اعتزام خوض الانتخابات
التشريعية كمجوعة عسكرية (على نقيض ما يقول الدستور العراقي!).
ولعلّ سليماني، وجنرالاته في «الحشد»، سوف ينشغلون بمعارك «تحرير»
الطريق البرّي إلى اللاذقية، أكثر بكثير من انشغالهم بما ستعتمده
«داعش» من تكتيكات قتال مضادة، وهجمات مضادة أكثر شراسة وعنفاً، في
مناطق أخرى من العراق. ذلك لأنّ تنظيم «الدولة» ما يزال ـ للتذكير
المفيد مجدداً، ودائماً ـ يمتلك هوامش مناورة قتالية، وجيوباً يسهل
التحشيد فيها، وخلايا نائمة يمكن إيقاظها في كلّ حين لتتولى مهامّ
التشويش والإرباك ودبّ الاضطراب. صحيح أنّ المواطن العراقي، في الموصل
ذاتها كما في كلّ وأية منطقة عراقية أخرى، يظلّ ضحية «داعش» الأولى؛
إلا أنّ قاتله التالي هو سلطة حاكمة بائسة، مطعون في شرفها الوطني
والأخلاقي، تنحدر أدنى فأدنى نحو درك الطائفية والتمييز والفساد
والقصور والتبعية، وتُسلم قياد البلد إلى جنرالات أغراب، على رأس
ميليشيات محلية مذهبية.
(القدس العربي) لندن
توريث محمد بن سلمان:
هلام الرمال المتحركة
صبحي حديدي
قد يصحّ القول إنّ الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز يدفع
اليوم ــ من تحت الثرى بالطبع، وبمفعول رجعي ــ ثمناً باهظاً لقاء
مناورة لاح أنها بارعة وحاسمة؛ خاصة بعد تقديمها في صورة خطوة
«إصلاحية»، لتنظيم تناقل العرش داخل ذرية عبد العزيز بن سعود. وبالفعل،
بدا أنّ إصدار «نظام هيئة البيعة»، خريف 2006، خصوصاً تعديل الفقرة ج
من المادة الخامسة لنظام الحكم (والتي تسحب من الملك صلاحية تسمية وليّ
العهد، وتسنده إلى هيئة البيعة)؛ خطوة تعديل حاسمة من طراز غير مسبوق
في المملكة. لكنها كانت ناقصة، ابتداءً من منطق صلاحياتها ذاته، لأنّ
الملك هو الذي يقترح على أعضاء الهيئة اسم، أو أسماء، المرشحين لولاية
العهد، حتى إذا كان النظام الجديد يمنح الهيئة حقّ رفض اقتراحات الملك،
واختيار مرشح آخر.
ولقد توفّر، مع ذلك، هامش مناورة مزدوج النتيجة، لأنه أتاح إمكانية
المزيد من الاتفاق بين الأمراء، أو المزيد من الشقاق والخروج على إرادة
الملك؛ وهذه حال لم تكن متوفرة في الماضي، أو كانت تتمّ في الخفاء وخلف
جدران القصور السميكة الكاتمة للأسرار. هذا، بالطبع، إذا استبعدنا
حقيقة أنّ مرض الملك (وهو تطوّر شبه دائم في حياة ملوك السعودية) قد
يعيقه عن القرار عملياً، رغم بقائه على رأس الحكم وفي سدّة القرار؛ كما
حدث مع الملك فهد طيلة العقد الأخير من حياته، حين أصيب بجلطة في
الدماغ، وعهد بتصريف شؤون المملكة إلى أخيه الأمير عبد الله، وليّ
العهد في حينه.
هنالك، إلى هذا، حقيقة عتيقة راسخة انتقصت من الطبيعة «الإصلاحية» لهذه
الخطوة؛ وهي أنّ أوالية التوريث والخلافة في المملكة ليست دائماً
بالسلاسة التي تبدو عليها في الظاهر، من جهة؛ وهي، من جهة ثانية، يندر
أن تأخذ صيغة سيرورة سياسية قائمة على توازنات القوّة ومحاصصة النفوذ
وحدها، لأنها أيضاً مسألة اجتماعية تضرب بجذورها عميقاً في نواظم
المجتمع السعودي، وهياكله القبائلية والمناطقية. في عبارة أخرى، لم يكن
واضحاً ــ على الدوام في الواقع، وحتى بعد تأسيس «هيئة البيعة» ــ ما
إذا كانت فلسفة الخلافة في المملكة قد ضربت صفحاً عن معظم، أو حتى بعض،
تلك القواعد الصارمة، البسيطة تماماً مع ذلك، التي وضعها ابن سعود في
عام 1933؛ حين اندلعت نزاعات الأبناء، وقرّر الملك المؤسس توريث سعود
وفيصل في آن معاً، لكي يقرّر ضمناً أن مبدأ الشراكة المعلنة هو القاعدة
الناظمة للولاء العائلي.
هذا هو بعض السبب في أنّ مبايعة الأمير عبد الله، صيف 2005، بدت سلسة
ويسيرة وخالية من أية عواقب دراماتيكية آنية. صحيح أنه لم يكن عضواً في
نادي «السديريين السبعة»، وهو أخ غير شقيق لهم؛ والملك الراحل نفسه،
فهد، كان في العام 1992 قد انفرد بتثبيت مبدأ مبايعة العضو «الأقدر»
و»الأرشد» بين أبناء عبد العزيز (مما أعطى سقيفة المبايعة صلاحيات
الطعن في قدرة، أو رشد، أي عضو مرشح بحكم السنّ، أو أقدمية التسلسل في
الخلافة، أو حتى ولاية العهد بموجب إرادات سابقة واضحة). ولكن من
الصحيح، في المقابل، أنّ الملك الذي تُوّج كان النائب الثاني لرئيس
مجلس الوزراء بقرار من الملك خالد، وكان ولي العهد، والنائب الأوّل،
وقائد الحرس الوطني (75 ألف مقاتل، بتدريب أمريكي رفيع)، وأبرز
المتحالفين مع عشائر شمّر التي تمتد أفخاذها حتى مثلث الحدود التركية ـ
السورية ـ العراقية.
ليس واضحاً، تالياً واستطراداً، ما إذا كانت قواعد الخلافة السابقة،
مثل أية قواعد لاحقة، قادرة على إسقاط المبدأ الآخر في تحكيم الوراثة؛
أي إقامة ميزان الذهب بين القبيلة والفتوى والدولة، وبين السلطة
القبلية وسلطة الإفتاء والسلطة المركزية، أياً كان المحتوى الفعلي لهذه
الأخيرة. وهكذا فإنّ صيغة التعاقد، بين المؤسسة السياسية والمؤسسة
الدينية، فرضت على آل سعود اعتماد مزيج من سياسات «إدارة» العقد؛ مثل
إضعاف الامتيازات القبلية، وتوطيد القرابات والولاءات، ودعم الأسس
الإدارية والبيروقراطية الضرورية، وإتمام الزواج (الناجح، أو حتى ذاك
القائم على المصلحة المشتركة) بين هذه الأسس شركات النفط العملاقة،
واستيراد التكنولوجيا، والمضيّ قدماً في التحالفات الإقليمية والدولية،
وتطبيق استراتيجية أمنية انعزالية وجامدة ووقائية… كل هذا، في آن معاً!
وكانت أربعة عقود من التصارع بين السلطة القبلية وسلطة الفتوى والسلطة
المركزية قد أقنعت ابن سعود باستحالة إغفال أيّ منها لصالح أخرى، فأوصى
أبناءه بإدامة التوازن الدقيق، وبذل آخر ما تبقى في جعبته من حنكة
سياسية في ضمان خطّ تعاقبي آمن في وراثة العرش. لكنّ تحوّل المملكة إلى
منتج أساسي للنفط في عهد الملك سعود، وتجاوز سقف المليون برميل يومياً،
أسند للعائدات النفطية وظيفة سوسيولوجية جديدة وخطيرة هي تدمير هياكل
التوازن التي شيّدها ابن سعود؛ خصوصاً ذلك التشارك القلق بين القِيَم
القبلية، وأصول الدين، ونظام الإدارة. والخبرة التي راكمتها الأسرة
الحاكمة في تدبير الشأن القبلي لم تستطع تقديم إجابات ملائمة على أسئلة
وتحديات العمران والتحديث (التي أضعفت الأواصر القبلية، بالضرورة)؛
وتوزيع عائدات النفط (التي ضاعفت إيقاع الولاءات الشخصية، وعلاقات
الاستزلام)؛ والظواهر السياسية الإقليمية والدولية، خاصة في ظل المدّ
القومي العربي، واشتداد الحرب الباردة، قبيل الثورة الخمينية وصعود
الإسلام السياسي.
ولكن المعادلة كانت مسقوفة، أو محتومة بمعنى ما، ولم يكن في وسع
المملكة أن تواصل انشطارها العميق والمؤلم بين حاجات المجتمع والحياة،
وبين تركة الزواج القسري الذي جمع المؤسسة والقبيلة. من جانب آخر كانت
سيرورة ارتهان المملكة للسياسة الأمريكية (من الإنفاق على الانتخابات
البلدية الإيطالية لكي لا ينجح الشيوعيون، إلى تحالف حفر الباطن
واستقدام القوّات الأمريكية، إلى غزو العراق 2003، وصولاً إلى عقود
التسليح والاستثمار المرّيخية التي حصدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خلال زيارته الأخيرة…)؛ تخلق وقائعها وظواهرها الرديفة أو المكمّلة،
التي لم تكن دائماً تأتي برياح تلائم سفائن آل سعود: من استيلاد
«الأفغان العرب»، إلى الـ 15 سعودياً من أصل 19 انتحارياً نفّذوا هجمات
9/11، مروراً بالتورط التمويلي مع بعض فصائل المعارضة الإسلامية في
سوريا، والتورط العسكري المباشر في اليمن…
تولية محمد بن سلمان تعيد عقارب الساعة إلى ذلك السقف المحتوم، رغم
أنها توحي بتقديم الزمن إلى 2030، (ليس أقلّ!)، ورغم ما تنطوي عليه من
«دغدغة» لما سُمّيت بـ»القوى الليبرالية» و»التكنوقراط»؛ على نقيض
(يُصوّر، هنا أيضاً، على أنه تناغم مع) المؤسسة الدينية الوهابية. وقبل
أن تنطلق مشاريع وليّ العهد، الثلاثيني، نحو عقد الثلاثينيات؛ ثمة مشهد
آخر رديف، تصعب إزالة عناصره عن المعادلة: اهتزاز شرعية آل سعود
الدينية والسياسية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، ومشكلات البطالة
وانخفاض الدخل الفردي، ارتفاع المديونية العامة، وعشرات المشكلات
الاجتماعية والسياسية الأخرى.
والتولية تعيد آل سعود إلى حصاد ما بعد مناورة «هيئة البيعة»، حين رحل
صانعها الملك عبد الله، وأُبطلت ولاية عهد مقرن بن عبد العزيز، ثمّ
محمد بن نايف اليوم؛ الأمر الذي لا يشير إلى أنّ هذه الهيئة حبر على
ورق، فحسب؛ بل لعلها لم تُكتب بمداد، بل برمال متحركة، رخوة وهلامية،
فاتحة كسور وصدوع وهزّات، داخل المملكة وخارجها. ما خلا أنّ الناس ليست
دائماً على دين ملوكها، وبالتالي قد يكون الآتي أعظم مما تقدّم، وأبعد
أثراً وعاقبة.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
بريجنسكي والجهاد الإسلامي:
رحل الصانع وبقيت الصناعة
صبحي حديدي
بين الصور الصحفية التي اختارتها صحيفة «نيويورك تايمز»، في مناسبة
رحيل زبغنيو بريجنسكي (1928ـ2017) قبل أيام؛ ثمة واحدة تجمع بين
الطرافة الفوتوغرافية، والمغزى السياسي والثقافي المزدوج: صورة «زبيغ»
يصغي إلى خطاب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أمام مجلس الشعب
المصري، في تشرين الأول (أكتوبر) 1979. وجه الطرافة الأوّل أنّ مستشار
الأمن القومي الأمريكي، يومذاك، كان يسبّح بمسبحة؛ قيل إنّ مسؤولاً
مصرياً أقنعه بـ«فضائل» استخدامها. وجه الطرافة الثاني أنّ كلام
الصورة، من
Gettyimages،
كان (ويظلّ، على مستوى الأرشيف، حتى اليوم!) يصف بريجنسكي بـ»مستشار
الأمن القومي الإسرائيلي»؛ وبالنظر إلى مسرد انحيازات الرجل العمياء
إلى إسرائيل، كان التوصيف يجيز اللجوء إلى قول مأثور، مع تعديل ضروري:
ربّ خطأ خير من ألف صواب!
وثمة تفصيل آخر، غير فوتوغرافي هذه المرّة، ينبثق من تقليد إسباغ
المدائح على الراحلين حديثاً، أو ذكر محاسن الموتى وليس البتة أياً من
مساوئهم؛ التي قد تكون مثاقيلها أشدّ استدعاء للتقبيح، بدل المديح.
هذا، على سبيل المثال، ما ذكّرنا به الرئيس الأمريكي السابق باراك
أوباما؛ الذي كان في عداد رؤساء أمريكا الأكثر نفوراً من التدخل
العسكري الخارجي المباشر (الأمر الذي تبدّل جوهرياً، أيضاً، في الأشهر
الأخيرة من الولاية الثانية)؛ ولكنه قال التالي، في تأبين بريجنسكي:
«مثقف جبار، ومدافع منافح مدافع عن القيادة الأمريكية. تأثيره امتدّ
على عقود عديدة، وكنت أحد رؤساء عديدين استفادوا من حكمته ونصحه. أنتَ
تعرف دائماً أين يقف زبيغ، وأفكاره وحججه ساعدت في تشكيل عقود من سياسة
الأمن القومي».
فلنذهب، على سبيل تلمّس بعض ذلك «النصح»، إلى موقفه من انتفاضة الشعب
السوري، وكيف رأى «الناصح الجبار» مشهد البلد عموماً. سوريا، عنده، محض
حال من الفوضى الشاملة، تسير من سيئ إلى أسوأ؛ وإنْ كانت تمنح الولايات
المتحدة فرصة استمالة إيران إلى اتفاق إقليمي شامل، يتضمن الملفّ
النووي أيضاً، وينتهي لصالح إسرائيل في المقام الأوّل. وما يجري في
سوريا، منذ آذار (مارس) 2011، ليس سوى «أزمة، شاركت في التخطيط لها
السعودية، وقطر، وحلفاؤهما الغربيون»، هكذا بجرّة قلم. كتب بريجنسكي،
في الدورية الأمريكية اليمينية ذائعة الصيت
National Interest:
«في أواخر العام 2011 حدثت اضطرابات في سوريا، تسبّب بها الجفاف
واستغلها نظامان أوتوقراطيان في الشرق الأوسط، هما قطر والسعودية».
ولكي تكتمل أركان «المؤامرة» هذه، دخلت المخابرات المركزية الأمريكية
على الخطّ، وقررت «زعزعة» الحكم في البلد، قبل أن تفطن إلى أنّ
«العصاة» الثائرين على «حكومة بشار الأسد» ليسوا جميعهم من الصنف
«الديمقراطي»، فكان أن خضعت السياسة بأسرها للمراجعة…
أو فلنذهب إلى ملفّ آخر، هو انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر؛ حيث بدأ
بريجنسكي من افتراض مركزي عنده، بأنّ الانقلابات العسكرية ليست كلها
شريرة بالضرورة (بالطبع، على أمثولة انقلاب الجنرال بينوشيه في
تشيلي!)؛ هكذا كانت حال الجيشَيْن البرازيلي والتركي، اللذَيْن استعادا
النظام الديمقراطي بعد انقلاب عسكري، وهكذا يمكن أن تكون حال الجيش
المصري: فلننتظر، يستحثّ بريجنسكي الإدارة الأمريكية، متسائلاً: هل
كنّا نعرف شيئاً عن أنور السادات قبل أن يتولى الحكم بعد جمال عبد
الناصر (بمعنى: هل كنّا نتوقع منه فضيلة المشاركة في صنع اتفاقيات كامب
دافيد مع إسرائيل)؟ هل نعرف ما يكفي، الآن، عن الفريق السيسي؟ مصر،
يختتم بريجنسكي، تعيش ثلاث ثورات معاً، سياسية واجتماعية ودينية،
فلننتظر إذاً، ولا نتعجّل الحكم.
وبمعزل عن حقيقة أنّ «الاضطرابات» في سوريا لم تبدأ أواخر العام 2011،
بل في الشهر الثالث منه؛ وأنّ مناطق «الجزيرة» السورية شهدت الجفاف،
ثمّ الهجرة، قبل أشهر من ابتداء «الربيع العربي» واندلاع الانتفاضة
الشعبية في تونس؛ فضلاً عن أنّ انتظار انكشاف طوية السيسي قد اتضح أنّ
دونه خرط القتاد، وإراقة المزيد من دماء المصريين، مدنيين وعسكريين على
حدّ سواء؛ وأنّ انقلابه، الذي اتكأ على إرادة شعبية واسعة ضدّ الأخونة
واستبداد الحكم الإخواني، قد ارتدّ على تلك الإرادة الشعبية فحوّلها
إلى تفويض مزوّر يعيد العسكر إلى مؤسسة الرئاسة، كما يعيد إنتاج نظام
حسني مبارك الأمني بصفة خاصة، بعد تجميله هنا وهناك… بمعزل عن هذه
وسواها من حقائق، فإنّ بريجنسكي اعتمد مقداراً فاضحاً من التقدير
السكوني لآمال الشعبين المصري والسوري، والشعوب العربية بأسرها في
الواقع، والدوافع العميقة خلف التضحيات الجسيمة والوقائع الدامية التي
شهدتها بلدان «الربيع العربي» خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
حول العراق، لم يتردد بريجنسكي في الذهاب أبعد ممّا يُنتظَر من أمثاله،
فجزم بأنّ «أخطاء الحرب في ذلك البلد لم تكن تكتيكية واستراتيجية فحسب،
بل تاريخية أيضاً. إنها، جوهرياً، حرب استعمارية، خيضت في عصر ما بعد ـ
استعماري»! تُضاف إلى هذه الخلاصة، التي بدت صاعقة في الواقع لأنها أتت
من بريجنسكي دون سواه، أطروحة تكميلية روّج لها الرجل في كتابه
«الاختيار: هيمنة عالمية أم قيادة عالمية»؛ مفادها أنّ الواقع العالمي
بعد الحرب الباردة وهزّة 9/11، وضع الولايات المتحدة في موقع فريد
لأمّة قادرة على تأمين الاستقرار العالمي من خلال السيطرة العسكرية،
وقادرة في الآن ذاته على تهديده من خلال الوسيلة العسكرية إياها.
بيد أنّ بريجنسكي هو، قبل هذه الملفات الانفجارية الثلاثة، المهندس
الأبرز وراء توريط السوفييت في أفغانستان، ثمّ إطلاق تلك «الصناعة
الجهادية» التي أنتجت الطالبان، والأفغان العرب، وأسامة بن لادن،
و«القاعدة»… وتتمة المسمّيات والأسماء التي أقضت، وتقضّ، مضجع أمريكا،
وأربع رياح الأرض، اليوم! وفي حوار شهير نشرته أسبوعية «لونوفيل
أوبزرفاتور» الفرنسية سنة 1998، اعترف بريجنسكي بأنّ البيت الأبيض هو
الذي استدرج السوفييت ودفعهم إلى خيار التدخّل العسكري، وذلك بعد إحباط
مخططات المخابرات المركزية الأمريكية لتنظيم انقلاب عسكري في
أفغانستان.
وحول ما إذا كان يندم اليوم على تلك العملية، ردّ الرجل: «أندم على
ماذا؟ تلك العملية السرّية كانت فكرة ممتازة. وكانت حصيلتها استدراج
الروس إلى المصيدة الأفغانية، وتريدني أن أندم عليها؟ يوم عبر السوفييت
الحدود رسمياً، كتبت مذكرة للرئيس كارتر أقول فيها ما معناه: الآن
لدينا الفرصة لكي نعطي الاتحاد السوفييتي حرب فييتنام الخاصة به».
ولكن، يسأله الصحافي الفرنسي فانسان جوفير، ألا يندم أيضاً على دعم
الأصولية الإسلامية، وتدريب وتسليح إرهابيي المستقبل؟ يجيب بريجنسكي:
«ما هو الأكثر أهمية من وجهة تاريخ العالم: الطالبان، أم سقوط
الإمبراطورية السوفييتية؟ بعض الغلاة الإسلاميين، أم تحرير أوروبا
الشرقية ونهاية الحرب الباردة»؟
من جانب آخر، ألا يُقال ويُعاد القول إنّ الأصولية الإسلامية تمثّل
اليوم خطراً عالمياً؟ يردّ بريجنسكي: «كلام فارغ!»، قبل أن يتابع:
«يُقال لنا إنه ينبغي على الغرب اعتماد سياسة متكاملة تجاه النزعة
الإسلامية.
هذا غباء: لا توجد إسلامية عالمية. فلننظر إلى الإسلام بطريقة عقلانية
لا ديماغوجية أو عاطفية. إنه الدين الأوّل في العالم، وثمة 1.5 مليار
مؤمن. ولكن ما هو الجامع بين أصوليي المملكة العربية السعودية، والمغرب
المعتدل، والباكستان العسكرية، ومصر المؤيدة للغرب أو آسيا الوسطى
العلمانية؟ لا شيء أكثر ممّا يوحّد بلدان الديانة المسيحية».
مهندس الجهاد الإسلامي رحل، إذن، وقد خلّف صناعة جهادية، أكثر عنفاً
وتوحشاً وغلواً، مع فارق أنها لا تنقلب على الصانع وحده، فحسب؛ بل تقلب
هندسة الصنع، ذاتها، رأساً على عقب!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
روحاني الثاني:
طيران فوق
عشّ «الإصلاح»؟
صبحي حديدي
الآن وقد فاجأ الرئيس الإيراني حسن روحاني أنصاره، قبل خصومه ربما،
بانتصار كاسح من الجولة الأولى، لم يكن هو شخصياً ينتظره على هذا
النحو، أغلب الظنّ؛ فإنّ الأسئلة الملحّة، والواقعية تماماً، التي تعقب
فورة الانتصار، هي التالية: وماذا بعد؟ ما الذي عجز روحاني عن إنجازه
في رئاسته الأولى، ويعد اليوم بإتمامه على مدار السنوات الأربع في
الرئاسة الثانية؟ وإذا جاز أنّ المرشد الأعلى، علي خامنئي، تقصد ضبط
هوامش روحاني الأوّل عند نقطة دقيقة، محسوبة بميزان الذهب، بين
«المحافظة» و«الإصلاح»؛ فأيّ تبدلات سوف تطرأ على ذلك التوازن، في ضبط
هوامش روحاني الثاني؟
ثمة اتفاق، لدى غالبية مراقبي الشأن الداخلي الإيراني، على حقيقة كبرى
ثابتة، واحدة على الأقلّ: أنّ المرشد الأعلى يريد من مؤسسة الرئاسة أن
تخدم غرضين، متناقضين ومتعارضين، في آن معاً: تطوير التنمية والاقتصاد
والخدمات ودغدغة بعض السخط الشعبي، وتحقيق بعض المطالب الاجتماعية
والثقافية (على نحو يواصل اجتذاب شرائح الشباب والمرأة ودعاة الإصلاح)،
من جهة أولى؛ وتفعيل حسّ التشكيك والسخط والاعتراض والتعطيل، ضدّ
سياسات الرئاسة، لدى فئة آيات الله وحجج الإسلام وجماعة «تشخيص» مصلحة
النظام (تماماً كما يشتهي «المحافظون» والمتشددون)، من جهة ثانية.
وثمة أسباب كثيرة تدعو إلى التشكيك في أنّ رئاسة روحاني الثانية سوف
تكون أفضل من الأولى، على صعيد اختراق هذا التوازن تحديداً؛ وأنّ نسبة
الـ 57٪، التي فاز بها منذ الجولة الأولى، سوف تتيح له أن يتجاوز حقاً
إسار التحليق مديداً حول عشّ الإصلاح، دون أن يحطّ فيه، ويستقرّ ويشيد.
تجربة السنوات المنصرمة تشكل مادّة أولى، دامغة، للتشكيك في أنّ
السنوات المقبلة سوف تشهد نقلة جذرية، أو حتى مختلفة عن السنوات
المنصرمة. وأمّا المادّة الثانية، والأهمّ ربما، فإنها التجربة الأبكر
للرئيس محمد خاتمي، حيث كان الإصلاح سيّد الرهان، فانتهت سنوات التجربة
إلى خسران شبه مبين أمام مؤسسة الولي الفقيه وشبكات المرشد الأعلى.
ففي عام 1997 انتخب الإيرانيون خاتمي، بأغلبية ساحقة أيضاً (بل فاضحة،
بالنسبة إلى خصمه علي أكبر ناطق نوري)؛ واختار خاتمي تشكيلة وزارية بدت
في حينه الأكثر تعددية و«اعتدالاً» منذ أن وطأ الإمام الخميني أرض مطار
طهران عائداً من منافيه الطوال؛ وصوّت البرلمان الإيراني على منح الثقة
لهذه الحكومة (ليس دون صعوبات ومقاومة ودسائس). ولقد حفلت سنوات خاتمي
بالجهود الإصلاحية، وبما يشبه ثورة ثقافية حداثية؛ ولكنها حفلت أيضاً
بالنقيض: تعطيل صحف، محاكمات، تصفية وزراء إصلاحيين، تضييق الخناق على
فريق الرئيس، الانتصارات والانتكاسات (التكتيكية إجمالاً) على
الجانبين، وصولاً إلى منع الناس من الترشيح للانتخابات.
وعلى نحو ما، يمكن القول إنّ الناخب الإيراني الذي منح روحاني هذه
النسبة الساحقة منذ الدورة الأولى، لم يكن يراهن على فرصة ثانية لرجل
لم يغتنم الفرصة الأولى؛ بل كان، ببساطة وحكمة عميقة، يقطع الطريق على
منافسه إبراهيم رئيسي، تماماً بمعنى اختيار بلوى مجرّبة تظلّ أهون،
بكثير في الواقع، من شرّ آت مستطير! وإذا صحّ هذا الافتراض، فإنه يكتسب
بعداً سوسيولوجياً عميقاً حين يتذكر المرء أنّ الناخب ـ الذي تفادى
رئيسي، عن طريق انتخاب روحاني ـ إنما ينتمي إلى نسبة الـ60٪ من
المواطنين الإيرانيين الذين هم تحت سنّ الـ30!
وإذا جاز أنّ بعض مغزى انتصار روحاني هو هزيمة رئيسي، بما يمثله كلّ
منهما في السياسة والاجتماع والعقيدة؛ فإنّ الراسخ الأعلى، بين فوز هذا
واندحار ذاك، هو بقاء مؤسسة «الولي الفقيه»، بقيادة المرشد الأعلى،
راسخة متينة، عليا وطاغية ومهيمنة؛ أياً كان الرئيس الذي يطيل التحليق
فوق عشّ «الإصلاح»!
(القدس العربي)
إرهاب مانشستر وإعادة
إنتاج التنميطات العمياء
صبحي حديدي
مدهش أن يقرأ المرء من معلّق مخضرم في شؤون الشرق الأوسط، مثل باتريك
كوبرن، في الـ»إندبندنت» البريطانية أمس؛ اختزالاً مذهلاً للإرهاب
الجهادي الذي ضرب مدينة مانشستر مؤخراً، وقبلها لندن وباريس وبروكسيل:
أنّ الأصل في هذا الجهاد هو الوهابية، وبالتالي المملكة العربية
السعودية، وهذا ما يتعمّد الغرب عدم الإشارة إليه بسبب علاقات المال
والأعمال مع آل سعود. «ما صار يُسمّى الجهادية السلفية، جوهر عقائد
تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة، انبثق من الوهابية، وحمل عقائده إلى
المجموعات الإرهابية كنتيجة منطقية وعنيفة. الشيعة واليزيديون لم
يكونوا هراطقة في نظر هذه الحركة، التي كانت طرازاً من الخمير الحمر
الإسلاميين، بل كائنات بشرية أدنى يتوجب استئـــــصالهم أو استعبادهم»؛
يكتب كوبرن.
بعض هذه الخلاصة، في ما يخصّ علاقة الجهادية السلفية بالوهابية
تحديداً، هو كلام حقّ بالطبع؛ ولا جديد فيه أصلاً، بل بات تحصيل حاصل،
قبل «داعش» بعقود، وربما قبل صعود منظمة «القاعدة» ذاتها. ما هو باطل،
في المقابل، واختزالي على نحو فاجع إذْ يصدر عن كوبرن نفسه، إنما يتمثل
في انتقاء جذور شبه وحيدة، لظاهرة باتت كونية ومتعددة النطاقات
والعقائد، ومن الجهل والفظيع، والحماقة التي لا تُغتفر، أن يتمّ حصرها
في جذور أحادية، وتربة وحيدة، هي الوهابية.
فإذا صحّ أننا لا نسمع عن مجموعات إرهابية يزيدية (وجمع هذه العقيدة مع
الشيعة خيار فاضح بدوره، وقاصر وجاهل، أصلاً)؛ فهل يعقل أنّ كوبرن لم
يسمع بإرهاب «شيعي»، على غرار ما مارسته وتمارسه مفارز «الحشد» هنا
وهناك في العراق، وفي الموصل بصفة خاصة؟ هل كان صعباً عليه أن يخطف
نظرة سريعة إلى موقع «غوغل»، فيقرأ ما وثقته مجلة «دير شبيغل» من جرائم
عناصر «الحشد»، الذين أطلقت عليهم الأسبوعية الألمانية صفة «الوحوش»،
ليس أقلّ؟ الأرجح أنّ كوبرن يعرف، بل لعله أعرف منّا بالنظر إلى صلاته
العتيقة بالمنطقة، وليس سكوته عن تلك الانتهاكات إلا بعض أغراض سيرورة
الاختزال؛ هذه التي لم تعد ركيزة كبرى في كتاباته، وأمثاله، فحسب؛ بل
باتت منهجية راسخة في فرز جماعات المسلمين إلى معسكرين: واحد يفرّخ
الإرهاب (من أهل السنّة، عموماً، الذين يعادون المثليين وحقوق المرأة،
أيضاً!)؛ ومعسكر آخر يتوجب تصنيفه في الطرف النقيض (من الشيعة
واليزيديين، ولا نعرف على وجه الدقة لماذا تجاهل كوبرن الفرق الإسلامية
الأخرى!).
وهذه المنهجية تستدعي التذكير، مجدداً، بأنه إذا كانت يد الإرهاب عمياء
غالباً تجاه يخصّ الضحايا، لأنّ البطش هنا يظلّ عشوائياً واعتباطياً،
لا يكترث بإقامة أية موازنة بين الغاية والوسيلة؛ فإنّ نقطة الاستذكار
التالية، المقترنة بالأولى مباشرة، هي حقيقة أنّ المنخرطين في مختلف
مستويات الإرهاب ليسوا دائماً قتلة محترفين، تخرّجوا من مدارس الجريمة
المنظمة والعنف وسفك الدماء. الثابت، خاصة بين شرائح مجنّدي «داعش» على
الأرض الأوروبية، أنّ غالبية كبيرة من هؤلاء ليست مصابة بمسّ من جنون
متأصل، تجعلها في حال من البغضاء المطلقة ضدّ الإنسانية جمعاء (كما
يوحي هواة التنميطات المسبقة، العنصرية منها تحديداً)؛ أو ضدّ «النموذج
الحضاري الغربي»، كما يساجل دعاة صدام الحضارات، ممّن يستهويهم حصر
مشكلات الإرهاب في جذور عقائدية ـ دينية تخصّ الإسلام أوّلاً.
ذلك، في خلاصة موازية غير اختزالية، يعني أنّ بعض أسباب الأعمال
الإرهابية الداخلية، إذا جاز التعبير، أي تلك التي تشهدها المجتمعات
الغربية على أيدي أبنائها وليس بأيادٍ خارجية؛ ليست بعيدة عن سياقات
التربية العائلية، ومشكلات الحياة اليومية، وطبائع السلوك العام،
والأمزجة النفسية، والنزوعات الفكرية والثقافية. تلك، في مثال أوّل،
كانت حال مايكل أديبولاجو، البريطاني من أصل نيجيري، مرتكب الجريمة
الإرهابية البشعة التي وقعت في ضاحية وولتش، جنوب شرقي العاصمة
البريطانية لندن، قبل سنوات قليلة: لقد ولد في بريطانيا، ودرس في
مدارسها، وانتسب إلى إحدى جامعاتها، حتى ساقته الأقدار (في سنّ
البلوغ!) إلى اعتناق الإسلام، ثمّ التطرّف في فهم التباس العلاقة بين
الغرب والمسلمين، وصولاً إلى اعتبار كلّ جندي بريطاني مسؤولاً عن «قتل
المسلمين كلّ يوم»، كما ردد على الملأ، حاملاً ساطور ذبح يقطر دماً.
تلك، أيضاً، كانت حال ياسين حسن عمر ومختار محمد سعيد إبراهيم ورمزي
محمد وحسين عثمان، البريطانيين من أصول مسلمة، الذين حوكموا وأُدينوا
بالتخطيط لأعمال إرهابية واسعة النطاق شهدتها العاصمة البريطانية، صيف
2005. فهل كان سقوط هؤلاء في حمأة الإرهاب والكراهية والقتل العشوائي
وهستيريا الاستشهاد الزائف، بمثابة مآل حتمي لتعاليم الديانة التي
اعتنقوها؟ أم جرّاء تفسير متطرّف لمصائر تلك الديانة في الأحقاب
المعاصرة، بعد أن تسيّست على أيدي سلطات حاكمة فاسدة ومجموعات متشددة
على حدّ سواء؟ أم لأسباب تربوية ذات صلة بهذه الاعتبارات وغير
منفصــــــلة عن وضعــية الالتباس ذاتها، بين الغرب والعالم المسلم؟
أم، أخيراً، وكما يستدعي المنطق البسيط، للأسباب هذه كلّها، مجتمعة
ومتكاملة ومترابطة؟
وما دامت هذه السطور تتناول واقعة مانشستر الإرهابية، ثمة هنا مثال
ثالث تصحّ استعادته لأنه قد يمثّل المستوى الأقصى في توصيف الإشكالية
بأسرها؛ أي حال ازدواج الشخصية التي كان يعيشها حسيب صادق وشاهزاد
تنويري ومحمد خان، إرهابيو عمليات تفجير أنفاق لندن، صيف ذلك العام
أيضاً، والتي أوقعت 52 قتيلاً ومئات الجرحى: بين اندماج كامل، أو شبه
مكتمل، في الحياة البريطانية والحضارة الغربية إجمالاً؛ وبين انسلاخ
إرادي عن هذه الحياة، استجابة إلى اعتبارات عقائدية صرفة، لا تغيب عنها
السياسة دون ريب. وبهذا المعنى تصبح التفسيرات الأحادية لسلوك هؤلاء
الإرهابيين مجرّد لغو، لأنهم لم يرتكبوا تلك الفظائع احتجاجاً على هذا
أو ذاك من أعراف الحضارة الغربية وأعرافها، أو هذه أو تلك القضايا التي
تخصّ واقع الإسلام في بريطانيا؛ أو ـ في استطراد المنطق ذاته ـ لأنّ
الوهابية كانت، وحدها، فلسفة التشدد والعنف الطاغية في نفوسهم.
والحال أنه ليس مدهشاً، في الخلاصة، أنّ اختزالات معلّقين من أمثال
كوبرن لا تبدي كبير اكتراث بالسياسة، أو بالأسباب الأعمق ـ الجديرة،
أولاً، بالصفة الراديكالية ـ التي قادت أمثال سلمان عبيدي، إرهابي
مانشستر، إلى «داعش»، في ليبيا أو سوريا أو العراق؛ ثمّ آبت بهم إلى
بروكسيل، وقبلها باريس، وأورلاندو، وبعدها لندن، ثمّ مانشستر قبل أيام؛
لكي لا يعود المرء بالذاكرة إلى حقبة أسبق، لم يكن الخليفة البغدادي قد
تسيدها بعد، حين أصاب الإرهاب قطارات مدريد وأنفاق لندن وباريس. حتى
الاجتماع السياسي، في حدوده الدنيا، وبمعنى روابط الحياة العائلية مع
السياسة في الشارع والوجدان والثقافة والديانة، لا يُطرح إلا على نحو
انتقاصي واختزالي. تأثيراته ليست هيّنة بالتأكيد، لكنها ليست العوامل
الكبرى الحاسمة في تكوين الذهنية الجهادية، ثم الإرهابية الانتحارية.
ليس أسهل من أن يدين كوبرن الوهابية، ويدين تغاضي الغرب عن السعودية
(وكان سهلاً عليه، كذلك، لو تذكّر كيف دُشّنت «الصناعة الجهادية» من
أفغانستان، ضدّ السوفييت، ليس بوحي من الوهابية بل بهندسة من زبغنيو
بريجنسكي مستشار الأمن القومي في رئاسة جيمي كارتر، وتنفيذ المخابرات
المركزية الأمريكية والبنتاغون). ثمّ، في استكمال المعادلة هذه، ليس
أيسر على المعلّق المخضرم من أن يقرأ واقعة إرهاب دامية، مثل تفجير
الحفل الغنائي في مانشستر، ليس من منطلق الذهاب إلى جذور الظاهرة، بل
بقصد إعادة إنتاج التنميطات العتيقة التي باتت أسطوانة مشروخة.
وليته زاد في الطنبور نغماً، واحداً على الأقلّ!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
ترامب والإسلام:
مَن توقف
عن كراهية الآخر؟
صبحي حديدي
على غرار القاعدة العتيقة، التي تفيد بأنّ كلام الليل يمكن أن يمحوه
النهار التالي؛ فإنّ علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإسلام،
والمسلمين والعالم المسلم استطراداً، يمكن أن تكون اتخذت هذا المآل:
كلام المرشح ترامب، أخذ يمّحي مع تحوّله إلى رئيس.
وليس في هذا أية عجيبة، إذْ لا ينفرد ترامب عن سواه من رؤساء أمريكا
(أو معظم ساسة عالمنا المعاصر، سواء أكانوا من أرباب الديمقراطية أم
الاستبداد)؛ لولا أنّ «عيار» الفارق بين خطابَيْ المرشح والرئيس يبدو
هائلاً٫ بل أدعى إلى صناعة البون الشاسع. وهذا الرجل، قائد القوّة
الكونية الأعظم، الذي هبط أمس في المملكة العربية السعودية للاجتماع
بزعماء أكثر من 50 دولة عربية/ مسلمة؛ هو، نفسه، الذي صرّح بالفم
الملآن، أثناء حملاته الانتخابية، أنّ «المسلمين يكرهوننا»، ولديهم
تجاه أمريكا «كمّ هائل من الكراهية».
فكيف، بافتراض وجود كمّ قليل فقط من الكراهية، يخطر للرئيس الأمريكي
أنّ بلده يستطيع إقامة تحالف أمني وطيد مع عالم المسلمين، والإسلام؛
و»بناء شراكات أمنية أكثر فاعلية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية
المتزايدة للإرهاب والتطرف من خلال تعزيز قيم التسامح والاعتدال»، كما
تردد حرفياً، عن الجانب الأمريكي؟ أليسوا هؤلاء أنفسهم، أبناء الإسلام،
هم أهل التطرف والتشدد والإرهاب في ناظر ترامب/ المرشح؟ هل تبدلوا
حقاً، وجذرياً، بل انقلبوا إلى نقيض يبرر إقامة الأحلاف معهم، في ناظر
ترامب/ الرئيس؟
لعلّ من المفيد استذكار بعض الحقائق البسيطة حول تاريخ العلاقات بين
أمريكا والعالم المسلم: أنّ الرئيس توماس جيفرسون علّم نفسه اللغة
العربية، مستخدماً نسخة من القرآن الكريم (كان يحفظها في مكتبته
الشخصية، ثمّ استخدمها كيث إليسون، أوّل نائب مسلم في الكونغرس، لأداء
القسم سنة 2006)، وأنه كان أوّل من أقام مأدبة إفطار رمضانية، استضاف
فيها السفير التونسي؛ أو الرئيس دوايت أيزنهاور، الذي حضر الاحتفال
الرسمي بافتتاح المركز الإسلامي في واشنطن، صيف 1957، أو الرئيس بيل
كلنتون، الذي كان أوّل من أصدر تهنئة رسمية بحلول شهر رمضان، كما عيّن
أوّل سفير أمريكي مسلم (عثمان صديقي، في فيجي)؛ أو الرئيس جورج بوش
الابن، الذي نقل نسخة القرآن الكريم من مكتبة جيفرسون الخاصة، إلى
مكتبة البيت الأبيض، سنة 2005.
وفي سنة 2009، أثناء خطبته العصماء في جامعة القاهرة، شدد الرئيس باراك
أوباما على الحقيقة التاريخية التالية: أوّل اعتراف رسمي بحكومة
الولايات المتحدة الأمريكية، المستقلة وكاملة السيادة، لم يصدر عن
حكومة أوروبية مسيحية، أو شرقية غير مسلمة؛ بل كان السبق فيه قد انعقد
لحكومة المغرب، المسلمة! كذلك شاء أوباما المضيّ أبعد، حين اعتبر أنّ
ما بين أمريكا والإسلام يظلّ أبعد من مجرد علاقات ثقافية ـ دينية،
لغوية أو رمضانية أو بروتوكولية؛ فأقرّ بأنّ الإسلام جزء من أمريكا،
بدلالة وجود سبعة ملايين مسلم، وأكثر من 1200 مسجد في مختلف الولايات.
وهكذا، إذا جاز التصديق على كلام ترامب/ المرشح، بصدد ما تحمله الشعوب
المسلمة من كراهية للسياسات الأمريكية في المنطقة (وليس للشعب الأمريكي
ذاته، كما يقول المنطق البسيط)؛ فهل يجوز، استطراداً، التصديق على
نوايا ترامب/ الرئيس، حول استقلاب تلك الكراهية إلى محبّة مع الشعوب،
بافتراض أنّ «تحالف» معظم حكام العالم المسلم مع ترامب يختلف، بأيّ
معنى، عن التبعية عينها؟
كلا، أغلب الظنّ؛ الأمر الذي يمضي بالسجال إلى سؤال آخر: في العلاقة
بين ترامب والإسلام، مَنْ توقف عن كراهية الآخر؟
(القدس العربي)
رئاسيات إيران:
شيكات بلا رصيد
على أعتاب الولي الفقيه
صبحي حديدي
كانوا ستة مرشحين، رجالاً، حصرياً (إذْ لم يأذن «مجلس صيانة الدستور»
بترشيح أية امرأة)، لانتخابات الرئاسة الإيرانية، التي تجري اليوم.
انتهوا إلى ثلاثة أساسيين، بعد سلسلة انسحابات؛ ثمّ كرّت السبحة،
بعدئذ، مع استسلام محمد باقر قاليباف: الطيّار، أصغر المرشحين سنّاً،
القائد السابق في «الحرس الثوري»، منافس محمود أحمدي نجاد في دورة
2005، والمرشح الذي حلّ ثانياً في دورة 2013 أمام حسن روحاني. وهكذا،
استقرت الجولة عند الصراع بين الأخير، الرئيس الحالي وممثل «الاعتدال»
و»الإصلاح»؛ وإبراهيم رئيسي، ممثل «التشدد» و»التيار المحافظ».
والحال أنّ توصيفات المرشحَين لا توضع بين أهلّة اقتباس، إلا لأنّ
معانيها تنطوي على الكثير من الإبهام والالتباس، ودلالاتها الفعلية لم
تستقرّ مرّة واحدة منذ شيوعها للمرة الأولى؛ خلال عهد الرئيس الخامس
محمد خاتمي، 1997. فإذا انطلق المرء من سجلّ الرئيس الحالي، فإنّ معظم
الوعود التي قطعها على نفسه، أمام الشارع الشعبي، لم يتحقق منها إلا
النزر اليسير؛ خاصة الاتفاق النووي مع الغرب، الذي تضمن رفع جزء من
العقوبات عن إيران، وسمح بمعدّل نموّ بلغ 6,6 بالمئة، لكنه أبقى معدّل
البطالة على حاله، بل تفاقم وتضخم في قطاعات عديدة. كذلك لم يفلح
روحاني في تخفيف حدّة القيود الاجتماعية المفروضة على المرأة، وعجز عن
ضخّ جرعة بسيطة ملموسة من الحريات السياسية والمدنية.
منافسه رئيسي لا يخفي تاريخه «الحافل»، سواء في سلك القضاء، حيث شارك
في إصدار أحكام بالإعدام على المئات، والبعض يتحدث عن الآلاف، أواخر
الثمانينيات؛ أو في انضوائه التامّ ضمن مؤسسات الولي الفقيه، و»الحرس
الثوري»، حتى أنّ الشائعات ترى فيه خليفة محتملاً للمرشد الأعلى علي
خامنئي. ومع ذلك فإنه، خلال خطبه أثناء الحملة الانتخابية ومناظراته مع
روحاني، لم يقطع وعوداً «مضادة»، إذا جاز القول، بخصوص إمكانية التراجع
عن الاتفاق النووي مثلاً، أو التضييق أكثر على الحريات، أو إلغاء بعض
التدابير التي اتخذها روحاني وصُنّفت في خانة «الإصلاحات».
ذلك لأنّ انتخابات الرئاسة في إيران، وهذه التي تجري اليوم هي الثانية
عشرة منذ الثورة الإسلامية والإطاحة بنظام الشاه، تبقى مسقوفة بمبدأ
عقائدي وفقهي وتشريعي، ثمّ سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني وعسكري… هو
ولاية الفقيه. وسنة بعد سنة، في كلّ استحقاق انتخابي تشريعي أو رئاسي،
تبقى آفاق التغيير الداخلي في إيران معلقة، أو بالأحرى مغلقة، عند
المراجعة الراديكالية الشاملة لهذا المبدأ بالذات، وتصحيح علاقته
بالحياة والحقّ والمجتمع والعصر. وهذا، للتذكير، مبدأ في «الحكم
الإسلامي» صاغه الإمام الخميني على عجل، حين كان منفياً في مدينة النجف
العراقية عام 1971؛ وخضع على الدوام لأخذ وردّ، حين اختلف حول تأويلاته
عدد كبير من فقهاء الشيعة. ونعرف أنّ خامنئي هو، اليوم كما في الأمس،
أشدّ المدافعين عن المبدأ، وأبرز المتمسكين بالإبقاء عليه في صلب
الدستور، بل وتشديد وتوسيع صلاحيات الوالي الفقيه المنصوص عنها حالياً
في الدستور. وليست عسيرة معرفة أسباب هذا الحماس، بالطبع.
فما الذي يتبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية، محافظاً كان أم إصلاحياً،
إذا كانت سلطة الوالي الفقيه تتضمن تسمية أعضاء مجلس المرشدين، وتسمية
مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة القيادة العليا للقوات المسلحة (بما في ذلك
تعيين أو عزل رئيس الأركان، وقائد «الحرس الثوري»، وأعضاء مجلس الدفاع
الأعلى، وقادة صنوف الأسلحة)، وإعلان الحرب والسلام والتعبئة، وإقرار
أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية، وتوقيع مرسوم تسمية رئيس
الجمهورية بعد الانتخابات، وإدانة الرئيس وعزله بموجب أسباب تتعلق
بالمصلحة الوطنية، وإصدار مختلف أنواع العفو؟ ثمّ ألم يحدث، مراراً،
أنّ بعض الفقهاء ورجالات الحكم ذهبوا أبعد مما ينبغي في تفسير مبدأ
ولاية الفقيه؛ كما حدث حين اعتبر أحمد أزاري ـ قمّي، أحد من كبار شارحي
فكر الخميني، أنّ بين صلاحيات الوالي الفقيه إصدار «منع مؤقت» من أداء
فرائض دينية مثل الحجّ، أو إصدار أمر بهدم بيت المسلم، أو توجيهه
بتطليق زوجته؟
وهكذا، إذا صحّ أنّ المعارك السياسية والاجتماعية والاقتصادية
والثقافية، التي تكتنف الرئاسيات الإيرانية، يمكن أن تدور بالفعل بين
«المحافظين» و»الإصلاحيين»، حول التنمية والمعيشة والوظائف والخدمات
والحريات؛ فإنّ المعركة الأكثر جوهرية، أي التخفيف من وطأة ولاية
الفقيه، ليست في عداد الملفات المسكوت عنها، فحسب؛ بل يتنافس المرشحون
في مقدار الحثّ على… تحريم النقاش حولها! ذلك، في عبارة أخرى، يعني أنّ
المعركة لا تدور حول مسائل الانفتاح على الغرب، وصواب أو خطل سياسة
«تصدير الثورة» ومواصلة الكفاح ضدّ الإمبريالية العالمية، والتورط في
سوريا والعراق ولبنان واليمن والبحرين والكويت. إنها، في الجوهر، ما
تزال تدور حول حاضر ومستقبل إيران، وحول مسائل داخلية سياسية واقتصادية
واجتماعية وثقافية، أوّلاً وجوهرياً.
ومن جانب آخر، إذا كان خامنئي قد حرص على إدامة التوازن بين فريقَي
المحافظين والإصلاحيين، واعتبرهما «جناحين لا بدّ منهما لكي يحلّق طائر
الثورة الإسلامية»؛ فإنه انحاز منذ البدء إلى الفريق الأوّل، بل رجّح
كفّة المجموعة الدينية ـ العسكرية المتشددة. وليست بعيدة في الزمن تلك
البرهة التي شهدت اندلاع تظاهرات طلابية ضخمة في شوارع طهران، تطالب
باستقالة خامنئي وخاتمي معاً؛ وأن تعلن مجموعة مؤلفة من 248 شخصية
إصلاحية أنّ «وضع أشخاص في موضع السلطة المطلقة والألوهية هو هرطقة
واضحة تجاه الله وتحدّ واضح لكرامة الإنسان»، في إشارة عدائية لمبدأ
ولاية الفقيه، كانت النقد الأوضح والأكثر جرأة حتماً منذ انتصار الثورة
الإسلامية. ومن الطريف أنّ أبرز انتقادات المرشح رئيسي، ضدّ منافسه
المرشح روحاني، تبدأ من اتهام الأوّل للثاني بـ»التفريط» بالسيادة
الإيرانية عبر توقيع اتفاق نووي مع الغرب لم يكن، في نظر رئيسي، سوى
«شيك بلا رصيد». ومصدر الطرافة أنّ الأخير يعد مواطنيه الإيرانيين
بمستندات مالية من طراز آخر، ضمانتها هذه المرّة لا تتوفر في المصارف
والمؤسسات والاتفاقيات الدولية، لأنها إنما تُصرف في غياهب الغيب فقط،
بضمانة من… المهدي الغائب! الأمر الذي يعيد الذاكرة إلى ذلك «النزاع
العقائدي» بين الرئيس السابق أحمدي نجاد، ونفر من آيات الله وحجج
الإسلام، حول زعم الأوّل بأنّ «يد الله سوف تظهر وترفع الظلم عن
العالم»، وأنّ «أعداء إيران يعلمون أنّ عودة المهدي الغائب حتمية».
وهذا ـ أحمدي نجاد، هو نفسه الذي منعه «مجلس صيانة الدستور» من الترشيح
لهذه الدورة، فهدد بكشف النقاب عن لجوء «الحرس الثوري» إلى تزوير
الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 ـ كان، ذات يوم غير بعيد، قد استُقبل في
العاصمة اللبنانية بيروت على رؤوس الأشهاد، بطبول وزمور وطقوس تفخيم
وتلميع وتعظيم، قلّ مثيلها؛ وتولى «حزب الله» تضخيم سجاياه القيادية،
ورفع خصاله الشخصية إلى سوية رفيعة (السند العظيم للمقاومين والمجاهدين
والمظلومين). الذروة جاءت من حسن نصر الله، الأمين العام لـ»حزب الله»،
شخصياً: «نشمّ بك يا سيادة الرئيس رائحة الإمام الخميني المقدس، ونتلمس
فيك أنفاس قائدنا الخامنئي الحكيم، ونرى في وجهك وجوه كلّ الإيرانيين
الشرفاء من أبناء شعبك العظيم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم
من قضى نحبه في كلّ الساحات، ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا».
.. على صعيد الشيكات التي بلا رصيد، في الواقع؛ إذْ أنهم، هنا تحديداً،
ما بدّلوا تبديلا!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
شارع الشباب
العربي المعاصر:
نُذُر الأنواء العاصفة
صبحي حديدي
«أصداء بيرسون مارستيلر» شركة متخصصة في العلاقات العامة واستطلاع
الرأي، تنتمي إلى مجموعة
MENACOM
التي تنتشر في 107 بلدان، وتستخدم 135 ألف موظف، في أكثر من 2000 مكتب
حول العالم. وترفع الشركة شعار «لا أحد يفهم الشرق الأوسط مثلنا»،
متكئة في المقام الأوّل على استطلاعها السنوي حول رأي الشباب العربي؛
وتزعم أنها تسعى من خلاله إلى «تقديم صورة واقعية حول مواقف ووجهات نظر
الشباب العربي، بما يتيح تزويد مؤسسات القطاعين العام والخاص ببيانات
وتحليلات ميدانية تساعدهم في اتخاذ القرارات الصائبة ووضع السياسات
السديدة». كذلك تعلن «أصداء بيرسون مارستيلر» أنّ استطلاعها هذا «يوفّر
رؤى غير مسبوقة حول الشريحة السكانية الأكبر في المنطقة وهم شبابها
الذين يصل عددهم إلى 200 مليون شاب وشابة».
استطلاع 2017 صدر قبل أيام، تحت عنوان «صورة واقعية حول آمال ومخاوف
وطموحات الشباب العربي»؛ وتشير معطياته المنهجية إلى 3498 مقابلة، في
16 بلداً عربياً (دول مجلس التعاون الخليجي، مصر، الجزائر، ليبيا،
المغرب، تونس، العراق، الأردن، لبنان، «الأراضي الفلسطينية»، اليمن)،
لفئات عمرية تتراوح بين 18ـ24 سنة، بمساواة تامة بين الذكور والإناث.
هنا أبرز نتائج الاستطلاع، مقتبسة بصفة شبه حرفية:
ـ انقسام الشباب العربي جغرافياً في نظرتهم للمستقبل، إذْ أنّ التفاؤل
والتشاؤم تحدده المنطقة التي يعيشون فيها؛ والخلاصة هي أنّ التفاؤل في
تراجع مستمر، وشباب منطقة الخليج العربي هم الأكثر تفاؤلاً حول مستقبل
بلدانهم.
ـ الشباب العربي يطالبون بلدانهم بالمزيد من الاهتمام، والعديد منهم
يشعر بأنهم لا يشكلون أولوية في سياسات حكوماتهم، وبالتالي: غالبية
الشباب العربي تعتقد بأنّ على حكومات بلدانهم القيام بالمزيد لتلبية
احتياجاتهم.
ـ الشباب العربي يرى بأن البطالة والتطرف هما من أكبر العقبات التي
تعيق مسيرة التقدم في منطقة الشرق الأوسط.
ـ غالبية الشباب العربي تعتقد بأنّ نظام التعليم الحالي لا يؤهلهم لشغل
وظائف المستقبل، وهذا خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة محددة.
ـ الشباب العربي يرى بأن تنظيم «داعش» أصبح أضعف خلال العام الماضي؛
استناداً إلى شرائح تقدير تبدأ من «أقوى بشكل كبير»، وتنتهي إلى «أضعف
بشكل كبير»، فضلاً عن خيار «بقي على حاله».
ـ يعتبر الشباب العربي أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معادٍ
للمسلمين، وينظرون إلى عهده بمزيج من القلق والغضب والتخوف؛ كما يرون،
في الخلاصة، أنّ انتخابه أكثر تأثيراً على المنطقة من ارتفاع أسعار
النفط وخسارة تنظيم «داعش» لمناطق نفوذه.
ـ استطراداً، يتنامى العداء تجاه الولايات المتحدة؛ كما تعتبر غالبية
من الشباب العربي أنّ روسيا، وليس الولايات المتحدة، هي الحليف الدولي
الأكبر للمنطقة.
ـ في الأبعاد الثقافية، ورغم اعتزازهم بلغتهم الأمّ، تقول غالبية من
الشباب العربي أنها تستخدم اللغة الإنكليزية أكثر من العربية. يُشار،
في هذا، أنّ شباب دول مجلس التعاون الخليجي يعتبرون اللغة العربية
مكوناً أساسياً لهويتهم الوطنية.
ـ الـ»فيسبوك» هو المصدر الأوّل للأخبار اليومية عند الشباب العربي،
وذلك على حساب القنوات الإخبارية التلفزيونية والمواقع الإلكترونية
والصحف المطبوعة.
ثمة، بادئ ذي بدء، غياب واضح لرأي الشباب السوري، لا يبرره ـ إلا
قليلاً فقط، ربما ـ أنّ ظروف البلد لا تسمح باستطلاع رأي هؤلاء الشباب.
الأرجح أنه كان في وسع فرق الاستطلاع أن تستفتي عيّنات من آراء هؤلاء
الشباب في دمشق العاصمة مثلاً، أو في مناطق تتمتع باستقرار أمني أعلى،
في مدينة مثل اللاذقية على سبيل المثال، رغم المظانّ المنهجية في خيار
مناطقي مثل هذا. كذلك كانت النتائج ستنطوي على معطيات دالة، أو بالغة
الدلالة في الواقع، لو أنّ أجهزة الاستطلاع وقفت على آراء الشباب
السوري في المهاجر، القريبة أو البعيدة، في الأردن ولبنان وتركيا، ثمّ
في أوروبا؛ مع تسويغ منهجي لهذا الخيار، كان ممكناً بدوره، وحمّال مغزى
أيضاً.
هنالك، تالياً، ذلك النقص (الفادح، في يقيني الشخصي)، المتمثل في تحاشي
طرح تلك الأسئلة التي تدخل في باب المسكوت عنه؛ مثل سؤال الطائفية،
والمذهبية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والسلطة، والاستبداد،
والفساد، وما إليها. ومن الواضح، استطراداً، أنّ «أصداء بيرسون
مارستيلر» تفضّل توفير الخدمات الآمنة، «الناعمة» إذا جاز القول، أو
تلك التي لا تثير حرج السلطات العربية إجمالاً؛ إلا إذا كانت الشركة
توفّر نموذجاً آخر من الاستطلاع، يحمل معطيات محظورة على اطلاع الجمهور
العريض، خاصة بالمشتركين، أو بالجهات التي تعتزم شراء تلك المعطيات.
ذلك لأنه ليس منطقياً، وليس من المقبول منهجياً في الواقع، أن تُطرح
أسئلة التفاؤل والتشاؤم والعمل والبطالة والتطرف واللغة والهوية… دون
أن تقترن هذه الملفات بأسئلة الطائفة والمذهب والسلطة؛ التي لم تعد
منفصلة، البتة، عن هواجس المواطن العربي المعاصر، خاصة في أوساط
الشباب.
ولعلّ من المفيد، هنا، العودة إلى دراسة رائدة بعنوان «الشارع العربي:
الرأي العامّ في العالم العربي»، كتبها دافيد بولوك، وصدرت سنة 1992 عن
«معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط». هنا ثلاث توصيات، بين أخرى عديدة،
خلص إليها بولوك:
1 ـ الشارع العربي ليس خرافة قوموية أو ثوروية أو رومانتيكية، بل هو
موجود وقابل للقياس؛ فلا تتجاهلوه، ولا تقللوا من قيمته، قياساً على
«عطالة» ظاهرية.
2 ـ الرأي العام العربي أبعد ما يكون عن التجانس والوحدة والثبات، حتى
في مسائل متفجرة مثل الإسلام والديمقراطية؛ فلا تضعوا كلّ الرأي العامّ
العربي في سلّة واحدة.
3 ـ النُخَب العربية جريحة بهذا القدر أو ذاك، في هذه الإشكالية
الإيديولوجية أو تلك، هنا أو هناك، ولكن حذار… النخبة شيء (هامّ
للغاية، بطبيعة الحال)، والشارع شيء آخر. لا تدعوا كوابيس الأحلام
المنكسرة عند المثقف تحجب هدير الشارع في ساعات الصباح الأولى، أو
نهايات يوم عمل شاق بحثاً عن اللقمة؛ وافتحوا كلّ العيون على المساجد
والأزقة والمقاهي وملاعب كرة القدم.
وقبل سبع سنوات، لم يكن في وسع شبلي تلحمي، أستاذ العلوم السياسية في
جامعة ماريلاند الأمريكية، أن يتكهن البتة بأنّ سنة 2011 سوف تحمل معها
بشارة انتفاضة تونس، أو انتفاضات العرب اللاحقة في مصر وليبيا واليمن
والبحرين وسوريا… وهكذا، كان استطلاع الرأي العام العربي، الذي يشرف
على تنفيذه سنوياً لصالح مركز حاييم صبان، معهد بروكنغز، قد تجاهل
تماماً مسائل الديمقراطية والتمثيل البرلماني وحقوق الإنسان والحرّيات
العامة والدستورية؛ ولم يتطرّق، أبداً، إلى موضوع التحرّكات الجماهيرية
وأشكال ومضامين الاحتجاج في الشارع الشعبي العريض.
أخيراً، قبل ثلاث سنوات، كان هوان كول، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط وجنوب
آسيا في جامعة مشيغان الأمريكية، قد أصدر كتابه «العرب الجدد: كيف يقوم
الجيل الألفي بتغيير الشرق الأوسط»؛ فتحدّث بإسهاب عن شرائح الشباب
العربي: مواليد الفترة بين أواخر 1970 ومطالع 2000، ثلث العالم العربي
أو أكثر قليلاً؛ مدينيون، غالباً، ومتعلمون (وبالتالي ليسوا، بالضرورة،
من فئة المثقفين!)، متمرسون في تكنولوجيا الميديا ووسائط التواصل
الاجتماعي، والعديد منهم عملوا خارج بلدانهم الأصلية، وفي أوروبا
وأمريكا تحديداً؛ كما أنهم، وهذا تفصيل هامّ في الواقع، أقلّ تديّناً
من آبائهم، وأكثر انفتاحاً على العالم.
ولأنّ المجتمع العربي بين أكثر المجتمعات المعاصرة شباباً، فإنّ شارع
الشباب العربي ليس أشدّ تعقيداً من معظم اختزالاته، السوسيولوجية
تحديداً، فحسب؛ بل إنّ نُذُر منعرجاته لا تأتي، أيضاً، إلا على هيئة
بروق ورعود و… أنواء عاصفة!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي) لندن
الانتخابات الفرنسية:
رميم اليمين ورماد اليسار
صبحي حديدي
مضى زمن طويل منذ أن شهدت فرنسا ثورة، أو حتى محاولة إصلاح جذرية؛ تجزم
أسبوعية «إيكونوميست» البريطانية، في ما يشبه التكهن بأنّ ثورة ما توشك
على الوقوع هنا، في مناسبة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تبدأ
جولتها الأولى يوم 23 نيسان (أبريل) الجاري. ليس التشخيص صحيحاً
بالطبع، إلا إذا وُضع في النصاب المعتاد الذي تعتمده أسبوعية محافظة
ويمينية لمفهوم «الثورة»، أو حتى «الإصلاح»؛ إذْ في وسع المرء أن يضرب
مثالاً واحداً، حديثاً، في احتجاجات 1968 التي أطاحت بالجنرال شارل
ديغول (أيقونة فرنسا الأبرز منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم
ربما)، وأرست سلسلة مواضعات سياسية واجتماعية وفكرية ما تزال فاعلة
وراسخة.
ليست هنا المسألة التي تعني هذه السطور، بل حقيقة أنّ الانتخابات
الرئاسية القادمة تبدو بالفعل حالة فارقة بالقياس إلى جميع سابقاتها،
على امتداد عقود الجمهورية الخامسة؛ التي دشنها الجنرال/ الأيقونة
نفسه، في سنة 1958، على أنقاض جمهورية رابعة برلمانية وشبه رئاسية،
انتهت إلى ما يقارب الشلل الدستوري.
الأكثر جدوى، في المقابل، هو التأمل في احتمال نوعي كبير، قد يصبح
حقيقة صاعقة مساء الأحد القادم: أنّ «اليمين» الديغولي، و»اليسار»
الاشتراكي، اللذَين تناوبا على حكم فرنسا منذ إطلاق الجمهورية الخامسة،
قد يخرج مرشحاهما ـ فرنسوا فيون وبنوا هامو، على التوالي ـ من الدور
الأوّل؛ وأنّ البديل قد ينحصر في ممثلة اليمين المتطرف مارين لوبين،
وممثل الليبرالية التكنو ـ مصرفية إمانويل ماكرون.
المفارقة التالية، والتي تجسدت طيلة الأسابيع الماضية ولا تحتاج إلى
برهة الحقيقة بعد يومين؛ هي أنّ تسعة على الأقلّ، من أصل أحد عشر
مرشحاً، يزعمون مرجعية عليا مشتركة، هي… الجنرال/ الأيقونة، دون سواه!
حتى لوبين، مرشحة «الجبهة الوطنية»، تعتبر أنها الوريث الأصدق الناطق
بلسان ديغول، في ميادين ثلاثة تشكّل «أقانيم» عقيدتها: الاستقلال،
الهوية، والأمن. وأمّا فيون، ممثّل حزب «الجمهوريين» والديغولي
«الرسمي» كما يتوجب القول، فقد صنع مفارقة مبكرة حين طلب من أهل اليمين
أن يتخيلوا الجنرال محالاً إلى القضاء ومرشحاً رئاسياً في آن (غامزاً
من قناة منافسه، يومذاك، نيكولا ساركوزي)؛ فوقع في شرّ مطلبه هذا، إذْ
هو اليوم المحال إلى القضاء، و… المرشح! ماكرون، من جانبه، يزعم شرعية
ديغولية على اليمين تارة، وشرعية اجتماعية على اليسار تارة؛ كيف لا وقد
كان وزيراً في حكومة اشتراكية، قبل أشهر معدودات، ثمّ استقال لأنّ
سياساتها لم تكن ليبرالية كما يشتهي ويحبّ! جان ـ لوك ملنشون، مرشح
«الإباء» الفرنسي، لا يعود إلى الجنرال بالطبع؛ إذْ يحلو له أن يمتدح
هوغو شافيز مرّة، ومرّة أخرى… فلاديمير بوتين!
حال أشبه بالسعي إلى نفخ الحياة في رميم اليمين، أو إحياء اللون القاني
في رماد اليسار؛ أو، على صفّ اليمين المتطرف، تجميل وجه جان ـ ماري
لوبين، الأب المؤسس لـ»الجبهة الوطنية»، عن طريق إخضاع ابنته لجراحة
تجميلية موازية»، ولكن دون القدرة على إرسال الإرث الثقيل، بأفكاره
العنصرية والرهابية الأثقل، إلى رفوف التاريخ. ولكي لا يشعر كاتب
الـ»إيكونوميست» بافتقاد حسّ الثورة في فرنسا، كان الراحل بيير بورديو،
أحد آخر المفكرين المحترمين في فرنسا المعاصرة، بين قلة قليلة ممّن
أقلقتهم هذه الحال، مبكراً؛ خاصة في قراءة شبكة العلاقات المعقدة بين
رأس المال المعاصر والخطابات ما بعد الحداثية، دون الوقوع في إغواء
الألعاب النظرية التي تطمس التاريخ كشرط أوّل لاستيعاب الحاضر.
ولم يكن غريباً، بالتالي، أن يشارك بورديو، ونفر قليل من ممثّلي هذه
الأقلية الفكرية، في اجتماع مع القيادات النقابية التي أدارت الإضراب
الكبير شبه الشامل الذي شلّ الحياة اليومية الفرنسية طيلة أسابيع،
أواخر العام 1995. ولم يكن غريباً، أيضاً، أن يضع إصبعه على الغور
العميق للجرح الحقيقي، أي اغتراب المجتمع الفرنسي بين خيارين أحلاهما
مرّ، شديد المرارة: الليبرالية الهوجاء التي تخبط في الإصلاح خبط
عشواء، والبربرية الوقحة لنفر من التكنوقراط يرون أنهم يعرفون الدرب
إلى سعادة الأمّة أكثر من الأمّة نفسها، قبلها وبعدها وفي غيابها إذا
اقتضى الحال. فكيف إذا اختلط الحابل بالنابل، اليوم، وتناطح أحد عشر
مرشحاً على أشبار محدودة من مساحة خبط العشواء هذه!
يومها عفّ بورديو عن التذكير بأنّ المواطن الفرنسي يعيش في نظام
ديمقراطي يعطيه الحق في ممارسة الإضراب، الشامل الكامل المفضي إلى شلل
شبه تامّ؛ مثلما يعطيه الحقّ في الذهاب إلى صندوق الاقتراع، ووضع
الورقة التي يشاء، منتخباً مَن يشاء. بمعنى آخر، في أواخر 1995 ـ كما
تكرر، أو سوف يتكرر، في كلّ جولة انتخابية، رئاسية أو تشريعية أو بلدية
ـ كان المواطن الفرنسي هو الذي انتخب هذا النفر من ممثليه؛ وكان يعرف ـ
أو توجّب عليه أن يعرف ـ جيداً أنّ البرامج القادمة ستكون هكذا. وكما
يحدث في كلّ مرّة، يمارس المواطن الفرنسي ما يشبه «فشّة الخلق» ضدّ
الجهاز الحاكم، رئيساً أو مجلساً وطنياً أو بلدية؛ ضدّ اليمين تارة،
وضدّ اليسار طوراً، في انتظار أن يكون لكلّ من اليمين المتطرف أو
اليسار المتمرد حصّة مستقبلية في العقاب!
وذات يوم أطلق جيم هوغلاند، المعلّق الأمريكي اليميني المحافظ، صفة
«الجنون» على حركات تظاهرات طلابية واسعة اجتاحت فرنسا سنة 2005،
احتجاجاً على ما عُرف باسم «عقد الوظيفة الأولى». ولقد ردّ هوغلاند
«جنون» تلك الأيام إلى جنون سنة 1789، أي عام الثورة الفرنسية التي لم
تبدّل وجه فرنسا مرّة وإلى الأبد، فحسب؛ بل قلبت أوروبا بأسرها، رأساً
على عقب. لكنّ المعلّق الأريب تعامى، عامداً بالطبع، عن الحقائق
الجوهرية التي تخصّ سلسلة مآزق الليبرالية الوحشية، والطور الراهن من
مآلات اقتصاد السوق وقوانينه. وتجاهل، كذلك، أنّ الظاهرة ليست منقطعة
الصلة عن اعتمالات الحاضر الفرنسي، الذي تتضاعف عواقبه كلّ يوم: داخل
الجمعية الوطنية، خلف الأعمدة الثقيلة لهذا الصرح التاريخي العريق الذي
شهد وقائع كبرى ليس أبرزها «إعلان حقوق الإنسان»؛ وغير بعيد عن ساحة
الكونكورد، حيث تذكّر المسلّة المصرية بأمجاد جنرال الثورة الفرنسية
نابليون بونابرت، وأمجاد التاريخ الاستعماري الفرنسي في آن معاً.
استطلاعات الرأي، إذا صحّت خلاصاتها حتى بنسبة ضئيلة، تشير إلى حيرة
الفرنسي بين يمين متطرف، ووسط ليبرالي ويمين تقليدي؛ ليس دون تلوينات
«يسارية» عند الوسط، أو حنين إلى إنزال العقاب عن طريق ترجيح التطرف.
وهذا، في حدود دنيا، قلق عميق حول الهوية، وذعر من مستقبل غامض أو شبه
غامض، وحذر من متغيرات عاتية… عناصر قد تأخذ الفرنسي على حين غرّة،
وتضعه بين مطرقة الليبرالية البربرية، وسندان الليبرالية التكنوقراطية،
على حدّ تعبير بورديو. ومنذ 1968، ثورة المجتمع المدني التي أسقطت
الجنرال/ الأيقونة عن عرش مكين، تبحث فرنسا ـ بصمت مخدَّر تارة، وبصخب
مؤلم طوراً ـ عن هوية فكرية وثقافية واجتماعية للخروج من حال تأرجح
طويلة بين الماضي والحاضر؛ وبين تراث الجار الألماني على مبعدة أمتار،
والحليف الأمريكي ما وراء المحيط.
وفي نحو اللغة الفرنسية ثمة صيغة فعل خاصة هي «الزمن الماضي الناقص»،
وكان عدد من المفكرين قد تتبعوا انتقال هذا الزمن من فقه اللغة إلى فقه
الحياة اليومية، ولم يجدوا صعوبة كبيرة في وصف الحاضر الفرنسي بالزمن
الماضي الناقص. أو، في تشخيص آخر، حال الحيرة بين رميم اليمين، ورماد
اليسار!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
(القدس العربي)
